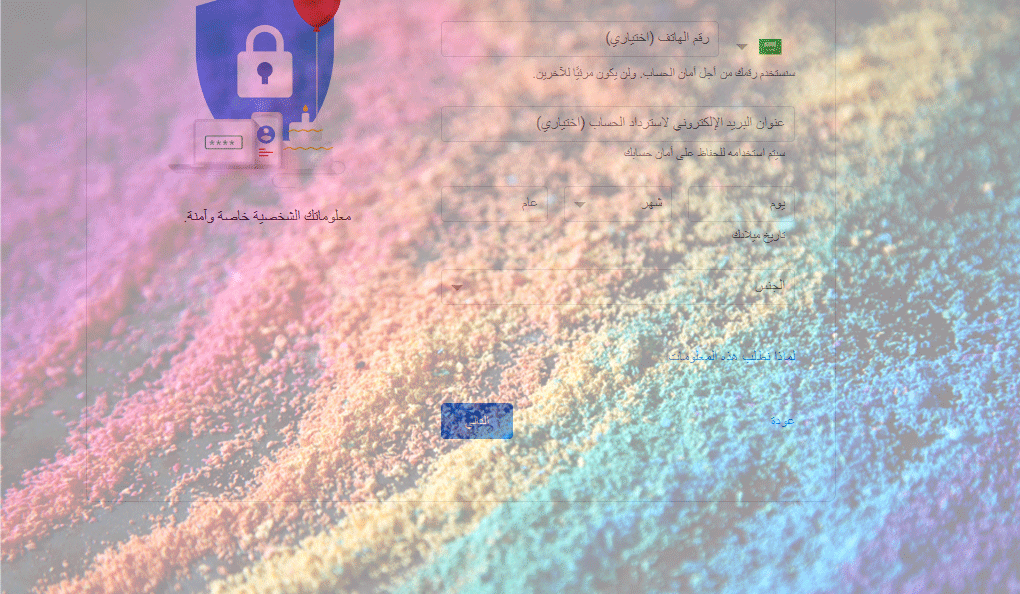- براندون أمبروسينو
- ترجمة: عبد الله الحربي
- تحرير: أسامة خالد العمرات
- مراجعة: مصطفى هندي
هل المعتقدات الروحية أو الدينية هي نتيجة حتميّة لعملية التطور؟ في هذا الجزء الثاني والأخير من السلسلة يقوم براندون أمبروسينو بتفحص الطّرق التي ساهمت في ظهور هذه المعتقدات نتيجة ميول نفسيّة قديمة.
عندما كنت في المدرسة الابتدائية كان دائماً ما يُذاع على التلفاز إعلانٌ عن التّحذير من المخدّرات بنسخ متعدّدة، ولكن حبكتُه تدور حول إظهار بيضة يصاحبها صوت يقول: هذا هو دماغك. ثم يليها تحطُّم البيضة على مقلاة، فيعلِّق نفس الصوت قائلاً: هذا هو دماغك تحت تأثير المخدرات! جميعنا فهم المقصود: وهو أنّ المخدرات تعبث بدماغك.
في كنيستي الخمسينيّة كان يتمّ الحديث عن المخدرات بطريقة مختلفة، كان يقال لنا بأنّنا لا نحتاجها، فنحن نستطيع الوصول للنّشوة عبر اللجوء إلى الرب! فالرب يستطيع أن يمنحنا تلك الفورة والشعور بالنّشوة دون أن تنتهي أدمغتنا أشبه ببيضة في مقلاة.
الرب يوفّر لنا الفوائد الإيجابية للهيروين دون آثاره الجانبية المدمرة (وبالطبع حين ننظر إلى كمية العنف الذي مُوْرِسَ باسم الدّين طوال التّاريخ، فمن المستحيل الادِّعاء بأنّه لا توجد آثار جانبية مدمّرة للإيمان بالرب، وسنفصِّل في ذلك لاحقاً).
لقد مضى زمن طويل منذ تركت كنسية الطّفولة، وأشعر غالباً بالإحراج حين أتذكَّر عقيدة أنّ “الرب كالمخدرات”.
لكن كلّما فكرت أكثر بالدين كظاهرة بارزة، أتساءل هل كان حديث قادة كنيستنا أثناء الصّغر (رغم كل مفرداتهم الكَنَسِيَّة المُشَوَّشَة) يحمل مغزى حول أنّ الإيمان بالإله يؤثّر على دماغك.
“هذا دماغك، وهذا دماغك بعد الإيمان بالرب”!
أندرو نيوبرغ عالم أعصاب يدرس الدّماغ تحت تأثير الخبرة الإيمانيّة، قضى مسيرته العلميّة مُتَتَبِّعاً لهذا الحَدْس، ليكتب قائلاً عن كيف يغيرالإيمان بالرب دماغك: “إذا تأمّلت الله لفترة كافية، شيءٌ مفاجئ يحدث في المخ، حيث تبدأ الوظائف الطبيعيّة بالتغيّر، ودوائر مختلفة تصبح فعّالة، وأخرى يتم تثبيطها؛ تشعّبات عصبيّة جديدة تتشكّل، ووصلات مشبكيّة تتجدّد، ويصبح المخ أكثر حساسية لعوالِمَ خفيّة من الخبرة؛ يتحوّل الإدراك، وتتغير المعتقدات، وإن كان الرب يعني لك شيئاً فإنّه يصبح في ذلك الوقت حقيقة عصبية”.
يحدثني د. نيوبرغ بمكتبه في بنسلفانيا كيف أنّ التجربة الدينيّة تحقّق عمليّتين أساسيّتين في الدماغ: العناية بالذات (كيف نعيش كأفراد وجنس بشري) والتعالي الذاتي (كيف نستمر بالتطوّر والتغيّر كأناس).
يقوم نيوبرغ وفريقه بمسح أدمغة المشاركين في نشاطات دينيّة كالصّلاة والتأمّل -مع أنّه حسب قوله لا يوجد جزء واحد من الدماغ يسهل هذه النشاطات- “فلو كان هناك جزء روحي فهو الدماغ بأكمله” ومع ذلك فهو يركز على هذين الأمرين.
هناك تعطيل للفص الجداري خلال أنشطة شعائرية معينة.
أولًا، الفَصُّ الجداري، الذي يقع في الجزء الأعلى الخلفيّ من القشرة الدماغيّة، حيث تتمُّ معالجة المعلومات الحسيّة، ويساعدنا على الشعور بالذات، ويمكننا من تأسيس علاقات بين الذات وبقية العالم كما يقول نيوبرغ. من المثير أنّه لاحظ تثبيطاً للفصّ الجداريّ خلال طقوس شعائريّة معيّنة.
“عندما نبدأ بممارسة مثل هذه الشعائر، ومع مرور الوقت، يظهر أنّ تلك المنطقة من الدّماغ تُغلق” كما يذكر نيوبرغ، ومع استمرارها بالسّكون، ولأنّها مسؤولة عن وعينا بذواتنا، يبدأ ذلك شعور إدراك الذّات بالتشوّش، وتتبخّر الحدود بين الذات وأي شيء آخر، سواء كان فرداً أو جماعة أو الرّب أو الكون، أيَّاً كان ما تظن أنّك مرتبط به، لتشعر بعدها بالتوحد معه.[1]
الجزء الآخر من الدّماغ المنخرط بكثافة في التجربة الدّينيّة هو الفصّ الجَبْهِيّ، الذي عادة ما يساعدنا على توجيه انتباهنا والتركيز على الأشياء كما يذكر نيوبرغ: “عندما تغلق تلك المنطقة فمن الممكن نظرياً أنْ يُعتبر ذلك كنوع من فقدان النّشاط الإرادي، أي أنّنا لا نتحكم في حدوث شيء ما، ولكنّنا فقط نستقبله”.
يظن نيوبرغ أنّ عمليات مسح الدّماغ التي قام بتجميعها قد تتوسل سؤالاً من قبيل: لماذا الدّماغ مصمّم بطريقة تُسَهِّلُ أنواعاً من التجارب الرُّوحيّة؟
ثم يُعقِّب قائلاً “إنْ كنت روحانياً أو متديّناً فالإجابة واضحة” ولكن حتى لو وضعنا جانباً أيَّ حديثٍ عن الرّب، فإنّنا لا نملك إلّا أن نتعجَّب من أنّ الدّماغ مصمّم بطرائق لا تُسَهِّلُ فقط الخبرات التي يَدرسها نيوبرغ، بل تُحفِّزُها كذلك، وهذه الخبرات يبدو أنّه لا يمكن تجاهلها كجزء من الوجود الإنساني.
“تفسير المعتقدات والسّلوكيّات الدّينيّة يوجد في الطريقة التي تَعمَل بها أدمغة البشر” هذا ما ذكره باسكال بوير في كتابه بعنوان “الدِّين مفسراً” وهو في الحقيقة يَقصد الدّماغ بكامله كما يقول، لأنّ ما يهم بالنّسبة للنّقاش هو خصائص الدّماغ التي توجد في أعضاء فصيلتنا الذين يتمتّعون بأدمغة طبيعية.
ولننظر إلى بعض هذه الخصائص، ونبدأ بخاصيّة تُعرَف بخاصيّة استشعار المؤثّرات شديدة الحساسيّة (HADD).
تخيّل أنّك في سهول السّافانا، وفجأة تسمع حفيفاً بين الشُّجيرات، ماذا ستقول لنفسك؟ هل هي مجرد رياح وأنا بخير تماماً حيث أنا، أم أنّه حيوان مفترس وهذا وقت الهرب!
من منظور تطوُّريّ، يبدو الخيار الثّاني منطقيّاً أكثر، فإنْ اتّخذْتَ خيار الهرب ووجدت بعده أنّ تلك الخشخشة ليست أكثر من رياح؛ عندها أنت لم تخسر شيئاً، ولكن لو قررت تجاهل ذلك الصوت، وظهر فعلاً أنّه حيوان مفترس مستعد للقفز عليك؛ فتصبح فريسة.
العالِم المتخصّص بالوعي جستن باريت أمضى تاريخه العلمي دارساً لمعمار الوعي الذي يبدو أنّه يسلّم نفسه بطريقة طبيعيّة للمعتقدات الدّينيّة، ومن وظائف الوعي التي يهتمُّ بها باريت وظيفة استشعار المؤثرات (HADD).
إنّها هذه الخاصية في الحيوانات الرئيسة المؤمنة (كما يذكر باريت) التي التي تجعلنا نعزو التأثير للأشياء والأصوات التي نواجهها؛ إنّها السبب الذي يجعلنا نحبس أنفاسنا إذا سمعنا وقع خطوات في الغرفة المجاورة التي افترضنا أنها فارغة!
يقول باريت إنّ أداة التّحسُّس هذه تجعلنا نَنْسِب الفاعليّة والتأثير لأحداث دون دليل ماديّ واضح من قبيل (ذهب الصُّداع بعد أن أدّيت الصلاة) أو كالأنماط المحيّرة التي تتحدى أيّ تفسير بسيط مثل (لا بد أنّ أحدهم رسم دوائر حقل الذرة تلك) هذا ما يكون عليه الأمر تحديداً حين تكون الأمور في المِحكِّ، ويضيف باريت إنّ الصّياد الجائع الذي يطلب حاجته؛ سيجد خاصيّة استشعار المؤثرات (HADD) مفيدة أكثر من الصّياد الذي يسعى فقط للترفيه.
أداة الاستشعار (HADD) هي ما يسمِّيه باريت بالتفكير غير التأملي، الذي دائماً ما يعمل في أدمغتنا حتى دون إدراك منا، بينما الأفكار التأملية في المقابل هي ما نفكر فيه بنشاط وقصد. الأفكار غير التأملية تأتي من أدوات عقليّة متنوعة وهي ما يسميه (بالنظام المرجعي الحَدْسِي)، إضافة لخاصيّة الاستشعار المذكورة، وتتضمَّن هذه الأدوات العقلية: العمليات الحيوية والفيزيائية البسيطة، والأخلاق الفطرية، وعمليات الفيزياء البسيطة. وكمثال، فإنّ هذه العمليات هي السبب في أنّ الأطفال يعلمون بشكل حدسي أنّ مادة جامدة لا يمكن أن تمرَّ عبر مادّة جامدة أخرى، وأنّ الأشياء تقع إذا لم يكن ممسكاً بها، وفي حالة الأخلاق البديهيّة، اقترَحَتْ آخر الأبحاث أنّ تقييم الرُّضّع بعمر ثلاثة شهور لتصرفات الآخرين بأنّها اجتماعيّة أو عدائيّة تتوافق مع الأحكام الاخلاقية للبالغين.
ويفترض باريت أنّ الأفكار غير التأمليّة مهمة في تكوين الأفكار التأمليّة، “كلما اندمجت الأفكار غير التأملية أكثر؛ كلّما كانت الأفكار التّأمليّة أكثر قابليّة للتّحقق” فإذا أردنا تقييم أفكار البشر التأمليّة عن الله؛ فلعلّنا أنْ نبدأ بفهم ماذا لو كانت هذه المعتقدات مغروزة في الأفكار البديهيّة غير التأملية؟
لكن كيف يُمْكِنُنا الانتقال من أفكار غير تأملية مثل خاصية الاستشعار (HADD) والعمليات الحيوية البسيطة إلى أخرى تأمليّة مثل أنّ هناك إلهاً يكافئ الصّالحين ويعاقب الطالحين؟ هنا يستحضر باريت مفهوم: عمليات الحد الأدنى غير الحدسية (MCI) والتي تكون غالباً مرشحّاً قوياً لِلَعِبِ دور النّواقل الثّقافيّة.
مفاهيم (MCI) هي أساساً مفاهيم حدسيّة، لكن مع تعديل صغير أو اثنين وفي ورقة بحثيّة أخرى، يضرب باريت مثال البِساط الطّائر حين يتصرّف كبساط عادي في كافة الأحوال ما عدا واحدة، “مثل هذه الأفكار تَجْمَع سهولة المعالجة وكفاءة الأفكار البديهيّة مع ما يكفي من الرّقي لتوجيه الانتباه، ومن ثمّ الحصول على معالجة أعمق”.
ليس من المفاجئ إذاً بأنّ دراسات مقارنة الثّقافات تُظْهِر سهولة استدعاء ومشاركة مفاهيم (MCI) ويوجد سببان لذلك كما يقول باريت: أولاً، أنها تحافظ على تركيبها المفاهيمي، وثانياً، ميولها للبروز بين طائفة من المفاهيم العاديّة، ويُعقِّب: “أيُّهما يُلفت انتباهك أكثر: تلك البطاطس البنيّة التي تزن رطلين أم تلك الخفيفة؟”
المعتقدات الإيمانيّة مشتركة، حيث تشترك فيها حيوانات بشريّة تتقاسم نفس التشريح العصبي، وصندوق أدواتنا العقلية يحوي تحيُّزات مدمجة، مثل خاصيّة (HADD) المسؤولة عن عدد من المحفزات الكاذبة (كأنْ تظنَّ بأنّ الصوت الذي تسمعه غالباً سببه الرياح!) وبالنّسبة لأدمغة يبدو أنّها مُجهَّزة لإيجاد المؤثرات بكل مكان؛ فمن الطّبيعي جداً أنْ يظهر الدِّين هنا.
كما يذكر دانييل دانيت بأنّ تبنينا لوضعيّة القصد والتّحكم يشكل جزءاً كبيراً منّا، لدرجة أنّنا نجد صعوبة في التّخلي عنها، خصوصاً بعد موت شخص مُقرّب، حيث يواجهنا ذلك بمهمّة كبيرة من تحديث الوعي، ومراجعة جميع عادات أفكارنا لتناسب عالَمَاً يحوي نظاماً أقلّ تحكُّماً، لذلك نتحدث عمَّن فقدنا وكأنهم معنا يسردون قصصاً عنهم، ونذكّر أنفسنا أنّهم سيدعمون قراراتنا.
باختصار، نحن نبقيهم حولنا، لكن ليس بأجسادهم. وبالتّأكيد يَظهَر أنّ الدِّين أكثر علاقة بالموت منه بالأجساد الفانية، لهذا السّبب اقترح بعضهم أنّ أوّل نماذج المؤثرات غير الطبيعيّة كانت أطياف الراحلين الشبحيّة التي تخالف حدسنا، وتتصرّف كتصرفاتنا، ما عدا أنّها تمرّ عبر الجدران.
وقريباً من فكرة المؤثّرات الفاعلة ما يصفه دينيت بظاهرة كشف الأوراق، فاستشعار المؤثّرات الفاعلة يحمل معه مخاطِرَهُ الخّاصّة من قبيل: هل تعلم عن ذلك الشيء السيئ الذي فعلته؟ كيف أستطيع أن أعرف انطباعك عنّي بسببه؟ هذه تساؤلات معقّدة، والناس لا يجيدون إدارة كل الخيارات، ما يحتاجه الجميع للخوض في هذه المياه الضّحلة هو تعلّم قواعد اللعبة بكشف جميع الأوراق لهم، ومرشدنا يكون فاعلاً مطّلعاً وبقدرة وصول كليّة يشاهد كل شيء، ويوجّهنا بناءً عليه.
ومرشدنا الفاعل صاحب القدرة الكليّة -كما يقول دينيت- كان الأجدادَ الفانين، ولكن مؤخّراً بدأنا نرى بذور هذه الفكرة تتشكل في عقائد لاهُوتيّة عدّة.[2]
“البشر لا يتصرّفون جيّداً لأنّك تعاقبهم على عدم التّصرّف الجيّد” كما يقول العالِم التطوّري النّفسي روبن دنبار (وإلا لكنا كُلّنا نقود بسرعة أقلّ من 70 ميلاً على الطرق السّريعة، فالمشكلة الحقيقية ليست سوء العقوبة، ولكن ما احتمال خطورة أنْ يتمّ الإمساك بك، فكلّما كانت هذه المخاطرة أقل؛ كلما كنت أكثر جرأة على التعرُّض للعقوبة).
كان هذا موضوعاً مهمّاً في عصور ما قبل التاريخ، حين تَنْمو مجتمعات الصّيادين، كان لا بد من فرض نظام عقوبات، لكن كلّما زاد حجم الجماعة؛ كلّما زادت فرصة الإفلات من اكتشاف الخطيئة.
ويقول دنبار: لا أحد يرى ما تفعل ليلة السبت ما عدا شخص واحد، فكن حذِراً.
هذه الفكرة كانت ثابتة مع أدوات العقل البديهيّة، مثل خاصيّة استشعار المؤثرات (HADD) والأخلاق الفطريّة، لذلك رَسَخَتْ بشكل جيد في أدمغة أجدادنا المتطوّرة، إضافة لترتيبها هرم سلوكياتنا من أسفل لأعلى.
يضيف دنبار: “دائماً ما تصبح أفضل سلوكيّاً مع التزامك الفردي أكثر من الإجبار”.
وكما تم مناقشته في الجزء الأول من هذه السّلسلة فإنّ الأخلاق تسبق الدِّين، وهذا شيء منطقيّ بكل تأكيد مع ما نعرفه عن الأصول القديمة للمشاعر والعاطفة، لكن يظل السؤال: لماذا أصبحت الأخلاق مرتبطة بشكل واضح مع الدِّين؟ يعزو بوير أسباب هذه العلاقة في أخلاقنا الفِطرية ومعتقداتنا بأنّ الرّب والأجداد الراحلين أطرافٌ مهمّون في خياراتنا الأخلاقية.
الأخلاق الفطرية تفترض أنّك إذا استطعت رؤية وضع معين رؤيةً شاملةً دون أيّ تشويش؛ فستعرف مباشرةً إنْ كان صحيحاً أو خاطئاً، فالمفاهيم الدّينية هي مفاهيم لأشخاص لديهم رؤية شاملة لوضع ما.
ولتفترض أنّني فعلت شيئاً يجعلني مُذنباً، هذه طريقة أخرى للقول بأنّ أحدهم لديه بيانات استراتيجية عن فعلي ليحكم عليه بالخطأ، الدِّين يخبرني إنّ هذا الشخص موجود ويشرح لي لماذا كان فعلي خاطئاً منذ البداية، ويُلخّص بوير المسألة بقوله: معظم أحكامنا الأخلاقية الفطريّة واضحة، لكن أصولها مجهولة لنا، وفهم هذه الأحكام على أنّها رؤية شخص ما هي طريقة بسيطة لاستيعاب لماذا هي مغروسة فينا. ومع ذلك يكمل بوير: “المفاهيم الدّينية تعتاش على أخلاقنا الفطريّة”.
نحن نميل للظن بأنّ معتقداتنا الدِّينية هي نتاج تأملات شخصية، لكنّها في الحقيقة نتاج اجتماعي، وهذا ليس مفاجئاً، حيث إنّني أفترض خلال جزئي هذا من الأطروحة أنّ الدِّين ظهر من خلال عملية تطورية أجبرت القرود العُليا على أن تكون اجتماعية!
لكن الإشكاليّة التي تحدث عند ارتفاع مستوى الجماعيّة هي المحافظة عليها، كما يشرح دنبار؛ فقبل أن يستقر أجدادنا البدائيّون في القرى، كانوا يستطيعون الانتقال من جماعة لأخرى عند ارتفاع التوتّرات، لكنهم بعد الاستقرار واجهوا مشكلة جِديّة، وهي أنّه كيف نمنع الجميع من قتل بعضهم البعض؟ هنا تبرز ظاهرة التّلامس.
عملية تكوين العلاقات تعتمد على نظام الإندروفين في المخ، والتي يتم تحفيزها عبر نشاط التلامس الجماعي عبر لمس وتمشيط أعضاء الجماعة لبعضهم البعض، لكن عندما نصل للجماعات الكبيرة -كما يذكر دنبار- يصبح لنشاط التلامس عيبان، أولاً، لا يمكن تمشيط إلا فرد واحد كل مرة، وثانياً، مستوى الحميمية عبر التلامس ينحصر في العلاقات القريبة.
البيانات الاخيرة تُبيّن أنّ أعلى نسبة تلامس وتمشيط يومي للثديّات العُليا تساوي 20% من مجمل نشاطها، ويحسب دنبار أنّ هذا الحد هو لمجموعة حجمها أقل من 70 فرداً، والذي يَقِلُّ كثيراً عن قدرات المجموعات عند البشر المعاصرين، والتي تصل إلى 150 فرداً، وكانت المشكلة تكمن في كيفية إيجاد طريقة لتحفيز الترابط الاجتماعي دون تلامس. الموسيقى والضحك كانت حلولاً جيدة وتخلق نفس تأثير إفراز الاندروفين عند التلامس والتمشيط في الثدييات العُليا، واللغة تفيد أيضاً، وهي نظرية ناقشها دنبار بكثافة في كتابه “التلامس والثرثرة وتطور اللغة”، لأن هذه التأثيرات يمكن تحقيقها دون تلامس، والترابط الاجتماعي يمكن حدوثه بشكل أوسع وأكبر.
يجادل دنبار أنّ الدِّين تطوّر كوسيلة للسّماح للعديد من النّاس دفعة واحدةً أن يستفيدوا من عمليّة تحفيز الاندروفين، والعديد من الشعائرالمتعلقة بالدِّين مثل الغناء والرقص واتخاذ وضعيات متنوعة للعبادة؛ هي محفزاتٌ جيّدة لتنشيط عملية إفراز الاندروفين لأنها تفرض جهداً وألمَاً على الجسم.
إحدى طقوس الدِّيانات الشّامانيّة -كما يقول دنبار- (وهي أحد أقدم المعتقدات شِبه الدِّينيّة) كانت تتضمّن رقص النشوة لأجل استعادة التّوازن الاجتماعي، ويعمل ذلك تحديداً من أجل زيادة التّرابط كما يقول، وكانوا يلجؤون إليه عندما تشتدُّ الأمور بينهم، ويبلغ ضِيقهم مداه، ثم يقولون لبعضهم هيا بنا ننتشي بالرقص.
يكمل دنبار قائلاً إنّ التأثير الكيميائي لفعالية الرقص حتى الانتشاء، كان نفس تأثير عملية التلامس والتّمشيط في الثّدييات العُليا، فالعديد من الأفراد المنخرطين يشعرون بزيادة الترابط بقوة بينهم، ولكن قد لا يستوعبون معنى ذلك كلّه.
يضيف دنبار “أنت تخرج من هذه الفعاليات مليئاً بالراحة والسّلام والشعور بالارتباط مع الأفراد الذين شاركوك، ثم تبدأ تتساءل عن مغزى كل ذلك، وكم هو جيد شعورك بعدها، ثمّ تقابل بعض الّلاهوتيين العباقرة الذين يشرحون لك معنى هذه الممارسات، لتصبح بعدها أكثر استعداداً لتَقَبُّل المزيد من التعاليم الدينية!”.
لكن هذه الرّقصات المتباعدة كانت فعّالة حتى بدأت السُّلالات الأولى من البشر بالاستقرار، وحالما بدأ الصّيادون الرُّحَّل في تأسيس مُستوطنات دائمة قبل 12000 عام تقريباً؛ أصبح هناك حاجة لشيء أكثر متانة لتشجيع السُّكان على التصرف بشكل اجتماعي تجاه بعضهم، خصوصاً مع زيادة التّوتُّر المرافقة للعيش بهذه التجمعات الكبيرة والإجبارية، ويمكن لرقصات الإنتشاء أن تحدث في هذه المجتمعات بشكل روتيني -لنقل شهريّاً- ولكن كان هناك احتياج لطقوس منظَّمَة لتحفيز التماسك الاجتماعي.
تزامَنَ تكوين المستوطنات الأولى مع اكتشاف الزراعة، حيث بدأت ثورة ما بعد العصر الحجري الزّراعية في الهلال الخصيب، والذي يُشار له أحياناً بمهد الإنسانية، هنا -كما يقول دنبار- كانت أُوْلَى مساحات الطقوس الشعائرية وأقدمها؛ موقع جوبكلي تبي جنوب شرق تركيا، والذي تمت معاينته لأوّل مرة في السّتينيات، وتم تنقيبه مابين 1996-2014 من قبل فريق بقيادة عالم الآثار الألماني كلاوس شميدت، وفي مجلة سميسثونيان أشار شميدت عام 2008 للموقع بأنّه يحوي على تلِّهِ أُوْلَى الكاتدرائيات الإنسانيّة، جوبكلي تبي والتي تعني التّلّة المنتفخة بالتركية، كان موقعاً غير سكني، يحوي معابد متعددة مبنية من العواميد، ويقدر عمرها بـ 10000 عام قبل الميلاد تقريباً.
وكما يذكر المؤرّخ ديفيد كريستيان في قصة الأنواع “تاريخ شامل لكل شيء” كانت الزّراعة ابتكاراً ضخماً، وشكّلت عتبة كبيرة، ما إنْ تمّ تخطِّيها حتى بدأت رحلة عاصفة حملت البشر الأوائل نحو تكوين المجتمعات المعقدة التي سيطرت على تاريخنا المعاصر، فتضاعف النمو السّكاني، وشهدت المستوطنات الضخمة زيادة في التعقيد الاجتماعي، وشبكات سياسية واقتصادية وعسكرية على نطاق واسع.
ولاستيعاب جماعاتٍ بهذا الحجم؛ كان على التّصورات الأولى عن القرابة أن يتم تعديلها بقوانين جديدة عن التّملك والحقوق والطبقية والسلطة، والنتيجة لهذا التوجُّه كانت مفاهيم عن التخصيص مما قاد لتقسيمات مختلفة للطبقات، فالبعض كان حاكماً والبعض تاجراً وآخرون كانوا قساوسة.
ويقول عالِم الاجتماع روبرت بيلا إنّه وعلى النقيض من الخبرات الدِّينية لمجتمعات الصّيد القديمة؛ كانت الطقوس الدِّينية لمجتمعات العصر الحجري الحديث تركز قبل كل شيء على مركز واحد؛ الملك المُقدَّس أو شِبه المُقدّس، وبضعة كهنة أو بعض أفراد السُّلالة الملكيّة، وخلال هذه الفترة اندمج الإله والملك، واستمروا في تلك العلاقة الخاصّة عبر التاريخ.
بالنهاية، وصلت تلك العلاقة لعَقَبَةٍ خلال ما يعرف بالعصر المِحوريّ، وهو مصطلح نَحَتَه الفيلسوف كارل جاسبر، وهو يشير إلى وقت من التغيّرات العاصفة، حدثت في الصين والهند وإيران وفلسطين واليونان خلال القرن الأول قبل الميلاد.
عندئذ، يفترض جاسبر أنَ الإنسان بدأ بالوعي بوجوده ككل، وباختبار الحقيقة المطلقة بتواصله مع الكائن المُتعالي، هنا أخذ جنسنا البشري خطوته نحو العالميّة.
يظلُّ مفهوم العصر المحوري كما وضعه جاسبر مثارَ نقاشٍ، فليس هناك خلاف حول متى وماذا، ولكن كما يقول بيلا بأنّ تاريخ جاسبر يشبه فلسفته الوجودية، فعند مناقشة مسألة العصر المحوري من السهل علينا قراءة التاريخ من خلال ما افترضناه مسبقاً، ومع ذلك، يظنّ بيلا أنّ مفهوم العصر المحوريّ يستحق المناقشة مع بعض التحفّظات، فلو وضعنا جاسبر جانباً، فمن المستحيل إنكار حدوث تحولات معرفيّة ضخمة وسريعة في القرن الأول قبل الميلاد، وحين سألت دنبار إنْ كان يتقبل فرضيّة العصر المحوري؟ قال: إنْ كنتَ تقصد حقبة من التحولات حصل خلالها ظهور سريع ومفاجئ لديانات وطقوس وعقائد؛ فالجواب نعم.
إذاً، ما الذي كان محورياً في العصر المحوري؟
أولا: كل القفزات المهمة حدثت خارج المراكز الإمبراطوريّة.
ويضيف بيلا: زيادة التنافس بين الدول سمح بظهور مفكرين متنقلين لا ينتمون لكيانات كهنوتية أو بيروقراطية، تلك الشّخصيات المحورية استطاعت نقد المراكز الحضريّة من الأطراف، والحقيقة أنّ أحد المؤرخين وصف العصر المحوري بعصر النقد.
يضيف بيلا بأنّ السؤال المركزي خلال تلك الفترة التقدمية كان: من هو الملك الفعلي الذي يمثّل العدالة؟
حتى ذلك الوقت كان أفلاطون في اليونان ينصح الناس بعدم النّظر لأخيل الارستقراطي، بل إلى سقراط.
وفي الهند، كان بوذا هو الشخص الذي تخلّى عن حقّه الملكيّ، وفي فلسطين كانت قُدسِيَّة الملك المقدّس تحطمها تلك الآثار عن إله اليهود وهو يُنصِّب ويُزيح الملوك بإرادته.
باختصار، يجادل بيلا بأنّ العصر المحوري كان حول القدرة على تصور نماذج واقعيّة جديدة، واعتبارها بدائل مفضّلة لتلك الموجودة، ومفتاح هذا التحوّل نحو النقد؛ كان ابتكار الكتابة والقدرة على صنع ذاكرة حفظ خارجية؛ بدونها لم يكن الجسر ما بين العصر الحجري المتأخر والإنسان الحديث ليظهر كما يقرر بيلا.
فمن دون القدرة على تخزين المعلومات خارج الدماغ، لم يكن البشر قادرين على التفكير النقدي أو التفكير في التفكير نفسه، وبدون ذلك لن يقدروا على تنظيم تجاربهم الدِّينية على نحو لاهوتيّ مفصّل.
يضيف بيلا: إنّه بالتأكيد كان هناك تنظير وتحليل قبل ظهور الكتابة، ولا يجب أن نغفل أنّ التراث الشفهي والكتابي يتداخل بطرق تجعل من الصّعب الإحالة إلى عامل واحد بأنه العامل الوحيد في الثقافة، ومع ذلك يجب ألّا نقلّل من أهمية الكلمات المكتوبة، والتي سمحت للمَرويَّات أن تدوِّن وتدرس وتقارن، ممّا سمح بزيادة القابلية للتأمل النقدي.
وكما يرى بيلا فإنّ نوعية التفكير التي ظهرت في العصر المحوري كان التفكير في عمليّة التفكير والنظر في النظريّة، إنّه التفكير النقديّ الذي قاد للتقدم الدِّيني والفلسفي، ليس فقط التقييم النقدي لِمَا تمّ طرحه، ولكن فهم جديد لطبيعة الواقع، وانطباع عن الحقيقة يمكن من خلاله الحكم على العبارات المزيفة وأنّ الحقيقة مشتركة وعالميّة وليست محليّة.
المؤرخ أنتوني بلاك لديه تحفظات كبيرة حول فرضيّة جاسبر عن العصر المحوري، ومع ذلك يتفق بأنّ نفس تلك الفترة تقريباً تطورت مقاربة نحو الذات والكون ووعي أكثر منطقية وتأمل، وبنفس الوقت أكثر وضوحاً، فما كان موجودا لم يكن أقلّ من تفسيرات لخبراتنا ومجموعة أهداف جديدة.
باختصار، يقرر جاسبر بأنّ ما يجعل العصر المحوري محورياً هو أنّه مستمر معنا إلى اليوم، فالأنماط الأساسيّة التي ما نزال نفكّر من خلالها، وبذور أديان العالَم التي ما زال البشر يتمسكون بها؛ تكونت في تلك الحقبة.
وبالطبع مرّت تلك الأديان والفلسفات ببعض التغيّرات، لكنها تمثّل شيئاً انبثقت منه كل الأديان المؤسسيّة المعاصرة.
كلمات “هذا جسدي” التي تُقال في قُدّاس الكنسية، وجهت تفكيري خلال هذه الرّحلة المكوّنة من جزأين نحو أصل الأديان، والتركيزُ دائماً ما كان على التجسُّد -نحن والمسيح وحواريوه أو أجدادهم من اليهود أوالصيّادون الرُّحَّل أو حتى أشباه البشر وقرود الشمبانزي والغوريلا.
أجسامنا تشعر وتتصرف بطريقة دِينية لأنّ ذلك التَّجسُّد الذي أصبح بالنهاية تجسُّدنا نحن، كان استجابة لضغوط بيئيّة (بيولوجية واجتماعية) كي نزدهر، والعديد من هذه التّطورات حدثت لأنّ الطّبيعة ضغطت على سلالتنا البشريّة كي نصبح اجتماعيين أكثر، وتتعايش أعداد غير مسبوقة من الأفراد بجوار بعضهم.
الدمج الاجتماعي كان لا بد أنْ يستمر ويدعم، لكن أسلوب التلامس الحميمي المجرّب لم يعد مُمكناً لأنّه محظور بتلك المرحلة.
طقوس معيّنة كالرقص، كانت قادرة على إنتاج نفس التأثير الهرموني لدى من يؤدونها، وأصبح الصيّادون الرُّحَّل السابقون يمارسونها بتكرار، خصوصاً مع ازدياد حجم جماعاتهم.
بالنهاية، استقرّ هؤلاء الصيادون في مستوطنات دائمة، والتي استلزمت تنظيماً اجتماعياً أكثر لتخفيف التوتُّر الناتج من العيش في مجموعات متجاورة، ومع تطور قُدرة الدّماغ على اكتشاف المؤثّر الفاعِل والأخلاق الفطرية، ظهر الدِّين شبه المنهجي بشكل طبيعي، ورسّخت هذه البذور جذورها خلال ثورة العصر الحجري الحديث، والتي مَهَّدت الطّريق لما يسمى بالعصر المحوري وأفكاره الرئيسة من الكونفوشيوسيّة إلى اليهوديّة والفلسفة اليونانيّة المستمرة معنا إلى اليوم.
على الأقل، هذه طريقة واحدة لسرد القصّة، وهناك قصص أخرى قد تُصيب الحقيقة أكثر من التي بين أيدينا.
المعرفة البشرية عن ماضينا خصوصاً دائمةُ التطور، لذلك نظرياتنا تبقى ما بين مثبتّة ومعدّلة أو منسيّة، ومهما تعلَّمنا عن تاريخ الأديان، نستطيع أن نتأكّد بأنّ مناهج حياتنا الدِّينية لديها جذور تاريخية عميقة في شجرتنا التطورية.
لكن ماذا عن مستقبلنا الدِّيني؟
يجادل البعض، بما أنّنا أصبحنا نعرف كيف ولماذا تطوّر الدِّين، فلدينا القدرة على ترك هذا الشيء السّاذج والبدائي وراء ظهورنا.
ويجادل آخرون بأنّه من الأفضل لنا أن نتخلى عن الدِّين، لأنّه مثل الفيروس قد أصاب جنسنا البشري، وجعلنا نرتكب مجازر مريعة حول العالم، ومن الأجدى أن نجعل العلم التجريبيّ والعقلانية تساعدنا على المضيِّ قُدماً، لكن وجهة النظر هذه قاصرة لأسباب منها: أنّ العلم التجريبي غير محايد، بل إنّه أيضاً تسبب في بعض أسوأ وقائع التاريخ كالقنبلة الذرية، والعُقم وحروب الطائرات بلا طيار، فهل يجب علينا هجر العِلم التجريبي بسبب تاريخه الملطّخ بالدماء؟ بالطبع لا.
نقدُنا للمؤسّسات البشريّة يجب ألّا يعمينا عن إسهاماتها الإيجابية عبر العالم، ولا أحد منّا يجب عليه إنكار الجانب النّبيل أو السيئ في تاريخ الأديان، عوضاً عن ذلك، يجدر بنا التّعرّف على هذا التّاريخ وتقديره حيثما نستطيع، وأن ندقّق فيه ما أمكن، ونتقدّم نحو المستقبل الفسيح أمامنا بعيون مفتوحة.
ومهما كانت نهاية هذا المستقبل، فيبدو حتى هذه اللحظة أنّ البشر سيستمرون بالوجود بشكل أو بآخر، وسنظلّ وقتها ترافقنا آمالنا ومخاوفنا ومشاعرنا وأنماطنا الاجتماعية، ونوبات فرحنا وتساؤلاتنا، جميع هذه القدرات التي تداخلت مع بعضها سابقاً بالطريقة المناسبة لتسمح للدِّين أن ينبثق ويزدهر عبر الكوكب بأكمله.
الدين مرتبط بقوة بكل شيء نعرفه عن نوعنا البشري، إلى درجة أن تخيّل مستقبلاً إنسانيّاً بلا عاطفة دينيّة، هو أمر شبه مستحيل.
يقول عالم الثّدييات الرئيسيّة فرانز دي وال: “لا أظنُّ بأنّ الدِّين سيختفي، ولا أعتقد أنّ ذلك خيار واقعي لجنسنا البشري، قد يتم استبداله بشيء أفضل، لكنه لن يختفي”.
ويبدو أنّ الخيار الأفضل للعديد من الناس سيكون الدِّين بلا تعاليم أو رتب هرمية، وقد أشار العديد من الباحثين إلى أنّه مع تناقص عدد الحاضرين للكنائس في الغرب، لكن وبنفس الوقت كان هناك تزايد ملحوظ في المشاعر الروحانية، أي ما يسمى بظاهرة التجربة الرُّوحيّة دون اعتناق دين (SBNR).
الروحانية بهذا المعنى، هي ما عرّفها أحد الباحثين بأنّها التزام الفرد بقِيَمِهِ الشخصيّة حول العلاقة بينه وبين الآخرين والطبيعة وما هو متعالٍ.
وفي إحصائية عام 2017 شملت 15 دولة غربيّة صرّح 64% من معتنقي التوجّه الروحاني غير الدِّيني بأنّهم رغم عدم إيمانهم بالرّب، كما وُصِفَ في الإنجيل، لكنّهم مع ذلك يعتقدون بقوة أعلى.
أشار البعض الى موجة (SBNR) الرّوحانية كمثال آخر لثقافة افعلها بنفسك (حيث لا حاجة لخبير أو مختص) عبر ممارسة ما يُشعرك بالتوحد مع ما هو متجاوز، وليس مفاجئاً بأنّ اليوغا والتأمل والتداوي بأحجار الكريستال تزداد شعبية.
وممّا يستحق الإشارة أنّ غالبيّة الأمريكيين المسيحيّين يؤمنون على الأقل بواحد من معتقدات العصر الحديث، كالتناسخ وعلم الأبراج مثلاً، حسب دراسة لمعهد بيو، ممّا يعني أنّه حتى أولئك الذين ينتمون لأديان تقليديّة قد يمارسون ما هو غير تقليدي، وبلا شك أنّ هذا التوجّه نحو التوفيق بين المعتقدات هو شاهد على العولمة.
فيليب تيليتش وهو أحد أشهر لاهوتيِّي القرن العشرين، طوّر نظريّة التّرابط اللاهوتي، حيث ينبغي على الإجابات التي يقدّمها الدِّين أن تتوافق مع الاسئلة التي تطرحها حضارة ما، وإنّ قَصَّر عن تحقيق ذلك يصبح هذا الدِّين غير مهم، ويبدو أنّ أغلب العقائد اللاهوتية ذائعةُ الصّيت، التي يدعو لها أشهر معتنقي الدِّين قد فشلت تحديداً في هذا الجانب، لذلك قرّر العديد من النّاس إحالة أسئلتهم لمكان آخر.[3]
لكن تظلُّ الأسئلة قائمة طالما أنّنا موجودون، “تلك الحيوانات الإنسانية التي تم تصميم أدمغتها لمسح ذلك الخط الفاصل بين الذات والآخرين” كما يقول دي وال.
سنظل دائماً باحثين عن تلك الفعاليّات، كالرّقص والصلاة والقُدّاس، التي تُذكِّرُنا وتعزّز بنفس الوقت طَمْس هذا الخط الفاصل.
مركز الدِّين -كما يذكر دنبار- هو اهتمام صوفيٌّ بالانتماء، اهتمام يسبق ويتجاوز الوجود الإنساني الذي سيقال بالنهاية أنّه شَغَل حيّزاً ضيّقاً من المكان والزمان في القصة الكونيّة العظيمة لهذا العالم.
اقرأ ايضاً: الحاجة إلى الهداية
[1] – وهذا الكلام يقترب كثيرا مما يحكيه الصوفية، كالفناء عن شهود السوي وغيره من أنواع الفناء، وأيضا يتشابه مع تجارب شهود وحدة الوجود التي يتحدث عنها المتصوفة. (المراجع)
[2] – الملفت للنظر أن دينيت ممن “يصلون” للعلم التجريبي ليل نهار، ثم ها هو ذا يتحدث بـ “يحتمل” و “من الممكن” دون أن يكون معه دليل علمي على ما يقول. (المراجع)
[3] – هذه وجهة نظر الكاتب، وظاهر جدا ما بها من خلل، ولا تعبر بالضرورة عن رؤية الموقع.