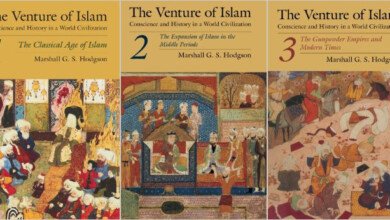- د. إسماعيل العبودي
عنوان الكتاب: الاستدلال في علم الكلام الأشعري
المؤلف: يوسف مدراري
الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت-لبنان
سنة النشر: 2020
عدد الصفحات: 393
يتميز كتاب الاستدلال في علم الكلام الأشعري أنه كشف عن من استفاد منه واعتمده في بحثه؛ وبهذا سهل على المراجع مساءلة المؤلف في حدود ما قدمه من توجه ومراجع، انطلق المؤلف في المقدمة من أسئلة دقيقة إثارتها بحد ذاته هو إضافة معرفية؛ لأنها بهذا التحديد تؤطر النقاش العلمي في الاستدلال الكلامي، والنظري الإسلامي بشكل عام، فكما يرى المؤلف أن الاستدلال في علم الكلام الأشعري يهدف إلى تحديد الأدوات المنهجية العقلية للنظر العلمي الإسلامي، وينطلق المؤلف من فرضية أن غالب مواضيع علم الكلام عبارة عن ردة فعل على الفلسفة اليونانية، وتساءل المؤلف عن سبب غياب أو ضعف المنطقيات في كتب علم الكلام بالرغم من وجود مباحث الطبيعيات في كتب علم الكلام، ثم قدم المؤلف إطاراً آخر من منهجيته وهو مباحث ابن خلدون في علم الكلام الأشعري، وأسئلتها التي طرحها، وأضاف إلى هذا نقد ابن تيمية الفقهي لأدلة علم الكلام، ونقله عن المتكلمين رفضهم للمنطق، وابن رشد في نقده لأدلة المتكلمين، ثم سأل سؤال صحيحاً وهو أن الشافعي كتب كتاباً في أصول الفقه نتيجة للاختلاف بين الفقهاء، فلماذا لم يبادر أحد من علماء المسلمين لكتابة كتاباً في أصول الفقه الأكبر ليكون فيصلاً في النزاعات بين المتكلمين، وإن كانت انطلاقة المؤلف انطلاقة من المكان الصحيح في البحث واعتماده على الكتب المهمة في تحديد أسئلة الاستدلال الأشعري، إلا أنه لم يضيف إلى ابن رشد وابن تيمية ابن سينا، فابن سينا أهم فيلسوف أثر على علم الكلام الأشعري، بل وأصبح هو مرجع المتكلمين للمنطق والفلسفة اليونانية عند المتأخرين بالأخص؛ ولذا فعدم وضع ابن سينا في خلفية النقاش في استدلالات الأشاعرة نقص في الكتاب، خاصة بعد الكتب والمقالات الكثيرة التي نشرت في الآونة الأخيرة باللغات الأجنبية والتي ترجم بعضها في نقاش أثر ابن سينا على المتكملين،[1] بل ونقاش هذا التأثير موجود عند ابن تيمية.
يهدف الكتاب إلى توضيح الأدوات الاستدلالية في علم الكلام الأشعري، بالرغم من أنه أشار إلى أنه قد يعتمد على بعض كتب المعتزلة والحنابلة؛[2] والمفترض أن يغير شيئًا من العنوان ليناسب موضوع بحثه، فقد يكون عنوان بحثه “الاستدلال في علم الكلام الإسلامي” ولو حدده في زمن معين أو منطقة معينة لكانت أحكامه أدق، من مميزات البحث أنه أضاف إلى المنطق علم الجدل الأصولي، وعلم أصول الفقه، إلا أن تبريره لإدخال هذين العلمين في بحثه بالخلفيات المعرفية المتنوعة للمتكلمين غير مقنعاً، وقد يكون الأدق وقد أشار إليه الباحث، هو تداخلاها مع موضوع البحث الذي هو الأدلة.
أما في الدراسات السابقة فقد راجع المؤلف مقالة يوسف فان أس، وكتاب حمو النقاري، وكتاب طه عبدالرحمن، وكتاب لاري ميلر في علم الجدل الإسلامي، وأشار إلى كتاب عثمان علي حسن “منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد” وأنه ممثل للمدرسة الحنبلية ونقد كتابه، إلا أن المؤلف لم يشِر إلى كتاب تميم القاضي “قلب الأدلة”[3] مع أنه شديد التعلق ببحثه في الاستدلال العقدي.
الباب الأول: الاستدلال في علم الكلام الأشعري السياق والتصنيف والمبادئ
قسم المؤلف هذا الباب إلى أربعة فصول، وقسم الفصل الأول إلى أربعة مباحث، المبحث الأول كتب فيه عن الاتجاهات الحديثة في دراسة علم الكلام، في هذا المبحث حدد المؤلف ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول: مدرسة مصطفى عبدالرازق، نعت المؤلف مدرسة عبدالرازق أنها ذات أهداف أيديولوجية في مواجهة المستشرقين والتقدميين العرب،[4] ونزع بعض من منتسبي المدرسة إلى تبني فكرة الأصالة ونفي أي استفادة لعلم الكلام من المنطق الأرسطي، إلا أنه لم يذكر المؤلفين الذين نفوا استفادة علماء الكلام من المنطق الأرسطي، أما النعت الأيديولوجيا فهو غريب على المؤلف ولا يتسق مع طرحه العام وفهمه لهدف علم الكلام وأنه للرد على المخالفين، وقام بنفس ما أنكر على مدرسة عبدالرازق القيام به. أما المدرسة الثانية التي ذكرها المؤلف فهي المقاربة السياسية والتي ترى أن علم الكلام هو استمرار للمعركة السياسية ضد حكم الأمويين خاصة في مسائل القدر، لم ينكر المؤلف السياقات السياسية والاجتماعية لعلم الكلام إنما يرى أن علم الكلام ذو بعد معرفي وعلمي أيضاً وهو الذي يبقى بعد انتهاء الحدث السياسي أو الاجتماعي. المدرسة الثالثة التي ذكرها المؤلف هي المدرسة الاستشراقية، وأهم علامة على هذه المدرسة هو إرجاعها علم الكلام الإسلامي إلى أصول ما قبل إسلامية سواء قومية مثل الفرس والقبائل العربية أو اليونان، إلا أن المؤلف في نقاشه لهذه المسألة رجع إلى كتب تاريخ الفلسفة الإسلامية وليس إلى كتب المستشرقين في علم الكلام وهم أصحاب التخصص وليس مؤرخي الفلسفة الإسلامية، ولا ينكر المؤلف تأثر علم الكلام بالسياق التاريخي والجغرافي لكن يرى أن علماء الكلام أضافوا ونقحوا بل وعدلوا من بعض أدوات علوم الأوائل. بعد أن نقد المؤلف هذه المدارس لم تتضح للقارئ أي هذه المدارس يتبنى المؤلف، ولم يوضح رأيه استقلالاً، وطبيعي أن يرى أن في كل مدرسة وجهًا من الصواب، وإن كان هذا لا يشمل المدرسة الأولى كما يتضح من رأي المؤلف، إلا أن رأيها في الجمع بين المدرستين الأولى والثانية لم تتضح معالمه للقارئ.
في المبحث الثاني من الفصل الأول شرح المؤلف موضوع علم الكلام ورأى أن هناك مشكلة في تعريف علم الكلام وذكر عدة تعريفات أغلبها من كتب التعريفات واصطلاحات الفنون، ولم يرجع إلى كتب علماء الكلام إلا إلى كتاب الإيجي والجرجاني، ونقد تعريف ابن خلدون،[5] ثم رجع في موضع آخر وقال ابن خلدون يشير إلى موضوع شديد التعلق بعلم الكلام،[6] ورجع في بعض التوضيحات إلى كتاب حسن حنفي من العقيدة إلى الثورة، وفي أخرى لعبدالمجيد الصغير، وكلاهما ليس متخصصاً ابتداء بعلم الكلام، وهذا ما أوقع المؤلف في حيرة بتعريف وتحديد موضوع علم الكلام، ولم يتضح للقارئ في نهاية الفصل رأي المؤلف بموضوع علم الكلام وإن كان المؤلف ذكر بعض العوامل في تحديد موضوعات علم العقيدة وهي التبريري[7] والمنهجي والدفاعي.[8] وفي المبحث الثالث تعرض للفروق بين مذهب المتقدمين والمتأخرين واستند إلى رأي ابن خلدون إلا أنه ذكر من المتقدمين البيهقي والحارث المحاسبي، ولم يذكر الأشعري الباقلاني، كما هو معروف وكما سيأتي في المبحث القادم، ولم يبرر المؤلف هذه الفئة من العلماء السابقة على أبو الحسن الأشعري الذي ينسب له المذهب، كان البحث أيضاً بحثاً في خمس صفحات، كان المفترض أن يوضح الفرق بين أدلة المتقدمين والمتأخرين؛ لأن الأدلة هي أساس بحث الكتاب. إلا أن المؤلف في المبحث الرابع والذي عنونه بـ (منهج التأليف في علم الكلام عند الأشاعرة) وقسم منهجية متكلمي الأشاعرة إلى ثلاث: الأولى: العقلية ويمثلها الغزالي والرازي، الثانية: الفقهية ويمثلها الأشعري والباقلاني، الثالثة: الحديثية ويمثلها النووي والبيهقي. ثم عاد وقال إني لا أتفق مع رأي ابن خلدون بالتقسيم الثنائي للأشاعرة لسببين الأول: أن الاختلاف هو اختلاف بحسب المخاطب وليس بالرأي، ثانياً: أنه تطور طبيعي في المذهب، وهذان السببان ليسا بذي علاقة في موضوع البحث، فلم ينقض المؤلف رأي ابن خلدون بالتفريق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين بالاستدلال، وأيضاً في المبحث السابق ذكر التفريق بين المتقدمين والمتأخرين ولم يظهر أنه يختلف معه، وأطال في نقاش متأخري الحنابلة وتفريقهم بين الطريقتين ورد عليهم، إلا أنه خرج عن عنوان كتابه وهو “الاستدلال” ودخل في المجادلة المذهبية، بل وحتى في التقسيم الثلاثي الذي ذكره المؤلف لم يدلل ويمثل باستدلالات من هذه المدارس، خاصة الفقهية، أو يستند فيه إلى مؤلف أو بحث آخر.
وعنون المؤلف الفصل الثاني من الباب الأول بـ(المتكلمون الأشاعرة ومحاولات الاستقلال المنهجي)، وذكر في المبحث الأول الاستقلال عن المنهج الحديثي، وذكر فرقين، الأول: القبول بالجدل العقلي، وذكر بعض العلماء المتقدمين الذي أنكرو الجدل العقلي كما يقول، ثم عاد وكرر ما ذكره في الفصل السابق عن متأخري الحنابلة واستغلالهم للاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، والفرق الآخر مع منهج المحدثين رفض الاستدلال بخبر الآحاد في أصول الدين وهذا المبحث أكثر المباحث تشنجاً ورداً ومذهبية بالرغم من أنه قال إن كتابه يعتمد على المنهج الوصفي، إلا أنه وقع فيما حذر منه في أول كتابه، ولا ينكر على الباحث تبنيه لرأي معين، إنما ينكر عليه إذا شنع على المخالفين، والاختلاف فيه قديم وله محل اعتبار، وذهب هذا الفصل والذي قبله بالصراع مع متأخري ومتقدمي الحنابلة ولم يوضح المؤلف رأيه، ولم يوضح الفرق المنهجي بين المدرستين عند تبني الجدل العقلي ورفض الأخذ بخبر الآحاد وأثر هذا في الاستدلال. وفي المبحث الثاني من هذا الفصل ناقش المؤلف الاستقلال المنهجي عن الفلاسفة، ذكر فروق وتشابهات في المواضيع ورجع مرة أخرى لابن خلدون بالرغم من أنه سبق وأن نقد رأيه، إلا أن الغائب في هذا النقاش هو طريقة الاستدلال، فلم يجب المؤلف عن الفرق بين استدلال الفلاسفة والمتكلمين أو بالأدق لم يركز على سؤال الكتاب الرئيسي، في آخر المبحث ذكر أن الأشاعرة يعتمدون على النص الشرعي،[9] وفي آخر سطرين من المبحث ذكر أنه سيأتي مزيد بحث بالاستقلال المنهجي بين المتكلمين والفلاسفة.[10] والمبحث الأخير من هذا الفصل الاستقلال الأشعري عن المعتزلة، وفي هذا المبحث كما في المباحث السابقة ركز المؤلف على الاستقلال الأشعري عن المعتزلة، ولم يعطِ لمبحث الاستدلال ما يستحقه من الاهتمام، وقد ذكر عدة فروقات منهجية بين استدلال الاشاعرة والمعتزلة، منها الإمكان العقلي بدل الوجوب العقلي كما يقول المعتزلة، ورجع في هذين الفرقين إلى كتاب عبدالمجيد الصغير “إشكالية السلطة العلمية”[11] وهذا إشكال منهجي كان من المفترض أن يرجع إلى الكتب الأصول في علم الكلام ويستنبط الفروقات، وذكر من الفروق رجوع الأشاعرة للنص الشرعي، إلا أن للعقليات مجالها وللسمعيات مجالها، ثم عاد المؤلف وقال “إنه من الثابت أن الأشعري لم يقل بتقديم النص؛ لأنه خرج من المعتزلة”[12]، وذكر أنهم يختلفون بالموجب للنظر هل هو الشرع أم العقل[13] ويختلفون في الإرادة الإلهية،[14]إلا أن المؤلف لم يوضح سبب هذا الاختلاف على الاستدلال.
في نهاية هذا المبحث نسجل ثلاث نقاط الأولى: أن المؤلف لم يستدل على بعض أحكامه، ولم يشر إلى مصادر، الثاني: رجوعه لمصادر ثانوية وفي علوم أخرى لتقرير مسائل مهمة في البحث، الثالث: بالرغم أنه أشار في مقدمة البحث أن سيناقش الأدوات بدل من المضامين إلا أن نقاشه كثيراً ما كان في المضامين.
الفصل الثاني: مبادئ المنهج الأشعري في الاستدلال
قسم المؤلف هذا الفصل إلى ثلاث مباحث الأول عن مركزية النظر في الكلام الأشعري، وأن هدف النظر هو تثبيت مشروعية علم الكلام، والوقوف أمام الباطنية، ثم وقف عند “تقريرات المتكلمين بخصوص التقليد، باعتباره نقيض النظر”[15]، إلا أنه رجع لكتب الأصوليين في مباحث التقليد، ولم يوضح علاقة الاستدلال بمركزية النظر عن الأشاعرة. وفي المبحث الثاني كتب المؤلف عن المصطلح الاستدلالي وعن نظرية العلم، وذكر فيهما أمثلة من بعض كتب المتكلمين وبالذات الأشعري والباقلاني واهتمامهم بالاستدلال ونظرية العلم، ورجع في بعض هذه المباحث لحسن حنفي، وهذه المباحث لم تتضح علاقتها بموضوع الفصل وهو مبادئ المنهج الأشعري في الاستدلال. أهم مبدأ ذكره المؤلف من مبادئ المنهج الأشعري في الاستدلال هو التأويل، عرف التأويل على عجل ولم يرجع في تعريف التأويل إلى أي من كتاب الكلام الأشعري، ولم يشر أنه رجع ولم يجد له تعريفاً في كتاب الكلام؛ لنجد المبرر لعودة لكتب الأصول، وذكر خمس قواعد من قواعد التأويل في المذهب الأشعري، واعتمد كلياً كما يقول على دانيال جماريه في مقدمته لكتاب مشكل الحديث لابن فورك، وهذا خطأ منهجي كبير جداً، فكيف يعتمد على مقدمة مؤلف مستشرق لكتاب في مشكل الحديث على قواعد التأويل عند الأشاعرة، بالرغم من وجود كتب علماء الكلام والمفترض أن ينظر بكتب الكلام قبل أن يستند على آخرين، وإن استند لا يسلم بما قالوا إلا بتبرير وإضافة مميزة على هذا الاستناد، والقواعد الخمس يمكن أن ترجع إلى اثنتين الأولى: التشكيك في صحة الحديث، الثاني: دخول المجاز على الألفاظ، ومن عجائب هذا المبحث أن المؤلف لم يرجع إلى كتابي مشرفة الرسالة فريدة زمرد المجاز والتأويل ولم يشر إليهما إطلاقاً على أهمية الكتابين وتعلقهما بالموضوع، بل لم يشر إلى أي كتاب في التأويل أو إلى قاعدة الرازي التأويلية المشهورة، أو إلى كتابي الغزالي وابن العربي في التأويل.
الفصل الرابع: تصنيفات الاستدلال عن الأشاعرة
تناول المؤلف في هذا الفصل مبحثين: الأول في تصنيفات الممارسة الاستدلالية والثاني في تصنيفات أولية لأنواع الأدلة، أما في المبحث الأول كتب عن الاستدلال والمناظرة والجدل والحجاج، لم يفرق الباحث بين هذه المصطلحات واستخدامها عند المتكلمين، بل ولم يرجع إلا كتب المتكلمين إلا كتاب المجرد لابن فورك والتمهيد للباقلاني في تعريف الاستدلال، أما بقية المصطلحات فرجع فيها إلى كتب الجدل الأصولي وأصول الفقه، بالرغم من أنه يوجد كلام في كتب المتكلمين لمصطلحات الجدل والمناظرة والحجاج ومشهور فصل الجدل في كتاب المجرد لابن فورك، وفي مقدمة البحث ذكر مصطلح النظر إلا أنه لم يناقشه في مسألة مستقلة على أهمية الكبرى في علم الكلام، خاصة في كتاب المجرد، بل وأحياناً يرجع لكتب ليست ثانوية بل خارجة عن نطاق العلم التخصصي، مثلاً في فصل المناظرة رجع إلى كتب معاصرة كتبت عن المناظرة في الأدب، بالرغم من وجود كتب تكلمت عن المناظرة كثيراً ومنها كتاب الطوفي الذي رجع لها المؤلف كثيراً. أما المبحث الثاني فلم أستطع الظفر بمقصود البحث ولا نتائجه، و لم يوضح هدف المبحث في مقدمته إنما دخل مباشرة إلى نقاش تقسيم الأدلة عند أرسطو، و قد ذكر في المبحث عدة مواضيع، وذكر أن الباقلاني لا يرى أن هناك فرق بين الأدلة،[16] ثم عاد وقال إنه يفرق بين الدليل الموصل للظن والدليل الموصل لليقين.[17]ختم المؤلف هذا الفصل بقوله إن مبحث الاستدلال عند المتكلمين الأشاعرة في صلب اهتمامهم، إلا أن مادته مشتتة وأغلبها في كتب علم أصول الفقه، وأنهم غير متوافقين في مصطلحاتهم؛[18] وهذا شيء طبيعي في نشأة العلوم، وإن كانت تصنيفات الأدلة عند المتكلمين استعانت بالاصطلاحات اليونانية إلا أن الأصل هو الاصطلاح القرآني،[19]يتضح في هذا الكلام النفس الدفاعي عن المذهب، فكيف أن يكون المتكلمون مهتمين بالاستدلال وأغلب مادته في كتب أصول الفقه، وأنه مشتت وغير منضبط في اصطلاحاته، فهذا استدلال على منهجية الاستدلال متناقضة وغير منتجة.
الباب الثاني: تلقي المنطق واستثماره في بناء الدليل في علم الكلام الأشعري
قسم المؤلف هذا الباب إلى ثلاثة فصول الأول في المنهج الأشعري من المنطق الصوري، والثاني: الجدل على الطريقة الأشعرية، الثالث: نقد الموقف الأشعري في الاستدلال، أما في الفصل الأول فقد حدده بالمنطق الصوري وهذا مصطلح يخرج أنواع من المنطق اليونانية غير الصورية مثل الرواقي، وقد يكون مقصود المؤلف المنطق اليوناني أو الأرسطي، والتقسيم صوري وغير صوري انتشاره متأخر، أما في موضوع البحث فهو يثبت المثبت من قرون طويلة أنه المتكلمين الأشاعرة تأثروا بالمنطق الأرسطي، بل ويرجع خطوة أخرى إلى الوراء في النتائج البحثية التي تفرق بين المتأخرين والمتقدمين وموقفهم من المنطق، فهناك فرق كبير جداً بني موقف الأشعري والباقلاني من المنطق والرازي والآمدي، إلا أن المؤلف نفى هذا التقسيم؛ ولذا لم يناقش هذه الفرق. وفي آخر هذا الفصل ذكر المؤلف فضل الأشاعرة في نظرتهم الوسطية للمنطق بدلاً من التحريم والنقد الانطباعي.[20]
في الفصل الثاني من الباب الثاني كتب عن المؤلف عند الجدل، وقسمه إلى مبحثين، الأول الجدل عند الأشاعرة السياق والأصول، في الجزء الأول من المبحث كتب المؤلف عن التاريخ المبكر للجدل الكلامي عموماً واعتمد فيه على رسالة دكتوراه محمد كارابيلا، بالرغم من أن ميلر بنجامين كتب عن نفس الموضوع قبل كاربيلا، كان المفترض أن يشير أو يقارن بين المؤلفين، ثم أشار إلى أن أغلب المؤلفات الكلامية المبكرة لم تصلنا إلا أن ابن فورك ذكر في كتابه المجرد فصل في الجدل، وأشار المؤلف إلى أن “المهم في هذا الفصل أن ابن فورك نقل نص كلام أبي الحسن الأشعري، ونادراً ما يضيف ابن فورك إلى نص أبي الحسن شيئًا إلا توضيحًا وتعليقًا”[21]، ولم يوضح المؤلف أو يستدل على هذا الحكم مع أنه سبق أن قال أن كتب الأشعري الجدلية لم تصلنا، فكيف حكم على فصل الجدل في المجرد من كلام الأشعري؟
عنون المؤلف المبحث الثاني بـ مكونات الجدل حسب الطريقة الأشعرية، وقسمه إلى عدة مطالب الأول: ذكر فيه علاقة الجدل بالنظر، في أول المطلب حكم المؤلف أن المتكلمين يرون أن الجدل والنظر من المترادفات، ثم بعد عدة مقاطع أورد نصًا للزركشي يفرق فيه بينهما إلا أنه لم يوجه أو يستدل بالنص على شيء مع أنه يخالف وجهة نظره، وأشار إلى الفرق بين رأي الفلاسفة والمتكلمين للجدل والنظر، وأن الفلاسفة لا يرون أن الجدل موصل للحقيقة بعكس المتكلمين، ومن العجيب أن المؤلف استدل على مشروعية النظر من كتاب المقدسي الشيعي،[22] وكان الأجدى أن يستدل من كتب المتكلمين الأشاعرة، ولم يرجع المؤلف إلى كتاب حمو النقاري الذي أشار إليه في المقدمة فقد كان بحثه في هذه المسألة. في المطلب الثاني لخص المؤلف رأي أبو الحسن الأشعري من كتاب المجرد لابن فورك في قواعد السؤال والجواب، وفي المطلب الثاني لخص المعارضة، والثالث في علامات الانهزام في المناظرة، ولم يقل الانقطاع كما هو مصطلح الأشعري، وفي المطلب الخامس عنونه “الكلام في العلل في الجدل” لخص كلام الأشعري في هذا من دون مقارنة أو نقد، وفي آخر المطلب ذكر أخلاقيات الجدل، ولا أعلم لماذا لم يسمها آداب الجدل كما يسميها العلماء المتقدمون، لم يذكر في مطلب مستقل إنما وضعها مع مطلب العلل.
في الفصل الثالث من الباب الثاني كتب المؤلف عن النقد ضد الموقف الأشعري وقسمه إلى مبحثين، الأول عن النقد الفلسفي والذي يمثله ابن رشد وابن ميمون، والمبحث الثاني النقد الفقهي ويمثله ابن تيمية، قسم المؤلف المبحث الأول إلى مطلبين الأول لابن رشد والآخر لابن ميمون، في المطلب الأول لخص المؤلف نقد ابن رشد للأشاعرة، وقسمه إلى عدة فروع الأول هو في نقد ابن رشد لقياس التمثيل، وأحال المؤلف على طه عبدالرحمن في الرد ابن رشد، أربع منهن ليست في موضع رد على ابن رشد خصيصاً من كتاب العمل الديني وتجديد العقل، وإحالة واحدة لكتاب تجديد المنهج في تقويم التراث، بالرغم أن الكتاب الثاني كتب فيه طه كثيراً عن ابن رشد ورده على المتكلمين، إلا أن المؤلف لم يناقش ويستعين بكتاب طه، ولم يرجع المؤلف إلى كتاب فؤاد أحمد منزلة التمثيل عند ابن رشد على شدة ارتباطه بالموضوع وجودة ما قدم، وفي فروع أخرى من نقد ابن رشد للمتكليمن كتب المؤلف عن خطابية أدلة المتكلمين وعدم صناعيتها، ونقد دليل الجوهر والتمانع، وفي الحقيقة أن المؤلف توسع في موضوع هذا المبحث بالذات وسبقه رسائل دكتوراه وبحوث كثيرة، إلا أنه لم يستعين بها أو ينقدها، ليضع لبنه في البحث العلمي؛ فأصبح بحثه مسبوقاً ومجتزأ، وفي أول المبحث قال “تهجم ابن رشد الشديد على المتكلمين إنما كان تصفية حسابات مع الغزالي”[23]، وهذه ليست لغة ولا اهتمام مؤلف عن الاستدلال، إنما لغة سياسية ومتمذهبين حد التعصب وليسوا دارسين. أما المطلب الثاني من مبحث النقد الفلسفي فقد خصصه لنقد ابن ميمون، ويرى المؤلف أن هناك فرقًا بين نقد ابن رشد وابن ميمون بالأخير يركز نقد على أن أدلة المتكلمين مستفادة من اليونانيين،[24] وأن المتكلمين استفادوا من رد المسيحيين على الفلاسفة من خلال كتب يحي النحوي وابن عدي،[25]ويرى ابن ميمون أن المتكلمين لم يكونوا مقلدين كلياً للفلاسفة،[26] ويرى ابن ميمون -بحسب رأي المؤلف- أن التجويز العقلي هو عمدة علم الكلام الأشعري،[27] وأشار المؤلف أن ابن ميمون عرض هذا القول بتهكمية واستهزاء، ورد عليه المؤلف أن هذا السلوك من أساليب الحجاج وأحال على بيرلمان، وكان المفترض يرد على ابن ميمون من كلام المتكلمين ويبرز موقف المتكلمين الأشاعرة من هذا القضية، وهذا المطلب من أفضل المطالب هدوءا لنفس المؤلف وخفوتاً للنزعة المذهبية؛ وقد يكون بعد ابن ميمون اليهودي عن الصراع بين المذاهب العقدية الإسلامية جعل المؤلف هادئا في نقاشه.
أما في النقد الفقهي لابن تيمية فقد قسم المؤلف النقد إلى مطلبين الأول في نقد المنهج الأشعري في السمعيات والآخر في العقليات، وقسمه إلى فرعين الأول عن فساد المنهج الأشعري في التعامل مع الأدلة من ناحية التأويل وخبر الآحاد، وضعف بضاعتهم بالأحاديث، وعدم يقينية الأدلة السمعية عند الأشاعرة، أما الفرع الثاني فهو مقابلة الدليل العقلي للدليل السمعي، وقول ابن تيمية هو عدم التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وفي آخر المطلب يرى المؤلف أن ابن تيمية اعتمد في نقده للمنهج الأشعري على الفروق بين أعلام الأشاعرة بين متقدمين ومتأخرين وخراسانيين وعراقيين، إلا أن المؤلف لم يرد على ابن تيمية في أقواله إنما فقط عرضها. والمطلب الثاني هو في الأدلة العقلية الأشعرية ورأي ابن تيمية فيها بحسب رأي المؤلف أنها متناقضة، ولا ينتفع بها، ولم يرد المؤلف على ابن تيمية في أقواله، وهذا الرأي فيه اختزال كبير لرأي ابن تيمية، ولم يرجع المؤلف إلى المراجع الثانوية التي كتبت عن رأي ابن تيمية في الأشاعرة وأدلتهم، وهذا خلل يتخلل كثير من مواضع بحثه.
كان اختيار ابن رشد وابن ميمون وابن تيمية بصفتهم ممثلين لنقد الأدلة الأشعرية خيارًا موفقًا، وإن ينقصه النقاش التفصيلي والرد، وكان المتوقع أن يذكر المؤلف رأي هؤلاء المصنفين ورأيهم في الأدلة المذكورة في صلب البحث، مثلاً موقف هؤلاء المصنفين من استخدام الأشاعرة للمنطق والجدل فقط، بدلاً من دخول في تفاصيل نقديه ليست متعلقة باب الاستدلال الذي ناقشه في الكتاب.
الخاتمة
اجتهد المؤلف في جمع مواضيع مختلفة في كتاب واحد تحت عنوان واحد وهذا بحد ذاته إنجاز يشكر عليه؛ لأن كثيراً من الكتب التي أُلفت بعض المواضيع التي طرحها جزئية فلم تظهر الصورة الكلية لموضوع الاستدلال في علم الكلام، إلا أن خطأ المؤلف في عدم الرجوع لهذه المصنفات والبناء عليها وتجوزها، ففقد البحث جزءًا مهمًا من مميزات الدراسات المؤثرة وهي الرجوع والاستناد إلى المؤلفين المؤثرين في العلم، وسبق في باطن المراجعة هذه الملاحظة كثيراً، إلا من مجمل البحث وعناوينه وجمع لأشتات الموضوع سابقة يعترف له بها.
أما بالنسبة للنقد في موضوع البحث فأكبر خطأ وقع فيه المؤلف وتناقض فيه وأضاع عليه محل نقاش مهم جداً، هو عدم تفريقه منهج الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين؛ وأخذ الموضوع من جانب مذهبي وأن الحنابلة المتأخرين يبرزونه؛ وهذا غير مبرر لعدم نقاشه أو أقل شيء إبطال هذا القول، مع أن أشهر من قال بهذا التفريق هو ابن خلدون وهو ينتمي في العموم إلى الأشاعرة، ومن نتائج هذا الخطأ، عدم التفريق بين استخدام المتقدمين والمتأخرين للمنطق إنما أثبت التأثر، الأهم أنه لم يذكر لماذا لم يستمر التأليف في الجدل عند الأشاعرة بعد ابن فورك؟ مع أنه في مقدمة الكتاب نقد طه عبدالرحمن بعدم أخذه بالتاريخ في دراسته للعلم ووقع في ما استشكله على طه. وفي الحقيقة كان تركيز المؤلف في الكتاب على منهج الأشعري ويأتي الباقلاني بعده، وليس للمذهب الأشعري ككل.
ومن النقاط المهمة أن المؤلف حصر في نفسه في الجدل والمنطق، ولم يتعرض لقياس الشاهد على الغائب على أنه من أهم أدوات الاستدلال عند المتكلمين.
كان هدف المؤلف واضحاً من مقدمة الكتاب وأشار إليه في خاتمته أن دراسته هي في الأدوات وليس في المضامين، إلا أن المؤلف أغلب عمله هو مضامين الأدلة وليس تحليلاً للأدلة المستخدمة؛ وهذا غير ما يراه طه عبدالرحمن كما استند عليه المؤلف في هذا الرأي، وللأسف لم يرجع المؤلف إلى مؤلفات طه وحمو النقاري بما فيها من عدة منهجية مهمة فقط أشار إليها في المقدمة لكن لم يظهر أثر كتابتهم في الكتاب، والذي ظهر كثيراً وأحال هو كتاب عبدالمجيد الصغير “الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية: قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة” وغيرها من كتابته؛ وهذا خلل منهجي منتشر في الكتاب، فمراجعه أحياناً ليست في محلها، مثلاً حسن حنفي ليس مختصا ولا معتداً به في علم الكلام.
[1] راجع شحاته، أيمن، من الغزالي إلى الرازي: تطور علم الكلام الفلسفي في القرن السادس عشر الهجري (الثاني عشر الميلادي) في بين الفلسفة والرياضيات من ابن سينا إلى كمال الدين الفارسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2016، 555- 600، الرويهب، خالد، المعارضات الأولى للمنطق اليوناني بين المتكلمين (في القرنين التاسع والعاشر)، في المرجع في تاريخ علم الكلام، تحرير زابينه شميتكه، ترجمة أسامة شفيع سيد، مركز نماء للبحوث والدارسات، بيروت، 2018، 693-729، جريفيل، فرانك، اتصال علم الكلام بفلسفة ابن سينا “تهافت الفلاسفة” للغزالي و “تحفة المتكلمين” لابن الملاحمي، في المرجع في علم الكلام، مرجع سابق، 733-764،
[2] مدراري، يوسف، الاستدلال في علم الكلام الاشعري، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، 2020، 17.
[3] القاضي، تميم، قلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، 1433.
[4] مدراري، يوسف، الاستدلال في علم الكلام، 43.
[6] المرجع السابق، 67.
[7] المرجع السابق، 66.
[8] المرجع السابق، .67
[9] المرجع السابق، 110.
[10] المرجع السابق، 111.
[11] المرجع السابق، 117.
[12] المرجع السابق، 119.
[13] المرجع السابق، 120.
[14] المرجع السابق، 121.
[15] المرجع السابق، 133.
[16] المرجع السابق، 186.
[17] المرجع السابق، 187.
[18] المرجع السابق، 191.
[19] المرجع السابق، 192.
[20] المرجع السابق، 270.
[21] المرجع السابق، 279.
[22] المرجع السابق، 285.
[23] المرجع السابق، 322.
[24] المرجع السابق، 344.
[25] المرجع السابق، 342.
[26] المرجع السابق، 346.
[27] المرجع السابق، 347.