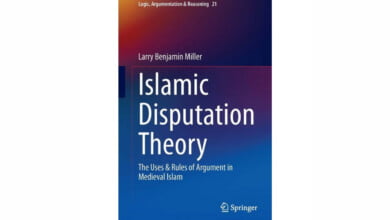- براندون بلوتش
- ترجمة: سوسن الشهري
- مراجعة: بدور القرني
- تحرير: غادة الزويد
يروي يورغن هابرماس في مسح جديد لتاريخ الفلسفة الغربية سردية عن تقدم البشرية على أنه توجه مستمر نحو ترسيخ العقل لدى العامة والخاصة؛ وتغيب عن هذه السردية أنظمة العنف والإخضاع التي تظهر جميع موروثاتها بوضوح اليوم.
أعرب رمز التنوير الألماني يوهان جوتفريد فون هيردر عن استيائه في كتابه (نحو فلسفة للتاريخ من أجل تكوين الإنسانية) عام 1774 بقوله “لا أحد في العالم يشعر بضعف التصنيف العام والشامل أكثر مني”، وكتب: “يريد المرء أن يجمع بين الشعوب والفترات الزمنية التي يتبع بعضها بعضًا كأمواج البحر؛ لمن يرسم المرء هذه اللوحة؟ ماذا تعني هذه الكلمة التي تصور تاريخ البشر ولمن توجّه؟”. بالنسبة إلى هيردر، فإن حلم التنوير المتمثل في استيعاب التاريخ البشري ككلٍ سلس منسجم، قد جاء ضد خصوصيات الأفراد والثقافات غير القابلة للاختزال.
يواجه الفيلسوف والمنظّر الاجتماعي الألماني يورغن هابرماس والذي يعد من بين أكثر المفكرين المؤثرين في عصرنا، نفس المعضلة في كتابه الجديد، والذي يعكس عنوانه ترتيب مصطلحات هيردر: “نحو تاريخ جديد للفلسفة”، والذي نُشر بالألمانية في سبتمبر الماضي. يمتد تأريخ هابرماس على مدى 3000 سنة ويقع في 1700 صفحة. إنه يمثل بحثًا فريدًا من نوعه. يسعى هابرماس -كأسلافه في القرن الثامن عشر- إلى إعادة صياغة شاملة للتاريخ البشري. يكتب، “المشاكل الفلسفية تختلف عن المشاكل “العلمية” فقط من حيث “قوتها التركيبية”. بالنسبة إلى هابرماس، لم يستنفد تفكك الحياة الحديثة وتشظيها قدرة الفلسفة على طرح الأسئلة الجريئة وتقديم الأطر المحددة للأفكار.
من المؤكد أن العمل يشيد بإرث نقد ما بعد الحداثة، حيث يتجنب هابرماس التكهنات السطحية من أجل إعادة بناء نص كثيف، وذلك لكونه قلقًا بشأن العراقيل التي واجهت هيردر إبان محاولته تقديم “تصنيف شامل”.
لكن هذا التاريخ للفلسفة -تمامًا مثل القراءات التنويرية لفلسفات التاريخ- مدفوع بالنزعة الغائية للتاريخ، وهو مبدأ يربط بين العشوائية والصدفة الظاهرة عبر التاريخ. كان هذا المبدأ بالنسبة إلى هيردر -الذي يهدف إلى “تكوين” الإنسانية (bildung بالألمانية)- مفهومًا أساسيًا للتنوير الألماني الذي يربط التطور الأخلاقي للفرد مع تقدم الحضارة. في حين أنه بالنسبة لهابرماس يعتبر “عملية تعلم” جماعية، ويُعتبر التاريخ حسب روايته قصة التعلم البشري، وسجل المشكلات التي تم حلها، والتحديات التي تغلبنا عليها. ويوضح أن “المعرفة الجديدة حول العالم الموضوعي” الى جانب “الأزمات الاجتماعية” تخلق “تنافرًا معرفيًا”، وتدفع هذه التناقضات المجتمعات إلى تبني أساليب جديدة من التفاهم والتفاعل.
إن اللغة هي وسيلة التعلم لدى هابرماس، حيث انها تُعتبر مصدر العقلانية البشرية، ومخزن المعرفة المتراكمة للبشرية، والوسيلة التي يمكن من خلالها تمحيص تلك المعرفة وتحسينها. وهنا أيضاً يلعب هابرماس على الاختلافات في موضوع التنوير، ولكن ثمة هناك خدعة؛ فعلى الرغم من انغماس خصوم هابرماس في منطق الأخذ والرد والحجاج العقلاني، إلا أنهم يطورون أنظمة ميتافيزيقية تخفي البناء “البين ذاتي” للمعنى. أما بالنسبة لهابرماس، أصبحت الفلسفة واعية لعملية التعلم فقط مع صعود التفكير الحديث “ما بعد الميتافيزيقي”.
من خلال تتبع عملية التعلم المستمر عبر ثلاثة آلاف عام من الفلسفة الغربية، فإن كتاب هابرماس يعد تحفة تحوي بحرًا من الندرة المعرفية والجامعة بين المعرفة العميقة والتوليف الجيد. يعد إتقان هابرماس للبحث الفلسفي أمرًا مذهلاً، وحتى أن الخبراء سيجدون نظرة جديدة فيما يقدمه من تحليلات. في الوقت نفسه، تدعونا روايته عن التطور العقلاني للبشرية إلى طرح تحدي هيردر من جديد: من الذي يحكم سير تاريخ هابرماس؟ والسؤال الأكثر إلحاحًا –والذي تم طرحه ولكن لم يُجب عليه- حول كيفية تفاعل عملية التعلم التي اجتازها الغرب مع التاريخ الأوسع للعالم الحديث.
*****
ولد هابرماس عام 1929 في الطبقة الوسطى البروتستانتية في ألمانيا الغربية، وهو أبرز فيلسوف ومفكر في أوروبا المعاصرة. على مدى حياة مهنية استثنائية امتدت لما يقرب من سبعة عقود، وضع نظامًا يربط بين نظرية المعرفة واللغويات وعلم الاجتماع والسياسة والدين والقانون. وقد ظهرت نصوصه الفلسفية بأكثر من أربعين لغة. لكن هابرماس فعل ما هو أكثر من ذلك، إذ ميّز نفسه كمناصر مخلص للدور الثقافي العام، وقد أثارت حواراته مع المحاورين من جون راولز إلى ميشيل فوكو النقاش حول العلوم الإنسانية، وشكلت تدخلاته السياسية الجدل حول مواضيع من الذاكرة التاريخية إلى التوحيد الأوروبي وحتى الهندسة الوراثية.
بدأ عيد ميلاد هابرماس التسعين في العام الماضي بمناقشات ملهمة حول حياته العملية. استقطبت محاضرته بتلك المناسبة في جامعة فرانكفورت حشدًا من الناس يصل الى حوالي أكثر من 3000 مستمع، بينما مهد ظهور معجم هابرماس من كامبريدج والمؤلف من ثمانمائة صفحة باللغة الإنجليزية الطريق للمرحلة التالية من تلك الحفلة. وبطريقة مثيرة أكثر للجدل، تحدى الفيلسوف السياسي ريمون جوس أسس فكر هابرماس وأثار تبادلاً للجدل بين علماء النظرية النقدية. يبلغ هابرماس اليوم 91 عامًا، ولايزال نشيطاً ومستمراً في الإلهام والعطاء.
الخيط الناظم لمشروع هابرماس هو الربط بين ما يسميه بـ “العقلانية التواصلية” وبين كتاباته ودعوته العامة، كمشروع شامل يساعد في تمثيل انتشاره العالمي. يرى هابرماس اننا حين نخاطب انساناً آخر بواسطة اللغة، فإننا نفترض إمكانية الفهم المتبادل والإقناع المنطقي، ولا يوجد هناك أي إكراه في حال الحوار أو الخطاب أو الحديث النموذجي أو المثالي باستثناء ” قوة الحجة”، فإن من شأن الحوار أن يعزز الإجماع على أساس الاتفاق المنطقي. يدرك هابرماس أن معظم الحوارات بعيدة عن هذه المثالية، ومع ذلك فهو يصر على أن المثل الأعلى شرط أساسي حتى للكلام العادي ويتضمن مصدرًا للديمقراطية المتطرفة. تعتبر الديموقراطية بالنسبة لهابرماس نظاماً يتغلب فيه التواصل غير القسري على القوة القسرية، حيث تشكل الحجة المنطقية بين المواطنين المتساوين أسس الشرعية السياسية.
خرج مشروع هابرماس من صدمات ما بعد حرب ألمانيا. نجا هابرماس البالغ من العمر وقت الانهيار النازي خمسة عشر عاماً بصعوبة من التجنيد العسكري الإجباري واستمع مذعورًا إلى البث الإذاعي لمحاكمات نورمبرغ، ليتخلى طالب الجمنازيوم عن دراسة الطب لمتابعة الفلسفة، عاقداً العزم على الكشف عن المكان الذي أخطأ فيه التاريخ الألماني، وما إذا كان قد امتلكت الثقافة الألمانية موارد لإعادة إعمار البلاد. وقد أصبح إعادة نشر مقالة من العصر النازي للفيلسوف مارتن هايدجر عام 1953 جزءًا لا يتجزأ من سيرته الذاتية، والتي تمجد “الحقيقة الداخلية وعظمة “الاشتراكية القومية، التي دفعت هابرماس الشاب إلى رفض الوجودية السائدة واليأس الثقافي. وبدلاً من ذلك كان يعود إلى منزله الأكاديمي في جامعة فرانكفورت مع المنفيين الألمان واليهود العائدين مثل ماكس هوركهايمر وثيودور أدورنو. مثّل معهدهم للبحوث الاجتماعية ملاذاً للنقاش النقدي وسط الثقافة الاكاديمية المختبئة في ألمانيا الغربية بعد الحرب.
ومع ذلك، حتى عندما حصل بسرعة على شهرة كقائد للجيل الثاني في مدرسة فرانكفورت، اختلف هابرماس عن الذين سبقوه. ففي حين أن كتاب “جدلية التنوير” لهوركهايمر وأدورنو تتبع اضمحلال العقلانية الغربية ووصولها إلى التدمير الذاتي المتمثل في “العقل الأداتي”، قدم هابرماس نمطًا من العقلانية يفلت من المنطق الأداتي الضيق، عن طريق وضعه في تواصل بين ذاتي. تنبأت أطروحة تأهيل هابرماس وكتابه الذي صنع اسمه “التحول الهيكلي في المجال العام” عام 1962 وبأهمية التواصل في الحياة العملية. تتبع هابرماس صعود “المجال العام” البرجوازي في المقاهي ومع ذيوع ثقافة الطباعة في القرن الثامن عشر في أوروبا؛ حيث تحدت التداولات العقلانية بين المؤسسات الرسمية السياسية ومجال الحياة الخاصة للأسرة السلطات الحاكمة وحثت على انتشار الأفكار الجمهورية. وعلى الرغم من أن كتاب ” التحول الهيكلي للمجال العام” -وهو قلق واسع الانتشار في حديث اليوم عن المعلومات المضللة والأخبار المزيفة- فقد أعلن العمل عن السمة التي ستلازم مؤلفه مدى الحياة ألا وهي: “المشروع غير المكتمل” للتنوير.
إذا كان كتاب “التحول الهيكلي” قد جعل هابرماس نجمًا صاعدًا، فإن أعظم أعماله عام 1981 هو “نظرية الفعل التواصلي” التي جعلته الفيلسوف الرائد للقرن العشرين. حملت النظرية ثمار عقدين من التأمل الفكري، بما في ذلك العمل كمدير لمعهد ماكس بلانك في بلدة شتارنبرغ في ولاية بافاريا الألمانية، وبرنامجًا طموحًا للقراءة عبر علم الاجتماع الكلاسيكي، ونظرية النظم، وفلسفة اللغة العادية، والبراغماتية الأمريكية. حَشَد الكتاب كل هذه العوامل المؤثرة للكشف عن الأسس العقلانية للتواصل كطريق نحو إعادة تنشيط الديمقراطية. واستنتج هابرماس أن “النظام” الحديث للاقتصاد والبيروقراطية يجب أن يخضع لرقابة صارمة من قبل “عالم الحياة”، حيث يمكن لفضاءات المجتمع وثقافة الاتصالات الحرة أن تزدهر. حذر هابرماس من “استعمار” المصالح الخاصة “لعالم الحياة” أثناء قبوله منشآت رفاهية الدولة الرأسمالية وسيعود إلى هذا الموضوع خلال الكتابات السياسية اللاحقة.
يمثل كتاب “نحو تاريخ جديد للفلسفة” تتويجا لمرحلة ثالثة من حياة هابرماس المهنية، والتي حظيت فيها مسائل الإيمان والدين بأهمية متزايدة. اعتمد عمل هابرماس السابق على نظرية العلمنة، فمهما كانت معتقدات المرء الخاصة، فإن المجال العام يعتمد على تبادل “شرعية المطالبات” التي في متناول جميع المواطنين؛ والتي تطالب بفصل الدين عن الحياة، لكن هابرماس وصف في خطابٍ الديمقراطيات الغربية المعاصرة -بعد شهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر- بأنها مجتمعات “ما بعد علمانية”. وقال إن المجال العام من الآن فصاعدًا يجب أن يستوعب التنوع الديني والسماح بمشاركة المواطنين المتدينين. وقد ذهب هابرماس أبعد من ذلك في مقال سنة 2005 الذي أعقب مناقشة عامة مع الكاردينال جوزيف راتزينجر (لاحقًا البابا بنديكت السادس عشر) حيث قال انه ليس فقط يجب أن يتمتع المواطنون المتدينون والعلمانيون بالمساواة في الوصول الى المجال العام، بل إن من المتوقع نسبياً ان ألا يستبعد الأخير احتمالية أن يكون للمساهمات [الدينية] جوهر معرفي”.
بالنسبة لبعض محاوري هابرماس العلمانيين، فإن هذه التنازلات الواضحة للدين تعد خيانة للالتزام العقلاني للنظرية الاجتماعية النقدية، ولكن مع ذلك -وكما هي الحال مع الكثير- فإن ذلك يعكس تغيير جذري لاهتمامات مترسخة سابقاً. ولقد كشف بحثي الخاص عن الشبكات الفكرية البروتستانتية في أوائل فترة ما بعد الحرب الألمانية عن دليل على مشاركة هابرماس في مجموعات العمل “المسيحية الماركسية” خلال أوائل الستينيات، وانخرط منذ ثمانينيات القرن الماضي في حوارات فلسفية مع علماء الدين المسيحي البارزين، أبرزهم معاصره الكاثوليكي يوهان بابتيست ميتز. استندت كتابات هابرماس الأخيرة على وجهة نظره القديمة بأن المواطنين المتدينين يمكن أن يساهموا برؤية أخلاقية في المجال العام، وقد فعلوا ذلك في ألمانيا الديمقراطية. وفي الوقت الذي تستقبل فيه أوروبا أفواجًا جديدة من المهاجرين المسلمين، سعى هابرماس إلى مكافحة خطابات كراهية الأجانب وعدم قبول الاختلافات الثقافية، مع تعزيز المداولات الديمقراطية العابرة للانقسامات الدينية.
ومع ذلك فإن المزيد من الاتهامات التحريضية تدفع بمؤلفات هابرماس ضد الدين، وعلى الرغم من دفاعه عن المجال العام للتعدد الديني، فإن هابرماس ظل مؤكدًا للدور الأساسي للمسيحية الغربية. لقد اعتمد بالفعل على عالم الاجتماع الكلاسيكي ماكس فيبر لتتبع صعود العقلانية الحديثة، حيث استفاد من الفكرة البروتستانتية عن “نعمة الخلاص” في “نظرية الفعل التواصلي”. وفي الآونة الأخيرة، نأى هابرماس بنفسه عن مزاعم خيبة الأمل الفيبيري بإشارته إلى أن عملية العلمنة لا تزال غير مكتملة. حيث صرح في مقابلة عام 2002 أن “المساواة الكونية” هي الإرث المباشر لأخلاقيات العدل اليهودية وأخلاقيات الحب المسيحية، ولا يوجد بديل لها حتى يومنا هذا. ولقد أوضح هابرماس ما سيصبح عليه جوهر برنامجه الفكري من خلال خلقه لتناقض مشكوك فيه بين الديانتين السماويتين. لم يكن تراث الغرب اليهودي المسيحي مرحلة عابرة في ظهور الفكر والسياسة الحديثين، لكنه ساهم -وربما لا يزال يساهم- في جوهره الأساسي.
*****
كتاب هابرماس هو تحقيق على نطاق واسع لدعوى هابرماس، فهو يقدم عرضًا تاريخيًا يربط بين نظرية هابرماس القديمة في التواصل مع حجته الأحدث لتفوق المسيحية اليهودية بشكل مبسط جدًا. الأطروحة المركزية موسعة ولكنها واضحة. برزت العقلانية التواصلية وكذلك الديمقراطية الدستورية من حوار استمر ثلاثة آلاف عام بين قطبي الفكر الغربي: الإيمان والمعرفة. صُنفت الشمولية الأخلاقية في جوهر المسيحية – التي تطورت من سلفها اليهودي – في التفكير الما بعد ميتافيزيقي المعاصر، عبر تاريخ طويل من النقاش الفكري والتحول الاجتماعي. إن رواية هابرماس عن العلمنة تنحرف عما سماه الفيلسوف تشارلز تيلور “سردية التجريد” حيث يتم استبعاد المعتقدات غير العقلانية من تقدم مسيرة العلم، في حين يعيد هابرماس بناء تفاعلات الإيمان المسيحي والمعرفة الدنيوية كعملية لا تتعلق بالصراع، بل التعلم المتبادل والترجمة.
تتجذر عملية التعلم لدى هابرماس في طبيعة الإنسان العاقل بصفته كائنًا لغويًا. وبالاعتماد على بحث عالم النفس التنموي مايكل توماسيلو، يبدأ بتمييز حاد بين الإدراك البشري والحيواني. وكما يشرح هابرماس، فإن الرئيسيات الأخرى تتواصل بالإشارة إلى الأشياء في بيئاتها الخاصة، لكن يتجلى التعقيد الاجتماعي الفريد للحياة البشرية في الأسرة أحادية الزوج، والصيد من العصر الحجري القديم، والقدرة المحفزة والمميزة على التواصل البين ذاتي حول عالم موضوعي مشترك. سمح هذا الشكل الفريد للغة للبشر بصياغة حلول جماعية لمشاكل مشتركة. وبالتالي يمكن للتعليم الاجتماعي والثقافي للإنسانية أن يفوق تطورها البيولوجي.
يشرع هابرماس في سرد التطور المبكر للمجتمعات البشرية على امتداد تسلسل هرمي للأشكال التواصلية حيث كانت الطقوس بمثابة الوسيط الأساسي للتواصل “الرمزي”، الذي يربط بين الفرد والجماعة. يحدد هابرماس مرحلة التحول إلى الأسطورة في “الثقافات العالية للشرق الأدنى” في الألفية الثالثة قبل الميلاد والتي تميزت باللغة المكتوبة والتقدم العلمي والتسلسل الهرمي السياسي، لكن التحول الحاسم حدث في “العصر المحوري” بوجود موسى وبوذا وكونفوشيوس، وأفلاطون، وهو مصطلح استعاره هابرماس من الفيلسوف كارل ياسبرز. في حين انهارت أسطورة (الإله-الإنسان)، فإن وجهات النظر العالمية المحورية حققت التمييز الأساسي بين المقدس والمدنس، والأبدي والزمني. يحدد هابرماس من خلال “الله العليم” في اليهودية، وعقيدة التناسخ في البوذية، ومثل أفلاطون، أسس المنظور التجاوزي لكل من العلوم الموضوعية والأخلاقيات العامة.
وكما يشير هابرماس فإن ياسبرز قد طور مفهوم العصر المحوري، “للتغلب على تضييق النظرة الأوروبية إلى المسار الغربي للتطور الثقافي”. لكن دراسة هابرماس تأخذ منحى حادًا تجاه الغرب حيث يرى أن التاريخ المعين للمسيحية الغربية هو الذي يقودنا من الكون العالمي القديم للعصر المحوري إلى العقل ما بعد الميتافيزيقي الحديث والديمقراطية الدستورية. أصبحت الديانات الشرقية مندمجة في سلطة الدولة أو تراجعت من المنافسة مع العلوم الجديدة. ظلت اليهودية مرتبطة جدًا بلغتها المقدسة ونصها للتفاعل بشكل مثمر مع محيطها. لكن الظروف الفريدة للمواجهة المسيحية المبكرة مع الفلسفة اليونانية وسلطة الدولة الرومانية حفزت عملية التعلم المتبادل. وصل التناغم بين الإيمان والمعرفة الى القمة مبكرًا في توليف أوغسطين في القرن الرابع بين المسيحية والأفلاطونية. وفي نفس الوقت الذي قدم فيه أوغسطين الفلسفة إلى الكنيسة، أدخل النظام القانوني المستوحى من المسيحية الغربية الكنيسة إلى نطاق قوة السياسة.
وصل هابرماس إلى إيطاليا كنقطة تحول جديدة في القرن الثالث عشر عابرًا لصراعات الكنيسة والدولة في أوروبا في العصور الوسطى: على الرغم من أن الأشكال الأولى للرأسمالية الصورية فتحت التمايز الوظيفي للمجتمع الحديث. خرج توما الإكويني، المفكر الأساسي في تلك الفترة، على توليف أوغسطين المسيحي الأفلاطوني لتأسيس اللاهوت والفلسفة كنظامين منفصلين. يقدم العقل والإيمان الآن مسارات مستقلة تماما نحو الخلاص. على الرغم من أن الأكويني ظل في النظامًا الملكيً، فإن صياغته لـ قوة “القانون الطبيعي”، التي غرسها الله في العقل البشري، فتحت الباب أمام النظريات الديمقراطية الوليدة. مع انتقادات غير مسبوقة للبابا، وضع خلفاء الأكويني المتأخرون في القرون الوسطى القانون كحدود لسلطة الكنيسة والدولة. وبذلك وضعوا حجر الأساس للعصر الذي يصبح فيه القانون موضوع نزاع بين المواطنين.
ومع ذلك، فمن المفارقات -ربما انعكاسًا لتأثير فيبر المستمر- أن “الرجعي السياسي” مارتن لوثر هو الذي حظي بمكانة مرموقة في رواية هابرماس عن العلمانية. وكما يرى هابرماس فإن هجوم لوثر على السلطة الكنسية لم يؤد فقط إلى تفاقم انشقاق الكنيسة والدولة، بل وضع الإيمان في تبادل داخلي بين ذاتي بين الإنسان والله. تنبأت التأويلات البروتستانتية، التي أصبح فيها كل مؤمن مترجمًا ومفسرًا للكتاب المقدس، بالتواصلية القومية التي تُمنح فيها السلطة “للحجة الأكثر إقناعًا”.
في الوقت نفسه، أدت محاولة “لوثر” لتأمين الإيمان من غارات السلطة الدنيوية إلى التراجع عنها. أدى التمزق الذي أحدثه الاصلاح الديني بالإضافة إلى العلم والثورات السياسية في القرن السابع عشر إلى اندماج الأوغسطينية والأنطولوجيا الإنسية (ماذا يوجد؟) مع الفلسفة العملية (ماذا أفعل؟). أن علمنة سلطة الدولة، التي تجسدت في الثورة الدستورية الإنجليزية، أدت إلى تآكل الأسس المسيحية للنظام السياسي؛ في حين هددت حتمية القوانين النيوتونية بتقويض الإرادة البشرية الحرة، التي هي نواة الأخلاق المسيحية، ومن ثم برزت مسألة الشرعية باعتبارها نقطة الضعف للفكر الحديث.
ديفيد هيوم وإيمانويل كانط هما مفكرا القرن الثامن عشر بالنسبة إلى هابرماس هما الذين عبّرا عن الاستجابات المتغيرة النموذجية لهذه المشكلة. لم يتمكن فلاسفة القرن السابع عشر من التوفيق بين الإيمان والمعرفة إلا على حساب “الأسس غير المتسقة”. ضع في اعتبارك حجة توماس هوبز حول نظام ملكي قائم على الدين. وعلى الرغم من إلحاده، وعودة جون لوك إلى القانون الطبيعي المطبق بشكل شرعي. فقط مع هيوم وكانط تحققت النقلة إلى للتفكير ما بعد الميتافيزيقي. قسم هيوم الذات البشرية إلى تسلسل انطباعات الحس، وحل الميتافيزيقيا المسيحية. لكن كانط يظهر كبطل لرواية هابرماس، الشخصية التي أعادت بناء الجوهر العقلاني للمسيحية في أعقاب نقد هيوم الهدام. حتمية كانط القاطعة، التي دعت الأفراد إلى فرض أفعالهم كأساس لقانون عالمي، أرست أخلاقًا عالمية على أسس عقلانية بحتة.
يقدم هابرماس تاريخ فلسفة ما بعد كانط كمسار قصير نحو نظريته الخاصة في الفعل التواصلي. كان التحدي الرئيسي هو بناء مفهوم “الحرية العقلانية” – التي عرّفها كانط على أنها طاعة الذات لقانون الإرادة الذاتية – في المجتمع. جعل هيجل -بناء على تحول هاردر للتاريخ والثقافة- السمة المحددة للعقل هي “الروح المطلق” التي تتكشف عبر الزمن. ومع ذلك، إذا اتخذ هيجل خطوة إلى الأمام إلى ما بعد الموضوع الكانطي (الشيء في ذاته)، فإن تقييمه “للأخلاق” التي تفرضها الدولة كان خطوة إلى الوراء إلى المسيحية الملكية. فقط أتباع هيجل اليساريون في ثلاثينيات القرن التاسع عشر هم من طوروا نظرية اجتماعية للغة للتوسط بين الذات والموضوع. حدد لودفيج فيورباخ “الهيجلي الشاب” أن إمكانية حرية الإنسان ليست في تعالي الله ولكن في العلاقات الاجتماعية اليومية، التي تشكلت من خلال اللغة.
أطلق هابرماس على فصله الأخير عنوان “معاصرة الشباب الهيغليين”، مؤكدًا على التحول الدائم في موضع العقل من الوعي ذاتي إلى التواصل البين ذاتي. وهو يرفض نقد كارل ماركس للأيديولوجيا، الذي وضع المُنظِّر “على رؤوس المشاركين أنفسهم”. في حين يعتبر هابرماس أن تشارلز ساندرز بيرس، مؤسس البراغماتية الأمريكية، هو الخليفة الحقيقي للهيغليين الشباب. طور بيرس فلسفة فيورباخ للغة إلى نظرية معرفة كاملة. وبالنسبة لبيرس، فإن الحصول على المعرفة العلمية يتم فقط في التفاهم البين ذاتي، وكانت اللغة هي الوسيط الأساسي للتنسيق بين العالم الخارجي وبحث المجتمع العلمي.
أخيرًا، رسم هابرماس خطاً لكتاباته. بينما كشف بيرس عمليات التعلم اللغوي في العلوم والتكنولوجيا، أظهر عمل هابرماس منذ الثمانينيات كيف يعزز التواصل التقدم في الحياة الأخلاقية والسياسية ايضاً. يختار هابرماس عدم الانخراط في مناقشات أواخر القرن العشرين التي أحاطت بمجموعته. وقد كتب أن هذا “كان سيتطلب كتابًا آخر على الأقل”. لكن هذا القرار يعزز الحتمية الواضحة في سردية هابرماس عن التاريخ. تظهر نظرية هابرماس عن العقلانية التواصلية كنتيجة وتفسير للمسار الذي تتبعه منذ العصر المحوري. يبدو أن عملية التعلم تتوج بوعيها الذاتي -الذي تحقق في أعمال هابرماس.
هذا الملخص الموجز لا يكاد ينصف المجموعة المذهلة من النصوص والمناقشات التي يستكشفها هابرماس. إن بنية العمل بارعة، وإن لم تكن “غائيتها” مقنعة تمامًا. لكن الأكثر إلحاحًا هو أن هابرماس لا يستهدف “التاريخ” فقط كممارسة تاريخية، ولكن كسجل للأفكار التي قدمت الأسس السياسية للغرب الحديث. يدعو العمل القراء للنظر في الصدى -والتناقضات- بين الفلسفة والسياسة.
يرى هابرماس بنفسه توافقًا وثيقًا بين الاثنين كما في أعماله السابقة، ثم لن تفاجئ الآثار التكوينية التي يرسمها هو القراء المخضرمين. يُشكل “مفهوم الحرية العقلانية غير المتعصبة” والذي جاء كنتيجة لحوار ثلاثة آلاف عام بين الإيمان والمعرفة “مفتاح الأخلاق العقلانية الكونية التي تجعل الحل الخطابي للنزاعات الأخلاقية ممكنًا، حتى مع تعدد الأصوات المتباينة”، وفي المقابل، فإن “الآثار التاريخية لعمليات التعلم الأخلاقية العملية” التي تم تتبعها خلال دراسته تودع في “الممارسات والضمانات القانونية للدول الدستورية الديمقراطية “. باختصار: تُنشئ الدساتير الحديثة الإطار المؤسسي لمجال عام تشاركي، وهو قلب الحياة الديمقراطية. وهنا لا يرتبط المواطنون إلا بقوة الحجة الأفضل ويمكنهم التوصل إلى اتفاق عبر الانقسامات الثقافية.
إنها رؤية جذابة في وقت تتفاقم فيه الجائحة العالمية، وتصاعد اللامساواة، والعنصرية المتفشية، وحركات التمرد المعادية للأجانب على كلا الجانبين من المحيط الأطلسي، يقترح هابرماس أن البشرية تمتلك بالفعل الموارد اللازمة للنقاش المتوازن الموجه نحو الصالح العام. ومع ذلك، لا يزال التوتر قائما بين مُثُل هابرماس السياسية وإطاره التاريخي. ليست الفجوة في النظرية والتطبيق إلى حدٍّ ما، والتي أقر بها هابرماس بسهولة. بدلاً من ذلك، يتعارض أصل قصته الأوروبية مع مقصدها العالمي. يصر هابرماس على أن العقل الما بعد ميتافيزيقي – لأنه يرفض اللجوء إلى اليقين التأسيسي- يوفر أساسًا للحوار بين الثقافات الضروري لمواجهة الأزمات العالمية لتغير المناخ، والهجرة الجماعية، والأسواق غير الخاضعة للتنظيم الرقابي. ولكن من خلال تتبع ظهور العقلانية الحديثة فقط في عملية التعلم الغربية والمسيحية، فإنه يتجاهل “تصفية الحساب” التاريخية الضرورية لأي حوار.
واجهت نفس المشكلة أسلاف هابرماس في عصر التنوير، الذين رأوا أوروبا مصدرًا للمثل العالمية. ومع ذلك، فقد اعترفت التواريخ الفلسفية للتنوير الألماني بدور القوة في التاريخ، والعنف المتفشي في تفاعلات أوروبا مع العالم غير الأوروبي. تنبأ مقال كانط في عام 1784 بعنوان “فكرة لتاريخ عالمي له هدف كوزموبوليتاني”، والذي يبرز حجة هابرماس حول مجال عام عالمي، بتحقيق السلام العالمي من خلال “تحسين الدساتير السياسية لقارتنا (والتي من المحتمل أن تصدر تشريعات في نهاية المطاف لجميع القارات الأخرى). واجه هيردرمور مباشرة العلاقة بين الهيمنة الأوروبية العالمية والعنف الاستعماري، واقترح أن التاريخ سينتقم منه. “يجب على أوروبا أن تقدم تعويضات عن الديون التي تكبدتها، وأن تُصلح الجرائم التي ارتكبتها – وذلك ليس خيار، وإنما أمر تقتضيه طبيعة الأشياء”.
حتى تاريخ هيجل المعتمد على الروح المطلق، وهو أكثر أطروحات الغائية التاريخية الأوروبية صراحةً للمثالية الألمانية الكلاسيكية، يشهد على الروايات المضادة التي هزت اليقين الذاتي في أوروبا الثورية. كما أوضحت المُنظرة السياسية سوزان باك-مورس، فإن ثورة هايتي من 1791-1804، وانتفاضة الرقيق التي أطاحت بالحكم الفرنسي على الجزيرة الكاريبية، ربما تكون قد تكون دافع وراء رواية هيجل المبكرة عن الحرية. على الرغم من أن هيجل قد أصبح فيما بعد مدافعًا عن العبودية، إلا أن نظريته الجدلية للتاريخ شكلت نموذجًا لكيفية ظهور المثل السياسية من الصراع، وليس الاتفاق فقط. ففي نفس الوقت الذي قامت فيه فلسفات التاريخ المثالية بتقديم مبررات عامة للاستعمار، فيمكنهم أيضًا -دون قصد- ان تقوضه.
على النقيض من ذلك، يكرس كتاب هابرماس اهتمامًا محدودًا لتناقضات العبودية والاستعمار الأوروبيين، فضلاً عن إشكالية علاجهم من قبل المعاصرين. يؤطر هابرماس بدلاً من ذلك، المواجهات الاستعمارية على أنها لحظات في عملية التعلم، وهي محطات على الطريق نحو العالمية الأخلاقية. يتناول غزو الأميركتين فقط ليخلص إلى أن فرانسيسكو دي فيتوريا، سكولاستيك القرن السادس عشر الذي دافع عن حقوق الملكية للشعوب الأصلية، مثّل الامتداد العالمي للقانون الطبيعي الكاثوليكي. لكنه يغفل قسما طويلا من استخدام نظرية لوك للحق الطبيعي لتبرير المصادرات الاستعمارية.
كما أن هاييتي أيضًا غائبة عن تاريخ هابرماس، مثلها مثل الجدل المسيحي الداخلي الذي دام قرونًا حول شرعية العبودية، وبدلاً من ذلك، يروي هابرماس أكثر من قصة مباشرة ويرى بأن “إلغاء الرق” هو “مثال مدهش ومذهل حقًا” للتعلم الأخلاقي:
“في حين أنه كان ينبغي دائمًا فهم الرقيق على أنهم أشخاص محرومون من الوضع الاجتماعي للأشخاص الأحرار، كان على “الأسياد” أولاً أن يدركوا ويتعلموا أنه يوجد في الآخرين ما يوجد في أنفسهم”
لكن هذا الوصف مضلل. إنه لا يستبعد الإرث الدائم للعبودية فحسب، بل أيضًا تاريخ المقاومة والحرب الأهلية ورد الفعل العنيف الذي مهد الطريق الملتوي نحو التحرر. وبالكاد يمكن فصل هذه التواريخ عن حقوق الإنسان. أخذ هابرماس سن الدساتير الديمقراطية لتمييز “التجسيد التاريخي للعقل”، لكن دساتير شمال الأطلسي لعصر الثورة استمرت في السماح بالعبودية في الوقت نفسه الذي وسعت فيه حقوق الفئات المتميزة.
يتقدم هابرماس بالمثل من خلال الإصلاح الاجتماعي في القرنين التاسع عشر والعشرين، متجاوزًا الصراعات المتنازع عليها والمسيَّسة والتي لا تزال مستمرة والتي من خلالها تطالب الجماعات المهمشة بحقوقها القانونية، مثل إلغاء الرق. يعتبر هابرماس أن “الإذن بالتسامح الديني وحرية الرأي والمساواة الجنسية، وكذلك الاعتراف أكثر بالحرية الجنسية ” كنتيجة لعمليات التعلم الأخلاقي. مثل هذا التعلم يحدث عندما تكتشف الأجزاء ذات الصلة من السكان صلات جديدة بالأشخاص “الآخرين”، الذين شعروا تجاههم حتى ذلك الحين بالتزام ضئيل أو ضعيف فقط مما يسمح لهم بفهم أنه حتى هؤلاء “الغرباء” لا يختلفون عنهم بأي شكل من الأشكال.
لا يقف تفسير هابرماس للتقدم الأخلاقي الغربي بعيدًا فقط عن كلاسيكيات النظرية النقدية مثل هوركهايمر وجدلية التنوير لأدورنو، بل يمكن القول إنه يتعارض مع أعماله السابقة في المجال العام. تؤكد الفيلسوفة ماريا بيا لارا في مقالٍ بمناسبة عيد ميلاد هابرماس التسعين، كيف أن مفهوم هابرماس للعلنية يوفر أدوات “للنسوية والمجموعات المستبعدة الأخرى” لتحدي هياكل السلطة والمطالبة بالاعتراف بها كمواضيع سياسية. ومع ذلك، فإن قصص المجموعات والأفراد المستبعدين الذين أدخلوا أنفسهم في المجال العام -وشريعة الفلسفة الغربية- غائبة عن “هذا أيضًا تاريخ الفلسفة“. بالنسبة إلى العديد من التقلبات والمنعطفات. يعد التاريخ الذي يرويه هابرماس تاريخاً كلياً يسير في خط مستقيم، ويتكشف عن منطق جوهري. نادرا ما نتعلم من الاستنتاجات المنبوذة ظلماً، والمعرفة المقموعة، والتجارب الفاشلة، فعلى ما يبدو أن القليل يُنسى في عملية التعلم.
ربما يعترض هابرماس على أن مثل هذا النقد يتجاهل جوهر الموضوع، حيث أن التاريخ المؤلم للرق والاستعمار ليس هو موضع الخلاف، لأن الفكر السياسي الغربي لا يزال يؤمن بإلغاء العنصرية (أو التحيز ضد المرأة، والتمييز الديني، وكراهية المثلية الجنسية) كمثال معياري للتوجه. يبدو أن تحدي مفهوم هابرماس لعملية التعلم وكأنه يفقد التنويرالوعد بتحسين منطقي للوضع الإنساني.
ومع ذلك، فإن إثارة التساؤلات التي تتعلق بالدقة التاريخية لا يعني رفض أفكار هابرماس. تظل أهدافه – الديمقراطية الدستورية التي يدعمها مجال عام قوي، وحقوق متساوية محققة في كل من القانون والممارسة، والتعاون الدولي حول المشكلات العالمية – ذات أهمية حاسمة، حتى عندما يبدو تحقيقها لا يزال بعيد المنال. لكن التاريخ الموجه نحو تحقيق هذه المثل العليا سوف يتطلب دراسة أوفى للسياسات التي تم تشكيلها والمتنازع عليها. تحد “عملية التعلم” المسيحية من فهمنا لكيفية حدوث التغيير السياسي في الماضي وذلك لتضييق النشأة الشمولية الأخلاقية للغرب. يقيد مثل هذا السرد – تحويل الأمر العرضي إلى أمر حتمي – تفكير النظرية الاجتماعية في المستقبل المحتمل.
يختم هابرماس بالإشارة إلى مقال ثيودور أدورنو المتأخر، “العقل والوحي” والذي توصل فيه من خلال التفكير في النهضة الحديثة للأديان غير العقلانية إلى أن عودة الدين لا يمكن أن تستمر. قال أدورنو: “لا شيء من المحتوى اللاهوتي سوف يستمر دون أن يتحول”. ” كل محتوى يجب أن ينجح في اجتياز قنظرة الدخول إلى العالم الدنيوي العلماني”.
كتب أدورنو هذه الكلمات تكريماً لصديقه ومحاوره والتر بنيامين، الذي انتحر في عام 1940 هربًا من الاضطهاد النازي على الحدود الفرنسية الإسبانية. وتم إدراجها تكريما لأدورنو، مدرس هابرماس والمفكر الذي تحدث عن أزمة الحضارة الحديثة التي تجاوبت معها مسيرة هابرماس. ويجيب هابرماس على أدورنو بأسلوب يناسب بنيامين، الذي أدركت كتاباته الأخيرة بصيص أمل ميساني من خلال تاريخ المعاناة:
“طالما أن التجربة الدينية لا تزال تدعم -على أساس ممارسات طقسية- وجود السامي والمتعالي المهيمن، فإن السؤال يبقى مفتوحًا أمام العقل العلماني عما إذا كانت هناك محتويات دلالية ليس لها مكافئ “دنيوي/علماني”، ومن ثم تنتظر تحويلها وتطعيمها بدلالات علمانية “.
وبالتالي، يقترح هابرماس أن الدين قد يحتفظ بنواة مقدسة تستعصي على العلمنة.
ومع ذلك، فإن تأمل هابرماس الختامي يعد مُنفرًا أيضًا، مما يؤكد على خروجه عن سنن الجيل الأول لمدرسة فرانكفورت. بالنسبة لأدورنو وبنيامين، فإن تجربة المعاناة الوحشية، التي تجسدت في عصرهم مع صعود الاشتراكية القومية، كشفت زيف الغائية التقدمية للعقل البشري. على النقيض من ذلك، يلمح هابرماس مرة واحدة فقط في نهاية مقدمة طويلة إلى الظروف التاريخية لفكر أسلافه، ويلاحظ أن “التراجع” يظل بمثابة الظل الملازم لـ “التقدم”:
“كاقتحام حقيقي للحضارة، يمكننا أن نسمي ما شهدناه في القرن العشرين أي شيء، لكن لا يمكننا أن نقول إنه “الانتكاس إلى البربرية”؛ ولكن الجديد تماماً في الأمر هو أنه يوجد دائماً ومن الآن فصاعدًا إمكانية الانهيار الأخلاقي لأمة بأكملها”.
ويمضي هابرماس في الاعتراف بأن “اللامعقول في التاريخ” سيكون “موضوعًا مهملاً في المستقبل” ولن تظهر الفترة النازية مرة أخرى.
في سياق التاريخ الألماني، قد يكون الافتراض الضمني لعمل هابرماس هو التحول الديمقراطي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وهو ما أطلق عليه هابرماس سابقًا “الانفتاح غير المشروط تجاه الغرب”، وهو يثبت المنحنى الطويل لعملية التعلم، ويبدو أنه يقترح أنه يجب ألا تعمينا “الغطرسة” التي شغلت أسلافه عن إنجازات الغرب التاريخية. لقي هابرماس الثناء المستحق لسعيه إلى الأمام بنقد أسلافه الشامل للعقل. أثبتت مساهماته العامة أهمية حيوية في تعزيز الثقافة الديمقراطية فيما بعد الحرب في ألمانيا، لكن تاريخ هابرماس يتجنب ربط ظهور العقلانية الغربية الشاملة بأنظمة العنف والنهب اللذَين بات إرثهما واضحًا لغاية اليوم، وهذا أيضًا شكّل تاريخ الفلسفة.
ومع ذلك يعد كتاب هابرماس إنجازًا بارزًا وبكل المقاييس. يتوج النص مهمة فكرية مولدة، موضحًا طريقة فهم هابرماس للأسس التاريخية والمفاهيمية لمشروع حياته، والأهم، أن العمل سوف يلهم المجموعة التالية من المنظرين النقديين لمواجهة مشكلة الأرضية التاريخية للفلسفة من جديد. قد تدحض التحديات التي تواجه الديمقراطية والنضال من أجل العدالة في لحظتنا الاقتناع بأن العقلانية العامة هو التراث الوحيد للغرب، أو أنها ذروة تقدمه التاريخي، لكن التفكير مع هابرماس وضده يوفر أدوات قوية لإعادة النظر في مكان الفعل التواصلي في مشروع التحرر في النظرية الاجتماعية. إن العودة إلى التاريخ كعدسة نقدية لخطاب الفلسفة -بدلًا من كونه مادة تطوره العقلاني- يوفر طريقًا واحدًا إلى الأمام.