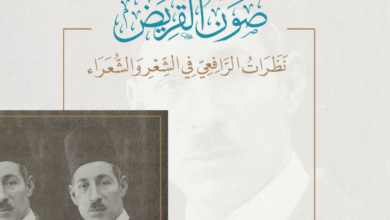- بيتر غوردون
- ترجمة: علي آدم عيسى
- تحرير: عبد الله الهندي
في السادس من أبريل 1967، لبّى ثيودور أدورنو دعوةً من رابطة الطلاب الاشتراكيين في جامعة فيينا لإلقاء محاضرة حول “جوانب التطرف اليميني الجديد”. كان للموضوع أهميةٌ خاصة آنذاك: لقد كان الحزب الوطني الديمقراطي (وهو مجموعة من الفاشيين الجدد تأسست مؤخرًا في ألمانيا الغربية)؛ تتزايد شعبيته وسيجاوز 5٪ قريبًا (العتبة الرسمية المطلوبة) لضمان التمثيل في سبعةٍ من البرلمانات الإقليمية الإحدى عشر في ألمانيا. في أوروبا -بعد الحرب العالمية الثانية-، كان أدورنو يحظى بتقدير كبير، ليس بسبب كتاباته الفلسفية والثقافية فقط، بل أيضا لتحليله الميولَ الفاشيةَ التي لا تزال تتمظهر فيما يُسمّى بالأوامر الديمقراطية الليبرالية في الغرب الرأسمالي، وسط حرص الطلاب والنشطاء الاشتراكيين الذين تجمعوا في فيينا لسماع أفكاره.
تناولت المحاضرة -رغم أنها موجزة- حالات محددة لعودة الفاشية الجديدة في ألمانيا الغربية بعد الحرب. وتحدثت عن السؤال العام حول ماهية الفاشية، وكيف يجب أن نفكر في تحديات الديمقراطية الليبرالية التي تأتي من اليمين المتطرف؟. وجادل أدورنو: بأن الديمقراطيات الليبرالية هشة بطبيعتها. ويرى أدورنو: أن الديمقراطية الليبرالية مليئة بالتناقضات، وهي عرضة للانتهاكات المنهجية، وكثيرًا ما يتم انتهاك مُثُلها المعلنة في الممارسة العملية، إلى درجة أنها توقظ الاستياء والمعارضة والتوق إلى حلول من خارج النظام، ويجب على أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية أن يواجهوا عدم المساواة المستمرة التي تولد هذا الاستياء، والتي تمنع الديمقراطية من أن تصبح كما تدعي. نُسِخت المحاضرة مؤخرا من تسجيل صوتي، ونُشِرت بترجمة إنجليزية، تحت عنوان: “جوانب التطرف اليميني الجديد”. وتذكرنا المحاضرة بإسهامات أدورنو السياسية في أواخر الستينات. كما يجب أن تكون بمثابة تصحيح للمفهوم الخاطئ الشائع حول أدورنو: بأنه فيلسوف غامضٍ، وسلبيّ لاهٍ -فيما وصفه جورج لوكاش -بازدراء-: “فندق الهاوية المهيب”-. عاد أدورنو -بعد سنوات من المنفى في الولايات المتحدة- إلى فرانكفورت، ولم يكرس نفسه للفلسفة فقط؛ ولكن لإعادة بناء جمهورية ألمانيا الاتحادية أيضًا، وتحدثَ كثيرًا -بصورة شخصية وعلى الراديو- وحث جمهوره لتبني المُثُل الديمقراطية للنقد الذاتي والتعليم والتنوير.
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا عمياناً عن عودة ظهور الحركات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، فإنه قد يكون التشنج المبكر لحماس الفاشية الجديدة -في منتصف الستينات في ألمانيا الغربية- بمثابة تأكيد واقعي لادعاءت أدورنو: بأن الحركات الفاشية ليست حكرا على الديمقراطية الليبرالية، بل هي بالأحرى داخلية، وهي بمثابة محددات هيكلية دالة على فشل الديمقراطية الليبرالية. هذه البصيرة لدى أدورنو (التي قد نطلق عليها: “الركيزة الأساسية في التقييم الجدلي لمدرسة فرانكفورت للفاشية”)= يساء فهمها بسهولة، ليس من قبل المدافعين المحافظين الذين يمكِّنون القوى التي تهدد الديمقراطية الآن فقط، بل حتى من بعض النقاد اليساريين الذين لا يرغبون في رؤية الفاشية على أنها تهديد دائم؛ حيث إنهم يقصرونها على ماضٍ منفصلٍ، رافضين تلك المخاوف من انبعاث الفاشية على أنها عَرَضٌ من أعراض الهستيريا الليبرالية. سيعرف أي شخص قرأ أدورنو أن هذا حديثٌ مجانبٌ للصواب. ويمكن أن تساعدنا قراءة محاضرات أدورنو خلال العصر الحالي الذي يشهد انبعاثا للفاشية الجديدة في تقدير مدى قوة مزاعمه.
إنَّ من أبرز التحريفات العديدة وربما أكثرها رواجاً: تلك التي تدور حول أدورنو والتي تنتشر بين النقاد اليساريين و اليمينيين على حد سواء، وهي فكرة أن أدورنو كان رجلًا ذا ثروة كبيرة، فضَّلَ حياة الترف في الأعمال الفنية للحداثة، ولم يكن لديه سوى القليل من الصبر أو الاستعداد للسياسة العملية. ولكن القصة الفعلية أكثر تعقيدًا. ولد أدورنو عام 1903 في فرانكفورت، ونشأ في أسرة من الطبقة المتوسطة. كان والده تاجر نبيذٍ من أصل يهودي، ميسور الحال ولكنه ليس ثريًا، وتلقى الشاب تيدي تعليمًا جيدًا في الموسيقى من والدته وعمته، وكلتاهما موسيقيتان بارعتان. لكنه أيضًا انجذب إلى الفلسفة الحديثة والفكر الاجتماعي (الكلاسيكيات: كانط وهيجل، وأعمال المتمردين: كيركيغارد، وماركس، ونيتشه، وفرويد) اللتين قرأهما -كما صار أسلوبه الخاص بعدُ- متلاعبًا بهما، وفاضحًا تناقضاتهما، حتى تحول ما كان بالأمس مذهبًا إلى ديالكتيك لا نهاية له.
بعد المرحلة الثانوية، التحق أدورنو بجامعة فرانكفورت، حيث انغمس في الفلسفة وكتب عن فينومينولوجيا هوسرل، وعن التحليل النفسي لفرويد. والتقى هناك بماكس هوركهايمر (الذي سرعان ما تولى منصب مدير معهد البحوث الاجتماعية/مدرسة فرانكفورت)، وانضم إلى دائرة من المثقفين اليساريين والنقاد الاجتماعيين، من بينهم: والتر بنيامين (الذي ألهم أدورنو أن يشحذ نصل نقده، ويطبقه بلا رحمة على تفاصيل الرأسمالية والحياة الحديثة). من حيث النمط والأسلوب، يشبه كتاب أدورنو الأول (وهو دراسة لكيركغارد) شبهًا وثيقًا دراسةَ بنيامين المعقدة الشهيرة عن الدراما الألمانية الباروكية إلى درجة أن المؤرخ غيرشوم تشولم (الذي لديه سابق معرفة بأدورنو) أطلق عليه اسم: “الانتحال”.
لم يكن أدورنو ناشطاً سياسياً، لكنه كان ينتقد -غريزياً- السياسة الليبرالية في سنوات ما بين الحربين العالميتين، ووجد – مع زملائه من ذوي التفكير المماثل- موطنًا مناسبًا في معهد البحوث الاجتماعية، الذي كان معروفاً -على سبيل المزاح بين الطلاب- في فرانكفورت باسم: “مقهى ماركس”. هناك صاغوا رؤاهم الفلسفية الأكثر تجريديةً في سياق المشاكل الملموسة في التاريخ والمجتمع، ومهما ابتعدوا عن الأجندة الماركسية أو الماركسية الجديدة لمؤسسي المعهد؛ فإن الفهم الجدلي الديالكتيكي للعلاقة بين الفلسفة والتجربة الحية الملموسة على أرض الواقع= ظل موضوعا ثابتا ومستمرا في أعمالهم.
اضطر أدورنو والعديد من زملائه في مدرسة فرانكفورت إلى مغادرة البلاد إلى المنفى في عام 1933، وأصبحوا منشغلين بالفاشية كموضوع للبحث الثقافي والاجتماعي. في الواقع، لقد انبثقت النظرية النقدية من هذه البوتقة. كافح أدورنو وأعضاء آخرون في المعهد لشرح كيفية تسيّد الفاشية، وكيفية استطاعتِها جذبَ مختلف الفئات في انتخابات ديمقراطية، وكيف غيّرت شكل الدولة بمجرد وصولها إلى السلطة. رغم أن أدورنو نادراً ما ينحدر من التحليل الفلسفي إلى التحليل المؤسساتي؛ إلا أنه شارك زملاءه قناعاتهم بأن الفاشية ليست مشكلةً ألمانيةً فحسب، بل هي مشكلة إنسانية، وهي سرطان يهدد جميع المجتمعات الحديثة، ولا يمكن تفسيرها إلا بأدوات تشتمل على عدة تخصصات تجمع بين العلوم السياسية وعلم الاجتماع بل حتى علم النفس. وقد حملت هذه الجهود خطر فَقْد الفاشية خصوصيتَها في استخدامها هذا الأسلوبَ، وتصبح مضخمة إلى أن تصبح محنة عالمية، مع وجود فروقات بسيطة تختلف باختلاف الزمان أو المكان. ومع ذلك، حافظ أدورنو وزملاؤه في أفضل أعمالهم على تركيزهم على ما أسماه أدورنو: النقد “الميكرليولوجي/نقد صغائر الأمور”؛ مما حافظ على جدلية بين العام والخصوص.
يتضح -على الفور- هذا التركيز على الخاص بمجرد أن نحول انتباهنا من الكلاسيكيات التأملية الشاهقة مثل: “جدلية التنوير” لأدورنو وهوركهايمر، إلى عمل أكثر تجريبية مثل: “دراسات النازية” لفرانز نيومان وأوتو كيرشهايمر (أعضاء مدرسة فرانكفورت) الذين تمر أسماؤهم -في كثير من الأحيان- دون ذكر اليوم، وكانت ذات يوم مركزيةً في برنامج المعهد المناهض للفاشية. ولا ينبغي لنا أن نتجاهل إسهامات أدورنو في علم النفس الاجتماعي، مثل: “الشخصية الاستبدادية” و”التجربة الجماعية”؛ حيث نظّمَ أدورنو وزملاؤه البيانات الكمية والنوعية لتطوير فهم شامل لإمكانية ظهور الفاشية بين المواطنين الديمقراطيين، وأن التعمق في النفس يجعل ملاحَظًا أن الاستبداد لا يمكن اختزاله في علم النفس الفردي، ولكنه -في النهاية- يعكس الظروف الموضوعية للمجتمع الحديث. ونتيجة ذلك: تصميم مقياس F الشهير لاختبار قياس الفاشية، وقد قُدَّم في عام 1950، مقياسًا للنزعات العامة، مثل: التقاليد والصلابة والعداء للخيال، في محاولة تفسير لسبب انجذاب المعاصرين إلى الفاشية، أو امتلاك القليل من الموارد الضرورية اللازمة لمقاومتها.
عند قراءة “الشخصية الاستبدادية” و”التجربة الجماعية” اليوم يُدهش المرء من الكم الهائل للتفاصيل التجريبية، والاستعداد لتمييز الاتجاهات الاستبدادية، ليس في مؤسسات سياسية محددة فقط، ولكن أيضًا في أكثر سمات المظاهر اليومية شيوعا. جادلت الدراسات بأن الفاشية ليست شرًا مُسْتَطِيرا أو مرضًا يستلزم علاجًا بسيطًا له، إنها شيء أكثر إثارة للقلق: انها سِمة كامنة بل منتشرة في الحداثة البرجوازية. ومع هذا التعريف المتوسع، بالكاد يمكن للمرء أن يطمئن إلى هزيمة الفاشية في نهاية الحرب. في تلك المحاضرة عام 1959، أوضح أدورنو هذه النقطة بوضوح: “إن الماضي الذي يود المرء الهروب منه لا يزال حاضرًا إلى حد كبير”.
بالنسبة لأدورنو، كان استمرار الفاشية الواضح لا يمكن إنكاره. وقد نجح المئات بل الآلاف من مسؤولي الحزب النازي السابقين في تجنب التدقيق في سلوكهم في زمن الحرب وواصلوا حياتهم المهنية في جمهورية ألمانيا الاتحادية دون انقطاع. ولكن الفاشية كانت أيضاً -على حد تعبيره- وليدة “الحالة العامة للمجتمع”. كانت الديمقراطية الليبرالية تحتوي -في حد ذاتها- على اتجاه نحو التوحيد القياسي، مدعومًا بنموذج السلع، الذي اختزل الأشياء -وكذلك الموضوعات البشرية- إلى عناصر تبادل. وبعد تجريدهم من اختلافاتهم، تضاءل الأفراد إلى كتلة خاملة تكره فكرة المقاومة وباتت مهيأةً للخضوع. لا يمكن أبدًا التصدي للفاشية أو هزيمتها إذا كان يُنظر إليها على أنها مجرد مرض ليبرالي غريب جاء من الخارج ولم يتألف من عناصر نادرة بل من معادن أساسية هي مواد بناء عالمنا المشترك. وفي محاضرة عام 1959، أعلن أدورنو: “أن أعتبار بقاء الاشتراكية القومية داخل الديمقراطية هو أكثر تهديدًا من بقاء النزعات الفاشية ضد الديمقراطية”. وهذا الفهم للفاشية باعتبارها شيئاً داخلياً لا غريباً عن الديمقراطية الليبرالية= قد يعكس أيضاً تاريخ أدورنو.
حتى قبل صعود هتلر والنازيين، كان يدرك أدورنو العنف الكامن الذي يسري في عروق المجتمع البرجوازي، وفي السنوات اللاحقة لم يكن محرجاً من التذرع حتى بالذكريات الأكثر عرضًا كدليل. في مجموعته للأقوال المأثورة بعد الحرب، المعروفة باسم: “الأخلاق الدنيا”، أشار إلى المتنمرين في فناء المدرسة في طفولته، حيث كتب قائلاً: “الوطنيون الخمسة الذين ثقفوا رفيقاً مدرسيًا وقاموا بضربه، وعندما اشتكى إلى المعلم، وشوا به باعتباره خائنًا لـلصف، هل هم نفس أولئك الذين عذبوا السجناء لدحض مزاعم الأجانب بأن السجناء تعرضوا للتعذيب؟ قد يبدو هذا الاقتراح قسريًا، ولكن فقط إذا تشبث المرء بالوهم القائل: بأن النازية كانت كلها سياسات عليا وليست متجذرة في السلوك اليومي”. بعد أن شهد صعود النازيين، لم يكن لدى أدورنو مثل هذه الأوهام. قبل فترة طويلة من استيلاء النازيين على السلطة، كان في دوامة من “الخوف غير الواعي” من أن المستقبل سيجلب كارثة. وبالفعل حدثت الكارثة، مع صعود النازيين إلى السلطة، حيث أجبرت قوانين الرايخ الثالث الجديدة أدورنو على النفي. في البداية حاول إعادة بدء حياته المهنية في أكسفورد، ثم تخلى عن هذه الفكرة وانضم إلى هوركهايمر وزملاء آخرين من المعهد في الولايات المتحدة. ظل والداه في ألمانيا بعد أن أقام ابنهما في نيويورك، وتمكنوا من البقاء على قيد الحياة بالرغم من وجود احتمالات ضئيلة. وقُبِض عليهم خلال موجة الاضطهاد التي أعقبت ليلة الكريستال، أو “الكريستال نايت”: المذبحة التي رعتها الدولة ضد الشركات والمنازل اليهودية. تعرّضَ والده للضرب وأصيب بجروح خطيرة في عينه، وتعرضت مكاتب الشركة العائلية للنهب وصودرت؛ إذ يمكن ببساطة أن تطالب الدولة بالممتلكات اليهودية. في نهاية المطاف أُفرِج عن والديه، رغم أن التجربة تركتهما مهتزين. هرب والداه عبر كوبا إلى الولايات المتحدة، ولكن شبح الفاشية ظل يطارد الأسرة بأكملها. أثارت هذه التجارب ونحوها إحساسا عميقا في أدورنو -وأُعجِب به-: أن الفاشية ليست مجرد شكل سياسي، بل هي كذلك نوع من أنواع الانحدار العنيف إلى أنماط قديمة من السلوك الجماعي لا يمكن فهمه إلا من خلال الانجذاب إلى فئات الأنثروبولوجيا والتحليل النفسي.
مدفوعا بمقال فرويد: “علم النفس الجماعي وتحليل الأنا”، وصل أدورنو إلى اعتقادٍ: أن المجموعات البشرية تظهر مقاومة غريزية للتغيير والتوق إلى السلطة. كتب فرويد: أن الجماعة “تريد أن تُحكم وتُضطهد”، وهي لا تنظر إلى أبطالها من أجل التنوير؛ بل من أجل “القوة، أو حتى العنف”. من التحليل النفسي، أخذ أدورنو أيضًا درسًا حاسمًا مفاده: أن التملق بين الجماعة وقائدها هو أمرٌ ليبيدي/شهواني -في الأساس- وليس عقلانيًّا، وأي محاولة لتفسير السياسة الجماهيرية من الناحية المؤسسية البحتة أو أنها تعبير عن المصلحة الذاتية العقلانية= ستفقد العوامل الكامنة التي تجعل الاستبداد تجربة دائماً.
إن تحليل الفاشية بأنها تهديد مستمر داخل الديمقراطية الليبرالية= موضوع مكرر في أعمال أدورنو. وهذا ينطبق على الشخصية السلطوية والتجربة الجماعية، وفي المحاضرات العامة التي ألقاها بعد عودته إلى ألمانيا كان منزعجًا بشدة من ظهور منظمات فاشية جديدة، مثل: الحزب الوطني الديمقراطي؛ لأنه -في رأيه-كان علامةً على أن روح الفاشية القديمة لم تقهر بعد. لقد كان أدورنو منزعجًا بنفس القدر من حقيقة أن الجمهور لم يبدِ اهتمامًا كبيرًا بإلزام نفسه بالعملية الصعبة المتمثلة في “العمل عبر الماضي”. في خطاباته -إن لم يكن في فلسفته المنشورة- تناول أدورنو هذه المخاوف بوضوح وإلحاح أخلاقي. إن محاضرة أدورنو عام 1967 حول التطرف اليميني الجديد ليست غير نموذجٍ واحدٍ متواضعٍ ومختصرٍ من هذا العمل، لكنها تلخص -ببراعة- وجهة نظره العامة القائلة: بأن الفاشية لم تُهزم حقًا بعد، بل إنها تكمن في الجوانب اليومية للبنية الاجتماعية والسلوك الشخصي، ويجب محاربتهما من جديد. في تلك المحاضرة، حذر أدورنو من أن اتخاذ مجرد نظرة “تأملية” للأحداث الأخيرة، كما لو أن السياسة سلسلة من الظواهر الطبيعية مثل: “الزوابع أو كوارث الأرصاد الجوية”، وقال: إن تبني مثل هذا الموقف علامة بالفعل على الخضوع والاستسلام، كما لو أنه بوسع المرء أن يتخلى عن نفسه موضوعا سياسيًّا. وقال: “كيف ستستمر هذه الأمور، ومن المسؤول عن كيفية استمرارها؟”، قال: إن ذلك -في نهاية المطاف- يقع في أيدينا.
في ربيع عام 1967، كان عدد قليل من اليساريين يشعرون بالتفاؤل إزاء آفاق الديمقراطية الحقيقية في ألمانيا الغربية. ومنذ تأسيسها في عام 1949، ظلت في قبضة الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة كونراد أديناور، وهو محافظ قوي كان يبلغ من العمر -عندما أصبح مستشاراً للبلاد- 73 عاماً. وخلفه سياسي آخر من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، هو لودفيغ إرهارد، الذي حل محله زميله كورت جورج كيسينغر في عام 1966، وشكّلَ حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي أعيد تنظيمه مؤخراً.
ربما بدا ظهور الحزب الاشتراكي الديمقراطي خافتا في بادئ الأمر، ولكن في عام 1966 و1967، عانت ألمانيا الغربية من أول نكسة كبرى في تاريخها عندما اخترق الركود “ثورتها الاقتصادية” الشهيرة، فقد ارتفعت البطالة إلى ما لا يقل عن نصف مليون شخص بحلول أوائل عام 1967، وبدأ الحزب الديمقراطي الوطني -الذي كان هامشياً آنذاك – في النمو، وارتفعت عضويته بحلول عام 1968.
لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي بأي حال من الأحوال أول حزب يميني متطرف يظهر في ألمانيا الغربية، فقد تأسس حزب الرايخ الاشتراكي بعد الحرب العالمية الثانية، وهو مجموعة من النازيين الجدد، ولكنه حظر في عام 1952. أيضا ظهر حزب الرايخ الألماني والجماعات ذات الصلة في أعقابه، لكن بحلول منتصف الستينات كان حزب الرايخ قد حُل. بيد أن الحزب استقدم العديد من قادته وأعضائه من المجموعات القديمة وشكل تهديدا أكبر بكثير، أبرزهم: أدولف فون ثادن، وهو نبيل بارز، كان نازياً نشطاً خلال الحرب، وكان مسيطرًا على مقاليد السلطة في الحزب، حتى لو لم يكن رئيسه الفخري في البداية، وبعد موجة من الصراعات الداخلية، اكتسب السيطرة في عام 1967. وفي الاجتماعات المحلية وعندما تأكد من أن وسائل الإعلام الوطنية في غفلة من أمرها؛ انتقد الحزب الوطني ضد “اليهودية الدولية والصحافة اليهودية”، مصراً على أن الرايخ الثالث لم يرتكب أي جرائم ضد الإنسانية. وادعوا أن النازية كانت مدعومة من “أفضل العناصر الألمانية” وأن مهمة الحزب الوطني الألماني الآن هي تخليص الشعب الألماني من عاره الوطني وجعل ألمانيا عظيمة من جديد مرة أخرى. في عام 1966، دخل الحزب إلى برلمانات “لانداغ” أو البرلمانات الإقليمية في كل من “هيسن” و”بافاريا”، وبدا أنه يستعد للفوز بالاندماج في العديد من البرلمانات الأخرى في جميع أنحاء ألمانيا الغربية.
بالنسبة لأدورنو، أظهر الحزب الوطني الديمقراطي بعض الاتجاهات التي درسها في عمله السابق حول الفاشية والسلطوية، ولاحظ ظهورهما في سياق عالمي، حيث كانت الفوارق في الهوية الوطنية تفقد أهميتها السياسية. إن أحزابًا مثل الحزب الوطني الديمقراطي الذي تحركه نزعة قومية “مَرَضية” في عصر تكتلات القوى العظمى، سوف “تأخذ على نفسها طابعها الشيطاني المدمر بحق، على وجه التحديد عندما يحرمها الوضع الموضوعي من الجوهر”. ومن المفارقات: أن عنصر اللاواقعية هذا قد يكون السمة الأميز للفاشية: فهو يفرغ السياسة من محتواها ويختزلها في مجرد أداة للبروبغندا. تتشابه الفاشية القديمة والجديدة على حد سواء في استخدامهما البارع للدعاية دون هدفٍ أسمى، كما لو كان الهدف الوحيد هو كمال علم النفس الجماهير من أجل مصلحتها الخاصة. قال أدورنو: “لم تكن الفاشية أبدًا نظرية كاملة التطور حقًا”. بدلاً من ذلك، جردت السياسة من أي معنى أعلى، واختزلتها إلى مجرد قوة و “هيمنة غير مشروطة”.
وقد ساعدت مثل هذه الاعتبارات في تفسير السبب الذي يجعل الحركات الفاشية تبدي مثل هذه المرونة في الأيديولوجيا، أو ما أسماه أدورنو: “التطبيق غير المفهوم”. نشأت الفاشية في ظل مجتمع ملتزم أُضعفت قدرته على المقاومة، ولم تكن الفاشية شكلاً سياسيًا مميزًا أكثر من كونها تطرفًا لما أصبح عليه المجتمع الحديث فعليا: بارد وقمعي وعديم الفكر. لذلك، لم تكن الفاشية -بالنسبة لأدورنو- نتوءًا شاذا يمكن إزالته ببساطة من كائن حيٍ معافًى.
بطبيعة الحال، لم يكن أدورنو غير مبالٍ بحقيقة أن بعض الأفراد قد ينجذبون إلى التطرف اليميني لأسباب نفسية. واعترف بأن كل مجتمع لديه بقايا “فاسدة”. لكن الحركة الجماهيرية لا تتكون منهم وحدهم فقط: إنها تتكون من رجالٍ ونساءٍ عاديين ليسوا أكثر عقلانية من العالم الذي يعيشون فيه. وإذا كانت سياساتهم غير عقلانية، فهذا يرجع فقط لكونهم يوضحون انتظام اللاعقلانية عند كل المجتمع.
سيصر أنصار الليبرالية الوسطية على محو الفاشية؛ حتى تستمر الديمقراطية كما كانت من قبل. لكن بالنسبة لأدورنو، الديمقراطية ليست حقيقةً كاملةً دمرتها الفاشية. إنها مثال لم يتحقق بعد، وإنها طالما تخون وعودها= فإنها ستستمر في توليد حركات الاستياء والتمرد بجنون العظمة. أصر بعض منتقدي أدورنو -وحتى بعض المعجبين به- على اعتباره متشائمًا راديكاليًا استخف بالمُثُل العليا لعصر التنوير، وشعر أن التقدم نفسه كان خرافة. لكنه كان أكثر جدلية في تفكيره: لقد أراد التغلب على الأيديولوجيا الخاطئة للتقدم حتى تظهر حقيقتها. بغض النظر عن المدى الذي قد يكون قد قطعه عن المعتقدات التفسيرية للماركسية الجديدة، فقد أدرك أن الديمقراطية ظلت شكليةً فقط في تعبيرها الحديث وليست ملموسة. وأصر على أن الأنظمة التي تتباهى الآن بنفسها على أنها ديمقراطية لن تكون كافية أبدًا لاستيفاء مثلها المعلنة، طالما أنها تقوم على اللاعقلانية والإقصاء. تُعد بضعة سطور لأدورنو بمثابة تلخيص أفضل لمفهومه عن الحركات الفاشية من ادعائه عام 1967 بأنها “جروح وندوب ديمقراطية لم ترق إلى مستوى مفهومها الخاص حتى يومنا هذا”.
لا يسع قراء أدورنو اليوم إلا أن يدركوا في تحذيراته انعكاسًا للوضع العالمي الحالي، ففي ألمانيا، تجددت عودة النازيين الجدد مرة أخرى، مع حركة “البديل من أجل ألمانيا”، وهي حركة يمينية متطرفة ومناهضة للهجرة حصلت في عام 2017 على 94 مقعدًا في البرلمان الألماني “البوندستاغ”، لتصبح ثالث أكبر حزب في الحركة (حركة النازيين الجدد). في جميع أنحاء أوروبا وحول بقية العالم، أصبح هذا الاتجاه في السياسة الفاشية الجديدة أو الاستبدادية في صعود (في تركيا وإسرائيل والهند والبرازيل وروسيا والمجر وبولندا والولايات المتحدة). إن الفكرة الباهظة القائلة بأن الماضي قد مضى تمامًا، وأن تغييره يمنعنا من رسم أي مقارنات عبر الاختلافات في الزمان والمكان= ستبقينا في قبضة الماضي إذا رأينا فقط التاريخ مقسمًا إلى رغم أن أدورنو حذر من “المقارنات التخطيطية”، إلا أنه كان يعلم أيضًا أن التعامل مع التاريخ كشيء مضى فكرة خاطئة. كما أظهر مؤرخو العنصرية الأمريكية منذ فترة طويلة، أن هناك استمرارية بين الماضي والحاضر أكثر مما يعترف به المدافعون، (ولا ينبغي أن ننسى أن النازيين استمدوا تعليماتهم من السياسات العنصرية في الولايات المتحدة). كما أن الفاشية تلقي بظلالها الطويلة ولا يمكن إلحاقها بالماضي، خاصة عندما تطل برأسها للظهور مرة أخرى.
بعد وفاة أدورنو في عام 1969، أعرب المؤرخون المحافظون في ألمانيا عن شكواهم من أن اليسار لن يتوقف عن تذكير المعاصرين بجرائم الدولة. وعلى حد تعبير المؤرخ إرنست نوتله، كانت النازية “الماضي الذي لن يزول”. الفيلسوف يورجن هابرماس (وكان تلميذاً لأدورنو) دخل في جدل مع المؤرخ إرنست نوتله، وأصر على أن الاستمرارية والمقارنة يجب أن تخدم كأدوات للنقد، وليس الدفاع.
من المؤكد أن لا شيء يحدث أبداً بنفس الدقة كما حدث سابقًا، وبطبيعة الحال التشابه لا يمنع الاختلاف، ولكن وجود أية تشابهات يجب أن تنبهنا إلى حقيقة أن تغير الأشياء الذي حدث أسفل المؤشرات السطحية للتحول التاريخي= لم يحدث تغيرا بقدر ما يجب أن يكون. إن ظلال الماضي تتمدد إلى الحاضر، وتحوم -كالتماثيل في الحدائق العامة- بشكل معتم فوق الوعي الجمعي العام. في نهاية المطاف، لقد تعلّمَ المواطنون في ألمانيا (أو معظمهم على أية حال)= أن نصب الفاشية يمكن أن تخدم غايات نقدية وليس تبريرية، إنها تذكر بعدم السماح لعودة الفاشية أبداً. وفي الوقت الذي يشق فيه حزب “البديل من أجل ألمانيا” طريقه لاحتلال مركز السياسة البرلمانية، يكتسب هذا الدرس مرة أخرى ضرورة ملحة. وفي الولايات المتحدة، لا يختلف الحال؛ حيث يبدو أن كثيراً من تماثيل الماضي تؤكد -بدل أن تنتقد- عنصرية زماننا. في الحقيقة إن الماضي لا يزول أبدا.
اقرأ ايضًا: الحياة العصرية سبب الصراع السياسي