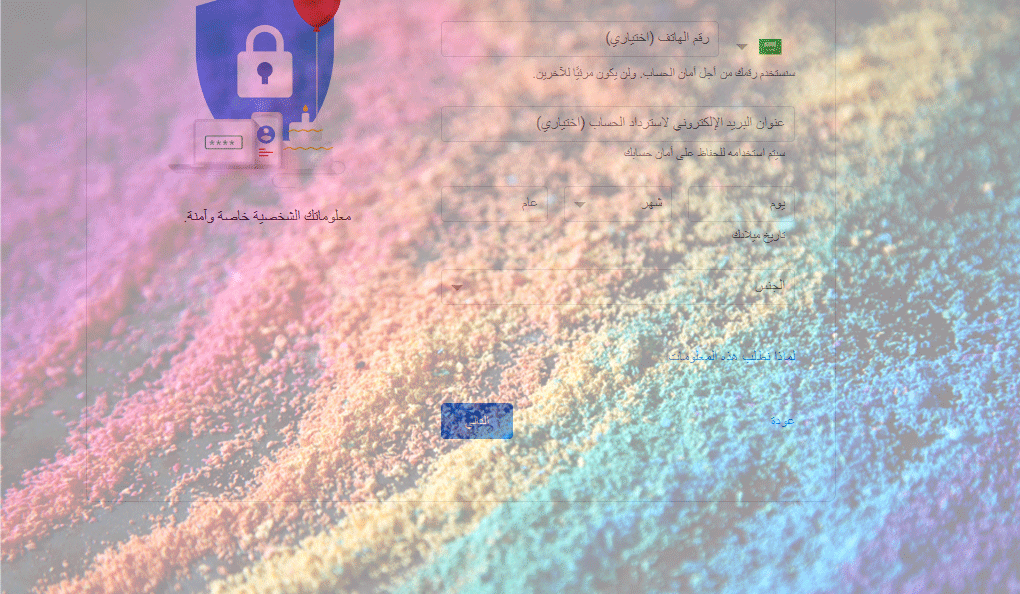- برانكو ميلانكوفتش*
- ترجمة: محمد صديق أمون
- تحرير: فضيلة المازن
تَحكمُ الرأسمالية العالمَ، فعدا بعض الإستثناءات الجانبيّة للغاية، يُدير العالمُ بأجمعه اليومَ الإنتاجَ الاقتصادي بالطريقة عينها؛ فالعمل طوعي ورأس المال معظمه بيد الخاصة أمّا عمليات الإنتاج فتنظّم بطريقة غير مركزية ويحركُها الربح..
لا يوجد مثيلٌ تاريخي سابق لهذا التغلُّب. ففي الماضي كان على الرأسمالية سواء كان في بلاد الرّافدين في القرن السادس قبل الميلاد أو في الإمبراطورية الرومانية أو في دول المدينة الإيطاليّة في العصور الوسطى أو في البلاد المنخفضة في بواكير الأزمنة الحديثة، أن توجد بالتزامن مع أساليب أخرى لإدارة الإنتاج. حيث كانت تلك البدائل تشملُ الصَّيد وجمع الثّمار والزراعة على المستوى الضيّق من قبل الفلاحين الأحرار وأقنان الأرض والعبيد. وحتى إلى ما قبل 100 عام فقط حينما ظهرت أول صورة من الرأسمالية المعولمة مع تقدّم الإنتاج الصناعي الواسع النطاق والتجارة العالمية، كانت العديد من أنماط الإنتاج الأخرى هذه لا تزال موجودةً. ثم بعد الثورة الرّوسية في عام 1917، اقتسمت الرأسمالية العالمَ مع الإشتراكية والتي كانت تحكمُ بلدانًا ضمّت في مجموعها ثُلث بني البشر تقريبًا، أمّا الآن فالرأسمالية هي نمط الإنتاج الوحيد المتبقي .
إنّه لأمر شائعٌ آخذ في الإزدياد، ما يطرق أسماعَنا من كلام المعلّقين في الغرب الذين يصفون النّظامَ الحالي بـ” الرأسمالية المتأخرة”كما لو كان النظام الإقتصادي على وشك الإختفاء. بينما يقترح آخرون أنّ الرأسمالية إنما تواجه تهديدًا متجددًا من قِبَل الشيوعية. لكن الحقيقةَ التي لا مفر منها هي أنّ الرأسمالية هنا لتبقى وأنّه ليس لها من منافسٍ. إنّ المجتمعات حول العالم قد تبنّت العقلية التنافسية والحيازيّة المتأصّلة في الرأسمالية والتي من دونها سينخفض الدخل ويزداد الفقر ويتباطأ التقدّم التكنولوجيّ. لكن بعيدًا عن هذا فإن المعركة الحقيقية إنّما هي في داخل الرأسمالية بين نموذجين متزاحمين يدافع أحدهما الآخَر..
كثيرًا ما يقع في التاريخ الإنسانيّ أن سرعان ما يتلو إنتصار نظام أو دين إنقسامٌ بين أشكال مختلفة من المُعتَقد نفسه. فبعد أن انتشرت النّصرانية في أحواض البحر المتوسط والشرق الأوسط مزّقتها أنياب الخلافات الإيديولوجيّة الضارية والتي أنتجت في نهاية المطافِ أكبر شِق في الدين بين الكنيستين الشرقيّة و الغربيّة. وكذلك كان الحال مع الإسلام، فبعد التوسع المذهل الذي شهده سرعان ما أفترق إلى شُعبتي السنّة والشيعة.
والإشتراكيّة خصيم الرأسمالية في القرن العشرين لم تبقَ طويلاً كتلةً موّحدة حيث إنشقت إلى صيغتين سوفيتية وماوتسيّة. ومن هذه الجهة لا تشكّل الرأسمالية إستثناء حيث يوجد اليوم نموذجان مسيطران ومتباينان في نواحيهما السياسيّة والإقتصادية والإجتماعيّة..
في دول أوروبا الغربيّة وأميركا الشمالية وبعض البلدان الأخرى مثل الهند وإندونيسيا واليابان يسيطر الشكل الليبراليّ الميتروقراطيّ من الرأسماليّة وهو نظام يركّز الغالبية العظمى من الإنتاج في يد القطاع الخاص، مُظهرًا تخويلَه صعود المواهب محاولًا أن يضمنَ الفرصَ للجميع عبر إجراءات من قبيل التعليم المدرسي المجاني وضرائب التَركاتِ. وإلى جانب هذا النظام يقوم النموذج السياسي من الليبراليّة المنقاد بيد الدّولة والذي تمثّله الصّين ولكنه يظهر أيضًا في مناطق أخرى من آسيا (ميانمار، سنغافورة، وفيتنام)، ومن أوروبا (أذربيجان، وروسيا)، ومن إفريقيا (الجزائر، وأثيوبيا، وراوندا). يمتاز هذا النّظامُ بالنموّ الاقتصاديّ المرتفع، إلّا أنّه يحدُّ من حقوق الأفراد السياسيّة والمدنيّة.
ينخرطُ نوعا الرأسمالية هذان بالولايات المتحدة والصّين على الترتيب بصفتهما الأمثلة الرّائدة في حومة تنافس لا ينقطع لما بينهما من تشابك وتداخل شديدين. فآسيا وأوروبا الغربيّة وأميركا الشّمالية الذين يشكلون مجتمعين 70 بالمئة من سكان العالم، و80 بالمئة من إنتاجه الاقتصادي هم في تماس دائم عبر التجارة والاستثمار وحركة النّاس وانتقال التكنولوجيا وتبادل الأفكار. وقد ولّدت هذه الارتباطات والتصادمات منافسةً بين الغرب وأجزاء من آسيا والتي زادت من حدتها الإختلافات بين النموذج الرأسمالي لكل طرف منهما. إنّ هذه المنافسةَ، لا التباري بين الرأسماليّة وبين نظام اقتصادي ما بديل، هي التي ستشكّل هيئة مستقبل الإقتصاد العالمي
في عام 1978، كانت نسبة 100 بالمئة تقريبًا من النتاج الإقتصادي الصينيّ تأتي من القطاع العام؛ أمّا الآن فتلك النّسبة قد هوت إلى ما دون العشرين بالمئة. ففي الصين الحديثة كما في دول الغرب الأكثر عراقة في الرأسماليّة تثوي وسائل الإنتاج بمعظمها تقريبًا في يد القطاع الخاص، حيث أنّ الدولةَ لا تُنزل قراراتٍ بشأن الإنتاج والأسعار على الشركات، والعاملين أغلبهم أجراء. والصّين في هذا تسجّل العلامة الرأسماليّة الكاملةَ.
لا منافسَ للرأسمالية اليومَ، لكنّ هذين النموذجين يَعرِضان طُرُقًا لهيكلة القوّة السياسيّة والإقتصاديّة في المجتمع مختلفةً إلى حد كبير. فالرأسمالية السياسيّة تعطي إستقلالية أوسعَ للنُّخب السياسيّة بينما تغري عامّة النّاس بمعدّلات نمو مرتفعة. إنّ النجاح الاقتصادي الصيني يقوّض زعمَ الغرب بأنّ ثمّة ارتباط ضروري بين الرأسماليّة والديمقراطيّة الليبراليّة.
ليس للرأسمالية من منافس، لكنّ نوعيها يقدّمان طرقًا لهيكلة القوّة السياسيّة والاقتصاديّة مختلفةً إلى حد كبير.
للرأسماليّة الليبراليّة الكثير من الحسنات المعروفة جيدًا، وأهم ما فيها الديمقراطيّة وحكم القانون. فهاتان الخاصيتان هما فضيلتان في حد ذاتهما، وإليهما يمكن ردُّ فضل تعزيز التطور الإقتصادي الأسرع وذلك من خلال دعم الإبداع، والحركيّة الإجتماعيّة. بيد أن هذا النظام يواجه تحديات جسيمةً، فظهور طبقة عليا تمهّد لنفسها مصحوبةً بلامساواة متعاظمة. حيث تمثل هذه اليومَ التهديد الأخطر لإستمرارية الرأسماليّة الليبراليّة على المدى البعيد.
في نفس الحين، تحتاج حكومة الصين وحكومات الدول الرأسمالية السياسيّة الأخرى لتحقيق نمو اقتصادي مستمر، وذلك لشرعنة حكمهم، وهو لازمٌ يغدو تحقيقه أصعب وأصعب. وينبغي على الدول الرأسماليّة الليبراليّة أيضًا محاولة الحد من الفساد، وهو ضاربٌ بجذوره في داخل النّظام وملازمه أي اللامساواة المتوسعة. إنّ إختبار
نموذجها يثوي في قدرتها على تقييد طبقة رأسماليّة نامية، والتي تحتك عادةً بالسلطة المتغطرسة لبيروقراطيّة الدولة .
في الوقت الذي تعمل فيه باقي أرجاء العالم ( البلدان الأفريقيّة خاصةً) على تحويل إقتصاداتها، وتحقيق قفزات إقتصاديّة سريعًا، ستقع الإحتكاكات بين النموذجين تحت تركيز أشد حدة. إنّ الصراع بين الصّين والولايات المتحدة كثيرًا ما يقدّم ببساطة من حيثيّات جيوسياسيّة، إلّا أنّه في لبّ الصراع، يبدو الأمر كأنّه شحذ صفيحتين تكتونيتين، والإحتكاك الناتج هو ما سيحدد كيف ستتطور الرأسماليّة في هذا القرن.
الرأسماليّة الليبراليّة
السيطرةُ العالميّة للرأسماليّة، هي أحد تحوّلين تاريخيين يعيش في ظلهما العالم. أما التحول الآخر، فإعادة التوازن في القوة الإقتصاديّة بين الغرب والشرق. فللمرة الأولى منذ الثورة الصناعيّة، تقارب معدلات الدّخل في آسيا، معدلات الدّخل في أوروبا الغربيّة، وأميركا الشّماليّة. كان الغرب ينتج في عام 1970، 56 بالمئة من الناتج الإقتصادي العالميّ، أما آسيا، بما في ذلك اليابان، فكانت تنتج 19 بالمئة لا غير. واليوم، بعد ثلاثة أجيال فقط، صارت هذه النّسب إلى 37 بالمئة، و43 بالمئة، ويعود الفضل في ذلك في معظمه إلى النمو الاقتصادي المذهل في بلادٍ مثل الهند والصّين.
ولّدت الرأسمالية في الغربِ تقنيات المعلومات والإتصالاتِ، التي أتاحت موجة جديدةً من العولمة في أواخر القرن العشرين، وهي الفترة التي أخذت فيها آسيا تضييق الفجوة بينها وبين “الشمال العالميّ”.
أدّت العولمة، المركوزة في الأصل في الإقتصادات الغربيّة، إلى تجديد بنى متهالكة، ونمو هائل في العديد من البلدان الآسيويّة. انخفضت اللامساواة في المداخيل العالميّة بشكل لافت عمّا كانت عليه في سنة 199٠، حينما كان معامل جيني العالميّ ( هو مقياس لتوزّع الدخل،حيث يمثل الصفر المساواة التّامة، ويمثل الواحد اللامساوة الكاملة)، يعادل 0.70 أمّا اليوم فهو تقريبًا 0.60، وسيواصل الإنخفاض مع استمرار معدلات الدّخل في آسيا بالارتفاع.
مع أنّ اللامساوة بين البلدان قد انخفضت، إلّا أن اللامساوة داخل البلدان خصوصًا الغربية منها، قد ازدادت. فقد ارتفع معامل جيني في الولايات المتحدة من 0.35 في عام 1979، إلى حوالي 0.45 اليوم. إنّ هذه الزيادة في اللامساواة، عائدةٌ في جزء كبير منها إلى العولمة، وتأثيراتها على أكثر الاقتصادات تقدُمًا في الغرب، وذاك في: إضعاف النّقابات العمّالية، وإدبار المِهن التصنيعيّة، وركود الأجور.
برزت الرأسمالية الليبراليّة الميتروقراطيّة في الأربعين سنة الأخيرة. ولكي تُفهم على النحو الأمثل، يحسن أن تُقارَن بصيغتين أخريين: الرأسماليّة الكلاسيكيّة، والتي كانت سائدةً في القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، والرأسماليّة الديمقراطيّة الإجتماعيّة التي عرّفت دول الضمان الإجتماعيّ في أوروبا الغربيّة وأميركا الشّماليّة منذ الحرب العالمية الثانية حتى بواكير سنوات 1980.
على خلاف ماكان زمن الرأسماليّة الكلاسيكيّة في القرن التاسع عشر، حينما كانت الثروات تحصّل من طريق التملّك لا العمل، يميل الأفراد ذوو الغنى في النظام الحاضر ليكونوا أغنياء من جهة رأس المال ومن جهة العمل كذلك أي أنّهم يجنون الدخل من الإستثمارات ومن العمل. وهم يميلون أيضًا للزواج، وبناء عائلاتٍ مع من يماثلونهم في الخلفيّة التعليميّة والماليّة وهي ظاهرة يسميّها علماء الإجتماع “الزواج التجانسيّ”. وفي حين أنّ الذين كانوا في القمّة حسب توزيع الدخل في أيام الرأسمالية الكلاسيكيّة كانوا في الغالب ممّولين، نجد اليومَ أن كثيرًا ممن هم في القمة، هم مديرون بأجور مرتفعة ومصممو مواقع وأطباء ومصرفيون ومن مثلهم من أبناء المِهن النخبوية. فهؤلاء الأشخاص يعملون من أجل تحصيل رواتبهم الضخمة ولكنهم أيضًا إمّا من طريق الإرث وإما من مدّخراتهم الخاصّة يجنون قدرًا كبيرًا من دخلهم مما لديهم من أصول ماليّة.
في الرأسمالية الليبرالية الميتروقراطية المجتمعات أكثر مساواةً مما كانت عليه في فترة الرأسمالية الكلاسيكيّة فالنساء والأقليات العرقية مخولين أكثر للدخول في القوة العاملة وقطاعات الضمان الاجتماعي والتحويلات الإجتماعية (الممولة من مال الضرائب)، موظفة لتخفيف حدة كوارث التركزات الحادة للثروة والنّفوذ. وقد ورثت الرأسماليّة الليبراليّة الميتروقراطيّة هذه الإجراءات عن سلفها المباشر الرأسماليّة الديمقراطيّة الاجتماعيّة.
أقيم النموذج على العمل الصناعي، وتميّز بالحضور القوي للنقابات، والتي لعبت دورًا كبيرًا في تقليص اللامساواة. سادت الرأسمالية الديمقراطيّة الإجتماعيّة في عصر شهد إجراءات مثل (Gi Bill) و معاهدة ديترويت في عام 1950، (تعاهد كاسح عبر المفاوضات النقابيّة متعلّق بعمال المركبات) في الولايات المتحدة والفقاعات الاقتصاديّة في فرنسا وألمانيا حيث ارتفعت الدخول. وقد وزّع النموّ بالتساوي إلى حد بعيد : حيث استفادت الجماهير من الوصول الأفضل للرعاية الصحيّة والإسكان والتعليم غير المكلّف وأتيحَ لعدد أكبر من العائلات الصعودُ على السّلم الاقتصاديّ المتحرك.
لكن طبيعة العمل قد تغيرت إلى حد كبير، في ظل العولمة والرأسمالية الليبراليّة الميتروقراطيّة، خصوصًا مع إبعاد الطبقة العاملة الصناعيّة، وإضعاف النقابات العماليّة. فمنذ أواخر القرن العشرين ونسبة دخل رأس المال من مجموع الدخل العام أخذةٌ في الإرتفاع، أي ازدياد في نسبة العائد للأرباح المجنيّة من قبل الشركات الضخمة الغنيّة أصلاً. ما زال هذا المنحى قويًا في الولايات المتحدة، لكنه سُجل كذلك في العديد من البلدان الأخرى سواء النّامية أو المتقدمة. إنّ هذه النّسبة المتزايدة لدخل رأس المال من مجموع الدخل العام، تعني في الواقع أنّ رأس المال والرأسماليين يكتسبون أهميّة أكبر من العمل والعمّال وبالتالي فهم يحصّلون قوةً اقتصاديّة وسياسيّة أكبر. وتعني أيضًا إزديادَ اللامساواة لأن أولئك الذين يجنون قدرًا كبيرًا من دخلهم من طريق رأس المال يغدون أكثر ثراءً.
الضائقة في الغرب
في حين أنّ النظام الحالي قد أوجد نخبةً أكثر تنوعًا (من ناحية الجنس والعِرق) إلا أن تركيبة الرأسمالية الليبرالية تؤدي في عاقبة أمرها إلى تعميق اللامساواة، وفي ذات الوقت تغطية هذه اللامساواة بستار الإستحقاق. فمن المسموح أكثر من أسلافهم العصر المذّهب، يمكن للأثرياء اليوم الزعم بأن مكانتهم إنّما تتيسّرُ لهم بفضل عملهم مهونين من شأن الإمتيازات التي حصّلوها من النظام ومن الإتجاهات الإجتماعيّة التي تجعل الإنتقال الإقتصادي بين الطبقات أصعب وأصعب. حيث شهدت ال40 سنة الفائتة، صعودًا لطبقة عليا شبه دائمة والتي تأخذ في الإنعزال عن باقي المجتمع. ففي الولايات المتحدة تملك العشرة بالمئة الأولى من أصحاب الثروات أكثر من 90 بالمئة من مجمل الأصول الماليّة. إنّ الطبقة المتحكمةَ ذات مستوى تعليميّ مرتفع والكثير من أفرادها يعملون ودخلهم من هذا العمل مرتفعٌ وهم يميلون للإعتقاد بأنّهم يستحقون ما هم عليه من مكانة رفيعة.
تستثمر هذه النُّخب الشيء الكثير في ذريّاتهم، وفي تأسيس التحكم السياسي. فمن خلال الإستثمار في تعليم أطفالهم، يخوّل أولئك الذين هم في القمة الأجيالَ القادمة من سلالتهم، المحافظةَ على استمرارية الدّخل المرتفع للعمل والمنزلة النخبويّة، التي لطالما كانت مرتبطةً بالمعرفة والتعليم. وبالإستثمار في التأثير السياسيّ في الإنتخابات وخلايا الخبراء والجامعات وفيما شابه هذا فإنّهم يضمنون بأنهم هم من يحدد قواعد الميراث حتى يكون سهلاً انتقال رؤوس الأموال إلى الأجيال القادمة. يؤدي هذان العاملان المجتمعان (التعليم المحصّل، ورأس المال المنتقل) إلى إعادة إنتاج الطبقة المتحكمة.
إنّ تكوينَ طبقة عليا مستدامة أمرٌ مستحيل، مالم تمارس تلك الطبقة التحكم السياسيّ. ففي الماضي، وهذا أمر كان يحدث بتلقائية، كانت الطبقة السياسيّة يشكّلها في معظم الأحيان الأثرياءُ، ولذا كان ثمّة آراء متشابهة ومصالح مشتركة بين الساسة وباقي أهل الثّراء. لكنَّ الوضع لم يعد على هذا النّحو حيث أنّ اليومَ ينحدر الساسة من طبقات اجتماعيّة وخلفيّات متنوعة وكثيرٌ منهم يشترك سوسيولوجيًا في القليل إن لم نقل في لاشيء مع الأغنياء. فالرئيسين بيل كلينتون، وباراك أوباما في الولايات المتحدة، ورئيسا الوزراء مارغريرت ثاتشر، وجون ميجر في الممكلة المتحدة، كلهم أتوا من خلفيّات متواضعة، إلّا أنّهم دعموا بفعالية بالغة مصالح الواحد بالمئة.
في الديمقراطية الحديثة، يستخدم الأثرياءُ مساهماتهم السياسيّة وتمويلهم أو ملكيّتهم لخلايا الخبراء ولوسائل الإعلام، في سبيل توفير الأجندات الاقتصاديّة التي تنفعهم: ضرائب مخفّضة على مداخيل مرتفعة، خصومات ضريبيّة كبيرة، وأرباح أعلى من رأس المال من خلال خصومات ضريبيّة لقطاع الشركات، وقوانين أقل إلخ . تزيد هذه السياسات في المقابل من إحتماليّة بقاء الأثرياء في القمّة، وهي تشكّل الرابط الأقصى في سلسلة تمتد من النسبة الأعظم لرأس المال من مُجمل الدخل العام لدولة ما، إلى تشكيل الطبقة العليا التي تسعى لمصلحتها الذاتيّة. وحتى لو لم تحاول الطبقة العليا أن تقتحم ميدان السياسة، فإنّها ستظل تتمتع بمكانة قويّة جدًا، فحينما تُنفق على الإجراءات الإنتخابيّة، وحينما تبني مؤسسات المجتمع المدنيّ الخاصة بها، يغدو موقع الطبقة عليا أبعد الأشياء عن أن يكون منيعًا .
كلما غدت النُّخب في الأنظمة الرأسماليّة الليبراليّة الميتروقراطيّة أكثر تحصّنًا وتكتلاً، كلما زادت نقمة باقي المجتمع. إنّ الضّيق بالعولمة في الغرب مردّه في معظمه إلى الهوّة بين النخب قليلة العدد، وبين جموع الناس الذين لم يستفيدوا من العولمة إلا بالقليل، والذين يعدّون، صوابًا أم لا التجارة العالميّة، والهجرة سبب علّاتهم. يمثّل هذا الموقف بكل ما يحمله من ما كان يُطلق عليه في السبعينيّات ” تجزؤ” مجتمعات العالم الثالث كالذي عُدّ في البرازيل ونيجيريا وتركيّا. ففي حين أن برجوازييهم كانوا موصولين بالنظام الاقتصاديّ العالمي معظم المناطق تُركت ظهريًا. إّلا أنه يبدو أن الداء الذي كان يُفترض أنّه يصيب الدولَ النّامية فقط، قد أصاب الشمال العالميّ.
رأسمالية الصين السياسيّة
في آسيا، ليس للعولمة سمعة مثل تلك، حيثّ أنّه حسب (polls)، 91 بالمئة من أهل فيتنام، على سبيل المثال، يعتقدون أن العولمة أداةٌ لجلب الخير . ومن المفارقات الطريفة أن تكون الشيوعيّة في بلدان مثل الصين وفيتنام، هي التي أرست أساسات التحول الرأسمالي في نهاية المطاف. وصل الحزب الشيوعي الصيني في عام 1949 من خلال إقامة ثورة وطنية ( ضد الحكم الأجنبي)، وثورة اجتماعية (ضد الإقطاعيّة)، ما خولها إزاحةَ جميع الأيديولوجيّات والتقاليد التي كانت تُعدّ أسبابَ تباطؤ النمو الإقتصادي خالقةً تقسيمًا طبقيًا مصطنعًا ( على خلاف هذا، لم ينجح الكفاح الهندي للإستقلال الأقل راديكاليّة بكثير في شطب النظام الطبقي. كانت هاتان الثورتان المتزامنتان على المدى البعيد شروطًا ضروريةً لتشكيل طبقة رأسمالية بلدية ستدفع الإقتصاد إلى الأمام . لعبت الثورتان الشيوعيّتان في الصين وفيتنام من ناحية الوظيفة نفس دور صعود البرجوازية أوروبا القرن التاسع عشر.
في الصين، جرى سريعًا التحول من شبه الإقطاعية إلى الرأسماليّة، وذلك تحت حكم دولة شديدة القوة. أمّا في أوروبا حيث أبليت الهياكل الإقطاعية شيئًا فشيئًا على مر القرون لعبت الدّولةُ دورًا أقل أهميّة بكثير، في عملية التحول إلى الرأسمالية. حسب هذا التاريخ إذن لا عجب أن كان للرأسماليّة في الصين وفيتنام وفي باقي أماكن المنطقة إطارًا تسلطيًا في غالب الأحيان.
إنّ لنظام الرأسمالية السياسية ثلاث خصائص معرّفة. أمّا أولها فأنّ الدولة تُدار من قبل بيروقراطيّة تكنوقراطية التي تستمد شرعيتها من النمو الإفتصادي وثانيها أنّه وإن كان في الدولة قوانين إّلا أنّها تطبق عشوائيًا وفي مجملها خدمة النخب الذين ينصرفون عن تطبيق القانون حين لا يكون ذلك مناسبًا أو يُعملونه بكامل شدّته في سبيل معاقبة خصومهم. هذه العشوائية في تطبيق القانون في هذه المجتمعات يوصل إلى الخاصيّة الثالثة للرأسماليّة السياسيّة، وهي ضرورة أن تكون لدولة مستقلةً. فمن أجل أن تتصرف الدولة بحسم تحتاج أن تكونَ حرةً من أي قيود قانونية. حيث أنّ التجاذبات بين الخاصيّة الأولى والثانيّة بين البيروقراطيّة التكنوقراطيّة، وبين التطبيق الفضفاض للقانون تنتج الفسادَ وهو جزء تكاملي في تركيبة النظام الرأسمالي السياسي وليس مجرد انحراف.
منذ نهاية الحرب الباردة، ساعدت هذه الخصائص على تغذية النمو في البلدان الشيوعيّة ظاهريًا في آسيا. حيث أنّه على امتداد ما يزيد عن 27 سنة حتى سنة 2017 سجّل متوسط معدل النموّ في الصين حوالي الثمانية بالمئة وفي فيتنام حوال الستة بالمئة، مقارنة بإثنين بالمئة فقط في الولايات المتحدة.
إن الوجه الآخر لهذا النمو الفلكي للصين هو الزيادة الهائلة للامساواة. فمنذ عام 1985 إلى 2012 قفز معامل جيني فيها من 0.30 إلى حوالي 0.50، وهو أعلى من معامل الولايات المتحدة، وقريب من المستويات المرصودة في أميركا اللاتينيّة. حيث ارتفعت اللامساواة بشكل صادم، في المناطق الريفيّة والمدنيّة جميعها وقد إزدادت أكثر من هذا في البلاد بعمومها، بسبب اتساع الهوّة بين هذه المناطق. وهذه اللامساوة الآخذة في الارتفاع مثبتة في التقسيمات كلها، سواءٌ بين المقاطعات الغنيّة والفقيرة أو بين العمال المتمرسين والعمال قليلي الخبرة أو بين الرجال والنّساء أو بين القطاع الخاص وقطاع الدّولة.
من المثير أنّه سُجّلت أيضًا في الصين زيادةٌ في نسبة الدخل من رؤوس الأموال الخاصّة التي يبدو أنّها متركّزة هنالك كما هي في الأسواق الإقتصادية المتقدمة في الغرب. لقد تشكّلت نخبة رأسمالية في الصين. ففي عام 1988، كان العمال في مجال الصناعة الخبير منهم وغير الخبير والموظفون المكتبيّون وموظفو الحكومة يشكلون 80 بالمئة من الذين هم ضمن الخمسة بالمئة الأعلى من مجموع المتكسبين. لكن في سنة 2013 هوت قسمتهم إلى النّصف تقريبًا وغدا أرباب الأعمال(20 %) والمهنيّون (33 %) هم المسيطرون.
إنّ من السمات اللافتة للطبقة الرأسمالية الجديدة في الصين هي أنّها قد خرجت من التراب كما يقال، فأربعة أخماس أعضائها تقريبًا ذُكر بأنّ آباءهم كانوا إمّا مزارعينَ أو عمالًا يدويين. هذه الحركية عبر الأجيال ليست مفاجئةً بالنظر إلى المسح الكامل تقريبًا للطبقة الرأسماليّة عقب إنتصار الشوعيين في سنة 1949، ثم مرة ثانية خلال الثورة الثقافيّة في الستينيات. لكن هذه الحركيّة قد لا تستمر في المستقبل، حينما يتوقع أن يبدأ مع هذا التركّز لملكية رؤوس المال وتكاليف التعليم الآخذة في الإرتفاع وأهميّة الإرتباطات العائليّة وإنتقال الثروات والسلطة عبر الأجيال في مماثلة ما هو ملاحظ في الغرب.
إلّا أنّه مقارنةً بنظيراتها في الغرب يمكن أن تُعدَّ هذه الطبقة الرأسمالية الجديدة في الصين أنّها طبقة بمفردها أكثر من كونها طبقة لنفسها. فالأنماط البيزنطية المتعددة للملكية في الصين التي تجعل على الصعيد المحلي والوطنيّ الخطوط الفاصلة بين العام والخاص ضبابية تسمح للنخبة السياسيّة أن تحدّ من قدرة الطبقة الرأسمالية الإقتصادية الجديدة.
على مدى عصور طويلة كانت الصين موطنًا لدول قويّة وإلى حد ما مركزية والتي لطالما منعت طبقة التجار من أن يصبحوا مركزَ سلطة مستقل. فحسب العلّامة الفرنسي جاك غيرنيه، فإنّ التجار لم يفلحوا أبدًا تحت حكم سلالة سونغ في القرن الثالث عشر في إنشاء طبقة تعي ذاتها ولها مصالح مشتركة ذاك لأن الدولة كانت لهم بالمرصاد دومًا مفتشة عن مدى قوّتهم. فمع أنّ التجار كانوا يثرون بصفتهم الفرديّة (كحال غالب الرأسماليين الجدد اليوم في الصين)، إلّا أنّهم لم يشكلوا أبدًا طبقة متماسكةً لها أجندتها السياسيّة والإقنصاديّة أو مصالحها التي تروّج لها وتذود عنها بقوة.
كان هذا السيناريو وفقًا لغيرنيه مختلفًا جدًا عن الوضع في نفس تلك الفترة في الجمهوريات التجارية الإيطالية والبلدان المنخفضة. إنّ هذا النّمطَ من مراكمة الرأسماليين للثروة من دون أن يحرصوا على تحصيل أي سلطة سياسيّة يتوقع أن يستمرَ في الصين وفي بلاد رأسماليةّ سياسيّة أخرى كذلك.
صِدام الأنظمة
مع توسيع الصين لدورها في المشهد العالمي فإنّ نموذجها من الرأسمالية داخل لا محالة في صراع مع النموذج الليبرالي الميتروقراطيّ في الغرب. ومن الممكن أن تحل الرأسمالية السياسية مكان النموذج الغربي في بلدان عديدة حول العالم.
تكمن ميزة الرأسمالية الليبراليّة في نظامها السياسي الديمقراطيّ. الديمقراطية مطلوبة لذاتها بالطبع لكن لها أيضًا ميزة وسائليّة. فمن خلال الإستشارة الدائمة للنّاس توفر الديمقراطيّة تصحيحًا قويًا للإتجاهات الإقتصادية والإجتماعية التي قد تكون ضارة للصالح العام. وحتى لو نتج عن قرار النّاس سياسات تؤدي إلى انخفاض معدل النمو الإقتصادي، زيادة التلوث أو متوسط عمر أقل فإنّ عملية صنع القرار الديمقراطية خلال فترة زمنيّة محدودة نسبيًا يفترض أن تصحح مسار هذه التطوّرات.
أمّا الرأسمالية السياسية فتقدم فيما يخص هذا الجانبَ إدارةَ أكثر فعالية للإقتصاد ومعدلاتِ نموٍ أعلى. إنّ واقع كون الصين حتى الآن البلد الأنجح اقتصاديًا في آخر نصف قرن يضعها في منزلة يحق لها فيه أن تحاول تصدير مؤسساتها الإقتصادية والسياسية. وهي تفعل ذلك بأوضح ما يمكن من خلال مبادرة الحزام والطريق المشروع الطموح الهادف لربط عدّة قارات ببنية تحتيّة محسّنة صينية التمويل. تشكل هذه المبادرة تحديًا أيديولوجيًا للطريقة التي كان يدير بها الغرب الشؤون الإقتصاديّة. فبينما يركّز الغرب على بناء المؤسسات تحرص الصين على ضخ الأموال لبناء أشياء ماديّة. ستربط المبادرة البلدان المتشاركة في فضاء نفوذ صيني، وحتى أنّ لدى بيجين مخططات للتعامل مع نزاعات المستثمرين المستقبليّة بالنظام القضائي الخاص بالمحاكم صينيّة الإنشاء وهو تحوّل كبير لبلد كان “قرن الذل” فيها في القرن التاسع عشر مصبوغًا برفض الأميركيين والأوربيين التحاكم إلى القوانين الصينيّة.
بلدان عديدة قد ترحب بأن تكون جزءًا من المبادرة. فالإستثمارات الصينيّة ستجلب الطرقَ والموانئ وسكك الحديد وأنواع البنى التحتيّة الأخرى المطلوبة حتى أبعد حد، ومن دون الشروط التي غالبًا ما ترافق الإستتثمارات الغربيّة. ليس للصين أي اهتمام بالسياسات المحليّة للأمم المستقبِلة، إنّما هي تؤكد على المساواة في معاملة جميع الدول. وهو إتجاه يجده جذابًا كثيرٌ من المسؤولين في البلدان الأصغر. تسعى الصين كذلك لتشييد مؤسسات عالمية كالبنك الإستثماري الآسيوي للبنية التحتيّة، سائرةً على نفس خط الولايات المتحدة بعد الحرب العالميّة الثانية حين تزعّمت واشنطن إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدوليّ.
لدى الصين أسباب أخرى تجعلها نشيطةً على الساحة الدّوليّة. فإن أبت الصين الترويجَ لمؤسساتها الخاصة، وإن استمر الغرب في نشر قيم الرأسماليّة اليبراليّة داخل الصين فقطاعات كبيرة من الصينيين يمكن أن يصبحوا مجذوبين أكثرَ للمؤسسات الغربيّة. لم تنجح الإضطرابات الحاليّة في هونغ كونغ في الإنتشار في أماكن أخرى من الصين لكنها توضح الإستياء الحقيقي من الإهمال الإعتباطي للقانون وهو إستياء قد لا يكون محصورًا بالمستعمرة البريطاني السابقة وحدها. كما أن الرقابة السافرة على الإنترنت غير محببة بالمرة عند الشباب والمتعلمين.
من خلال تسليط مزايا الرأسماليّة السياسيّة في الخارج ستقلل الصين من إستمالة النموذج الغربي الليبرالي لمواطنيها. فنشاطاتها العالميّة هي في الأساس مرتبطةٌ بالنجاة محليًا . مع أي اتفاقات رسميّة كانت أو غير رسمية تصل إليها بيجين مع الدول التي تعتنق الرأسمالية السياسيّة، فإنّ على الصّين أن تمارسَ تأثيرًا متصاعدًا على الهيئات العالميّة، والتي على مدى القرنين الأخيرين، أنشئت بيد الدول الغربية حصرًا، ولخدمة المصالح الغربيّة.
مستقبل الرأسماليّة
جادلَ جون رولز، فيلسوف الليبرالية الحديثة البارع، أن المجتمع الخيّر يفضّل أن يعطي الأولوية القصوى للحريات الأساسيّة على حساب الثروة والدخل. لكن التجربة تُظهر أن الكثير من الناس مستعدون لمقايضة الحقوق الديمقراطية بدخل أعلى. فما علينا إلا أن نراقب ذلك داخل الشّركات، فالإنتاج منظّم بشكل عام بأكثر الأنماط تراتبيّة لا أكثرها ديمقراطيّة. فالعمال ليس لهم أن يصوّتوا على المنتج الذي يرغبون بإنتاجه أو على طريقة الإنتاج التي يفضّلونها. إن التراتبيّة تنتج كفاءة وأجورًا أعلى. قبل أكثر من نصف قرن كتب الفيلسوف الفرنسيّ جاك إيلول: أن “التقنية حد الديمقراطيّة” فالذي تكسبه التقنية تخسره الديمقراطيّة. فإن وجد مهندسون ذوو شعبيّة بين العمال فيسكونون جاهلين بالماكينات. نفس التشبيه يمكن أن يوسع ليشمل المجتمع بكامله، إنّ الحقوق الديمقراطيّة يستغنى عنها طواعيةً في سبيل دخلٍ أعلى.
في هذا العالم المتجَّر المحموم الذي نعيش فيه اليوم من النادر أن يحظى المواطنون بالوقت، أو المعرفة، أو الرّغبة، في أن يتدخلوا في الشؤون العامة، إلّا أن تكون المسألة تمسهم مباشرةً. فمن اللافت أنّه في الولايات المتحدة، إحدى أقدم الديمقراطيّات في العالم، لا يرى انتخاب الرئيس، الذي له من جوانب متعددة في النظام الأميركيّ، صلاحيات ملك منتخب، على أنّه مهم لدرجة تدفع أكثر من نصف المقترعين، للذهاب إلى الصناديق. فمن هذه الناحية، تؤكّد الرأسماليّة السياسيّة تفوقها.
لكن المشكلة أنّها إن إرادت أن تثبت تفوقها، وأن تتفادى التحدي الليبراليّ، فإنّ على الرأسمالية السياسيّة أن تؤمّن باستمرار معدلات نمو عاليّة. فإذن في حين أن مزايا الرأسمالية الليبراليّة طبعيّة، أي أنّها موجودة في تركيبة النظام، فإن مزايا الرأسمالية السياسيّة وسائلية: تحتاج أن تُبرزَ باستمرار. يبدأ مشوار الرأسمالية السياسيّة إذن بعائق الحاجة لإثبات تفوقها عمليًا وهي زيادة على هذا تواجه مشكلتين مختلفتين. فبالمقارنة مع الرأسمالية الليبراليّة للرأسمالية السياسية ميل أقوى لإستحداث سياساتٍ سيئة، ونتائج اجتماعيّة متدنيّة، يصعب التراجع عنها، بما أنّه ليس لأولئك الذين في السلطة أي دافع لتغيير المسار. ويمكن لها أيضًا أن تثير بسهولةٍ سخطًا شعبيًا وذلك بسبب الفساد المنظّم في بنيتها في غياب حكم واضح للقانون.
تحتاج الرأسماليّة السياسيّة إلى الترويج لنفسها من خلال توفير تخطيطاً مجتمعيّاً أفضلَ، ومعدلات نمو أعلى، وإدارة أكثر نجاعةً ( بما في ذلك إدارة العدالة). وذاك على خلاف الرأسمالية الليبراليّة، التي يسعها أن تتعامل مع المشاكل الحادثة براحة أكبر. إنّ الرأسمالية السياسيّة ينبغي أن تبقى متأهبة على الدوام. إلا أنّ هذا يمكن أن يُعدَّ ميزة من وجهة نظر الداروينية الإجتماعية: حيث أنّه بسبب الضغط المتواصل لتحقيق المزيد لناخبيها، يمكن للرأسمالية السياسيّة أن تشحذ قدرتها على إدارة المجال الاقتصاديّ، مستمرةً في توفير سنة بعد أخرى منتجات وخدمات أكثر من منافستها الليبراليّة. فالذي يبدو لأول وهلة عيبًا ربما يتبيّن أنه ميزة.
لكن هل سيبقى الرأسماليون الجدد في الصين مُذعنين للحالة الراهنة التي تجعل حقوقهم الرّسمية عرضة للتقييد والنّقض في أي لحظة والتي تضعهم تحت الوصاية المستمرة للدولة؟ وهم في إزدياد في القوة والعدد هل سينظمون ويؤثّرون في الدّولة ومن ثم يفرضوا سيطرتهم عليها في آخر الأمر، كما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا؟
يبدو المسار الغربي كما يخطّه كارل ماركس ذو منطق مُحكمٍ، حيث تتوجه القوة الاقتصاديّة لإطلاق نفسها، والبحث عن، أو فرض مصالحها الخاصّة. بيد أنّ السجل المحفوظ عمّا يقارب 2000 عام من الشراكة غير المتساوية بين الدولة الصّينيّة، وأرباب الأعمال الصّينيين، يُسفر عن عقبة رئيسيّة في نهج الصّين لنفس المسار الغربيّ.
إنّ السؤال المركزي هو هل سيصير رأسماليو الصّين إلى السّيطرة على الدّولة؟، وهل سيتوسّلون في سبيل فعل ذلك بالديمقراطيّة التمثيليّة؟ لقد استعمل الرأسماليون في الولايات المتّحدة، وأوروبا، هذا العلاجَ بحذر شديد، مقسمينه على جرعات مثليّة، بينما كانت الحقوق الدستوريّة تنتشر رويداً رويداً، ومانعينه كلّما برز تهديد محتمل للطبقات المالكة (كما في بريطانيا العظمى بعد الثورة الفرنسيّة، حينما صار حق التصويت أكثر تقييداً مما كان عليه) . من المرجح أن الديمقراطيّة الصّينيّة، إن أتت، ستماثل الديمقراطيّة في باقي العالم اليومَ، من الناحية القانونيّة من إعطاء صوتٍ لكل شخص. إلّا أنّه باعتبار ثقل التاريخ، والطبيعة المتقلقة للطبقة الممتلكة، و حجمها الذي لا يزال محدوداً، فإنّه من غير المؤكد أنّ حكمَ الطبقة المتوسطة يمكن أن يستمرَ. فذلك لم ينجح سابقاً في الجزء الأول من القرن العشرين، تحت حكم جمهورية الصّين( التي بسطت سيادتها على معظم المناطق الرئيسيّة من 1912- 1949ومن الصعوبة بمكان أن يعاد إنشاؤها بنجاح أكبر بعد مئة سنة.
تقارب بلوتوقراطيّ
ما الذي يحمله المستقبلُ للمجتمعات الرأسماليّة الغربيّة؟ يرتبط الجواب بقدرة الرأسمالية الليبراليّة الميتروقراطيّة في المستقبل على التحرك نحو مرحلة أكثر تقدمًا ما يمكن تسميته “رأسمالية الناس”، حيث يوزّع الدخل من قطبي الإنتاج، رأس المال، والعمل، بطريقة أكثر مساواةً. وقد يتطلب هذا، توسيع الملكية الفعّالة لرأس المال، خارج حدود العشرة بالمئة العليا من السكان، كما هي الحال، وفتح المجال للوصول للمدارس الرفعية، والوظائف ذات الأجرة الممتازة، من غير إعتبار للخلفية العائلية للشخص.
في سبيل الوصول لمساواة أكبر، ينبغي على البلدان أن تطور حوافز ضريبيّة وذلك لتشجيع الطبقة المتوسطة على امتلاك أصولًا مالية أكثر، وأن تفرضَ ضرائب أعلى على الإرث وعلى شديدي الثراء، وأن تحسِّنَ التعليم العام المجاني، وأن تقيم حملات إنتخابية ممولةً من المال العام. والثمرة المجتمعة من كل هذا هي جعل رأس المال والمهارات في المجتمع منتشرةً متفرّقة. ستشابه رأسمالية الناس الرأسمالية الديمقراطيّة الشعبية من حيثُ اهتمامها باللامساواة، إلّا أنّها ستطمح إلى نوع آخر من المساواة: فبدلًا من التّركيز على إعادة توزيع الدخل، سيسعى هذا النموذج لتوفير مساواة أفضل في الأصول، سواءٌ الماليّة أو ما يتعلق بالمهارات. وعلى خلاف الرأسمالية الديمقراطيّة الشعبيّة سيتطلب اليسير فقط من سياسات إعادة التوزيع ( كالبطاقات التموينيّة، واستحقاقات السّكن) وعندها سيكون النموذج قد وفّر قاعدة أعظم من المساواة. أمّا إذا فشل النموذج في معالجة مشكلة اللامساواة المتعاظمة فإنّ الأنظمة الرأسماليّة الليبرالية الميتروقراطيّة تخاطر بأن تنحدر في درب آخر، ليس نحو الشيوعية بل نحو تقارب مع الرأسمالية السياسيّة. حيث أن النخبة الاقتصاديّة في الغرب ستغدو أكثر عزلةً، ممسكة بزمام سلطة غير مقيّدة مسلّطة على مجتمعات ديمقراطيّة في ظاهرها، بصورة مشابهة للطريقة التي تتسيد فيها النّخبة السياسيّة في الصين على البلاد. فكلما غدت القوة السياسيّة والاقتصاديّة أكثر التحامًا معًا كلما غدت الرأسمالية الليبرالية أكثر بلوتوقراطيّة متخذة بعض سمات الرأسماليّة السياسيّة. ففي النظام الأخير السياسة وسيلة الظفر بمكتسبات اقتصاديّة، أمّا في الرأسمالية البلوتوقراطيّة الليبراليّة الميتروقراطيّة سابقًا فستغزو القوة الاقتصاديّة السياسةَ. إلّا أن نقطة النهاية في كلا النظامين ستكون واحدة: عُصَبٌ متحالفة من القلة ذوي النفوذ، وإعادة إنتاج للنّخبة في المستقبل، إلى ما لا نهاية.
اقرأ ايضاً: عندما تتصادم الرأسماليات
- برانكو ميلانكوفتش، باحث في مركز CUNY، وأستاذ في كلية لندن للإقتصاد.