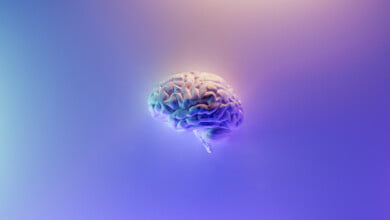“كل ما هو ثابت يذهب هباءً، وكل ما هو مقدس يُدنس، والبشر قد أُجبروا أخيرًا على مواجهة شروط وجودهم وعلاقاتهم بعيون يقظة، قد سقط عنها غشاء الوهم”
– ماركس –
“إن فترة الغياب التام للمعنى هي الفترة التي يتم فيها التحقق الكامل لماهية العصور الحديثة”
– هيدجر –
مقدمة
دائمًا ما كنت أتساءل عن الحكمة في قصر عمر الإنسان؛ وإذا بالعصر الحديث يكشف لي عن حكمة عميقة من قصر عمر الإنسان؛ إنها الصيرورة. لم يمر ربع هذا القرن، والجميع يشهد بأن الحياة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وتتغير وتتبدل بوتيرة أسرع من وتيرة تكيفنا -نحن البشر- مع التغيير؛ وهذا لا يقتصر على ظهور تقنيات جديدة، أو نظام جديد للأشياء فحسب، بل ينطبق أيضًا على كل ما يتعلق بالحياة؛ من أفكار وقيم، إلى تقنيات وأشياء.
تخيل أنك ستعيش مائة عام حتى يتغير ويتبدل كل ما تعرفه، ولا يصير له وجود إلا في رأسك؛ كل ما تعرفه بمعنى الكلمة، من أشخاص وأشياء وقيم وأفكار وعادات…الأمر أشبه بأن تستمر في القطار رغم فوات محطة نزولك؛ فتذهب -مجبرًا- لأماكن لم ترها وأشخاص لا تعرفهم.
أخشى أن من يُعمَّر مائة عام في هذا القرن، سيعيش اللحظة التي تصير فيها نبوءة هكسلي في روايته عالم جديد شجاع حقيقة: “قد كان هناك زمانٌ يولد فيه الأطفال من أبوين!”.
تقدم هذه الورقة تتبعًا تاريخيًا لتطبيع المثلية الجنسية،[1] متبوعًا بتحليل سوسيولوجي لهذا التاريخ. وليس غرضنا في هذه الورقة استعراض التاريخ الكامل لمجتمع الميم،[2] ولا كل الأحداث التاريخية التي وصلت به إلى إقحامه في الهيكل الاجتماعي، حتى صار مجرد الجهر برفض المثلية الجنسية يعرض صاحبه لحملة من التشهير والسباب، وهو ما دفع المفكرين لأن ينددوا بهذه المحاكم التفتيشية وشرطة الفكر التي تكبت الحريات وتوزعها كيف تشاء.[3]
تبدأ هذه الورقة بسرد تاريخ عام لهذه الحركة، في مختلف الدول الغربية، مع الوقوف عند أبرز محطات هذا التاريخ؛ والغرض الأساسي من هذا التاريخ العام هو الوقوف مع سؤال مهم: كيف حدث هذا التحول؟ وكيف انتقل مجتمع الميم من المطاردة والملاحقة القانونية والوصم الأخلاقي إلى أقصى درجات التأييد الاجتماعي والقانوني والسياسي والقِيَمي؟ ولماذا هذا السعي الحثيث لإقحام الميول الجنسية في الهيكل الاجتماعي؟
ما تحاول هذه الورقة بيانه هو أن تطبيع المثلية ليس هو المرض العضال، بل هو بالأحرى عرض من أعراض القيم والأفكار التي سادت في الزمن الحديث؛ والابن الشرعي للأسس الفلسفية للحداثة وما بعدها. وما لم يتبين المشتغلون بهذه الظاهرة الرابطَ بين الحداثة وانقلاب مؤسسة الزواج والأسرة، وما لم يؤخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والثقافي الكامن وراء تطبيع المثلية= فلن يكون من الممكن وقف قطار الانحطاط، لأن الأمر -كما يتنبأ كاتب هذه الورقة- لن يتوقف عند تطبيع الممارسة المثلية على سن قانوني محدد وبشرط التراضي بين الطرفين، بل سيتطور إلى تطبيع جنس الأطفال والبهائم، وسائر أطياف الشذوذ الجنسي، وهذا على كل حال ليس ببعيد.[4] وستأتي المرحلة التي لن يكون من المجدي فيها تكرار ونشر الأضرار الجسيمة المصاحبة لكل أطياف التوجهات الجنسية المنحرفة عن الميول الطبيعية -سواء كانت هذه الأضرار طبية أو اجتماعية- ما لم يُتنبه منذ البداية إلى أصل الداء وأساس التغيير الاجتماعي في المجتمع الحديث.
ثم بعد التحليل السوسيولوجي و بيان ربط تطبيع المثلية بقيم الحداثة وما بعد الحداثة، أقدم دراسة حالة -موقف المسيحية من المثلية في القديم والحديث- في محاولة لتلمُّس الأبعاد الواقعية للتنظير السوسيولوجي الذي سبق بيانه.
تنطلق هذه الورقة من نظرة محددة إلى المثلية لا تتعامل معها على أنها ظاهرة سيكولوجية -وإن كانت نظرة جديرة بالبحث- بل على أنها ظاهرة سوسيولوجية؛ وإن لم تتحقق فيها بالفعل سمات المؤسسة الاجتماعية، فهي قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح كذلك.
والفرق بين النظرتين: هو أن الأولى تتعامل مع المثلية في فرديتها؛ حيث يركز المعالج أو الطبيب النفسي على الفرد الذي لديه ميول مثلية؛ جهر بها أم لا. أما النظرة الثانية، فهي تأخذ في الاعتبار الحراك المجتمعي الأوسع، والذي ليس بالضرورة أن يكون كل أفراده مثليي الجنس أو ينتمون إلى مجتمع الميم، بل منهم من يؤيد ويطبّع المثلية وهو بالأساس ليس مثليًا ولا ينتمي لمجتمع الميم، وربما كان مسيحيًا متدينًا أو مسلمًا. وهذا هو ما تركز عليه هذه الورقة، وتحاول تحليله وبيان أبعاده المختلفة.
حركة المثليين في قشرة جوز
في يونيو عام 2015 جاء نص المحكمة الأمريكية العليا في تقنين الزواج المثلي كما يلي:
“لا يوجد اتحاد أعمق من الزواج، لأنه يجسد أسمى مُثُل الحب والإخلاص والتفاني والتضحية والعائلة. عند تكوين اتحاد زوجي، يصبح الشخصان أعظم مما كان عليه في السابق. وكما ظهر من بعض من قدموا التماسات للنظر في حالاتهم، فإن الزواج يجسد حبًا قد يستمر حتى الموت. إنه لمن سوء فهم هؤلاء الرجال والنساء أني يقال إنهم لا يحترمون فكرة الزواج؛ فإن شعارهم هو أنهم يحترمونها، ويحترمونها بعمق لدرجة أنهم يسعون إلى تحقيقها بأنفسهم. أملهم هو ألا يُحكم عليهم بالعيش في عزلة، مستبعدين من واحدة من أقدم مؤسسات الحضارة. إنهم يطالبون بالمساواة في الكرامة في نظر القانون. والدستور يمنحهم هذا الحق”.[5]
لكن هذا لم يكن سوى حلقة في سلسلة طويلة من التغيير الاجتماعي لإحدى أقوى المؤسسات الاجتماعية وأقدمها وأعمقها أثرًا لدى البشر: الزواج والأسرة.
لنعد إلى الوراء قليلًا…
حركة حقوق المثليين -وتسمى أيضًا حركة تحرير المثليين- هي حراك اجتماعي ينادي بمنح كافة الحقوق المدنية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (ما يطلق عليه إجمالًا مجتمع الميم LGBTQ). وتسعى هذه الحركة إلى إلغاء القوانين التي تمنع العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين؛ وتدعو إلى إنهاء التمييز العنصري ضد مجتمع الميم، في التوظيف والإسكان والمرافق العامة وغيرها من مجالات الحياة.
قبل القرن العشرين، كانت المسيحية تقف بالمرصاد ضد العلاقات الجنسية بين الأفراد من نفس الجنس (خاصة الرجال) ولطالما وصمت هذا السلوك. لكن من الناحية القانونية فإن معظم قوانين أوروبا لم تتعرض للمثلية الجنسية في بادئ الأمر. ولئن كان التجريم القانوني ضعيفًا، فالوصم الاجتماعي في البلدان المسيحية كان شديدًا ضد العديد من الممارسات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس، وفي الوقت الذي كانت فيه المسيحية ميهمنة على التشريع، كانت عقوبة المثلية: الإعدام.
ابتداءً من القرن السادس عشر، بدأ المشرعون في بريطانيا بتصنيف السلوك المثلي على أنه سلوك إجرامي وليس مجرد سلوك غير أخلاقي.[6] وفي ثلاثينيات القرن الخامس عشر -في عهد هنري الثامن- أصدرت إنجلترا قانون اللواط، الذي جعل العلاقات الجنسية بين الرجال جريمة عقوبتها الإعدام. ظل اللواط في بريطانيا جريمة يعاقب عليها بالإعدام شنقًا حتى عام 1861. وبعد عقدين، في عام 1885، أقر البرلمان تعديلاً برعاية هنري دو بري لابوشير، والذي أقر جريمة “الفحش الفادح” للعلاقات الجنسية بين الذكور، وذلك من أجل استدماج أي شكل من أشكال السلوك الجنسي بين الرجال داخل طائلة المقاضاة القانونية، وليس فقط العلاقة الجنسية الكاملة. وبالمثل، في ألمانيا في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر، تضمن قانون العقوبات الألماني الأخير الفقرة 175، التي تجرم العلاقات بين الذكور من نفس الجنس مع عقوبة السجن والحرمان من الحقوق المدنية.[7]
قبل نهاية القرن التاسع عشر، ليس بإمكاننا رصد أي حراك اجتماعي من أجل حقوق المثليين؛ لكن تجلى ذلك في إنتاج بعض مشاهر الشعراء والمفكرين. ففي قصيدته التي كتبها عام 1890 بعنوان “Two Loves”، أعلن اللورد ألفريد دوغلاس -عشيق أوسكار وايلد- “أنا المثلية الجنسية؛ أنا الحب الذي لا يجرؤ أحد على التحدث باسمه”.[8]
مُنح المثليون من الرجال والنساء صوتًا انتخابيًا في عام 1897، مع تأسيس اللجنة العلمية الإنسانية (Wissenschaftlich-humanitäres Komitee؛ WhK) في برلين. وقد كان نشاطهم الأول هو تقديم التماس للمطالبة بإلغاء الفقرة 175 من قانون العقوبات. كما نشرت اللجنة مؤلفات تروج للتحرر الجنسي، ورعت تجمعات المثليين، وقامت بحملات لدعم التغيير القانوني في جميع أنحاء ألمانيا، وكذلك في هولندا والنمسا، وبحلول عام 1922 كانت قد طورت حوالي 25 لجنة محلية للمثليين. كان مؤسس هذه الجمعية هو ماجنوس هيرسفيلد Magnus Hirschfeld، الذي افتتح في عام 1919 معهد العلوم الجنسية (Institut für Sexualwissenschaft)، والذي تبعته بعد عدة عقود مراكز أخرى (مثل معهد كينزي لأبحاث الجنس والجندر والتكاثر في الولايات المتحدة). ساعدت هذه المراكز في رعاية الرابطة العالمية لما أسموه: الإصلاح الجنسي، (على غرار الإصلاح البروتستانتي) والتي تأسست عام 1928 في مؤتمر عقد في كوبنهاغن. وعلى الرغم فشل الرابطة في إلغاء المادة 175، فقد عاش مجتمع الميم قدرًا من الحرية في ألمانيا، لا سيما خلال فترة فايمار، أي بين نهاية الحرب العالمية الأولى واستيلاء النازيين على السلطة. وفي العديد من المدن الألمانية الكبرى، أصبحت السلطات أكثر تسامحا مع النزوات الليلية للمثليين، وزاد عدد المنشورات المؤيدة لهم. ووفقًا لبعض المؤرخين، تجاوز عدد الحانات والمجلات الدورية للمثليين في برلين في عشرينيات القرن الماضي نظيرها في مدينة نيويورك بعد ستة عقود. [9] لكن استيلاء أدولف هتلر على السلطة قضى على هذه الانتعاشة المثلية؛ فقد أمر على الفور بإعادة تنشيط المادة 175؛ وفي 6 مايو 1933، داهم النازيون مقر هيرسفليد ونهبوا أرشيفه، وأحرقوا مواد المعهد.
إبان الحرب العالمية الثانية، لم يكن النشاط الاجتماعي والسياسي للمثليين مرئيًا بشكل عام. وكثيرًا ما تتبعتهم الشرطة أينما تجمعوا؛ لكن هذا تغير بعد الحرب العالمية الثانية؛ فقد جلبت الحرب العديد من الشباب إلى المدن وسلطت الضوء على مجتمع المثليين. لكن في الولايات المتحدة أثار الحضور الاجتماعي للمثليين بعض ردود الفعل العكسية، لا سيما من الحكومة والشرطة؛ فغالبًا ما فصل موظفوهم من الخدمة المدنية، وحاول الجيش كثيرا تطهير صفوفه من الجنود المثليين (وهي السياسة التي اتبعت خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يظهر المثليون في الجيش حتى ولاية بايدن حديثة العهد). لكن تحت هذه القشرة من الملاحقة القانونية كان هناك حراك سياسي واجتماعي أكبر، يهدف إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
ابتداءً من منتصف القرن العشرين، بدأت المنظمات الداعمة للمثلية في التزايد. فتأسس مركز Cultuur en Ontspannings (“مركز الثقافة والترفيه”)، أو COC، في عام 1946 في أمستردام. وفي الولايات المتحدة، أسس هاري هاي في لوس أنجلوس في 1950 أول منظمة للمثليين الذكور، هي جمعية ماتاشين (اشتُق اسمها من الاسم الذي أطلقه المجتمع الفرنسي في العصور الوسطى على اللاعبين المقنعين، وذلك لبيان القيود والأقنعة التي يفرضها المجتمع على المثليين مما يجبرهم على التخفي).[10] كما تأسست منظمة مثليات بيليتس (التي سميت على اسم قصائد الحب لبيير لويس، Chansons de Bilitis)، عام 1955 على يد فيليس ليون وديل مارتن في سان فرانسيسكو. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الولايات المتحدة نشر دورية وطنية للمثليين، والتي فازت في عام 1958 بحكم المحكمة العليا الأمريكية الذي مكنها من إرسال نسخها بالبريد عبر الخدمة البريدية.
وفي بريطانيا، أصدرت لجنة برئاسة السير جون ولفندن تقريرًا في عام 1957،[11] يوصى بحذف العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين من جرائم القانون الجنائي. وبعد عقد من الزمان، نفذ البرلمان توصية ولفندن وحذفت الممارسات المثلية من قانون الجرائم الجنسية، مما أدى فعليًا إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية للرجال الذين يبلغون من العمر 21 عامًا أو أكبر (خفض السن أولاً إلى 18 عامًا في 1994 ، ثم إلى 16 في 2001، والذي يساوي بين السن القانوني للممارسة الجنسية المثلية، مع نظيرها بين الشركاء من جنسين مختلفين).
ومنذ ذلك الوقت، بدأت حركة حقوق المثليين في كسب العديد من الحريات القانونية، لا سيما في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ولكن الحدث الأهم والمحدد لنشاط المثليين في الولايات المتحدة؛ جاء في الساعات الأولى من صباح يوم 28 يونيو/حزيران 1969، عندما داهمت الشرطة حانة ستونوول Stonewall Inn، وهي حانة خاصة بالمثليين في قرية غرينتش في مدينة نيويورك. فكانت النتيجة أن انضم ما يقرب من 400 شخص إلى أعمال شغب استمرت 45 دقيقة، واستؤنفت في الليالي التالية. ويحتفل مجمتع الميم كل عام بهذه الحادثة في شهر يونيو (الذي يطلقون عليه شهر الفخر)، ليس فقط في المدن الأمريكية، بل في العديد من البلدان الأخرى، وذلك بتنظيم مسيرات الفخر.
في السبعينيات والثمانينيات، انتشرت المنظمات السياسية للمثليين كالنار في الهشيم، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أجزاء أخرى من العالم؛ مع تفاوت ضخم في الحجم والقوة والتأثير. وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، حصل النشطاء المثليون على دعم الحزب الديمقراطي في عام 1980، وذلك عندما أدرج الحزب في برنامجه شرط “عدم التمييز” الذي يتضمن المساواة بين الميول الجنسية المختلفة. هذا الدعم -جنبًا إلى جنب مع حملات نشطاء المثليين الذين يحثون الرجال والنساء المثليين على “الخروج من القمقم”- شجع مجتمع الميم على دخول الساحة السياسية؛ فكان أول المسئولين الحكوميين المثليين في الولايات المتحدة هما: جيري ديجريك ونانسي ويشسلر، في ميشيغان. وفي عام 1977، انتخب الناشط الأمريكي هارفي ميلك في مجال حقوق المثليين، لعضوية مجلس المشرفين Board of Supervisors في سان فرانسيسكو، لكنه اغتيل في العام التالي. وفي عام 1983، أصبح جيري ستودز -وهو ممثل حالي عن ولاية ماساتشوستس- أول عضو في كونغرس الولايات المتحدة يعلن عن مثليته الجنسية. كما أصبح تامي بالدوين، من ولاية ويسكونسن، أول سياسي مثلي الجنس يتم انتخابه في كل من مجلس النواب الأمريكي (1998) ومجلس الشيوخ الأمريكي (2012). وفي عام 2009، انتخب أنيس باركر عمدة لمدينة هيوستن -رابع أكبر مدينة في أمريكا- مما يجعلها أكبر مدينة في الولايات المتحدة تنتخب سياسيًا مثليًا علنًا رئيسا للبلدية[12]، ثم أتى إقرار المحكمة العليا في 2015 ليمثل حلقة ضمن سلسلة طويلة من الحراك الاجتماعي والسياسي لمجتمع الميم.
المثلية والحداثة
ما الحداثة؟ ومتى بدأت؟
أسئلةٌ ليس لها إجابة محددة؛ ليس لأنها بلا معنى؛ بل لأن التغييرات الكبرى التي تطرأ على المجتمع البشري لا يمكن قياسها باليوم والشهر، أو حصرها في عللٍ أحادية، وهو الأمر الذي ثبت أنه غير مفيد على مدار تاريخ الفكر. لكن عامة الكتابات تؤرخ للحداثة منذ القرن الخامس عشر، قد تتقدم أو تتأخر قليلًا، فمنهم من يؤرخها تحديدًا بفتح القسطنطينية، ومنهم من يضعها عند غزو الأمريكيتين، ومنهم من يعممها على عصر النهضة؛ لكن على كلٍ ليست بداية الحداثة ومكانها هو ما يهم، بل الأفكار التي جاءت بها.
الأسس الفلسفية للحداثة
قد يظن البعض أننا عندما نتحدث عن أسس فلسفية أننا نبالغ عندما نريد تلمس مناطق تأثير الأفكار الفلسفية على الحياة الواقعية؛ لكن في حقيقة الأمر، كل تغيير جذري في الحياة البشرية كان مسبوقًا بثورة فكرية شاملة. على سبيل المثال -لا الحصر- لولا الجهود الفلسفية طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر لم تكن الثورة الفرنسية لتولد في نهاية القرن الثامن عشر، لأن هذا التراث الفلسفي مثل وقودًا حيويًا للتغيير الاجتماعي.
مرة أخرى: ثورات الشعوب الأوروبية عام 1848، لم تكن لتقوم إلا على تراث فكري ثري إن في الفلسفة أو الاجتماع أو السياسة.
لذلك، فالتاريخ يعلمنا أن للأفكار قوة وسلطة قادرة على إحداث تغييرات اجتماعية جذرية، ليس هذا فحسب، بل يمكننا أن نخاطر بالقول بأنه ما من تغيير اجتماعي إلا وهو مسبوق بتغيير على مستوى الفكر.
ولما كانت الظاهرة محل الدراسة -مجتمع الميم- هي تغيير اجتماعي بامتياز، يهدف إلى زعزعة نظام الأسرة وبنية الزواج، وإعادة تعريف الميول الجنسية الطبيعية من الشاذة، فبالطبع ثمة أفكار كبرى كامنة وراء هذا السلوك، ويمكننا تلمس هذه الأفكار في الأسس الفكرية التي قامت عليها الأزمنة الحديثة.
بطبيعة الحال، لا يمكننا -كما سبق وبينا- أن نضع حدًا زمنيًا فاصلًا بين العصر الحديث والعصور السابقة، كل ما يمكننا تلمسه هو تحولات اجتماعية في نظام العيش ونظام الإنتاج والتواصل وجمع الثروة، وحتى الممارسات الدينية، وطرق بناء الهوية. وسنركز هنا على أربع سمات أساسية للأزمنة الحديثة نراها في علاقة مباشرة بنشاط مجتمع الميم هي: الهوية السائلة، الصيرورة، نزع القداسة.
مبدئيًا لا تعمل هذه الأفكار الكبرى فرادى، بل هي في تفاعل مع بعضها البعض. ونظرًا لتعقيد كل الظواهر المتعلقة بالإنسان، فلا يمكن لتفسير أحادي أن يقدم شرحًا وافيًا لأي تغيير اجتماعي. ومن ناحية أخرى، قد يقال إن هذه السمات هي سمات مابعد حداثية؛ وهنا أقول إن “ما بعد الحداثة” ليست إلا حداثة منقلبة على قيمها، وهذا الانقلاب بحد ذاته تطبيق عملي لقيمة كبرى من قيم العصر الحديث: “ليس هناك ثوابت”، حتى وإن كانت ثوابت الحداثة نفسها. فعلى أي حال سواء كانت هذه القيم من حداثة التنوير، أو من حداثة مضادة، فالواقع يقول إن هذه السمات لاتزال تعمل عملها في توجيه التغيير الاجتماعي المعاصر.
الصيرورة
لا يمكننا أن نقول إنه قبل الأزمنة الحديثة لم يكن هناك تغيير اجتماعي، بل المجتمع البشري ديناميكي في أبسط تفاعلاته، ومن هنا فالسمة التي نتحدث عنها هنا ليست تغيرًا اجتماعيًا بسيطًا، بل إنها صيرورة فريدة غير مسبوقة، سواء في وتيرتها، أو في المساحات التي تغلغت فيها.
“كلمة التحولية أو الصيرورة [في سياق الحداثة] لا تشير فقط إلى أجوبة جديدة ومتغيرة على أسئلة أساسية دائمة ومتكررة، أو حتى إلى ثورات كبيرة في عالم الفكر؛ إنها تشير بدلا من ذلك إلى نموذج جديد في التفكير يتأمل في كل شيء، الإنسان، المجتمع، التاريخ، الطبيعة، الفرد والدولة، ليس فقط كظاهرة تتغير، بل كظاهرة تتطور باستمرار إلى شيء جديد ومختلف. إن إرنست رينان شبه طبيعة هذا التحول منذ قرن ونصف تقريبًا عندما كتب بأن الخطوة الجديدة الكبيرة في النقد الحديث كانت إحلال مقولة الصيرورة محل مقولة الجوهر أو الكينونة، وإحلال مفهوم النسبی محل مفهوم المطلق، والحركة مكان الثبات، وبعد ذلك بمدة قصيرة قال توماس هكسلي متكلما باسم جيل بكامله بأن الميزة الأكثر وضوحا في الكون في أنه غير دائم أو غير ثابت”.[13]
لقد أصبحت الطبيعة (بشرية كانت أو مادية) كونًا من التحولات، بدلا من كونها نظامًا للأشياء، واستطاعت الحداثة بما ملكته من آليات اجتماعية واقتصادية وثقافية أن تشكل نوعًا من العقل الهدام للثوابت، يرى في كل ما هو ثابت صنما يجب تحطيمه؛ حتى لو كان هذا الثابت هو منظومة الأسرة والزواج والأدوار الجنسية.
لقد هدمت الحداثة -أو كادت- مقولة المطلق، وبذلك ولّدت نزعة النسبية، التي تستهدف كل ما هو مطلق من مفردات الاجتماع الإنساني، وكانت النتيجة إمكانية هدم الحقائق والمؤسسات الجمعية التي يتشاركها البشر في أنحاء الأرض (بالقوة أو بالفعل)، حتى لو كانت هذه المؤسسات هي العائلة، أو الكنيسة.
كانت هذه المؤسسات تؤمن للأفراد مقولات ثابتة يستطيعون بها ومن حولها بناء هويتهم وتحقيق ذاتهم، كما كانت أهم مثبتات التكامل والتضامن بين الأشخاص. أما الحضارة الحديثة فهي وليدة تفكيك هذه المؤسسات الاجتماعية، حيث كانت تنبني -في الماضي- هوية الإنسان. بعد هدم هذا المؤسسات التي كانت بمثابة النقاط المعيارية التي يهتدي بها الأفراد في العالم، أضحى كل فرد مسؤولًا عن سفينة نجاته الخاصة، وبرزت الحاجة إلى اختراع “سفن نجاة” جديدة في بحر العالم اللجي؛ فبدلا من أن تتحدد هوية الفرد من خلال اسمه ونسبه والقرية التي ينتمي إليها والأرض التي يقيم فوقها، والدين الذي يعتنقه؛ صار الطعام، والثياب، والأثاث، والموسيقى، والرياضة، وحتى الكلمات التي يستعملها الفرد محددات لهويته؛ لقد أصبحت ممارسات الحياة اليومية، في أدق تفاصيلها، صالحة لأن تحدد هوية الفرد.
من هذا الشق في عالم الحداثة، دلف التوجه الجنسي كمحدد من محددات الهوية في عالم الصيرورة، ففي الوقت الذي كانت البشرية فيه تتشارك توجهات جنسية شبه متطابقة يميل فيها الذكر للأنثى، وحيث كانت المؤسسات الاجتماعية مثل الأسرة والكنيسة تحكم قبضتها على مساحة تشكيل الهوية= لم تكن ثمة حاجة لاعتبار التوجه الجنسي محددا من محددات الهوية، بل العكس، كان الوصم الاجتماعي هو مآل من يحاول خرق هذه المؤسسات.
في العالم الحديث حيث الصيرورة الدائمة، وحيث تفككت المؤسسات سالفة الذكر، صار من الممكن أن يبني الفرد هويته حول سلوكه الجنسي. لكن مقولة الصيرورة بحد ذاتها والنزوع الحديث لهدم المطلقات كان عاملًا أساسيًا في تأجيج الثورة على ممارسة عميقة كانت هي الأساس والأصل طيلة التاريخ البشري، فلولا إيمان الحداثة بأن “كل ما هو ثابت يتغير”، لم يكن من المتصور التسليم بخرق مؤسسة مثل الأسرة أو الزواج.
ومن هنا نقول إنه “لا يمكن فهم التحولات التي طرأت على وضع العائلة المعاصرة بمعزل عن التغيرات الجذرية التي أصابت المجتمعات الصناعية وربما مجتمعات أخرى، ولا بمنأى عن عملية العولمة التي بدأت آثارها تتمثل في جميع بقاع العالم. وقد أدت هذه التغيرات بمجملها إلى تغيير أنماط تشكيل العائلة أو تفككها، كما أدت إلى تبدل طبيعة التوقعات التي تسود العلاقات الشخصية الحميمة بين الأفراد داخل العائلة وخارجها”.[14]
بطبيعة الحال لم يكن الأمر ليتم بدون مواجهة أقرب ما تكون بين عالمين مختلفين، وقد اختصر دوبیلابر التعارض بين المجتمع الحديث -المعقد والنفعي- وبين المجتمع التقليدي قائلا:
“في هذه المواجهة ينتصر القانون العلماني/الدنيوي على القيم التقليدية، والأنماط النفعية تنتصر على المظاهر الأخلاقية. ولا يصمد الدين الأخلاقي في وجه الانتشار الأفكار النفعية؛ ويستعاض عن العلاقات الشخصية -إجماليا- بتوزيع أدوار اجتماعية جديدة ومجهولة. وتستبدل العلاقات التي تقوم وجها لوجه مع أشخاص معروفين بعلاقات تفاعلية بين أشخاص يؤدون هذه الأدوار ولا يعرف بعضهم بعضا. ثم العلاقات المبنية على المشاعر تغيب لصالح العلاقات التعاقدية، الشكلية، والنفعية. بينما الكنيسة، كتنظیم کامل ورسمي، تقوم مقامها جماعات من العلمانيين المتدينين”.[15]
“أن تكون حديثا، يعني أن تكون جزءًا من عالم (كل ثوابته تتبخر في الهواء) كما قال ماركس”[16]
نزع القداسة
هل هناك مقدسات في عالم اليوم؟
إن العالم الذي يشك في سلطة الإله وتدخله في العالم، لن يكون من السهل عليه قبول معيار أخلاقي مقدس لدى العالم أجمع. وليست المسألة أننا في عالم بدون مقدسات، بل بالأحرى نحن في عالم المقدسات المحلية؛ والمقدس المطلق الوحيد هو أنه لا مقدسات مطلقة.
ومن تمثلات هذا الشعار دعوات تقبل الاختلاف -أيا كان- فالدافع وراء هذه الشعارات -فيما نراه- ليس تقبل الآخر والانفتاح عليه، بل زعزعة أسس المعايير الأخلاقية العالمية. والجدير بالذكر أن شعار “تقبل الآخر” هو نفسه غير مقدس على نحو تام، فثمة “آخرون” غير مقبولين بحال من الأحوال.
إن من ينتقدون تطبيع المثلية انطلاقًا من مبادئ دينية أو كونية المعايير الأخلاقية أو الفطرة الإنسانية، يصطدمون مباشرة بأساس من أسس الحداثة تفرضه عليها طبيعتها؛
“لا تستطيع الحداثة -ولا تريد- أن تقترض من عصرٍ آخر المعايير التي تتوجه على أساسها؛ إنها مجبرة على أن ترتجل معياريتها من ذاتها. ولأنه ليس لها من ملاذ آخر، فلا يمكنها إلا الاعتماد على ذاتها. وهذا ما يفسر حساسيتها، وسرعة غضبها، حينما يتعلق الأمر بالفكرة التي تكونها عن نفسها، ويفسر ثانية محاولاتها الدؤوب من أجل “الاستقرار”؛ وأن تستقر فوق نفسها، وهي محاولات مستمرة حتى لحظتنا هاته”.[17]
فما قدسية الأديان والأخلاق إلا أشياء من “عصر آخر” بائد، تجاوزته الحداثة فقط لأنها تليه على سلم التطور التاريخي؛ ولذلك يُنظر إلى هؤلاء المعارضين على أنهم من عالم آخر -حرفيًا- لأن الحداثة تستلزم تحولا جذريًا عن القيم الآتية من العالم الآخر إلى القيم الدنيوية التي تقع “هنا والآن”؛ وهذه القيم محكومة بسيادة الإنسان والانسجام مع رغباته.
من ناحية أخرى؛ احتكرت الحداثة حق الحديث في المسائل الأخلاقية؛
ففيما قبل الحداثة؛ كان الفَصَل بين الشعوب والفئات وكذلك قواعد السلوك تستمد سلطتها من المصدر الإلهي، لا من الإنسان؛ وعلى هذا الأساس كان رفض المثلية راسخًا بشدة في المجتمعات المسيحية؛ لكن مع قدوم الحداثة: “أحدثت العصور الحديثة تخصيصا لدوائر القيم الخاصة بالعلم والأخلاق والفن، حيث تصبح النقاشات العلمية ودراسات الأخلاق والقانون والإنتاج الفني مسألة متخصصين”[18]؛ بمعنى أنه لم يعد متروكًا للعامة حق الحكم الأخلاقي على ممارسة من الممارسات، حتى لو كان في فجاجة المثلية؛ بل صادر من يسميهم المجتمع الحديث “المتخصصون” حق الكلام في هذه الأخلاق، كما في العلم.
وعلى هذا الأساس نرى كافة الدعوات التي تحاول إثبات أصالة المثلية بيولوجيًا، وتاريخيًا، لأن “المتخصصين” ستكون كلمتهم مصدقة لدى العامة، في العلم كما في الأخلاق. أما أعراف البشر وطبيعتهم وحتى دينهم وأخلاقهم= فقد سطا المتخصصون على قدسيتها ليحلوا محلها مقدسًا آخر هو الخطاب العلمي الذي يُلجأ إليه باعتباره سلطة أخلاقية. و”إذا كان الفكر اليوناني مركزه الكون، والفكر المسيحي مركزه اللاهوت، فقد غدا الفكر في العصر الجديث بشري المركز”.[19]
الهوية السائلة
في سوسيولوجيا الهوية يمكننا أن نفرق بين نوعين من الهوية: الهوية الذاتية و الهوية الاجتماعية الهوية بشكل عام تتعلق بفهم الناس وتصورهم لأنفسهم و لما يعتقدون أنه مهم في هذه الحياة. واعتماد الفرد لهويته يعني تعيينها مصدرا للمعنى والدلالة، و السلوك في حياته.
أزمة الهوية هي إحدى أزمات العالم الحديث، لأنه في هذا العالم الذي تمت عقلنته – كما تنبأ فيبر – لم يعد ثمة مكان للثوابت، والمرتكزات، إنه عالم الصيرورة، حيث كل الثوابت طارت في الهواء كما كتب ماركس؛ إنه عالم السيولة، حيث “كل شيء ممكن” وحيث المرجعية القيمية كامنة هنا في هذا العالم “هنا والآن”. في حين أن بناء الهوية يتطلب الثابت، يتطلب صخرة راسخة من القيم، كان الدين – فيما مضى – هو مثالها الأول.
الهوية الاجتماعية هي تلك التي تتضمن بعدا جماعيا، بمعنى أنها هوية تتشكل بالأساس من تفاعل الفرد مع غيره أو بانتمائه وتمثيله لدور اجتماعي محدد؛ و يضرب السوسيولوجيون لهذه الهوية أمثلة مثل الطبيب، الأم، العامل، الأمريكي، والمسلم طبعا.
و رغم أن الهويات قد تتعدد داخل الشخص الواحد، إلا أنه عادة ما تكون هناك هوية واحدة هي المهيمنة على سلوك الفرد و تتمتع باستمرارية زمانية و مكانية بالنسبة له. لكن عندما يتعلق الأمر بالحراك الاجتماعي، فالهوية الاجتماعية هي الجديرة بأن تدعم الحركات الاجتماعية، و هي التي يمكنها أن توجه مطالبها و توجهاتها.
أما الهوية الذاتية ففيما مضى -قبل المجتمعات الصناعية- كانت تتطابق بشكل كبير مع الهوية الاجتماعية، وكانت التقاليد الموروثة و الدين هي الفاعل الأكبر في تشكيل تصور الفرد عن نفسه، أما اليوم في عالم الصيرورة، و تبخر الثوابت، فقد خفت كثيرا وطأة الموروث و التقليد على تشكيل الهوية، مما فتح المجال لمصادر أخرى لرسم الهوية الذاتية.
صحيح أن أي هوية منها جانب لا بأس به يشكله التفاعل بين الفرد والمجتمع، لكن اليوم صار الفرد أكثر حرية في تشكيل و اختيار هويته الذاتية من أي وقت مضى، فتعزيز الفردانية في المجتمع الحديث أدى و لا شك إلى خلخلة قبضة التقليد و سلطة المؤسسات الاجتماعية مثل الأسرة و الدين على تشكيل الهويات.
لقد وجد الانسان الحديث نفسه في خضم بحر متلاطم من محددات الهوية، وهو ما أدى إلى مسؤولية كل فرد عن تشكيل هويته خارج دائرة المألوف والموروث، بغض النظر عن قيمة هذا الموروث، لأن الحياة الحديثة تعد من مدارج المجد أن يخرق الفرد حدود المتعارف عليه.
فصرنا الآن نسمع عن مصادر هوية حديثة، و نتكلم عن فلان اليوتيوبر، وفلان الانفلونسر، وفلان المثلي، وفلانة النسوية.
في حقيقة الأمر إن سعي أصحاب هذه الهويات إلى القبول المجتمعي هو علامة على المأزق الحديث.
فالتوجه الجنسي بحد ذاته لا يصلح كهوية اجتماعية، ومن ثم لا يصلح لأن يكون دافعا لحراك اجتماعي له أهداف سياسية، فكان لابد من فرض هذه الهوية على المجتمع و تحويلها لهوية اجتماعية صالحة لأن تكون مصدرا من مصادر هوية الفرد.. نفس الشيء يمكن أن يقال عن النسوية، و غيرها من هويات العالم الحديث. و قد ساعدت فوضوية القيم و نسف الثوابت على فتح باب القبول لكل شكل ولون من ألوان الهوية القائمة على النوع الفردي.
لذلك، ليس من المستغرب السعي الغربي الحثيث لتطبيع المثلية، لأن القبول المجتمعي سيحولها من هوية ذاتية إلى هوية اجتماعية معترف بها، و يمكنها أن تحكم و توجه سلوك الفرد، حتى تصير من محددات الولاء والبراء، فيوالي الفرد المؤسسات الداعمة للمثلية/النسوية/إسرائيل، و يعادي ويندد بمن يرفضها أو لا يعترف بحقوق كذا و كذا من الحركات او الاقليات، كما أن مجتمع الميم أو أي منتج هوياتي من منتجات الحداثة، سيسعى جاهدا – لإتمام تحويل ذاتيته إلى هوية اجتماعية – لصناعة تاريخ خاص بهذه الهوية، يبرر اولا وجودها، و ثانيا دعمها. و من هذا المنطلق لن يكف اي مؤيد للمثلية عن الضرب على وتر الاضطهاد والقمع الذي تعرضوا له، ليبرر شرطة الفكر التي تلاحق كل من يعلن رفضه للمثلية، تماما مثلما يعزف اليهود على وتر الهولوكوست لتبرير المذابح الفلسطينية، وكما تعزف النسويات على وتر المجتمع الذكوري.
لا تزال الحياة الحديثة مستمرة في مسلسل تعميم ما هو ذاتي و فرضه واقعا اجتماعيا. ومن داخل السوسيولوجيا أيضا نقول إن نجاح هذه العملية يعتمد بالمقام الأول على قوة النسيج الاجتماعي، وقوة محددات الهوية الأخرى، لذلك لا مناص من استمرار الرفض الاجتماعي الكامل لقبول أي محدد هوياتي جديد. وهذا الرفض الاجتماعي لا يلزم عنه الاضطهاد أو العدوان، و إنما يعني أن المجتمع يرفض اعتماد التوجه الجنسي مثلا محددا من محددات الهوية، وبالتالي تطبيعه والتصالح معه.
دراسة حالة: الموقف المسيحي من المثلية في القديم والحديث
قد لا يستغرب الناظر من تطبيع المثلية في مجتمع علماني يستمد قيمه من الأرض، لكنه قد يتعجب من أن تقف الكنائس -وهي عدو المثلية الأول- في صف حقوق المثليين، رغم نصوص الآباء والكتاب المقدس التي تشجب مثل هذا السلوك، ورغم الاضطهاد التاريخي المعروف.
كتب آباء الكنيسة عن الأنشطة الجنسية المثلية بين الذكور والإناث منذ العقود الأولى للمسيحية؛ وخلال غالبية التاريخ المسيحي، اعتبر معظم اللاهوتيين والطوائف المسيحية السلوك المثلي غير أخلاقي وخطيئة تستوجب العقاب.[20]
ظهرت كلمة المثلية الجنسية homosexual لأول مرة في ترجمة الكتاب المقدس المعروفة بـ النسخة القياسية المنقحة من العهد الجدسد RSV New Testament المنشورة من عام 1946 حتى عام 1970، والتي أزالت في نفس الوقت معظم التحذيرات من “الزنا/السفاح” الموجودة في نسخة الملك جيمس، واستبدلتها بالكلام عن المثلية والجنس بين الذكور. فمن الناحية التاريخية، تحتوي الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس على الأصل اللاتيني “ornicate” الذي يعني أي فعل جنسي محرم -وبوجه خاص: الزنا- في 92 نص من نصوص الكتاب المقدس. أما النسخة القياسية المنقحة من العهد الجديد فقد استعاضت عن هذه الكلمة في الترجمة اللاتينية في بعض المواضع بتوبيخ صريح للذكور الذين يعاشرون الذكور.[21]
لكن، على كل حال، لسنا معنيين هنا بنصوص الكتاب المقدس التي حُرفت؛ فهي على كل حال ليس لها -بذاتها- تأثير كبير داخل المجتمع الكنسي المعاصر، وهي عرضة لإعادة الإنتاج والتأويل لتتماشى مع أهداف الكنيسة؛ فالعبرة الأكبر هي بأقوال وأفعال الآباء الكبار؛ وسأكتفي هنا ببعض النقول عن أهم رموز المسيحية.
فأما المسيحية المبكرة؛ فيقول ترتليان:
عندما أكد بولس أن الذكور والإناث قد بدلوا فطرتهم، بما يناقضها؛ فإنه يثبت صحة الطريقة الطبيعية التي خلق الناس عليها”[22]
وفي عظته الرابعة عن الرومان، قرر جون كريسوستوم من القرن الرابع أن الممارسات الجنسية المثلية هي أسوأ من القتل، ومهينة للغاية لدرجة أنها بحد ذاتها نوع من العقوبة، وأن التمتع بهذه الأفعال يزيدها في الواقع سوءًا.[23]
وكتب أمبروسياستر:
“يخبرنا بولس أن هذه الأشياء [فعل قوم لوط] حدثت، وأن المرأة اشتهت امرأة أخرى لأن الله كان غاضبًا من الجنس البشري بسبب عبادة الأصنام. أولئك الذين يفسرون هذا بشكل مختلف لا يفهمون قوة هذه الحجة. ما هو تغيير الطبيعة والفطرة، استخدام جزء من الجسم من قبل كل من الجنسين بطريقة غير التي خلق من أجلها؟ … من الواضح أنه، لأنهم غيروا حقيقة الله إلى كذبة، فقد قاموا بتغيير الاستخدام الطبيعي (للجنس) إلى ذلك الاستخدام الذي يعد بحد ذاته إهانة لهم”.[24]
وفي العصر الوسيط، جادل توما الإكويني بأنه ليست كل الأشياء التي قد يميل إليها الشخص “طبيعية” بالمعنى الأخلاقي؛ بالأحرى، فإن الميل إلى التعبير الكامل والصحيح عن الطبيعة البشرية، والميول التي تتماشى مع هذا الميل هي التي يجب أن تعد أمورا طبيعية. أما الميول المعاكسة فهي انحرافات عن الطبيعة؛ وحتى لو كانت تسعى إلى الخير، فهي تسلك طريقا مدمرة للخير.[25]
وأما البروتستانت، فيقول مارتن لوثر:
إن رذيلة السدوميين [قرية لوط عليه السلام حسب الكتاب المقدس] هي فداحة لا مثيل لها؛ إنها أبعد ما يكون عن العاطفة والرغبة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها؛ والتي بموجبها يكون لدى الذكر رغبة عاطفية تجاه الأنثى. يرغب اللوطيون في ما يتعارض تمامًا مع الفطرة؛ فمن أين يأتي هذا الانحراف؟ إنه بلا شك يأتي من الشيطان، فعندما يموت الخوف من الله في قلب الإنسان، يمارس الشيطان ضغطًا كبيرًا على طبيعته لدرجة أنه يطفئ نور الرغبة الطبيعية ويثير نار الشهوة التي تتعارض مع الفطرة.[26]
لننتقل الآن إلى العصر الحديث؛
في 2007، وقبل أن يتولى منصب البابا، اعتُبر الكاردينال برجيليو -الذي أصبح البابا فرنسيس الآن، بابا الكنيسة الكاثوليكية- مدافعًا عن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية بخصوص المثلية الجنسية، حيث قال:
“إنّ الله خلق الإنسان، رجلاً وامرأة، وأعدهما جسديًا الواحد للآخر، في نظام قائم على العلاقة المتبادلة، يثمر في وهب الحياة للأولاد، لهذا السبب لا توافق الكنيسة على الممارسات المثلية. لكنّ المسيحيين مدينون لجميع البشر بالاحترام والمحبة، بغض النظر عن توجههم الجنسي، لأنّ جميع البشر هم موضع اهتمام الله ومحبته”.[27]
ولكن، بعد توليه منصب البابا، قال للصحفيين أثناء رحلة العودة إلى روما من ريو دي جانيرو بعد يوم الشباب العالمي في يوليو 2013: “من أنا لأحكم على المثليين؟”.
لكنه عاد في الفيلم الوثائقي الذي وثق حياته بعنوان Francesco وقال:
“المثليون لهم الحق في أن يكوِّنوا أسرة. إنهم أبناء الله، ولهم الحق في تكوين عائلة. لا ينبغي طرد أحد من عالم الله أو جلعه بائسًا بسبب ميوله الجنسية”.[28]
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فالبابا فرنسيس من ناحية يؤيد الزواج المدني من نفس الجنس، لكنه يقف ضد تعميد زواج المثليين في الكنيسة. ومن ناحية يقول إنه لا ينبغي جعل الناس “بائسين” بسبب ميولهم الجنسية، لكنه لا يوافق على انضمام المثليين إلى رجال الدين. يبدو أن تناقضات المسيحية تعمل عملها في مواقف البابا!
فعندما كان يشغل منصب رئيس أساقفة بوينس آيرس من عام 1998 إلى عام 2013، قام بحملة ضد الاتحادات المدنية للزواج من نفس الجنس، حتى يتمكن من منع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من الفوز بحق الزواج القانوني؛ لكن استراتيجيته جاءت بنتائج عكسية؛ ففي عام 2010، أصبحت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تشرع زواج المثليين! واتخذت العديد من الدول حول العالم نفس الاختيار في العقد التالي، بما في ذلك ألمانيا في عام 2017.
لكنه في أكتوبر 2015، طرد قسًا بولنديًا مثليًا. وفي عام 2018، في سلسلة من المحادثات مع المبشر الإسباني فرناندو برادو، قال البابا فرنسيس إنه “لا يوجد مكان” للمثلية الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية. وقال: “لهذا السبب، تحث الكنيسة على عدم قبول الأشخاص ذوي الميول المثلية في الخدمة الكهنوتية”.
لكن في ألمانيا، دعت اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان بإشراف مباشر منه إلى “عدم حجب البركات” عن الأزواج من نفس الجنس! وقالت في بيان رسمي في نوفمبر 2019: “نحن نقوم بحملة من أجل إقامة طقوس رسمية لمباركة الأزواج المثليين”.[29]
يعيش نصف عدد الكاثوليك المقدَّر في العالم بنحو 1.3 مليار كاثوليكي في الأمريكتين ، ولا سيما أمريكا اللاتينية. بينما يعتبر 20٪ فقط من سكان أوروبا أنفسهم كاثوليكيين، وهذا الرقم آخذ في الانخفاض. ومع ذلك، وفقًا لوكالة أنباء الفاتيكان Agenzia Fides، هناك عدد متزايد من الكاثوليك في آسيا وخاصة في إفريقيا. لكن حتى في هذه المجتمعات الكاثوليكية المتنامية في آسيا وإفريقيا، لم تكن كلمة البابا موضع ترحيب؛ حيث قال “إن الكاثوليك الأفارقة، أو المسيحيون في الشرق الأوسط، سيصابون بالصدمة عندما يعرفون أن الشراكة الجنسية بين اثنين نفس الجنس يجب أن تكون متساوية مع الزواج”، مضيفًا أنهم -مثل البابا- ليسوا مستعدين لقبول المثلية الجنسية تمامًا في الكنيسة الكاثوليكية!
لكن من ناحية أخرى، قال ألكسندر فوجت -رئيس المجموعة التي تمثل مصالح مجتمع الميم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ في البرلمان الألماني- إنه سعيد للغاية بآخر كلمات البابا، قائلاً إنها “شيء انتظرناه منذ فترة طويلة…لقد أدلى بتصريح أو آخر في الماضي أظهر على الأقل أنه متعاطف مع المثليين والمثليات؛ شعرت على الفور [بوجود] أمل لبعض كلمات الأسف حول المعاناة والألم الذي تسببت فيه تعاليم الكنيسة في القرون الماضية للمثليين والمثليات”.[30]، وعلى كل حال، فوجت محق، فهذا هو ما نشرته صحيفة الـ BBC عن البابا مؤخرًا.[31]
إن هذه الأحداث التي لا يربط بينها رابط، تعكس الوضع القلق الذي تعيشه المسيحية،[32] فمن ناحية:
هناك نصوص الكتاب المقدس، وتعاليم آباء الكنسية من كل الحقب المسيحية التي تنص على عدم التسامح مع المثلية؛ ومن ناحية أخرى هناك ضغط اللوبي المثلي، والضغط الأوسع من المجتمعات الأوروبية الذي يدفع البابا دفعًا نحو الاعتراف المتزايد بالزواج المثلي ومباركته في الكنيسة.
في حقيقة الأمر، موقف المسيحية والبابا المتناقض من المثلية، يعكس شيئين:
الأول: أنه حتى في هذا العصر الذي تمت علمنة الجزء الأكبر من مؤسساته، لا يزال المثليون يسعون إلى كسب تأييد الكنيسة الكاثوليكية، رغم قلة عدد الكاثوليك في أوروبا، لعلمهم أن هذا سيكسبهم مساحة جديدة، فأن يوجد المثليون داخل التيار المسيحي “الأصولي” لهو دلالة عميقة على تغلغل المثلية في المجتمع الأوروبي.
الثاني: أن العصر الحديث لا يجد حرجًا في أن تتنصل مؤسسة اجتماعية كبرى -مثل المسيحية- من تاريخها وتعاليمها ونصوص كتابها، في سبيل إرضاء حفنة من البشر، يزعمون أن لهم حقوقًا.
خاتمة
- تبين مما سبق أن القيم التي أصلتها الحداثة وما بعدها قد كان لها كبير الأثر في تطبيع المثلية الجنسية، وإذا استمرت الحال كما هي، فيُتوقع أن قطار الانحدار سينزل أكثر فأكثر إلى دركات السفول، طالما ظلت مقولات مثل الحريات والحقوق والنسبية الأخلاقية -بمفاهيميها الغربية- هي المهيمنة على ساحة الخطاب حول حقوق المثليين.
- يرى الكاتب أن المعضلة الكبرى التي ستواجه المشتغلين بنقد تطبيع المثلية لن تكون في تعداد مضارها وأخطارها على الفرد والمجتمع، بل في التأسيس لخطاب أخلاقي يعتمد المطلقات الأخلاقية في عالم لم يعد يتسع صدره لأي مطلق، لذا من الواجب أولا إعادة مفاهيم مثل: الحق، والأخلاق إلى نصابها الصحيح وتفكيك السياق الحداثي الذي أهدر جوهرها، ومن هناك يكون الحديث عن إجماع إنساني ممكنا.
- على المؤسسات الإسلامية أن تتخذ من الكنيسة الكاثوليكية عبرة وعظة، لأنه ما كانت الكنيسة لتصل إلى هذا الدرك من الانحطاط وأن تضرب بتعاليم الكتاب المقدس والآباء عرض الحائط إلا بأنها رضت أولا بتبني مقولات الحداثة، ومحاولة الترقيع لتظهر بلباس الحداثة.
[1] يشجب البعض مسمى المثلية الجنسية باعتباره وصفا يتبع الصوابية السياسية، ويخفف من شناعة الفعل، ويفضلون اسم الشذوذ أو اللوطية. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، فالشذوذ الجنسي يشمل كل الممارسات الجنسية المخالفة للميل الطبيعي، بما في ذلك الجماع من الدبر -وقد سماه السلف “لوطية صغري”- ومن ذلك اشتهاء الأطفال، والبهائم، والفيتشية، والسادية، وجميع صور الانحرافات الجنسية عن الميل الطبيعي يصدق عليها اسم الشذوذ. لذلك فالتسمية الصحيحة لما نتحدث عنه هنا -مجتمع الميم- هي المثلية، لأنه هو الوصف الأدق، أما الشذوذ فهو طيف واسع، وحتى الآن لم تحظ كل أطياف الميول الجنسية بنفس الاعتراف والحقوق.
[2] لمتابعة أكثر شمولا لأهم اللحظات التاريخية الهامة في تطبيع الممارسات المثلية انظر:
https://edition.cnn.com/2015/06/19/us/lgbt-rights-milestones-fast-facts/index.html
[3] انظر هذا الخطاب الذي وقع عليه أعلام الفكر المعاصرين:
https://atharah.net/a-letter-on-justice-and-open-debate/
[4] أشار أنتوني غدنز أن جنس الأطفال تجارة رائجة في دول جنوب شرق آسيا، وأنه العمدة الأساسية لاقتصاد هذه الدول. انظر: علم الاجتماع، أنتوني غدنز، ت.فايز الصياغ، ص170.
[5] https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/06/26/the-one-supreme-court-paragraph-on-love-that-gay-marriage-supporters-will-never-forget/
[6] https://www.britannica.com/topic/gay-rights-movement
[7] https://www.britannica.com/topic/gay-rights-movement
[8] https://www.britannica.com/biography/Lord-Alfred-Douglas
[9] https://www.britannica.com/topic/gay-rights-movement
[10] Harry Hay, Early Proponent of Gay Rights, Dies at 90: The New York Times.
[11] https://www.britannica.com/event/Wolfenden-Report
[12] https://www.britannica.com/biography/Annise-Parker
[13] العقل الحضاري العربي، العدد 51، عام 1989، ص80-81.
[14] علم الاجتماع، أنتوني غدنز، ت. فايز الصياغ، ص262.
[15] دانيال ليجيه، دين وحداثة ودنيوة، مجلة مواقف العدد63.
[16] مارشال بيرمان، الحداثة أمس واليوم وغدا.
[17] هابرماس، خطاب فلسفي عن الحداثة.
[18] هابرماس، الحداثة غير المكتملة.
[19] داريوش شيغان، أوهام الهوية، ص10.
[20]Pavao, Paul F. “Homosexuality Quotes”. Christian History for Everyman. Paul F. Pavao. Retrieved 30 November 2020.
[21] في الترجمة اللاتينية (كورنثوس الأول 6: 9-10) و (تيموثاوس الأولى 1:10) صارت في الترجمة الإنجليزية تعني الجنس مع الرجال.
[22] 3:96. Roberts, A. and Donaldson, J. eds. 1885-1896. Ante-Nicene Fathers, 10 vols. Buffalo, NY: Christian Literature.
[23]“CHURCH FATHERS: Homily 4 on Romans (Chrysostom)”. Newadvent.org. Retrieved 18 April 2012.
[24]81:51 in Vogels, Heinrich Joseph and Ambrosiaster. Ambrosiastri Qui Dicitur Commentarius In Epistulas Paulinas. Vindobonae: Hoelder-Pichler-Tempsky, 1966.
[25] “SUMMA THEOLOGICA: The natural law (Prima Secundae Partis, Q. 94).
[26] Plass, Ewald Martin. What Luther Says: An Anthology, Volume 1, 1959. p. 134.
[27] https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-archbishop-of-buenos-aires-rages-against-abortion-death-sentence
[28] https://www.dw.com/en/pope-francis-and-homosexuality-in-the-catholic-church-an-analysis/a-55371918
[29] https://www.dw.com/en/how-a-church-in-germany-posthumously-reinstated-a-gay-clergyman/a-54784996
[30] https://www.dw.com/en/pope-francis-and-homosexuality-in-the-catholic-church-an-analysis/a-55371918
[31] https://www.bbc.com/news/world-europe-54627625
[32] https://www.nytimes.com/2021/06/27/world/europe/pope-sends-more-mixed-messages-on-lgbtq-rights.html