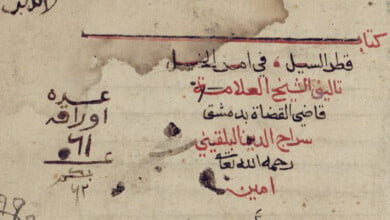- خبّاب بن مروان الحمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
ما إن يموت غير مسلمٍ كانت له مآثر ومناقب حسنة في الدنيا؛ حتى تختلف الأصوات وتتعدد الأفكار في طريقة التعامل مع وفاته من ناحية دينية، حتى يصل الحال ببعضهم للقول بجواز الترحم والاستغفار لموتى غير المسلمين، ومنهم من يُفرَّق بين الدعاء لهم بالرحمة فيرى جوازه، والمنع من الاستغفار لهم.
وعلى غير العادة العلمية المعاصرة في كتابة البحث العلمي؛ فلست ممن يود كتابة النتيجة والخلاصة في آخر الجواب؛ بل أبتدئ بها بمختصر القول في ذلك، وأنّه لا يجوز الترحم على من مات من غير المسلمين؛ فضلاً عن القول بعدم جواز الاستغفار لهم، فكيف إذا قيل بأنه في الجنة، فإن هذه الأقوال باطلة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وما عليه علماء المسلمين.
سبب الاجتراء المعاصر بالترحم أو الاستغفار على موتى غير المسلمين
إنَّ الذي سبّب القول بجواز الترحم والاستغفار عدّة أمور، وليس شرطاً أن تكون مجتمعة في كل من قال بذلك؛ فقد يكون هذا السبب منطبقاً على بعضهم دون الآخر، لكنّها أسباب ودوافع قد تجتمع في بعضهم دون بعض، وقد يكون سببٌ واحدٌ منها مسبباً للقول بجواز الترحم أو الاستغفار، ومن ذلك:
- عدم الجمع بين الآيات التي يحتج بها بعض المجيزين؛ مع الآيات الصريحة التي تمنع دخول الكفار في رحمة الله، فقد يحتجُّ بعضهم على آياتٍ يرونها حجّة في الجواز وهي ليست كذلك؛ فإمّا أن يكون الاستشهاد ووجه الدلالة لا علاقة لهما بالدليل، أو يكون بعضها من قبيل المتشابه الذي يُظنُّ فيه القول بالجواز! بصرف النظر عن الرجوع للآيات المحكمة التي توضح وتفصّل تحريم الترحم والاستغفار لأموات الكفّار.
- الهزيمة النفسية تحت ضغط الجماهير والإعلام، وعدم المقدرة على المواجهة العلمية؛ فيلجأ بعضهم إلى الأخذ ببعض الأقوال كي لا يُوصموا بالتشدد والتطرف، أو الوهّابية والداعشية، وكأنَّ من قال بالتحريم للترحم والاستغفار لأموات الكفار من كافّة علماء الأمّة عبر قرون وعصور كانوا قد ولدوا بعد دعوة ابن عبد الوهاب أو فتنة داعش!
- ضعف العناية بمنهج أهل السنة والجماعة وأسس أصول الاعتقاد في دراسة طريقة القرآن في وصف حال الكافرين ومصيرهم والتعامل معهم.
- قلّة النظر والتدقيق في الأساليب العربية التي نزل القرآن مخاطباً بها العرب بلسانهم؛ والقراءة السطحية غير المتأنية للنصوص واستنباط بعض المعاني منها على القول بالجواز.
- محاولة استرضاء النصارى ببذل بعض المقولات والأدعية لكسب ودهم؛ ولأجل تحقيق اللحمة الوطنية والوحدة العامة ضد المعتدين أو المحاربين.
- الحفاظ على الوظيفة، والخوف من إظهار القول الذي يؤمن به ويقتنع به؛ بل وجدتُ من يخشى من التصريح بتحريم ذلك حين يكون في مناصب حسّاسة في عمله أو وظيفته.
- الحقد والتطاول على بعض المخالفين لهم المانعين من الترحم والاستغفار، وقد يتصف بعض المانعين بشيء من الصلف والقسوة والعنف في نقض قول المجوزين؛ مما يجعل فئة من المجوّزين يتخذون موقفاً مغايراً للنكاية والتنكيل والسخرية بهم، وتكون مواقفهم نتاج مواقف أخرى مضادة غير منضبطة فيحصل بها التجاوز من الطرفين.
- طبيعة بعض الناس الميّالة للرفق واللين والرحمة وعدم القدرة على الانتهاض لموقف يتصلب فيه تجاه خطأ؛ فتراه يتخذ هذا الموقف اللين بهذه الشاكلة.
- الخشية من الدعاوى العريضة التي تجعل من يمنع الترحم على من مات من غير المسلمين؛ بأنّه يُحجّر على رحمة الله، ويتألى على الله، وأنه يرى ضرورة انتقال هؤلاء الموتى من غير المسلمين للعذاب والنار، وفي هذا من الخطأ البيّن ما فيه؛ إذ إنّ القول بذلك لا يعني التحجير أو التألي على الله؛ بل هو من اتباع كتاب الله، ومن يقول بعدم جواز الترحم عليه فإنه لا يَلْزَمه أنّ الميت غير المسلم في جهنم، لأنّ الله أعلم بهم حال وفاتهم، وإنما حديثنا عن الناس بظاهرهم في الدنيا، وأما بواطنهم وخفاياهم وما فعلوه في آخر حياتهم، فإن علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
- عدم استشناع الكفر الذي يصدر عن الكافرين من أهل الكتاب؛ ورّقة التديّن في النظر لعقائد الملل والنحل الكافرة، بل إن فئة من المجوزين ترى أنّ هذه الديانات كلّها طرق تؤدي إلى معبود واحد.
- أنَّ الترحم والاستغفار لموتى أهل الكتاب ما هي إلا سلسلة من بدايات سلسلة تحقيق الوحدة الإبراهيمية عند فئة من المجوزين؛ فلم يقتصر الأمر عندهم بذلك فحسب بل أجازوا الصلاة على من مات من غير المسلمين، والجزم بأنّهم في الجنة، وعدم القبول بجنة لا يدخل فيها فلان أو علان من غير المسلمين.
الواجب الدياني/الأخلاقي تجاه البحث قبل الوصول إلى قرار الحكم
إنَّ من أخطر المناهج في دراسة القضايا البحثية؛ أن يعتقد المرء ثم يستدل، وأن يبحث بعد أن يُقرر. والواجب أثناء دراسة هذه القضيّة أن نستذكر عدة تنبيهات:
- على الباحث والقائل أن ينتبه لمعتقداته ومقولاته قبل النطق بها، فإنَّ كثيراً من الناس يصعب عليهم التراجع بعد القيل والقال في إثبات رأيهم، ولو أنّ أحدهم تأنى ودرس ومحًّص أو توقف حال وجود معضلة؛ لكان ذلك أدعى له لقبول قول مخالفه بعد اتضاح حجّته وبيان خطأ مقولته.
- مراجعة النفس وقمع الهوى الخفي الذي فيها، وتطلب كسب رضا الله فإنّه أولى من كسب رضا البشر؛ وإنَ الواجب على المعتني بنشر العلم ألا يلتفت إلى ضغط الجماهير أو الناس فإن قولة الحق في العلم أولى من إرضاء الناس، ورحم الله الإمام مالك حيث قال: “نصرة العلم أحب وأعز من نصرة الناس”.
- تجريد النفس من المسبقات الفكرية، والمؤثرات الإعلامية، والضغوط الجماهيرية، والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله بحق وصدق كما قال تعالى: {كِتَـٰبٌ أُنزِلَ إِلَیۡكَ فَلَا یَكُن فِی صَدۡرِكَ حَرَجࣱ مِّنۡهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِینَ} وكما قال تعالى: {فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يُحّكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلّموا تسليماً}.
- بناء الرأي على منهجية محددة تنطلق من أسس وأصولٍ متسّقة مع معتقد وطريقة أهل السنّة في التلقي والاستدلال، وليس كما نراه في كثيرٍ من المكتوبات في مواقع التواصل حيث نرى كثيراً من هذه الاحتجاجات مبنيّة على عبثية وفوضوية وانتقائية في الاستدلال، مما سيصنع في حسّ المستدل تناقضاً يكتشفه في نفسه حال دخوله في مباحثة قضية أخرى حيث يرد الدليل الذي استدل به واحتج لمغايرته لبعض مفاهيمه الخاصة.
- حسن الفهم والإدراك والعناية باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم؛ فلقد وجدتُ من كثيرين استدلالات مجانبة للصواب؛ بسبب عدم مكنتهم من فهم اللغة التي نزل بها القرآن.
- عدم تطبيع المفاهيم القرآنية مع مستحضرات الفكر الحر الحديث الذي يقوم على تسويق لغة الإخاء والحرية والمساواة والنسبية؛ فإنَ كثيراً من الاستدلالات ما طرأت ولا وُجدت إلا من جديد، ولم يكن لها أساسٌ من احتجاج وبرهنة لدى كافّة علماء المسلمين؛ فما الذي جعل مثل هذه الاستدلالات حاصلة؛ إلا أنَّ أكثرها أتت نتيجة ظروف يعايشها المسلمون تحت قهر وظلم ووطأة الأمم الكافرة الظالمة؛ مما يجعل كثيراً منهم يكاد يكون قصارى جهده ومبتغى أمله وأس دعوته أن يبيّن سماحة الإسلام ويبذل الغالي والنفيس للاحتجاج لأشياء لم تكن من أساسات الاحتجاجات الإسلامية عموماً؛ لولا أنَّ الحال المزرية في الضعف والهوان الذي وصلنا إليه وإلا لما كانت هذه الضجّة الكبرى في التعامل مع أموات غير المسلمين؛ ونحن نرى مئات وآلاف المسلمين يقتلون وتُقتل كثيرٌ من النساء العالمات الداعيات المجاهدات ويرحمهم الله ويرحمهنَّ الله، وما ضرّهم أنَّ الناس لم يعرفوا أو يتحدثوا عنهم فالله يعرفهم ويعلمهم، وليت هؤلاء المتسابقين يرصدون حالة وفاة أحد المحسنين المسلمين بطريقةٍ غير اعتيادية بل جرت عليه بظلم أو استهدافٍ؛ فكيف تتعامل معهم المجتمعات غير الإسلامية والمعابد الدينية الخاصة بهم، والقنوات الإعلامية؟!
أدلة التحريم والمنع للاستغفار والترحم على أموات غير المسلمين
نحن نعتقد أنّ أدلّتنا متينة ومتسقة ومطّردة لا تناقض فيها، تدل على تحريم الترحم والاستغفار لمن مات من غير المسلمين، ومن ذلك:
- عدم جواز الاستغفار للكفار والمشركين.
قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}.
وجه الدلالة: أن أبا طالب مع كونه قد خفف عنه العذاب لأجل شفاعته صلّى الله عليه وسلّم في عمّه أبي طالب أن يُخفف الله عنه العذاب؛ إلا أنه لا يجوز الاستغفار؛ فسؤاله عليه الصلاة والسلام لربه أن يُخفف العذاب عن عمه أبي طالب ليس لها تعلٌّق بأمر الرحمة بل هي متعلّقة بشفاعته صلى لله عليه وسلّم، وأدلّتها أنّه:
وقد ثبت في صحيح البخاري عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: “نَعَمْ. هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ. وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ”.
وفي صحيح البخاري من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: “فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ”.
وفي صحيح مسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً أَبُو طَالِبٍ. وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ”.
فدلَّت الأحاديث على أنَّه صلى الله عليه وسلم قد شفع في عمّه أبي طالب بتخفيف العذاب عنه، وهذا قصارى أمره معه؛ هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك: “لأستغفرنَّ لك ما لم أنه عنك” فأُنْزِلت عليه الآية: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}.
إنَّ القول بعدم الترحم والاستغفار لمن مات كافراً؛ فيه تحقيق معنى الاتباع لهدي وسنة رسول الله وهو خير مثال للاحتجاج بسّنة رسول الله العملية، ومن تبعه من صحابته الكرام؛ إذ لم نجده صلّى الله عليه وسلّم حين مُنع من الاستغفار لعمه أبي طالب أن دعا له بالرحمة؛ ولو كان ذلك لتوافر نقله، وتتابعَت حكايته؛ فإنّه عمّه الذي نصره وآواه وقد تأثّر على وفاته عاماً كاملاً؛ فهل يُعقل أنّه كان يترحم عليه ولم يُنقل ذلك عنه؟! فلولا أنَ الاستغفار ممنوع فإنّ الدعاء له بالرحمة غير مشروع كذلك!
ثم لنأخذ هذا الاحتجاج ونتأمل!
فإنّه عليه الصلاة والسلام حين مات عبد الله بن أبي بن سلول، وعلى الرُّغم من كونه معادياً لرسول الله وكان رأس النفاق والمنافقين وقد نزلت فيه عدَّة آيات؛ فما زاد ذلك رسول الرحمة المهداة إلا أن يهم بالدعاء له والاستغفار، فإنّه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: لَمَّا تُوُفِّيَ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبَيٍّ، جاءَ ابنُهُ عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَهُ أنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فيه أباهُ، فأعْطاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أنْ يُصَلِّيَ عليه، فَقامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيُصَلِّيَ عليه، فَقامَ عُمَرُ فأخَذَ بثَوْبِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، تُصَلِّي عليه وقدْ نَهاكَ رَبُّكَ أنْ تُصَلِّيَ عليه؟! فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما خَيَّرَنِي اللَّهُ فقالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80]، وسَأَزِيدُهُ علَى السَّبْعِينَ، قالَ: إنَّه مُنافِقٌ! قالَ: فَصَلَّى عليه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84].
وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أنّه حين خاطبه بقوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} ثم قال: إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ:{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إِلَى قَوْلِهِ {وَهُمْ فَاسِقُونَ}”.
والظاهر من هذا: أنّ أكثر الناس مناصرة لرسول الله في مكّة كان عمه أبي طالب، وقد حزن على وفاته، وهمّ بالاستغفار له، ونُهي عن ذلك فلم يستغفر له ولم يترحم عليه أو يطلب له الدعاء بالرحمة.
وأنَّ أكثر الناس عداوة لرسول الله في المدينة كان عبد الله بن أبي بن سلول، وقد حاول أن يستغفر له أو يزيد في الاستغفار لو كان يعلم أنَّه سيُغفر له، ولم يفعل ذلك ولم يدع له بالرحمة.
- عدم جواز الصلاة على أموات غير المسلمين.
قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ(84)}
وجه الدلالة: منع الله تعالى رسوله محمداً صلّى الله عليه وسلّم عن الدعاء للكافر بالرحمة والمغفرة؛ لأنّ صلاة المسلم على الميت فيها رجاء من ربّه أن يغفر له ويرحمه، وما سبب منع الصلاة على غير المسلمين إلا لئلا يتعرض لرحمة الله، ولهذا جاء عند القول المشهور لدى العلماء أنّه إذا قيل: صلّى عليه الله أي رحمه، ولأجل ذلك عطف الرحمة على الصلاة لأنّ الصلاة معنى خاص، والرحمة معنى عام.
إنَّ معنى الصلاة كذلك يحمل الاستغفار والرحمة؛ والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال عمّن يأتي إلى المسجد ثم يجلس منتظراً الصلاة: ” وَتُصَلِّي – يَعْنِي عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ – مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ”؛ وقد بيّن عليه الصلاة والسلام معنى صلاة الملائكة الذي يحمل الدعاء له بالمغفرة والرحمة.
ومن هذا وجدنا علماء المذاهب الفقهية المعتبرة فلقد اتفقت كلمتهم على عدم جواز الصلاة على من مات كافراً؛ وهذا إيراد لبعض النقولات عنهم في:
قال الكاسانيُّ في (بدائع الصنائع): “كتابيَّةٌ تحت مسلم حبلت، ثم ماتت وفي بَطْنِها ولدٌ مُسْلِمٌ، لا يُصلَّى عليها بالإجماعِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ على الكافرةِ غيرُ مشروعةٍ”.
وقال النووي في (المنهاج): ” ولو اختلط مسلمون بكفار؛ وجب غَسلُ الجميع والصلاة، فإنْ شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين، وهو الأفضل والمنصوص، أو على واحدٍ فواحدٍ ناوياً الصلاة عليه إنْ كان مسلماً، ويقول: (اللهم اغفر له إنْ كان مسلماً)”.
وقال النووي في (المجموع): “وأما الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة، فحرام بنص القرآن والإجماع”.
والهيتمي في (تحفة المحتاج) فإنه تحدث عن منع الدعاء لبعض الأصناف ثم قال: “وعلى (الكافر) بسائر أنواعه لحرمة الدعاء له بالمغفرة قال تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا }”.
وقال الرملي في (نهاية المحتاج): “(وَتَحْرُمُ) الصَّلَاةُ (عَلَى الْكَافِرِ) وَلَوْ ذِمِّيًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] ؛ وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]”.
وقال البهوتي في ( كشّف القناع): “( إسلام ميت ) لأن الصلاة عليه شفاعة والكافر ليس من أهلها ولا يستجاب فيه دعاء قال تعالى {: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا }”.
- عدم الاستغفار لأولي القربى.
ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي).
وجه الدلالة: أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم مُنع من الدعاء لأمّه وطلب المغفرة لها، لكفرها؛ وإن كان قد أذن له بزيارة قبرها، فلو أنّه مُنع من الاستغفار لها لانتقل للدعاء لها بالرحمة، ولم يفعل.
- أنّ من لم يسأل ربّه الرحمة والمغفرة لا يغفر الله له.
ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين».
- إجماع العلماء على عدم جواز الدعاء للكافر بالترحم والاستغفار.
قال الإمام ابن تيمية: “الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع”.
وقال العلاّمة النووي: “الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع”.
وقال القرافي: اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار ذاته، من حيث هو طلب من الله تعالى، وهو الندب؛ لاشتمال ذاته على خضوع العبد لربه، وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه، فهذا ونحوه مأمور به، وقد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه، والتحريم قد ينتهي للكفر، وقد لا ينتهي: فالذي ينتهي للكفر أربعة أقسام:
القسم الأول: أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته، وله أمثلة: الأول: أن يقول: اللهم لا تعذب من كفر بك، أو اغفر له، وقد دلت القواطع السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات كافرًا بالله تعالى؛ لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به {النساء: 48}، وغير ذلك من النصوص، فيكون ذلك كفرًا؛ لأنه طلب لتكذيب الله تعالى فيما أخبر به، وطلب ذلك كفر، فهذا الدعاء كفر”.
وبصرف النظر عن التحقيق في قول القرافي بشأن كفر من استغفر لمن مات كافراً؛ فإنّ مثل هذا التغليظ لا يمكن أن يصدر عن القرافي وهو العالِم النحرير؛ إلا لشدّة النظر تجاه من زعم ذلك؛ وكأنّه لم يتصوّر عقلاً أن يكون مسلماً قد تطّلب من ربّه الاستغفار للكافر بعد موته؛ استبشاعاً واستشناعاً لمقوله الكفر ومصير الكافر؛ ولهذا رأى الآلوسي – رحمه الله – أنّه لا مساغ عقلي لمن دعا لشخصٍ مات كافراً؛ وإن كان يجوز الدعاء له في حال حياته فيقول: ” والتحقيق في هذه المسألة: أن الاستغفار للكافر الحي المجهول العاقبة، بمعنى طلب هدايته للإيمان مما لا محذور فيه عقلاً ونقلاً، وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طُبع على قلبه وأَخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وعلم أن لا تعليق في أمره أصلا: مما لا مساغ له عقلاً ونقلاً، ومثله طلب المغفرة للكافر مع بقائه على الكفر على ما ذكره بعض المحققين، وكان ذلك – على ما قيل – لما فيه من إلغاء أمر الكفر الذي لا شيء يعدله من المعاصى، وصيرورة التكليف بالإيمان – الذي لا شيء يعدله من الطاعات – عبثاً، مع ما في ذلك مما لا يليق بعظمة الله عز وجل”.
- النهي عن الاستغفار يشمل كل من مات كافراً بالله.
أنَّ النهي عن الاستغفار لمن مات من غير المسلمين يشمل الكفار والمشركين، وليس مختصاً أو مقتصراً على من أشرك بالله، لأنَّ الله تعالى ذكر كافّة الأوصاف من المشركين والمنافقين والكفار عموماً؛ مع أنّ إيراد كل واحدٍ منهم يكفي عن الآخر فالجامع كفرهم بالله، وشاهد ذلك ما يلي:
فأمّا من حيث الشرك فإنَّ الله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا}.
وقال تعالى:{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار}.
وأمّا من حيث الكفر عموماً فقد قال تعالى:{إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا}.
وقال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ}.
وأمّا من حيث المنافقين الذين ولجوا طريق الكفر فقد قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا}.
مناقشة قول المجيزين للترحم على الكافرين المانعين من الاستغفار له
قد يقول قائل: نتفق على أنّه لا يجوز الاستغفار للكافر ولكن ألا يصحّ أن ندعو له بالرحمة، ويحتجون بقوله تعالى: {ورحمتي وسعت كلّ شي} حيث احتجوا بها على أنَّ رحمة الله واسعة يرحم جميع الخلق؛ وأنَّ من منع الدعاء للكافر فإنَّه يُحجّر على رحمة الله تعالى، وأن قوله: “فسأكتبها” هي الرحمة الخاصة تفريعا من رحمته العامة، وليس تخصيصا لرحمته العامة.
والجواب عليهم من وجوه:
- الوجه الأول:
إنّ الله تعالى رحمن ذو رحمة واسعة لعموم الخلق من حيث قضاء الله الكوني القدري، وهو كذلك رحيم ذو الرحمة الخالصة الخاصة الواصلة للمؤمنين؛ كما قال تعالى: {وكان بالمؤمنين رحيماً}.
وإنَّ رحمة الله العامة بخلقه مسلمهم وكافرهم؛ ترجع إليه وحده؛ وقرارها إليه؛ فهو الفعّال لما يشاء، ولا يُسأل عما يفعل، ولكنّنا معرَّضون للسؤال؛ إذ إنّه مُنع علينا سؤال الله الرحمة لغير المسلم؛ ولا يصح لنا أن نجيز لأنفسنا شيئاً أجازه الله لنفسه؛ فالله تعالى قد منع من الحلف بغيره؛ لكنه يحلف بكثيرٍ من مخلوقاته؛ فلا يصح أن نقول: إنَّ الله حلف بالشمس والقمر فعلينا أن نحلف بهما كما حلف وأقسم الله بهما.
- الوجه الثاني:
أنَّ رحمته للمخلوقين في الدنيا؛ يكون تارة برفع العذاب عنهم بالدنيا، أو تخفيف ما يُصيبهم، أو تهوين المصاب عليهم بوقوع النكبات والمصائب.
وإنَّ من عموم رحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ ولكن من جحد وعاند، وكابر وكفر؛ فلن تصيبه الرحمة إلا بمن سبق الكتاب عليه بتخفيف العذاب عنه وهو شيء خاصٌ كعمّه أبي طالب، أو بما يُقدّره الله من رحمة لا نعرف على من تقع يُصيب بها من يشاء ويصرفها عمّن يشاء.
وعلى هذا الأساس يُقال؛ إنّ من دعا لمن مات من الكفار بالرحمة؛ فلقد أسرف وجاوز وكان ذلك من سبيل الاعتداء في الدعاء، وقد نبّه قال شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك فقال:” وقد قال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين) في الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين، ونحو ذلك”.
لقد أخبر الله تعالى عن حال من كفر بالله من أهل الكتاب والمشركين أنّهم في النهار وأنَّهم شرُّ البريّة فقال: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ}.
وأخبر عزّ من قائل أنّه لا يُخفف العذاب عن الكفرة؛ بسبب كفرهم، فقال: {وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ لَا یُقۡضَىٰ عَلَیۡهِمۡ فَیَمُوتُوا۟ وَلَا یُخَفَّفُ عَنۡهُم مِّنۡ عَذَابِهَاۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِی كُلَّ كَفُورࣲ} وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ} وقال تعالى أيضاً: {وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ* قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلال} وفي هذا دلالة على أنّ العذاب يتجدد على الكفار وأنّه لا يُخفف عنهم منه شيءٌ بسبب كفرهم بالله؛ وبهذا يستقيم القول بالمنع من الدعاء بالرحمة للكافر الميت؛ فإنّه متوافق مع قوله تعالى: {والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي} والرحمة في هذا السياق أتت على أنها نكرة مضافة فكانت من صيغ العموم؛ حيث تنفي عنهم عموم الرحمة.
- الوجه الثالث:
الاحتجاج بالآية: {ورحمتي وسعت كلّ شيء} دليل على من يمنع الترحم وليست دليلاً لهم؛ لأنّه تعالى يقول: {قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ}.
ووجه الدلالة: أنه تعالى قال: {ورحمتي وسعت كلّ شيء} وقد بيّن أنّه كتبها لمن يستحقها من المؤمنين وذكر أوصافهم واشترط إيمانهم، واشترط اتّباعهم للرسول النبي الأمي محمد القرشي الهاشمي فقال: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚفَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ومن تأمل الآية أدرك أنّ الله يُطالب أهل الكتاب أن يؤمنوا بنبوة سيدنا محمد وأن يتّبعوه.
- الوجه الرابع:
أنَّ الله جلّ جلاله وسع كل شيءٍ رحمةً وعلماً؛ إلا أنه وضّح أنّ الاستغفار يكون للمؤمنين، ولهذا بدأ بالاستغفار للمؤمنين ثم ذكر منتصف الآية أنّه وسع كل شيء رحمة وعلماً ثم كرّر الأمر من جديد أنّه يغفر للمؤمنين؛ فالدعاء اقتُصر على من آمن به واتبع سبيلهم حتى يقيهم الله عذاب الجحيم، وبهذا تدعو الملائكة الذين يطوفون حول عرش الرحمن، فقد قال جلّ جلاله: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ}.
- الوجه الخامس:
ليس صحيحاً قول أحدهم: “أنَّ معنى قوله تعالى: {فسأكتبها} هي الرحمة الخاصة تفريعا من رحمته العامة، وليس تخصيصا لرحمته العامة”.
بيانه: أنّ رحمة الله العامة الشاملة لكل من في الكون هي من قضاء الله وقدره الكوني القدري؛ وهي من صفات أفعاله التي لا علاقة لنا بها؛ أمّا رحمته بالمؤمنين فهي الرحمة الدينية الشرعية التي بها يرحم، وبها يدعو الخلق لبعضهم بالرحمة.
ثم إنّ الرحمة التي وسعت كل شيء هي التي يتراحم بها الخلق فيما بينهم؛ والتي يرحم بها عموم عباده في الدنيا وليس معناها أنَّه سيرحم الكافرين في الآخرة؛ فإنَّ الرحمة التي كتبها على نفسه خصّ بها أهل الإيمان خلافاً لغيرهم.
يقول العلاّمة الطاهر بن عاشور: “التَّفْرِيعُ فِي قَوْلِهِ: فَسَأَكْتُبُها تَفْرِيعٌ عَلَى سعَةِ الرَّحْمَةِ، لِأَنَّهَا لَمَّا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ مِنْهَا مَا يُكْتَبُ أَيْ يُعْطَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِلَّذِينَ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِمُ الصِّفَاتُ وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ وَعْدًا لِمُوسَى وَلِصُلَحَاء قَوْمِهِ لتحَقّق تِلْكَ الصِّفَات فِيهِمْ، وَهُوَ وَعْدُ نَاظِرٍ إِلَى قَوْلِ مُوسَى إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوب فِي فَسَأَكْتُبُها عَائِدٌ إِلَى رَحْمَتِي فَهُوَ ضَمِيرُ جِنْسٍ، وَهُوَ مُسَاوٍ لِلْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْجِنْسِ، أَيِ اكْتُبُ فَرْدًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ لِأَصْحَابِ هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكْتُبُ جَمِيعَ الرَّحْمَةِ لِهَؤُلَاءِ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي الِاسْتِعْمَالِ فِي الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَجْنَاسِ، لَكِنْ يُعْلَمُ مِنَ السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الرَّحْمَةِ نَوْعٌ عَظِيمٌ بِقَرِينَةِ الثَّنَاءِ عَلَى متعلقها بِصِفَات توذن بِاسْتِحْقَاقِهَا، وَبِقَرِينَةِ السُّكُوتِ عَنْ غَيْرِهِ، فَيُعْلَمُ أَنَّ لِهَذَا الْمُتَعَلِّقِ رَحْمَةً خَاصَّةً عَظِيمَةً وَأَنَّ غَيْرَهُ دَاخِلٌ فِي بَعْضِ مَرَاتِبِ عُمُومِ الرَّحْمَةِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ: وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدْ أَفْصَحَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى الْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ فِي آخِرِ الْآيَةِ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”.
- الوجه السادس:
أنَّ دعوى التفريق بين الرحمة والاستغفار لمن مات من الكفار؛ لا حجّة فيها؛ لأنَّ الرحمة أوسع من المغفرة فهي مغفرة وزيادة؛ ونحن حين نقول عن الكافر إذا مات: اللهم ارحمه؛ كان ذلك دعاءً له بدخوله في رحمة الله وهي جنّته، لأنّ الرحمة هنا لا تتناول رحمة مخصصة بل رحمة عامة، ولهذا حين نسأله تعالى رحمته نطمع بها كاملة؛ وقد قال تعالى:{وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنّه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثمّ تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم}.
ثمّ إنه يحق أن نسأل: ما معنى قولك: رحمه الله؟!
هل معناها: أدخله الجنة؟
فإن كان كذلك؛ كان هذا تكذيباً لصريح القرآن الكريم.
وإن كان معناها: خفّف عنه من العذاب الذي سيصلاه في نار جهنم؟ فإنَّه دعاءٌ ليس فيه إلا انتقال من دركة من العذاب إلى أخرى؛ فهل هذه الرحمة المطلوبة من الداعي حين يقول: اللهم ارحمه أي خفّف عنه العذاب بدلاً من أن يذوق الزّقوم ليشرب نار السّموم؛ فهل هذا هو التخفيف المرتجى من الداعي؟!
إنَّ الرحمة ضدّ العذاب؛ ولهذا من رُزِق الرحمة فقد صُرّف عنه العذاب؛ فالله تعالى يقول: {مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚوَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ}، وقال تعالى: {وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚوَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚوَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقد جعل الله محلَّ رحمته الجنّة فقال: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ}.
ولا يمكن أن تكون النار محل رحمة الله؛ بل إنّها محل عدل الله؛ ويدلُ عليه الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: “احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها” لهذا لا نجد في النار رحمة بل نجد فيها العذاب، ولا نجدها قد قُرنت في كتاب الله برحمة؛ بل الذي ذُكِر فيها مغاير للرحمة، فكان في الدعاء للكافر بالرحمة بعد موته فيه تجرؤ على مقام الإلهية.
- الوجه السابع:
إنَّ من الملاحظ أنَّ من أكثر الناس رحمةً بأولاده ورغبة في إنجائهم من الدخول في عقيدة الفكر والضلال؛ نوحٌ عليه السلام فإنّه رُغم معاناته مع ابنه وحثّه على الدخول في الإسلام؛ مازادته نصيحة أبيه إلا كبراً وعناداً؛ ولهذا يُخبر القرآن أنّه: {قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ} وقد أجابه والده: {قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ} ولكن الموج كان أقوى فحال بينهم وغرق ابنُ نوحٍ عليه السلام.
من هنا أتت عاطفة الأبّوة، وحضرت لحظة الخشية عليه من عذاب الله فقال تعالى: {وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ}.
فتأمل الآية تُدرك أنَّ نوحاً عليه السلام أدرك أنّ ابنه ليس من أهله؛ وأنَّه لا يجوز أن يسأل ربّه شيئاً ليس له به علم؛ لأنّ المتصور ذهناً أنّ نوحاً عليه السلام كان يسأل راجياً ربّه أن يدخل ابنه في رحمته، وأن يُنجيه من العذاب.
قال الشيخ محمد رشيد رضا ” وهذا النهي يدل على أنه يشترط في الدعاء أن يكون بما هو جائز في شرع الله وسننه في خلقه، فلا يجوز سؤال ما هو محرم وما هو مخالف لسنن الله القطعية بما يقتضي تبديلها، ولا تحويلها وقلب نظام الكون لأجل الداعي، ولكن يجوز الدعاء بتسخير الأسباب، وتوفيق الأقدار للأقدار، والهداية إلى العلم بالمجهول من السنن والنظام، مع ما يؤدي إلى ذلك من الأعمال – كما فصلناه من قبل”.
وقد أحسن قبله ابن عجيبة في تفسيره عند قوله تعالى: {ما كان للنبي والذي آمنوا أن يستغفروا للمشركين} فقد قال: ” والشفقة مطلوبة، ما لم يظهر مراد الله من خلقه، فإن برز من عنصر القدرة شيءٌ من القهريات فالتسليم لمراده تعالى أحسن، فالله أرحم بعباده منك أيها الشفيق”.
وبعد هذا كلّه فإنّ الله تعالى قد خاطب نوحاً عليه السلام بخطاب الحزم والفصل النهائي: {إنه ليس من أهلك} {إنه عمل غير صالح} {فلا تسألن ما ليس لك به علم} {إني أعظك أن تكون من الجاهلين} قال القرطبي: “فمن فعل ذلك كان من الجاهلين وقيل: المعنى أرفعك أن تكون من الجاهلين. قال ابن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلين , ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين” ومن هنا استعاذ نوحٌ بربّه وأدرك أنّه يخشى أن يسأله رحمة ابنه ورجا منه أن يغفر له ويرحمه على ما جرى منه من دخول في التحكم بما قضاه وقدّره وخشي على نفسه أن يكون من الخاسرين بسبب ذلك!
- الوجه الثامن:
جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بلفظ: اجتمع المسلمون واليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشمته الفريقان جميعا، فقال للمسلمين: “يغفر الله لكم، ويرحمنا الله وإياكم” وقال لليهود: “يهديكم الله، ويصلح بالكم”.
وفي حديث أبي موسى قال: “كان اليهودُ يتعاطسون عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يرجونَ أنْ يقولَ لهم: يرحَمُكم اللهُ فيقولُ يَهْدِيكم اللهُ، ويُصْلِحُ بالَكُمْ” [ أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح].
وجه الدلالة: يُنظر إلى المغايرة بين دعاء رسول الله للمسلمين ودعائه لغيرهم فللمسلمين الدعاء بالمغفرة والرحمة ولليهود بصلاح البال في الدنيا والهداية لهم.
ومن التأويل العجيب قول أحدهم معلقّاً على الحديث السابق وأنّه صلى الله عليه وسلم كان يقول لليهود:”يهديكم ويصلحُ بالكم”، أي يدعو لهم بالهداية وإصلاح البال، وهذه أعظم رحمة ممكن أن تتنزل على إنسان. وغني عن البيان هنا أنّ المسألة المطروحة تتعلق بطلب الرحمة لغير المسلم بعد موته، وليس عند حياته.
بل هذا الكلام يُبطله الحديث نفسه؛ فإنّ اليهود كانوا يريدون التعرُّض إلى دعاء رسول الله بالرحمة؛ ومع ذلك ما كان يحب أن يدعو لهم بذلك؛ بل يدعو لهم بما هو أنفع لهم وهو هداية الله تعالى لهم؛ على الرغم من أنَ الدعاء للكافر في حال حياته بالرحمة جائز؛ لكن رسول الله دعا لهم بما هو أنفع لهم؛ فكيف يُقال: إنَّ الدعاء لهم بالرحمة بعد وفاتهم أدعى لأن تكون جائزة، فبما أنّه لم يدع لهم في حياتهم مع جواز ذلك؛ دلّ ذلك على أنهم إن ماتوا على ما هم عليه فلا يُدعى لهم بالرحمة.
وإنَّ مما يجانب التحقيق العلمي في هذه المسألة أن يُقال: إنَّ الهداية من الرحمة؛ وأنها أعظم رحمة ممكن أن تتنزل على إنسان؛ فكأن الشيخ في هذا لا يُريد أن يثبت معنى خاصاً للرحمة رُغم أنّه قدح بالعلماء الذين منعوا الترحم والاستغفار بدعوى أنّهم لم يُفرّقوا بينهما؛ وكلامه كما سيأتي غير صحيح بل إنّهم قد فرّقوا بين معنى الرحمة والاستغفار؛ لكننا نجده هنا لم يُفرق فرقاً واضحاً بين الهداية والرحمة حيث اعتبر أنَّ الهداية أعظم رحمة؛ وعلى هذا الأساس نقول: وإنَّ الاستغفار كذلك لهم أعظم رحمة؛ فما الذي يمنع من هذا بما أنَّ معنى الرحمة صار عاماً يشمل كل ما يُمكن ادّعاء أنّه رحمة.
- الوجه التاسع:
أنَّ عادة العلماء والمفسرين عموماً منذ القِدَم أنهم يجمعون بين الرحمة والاستغفار؛ إذ بينهما عمومٌ وخصوص وجهي، وربما إذا حضر أحدهما تضمن معنى الآخر؛ ولم نجد منهم ذلك التفريق بين الاستغفار والترحم إذ هو من بابة واحدة ولهذا قال ابن رشد في البيان والتحصيل:” فليس تحظير الدعاء للميت الكافر، والترحم عليه، والاستغفار له، لقوله عز وجل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} [التوبة: 113]- الآية – بالذي يمنع من تعزية ابنه المسلم بمصابه به”.
- الوجه العاشر:
أنَّ دعوى بعضهم بجواز الترحم على أموات الكفار وأنها من باب الحقيقة اللغوية البحتة التي تحمل معنى الإحسان إليهم، أو من باب الحقيقة العُرفية حيث يُقصد بها دمج الصف ووحدة الكلمة تجاه المعتدين والمحتلين والمحاربين والبر والقسط مع المسالمين من غير المسلمين؛ فإنّ الاحتجاج بهذه الحجة لا تقوم لها قائمة؛ فإننا نتعبّد ربّنا بما فرضه علينا من مصطلحات شرعيَّة.
إنَّ الحقيقة الشرعيّة تُقدَّم على الحقيقة اللغوية أو العرفية، والحقيقة الشرعية متعلّقة باللفظ المستعمل فيما وُضع له أولاً في الشرع؛ فحين نتحدث عن الرحمة لن تكون متعلقاتها كما يريد أن يوهمنا بعضهم بأنّها مغايرة للمعنى الشرعي.
وإن من الخطأ أن نجعل الأحكام الشرعية التي لها خصوصياتها في الاستعمال واستقلاليتها في الاصطلاح؛ يُمكن للغة أن تكون مستقلّة بمعانيها؛ فقد نبّه الأصوليون أنّه: “لا مدخل للغة في الأحكام الشرعية”.
- الوجه الحادي عشر:
أنَّ من تبنّى جواز الترحم على أموات غير المسلمين، وحرَّم الاستغفار لهم، قد وقع في عدة تناقضات:
- التناقض الأول:
أنّه يرى أنَّ المغفرة من الرحمة، وأنّه يُسلّم بأنَّ الرحمة معنى أشمل من المغفرة، وأنَّ كل مغفرة فيها رحمة؛ فإذا كان كذلك فإنّه قد نازع في شيءٍ يُقرُّ أساساً بكونه يشمل ما حُرّم قوله؛ فما الذي يُجيز أن يستغفر لغير المسلمين إذا ماتوا، ولا يُجيز له أن يترحم عليهم؛ بل إن الاستغفار سيكون أضبط لأنّه معنى أضيق من الرحمة؛ أمّا سؤال الرحمة فإنّه ولابد أن يشمل قدراً من الاستغفار لأنّه يتناوله.
- التناقض الثاني:
أنَّ الرحمة أصل معناها اللغوي يدل على الرقة والعطف والرأفة؛ ومع صرف النظر إلى وجود مثل هذه المعاني في حق الله إذ لا يُوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؛ ولا يُشبهه أحد؛ فإنَّ هذه الرحمة عند من يقول بالترحم معناها في الآخرة إحسان وتلطف وتخفيف للعذاب؛ وهذا يُناقض آي القرآن فقد نفى تعالى فيها تخفيف العذاب عن غير المسلمين؛ لأنّه تعالى لا يتعامل مع الكافرين في الآخرة إلا بميزان العدل؛ فكلٌ منهم يأخذه قسطه ونصيبه من العذاب الذي قدّره الله؛ ويبقى في هذا الجحيم إلى ما شاء الله.
- التناقض الثالث:
أنَّ قياس الرحمة الأخروية بالرحمة الدنيوية؛ إن هو إلا قياس مع الفارق؛ وفيه خلطٌ باستجلاب أحكام الدنيا إلى أحكام الآخرة، ونحن نعلم أنّ الآخرة لها أحكامها وميزانها وحسابها ورحمتها وغضبها وموضع الرحمة وموضع الغضب؛ فلا مجال للقول بأنَّ الرحمة في الآخرة تكون من باب تقريب الصورة كحال القاضي يكون الحكم سبع سنوات ثم يجعله خمس سنوات، بخلاف المغفرة للمحكوم عليه بأن لا يُصدر في حقه حكم بل يعفو ويصفح ويرأف به؛ فهذا خطأ في التصور وبناءُ علمي على غير إحكام؛ لأمرين:
- أنَّ قياس الوقوف بين أمام الله تعالى وأمام القاضي قياسٌ مع الفارق؛ فلا يمكن أن تكون موازين الدنيا مثل موازين الآخرة، ولا تُقاس أفعال البشر بأفعال رب البشر، وأفعال ربّ البشر من الغيب الذي لا نعرفه فكيف يليق بنا أن نقيس أفعالنا عليها.
- أنَّ الجاني أو المجرم يقف ويطلب الاسترحام في قضيته؛ خلافاً لمن للكافر الذي مات على كفره فنحن لا نعرف إن كان سيطلب أو لا، بل الأدلة أوضحت أنّهم لا يُخفف عنهم العذاب.
أمّا البناء المُحكم فإنّا نجد أنَّ المغفرة تسبق الرحمة إن قُرنت معها؛ والآيات طافحة بذلك؛ بل كلّها على تقديم الغفور على الرحيم، والمغفرة على الرحمة؛ في قرابة خمسين موضعاً في القرآن الكريم؛ إلا في موضعٍ واحد، فمثلاً من ضمن المواضع التي قُدّم فيها الغفور على الرحيم قوله تعالى: {وَإلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} ومنها قوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمينَ} وهذا لا يدل إلا على أنّ المغفرة تسبق الرحمة؛ إذ هي مسح الذنوب ومحوها التي تجعل النفس مستحقة لإرادة الإنعام ودخول الجنة.
وقد ذكر جمعٌ من العلماء منهم الزركشي، وابن القيم، والسماكي فيما نقله عنه ابن عرفة عن سبب تقديم الغفور على الرحيم في قوله تعالى:{غفور رحيم}؛ فقالوا: ” لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة”.
ومن نظر في أقوال المفسّرين المتعلقة بشأن الرحمة والمغفرة؛ أدرك تماماً أن تفسيرهم كان مغايراً للتفسيرات العصرية التي تزعم أنّ الرحمة تخفيفٌ من العذاب؛ وأنَّ الرحمة عندهم متعلّقها دعاء المسلمين ربّهم بعد سؤاله المغفرة.
حيث يقول الطبري إمام المفسرين: “قوله: “واغفر لنا“، يعني: واستر علينا زلَّة إن أتيناها فيما بيننا وبينك، فلا تكشفها ولا تفضحنا بإظهارها……ثم قال: القول في تأويل قوله: {وَارْحَمْنَا} يعني بذلك جل ثناؤه: تغمدنا منك برحمة تنجينا بها من عقابك”.
وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا}:” والمغفرة أن يستر عليه جرمه صونا له من عذاب التخجيل والفضيحة….وارحمنا طلب للثواب الجسماني”؛ فمن خلال كلامه يتضح أنَّ المغفرة طلب الستر، وأن الرحمة طلب الثواب.
وقال ابن كثير: {وَاعْفُ عنَّا} [البقرة: 286] أي: فيما بينَنا وبينك مما تَعلَمُه من تقصيرنا وزللنا، {وَاغْفِرْ لَنَا} [البقرة: 286]أي: فيما بَينَنا وبينَ عبادِك، فلا تظهرْهم على مساوينا، وأعمالنا القبيحة، {وَارْحَمْنَا} [البقرة: 286] أي: فيما يُستقبَلُ؛ فلا توقعنا بتوفيقِك في ذنب آخر.
أمّا الآية الوحيدة التي قُدّم فيها الرحيم على الغفور فهي الواردة في سورة سبأ؛ ومن ذلك قوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ}، وهي التي قال عنها الإمام ابن القيم: “وأما قوله: {وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ}؛ فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة: فإما بالفضل والكمال وإما بالطبع لأنها منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم والعموم بالطبع قبل الخصوص كقوله: {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}، وكقوله:{وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ}
وقال الزركشي:” وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله هذا الغفور ثم لأنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم وهو قوله: {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ} فالرحمة شملتهم جميعا والمغفرة تخصهم والعموم بالطبع قبل الخصوص”.
- الوجه الثاني عشر:
أن المنع من الدعاء للكافر بالترحم عليه والاستغفار له؛ لا يمنع أن يكون الله قد أثابه على ما فعله من خير في الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح:” وأما الكافر فيُعطى حسناته في الدنيا؛ حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة” [أخرجه مسلم في صحيحه].
وثمّة قولٌ آخر لبعض العلماء أنه ينتفع بعمله الصالح في الآخرة حيث يجري التفاوت بينهم من العذاب في دركات النار ؛ لحديث ابن مسعود – رضي الله عنه -، عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: “ما أحسن محسن من مسلم، ولا كافر إلا أثابه الله ” قال: فقلنا: يا رسول الله، ما إثابة الله الكافر ؟ قال: “إن كان قد وصل رحما، أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك”، قال: فقلنا: ما إثابته في الآخرة ؟ فقال: “عذابا دون العذاب” [ أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه”].
قال البيهقي في ( البعث والنشور): “الأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر، ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات”.
- الوجه الثالث عشر:
أنَّ القائلين بتحريم الترحم يُدركون الفرق بين الرحمة والاستغفار، وقد أعطوا لكلٍ منهما معنى يخص به؛ فلا يصح الادعاء عليهم أنهم جعلوه واحداً، وهاهم علماء التفسير الذين مزجوا تفسير القرآن بذكر غريب اللغة بيّنوا الفروقات بين الترحم والاستغفار، ولم يجدوا دليلاً يدل على جواز الترحم فقط، وقد بيّنت شيئاً من ذلك فيما سبق.
أمّا ما قاله أحد المشايخ الذين يرون جواز الترحم على من مات من غير المسلمين؛ إذ إنّه وصف العلماء أنهم يقولون الشيء ولا يُدققون به، وأنهم يتوسعون في كلامهم؛ فإنَّ هذا لا يليق أن يصدر عن الشيخ؛ فالعلماء الذين يتحدث عنهم هم كافّة الفقهاء والمفسرين والمحدثّين وغيرهم ممن منع الترحم والاستغفار، وهم من أكثر الناس عناية بلغة القرآن، ولغة العرب، ولا يُوازى علم أحدنا بعلمهم جميعاً؛ فكيف يُطلب من عموم الناس في عصرنا أن يدققوا في الألفاظ والشيخ يعلم أنّهم لا يمتلكون ملكة أو ذائقة لغوية؛ ويُنفى عن هؤلاء العلماء التدقيق في الكلمات والمعاني؛ وهم أهل النظر والحظوة في المسائل العلمية؛ فمن الذي يُدقق إن لم يُدقق العلماء؟!
مناقشة احتجاجات من يتزّعم الدعاء بالرحمة والمغفرة للأموات من الكفار
فيما يلي مناقشة بعض الاحتجاجات التي يحتج بها من يُجيز الدعاء لمن مات من الكفار بالرحمة أو بالمغفرة، وسأجملها على النحو الآتي:
- الاحتجاج بقول الله تعالى: {وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرا}
نصُّ الآية: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} إذ يحتج بعضهم على أنَّ الآية فيها دلالة على جواز الدعاء للأبوين عموماً بالرحمة؛ فقد يكون الأب كافراً ويُدعى له بالرحمة.
وما هذا الاستدلال إلا انتزاعٌ احتياجي للتبرير بطريقة باطلة إذ في اقتطاع للآية من سياقها؛ فإنّ الآية واضحةٌ في أنّ قضاء الله الذي أمر به ووصّى شرعاً وديناً ألا يُعبد إلا هو، ومنه نفهم أنَّ المسلم يُفرّق بين البر وحسن الصلة، وما يتعلّق بأسس الاعتقاد؛ فإنّ دعاء الولد لأبويه بالرحمة ليس إلا إذا كانا مسلمين فحسب، وأمّا غير ذلك فليس لهما الدعاء بالرحمة والاستغفار، وإنما الزيارة لقبرهما، وإكرام صديقهما، ولهذا وجدنا أنّ الله قطع الصلة بين إبراهيم ووالده ومنعه من الاستغفار له.
ولأنَّ الأمر متقررٌ في ذهن الصحابة؛ فإنّه قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} وأياً ما كانَ النسخ المقصود به إن كان مخصصاً فيكون مراد ابن عبّاس أنّه خاص بالوالدين المسلمين؛ أو كان منسوخاً بمعنى أنّه حكمٌ قد زال تقريره إلى حكمٍ آخرٍ يليه؛ فإنّ هذا واضح في قطع الصلة بالدعاء بالترحم للأبوين إذا ماتا كافرين، على أنّ ترجيح معنى كونه منسوخاً بمعنى أنّه مخصص هو الأقرب للآية؛ إذ هو الفهم الصحيح المتبادر لكلّ مسلمٍ يقرأ القرآن ويفهم الخطاب الخاص بالمؤمنين والخطاب الخاص بالكافرين، وبهذا تبقى في الآية معاني الاحتجاج بها.
وثمّة معنى آخر تزعّمه الصحابي الجليل ابن عباس؛ حيث قال: “كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فأمسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا”، ويُحتجُّ عليه بقوله تعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} والمعنى واضح أن المصاحبة في الدنيا بالمعروف تنتهي بانتهاء حياة الكافر، ولعل من حسن الصحبة أن يستغفر لهما ما داما على قيد الحياة؛ وهو الفعل الذي كان يفعله رسول الله حتى طُلب من المنافقين أن يستغفر لهم رسول الله في حياتهم ورفضوا كما أخبر تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ}، وهي الدعوة التي طلبها صالح من قومه أن يستغفروا ربهم في حال حياتهم: {قال يا قوم لِمَ تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم تُرحمون • قالوا اطَّيَّرنا بك}.
وعلى ذلك تقررت أقوال الفقهاء؛ فلقد قال القرطبي مُعلّقاً على قوله تعالى: {رب ارحمهما}: ” فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيين، كما تقدم. أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك، لا رحمة الآخرة”.
وقال في الفواكه الدواني: “والحاصل أنَّ حرمة الاستغفار للكافر بعد موته مجمعٌ عليها ولو للأبوين”.
وفي شرح سيدي زروق على الرسالة: “وأشار بالاستغفار لأبويه المؤمنين إلى أنَّ الكافرين لا يستغفر لهما لقوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}”.
وفي الشرح الصغير على أقرب المسالك عند ذكر الدعاء في التشهد: ” ولوالدينا: يعم كل من له عليك ولادة” قال الصاوي في الحاشية:” أي ممن مات على الإسلام؛ فيُلاحظ الداعي ذلك لقوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}.
وقال الهيتمي في (تحفة المحتاج):” ويحرم الدعاء بأخروي لكافر وكذا من شك في إسلامه ولو من والديه”.
وقد سئل ابن تيمية عمّن ترك والديه كفارا ولم يعلم هل أسلموا، هل يجوز أن يدعو لهم؟ فأجاب: “متى كان من أمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر لأبويه، إلا أن يكونا قد أسلما، كما قال تعالى: “مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ“.
- الاحتجاج على جواز الاستغفار لمن مات كافراً بقصة إبراهيم.
يزعمون أنَ إبراهيم مُنع من الاستغفار لوالده لأنّه تبيّن له أنّه في النار، بإخبار الله له.
وهذا المعنى غير صحيح فهو مثل قوله تعالى في سورة هود: {حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ} فهو ممن سبّق عليه القول بكفره وعدم إيمانه؛ ومن مات كافراً يُتعامل معه على حسب ما مات عليه.
وقد قرّرنا سابقاً أنَّ الكافر في حياته قد يُدعى له بما يُرتجى منه الرحمة والمغفرة له؛ لكن إذا مات فقد انقطع ذلك؛ فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: مات رجل نصراني فوكله ابنه إلى أهل دينه فذكر ذلك لابن عباس فقال ما كان عليه لو مشى معه ودفنه واستغفر له ما كان حيا ثم تلا قوله تعالى: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه}.
والدعاء بالرحمة للكافر حال حياته أن يُوفّق للإسلام؛ كي تُغفر له ذنوبه، ويكرمه الله برحمته، وليس معناه أن يلقى الله كافراً فيرحمه ربه، أو أن يغفر الله له حال شركه؛ ذلك أنّ الله تعالى لا يغفر لهم.
من هنا نفهم سبب قول إبراهيم عليه السلام – {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}؛ فإنَّ هذا دالٌ على أنَّ يوفقهم للتوبة والرجوع لأحكام الإسلام، ولهذا قال ابن القيم: {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ولم يقل ” فإنك عزيز حكيم ” لأن المقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي: إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة كما في الحديث: (اللهُمَّ اِغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) “
- الاحتجاج بقول أحد الأنبياء: ” اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون”، وقد كانوا كفّاراً.
روى عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ يحكي نبيًّا من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ضربه قومه فأدمَوْه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون. [متفق عليه]، واحتجوا به على جواز الدعاء للكفار بالمغفرة.
وليس هذا إلا في حق المشرك أو الكافر ما دام حياً أما إذا مات فقد انقطع عنه الرجاء؛ وهو مع ذلك مُقيّد كما قال الإمام ابن حبان في صحيحه تعليقاً على حديث سهل بن سعد عند قوله -صلى الله عليه وسلم- “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون”: إذ قال: “معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لما شج وجهه أي اغفر لهم ذنبهم في شج وجهي، لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقا”.
وقد حمله بعضهم على معنى آخر نبّه عليه الإمام ابن حجر؛ فقد قال:” المراد بالمغفرة: العفو عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم كلها، لأن ذنب الكفر لا يمحى، أو اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، أو المعنى اغفر لهم إن أسلموا”.
وقال القرطبي: “الاستغفار للأحياء جائز لأنه مرجو إيمانهم، ويمكن تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدين”.
وقال العيني في شرح حديث (اللهُمَّ اِغْفِرْ لِقَوْمِي) معناه: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة ؛ لأن ذنب الكفر لا يُغفر، أو يكون المعنى: اغفر لهم إن أسلموا”.
- احتجاج بعضهم بقوله تعالى: {ويستغفرون لمن في الأرض}.
يقول تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} فمن يجيز الاستغفار للكفار الأموات يقولون: في الآية دلالة على الاستغفار لغير المسلمين ممن هم في الأرض.
وهذا الفهم غير صحيح؛ والواجب الجمع بين النصوص حال وجود تشابه فيها حتى يُرجع فيها إلى المحكم؛ والمجمل إلى المُبيّن.
إنَّ احتجاجهم بالآية: {ويستغفرون لمن في الأرض} لا يصح؛ لأنّ الآية هذه قد وضّحتها آية أخرى؛ وهي قوله تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم} ففي هذه الآية بيانٌ أنَّ من تستغفر لهم الملائكة في الأرض إنما هم أهل الإيمان بالله، ويؤكده تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عبّاس حيث فسّر آية: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرْضِ} بقوله: “ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان به” وعن السديّ, في قوله: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرْضِ} قال: “للمؤمنين” وهو الذي قرّره الطاهر بن عاشور في تفسيره ثمُّ قال: ” ولما كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كما تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ هم في عذاب خالد فلا حاجة إلى تخصيص عموم كل شيء بالنسبة إلى سعة الرحمة بمخصصات الأدلة المنفصلة القاضية بعدم سعة رحمة الله للمشركين بعد الحساب”.
- الاحتجاج بدعاء إبراهيم وعيسى لقومهما:
يحتجُّ المجيزون بقول إبراهيم عليه السلام: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ويقولون: فهذا أبو الأنبياء يطلب المغفرة والرحمة للكفار؛ لأنّ من اتّبعه كان من المؤمنين؛ وسؤاله لهم المغفرة والرحمة دالٌ على أنَّه يقصد به الكفار لا أهل الكبائر.
ويحتجّون كذلك بقوله تعالى: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖوَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} ويرون أنَّ المسيح عيسى بن مريم يستغفر لمن يُحتمل عليهم العذاب لأنّه لا يعلم نتيجة مصيرهم؛ فهذا يدل على جواز الاستغفار والترحم؛ لأنّه لو كان المسيح يعلم تحريم ذلك ما قال: {وإن تغفر لهم} رُغم أنّ بعض قومه ادّعوا فيه الألوهية.
والجواب على ذلك في عدّة نقاط:
- أنّ استغفار إبراهيم وعيسى لقومهما؛ ما كان ليحصل في حال وفاتهم، فكلّ الأدلة شاهدة منتهضة على أنّه يقصد الأحياء منهم؛ وقد قرّرنا جواز الدعاء للأحياء من الكفار بالرحمة والمغفرة ليخرجه الله من الكفر إلى الجنّة.
لهذا قال ابن جرير الطبري أبو جعفر إمام المفسّرين في قوله تعالى: {وإن تغفر لهم} أي: ” بهدايتك إياهم إلى التوبة منها، فتستر عليهم ” فإنك أنت العزيز ” في انتقامه ممن أراد الانتقام منه، لا يقدر أحدٌ يدفعه عنه “الحكيم”، في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة، وتوفيقه من وفَّق منهم لسبيل النجاة من العقاب”.
- أنَّ سياق الآية في قول عيسى ابن مريم دالٌ على عدم جواز الدعاء لموتى الكفار بالرحمة والمغفرة؛ لأنّه تعالى قال: {فإنك أنت العزيز الحكيم} ولم يقل: “فإنك أنت الغفور الرحيم” قال القرطبي: “على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره، والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه وذلك مستحيل ; فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك، وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله; تضل من تشاء وتهدي من تشاء”.
- أنّ القرآن الكريم بيّن وقوع فئة من قوم عيسى بالشرك حين اتخذوه إلهاً، وحكم بكفرهم، وبيّن أنَّ المسيح قد خاطبهم بعدم دخولهم في رحمة الله فقال: {لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسِيحُ ابنُ مَريَمَ وَقَالَ المَسِيحُ يَا بَنِي إِسرائيلَ اعبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم إِنَّهُ مَن يُشرِك بِاللَّهِ فَقَد حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ وَمَأوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ}.
- أنَّ المراد بقوله: {وإن تغفر لهم} لا يدل على جواز الدعاء لهم في آخرتهم بالرحمة والمغفرة؛ بل يدلُّ على أنّهم يُسلّمون أمرهم إلى الله في الآخرة؛ فالأمر كلّه بيد الله؛ فالله تعالى قد يغفر ويرحم لعلمه التام بأحوال كلّ فئة ممن غفر لهم ورحمهم؛ لا أنَّ هذا دالٌ على أنّه يجوز لنا أن نطلب من ربّنا الرحمة والمغفرة لهم؛ فهذا لا يجوز لنا؛ لكنه جائز في حقّ الله تعالى، وفرقٌ وأي فرقٍ بين القرار الربّاني في الشيء، وبين الدعاء الإنساني للشيء؛ فالدعاء له محدّداته ومقوّماته وحدوده فلا يجوز التجاوز من البشر في حقّ ما أمرهم به ربّ البشر؛ فإنّ الله تعالى كما أخبر عن نفسه: {لا يُسال عمّا يفعل وهم يُسألون} وقال كذلك: {وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخِيَرة} وقال: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} وقال كذلك: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين}.
وممن أشار إلى هذا المعنى طائفة من المفسّرين منهم ابن جزي الغرناطي؛ فإنّه في تفسيره لقول عيسى: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم}؛ قال رحمه الله: “المعنى تسليم الأمر إلى الله، وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه، لأن الخلق عباده، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار، وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته، وفرق بين الجواز والوقوع”.
وقال ابن كثير: “هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله، عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله، وعلى رسوله، وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا”.
وقال البغوي: قوله تعالى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فإن قيل كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار، وكيف قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا لا يليق بسؤال المغفرة، قيل: أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الإيمان وهذا يستقيم على قول السدي: إن هذا السؤال قبل يوم القيامة لأن الإيمان لا ينفع في القيامة.
وقيل: هذا في فريقين منهم، معناه: إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن آمن منهم.
وقيل: ليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو كان كذلك لقال: فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكنه على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده”.
حكم القطع والجزم بمصير الكافر الأخروي والشهادة عليه بأنّه في النار
إنَّ تحريم الدعاء بالرحمة لمن ظهر لنا أنّه مات على كفره؛ لا يلزم منه القطع والجزم وحسم القول بأنّه في النار؛ فالقول المعتبر في عقيدة أهل السنّة والجماعة أنّه لا يجوز الشهادة لمُعيّن مات أنّه في الجنّة أو في النار؛ إلاّ ما جاء النص بالشهادة له، فالشهادة على مسلم مُعيّن بالجنّة يتقلّب في نعيمها، أو كافرٍ معيّن أنّه بالنار يتقلّب؛ فإنّ هذا ليس لنا، ولم نُكلّف معرفته، وهذا القول هو الذي عليه جماهير علماء المسلمين؛ لأنّ أحكام الآخرة عند الله تعالى.
وعلى ذلك الأدلّة النقلية والعقلية:
- حديث ابن مسعود أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “فإنَّ الرَّجُلَ مِنكُم لَيَعْمَلُ حتَّى ما يَكونُ بيْنَهُ وبيْنَ الجَنَّةِ إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عليه كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ النَّارِ، ويَعْمَلُ حتَّى ما يَكونُ بيْنَهُ وبيْنَ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عليه الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ” [أخرجه البخاري في صحيحه]
وجه الدلالة: أنَّه لا يُدرى بم يُختم للعبد من عمل؛ فقد نرى من نعتقده مسلماً ونرجو له الجنة؛ فيكون عند ربّه في النار، وقد يكون الشخص فيما نعتقد من ظاهر ديانته وعمله أنّه كافر ويُظنُّ دخوله إلى النار؛ فيكون من أهل الجنّة.
- أنه ثبت في الحديث الصحيح أنّ من يُقاتل الكفار ويُقتل؛ لا يُعيّن باسمه أنّه شهيد، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عُمر بن الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ، فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ “. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اذْهَبْ، فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ “. قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ.
وجه الدلالة: أنَّ رسول الله لم يعدّ من قُتل من المسلمين في أرض المعركة شهيداً؛ وخالف من حكم عليه بذلك؛ لوجود عملٍ أوبق شهادته في دنياه.
- عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن أمَّ العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ـ أخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم في السُّكنى، حين اقترعت الأنصار على سُكنى المهاجرين، قالت أم العلاء: فاشتكى (مرض) عثمان عندنا فمرَّضْناه حتى تُوُفِّيَ، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: رحمة الله عليك أبا السائب (كُنية عثمان بن مظعون)، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكِ أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه والله اليقين (الموت)، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يُفعل بي، قالت: فوالله لا أزكي أحداً بعده) [رواه البخاري في صحيحه]
وجه الدلالة: لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على قول أم العلاء رضي الله عنها: (رحمة الله عليك يا أبا السائب) إذ هو دعاء له بالرحمة، أما حينما قالت: (فشهادتي عليك لقد أكرمك الله)، وفي رواية قالت: (هنيئا لك الجنة يا أبا السائب)، اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: (وما يدريكِ أن الله أكرمه؟) ثم قال: (والله إني لأرجو له الخير).
يقالُ هذا في حقّ قتلى المسلمين على أيدي الكفرة أو الظالمين ومن الجدير بالذكر أنّه يوجد خلافٌ قوي في حكم التعيين والتحديد بأنّ فلان شهيد من المسلمين؛ فكيف يُجزم بأنّ النصراني حين يموت بأنّه شهيد؛ أو أنّه في الجنّة؟!
- أنَّ مِن القول على الله بلا علم أن يُشهَدَ أوْ يقال إنّ فلاناً في النار؛ أو أنّ الله لا يغفر لفلان، فهذه المسألة غيبية مدارها على قاعدة الإيمان بالأمور الغيبية، فعن جُندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنَّ رَجُلًا قال: واللَّه لا يغْفر اللَّهُ لِفلان، وإنَّ اللَّه تعالى قال: مَن ذا الذي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أنْ لا أغْفِرَ لِفُلانٍ، فإنِّي قدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ، وأَحْبَطْتُ عملك) [ أخرجه مسلم في صحيحه ].
قال النووي والقاضي عياض:” معنى (يَتَأَلَّى): يحلف، وَالْأَلْيَةُ اليمين، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها”.
ومن ثمّ فالمسلم لا يشهد على غيره في الآخرة، ولا يتدخل فيما بين العبد وربه في مصيره الأخروي.
- أنّه ثبت عن الصحابي الجليل ابن عباس حين تلا قوله تعالى:{النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم} قال: “إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، ولا ينزلهم جنة ولا ناراً”.
وروى أبو عبيد أنه قال: “اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أنَّ الشهادة بدعة، والإرجاء بدعة، والبراءة بدعة” قال ابن بطّة العكبري:” والشهادة: أن يشهد لأحدٍ ممن لم يأت فيه خبر أنّه من أهل الجنّة أو النار”.
ذلك أنَّ الله يعلم السر والجهر وأخفى، ويعلم ما تُكنّه الأنفس، فندع الأمر الأخروي في حقّ المُعيّن إلى الله تعالى؛ فهو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي يُدخل الجنّة ويُعذبّ في النار.
- أنَّ الحكم على المعين بالنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله -تعالى- وقد قال: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيبِ لا يَعلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحرِ وَمَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرضِ وَلا رَطبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)(الأنعام: 59) وقال تعالى: (عَالِمِ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشرِكُونَ)
- أننا لا ندري بماذا ختم لهذا المعين فلعله تاب إن كان مرتدا أو أسلم إن كان كافرا كما أسلم الرجل الذي قتله أسامة بن زيد -رضي الله عنه.
- أن من مات على الكفر قد يعذر بالجهل حيث لم تبلغه الرسالة، أو لوجود شكٍ في صحّة معتقد يحمله، كمن قال لأبنائه حرقوني وذروني فلو سمعه أحد الناس لحكم عليه بالكفر ولكن الله عذره، ولهذا يقول ابن تيمية: “وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني. ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت ؟ قال: خشيتك, فغفر له؛ فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذُرِيَ، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك”.
- إنَّ هذا التقرير الاعتقادي عليه جماهير علماء وفقهاء أهل السنة. فقد ذكر ذلك في عقيدة سفيان الثوري وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل المذكورة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي.
قال سفيان الثوري: “لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله وكلهم من قريش”.
وقال علي بن المديني: “ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح، ونخاف على الطالح المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل”.
وقال أحمد بن حنبل: “ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله”.
وقال أبو بكر الإسماعيلي: “ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت، أعلى الإسلام، أم على الكفر”.
وقال الطحاوي: “ونرى الصلاة خلف كل بَرٍّ, وفاجرٍ, من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا نُنزِلُ أحداً منهم جنةً ولا ناراً”.
ويقول ابن تيمية: “ولهـذا لا يشهــد لمعين بالجنـة إلا بدليـل خاص، ولا يشهـد علي معين بالنـار إلا بدليـل خاص، ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم؛ لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله تعالي: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8]”.
ويقول ابن تيمية: “فنقولُ بطريق العموم: المؤمنون في الجنة والكافرون في النار، ولا نُعيِّن أحدًا أنه في جنة أو في نار إلا أنْ نَعلَم عاقبته”.
- أنَّ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار؛ فإنّه لا يصح بل هو من مراسيل الزهري كما قال أبو حاتم الرازي والدار قطني.
- أنّ الله لا يُعذب أحداً دون قيام الحجّة عليه وسماعها وفهمها؛ لقول الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء:15]، ولقول الله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام:19].
يقول ابن القيم: “والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا ؟ فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه”.
وقال ابن القيم: ” قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أُخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبى هريرة وغيرهما”.
وقال ابن القيم: ” العذاب يستحق بسببين، أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل”.
الخاتمة والنتائج:
- جاءت النصوص صريحة صحيحة في المنع من الترحم والاستغفار على من مات من الكفّار؛ وحُكيت في ذلك إجماعات، وهو عمل كافّة علماء المسلمين.
- أن التفريق بين جواز الرحمة وتحريم الاستغفار لا أساس له من الصحّة؛ فإن النهي عن الاستغفار لمن مات من الكفار لم يُلجئ رُسُل الله صلوات الله عليهم وسلامه من قبل؛ ولا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولا صحابة رسول الله الكرام، أن ينتقلوا للترحم على من مات من أقاربهم ومعارفهم من الكفار؛ ولم يُنقل من ذلك شيءٌ.
- أنَّ الدعاء للكفار بالرحمة أو المغفرة من سبيل الاعتداء في الدعاء؛ ودخول في طلب شيءٍ لم يشرعه الله.
- أنّ مسائل العقائد لا مدخل للقياس فيها، وأن قضايا الأحكام الشرعية لا مدخل للغة بها لكي تستقل بأحكام خاصّة على غير ما اصطلح عليه شرعاً.
- إنَّ تحريم الدعاء بالرحمة لمن ظهر لنا أنّه مات على كفره؛ لا يلزم منه القطع أنّه في النار؛ إذ إن من معتقد أهل السنة أنّه لا يجوز الشهادة لمُعيّن مات أنّه في الجنّة أو في النار؛ إلاّ ما جاء النص بالشهادة.