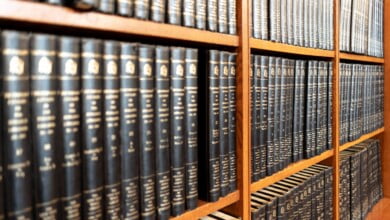أ.د عبدالله بن حمد السكاكر
(2) تحصيلُ العلمِ
قال الذهبي رحمه الله: قال السِّلَفي: «دخلت بغداد في الرابع والعشرين من شوال، فبادرت إلى ابن البطر، فدخلت عليه، وكان عسرًا، فقلت: قد وصلت من أصبهان لأجلك، فقال: اقرأ، ونطق بالراء غينا، فقرأت متكئًا من دماميل بي، فقال: أبصر ذا الكلب! فاعتذرت بالدماميل، وبكيت من كلامه، وقرأت سبعة وعشرين حديثا، وقمت، ثم ترددت إليه، فقرأت عليه خمسة وعشرين جزءا، ولم يكن بذاك» ا.هـ
والقصد أن طريق العلم لابد فيه من الصعوبات والمشاق، فلابد فيه من ترك المتع والراحات، وكد الذهن وتعاهد المحفوظات، وقد يحتاج الطالب للسفر والتغرب، والصبر على ضيق العيش، وقد يكون الأستاذ ضيق العطن، شرس الطباع وغير ذلك من الصعاب وما لم يكن بطالب العلم صبر على هذه المشاق فلن يبلغ مبتغاه، ولابد دون الشهد من إبر النحل، ومن أعظم مايستعين به طالب العلم على مشاق التعلم عون الله وفتحه ثم استطعام حلاوة العلم وتذكر حسن عاقبته في الدنيا والآخرة، قال رجل للإمام البخاري رحمه الله: يا أبا عبدالله يقال إنك تأكل الزبيب للحفظ؟
فقال: «يابن أخي إنما هي نهمة العلم».
ومن لم يذق ذل التعلم ساعة ذاق ذل الجهل إلى قيام الساعة.
ومن أجمل ما كتب في هذا الباب مما يحفز طالب العلم ويعيد شحن طاقته وشحذ همته للطلب وتحمل مشاقه كتاب (صفحات من صبر العلماء) للشيخ عبدالفتاح أبي غدة .
ومن وسائل تحصيل العلم:
لا يدور في ذهن كثير من طلاب العلم عند الحديث عن أهم أدوات طلب العلم إلا الأدوات المادية كالذكاء والحرص والدأب والمعلم الجيد ووفرة المراجع، ولا شك أن هذه أسباب مهمة لطلب أي علم من العلوم بيد أن علوم الشريعة تنفرد بخصائص لا يشاركها فيها غيرها، ومن أهم تلك الخصائص أنها علوم إلهية مصدرها وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله ﷺ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لتحصيل هذه العلوم أسبابا معنوية مع الأسباب المادية، ومن أعظم هذه الأسباب المعنوية: «التقوى وصلاح الباطن».
قال الله سبحانه وتعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ “ [سورة الأنفال:29].
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: «فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره، وُفِّق لمعرفة الحق من الباطل».
وقال ابن القيم رحمه الله: «ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم»
وقال سبحانه وتعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” [سورة الحديد:28]».
قَالَ مُجَاهِدٌ: «النور: هو الهدى والبيان، أي يجعل لكم سبيلا واضحا في الدين تهتدون به».
وقد فَهِم من ذلك أهلُ العلم أن التقوى وصلاح الباطن من أعظم الأسباب التي يُنال بها علم الكتاب والسنة، قرأ الشافعيُ على الإمام مالك عليهما رحمة الله فلما رأى مالكٌ فرطَ ذكائه قال له: «إن الله، عز وجل، قد أَلْقَى على قلبك نوراً فلا تطفئه بالمعصية».
وقال علي بن خشرم قلت لوكيع: «يا أبا سفيان، تعرف شيئًا للحفظ فإني بليد، قال: نعم، كان يقال: استعينوا على حفظ الحديث بترك المعاصي».
وقال الشافعي رحمه الله:
فَأَرْشَدَنِي إلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي | ||
وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ | وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي |
وكانوا إذا انغلقت عليهم المسائل فزعوا إلى التوبة والاستغفار، قال في الجواهر المضية: وَكَانَ الإِمَام أبو حنيفة رحمه الله إِذا أشكلت عَلَيْهِ مسألة قَالَ لأَصْحَابه: «مَا هَذَا إِلَّا لذنب أحدثته» وَكَانَ يسْتَغْفر وَرُبمَا قَامَ وَصلى فتنكشف لَهُ المسألة وَيَقُول رَجَوْت أَنِّي تيب عَليّ.
وقال ابن القيم رحمه الله: «وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار، والاستغاثة بالله واللجأ إليه، واستنزال الصواب من عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ، ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالا، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم».
ولعل طالبَ العلم يحصل له من إصابة الحق بصلاحه وتقواه ما لا يحصل له بذكائه وغزارة علمه قَالَ المروذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «عبد الوهاب الوراق: رجل صالح، مثله يوفق لإصابة الحق».
قال النووي رحمه الله: «مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيامًا» ا.هـ.
هذه الكلمة العظيمة لهذا الإمام الجليل تختصر درسا من أعظم الدروس التي ينبغي لطالب العلم المبتدئ والمنتهي أن يستوعبها ويستحضرها ويطبقها في مسيرته العلمية
إن مذاكرة الحاذق في الفن تشحذ الهمة، وتفتق الذهن، وتفتح مغاليق المسائل، وتقدح زناد العقل، وربما كان طالب العلم يرى رأيا فانكفأ عنه بعد مذاكرة حاذق في الفن، قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى:«ذُكر أن الشافعي وأبا عبيد رضي الله عنهما تناظرا في القرء فكان الشافعي يقول إنه الحيض وأبو عبيد يقول إنه الطهر فلم يزل كل منهما يقرر قوله حتى تفرقا وقد انتحل كل واحد منهما مذهب صاحبه وتأثر بما أورده من الحجج والشواهد» ا.هـ
وينبغي أن يعلم أن الحذق والمهارة مهمة في هذا الباب، فكلما كان طالب العلم أحذق كان الانتفاع به أعظم، ولا بد من استعمال الأدب أثناء المدارسة والمذاكرة لئلا يحرم الإنسان الخير بسوء أدبه، قال النووي رحمه الله وهو يبين آداب المذاكرة النافعة: «وليكن في مذاكراته متحريًا الإنصاف قاصدًا الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله مخاطبًا له بالعبارة الجميلة اللينة فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته» ا.هـ
إن أهل الفضل كصندوق أُغلق على جوهر وإنما يستنطف ما عندهم من العلم والحكمة بحسن الخلق، ولين الجانب، والإجلال، وحسن العبارة، والبعد عن التعالم، وسوء الأدب، فإذا انبسط لك فقيه فالزم غرزه فثمَّ الفقه، جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل، فبينا هو عنده، إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه، وتبعه فأبطأ، ويحيى جالس، فلما جاء قال يحيى:
«يا أبا عبد الله! كم هذا؟
فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة».
(التدريس أوسع أبواب طلب العلم) حفظت هذه المقولة أو نحوًا منها عن اثنين من كبار أهل العلم والفضل أما أحدهما فشيخي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، وأما الآخر فالشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان حفظه الله(15)، ثم درّست في الجامعة وخارجها فرأيت ما قالاه رأي عين.
إن طالب العلم إذا حصّل مفاتيح العلم، وآلة البحث فقد آن له أن يدخل للعلم من باب جديد هو باب التدريس، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتأخر في اقتحام هذا الباب بحجة أن هذا من التعالم، والتزبب قبل التحصرم، وربما تندر الناس بتمشيخه، فإن التدريس في هذه المرحلة مقصوده الأعظم التعلم والإتقان، أما التعليم ونفع الآخرين فتابع، ومداراة الناس ومحاذرة نقدهم في كل شيء قد تقطع عن كثير من الخير.
التدريس وسيلة من وسائل طلب العلم تنفرد بخصائص ومزايا لا توجد في غيرها من وسائل طلب العلم كحفظ المتون وقراءة الشروح على الشيوخ وحضور الدروس وحلق العلم، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
1- مساعدة طالب العلم على الالتزام ببرنامج يعينه على الاستمرار في طريق العلم وأهله.
2- مساعدة طالب العلم على تحقيق المسائل وتحريرها وفهمها فهمًا دقيقًا، فطالب العلم قد تمر به عشرات المسائل أثناء الحفظ أو حضور الدروس عند المشايخ دون أن تتحرر في ذهنه ومع ذلك يتجاوزها لكثرتها وضيق الوقت، وعدم الاضطرار لتحريرها، أما إذا كان مدرسا يريد بناء شخصيته العلمية ويحترم عقول طلابه فلن يلقي على طلابه مسألة لم تتحرر له ولو رجع إلى عشرات المراجع لتحريرها، وربما لم تحررها المراجع فإذا تدارسها مع طلابٍ نجباء تحررت وانجلى غامضها.
3- مساعدة طالب العلم على حفظ العلم وتثبيته واستحضاره، فإن الأستاذ إذا كرر الدرس مرة أو مرتين استظهره وكاد يحفظه، وكم من طلاب العلم من بلغ في العلم شأوًا عظيمًا لم يبلغه بقدرته على الحفظ ولكن بدأبه على التدريس حتى سبق في التحصيل والخير من هم أحفظ منه ممن لم يقوو على هذا الباب.
4- والتدريس يُكسب طالب العلم عددًا من المهارات كجودة اللغة وحسن المنطق والقدرة على إيصال المعلومة والتواصل مع المتلقين وكل ذلك لا يحصل بالطرق السابقة كالحفظ والتلقي.
ومما ينبغي الالتفات له أن ثمة أمورًا متى اجتمعت في التدريس كان أنفع وأجدى، وأكثر خير وبركة، ومتى نقص شيء منها نقص بقدره من الفائدة والأثر، فمن هذه الأمور:
ا- نجابة الطلاب، فمتى كان الطلاب نجباء كان الدرس أقرب إلى المذاكرة منه إلى التدريس، ولا يخفى ما في المذاكرة من النفع وفتح مغاليق المسائل.
ب- أن يكون الكتاب المشروح مخدوما بكتب تشرحه، وتزيل غامضه، وتخرّج أحاديثه، فهذا من أعظم العون بعد الله على فهم هذا الكتاب وإتقانه، كما أنه يسهل عملية التحضير والإعداد فلا تثقل الدروس أو تنقطع.
ج- الدأب على التدريس والاستمرار عليه، فإن التدريس شاق في بداياته، ومن لم يصابر نفسه عليه انقطع وحرم.
د- حسن الخلق مع الطلاب وتحمل ما قد يبدو من بعضهم من سوء أدب مرده إلى حداثة السن وقلة الخبرة، فما لم يكن الأستاذ لين الجانب موطأ الأكناف فإن الطلاب إما أن يَنْفَضُّوا من حوله، أو ينقمعوا عن المشاركة والمناقشة أثناء الدرس وبعده، فيخسر الأستاذ مذاكرة طلاب نجباء ربما فتحوا عليه ما استغلق، قال الذهبي رحمه الله: قال السِّلَفي: «دخلت بغداد في الرابع والعشرين من شوال، فبادرت إلى ابن البطر، فدخلت عليه، وكان عسرًا، فقلت: قد وصلت من أصبهان لأجلك، فقال: اقرأ، ونطق بالراء غينا، فقرأت متكئًا من دماميل بي، فقال: أبصر ذا الكلب! فاعتذرت بالدماميل، وبكيت من كلامه، وقرأت سبعة وعشرين حديثا، وقمت، ثم ترددت إليه، فقرأت عليه خمسة وعشرين جزءا، ولم يكن بذاك» ا.هـ
ه- التعامل مع إشكالات الدرس بإيجابية، بالتفاعل مع الطلاب في حل غوامض المسائل وفك ألغازها عن طريق البحوث والمراجع والسؤال والتدارس، فما تمر مسألة مشكلة إلا عالجوها حتى تنحل، قال الشافعي رحمه الله: العالم يُسأل عما يعلم وعما لا يعلم، فيثبت ما يعلم، ويتعلم ما لا يعلم، والجاهل يغضب من التعلم، ويأنف من التعليم ا.هـ
أما إهمال المسائل المشكلة، ومماطلة الأجوبة إلى آجال غير مسماة، وتسويف التحرير والتحقيق فإنه يورث حشدا من المسائل غير المحررة التي تشوش ذهن طالب العلم، وتمنع تحرير مئات المسائل المبنية عليها، وتذهب لذة العلم وبهاءه.
قال الشافعي رحمه الله: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به».
إن تلاميذ العالِم هم زينته وبهاؤه وأعظم استثماراته لو أجرى لهم الرواتب مع العلم الذي يبذله لهم لم يلحق لهم جزاء، فبهم تفقه، وبمذاكرتهم تفتحت له المسائل، وعبرهم انتشر علمه، وذاع صيته، وعلا في الناس ذكره.
إن العالم بلا طلاب كشجرة نبتت وماتت ولم ينتفع بها إنسان ولا حيوان.
فالطلاب هم من يحفز الفقيه إلى البحث والتفقه، ويراجعه لما استغلق من المسائل، وهم حملة علمه، وإنما ينتفع العالم بعلمه بأمرين: عمله به، وتعليمه للناس، والطلاب النجباء هم خير من يحمل علم الفقيه وينشره.
وقد كان أهل البصيرة من العلماء يحتفون بطلابهم جدا اعترافا بفضلهم ورجاء نفعهم بحمل العلم ونشره وهداية الخلق، قال الشافعي رحمه الله لأخص طلابه الربيع بن سليمان: يَا ربيع لَو أمكننى أَن أطعمك الْعلم لأطعمتك.
وروى في جامع بيان العلم وفضله عن الزهري قال: «كان عروة يتألف الناس على حديثه»
وكان سفيان الثوري يقول: «والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم يعني أصحاب الحديث»
وقال الربيع بن سليمان، كان الشافعي رحمه الله يملي علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس فمر به بعض إخوانه فقال: يا أبا عبد الله في الشمس فأنشأ الشافعي يقول:
أهين لهم نفسي لأكرمها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها
وينبغي للفقيه أن يتوسم في طلابه أهل النجابة والإقبال فيمنحهم مزيد اهتمام وعناية، ورب طالب استثمرت فيه فوجدته يوم القيامة في ميزانك أُمّةً.
يعتبر علم الفقه من أكثر علوم الشريعة ملامسة لحياة المسلم، فمن العبادات اليومية إلى العبادات الموسمية، إلى المعاملات التي يمارسها المسلم في يومه عدة مرات، بالإضافة إلى الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى الفقه في تنظيم علاقاتها وما يحيط بها، فضلًا عن أحكام الجنايات والديات والحدود والتعزيرات والأطعمة والأيمان والنذور والتقاضي، وهو ما يفسر الكم الهائل من الأسئلة الفقهية التي تُمطر بها برامج الإفتاء في القنوات والإذاعات والمواقع الألكترونية بالإضافة إلى ما يتلقاه المشايخ وأهل العلم مباشرة أو على هواتفهم الشخصية
وطالب العلم المبتدئ له نصيب وافر من هذه الاستفهامات فيما يخصه شخصيًّا أو يلقى عليه أو يسمعه، وهو في تعامله مع هذه الاستفهامات يسلك أحد طريقين:
الأول: طريقة التمرير للفتاوى الجاهزة، بالبحث عنها بسؤال المشايخ مباشرة أو عبر وسائل أخرى مما سبق ثم العمل بها أو تمريرها للسائل، وهذه الطريقة لا تكسب فقها، ولا دربة بحثية، وقصارى ما يستفيده طالب العلم بهذه الطريقة أن يكون محرك بحث جيد، ولو أن شابا أراد أن يتعلم النجارة فكل ما طُلب منه بابٌ أو نافذةٌ دل طالبَها على النجارين، أو اشترى له منهم بابًا أو نافذة لما تعلم النجارة أبدًا.
الثاني: أن يتعامل مع هذه الاستفهامات بطريقة إيجابية، فيبدأ البحث عن المسألة عبر المراجع الفقهية، ثم يقرأ ما كتبه أهل العلم بنفسية الباحث المتفقه، فهو لا يبحث عن الحكم فقط بل عن الحكم والخطوات التي سبقته، فأول خطوة يستفيدها دربة البحث عن عين المسألة المطلوبة في مظانها من كتب الفقه القديمة والحديثة حسب المذاهب المعروفة، يتلو ذلك حسن التصور للمسألة محل البحث وتخليصها مما يختلط بها مما يخالفها في الحكم وهو ما يسمى بتحرير محل النزاع، وبعد ذلك الاطلاع على أقوال أهل العلم في المسألة، وسبب الخلاف إن وجد، ثم التعرف على أدلة كل فريق، ما يسلم منها من المناقشة وما لا يسلم، وثمرة الخلاف إن كان له ثمرة، ومتى مر الباحث بهذه الخطوات بنفسية فاحصة ناقدة متحررة لا تعطي القداسة لغير الدليل والحق فإن الترجيح سيحصل له تلقائيا.
إن التعامل مع هذه الاستفهامات بهذه الطريقة، والدأب على هذا المنهج مع ما فيه من مشقة وصعوبة في بادئ الأمر لهو كفيل بإذن الله أن يخرج فقيها متمرسا خبيرا بمذاهب الفقهاء وكتبهم ومناهجهم في الاستدلال وإقامة الأدلة، وفي المناقشات ونقض الأدلة، كما سينمي الحس الفقهي الذي يقرأ مذاهب الفقهاء ومآخذهم الفقهية قبل الاطلاع عليها بمعرفة أصول كل مذهب وقواعده، وهو ما يسهل على الفقيه التخريج والقياس على أصول كل مذهب.
لقد سلك هذه الطريقة بعض طلاب العلم فأفلحوا وتفقهوا ووصلوا، وسلك الطريق الأولى كثير من طلاب العلم فتحولوا إلى عوام لا يعرفون إلا هواتف أهل العلم، وعناوين مواقع الفتوى، وشتان بين حامل فقه وفقيه!
اطلع على المقالة السابقة : فقه النفس (١)
اطلع على المقالة التالية : فقه النفس (٣)