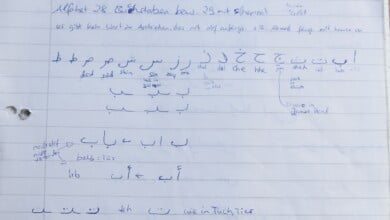- ليلى محمّد العمودي
ترغب هذه المادة في التشديد على خصوصيّة الهجرة الحضرميّة، لا يعود ذلك لمنطلقات عاطفيّة/جهويّة، إنما لحقائق واقعيّة أثبتت نفسها دون عناءٍ ودون تعصّب وربما وراء هذين السرّيْن يكمن السبب في التجاهل المستمرّ والمستغرب لهذه الهجرة المهمّة دينيًّا وعربيًّا، لقد مثّلت ليونة المُهاجِر والمُهاجَر إليه عاملًا أوليًّا في هذا الذوبان صعب الاكتشاف والتمييز، كما يقول أحد مهاجري الشرق الآسيوي، حين سأل (الإعلامي عبد العزيز النهاري) عضو البرلمان الإندونيسي السيد شيخ الجفري عن سبب عدم وجودِ رفضٍ للهجرة الحضرميّة من قبل السكان الأصليين، أجاب: “الشعب الإندونيسي كما قال لك أخي عبد الرحمن العطاس شعب طيب، والعرب أيضًا كانوا على نفس القدر من الطيبة والألفة والاحترام للمجتمع الذي انتقلوا إليه…” تشير بعض المراجع العربية للوجود الحضرمي في إندونيسيا بـ “عرب إندونيسيا”، معَ أنّ المهجر الشرق آسيوي كان حضرميًّا خالصًا، عكس الهند –على سبيل المثال- والتي ضمت حضارمة وجنسيات عربيّة أخرى، أو الشرق الإفريقي حيث كان هناك تواجدٌ حضرميّ ممتد وراسخ، غير أنّ ذلك لا يلغي الوجود العربيّ فيها أيضًا، مع أنهم امتازوا بالأسبقية، “يذكر المؤرخون قدوم أربعة وأربعين عربيًا من حضرموت إلى بلاد الحبشة، حيث قاموا بالدعوة إلى الإسلام مستغلين الخلافات المذهبية بين المسيحيين بالحبشة وذلك عام 833 هـ 1430 م، كما دخلوا كذلك إلى بلاد الصومال، وكان وصول هجرة الحضارم إلى شرق إفريقيا قبل وصول العُمانيين بنحو ثمانين عامًا”.
اعتدنا ربط مصطلح “شتات” بعرقيات وجهويات أخرى، بينما لو جرّدنا مشاعرنا الأوليّة من هذا المصطلح، لحمل أكثر مما يحمل. في المقابل، قد ينفر بعض الحضارمة من هذه التسمية –لارتباطها في الذاكرة بطائفة محددة- ويكتفون بـ (الهجرة) و(الغربة)، وبإعمال الملاحظة، وجدتُ أنّ بعضهم لا يجد حاجة في استخدام مصطلح (الهجرة)، خاصة حين يغتربون في أراضٍ عربيّة! لذلك لن أُعير رغبتهم أيّ اهتمامٍ في تسمية وتوصيف الوضع الحضرميّ. ومع وجود التطابق الحرفي لعناصر تعريف الشتات على الحضارم بقيَ هذا المصطلح قليل الاستخدام في الدراسات والمواد التي تناولت الهجرة الحضرمية –مع قلتها أصلًا-، جاء في كتاب (الحضارم في المحيط الهندي.. تحرير د. فريد العطّاس، ترجمة د. عبد الله الكاف) ما يصف بعدلٍ الأمر في شرق آسيا: “في حقيقة الأمر إن ما يمكن أن يقال عن المجتمع الحضرمي في جنوب شرق آسيا أنه يشكل بحق “شتاتًا”” حيث أنّ “هناك تعريفًا أوسع للشتات يشمل الخصائص الآتية:
- تشتت من المركز الأصلي.
- ذاكرة جماعية أو أساطير من الوطن الأصلي.
- الشعور بالتهميش وبالغربة في البلد المضيف.
- صلة مستمرة بالوطن الأصلي طبيعيًا (بدنيًا) وانفعاليًا.
في حالٍ كهذه يمكن الحديث عن الشتات الحضرمي… الشتات الحضرمي يعد حالة مثيرة وهامة لمجتمع دولي ذاب في المجتمع المضيف لكنه احتفظ بهويّته الثقافيّة في نفس الوقت. الحضارم في مناطق الشتات لعدة قرون تزاوجوا مع المجتمعات الإندونيسية الملايوية دون فقدان إحساسهم بالهويّة الحضرميّة والسبب في ذلك أن هذه الهوية ليست ذات طابع وطني ولا عرقي، لكنها مبنية على النسب وصلة القرابة. أي إن مكانة الهويّة الحضرميّة ليست مسألة رابطة لغة، بل إنها مسألة نسبٍ وأصلٍ وانحدارٍ أسريّ يشكل أساسًا لنوعٍ حضرميٍّ فريد من الشعور الجماعي (العصبية)”
-أوّل خطوة خارج حضرموت-
تتفق جميع المراجع التي وثّقت الهجرة الحضرميّة، أنّها فعلٌ قديم، قد تختلف الظروف، والأسباب، والوجهات، لكنّ الفعل لا يختلف: هجرة دائمة، هجرة متّصلة. وقد تنوّعت مطارح الهجرة، فشملت، إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، والفلبين، (الشرق الأقصى لآسيا)، أيضًا الهند. وإثيوبيا، وكينيا، وإرتيريا، وزنجبار (تنزانيا)، وجزر القمر، والصومال، والسودان، (شرق إفريقيا)، وكذلك مدن الحجاز تحديدًا مكة وجدة. وارتبطت الهجرة الأخيرة بالخليج العربي، مع تجارب قليلة في تركيا الآن، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. يقول (المهندس بشر النهدي) في مقالته عولمة الحضارم ما بين الاستثمار والتوطين أنّ الهجرة الأولى للحضارم كانت في القرن الأول قبل الميلاد، وكانت إلى الحبشة، مع امتدادٍ للشرق الإفريقي، و”كانت هجرة استقرار وتوطن”. أما الهجرة الثانية، فكانت في القرن الخامس الميلادي، حينها “كانت حضرموت مركزًا اقتصاديًّا حيويًّا للتجارة بين الشرق والغرب وتحريك القوافل الحضرمية لتصدير البخور والبضائع الهندية”. يسمي النهدي فترة ما قبل فتوحات الإسكندر المقدوني الأكبر بالعصر الذهبي للتجارة الحضرمية نظرًا لاحتكارها الطريق الوحيد إلى شرق آسيا، و”كان يمر عبر صحراء الربع الخالي وصولًا إلى موانئ جنوب شبه الجزيرة العربية، ومن ثم بحرًا إلى الهند والصين”. أما في سنغافورة وأوّل وصول حضرميّ إليها جاء في كتاب (حضرموت والمهجر): “وصل الحضارم إلى سنغافورة قبل وقت قصير من استيلاء رافيلز Raffles على هذا الموقع الاستراتيجي عام 1819م”.
لَطالما احتلّت إندونيسيا بقعة خاصة في وجدان الحضارمة، وكانت كالأصل الذي يُعاد إليه كُلّ شيء، بل وتقوم أحيانًا مقام التدليل على حضرميّة هذا الشخص! إندونيسيا التي نحبّ أن نندهها بـ “جاوا”، كانت علامة الجودة في كل المهاجر الحضرميّة، وفيها أرسى هذا الإنسان معالم هُويّته الجديدة، وكما يقول (الكاتب عمار باطويل) في روايته سالمين: “جاوة خطفت قلوب الحضارم”. ارتبطت إندونيسيا بالبحر، مغامرته، وموته، ومداه الواسع والمظلم، معَ ذلك وصلوا، واستمروا في الهجرة، وعنها يقول (الإعلامي عبد الرحمن الشبيلي) في مقالته هجرات الحضارم والعقيلات ورحلاتهم-نموذج لتنقلات أهل الجزيرة العربية عبر القرون: “لا توجد معلومات مؤكدة عن بدايات الهجرات الحضرمية إلى أرخبيل الملايو، لكن من المرجّح أن تكون بدأت في أثناء القرن الثالث الهجري (الثامن الميلادي) وهناك كتابات تذكر أن هجرات الحضارم بدأت تتجه شرقًا نحو الهند ومنها إلى بلاد الجاوة قبل ظهور الإسلام”. وجاء في كتاب التاريخ والمؤرخون الحضارمة من القرن السادس حتى القرن التاسع الهجريين عن وسيلة الهجرة: “بدأ الحضارم هجرتهم إلى الجزر الإندونيسية عبر المحيط الهندي بمراكبهم الشراعيّة من البحر العربي وأصبح لهم وجود في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما تأسست في بعض الجزر سلطنات صغيرة تحت رئاسة أمراء من بعض العائلات الحضرمية، وكان السادة العلويون من أوائل المهاجرين إلى هذه الجزر قبل وصول الهولنديين إليها…”
ما يصب في تأكيد فرديّة المهجر الآسيوي عند الحضارم، ما ذكره (د. خالد حسين سعيد الجوهي) في دراسته: المجاورون الحضارم في الحرمين الشريفين ودورهم في الحياة العلمية من القرن السابع حتى القرن التاسع الهجري من أنّ هناك أمورًا تخصّ المهجر الحجازي وتفصله عن بقية المهاجر، يقول: “لم يُنشئ الحضارم في الحجاز أنظمة حكم سياسية مستقلة، عكس ما هو موجود في البلدان الأخرى التي هاجروا إليها مثل شرق إفريقيا وإندونيسيا ماليزيا، حيث أسسوا حكومات ودويلات يرأسها السادة العلويون الحضارم”، في المقابل يقول مدافعًا عن الحراك العلمي والمجتمعي الذي أحدثه الحضارمة في الحجاز: “لم يكن ذووا الأصول الحضرمية في مجتمع الحجاز فئة خاملة الذكر غير مؤثرة في محيطها، بل كان على العكس من ذلك إذ كانت لهم علاقات مميزة مع أركان الحكم والزعامات الدينية والسياسية في الحجاز، كما كانت لهم مراسلات تكاد لا تنقطع مع السلاطين العثمانيين وأمراء مكة، ومن الطبيعي أن هذه العلاقة “لم تكن دائمًا بصورة حسنة بل شابها في بعض المراحل التاريخية حالات من التوتر والصراع”. وعن الوجود الحضرمي في مدن الحجاز جاء في كتاب (حضرموت والمهجر): “ومنذ عام 1916م… اعتبرت الجالية الحضرمية في جدة طائفة، ويُقصد بها: مجتمع منظم له نظمه الخاصة المحددة به، وتقاليده، تحت سلطة الشيخ التي تقرها الحكومة. كتب (كيستيان سنوك هرخرونيه)، يقول: “إن طائفة حضرموت موجودة منذ وقت طويل، وطبقًا للمصادر العثمانية والأوروبية –كما هو حال المصادر المحلية- فإن شيخ الطائفة اعتاد أن يمثل الحضارم في المدينة”. فيما يتعلّق بالمهجر الحجازي، فإن الارتباط كان قديمًا وراسخًا، وله علاقة بالدين الإسلامي، يقول (إيان ووكر) بترجمة (محمد سالم قطن): “ويمكن لنا بكل سهولة القول بأنّ الوجود الحضرمي في السعودية قد سبق بفترة زمنية طويلة عصر الطفرة النفطية فيها. فكثير من العائلات الحضرمية أرست وجودها في جدة قبل تأسيس المملكة على يد (الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932م). وكان الحضارم يمارسون التجارة من خلال البحر الأحمر إلى حضرموت وعبر المحيط الهندي. وصنعوا لأنفسهم فرصًا معيشة موفورة عن طريق بيع السلع وتقديم الخدمات للحجاج الذين يأتون إلى هذه البلاد المقدسة في مواسم الحج. فالحج إلى مكة هو واحد من الأعمدة الخمسة للإسلام المطلوبة من كل مسلم قادر عليها. وجدة هي بوابة مكة، لكل القادمين عبر البحر، وما أكثرهم. وهكذا ظلت جدة سوقًا تجاريًا كبيرًا له نفس جاذبية الأماكن المقدسة المجاورة له”.
ويؤكد (كازوهيرو آراي-أستاذ في جامعة كايو باليابان) في كتاب حضرموت والمهجر أنّ جنوب شرقيّ آسيا ومع وقوعِ كل تلك الاضطرابات السلبيّة سواء عند استقلال بلدان الشرق الآسيوي والتبعات السلبية على المهاجرين الحضارم، والعودة الاضطراريّة للديار الحضرميّة، أو مع الظروف المعقدة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، -أنه- بقيَ محافظًا على مطرحه في قلوب الحضارم. يقول آراي: “أحاول هنا أن أبرهن أن جنوب شرقي آسيا أثبت –رغم هذه التطورات- أنه الإقليم الذي ظلّ مهمًّا بالنسبة إلى الحضارم”
هذا المدى الشاسع والرحب الذي منحته إندونيسيا لمن حلّ بها من الحضارمة كان السرّ خلف خصوصيّة المهجر الآسيوي-الجاوي عن غيره من المهاجر تحديدًا العربيّة منها، أيضًا هذا الارتباط العميق، الذي وجد سبيله حتى للهُويّة الشكليّة للإنسان الحضرمي، واستمرار العلاقة، واصطباغها بصبغة دينيّة/صوفيّة، كُل ذلك –وغيره-، ساهم في تعزيز هذه الخصوصيّة ودواميّتها.
وفيما يتعلّق بسبب اختيار وجهة محددة، يحيل بعض الباحثين ذلك لأسباب التنشئة الأولى، حيث يقول (إيان ووكر) في كتاب حضرموت والمهجر أن “الذين يأتون من الساحل يميلون إلى السفر بحرًا”، و”يبدو أن الأُسر من وادي دوعن كانت تميل أكثر إلى التجمع في شبه الجزيرة العربية”. لا يعني ذلك وجود قاعدة أبديّة، فبعض أبناء الوادي نجدهم في آسيا وإفريقيا أيضًا، معَ ذلك هيَ إشارة مهمة، قد يستدعي موضوعها بحثًا ومتابعة.
أما الأستاذ (ستيفن ديل) فيذكر في معرض حديثه عن الهجرات الحضرميّة ضمن مؤتمر حركات الهجرة الحضرمية في المحيط الهندي ما بين الأعوام 1750 و1967م –والذي عُقد في بريطانيا برعاية مركز دراسات الشرق الأوسط/معهد الدراسات الشرقية والإفريقية جامعة لندن-، يذكر أن “الهجرات الحضرمية قد بدأت قبل بزوغ الإسلام، واشتدّت في القرن التاسع الميلادي وأقيمت مستوطنات زاهرة للحضارم لشراء التوابل والأقمشة”.
بالرغم من كل ذلك.. لم تنقطع الصلات، بقيت تجري مجرى الدم، أشار لذلك البروفسور (إنغسينغ هو Engeseng Ho) رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة هارفارد في كتابه (قبور تريم) حين قال: “الحضارم صاهروا المجتمعات المحلية التي هاجروا إليها وأسسوا مناطق حكم، ومجتمعات ترتبط ببلدهم الأمّ عبر صلة الدم، وكان ذلك عبر قبيلة (كِندة) في نجد وقبيلة (الصدف) في البحرين، واستطاعت بعد ذلك أجيالهم عبر الثقافة الاجتماعية وعلم الاقتصاد في التجارة من إنشاء مجتمعات تمتد عبر بحر العرب إلى آسيا وإفريقيا”. يقول (لايف مينجر-أستاذ علم الإنسان الاجتماعي في جامعة بيرجن) في كتاب حضرموت والمهجر: “في مسار عملي على تاريخ هجرة الحضارم أدهشني هذا المدى، وكذلك استمرار الروابط بين التجمعات، وهي روابط تعود إلى أقدم فترات الهجرة”.
ويذكر (فاروق لقمان) في مقالته: الحضارم رواد الهجرة عبر عدن إلى الهند الأثر الديموغرافي والاجتماعي الذي أحدثه حضارمة الهند فيها: “ومنها –يعني الأسر الحضرمية- من تزاوجت مع الأهالي الأصليين مثل آل كويا وكوّنوا طبقة جديدة من سكان ملبار عُرفت بالمابيلا وأخرى بالبرديسي، وهي كلمة هندية أصيلة تعني الغريب أو المهاجر”. إلا أنّ الهند لم تكن قوية الحضور كما إندونيسيا: “لم يكن الوجود الحضرمي في الهند بالقوة التي كانت لإخوانهم في الجزر الإندونيسية من حيث القوة الاقتصادية والسياسية”، ومع ذلك فهي تضم جالية حضرمية واسعة وممتدة، ومتجذرة الارتباط، حتّى الآن، تحديدًا في حي باركاس-حيدر أباد ولا تزال الدكاكين التجاريّة تحمل أسماء الحضارمة، والبيوت كذلك لا زالت تُنسب لعائلاتها الحضرميّة، وما اختفاءُ اللغة العربيّة بين مهاجري الهند إلا دليل على وجود أجيال متعاقبة من الحضارمة فيها، ومع أنّ الإشارة هنا للمهجر الهندي قصيرة جدًّا إلا أنّ ذلك لا يعني تقليلًا من حجم الجالية الحضرمية هناك، أو تهميشًا لحقيقة الانصهار، بل –في حقيقة الأمر- يستدعي ذلك الوجود قراءات متجددة، وكتابات مطوّلة، ودراسات رصينة، فهو على علاقة بتفاصيل الحياة هناك، ومنذ القدم، في السياسة، والاقتصاد، وحتى في التاريخ المجتمعي لحضرموت نفسها، فقد ادّعت إحدى الهويات العربيّة هناك نسبتها لحضرموت، وليست صادقة في ذلك، بل يعود الأمر للبسٍ في انتساب البعض لحضرموت، سواء بفعل الاحتلال البريطاني، أو بفعل الاضطرابات الداخليّة وعمليات الثأر في المحيط المجاور لحضرموت
-تجربة الثّورة في المهجر-
للدلالة على أنّ الاحتلال الهولندي لإندونيسيا حين جاء لم يُفرّق بين إندونيسي وحضرمي في قسوة المعاملة، بل شعروا بالقلق تجاه الوجود الحضرمي، يقول (د. خالد حسين سعيد الجوهي): “تعددت الجاليات المهاجرة إلى إندونيسيا من صينيين وهنود ويابانيين وأوربيين وغيرهم، إلا أن الجالية الحضرمية أكثر الجاليات ارتباطًا بالشعب الإندونيسي مما جعل السلطات الهولندية تنظر إليها بحذر وتعدها خطرًا يهدد وجودها، وبالتالي عملت على تشديد إجراءاتها القانونية، مثل قانون الإقامة والتنقل الذي ينص على وجوب إقامة كل المهاجرين القادمين من خارج الأرخبيل الإندونيسي في أماكن محددة داخل المدن الرئيسية، كما نص قانون التنقل على أنه لا يمكن السماح لهؤلاء المهاجرين بالانتقال من مدينة إلى أخرى إلا بموجب إذن مرور يتم الحصول عليه من السلطات الاستعمارية الهولندية”، ولم يقف الحضارم موقف المتفرجين من الظلم الاستعماري، بل كانوا ثوّارًا في وجهه، برفقة أبناء الأرض، فقد أفرز حراك الاستقلال مزيجًا فريدًا، ووحدة لم تكن لتوجد بالشدة، إنما جاءت أُلفةً ومحبّةً وضرورة يتطلبها السياق، وإيمانًا بواحديّة المصير، يُكمل الجوهي مستتبعًا الأحداث: “واستمرت هذه السياسة المناهضة للعرب الحضارم طويلًا حتى قلّت تدريجيًا مع ظهور حركة عرب إندونيسيا وكفاحها مع بقية أبناء إندونيسيا ضد هولندا، ثم انتهت بدخول اليابان إلى إندونيسيا إذ شارك المهاجرون في الثورة ضد اليابان وحتى استسلامها للحلفاء في عام 1365هـ/1945م”.
ينفي ذلك مزاعم البعض حين يدّعون حصول علاقات ودية بين حضارمة إندونيسيا والاحتلال الهولندي؛ إذ لو كانت العلاقات منفرجة بين الطرفيْن ما حصل هذا التضييق، بل الأصلُ هُنا هو الفعل الذي يُصدره حضارمة تلك المهاجر والحال أنهم وقفوا مع الثورة وكانوا جزءًا أصيلًا منها، في مشهدٍ جدير بالتوقف عنده، إذ يحلو للبعض التشكيك في انتماء المهاجر ومدى قدرته على استيعاب المواقف الوطنيّة الفاصلة في أرض هجرته، كالثورة هُنا. ولم يكن وقوف الحضارمة وقوفًا اعتباطيًا ولا “غشيمًا”، أو مسايرة للجوّ الثوريّ. على العكس، كانوا مدركين لأبعاد المشهد السياسي، وصراعاته المتداخلة التي تجعل من البعض أحيانًا يظهر بمظهر المتناقض/المتلوّن، فجاء الرفض الحضرمي للمحتل الهولندي مساويًا ومتماثل المبدأ لرفضهم المحتل الياباني، وقد مثّل الأديب الكبير علي أحمد باكثير هذا الوعي خيرَ تمثيل في مسرحية “جنة الفردوس”، وأيضًا في عمله “ذكرى من الشرق الأقصى” حيث كانت سنغافورة مسرحًا للأحداث، والزمن: قبيل إعلان الحرب العالمية الثانية على اليابان. وكذلك في بقية أعماله الأدبية والشعرية، وكم كان المشهد حنونًا من أعلى حين تزوره حضرموت وهو يناضل لأجل إندونيسيا. لقد قدّرت إندونيسيا ذلك، فحين توفي باكثير في آخر محطات هجرته: مصر، شيّعه سفيرها في مصر (أحمد يونس موكوجينتا) وقال في العزاء الذي فتحته السفارة له: “لقد فقدت إندونيسيا بوفاة الأديب الإسلامي الكبير علي أحمد باكثير مواطنًا مخلصًا، وأديبًا عملاقًا، ومناضلًا عنيدًا سخّر فكره وجهده وقلمه للدفاع عن حرية إندونيسيا واستقلالها، وهاجم المستعمرين بضراوة لم نرها عند أديب مثله رحمه الله”، وفي الذكرى الأربعين لوفاته قال كلمة جاء فيها: “ولو أرادت إندونيسيا في يوم من الأيام الاحتفال بالأدباء الذين حملوا عبء التعبير عن قضاياها وطموحاتها خلال فترة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال لكان علي أحمد باكثير في طليعتهم، إن لم يكن أولهم على الإطلاق…”، وقبل كل ذلك يقول (د. محمد أبو بكر حُميد) في كتابه إندونيسيا ملحمة الحب والحرية في حياة علي أحمد باكثير وأدبه أنّ الرئيس أحمد سوكارنو عندما زار مصر منح باكثير وسام الجمهورية للفنون والآداب “تقديرًا لنتاجه الأدبي الذي قدمه آناء الكفاح لأجل انتزاع حرية إندونيسيا واستقلالها”. لقد لبّت إندونيسيا كل اعتقادات الحضارم عن المهجر، لذلك حُملت لها كل مشاعر الحبّ، وكانت الأحقّ بها.
ولم يكن المهجر الإفريقي بعيدًا عن المدّ الثّوري، حيث “أسهم الحضارم في قيادة الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي التي كان من أبرز قادتها السيد محمد آل الشيخ أبو بكر بن علوي. كما مثل السيد أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العلوي جزر القمر نائبًا في البرلمان الفرنسي، ثم تولى رئاسة الدولة عام 1975، وأعلن استقلال بلاده من جانب واحد بعد أن طالت مفاوضات الاستقلال في فرنسا، غير أن فرنسا أبعدته عن الحكم ونفته إلى خارج بلاده، ثم اضطرت إلى إعادته والاعتراف باستقلال جزر القمر تحت ضغط الحركة الوطنية”، أما الهجرة الحضرمية لجزر القمر، فيقول عنها (عبد الباسط الغرابي) رئيس لجنة التراث المشقاصي أنها كانت في شكل مجموعات بشرية منذ القرن الـ 14 الميلادي. وحتى في إرتيريا التي حملت وضعًا معقدًا للحضارمة فيها، فبالرغم من الضغوط التي تعرضوا لها أثناء مرحلة ما قبل الاستقلال، إلا أنّ حضور بعضهم كان واضحًا وقويًّا ووطنيًّا، بل كان ذلك في مواقع شديدة الحساسية، كحزب الرابطة الإسلامية الذي كان يدعو للدولة الإرتيرية المستقلة مقابل دعوات حزبية أخرى للاتحاد مع إثيوبيا، وكان من مؤسسي حزب الرابطة الإسلامية (ياسين باطوق)، وبالتوازي كان محررًا صحفيًّا في جريدة الحزب، واسمها: “صوت الرابطة”.
لقد رست سفن الحضارم حتّى الفلبين، وهُناك أيضًا ناضلوا، أكد (فان دن بيرج) في كتابه الرائد “حضرموت والمستعمرات العربية في الأرخبيل الهندي”، أنه “بينما كانت السفن الحضرمية ترسو في الموانئ الفلبينية بين الفينة والأخرى، فإنه لم توجد أي “مستعمرة” قائمة هناك”. يُكمل: “وفي سلطنة كوتاباتو في مينداناو وُجِّهت مزيد من التهم “للأشراف” بأنهم يُذَكُّون نيران المقاومة ضد الإسبان”، أما فيما يتعلّق بالأمريكان، يقول: “واجه الأمريكيون صعوبات، خاصة في إخضاع شعوب ماراتاو حول بحيرة لاناو. وأشار مراقب بريطاني أن المنطقة يديرها السادة والوُعّاظ، وأنهم هم مثيرو الشغب الرئيسيون. وقد وُجّه اللوم إلى “الوعاظ العرب” للمرة الثانية بسبب إثارة الشغب في منطقة بحيرة لاناو عام 1905م”. ليس النضال وحده هو ما يثبت ارتباط الحضارمة بالأرض التي سكنوها، بل أيضًا الوجود المستمر، أو للاهتمام بالعلم والتعليم، فـ “الشيخ عمر باجنيد أصبح عام 1951م مديرًا للمدرسة الرشيدة في بانداج Pandag، بولوان Buluan في إقليم كوتاباتو…”
لكنّ الوجود الحضرمي في الفلبين ما زال كثيرهُ مجهول، وجاء في كتاب حضرموت والمهجر: “لقد فضّل كلا النظامين الاستعماريين استبعاد المهاجرين الحضارم، لكنّ الأمريكيين كانوا أقدر على تحقيق ذلك الهدف، وهذا معناه أن الحضور الراسخ للعائلات الحضرمية في تسعينيات القرن الماضي يستدعي سؤالًا عن الوقت الدقيق الذي استقروا فيه في البلد”. هذه المشكلة التّوثيقيّة ليست خاصة بالفلبين فحسب، بل تمتدّ لمهاجر حضرميّة أخرى منها إرتيريا، تحديدًا مصوع، “بينما وُجد بعض الحضور المستمر للحضارم في مساوى منذ القرن السادس عشر؛ فإنه بالكاد يوجد أي توثيق لهذا الوجود حتى منتصف القرن التاسع عشر”.
-الأثر والتأثير-
لقد كان للحضارم أسلوب معيشة خاص في المهجر، ساعد ذلك على تمييزهم عن بقية العرب الذين شاركوهم بعض المهاجر، كإفريقيا، يذكر (الصحفي جمال شنتير) في مقالته “نوبل الآداب تذكر حضرموت بابنها المهاجر” بعضًا من تلك الاختلافات: “نقل صالح علي باصرة رئيس جامعة عدن السابق عن المقيم البريطاني في زنجبار “أف بي بيرس” عام 1919 قوله عن الحضارم: “إنهم يشكلون قسمًا مهمًا من سكان زنجبار العرب، ويختلفون في مظهرهم وسعيهم للمعيشة وأسلوب حياتهم عن عرب عُمان، وفي الأحوال العادية في زنجبار هم عملًا أشِداء يعيشون في مساكن جماعية، وعلى الرغم من أن بعض الأثرياء منهم قد استقروا في زنجبار، فإن الغالبية يأتون لفترات يجمعون فيها بعض المال ليعودوا ثانية إلى بلادهم”. وحتى حين لا يعودون، تبقى الحبالُ ممتدة، فكما يعطون للوطن الأم يعطون للوطن المضيف، جاء في كتاب (حضرموت والمهجر) عن حضارمة كينيا: “وفي المحصلة، فإن الحضارم في كينيا كانوا ناجحين، سواء أكان ذلك من خلال أداء واجب ديني أو الإيثار؛ ذلك أن عددًا منهم موّل أعمالًا خيرية، فمحمد باوزير أوقف وديعة لم تقم بتمويل المشاريع في حضرموت فحسب؛ بل إنها شادت مدارس في مومباسيا أيضًا، واحدة منها يديرها الأزهر… كما أنها موّلت بناء مساجد في السودان وإندونيسيا وتنزانيا، كما ترسل أموالًا إلى الجاليات الحضرمية في المهجر، خاصة في جيبوتي، والأرباح من المدارس يتم إعادة تدويرها من خلال وقف يُموّل الصحة والتعليم”.
أما في إرتيريا، يقول (محمد بن سالم بن علي جابر): “وكان للحضارمة في إرتيريا دورٌ كبير في قطاع البناء، فقد عمّر محمد سليم باطوق 40 مبنًى في مصوع، ونحو 60 في أسمرة، وموّل أحمد عبيد باحبيشي، بين ثلاثينيات القرن الماضي وخمسينياته بناء عددٍ من المباني العامة والتجارية والسكنية في مدينة أسمرة”. وسواء في إرتيريا أو غيرها من المهاجر، حين يفعل الحضارمة ذلك لا يفعلونه من منطلق مادي بحت، أو من خلال مشاعر جوفاء، بل عن قناعة تامة، لم يجبرهم أحد، فعلوه وحسب.
يتحدث (عبد الباري طاهر) نقيب سابق للصحافيين اليمنيين في مقالته حضرموت الريادة عن دور الإنسان الحضرمي في مهجره الاسيوي تجاه المجتمع الذي صار جزءًا منه جسدًا وروحًا، وكذلك عن نظرته للأحداث السياسيّة العالميّة: “في قراءة عجلى للصحافة الحضرمية في المهاجر، يلاحظ اهتمام الإنسان الحضرمي المبدع والذكي بأحداث العالم: الحربين العالميتين، والدعوات المشروطة في تركيا وإيران، ودعوات الإصلاح، والاهتمام بالحداثة والتجديد. ولم يغب الحضرميّ عن النشاط التجاري والتنمية والبناء؛ فقد أسهم في بناء المدارس والجمعيات الخيرية والإحياء الديني، والحفاظ على اللغة العربية، وبناء الجسور مع الوطن العربي والعالم، ومتابعة قضايا فلسطين”، وتأكيدًا على واحديّة الموقف في المهجر والداخل في رفض المحتلّ، نورد قول عبد الباري طاهر من نفس المقالة: “وقف الحضارم ضد البرتغاليين والبريطانيين في موطنهم حضرموت. والشهداء السبعة تماثيلهم قائمة حتى اليوم. كما دافعوا عن تحرر واستقلال مهاجرهم في جنوب شرق آسيا، وشرق إفريقيا”.
ساعد الوجود في بيئة مغايرة لحضرموت، لتجاوز احتكار بيوت “السادة” للعلم، جاء في كتاب (حضرموت والمهجر): “لم يكتف الإرشاديون بتمويل فتح المدارس والأندية في حضرموت، ولكنهم أكدوا لخريجي مدارسهم في إندونيسيا أنهم سيديرونها كذلك، بل سوف يُدرِّسون فيها أيضًا. وقد هدف دعم فتح المدارس الجديدة في حضرموت إلى وضع نهاية فعلية لسيطرة جماعات السادة على واحد من أهم مواردهم، وهو: العلم”، من كان يدري مدى صعوبة وقوع هذا الحدث، أو العقود التي ستمر دون تحقيقه، والبقاء تحت “فضل” من يدّعي أنّ العلم وجد له فقط! لقد أحدثت الهجرة ثورة في النظام الطبقي الحضرمي، فهي “لم تكن محصورة قط في جماعة اجتماعية معينة، بل شملتهم جميعًا”. أما في مجال السياسة والتأثير الذي وصل حدّ التطرف جاء: “وثمة خاصية تثير الاهتمام ميزت الحركة القومية الحضرمية تمثلت في وجود مجموعة صغيرة (متطرفة) من الماويين بين صفوف مؤيدي الجبهة القومية للتحرير، ويميل البحّاثة في الحركات القومية للجنوب العربي إلى عزو مثل هذه النزعات إلى التأثير على موطن الأفكار التي تحفز المهاجرين وإلى الاتصالات بين الحضارم والحركات الراديكالية في جنوب شرقي آسيا وزنجبار”
في الشرق الآسيوي، تحديدا إندونيسيا، ما زال التأثير المتبادل مستمرًا، جاء في كتاب حضرموت والمهجر: “الإندونيسيين أحيوا عادة السفر إلى تريم للدراسة في معاهدها الدينية المهمة، محاكين بذلك الطريقة التي بعثت بها الأجيال السابقة من الحضارم أبناءها إلى أرض الوطن من أجل التعليم الديني”، ويقول (كازوهيرو آري) أنه “بالنسبة إلى المقيمين في إندونيسيا فإن حضرموت أصبحت مكانًا مألوفًا”. وتريم معقل علمٍ وعلماء منذ قرون خلت، ومن العزيز أنّ الهجرة أسهمت في إحياء وتثبيت دورها العلمي والديني.
يُحيلنا ذلك للحديث عن ديمومة الهجرة، حتى في حال توقفها، لقد دخلت واستقرّت الهجرة في كل منزلٍ وفي كل جيلٍ حضرميّ، الأمر الذي يُصعّب تجاوزها، أو التقليل من تداعياتها بمساوئها وإيجابياتها، بل يبدو أنه من المستحيل ادعاء “هُوية حضرميّة” دون ارتباطٍ بالهجرة والمهجر. نجدها حاضرة في مظاهر الحياة وتفاصيلها، في تصميم البيوت، في الملبس، وفي العادات، وفي الأكل، في الذاكرة الجمعية، في النظرة للحياة، وأسلوب الحياة، في تأخير تحقيق واقعٍ عادلٍ لحضرموت… وحتى في أسمائنا، وأشكالنا، ومعتقداتنا الدينية. حتّى صارت المسحة الآسيوية في وجوه الحضارمة شيئًا متعارفًا عليه، امتدّ العرق الشرق آسيوي، والهندي، والحبشي لشريحة واسعة من حضارم الداخل والمهجر، وإنني لا أحبّ فصل الحضارمة بقول “الداخل والخارج/المهجر” فجميعنا ندور في دوّامة الهجرة شئنا ذلك أم أبيناه.
لم يقتصر تأثير المهجر في الجانب المادي/الاقتصادي فحسب، بل كان له الدور المهم في التثقيف والتعريف بحضرموت، عربيًا، وإسلاميًا، وعالميًا، حيث يُعتبر كتاب (حضرموت والمستعمرات العربية في الأرخبيل الهندي) والذي كتبه فان دن بيرج، أحد أهم الكتب عن حضرموت، ويمثل مدخلًا لمعرفتها، تحديدًا لمن هم من خارج حضرموت، وفي ذلك يقول (كازوهيرو آري): “لم يكن ممكنًا لدراسة فان دن بيرج أن تظهر إلى الوجود لولا العلاقة الإنسانية القوية بين جنوب شرقي آسيا وحضرموت”.
لن تتطرق هذه المادة للبُعد الديني، أو الأثر الديني في معاقل الشتات الحضرمي من باب “أسلمتها”، سأتجاوز ذلك لأتحدث عن (الصوفية) –دون تعمّق- وأثرها المستمرّ حتى الآن، أحد الأمور التي تدلّ على استمراريّة ذلك، أنّ طلاب العلم ما زالوا يجيئون من الشرق الآسيوي إلى تريم، أحد أهمّ المدن الصوفيّة، وفيها يتلقون تعليمهم الديني، مع الأخذ بالاعتبار الوضع المحيط بجغرافيّة حضرموت، إلا أنّ وجودهم ما زال حاضرًا في تريم. بالانتقال لأرض المهجر، فإنّ التأثير الصوفي بلغ مداه، يقول (د. فريد العطاس) في كتابه سابق الذكر: “دخل الزفين جنوب شرق آسيا عن طريق الصوفيين والعلماء والتجار العرب القادمين من حضرموت قبل بضعة قرون. خلال تلك الفترة ظهرت أنواع (محلية) من الزفين في عالم الملايو-إندونيسيا في جنوب شرق آسيا بين غير العرب من السكان. حتى يومنا هذا وتوجد اختلافات فلسفية وثقافية بين الزفين بمفهومه الحضرمي، وهذا الزفين في صيَغهِ المحليّة في ثقافة جنوب شرق آسيا” . ومجيء الفعل الفعل الجديد، واستقراره، ومزاولته من قبل السكان الأصليين، ثم انصهاره في ثقافتهم، حتى خرج في “صيغ محلية” يدلُ بحقّ على مدى التأثير.
-براحُ المهجر.. وضيقُ الوطن-
في مقابل كل ذلك، مثّل المهجر للحضارمة فسحة فِكاك، وانطلاقة جديدة، وتغييرًا لأمورٍ حسبوها لِزامًا عليهم، ولم تكن كذلك، بل كان النظام المجتمعي الطبقي في حضرموت هو من أوجدها وعززها وأدامها، يقول (أ.د. مسعود عمشوش) في مقالته المهاجرون الحضارم في رواية سالمين: “في المهجر يبتعد الحضرمي عن بعض العادات التي يلتزمها في حضرموت، وذلك بسبب اختلاطه بحضارم من فئات اجتماعية أخرى أو بالسكان الأصليين. فحتى الأسماء، يختار المهاجر أسماءً من غير تلك الأسماء التي يختارها بني طينته في حضرموت التي يردد سكانها: “بعض الأسامي ما تجيب إلا المرض.. علوي في الضعفاء وفي السادة عوض”، ويذكر الراوي حمد بن صالح: “جلستُ أفكر قليلًا، وخديجة تتحدث عن جاوة والناس هناك، وعرفت أن اسمها لا يسميه من ينتمي إلى الأصول البدوية، لكن احتكاك والدي بالناس، وبكل الأجناس غيّر في حياته، وسمى بنته خديجة بدلًا من الأسماء المتداولة عند البدو، مثل بركة، عائشة، غيثة، قصع، قرنفل، وغيرها من الأسماء المتداولة”. لكنّ اسم خديجة يبقى مألوفًا في الوعي الحضرمي، قد يكون مرتبطًا بفئة اجتماعية معينة فيها، لكنه ليس مستجلبًا. يُحيلني ذلك للحديث عن غربة الاسم في الخليج العربي والمتمثلة في النطق الخاطئ، والغياب التدريجي الذي فسح المجال للتسمي بأسماء ليست غريبة عن بيئة حضرموت هضبةً وواديًا وصحراء وساحلًا وحسب، بل لا تشبهها البتة، أتذكر حين سمعتُ مرةً أنّ فلانة وفلان أطلقوا على مولودتهم اسم “العنود”، للوهلة الأولى يبدو ذلك غريبًا، لكنه قد يُطبّع، وأكثر ما أخشاهُ التطبيع، لا تقف الإشكاليّة هُنا، بل تمتد لأسماء الأسر الحضرميّة، فعائلة (العمودي) يحلو للبعض –في المهجر الخليجي- أن يخترع لها ألفًا زائدة، فيقول/يكتب “العامودي”، وما يثير دهشتي أنّ هذا التحريف امتدّ لأفراد من الأسرة أيضًا، فبعضهم يكتب العامودي عمدًا أو دون قصد. يدور في الأوساط معتقد يفسر هذه الألف، يُقال: “العامودي” تكتب لمن حصلوا على الجنسية السعودية، وكُتبت هكذا في أوراقهم، بينما ينفي جزءٌ من الواقع هذا التفسير، إذ هناك كُثر لديهم الجنسية وما زالت أوراقهم الرسمية مكتوبٌ عليها “العمودي”، لا نعرف –حتى الآن- مصدرًا لهذه الألف الزائدة، لكنّ الذي أعرفهُ على وجه اليقين أنها من التداعيات السلبية للمهجر. أتذكر أيضًا الاختراعات التي حظيت بها عائلة (قَرنح) حين تصدّر المشهد ابنها الروائي (عبد الرزّاق قرنح) بعد فوزه بجائزة نوبل الآداب، فقد أُضيفت حروف، وحُذفت أخرى وتداول الجمع –بمن فيهم زمرة المثقفين وحتى المترجمين- اسمًا اخترعوه هُم، ما جاءت به حضرموت. لدى (ووكر) قول يزيد من خصوصيّة (الاسم) في الحالة الحضرميّة: “والأسماء بطبيعة الحال علامات بارزة، ولكنّ اعتياد الأسماء الحضرمية وخاصة القدرة على تمييز اسمٍ ما من بقية الأسماء العربية الأخرى، يظلّ ضروريًّا لتحديد شخصيّة الحضرمي”.
يقول أحد الحضارمة في المهجر: “هناك من فقدوا سلسلة نسبهم، وبالتالي فقدوا هويتهم، وكل ما بقي لديهم هو الاسم القبيلي”! ما يعني أنّ الاسم في حالتنا ليس مجرد اسم فحسب، بل جزء أصيل ومهم من هويتنا التي تؤكل من كل جانب. في ذلك يضيف (ووكر): “فإن الاحتفاظ بالاسم القبيلي قد يُجدي باعتباره أساسًا لإعادة بناء الهوية ومن ثم؛ فإن الهويات معلومات مشتركة يتم ممارستها من خلال العلاقات ومن خلال السلوك، ومن خلال الملبس والممارسات الثقافية، وتُعززها السمعة”. يستكثر بعضهم حديثك بجزء من لهجتك، أو بكلمات محددة دون غيرها، بالرغم من كل المغريات السهلة ما زلت تحرص على استخدامها هيَ، يسكثرون مخاطبتك الأنثى بالكشكشة “الشين”، أو رفضك لأحرف تُزاد في أسماءِ أسر حضرميّة، لكنهم لا يدركون أنّ هذه التفاصيل هيَ نجاةُ هويتنا، ومن خلالها نكون نمارس حاجة إنسانيّة وفطريّة ليست أقلّ من حاجة الماء ولا الهواء.
لَطالما مثّل المهجر علاقة مركّبة بين من هاجروا ومن بقوا، بين من تمكّن من الفرار ومن لم يحالفه الحظ بعد، أحد صور هذا التركيب: العلاقة المجتمعيّة بين حضارم “الداخل والخارج”، معَ الأخذ في الاعتبار التّحويلات الماليّة للمهاجرين باعتبارها عمود الحياة الاقتصاديّة في حضرموت، لقد ظلت لفظة “مولَّدين/مولّد” بقدر ما تحمل من رغبة دفينة في نفس قائلها للتقليل والتهميش من قيمة/وطنيّة/وعي الطرف الآخر، كانت تحمل أيضًا رغبة سريّة/حانقة في أن يكون قائلها مكان من قيلت له، أو لأمانةِ الوصف، من قيلت ضده! أتذكر الآن ما يقال عن علاقة الإنسان الحضرميّ بالهجرة، هذا التلازم الأبديّ، لا يبدو أنهٌ كلامٌ يقال وحسب، أو ادعاءٌ يُعتقد لتدعيم وجهة نظر، إنه يبدو كجوهرٍ تتشكّل منهُ وحولهُ هُوية الإنسان الحضرمي؛ الرغبة في البقاءِ والهجرة، الرغبة بالعودةِ والذهاب، حُبّ النقيضيْن. يدرك الحضارمة هذه المشاعر، وبعضهم يعيشها دون إدراك، لكن ما يدعونا للأمل أنّ الحضارمة رفضوا مرّةً هولندا ومن ثم اليابان في مهجرهم وفي نفس الوقت بريطانيا في وطنهم، فهل كما تتكرر مآسي المهجر، يتكررُ وعيهُ؟
ما يؤكد هذه العلاقة المتشعبة ما جاء في مقدمة كتاب (حضرموت والمهجر): “لقد انخرطت في الهجرة نسبة عالية جدًّا من سكان حضرموت، وخصوصًا إذا ضممنا إلى المهاجرين أولئك الذين ظلوا في أرض الوطن؛ يتلقون تحويلات ومساعدات من الذين هُم في المهجر” و”توقف التحويلات المالية من جنوب شرقي آسيا في أربعينيات القرن الماضي أدى إلى حدوث مجاعتين؛ لذلك، من الصعوبة بمكان أن نستشرف اقتصادًا حضرميًّا قويًا من دون إسهام التحويلات المالية من المهاجرين”.
لا يمكننا تجاهل مشاعر أبناء المهجر تجاه حضرموت، بل إنّ أحنّ ما قيل في حضرموت قاله أبناء المهجر، ومن عانوا من الهجرة، ومن أدرك الغربة، ومن أحبّ البلاد، تتمثّل أمامنا الآن أشعار (حسين أبو بكر المحضار) الكيان الذي جسّد مشاعر مجتمع الشتات الحضرمي في قصائد يندر أن تجد حضرميًا لا يحفظ بيتًا منها، من ذلك حين قال: “وَا ويح نفسي لا ذكرت أوطانها حنّت/ حتى ولو هي في مطرحِ الخير رغبانةْ”! ومن ذلك شعر (علي أحمد باكثير) الخالد حين جمع بين مسقط رأسه سورابايا في إندونيسيا، ومدينته في حضرموت، سيؤون: “سورباي إنكِ موطنٌ لولادتي/ ومحلّ تربيتي ومهدُ صبايا لكن لي وطنًا يعزّ فراقهُ/ كيف السبيل لذاك وهو حمايا؟ هي (حضرموتُ) وما عنيتُ سوى رُبا/ (سيؤون) فهيَ مرابعي ورُبايا”. وهي مشاعر يصعب وصفها، وأحيانًا فهمها! يقول (نيكو جي. جي. كابتيان): “هناك عناصر من النتاج الثقافي.. تُغذّي مشاعر الحنين إلى حضرموت بين أفراد المهجر. وعلى سبيل المثال: هناك قصيدة قصيرة بلغة المالاي تعود إلى عام 1924م، عنوانها: “قمر الزمان”، تحوي قصة حياة السيد عثمان بن عبد الله بن يحيى نفسه، وفي الصفحة الأولى منها رسم بناء المعمار الحضرمي بخلفية من جاوة، ما يُصوّرُ عالمَين عاش فيهما السيد عثمان حياته” “عالمَين”! يا له من وصف!
“الاستثنائيّة الحضرميّة”.. قراءة (ثانوس بيتورس)
هذه القدرة على حمل انتماءَين –بل حتى أكثر-، وهذا الحنين لموطنَين، والارتباط بأرضين، سيّما حين تكون الأولى أرض الولاء، والثانية أرض الميلاد، هذه المشاعر التي قد تجمع بين نقيضين لا يصحّ لهما أن يلتقيا، فنجدهما في أقصى مراحل الامتزاج، حدّ الذوبان، في شخصيّة الإنسان الحضرميّ، ربما هذه هيَ “الاستثنائية الحضرمية” التي قالها بيتورس.
استطاعت حضرموت أن تخلق مفهومًا جديدًا للمتحف، فكان كلّ مهاجر منها متحف متنقل، وكان كمتحف الدولة يضمّ كلّ الأطياف التي شكّلت هذا الإنسان ونمّت ثقافته، وعززت إنسانيته. فحين يُحدّثك أحد حضارمة جدة –على سبيل المثال- عن هويته، حينها، هو لا يقدّم لك نموذجًا يسهلُ فهمه، بل ماضٍ متّصل، متحفٌ ممتد على أعرق الحضارات، أنتَ تشاهد الآن –ربما- آخر محطاته، لكنه قد يكون من أحفاد حضارمة الشرق الآسيوي الذين اضطرتهم ظروف الاستقلال لترك جاوا، أو سنغافورة، وغيرهما، قد يكون جده عاد حينها إلى حضرموت، ربما لم يعد كله، بل عاد ناقصًا تاركًا أبناء وأقارب متناثرين في أقصى الشرق، والهند، يُمارسون الحلمَ الحضرميّ، المتمثّل في رفض الواقع والرغبة بالبقاء. الأبناء الجدد كرروا المغامرة الحضرميّة في الشرق الإفريقي في الحبشة وكينيا وزنجبار والصومال وإرتيريا… نالهم ما نال الآباء، جالت أعينهم، فوقعت على إحدى مدن الساحل، الساحل الذي لم ينفصلوا عنه في موطنهم، ما زال الحنين مستمرًا، رغبة دفينة في التواجد في بيئة تشبه البلاد، كانت هذه المرة: جدة. حينها… تأكد أنك لا تخاطب إنسانًا واحد الهويّة، بل متحفٌ جامعٌ لحضاراتٍ أصيلة وعتيقة، ممزوجة بحضارة حضرموت. وكما يقول (د. عبد الوهاب المسيري): “ويمكن للماضي السحيق أن يجد مكانه بجوار الحاضر، فالحضارة ليست إنجازًا جامدًا ميتًا وإنما عملية متحركة مستمرة متنوعة”.
يذكر (ثانوس بيتوس) السبب الدقيق الذي دفعه لاستخدام مصطلح “الاستثنائية”، فيقول: “منذ عام 1990م مرت حضرموت بأطول مرحلة في تاريخها الحديث، أُديرت فيها كوحدة أرض منفردة في ظل سلطة سياسية واحدة، هي: الجمهورية اليمنية… إذن فأنا أعني بـ “الاستثنائية الحضرميّة”: البقاءَ النسبيَّ للاستقلال الثقافي والسياسي في حضرموت، وإحساسًا قويًا بالتماهي داخل مجتمع حضرمي، بغضّ النظر عن –ولكن في غالب الأحيان بسبب- الظروف الخارجية والداخلية السائدة…”
أما (هينجر) فنجده يعبر عن هذه الخصوصية حيث جاء في كتاب حضرموت والمهجر: “يصل –هينجر- إلى فهم أعمق للحضارم بوصفهم مجتمع مهجر. كما يناقش قضايا الإسلام ودور الحضارم في مقاومة الهيمنة الأوروبية في وجهاتهم المختلفة، ليس نيابة عن الحضارم وحدهم؛ بل نيابة عن المجتمعات الإسلامية بصفة عامة”.
في توصيف آخر لهذه الحالة لكنه في الحجاز هذه المرة: “كما هو حال بني جلدتهم في جنوب شرقي آسيا، كان الحضارم في الحجاز مشغولين في عملية مزدوجة المسار؛ فمن ناحية يغرسون انتماءً بارزًا لمجتمعهم، ومن ناحية أخرى، كانوا منخرطين بشكل عميق في الاقتصاد المحلي والسياسة المحلية”. و”إنّ حالة عائلة بن زقر توضح كيف استطاعت عائلةٌ أن تتجذر في كل مجتمعي المهجر، والحضرمي المحلي، وتمكنت تدريجيًا من أن توسّع شبكة أعمالها لتشمل شركاء غير حضارم”. وكما يقول (فيليب بيترييه): “يُديروا تجارة دولية دون اللجوء إلى مجتمع مهجرهم. يجب –مع ذلك- أن يظل في أذهاننا أن مثل تلك الشبكات العاملة لم تستبعد الانتماء إلى المهجر”. جزءٌ واسع من مفهوم الهجرة يندرج تحت العلوم الإنسانية، ويصف المسيري أحد اتجاهات هذه العلوم بـ “التعميم المتطرف”، والذي: “يفقد الظاهرة موضع الدراسة أي خصوصية حضارية أو إثنية أو اقتصادية…” ولأنّ هذه الهجرة كانت ممتدة عبر قرون سابقة، ومرتبطة بجغرافيّة حضرموت وبيئتها، وفيما بعد دينها، فقد امتزجت هذه العوامل في الإنسان الحضرمي، وكوّنت هذه الخصوصية للهجرة، ويمكننا حين نقرأ/ندرس هذه المسألة أن نُعمل ما أشار إليه المسيري بـ “النماذج المركبة” باعتبارها أداة تحليلية، وعادلة! وتساهم في “الابتعاد عن الموضوعية المادية المتلقية”. و”النماذج المركبة هي النماذج التي يدخل في تركيبها عدد من العناصر المتنوعة والمتداخلة بل والمتناقضة، منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني والحضاري”. فكما يقول: “الإنسان ظاهرة فريدة مركبة، وكل إنسان فرد له نتوءه وتعرجاته وأسراره ومنحناه الخاص الذي يميزه عن بقية الجنس البشري. وبرغم إيماننا بأن ثمة إنسانية مشتركة تجمعنا جميعًا، فإن هذا لا يعني رفض الخصوصيات الإنسانية المختلفة”.
تحدّث المسيري أيضًا عن مفهوم “الجماعة التعاقدية” فيقول: “فالجماعة الوظيفية جماعة تعاقدية لا تدخل في علاقة تراحمية مع المجتمع… وقد ازداد نموذج الجماعات الوظيفية تبلورًا في الرياض، إذ يُشار إلى الأجانب أمثالي من العاملين في البلاد الخليجية باسم “الوافدين” وأحيانًا “المتعاقدين”… وبالفعل، يعيش كثير من المتعاقدين في غربة، لا يشعرون بأي عاطفة نحو الوطن المضيف، تنتهي علاقتهم به مع انتهاء العقد… مما يجعله شخصية حركية، وكيانًا غير متجذر في أي شيء…” لكنّ الإنسان الحضرميّ يبقى متحرّكًا ومتجذّرًا في آنٍ واحد! فهو لا يندرج تحت مفهوم الجماعة التعاقديّة، مهما اشترك في بعض جوانب وصفها، ومهما تشارك ظروف “الوافد/الأجنبي”، لكنه يبقى يختصّ بشيء يستثنيهِ على الدوام من كلّ التعميمات.
هناك إشكاليّة، وإن صحّ التعبير: “منطقة حساسة” تتعلق بجغرافيّة حضرموت، فريقٌ يلزّم الارتباط وآخر ينفي هذا الارتباط ليحوّله لارتباط آخر دون أن يعي فداحة فعله، وثالثُ يكرر فعلة الثاني مع اختلاف وجهة الارتباط لكن مع اتفاقها في الفداحة! لكنّ أحدًا لم يدرك أنّ سرّ حضرموت هو أن تبقى ولا تبقى، مثل حال مهاجريها فيها وهم خارجها، هناك شيء يستدعي هذه الاستثنائيّة، وهناك خيط رفيع نشعر به ولم نمسكه بعد، يخبرنا أن حضرموت هيَ حضرموت وحسب، “بدأت الهجرة من حضرموت منذ قرون، وهي مستمرة حتى الآن، وقد تأثرت بشكل مركّز وعميق؛ ليس بالتطورات الثقافية والاقتصادية والسياسية للوطن الأم فحسب، ولكن أيضًا بالبنية العقلية وشخصية الشعب الحضرمي، ومن ثم؛ فإن تأثيراتها واضحة جلية في سمات السلوك الاجتماعي واللغة، وحتى السمات الشخصية للحضارم، وهذه تخدم ما اصطلح ثانوس بيتوريس على تسميته: “الاستثنائيّة الحضرميّة”. ليست الهجرة فعلًا حضرميًّا خاصًا، بل مارستها شعوبٌ كثيرة ولا زالت، لكنّ شيئًا فيها يستدعي أن نبصره، “ما نراه أمامنا هو مهجر يتخذ أشكالًا مختلفة؛ فالحضارم، في مختلف مجتمعاتهم في المهجر، لا يمثلون أي مجتمع أو تجمُّع أو جماعة سبق تحديد شكلها. فليس المهجر الحضرمي مركزًا، باستثناء محطة نشأته، وهي تتميز بكونها ذات قدرة استيعابية عالية”.
أخيرًا… “ينتهي ووكر، إلى أن الحضارم متعددو الجنسيات، وأصحاب جنسيات عابرة، شخصيتهم عرقية، وتنفرد بالخصوصية، وجاهزة للظروف الطارئة. وفي حين أن جوازات السفر الكينية أو اليمنية أدوات مفيدة في عالمنا المعاصر، فإن الشخصية الحضرمية قائمة على فهم تاريخي عميق واعتراف بالانتماء الذي نراهُ مترسخًا.. عبر الممارسات اليومية في الأماكن والفضاءات المختلفة، بمعنى أنه من حيث المصطلحات القومية، فإن الحضرمي: يكون مرة كينيًّا ويمنيًّا، ومرة أخرى غير كيني وغير يمني”. وفيما يتعلّق بمفهوم الجواز، فهناك خصوصيّة أخرى، يقول: “كثيرًا من الحضارم يحملون جوازات سفر يمنية “للطوارئ فقط”. وهذا بطبيعة الحال اعتراف ضمني بعدم الانتماء”، ليس ذلك مختصًا بيمن 1990م بل حتى “بعد الاستقلال عن بريطانيا، وجدت الجمهورية الشعبية الوليدة لجنوب اليمن أن من الصعب عليها التكامل مع حضرموت في البنى المكونة للدولة الحديثة… المرحلة التي عُرفت لوقت قصير باسم “جمهورية حضرموت الديقراطية الشعبية” (مايو – يونيو 1968م)، التي نادى بها فيصل العطاس ورفاقه الماويون مع دعم صيني صامت، كانت مؤشرًا على الإصرار على العصبية الحضرميّة”، أيضًا ذلك ليس مختصًا بالهُويّة اليمنيّة بتنوعها وتعددها وتعقدها، بل لَطالما كان الجواز –أيّ جواز- قيمة مضافة، ليست قيمة أصليّة، مع كلِّ الظروف، المعروفِ منها والمجهول، المنشور والمغيّب، البسيط والمركب منها، بقيت حضرموت هي المحطة الأخيرة. يقول (ووكر): “فإذا ما أصبح إنسانٌ ما حضرميًّا، فإنهُ يظلّ على الدّوام حضرميًّا، وبالإيحاء فإنّ هذا يعملُ بشكليْن: “أنا حضرميّ، ورغم ذلك أنا أحملُ جواز سفرٍ كينيّ. نحنُ عالميّون (كوزموبلوتانيون) جدًّا”.