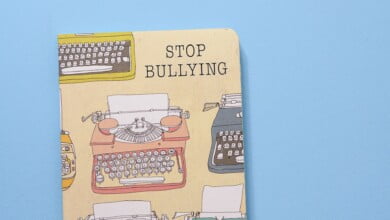- أندرو ج. باسيفيتش
- ترجمة: سمية عبد العليم
- تحرير: عبير العتيبي
متى بدأت قصة أمريكا؟ وماذا تعني هذه القصة؟ أصبحت اليوم هذه الأسئلة القديمة موضع خلاف حاد مرة أخرى، وإذا كانت نتيجة هذا النزاع ستزود الأمريكيين بفهم أكثر صدقًا لكيفية انتقالهم من حيث بدأ كل شيء إلى حيث وجدوا أنفسهم اليوم فهي جديرة بالبحث.
الجواب التقليدي للمكان والزمان الذي بدأت فيه القصة الأمريكية هو فيلادلفيا في صيف 1776. يختلف المحررون الحاليون لصحيفة نيويورك تايمز، لكن بحسب مقال “مشروع 1619” المنشور في الصحف فإن قصة أمريكا تعود إلى العام الذي وصلت فيه أول مجموعة من الأفارقة المستعبدين إلى مستعمرة فرجينيا. كل ما حدث منذ ذلك الحين نابع من تلك اللحظة المصيرية. ووفقًا لصحيفة التايمز فلم يكن أي جانب من جوانب الدولة التي سيتم تشكيلها هنا بمنأى عن سنوات العبودية التي تلت ذلك، وللعنصرية المؤسسية التي استمرت بعد إلغاء العبودية الرسمية أن الغرض الصريح من مقالات مشروع 1619 هو إعادة صياغة تاريخ الولايات المتحدة من خلال وضع عواقب العبودية وإسهامات الأمريكيين السود في صميم قصتنا الوطنية.
إن أولئك الذين تعرضوا وما زالوا يتعرضون للقمع والاستغلال والتهميش لأنهم كانوا من السود سيحتلون من الآن فصاعدًا مركز الصدارة كمهندسين حقيقيين للحرية والازدهار والثقافة الأمريكية. وفقًا لنيكول هانا جونز -المبدع الرئيسي لمشروع 1619- فالحقيقة هي أن الديمقراطية التي تحملها هذه الأمة اليوم، حُملت أول مرة على ظهور السود المقاومين، وهو بيان أدلى به دون استثناءات أو شروط. وتتابع حديثها باسم زملائها الأمريكيين من أصل أفريقي: “لقد أصبحنا أكثر الأمريكيين على الإطلاق بفضل عبوديتنا” وإذا فهمناها حرفياً فإن “نحن” تشير إلى أن المواطنين غير السود هم بالتالي أمريكيين بدرجة أقل. إن مقال “مشروع 1619”-ولو بشكل ضمني فقط- هو رد فعل لعنصريِي تيكيتورش البيض الذين تقدموا في شارلوتسفيل في أغسطس 2017 وهم يهتفون “لن تحل محلنا” ربما لن تحل محلنا لا تعني القتل لكن تعني أنه يجب أن تعتبروا أنفسكم هنا أقل مرتبة في التسلسل الهرمي للأمريكية.
لذا فإن الحديث عن مشروع 1619 -ولا شك أنه من المفترض أن يكون كذلك- استفزازي. لسان حاله يعني أنك يجب أن تسمعنا وتنظر إلينا وتعترف بنا وربما تعوضنا. والأكثر جرأة هو أن مشروع 1619 يشكك في أساس الشرعية السياسية لهذه الأمة. يستمد المشروع المعروف رسميًا باسم الولايات المتحدة الأمريكية شرعيته من ثورة 1776، والتي يُفترض أنها مبرَّرة بحقائق بديهية ويُضطلع بها ظاهريًا سعيًا وراء حقوقٍ غير قابلة للتفاوض ومن بينها الالتزام بالحرية. وبدعم من سلطة صحيفة نيويورك تايمز، رفضت هانا جونز الآن هذا الأمر ووصفته بالصدفة، مؤكدةً أن “أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المستعمرين إلى إعلان استقلالهم عن بريطانيا هو رغبتهم في حماية مؤسسة العبودية”. باختصار، لم يكن الغرض من الثورة الأمريكية تأمين الحرية بل إنكارها. هذه تحريفية فجة.
مشروع بهذه الجرأة المذهلة سوف يثير بالضرورة المعارضة، ولن يقتصر الأمر على القوميين البيض من اليمين. لذلك نجح مشروع 1619 بعمله، ولا سيما لدى أعضاء المهن التاريخية. في تعبير عن الاحتجاج على غرار القرن العشرين، كتب خمسة من المؤرخين (البيض) البارزين للولايات المتحدة رسالة إلى التايمز عن استشعارهم بليّ الحقائق التاريخية لصالح الأيديولوجيا، فقد اعترضوا – بأدب – على النسخة الجديدة من التاريخ الأمريكي التي يقدمها مشروع 1619 والتي تصبح فيها العبودية وتفوُّق البيض الموضوعين المنظمين المهيمنين. عند نشر الرسالة، ردت التايمز على المؤرخين بمجاملة مكافئة “نحن ممتنون لمساهمتكم” في حين رفضت شكواهم تمامًا.
وللعودة للرد بشكل أكثر صعوبة، اختارت مجموعة ثانية من الأكاديميين – معظمهم من السود وليس كلهم – منصة twenty-first-century للتعبير عن اعتراضاتهم. ردًا على صحيفة nation التي أعادت كتابة الأرقام القياسية لتاريخ الولايات المتحدة، فقد قاموا بإنشاء موقع ويب في تقدير العلماء الذين ساهموا في مشروع “1776 Unites” في ذلك العام – بدلاً من 1619- بدأ “التأسيس الحقيقي لأمريكا” وبدلاً من التأدب اختار المساهمون في مشروع 1776 Unites الصراخ العلني.
لنأخذ على سبيل المثال مقال البروفيسور جون ماكوورثر من جامعة كولومبيا. يصر جون على أن مشروع 1619 ليس تاريخًا مشبعا بالأيديولوجيا وأنه دعاية صريحة لخدمة الصواب السياسي أو -على حد تعبيره- “حكمة شاردونية” معبأة في زجاجات تسوق لفخر “استيقظ”. يصر دون على أن جزءًا لا يتجزأ من مشروع 1619 هو الاعتقاد بأن التجريب المحض لن يكون كافيًا لكشف الحقيقة المهمة حقًا. الحقيقة تتطلب السرد المصمم بعناية لتشجيع تعليق الحكم بعدم الإيمان، وبالتالي الكشف عما تم إخفاؤه. من هذا المنظور فإن فكرة عام 1619 المقدمة على أنها تنوير هي في الواقع رفض للتاريخ لصالح ما يمكن أن نسميه التقاليد الشعبية.
يخبرنا مقال نشرته مجلة ذي أتلانتك أن المعركة حول مشروع 1619 ليست معركة حقائق وهذا صحيح تماما، فإذا كانت نقاط المعركة تُحسب بالحقائق وحدها فسيُجمِع الحكام على إعلان فوز ماكوورثر وفريقه. يفتح ماكوورثر النار على مشروع 1619 ويصفه بأنه قوي الادعاءات لكنه عارٍ تمامًا من البيِّنات؛ فيكتب معلقًا:
“يزعم المشروع أن الآباء المؤسسين قد قاموا بثورتهم التحريرية لحماية العبودية، وأنهم لم يعلنوا هذا الهدف للتاريخ صراحة، رغم أن تصريحًا كهذا في زمنهم لم يكن ليشينهم. فكيف ظلت هذه الثورة المزعومة مدفونة غير مكتشَفة حتى الآن، فيما أكادميو العلوم الإنسانية (ولما يقارب الخمسين عاماً) من كل جنس ولون يحفرون مفتشين عن العنصرية في النسيج الأمريكي؟ هل يُنتظر منا تصديق أن مجموعة من صحفيي التايمز وقعت على ثورة تاريخية مفتاحية من القراءة هنا وهناك، ولم يمر ببال أحدٍ من الباحثين طوال هذه العقود أن يخرج زاعقًا باكتشافه في وسائل الإعلام المنتشرة ؟”
إذا كان ماكوورثر محقا- وأنا اعتقد أنه كذلك – فعلام تدور هذه المعركة إذاً؟
إن هذه المعركة، في إحدى مستوياتها، صراعٌ حول أحقية المساحة. تمارس التايمز امتياز “صياغة الماضي” الذي كان قبلُ حكرًا على المؤرخين المحترفين. تخيل منبرًا صحفيًا كبيرًا يُطلق مشروعًا معلنًا أن هدفه إثبات أن المسيح ليس ابنًا للإله بل هو أحد أعوان الشيطان. سيثير هذا سخط رجال الدين المسيحيِّين (بعضهم على الأقل). هذا أيضا ما يحدث في مشروع 1619؛ تنازع التايمز على مساحة لا تزال تقع إلى يومنا هذا في عين اختصاص حَمَلة صكوك تفسير الماضي.
ترى عُصبة المؤرخين الأكادييمن الحريصين على الاحتفاظ بامتيازات مجالهم في مشروع 1619 صفعة على الوجه، وهذا دليلٌ آخر على تناقص نفوذهم. صحيح أن المؤرخين العاملين في الكليات والجامعات لا زالوا مستمرين في الكتابة والتدريس وتوجيه الطلبة الخريجين (مخرجين رسائل دكتوراه أكثر من الوظائف المتاحة في مجالهم). بل إن بعضهم يكتب بصفة غير دورية في صفحة الآراء الحرة لمجلة نيويورك تايمز لكن تأثيرهم الكلي على تشكيل رؤية الأمريكيين لتاريخهم يلهث محاولًا اللحاق بتأثير كُتَّاب الرواية الشعبية مثل (فيليب روث، مؤامرة ضد أمريكا) وكتاب الكتب الأكثر مبيعا مثل (دوريس جودوين، فريق من المتنافسين) والمخرجين مثل (ريك برن، الحرب الأهلية) ناهيك عن ذكر تأثير ألعاب الفيديو والمشاريع التجارية المختلفة بما فيهم جريدة التايمز نفسها.
لقد حان وقت الاعتراف بأن نفوذ المؤرخين الأكاديمين هذه الأيام يُقاس بمدى تأثيرهم على المناخ الثقافي العام، كنفوذ رجال الدين بالضبط أي الِنزر اليسير. لذا فإن الانزعاج الذي يبديه أساتذة الوسط الأكاديمي عند رؤيتهم لبعض الصحفيين يغزون مجال اختصاصهم – وإن كانوا مدعومين بقلة موالية من الأكاديميين – مفهومًا.
بغض النظر عن هذا الانزعاج فإن ما يدورهنا أكبر بكثير من فكرة اغتصاب صحفيين لامتياز وحق محفوظ تقليديًا للباحثين المدرَّبين جيدًا. ربما يذهب مهندسو مشروع 1619 لادعاءات أبعد مما بين أيديهم من الشواهد والأدلة، لكن دعوني أقول لكم أنهم قد أماطوا اللثام عن حقيقة هامة؛ أن قصة الاستقلال الأمريكي التقليدية هي حجر زاوية للهوية الوطنية، وما غُزِل حولها من الأساطير الوطنية قد ولَّى زمنها.
لا يتوقف الأثر التهديمي لمشروع 1619 عند التشكيك في الثورة الأمريكية التي كانت خطًا أحمر سواءً متعمدين أو غافلين، فإن محرري جريدة التايمز يتلاعبون بمساحة “الميتا تاريخ”[1] الحاضنة والمُشكِّلة للطريقة التي ألفها معظم المواطنيين الأمريكيين – وخاصةً النخبة المثقفة – لموضعة أمريكا في مجرى تاريخ الإنسانية.
ترتكز الميتا-تاريخ على ثلاثة أحداث حُقنت في الذاكرة الأمريكية كصنائع تحرير: الثورة الأمريكية والحرب الأهلية والحرب العالمية الثانية. مجتمعةً عناصر هذا الثالوث المقدس تتآزر وتُشكل البرهان على أن التاريخ نفسه قد عيَّن الولايات المتحدة وكيلته المختارة لحمل شعلة الحرية، معطيًا إياها حق التحرك للدفاع عن الحرية وتأكيد انتصارها دائمًا وأبدًا.
إذا كانت ” دماء الوطنيين والطغاة هي سُقيا شجرة الحرية كما كتب توماس جيفرسون في عام 1787 فإن الدماء المراقة في هذه الأحداث الثلاث كانت السُقيا التي أقامت صلب الولايات المتحدة، هذا ما تقوله السردية التقليدية. لكن إذا اعترفنا مثلًا باحتمال اختلاف الدوافع الواقعية لإعلان الاستقلال في 1776 عن المبادئ المثالية التي جاءت بعده في خطاب جيفرسن الشهير، فسنشهد انهيار سرديات عناصر الثالوث المقدس تباعًا.
وما هي إلا مسألة وقت، في رأيي، قبل أن ينهار التصوير السائد للحرب العالمية الثانية على أنها كانت معركة خير وشر. إن الشرور التي قام بها معسكر أعدائنا في هذه الحرب مسلمٌ بها ولا يمكن لأحد أن ينكرها، لكن المحاسبة الأخلاقية المنصفة لا يسعها إلا أن تُقر بالخطايا التي قامت بها الولايات المتحدة وحلافائها الرئيسيين من إطالة أعمار إمبراطوريات عنصرية وتعمُّد الإكثار في قتل غير المقاتلين وحمل وزر الشراكة في الجرائم الشنعاء التي قام بها الجيش الأحمر. أضف إلى هذا ما مر به الجنود الأمريكيين السود الملتحقين بجيشٍ تحكمه قوانين الفصل العنصري وما حدث لليابانيين الأمريكيين من شحن إلى معسكرات الاعتقال، يتضح لك أن هذه “الحرب الخيِّرة” لم تعد بالخير حتى على الأمريكيين.
في وقت يحتل فيه دونالد ترامب البيت الأبيض ويتعمق انقسام الشعب الأمريكي بين حزب جمهوري استشرى فساده وبين ديمقراطيين يراهنون بكل ما يملكونه على حصانٍ متواضع، تأتي محاولات إعادة النظر في التاريخ الأمريكي بشكل راديكالي في وقتها.
انظر في بشاعة التفاوت الاقتصادي والحروب الفاشلة التي فضحت زيف أسطورة التفوق العسكري الأمريكي وستعلم أنه قد حان وقت اصطناع ماضٍ أكثر ملاءمة لما نعيشه الآن. أضف إلى الصورة تحدياتٍ مُلحة مثل التغير المناخي والتحول الكبير في ميزان القوى العالمي وستتضح لك حقيقة أن الثالوث المقدس قد استنفذ منفعته.
لقد وضع إبراهم لينكون يده على مربط الفرس في عام 1862 حين قال ” توجب علينا جِدَة قضيتنا، أن نفكر بشكل جديد ونتحرك بشكل جديد” وكما قال مخاطبا الكونجرس “علينا أولًا أن نحرر أنفسنا وعندها سوف تحرر بلادنا”.
إن مشروع 1916 يمثل خطوةً أولى نحو انعتاق أنفسنا من أسر تاريخنا المصوِّر للولايات المتحدة كوكيل عَيَّنه التاريخ لتحرير الأمم. لقد فقد هذا التصور صلته بحاضرنا، كما أنه يقف عقبةً أمام استيعابنا للموقف الذي نجد أنفسنا فيه اليوم. أخيرًا وبعد طول انتظار، جاءت لحظة الاعتراف بأن وجه الاستغلال يظهر كتيمة ثابتة عبر التاريخ الأمريكي بنفس القدرأو أكثر من وجه الحرية، وأن هذا الاعتراف يستدعي تأطيرًا جديدًا للماضي.
ليست هذه بالمهمة التي نعهد بها إلى مجلة نيويورك تايمز التي لا يخفى على أحد أن لها أجندتها الأيدولوجية، إنما هي مهمة مجتمع الباحثين وعليهم أن ينهضوا بها بالشكل الذي وصفه لينكون، فيستوعبون انحيازاتهم الأيدولوجية المستبطنة هم أيضًا ويتحررون منها وإلا فسنجد التايمز تملأ الفراغ دونهم وسيكون هذا من سوء حظنا.
دعونا نعترف في الوقت الحالي بهذا المقدار؛ أن الإجابات التي خرج بها مشروع 1916 حتى الآن قد تكون ناقصة، لكن محاولاتها استنطاق الماضى جديرة بالإعجاب وفي وقتها المناسب.
اقرأ ايضاً: لقد وصل المسلمون إلى أمريكا قبل البروتستانت بأكثر من قرن
[1] – ظهر مصطلح الميتا تاريخ لأول مرة في كتابات الناقد والمفكر الكندي نورثروب فراي (1912 – 1991) الذي يعطي مفهوم “تاريخ التاريخ” أو فلسفة التاريخ”، ثم أدرجه المؤرخ الأمريكي هايدن وايت عنواناً في كتابه الهام “ميتا تاريخ: التصور التاريخي في القرن التاسع عشر في أوربا” الذي أصدره عام 1973 ثم أعيد طبعه لمرات عديدة، والذي ارتقى فيه إلى منهج علمي يتخطى السرديات للوقائع التاريخية والنتاجات الفكرية لصيرورة الفكر وتطوره لدى هيجل وسبنسر وماركس، ليتخطاها إلى البحث في خلفياتها وتنقيتها مما لحق بها ومناقشتها بديناميكية فكرية مع إزاحة التلقي كمسلمات مما يقدم فكراً غنياً يتجاوز الأيديولوجيا الضيقة الى رحابة الفكر وديناميكيته وجعل التصور مقارباً للواقع. -المراجع.