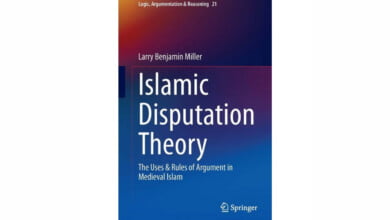- ليفنات هولتزمان
- ترجمة: مصطفى هندي
- تعليق: عبد الله الــغِــزِّي[1]
بيانات الكتاب: - العنوان: السياسة والفقه والمجتمع في الفكر الإسلامي: اللحظة التيمية
- المؤلف: عُوَيمِر أنجُم
- الناشر: Cambridge University press
- تاريخ النشر: مارس ٢٠١٢
- عدد الصفحات: ٣١٤
لسنا بحاجة لأن ندلل على أن اللاهوت/علم الكلام كان المحرك الأقوى لسياسات المجتمع الإسلامي المبكر، بل هي فكرة أقرب إلى البدهية. لقد كانت نشأة الانقسامات المختلفة في المجتمع الإسلامي “الأمة”، إلى جانب النقاشات اللاهوتية التي رافقتها= محل دراسة دقيقة من قبل علماء العصور الوسطى والحديثة على حد سواء؛ حيث أكد مؤرخو الفترة الكلاسيكية عند وصفهم للجماعات السياسية اللاهوتية -مثل الخوارج والقدرية- أن مفهومي العدالة الإلهية وحرية الإرادة البشرية كانا من العناصر الرئيسية في سلسلة الأحداث الدرامية التي أدت إلى ظهور الفرق العقدية التي صار لها فيما بعد هيمنة سياسية[2] وقد كانت المفاهيم اللاهوتية التي تبناها الخلفاء وروجوا لها -بمساعدة العلماء- لتثبيت مكانتهم وإضفاء الشرعية على حكمهم= محل اهتمام من الباحثين.
وهكذا، فإن الأحداث المؤثرة -مثل محنة المأمون (بين عامي 833 و847م)- كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمناقشات الساخنة بين المحافظين والعقلانيين[3] حول مفهوم “القرآن غير المخلوق”. وباختصار، فإن الارتباط بين الخلاصات اللاهوتية التبسيطية وبدايات الفكر السياسي المبكر في الإسلام دائمًا ما كان محل دراسة واهتمام؛ إلا أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة إلى علاقة المناقشات اللاهوتية الأعمق بالفكر السياسي لاحقًا في الإسلام، وإن كتاب أوفامير “السياسة والفقه والمجتمع في الفكر الإسلامي: اللحظة التيمية” يسد هذه الفجوة؛ حيث كشف عن تشابكات السياسة والأفكار اللاهوتية المتخصصة والدقيقة بالكامل في دراسة متعددة الطبقات إلا أنها تركز على موضوع واحد.
لقد غاص المؤلف الخبير والضليع بكتابات ابن تيمية (ت1328) المثيرة للجدل، وتلميذه المخلص ابن قيم الجوزية (ت1350)، في أعمق شق للسياسة الإسلامية؛ ومن هناك تتبع تيارات لاهوتية غير مألوفة شكلت النظرة العالمية لهؤلاء المفكرين، مع التركيز بشكل خاص على ابن تيمية. لقد قدم ابن تيمية وابن القيم المعارضة الأكثر تماسكًا للمؤسسة الدينية في عصرهما؛ ومع ذلك، فإن مسألة موقفهم من النظام السياسي المملوكي لم يتم الكشف عنها بالكامل. كان كلٌ من ابن تيمية وابن القيم منخرطين بعمق في هذا النظام السياسي عن طريق نسيج من العلاقات الحميمة بين المسؤولين المماليك وضباط الجيش وعلماء الدولة؛ كما كانت المؤسسة الدينية وأعمال هؤلاء العلماء هدفًا للانتقادات القاسية لهذين العالِمَين في أعمالهما الفقهية واللاهوتية. ومع ذلك، تطوع ابن تيمية وابن القيم لتقديم نصائحهم بشأن إدارة الدولة إلى عناصر الحكومة “القائمة على أمور الدنيا”، أي المسؤولين المماليك. كما كشفت أطروحاتهم عن السياسة والحكومة (مثل كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، والفروسية لابن القيم) عن نظرة عالمية طوباوية يشارك فيها العلماء بنشاط في شؤون الدولة، ليس فقط من خلال استغلال النظام السياسي لتحقيق أغراضهم، بل من خلال توجيه هذا النظام بأكمله، فالحاكم الذي هو بالأصل عالم دين= هي الصورة المثلى التي روج لها هذان العالمان.
إن هدف أنجوم في هذا الكتاب هو الكشف عن الصورة الكاملة لفكر ابن تيمية السياسي، سواء كرؤية ثورية جديدة أو كبديل للمؤسسات الحكومية والدينية الراكدة في عصره، وفي نفس الوقت: النظر إليه باعتباره نظرية كاملة ذات أبعاد لاهوتية لم تُكتشف بعد. إن البديل السياسي التيمي معروف جيدًا وقد نوقش في بحث سابق، بداية من كتاب هنري لاوست الضخم “مقال عن الأفكار الاجتماعية والسياسية لتقي الدين أحمد ابن تيمية” الذي صدر عام 1939.
بناءً على رؤية ابن تيمية للأمة -المجتمع الإسلامي الأول- كمجتمع مثالي يتميز بالنشاط والمشاركة السياسية والصلاح الديني= يصور ابن تيمية الخطوط العريضة لهذا المجتمع الطوباوي على أنه مجتمع يشارك فيه رجال الدين غير الرسميين في شؤون الدولة إلى درجة تحديد من يستحق الانتخاب كزعيم. ومع ذلك، فإن الأبعاد اللاهوتية للبديل السياسي التيمي لا تزال أرضًا غامضة بالنسبة للباحثين. إن الإنجازات الكبرى التي حققها أنجوم في هذا الكتاب المثير للإعجاب هي استخلاصه الفكر السياسي لابن تيمية من كتاباته اللاهوتية، لا سيما أعظم أعماله المعروف بـ “درء تعارض العقل والنقل”. يقدم أنجوم قراءة سياسية سياقية لهذه الموسوعة اللاهوتية المعقدة، وهي حقًا خطوة رائدة. يبدأ أنجوم تحليله بدراسة المواجهة بين الكلام الأشعري -الذي كان سائدًا بين النخبة الدينية في المجتمع المملوكي- مع التنظير اللاهوتي التيمي؛ ويؤكد أن المذهب الأشعري -في نسخته التي قدمها فخر الدين الرازي تحديدًا- كانت عاملًا قويًا في الركود السياسي في المجتمع المملوكي؛[4] وانطلاقًا من هذه النظرة، يضع أنجوم فكر ابن تيمية اللاهوتي في إطار يظهر من خلاله أنه أكثر من مجرد تفنيد منهجي للكلام الأشعري، حيث يُقرأ درء التعارض من هذه الزاوية على أنه بيانٌ سياسي. إن الكشف عن البعد السياسي لفلسفة ابن تيمية هو الإسهام الأكثر أهمية لكتاب أنجوم؛ إلا أنه قبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب على القارئ أن يتجاوز 169 صفحة عن تاريخ الفكر السياسي في الإسلام.
يتبع أنجوم مسارين متوازيين في تحليله؛ الأول: يكشف عن العلاقة بين الملكية الإسلامية الكلاسيكية والموقف المعرفي الأشعري الذي كان على النقيض من واقعية ابن تيمية المتفائلة؛ بينما يفحص الاتجاه الثاني مفهوم ابن تيمية اللاهوتي عن الفطرة ويكشف عن مكانة هذا المفهوم المتأصلة في واقعية ابن تيمية المعرفية إلى جانب فكره السياسي. يتكون الكتاب من سبعة فصول ضخمة، مقسمة إلى جزأين يمكن قراءتهما بشكل مستقل. الجزء الأول بعنوان “الإرث الكلاسيكي” يرسم فيه المؤلف الفكر السياسي في الفترة الإسلامية المبكرة (القرن السابع) ويحدد معالم تطور هذا الفكر في الفترة الكلاسيكية (في هذا الكتاب تقع الفترة الكلاسيكية تقريبًا بين القرنين 8 و14).
أتى الجزء الثاني من الكتاب بعنوان مبهم “التدخل التيمي”، يدرس فيه المؤلف المواجهة بين فكر ابن تيمية السياسي والنظام السياسي السائد في عصره. قبل الخوض في قراءة هذا الكتاب الضخم، تساءلتُ عن قرار المؤلف باستحضار الفكر السياسي بشكل شامل من أيام النبي محمد حتى العصر المملوكي في دراسة تهدف إلى التركيز على ابن تيمية؛ وطوال قراءتي، لم أكن مقتنعة تمامًا بأن بعض الموضوعات التي يناقشها المؤلف بجدية (والتي اعتمد في غالبها على مصادر ثانوية) كانت ذات صلة بالموضوع فعلًا. أظن أن المؤلف اختار تخصيص أول فصلين من كتابه (حوالي 136 صفحة) لسياسات القرون الأولى للإسلام؛ لأن فكر ابن تيمية السياسي ينبثق من رؤى عميقة للأحداث السياسية التكوينية في تاريخ العرب؛ وربما يكون منطق المؤلف هو أنه: لفهم رؤية ابن تيمية عن المجتمع الإسلامي الطوباوي بشكل كامل، يجب أن يتعرف المرء على الأحداث التاريخية منذ ظهور الإسلام حتى عهد ابن تيمية، وألا يكتفي بالكليشيهات السائدة عن عظمة المجتمع الإسلامي المبكر. وبالمثل، لم أكن مقتنعة تمامًا بأن الفصلين الأولين كانا بالفعل مهمين لموضوع الكتاب. وعلى العكس من ذلك فإن الموضوع الآخر الذي يظهر في الجزء الأول من الكتاب -التشاؤم المعرفي للكلام الأشعري- وثيق الصلة بفكر ابن تيمية اللاهوتي. في الصفحات التالية، سوف أرسم ملامح الكتاب وأركز أكثر على الجوانب اللاهوتية والسياسية بدلًا من الجوانب التاريخية لمناقشات أنجوم.
في الفصل الأول (ص37-92)، يصف المؤلف كيف تحطمت فكرة الأمة المثالية سياسيًا، والتي يكون الجميع فيها على قدم المساواة في القرن الأول للإسلام، وذلك بسبب الاحتياجات المتزايدة للإمبراطورية المتنامية، وكيف أُعيد تعريف الأمة المثالية وتضمينها في مجتمع تقليدي يحكمه ملك. يقدم أنجوم مناقشة شاملة حول المفاهيم الأساسية مثل “خليفة الله” و “أولو الأمر” و”الشورى”، و”السياسة الشرعية” بشكل أعمق، وذلك من خلال الوقوف مع النقاط الفاصلة في تاريخ الدولة الأموية ونظيرتها العباسية. يمهد هذا النقاش المتعمق الطريق لفحص صعود “العلماء” كقوة سياسية رسخت نفسها كمعارضة شديدة للخلفاء.
يقدم الفصل الثاني (ص93-136) -كما هي الحال في الفصل الأول- نظرة عامة واسعة على الأدبيات التي كتبها علماء سنة بارزون من القرن العاشر وما بعده، إبان التدهور التدريجي للخلافة العباسية. يجادل أنجوم أن الخطاب الأشعري اللاهوتي -وليس الفقهي- قد بلور مجموعة من المقدمات الإرشادية حول شرعية الخلافة[5]؛ حيث اعتبر متكلمو الأشاعرة أنفسهم حراس المذهب السني، وبالتالي حماة الخليفة، وهي السمة الأبرز للمذهب السني؛ وقد أدرج هؤلاء المتكلمون عادةً فصلًا عن الخلافة (أو الإمامة) في أعمالهم في علم الكلام كجزء من الرد السني على المعتزلة[6] والشيعة. وقد كانت الرسائل الكلامية التي كتبها هؤلاء المتكلمون -مثل الباقلاني (ت1013)، البغدادي (ت1037)، أبو يعلى (ت1066)، الجويني (ت1085)، والغزالي (ت1111)، فقط على سبيل المثال لا الحصر- تُقرأ في غالب الدراسات الغربية مقصورةً على فصولها المتعلقلة بالتقرير العقدي أو الجدل الكلامي؛ إلا أن أنجوم تناول فصول الإمامة في هذه الكتب بالبحث والدراسة وقدم مخططًا مفيدًا لمسألة الخلافة. باختصار: قدم الأشاعرة تبريرًا نظريًا لمفهوم حكم الخليفة المطلق[7] مع استبعاد المجتمع أو الجماهير من الانخراط في الشؤون السياسية[8]. بالإضافة إلى ذلك، رأى الأشاعرة في كتاباتهم أن الحياة الدينية المثالية هي تلك التي ليس لها أي صلة بشؤون الدولة؛ كما أعلن الأشاعرة ازدراءهم للسياسة، على الرغم من أنهم كانوا في الواقع جزءًا من النخبة الحاكمة القابعة في مركز السلطة.[9] لا شك أن الأشاعرة استفادوا من تدخلهم في شؤون الدولة؛ ومع ذلك، فقد حافظوا على واجهة ترفع شعار الامتناع عن الشؤون الدنيوية، بما في ذلك السياسة. ويؤكد أنجوم أن انخراطهم في السياسة كان من أجل مصلحتهم فقط، حيث إنهم لم يشعروا بأي مسؤولية تجاه الجماهير؛ ويكشف هذا الموقف عن نظرتهم لأنفسهم باعتبارهم متفوقين من الناحية الفكرية على العلماء التقليديين.[10]
في الفصل الثالث (ص137-169)، يغوص أنجوم في أعماق العقائد الكلامية الراسخة لفك شفرة ذلك الشعور الذاتي بالتفوق الذي تشبع به متأخرو الأشاعرة، خاصة فخر الدين الرازي (ت1209) ومن تبعه؛ ولأن نصيب الأسد من مجادلات ابن تيمية كان مع الرازي، فإن المؤلف ركز في الفصل الثالث على هدف كتابه: وهو استخلاص الفكر السياسي لابن تيمية. يبحث أنجوم في جذور نظرة الأشاعرة لأنفسهم بتفردهم وتفوقهم[11]، سواء كمدافعين عن المذهب السني أو كأصحاب المعرفة الباطنية التي لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة.[12] وبالاعتماد بشكل كبير على بحثي إميلي ماري جويشون ورضوان السيد، يجادل أنجوم بأن أفكار الأفلاطونية الجديدة الفلسفية كانت أساسية بالنسبة لمسائل الفاعلية السياسية والتنظيم الاجتماعي، كما شكلت هذه الأفكار بدورها شعور التفوق لدى الأشاعرة.[13] رأى الأفلاطونيون الجدد أن العقل البشري هو الجوهر الممنوح لهم من فوق، “ومثل علاقة الإنسان بالعقل -كجوهر (خارجي) فعال- فإن علاقته بالمجتمع هي نفسها، بمعنى أن المجتمع محكوم ومقيد في حياته الخاصة والعامة من قبل النخبة الفكرية التي منحها العقل الفعال الحق في الحكم… فالحاكم هو عقل المجتمع” (ص146-147، اقتباس ترجمه أنجوم من كتاب رضوان السيد “الجماعة والمجموعة والدولة”).
استطاعت هذه الأفكار التي يمكن تلخيصها على أنها سيادة العقل -عقل النخبة المتعلمة بالطبع- عن طريق التفكير الفلسفي في مصادر المعرفة الأخرى (مثل الحس المشترك بين رجال الدين)= أن تخترق الكلام السني عن طريق كتاب “قانون التأويل” للغزالي، واتخذت صورة أكثر انتظامًا مع فخر الدين الرازي.[14] يعتقد أشياع الرازي من النخبة الحاكمة في المجتمع المملوكي أن المعرفة اليقينية لا يمكن الوصول إليها اعتمادًا على الوحي؛[15] علاوة على ذلك، عند وقوع تعارض بين العقل والوحي، فإن الاستنتاجات التي أدى إليها التأمل العقلي الصحيح يجب أن تُوجِّه محتوى نصوص الوحي؛[16] وقد وسع الرازي هذا المبدأ وذهب به إلى منتهاه في كتابه “أساس التقديس” وقرر أن المقياس الذي يجب أن تُحاكَم معارفُ الوحي إليه هو المقياس العقلاني.[17] كانت إحدى النتائج الثانوية الرئيسية لهذا النظام المعرفي هو زرع الشعور بالتفوق لدى متأخري الأشاعرة؛ فقد تصوروا أنفسهم على أنهم -وحدهم- حراس الحقيقة العقلانية الصافية (ص150)[18]. وبالمثل، فقد ازدروا العلماء المحافظين وعامة الناس لتمسكهم الساذج بنصوص الوحي وعدم إبدائهم أي تحفظ حيال معانيها، وخاصة النصوص التي اعتبروا أن ظاهرها يوحي بالتجسيم، سواء في القرآن أو السنة. وهكذا رسم متأخرو الأشاعرة محيطهم، مقتبسين من “أساس التقديس” لتبرير رؤيتهم النخبوية والهرمية للعالم؛[19] كما كان تقديم وجهات نظر متشائمة حول تقدير الله السابق للأمور -مما يعني التسليم والحفاظ على النظام المجتمعي القديم- في مصلحتهم أيضًا [20]؛ ويسمي أنجوم أفكار متأخري الأشاعرة بـ “الكلبية اللاهوتية” (ص168).[21]
يناقش الجزء الثاني من الكتاب (الفصول 4-6) فكر ابن تيمية والنظرة البديلة التي قدمها على أنها تتعارض مع النظرة الأشعرية للعالم؛ ففي حين أبدى الأشاعرة نظرة تشاؤمية، أبدى ابن تيمية واقعية معرفية واجتماعية متفائلة.
الفصل الرابع (ص173-195) هو مسح تمهيدي لا غنى عنه؛ وهنا يفحص أنجوم موقف ابن تيمية من العلماء، ونظرته إلى أمراض المجتمع المملوكي، والعلاجات التي قدمها. يتمثل إنجاز أنجوم في هذا الفصل في تقديم وصف دقيق لموقف ابن تيمية الدقيق تجاه الكلام الأشعري، لا سيما استيعابه لرأي ابن تيمية أن استخدام الحوار العقلاني كان ضروريًا لمحو الأثر الضار للكلام. يسلط أنجوم الضوء على نص لم يكن محل دراسة دقيقة لأحد كتاب سيرة ابن تيمية ألا وهو محمد بن علي البزار (ت1350)، والذي يشرح فيه ابن تيمية قراره بتكريس جهوده الفكرية للكلام بدلًا من الفقه؛ فقد كان ابن تيمية ملتزمًا بشدة بالعقل لأنه كان يعتقد أن علماء الأمة -السلف- سمحوا باستخدام الحجج العقلانية لرد الأفكار الضالة، وانخرطوا في مثل هذه المساعي بأنفسهم (ص178-181).[22] وقد كان ينبغي أن يشرح أنجوم هذه النقطة بمزيد من التفصيل، ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن يفعل ذلك في أعماله المستقبلية.
لاحقًا في الفصل الرابع، يسلط المؤلف الضوء على نقاط الجدل الأساسية بين ابن تيمية والأشاعرة، ولا سيما نظرته للإرادة الإنسانية وفعالية العامل البشري. وعلى الرغم من أن هذه الموضوعات نوقشت بدقة من قبل دانيال جيماري وجون هوفر، فإن أنجوم يضع بصمته الخاصة عندما يسلط الضوء على الآثار السياسية للنظرة التيمية للإرادة الحرة، والتي تتناقض مع النسخة الرازية من العقيدة الأشعرية في أفعال العباد؛ وقد كانت تصريحات الرازي المثيرة للجدل لنصرة مذهب الجبر محل نقد ابن تيمية، الذي أكد مرارًا وتكرارًا على التأثير المدمر للجبرية على المجتمع.[23]
في الفصل الخامس (ص196-227)، يقدم أنجوم مسحًا ثاقبًا لـ “درء تعارض العقل والنقل” وأهدافه وبنيته وموضوعاته وأسلوبه. كان الغرض الرئيسي لابن تيمية من هذا العمل الضخم هو تفنيد أسس الكلام الأشعري المتأخر. ولإثبات نظرة ابن تيمية الواقعية المتفائلة في مجال السياسة، يناقش أنجوم مفاهيم “الفطرة” و”العقل الفطري” التي روج لها ابن تيمية بشكل منهجي في كتاباته. صحيحٌ أن هذه المصطلحات أساسية في نظرية المعرفة عند ابن تيمية؛ إلا أن المؤلف تناول دورها في الفكر السياسي لابن تيمية. ووفقًا لابن تيمية، فإن الفطرة صفة أساسية من سمات الشخصية الإنسانية، وجوهرها هو “حب النافع والاعتراف بالخالق الكامل، ثم محبة الله” (ص203). على المستوى المعرفي، يمكّن مفهوم الفطرة ابن تيمية من رفض ادعاء المتكلمين بأن إثبات وجود الله غير ممكن إلا من خلال التأمل العقلاني “النظر”؛ ويرى ابن تيمية أن الأشخاص الذين لم تفسد فطرتهم لديهم معرفة متأصلة بوجود الله، وهم في الواقع لا يحتاجون إلى استقراء الكتب المقدسة لكي يدركوا وجود الله.
في نهاية الفصل الخامس، يشرح أنجوم أن النظرة النخبوية لدى متكلمي الأشاعرة جعلتهم ينأون بأنفسهم عن المعتقدات الساذجة لعامة الناس[24] إلى أن أعاد ابن تيمية بناء نظام معرفي مستقل يعيد للفطرة السليمة مكانتها، ومن هنا كانت المعتقدات الفطرية التي يتشاركها عامة الناس سليمةً مقبولةً. ومع هذا النظام، أنشأ ابن تيمية بديلًا للنظام المعرفي النخبوي عند الأشاعرة، وقُدِّم هذا البديل على أنه طريق يسع عامة الناس. هذا لا يعني أن ابن تيمية يقبل كل أنواع المعتقدات الشعبية والعادات المبتذلة، بل على العكس من ذلك، فقد هاجم بشدة الطقوس الشعبية مثل تقديس الأضرحة. إن جوهر موقف ابن تيمية هو أن العقل الطبيعي -أي العقل المستنير بالفطرة السليمة- يلعب دورًا حاسمًا في الوصول إلى الحقائق الأخلاقية. لذلك، قدم ابن تيمية وجهة نظر متفائلة اعتمدت على المعتقدات “الفطرية” في مقابل الآراء التشاؤمية الوعِرة والنخبوية للأشاعرة والتي لم تولد سوى الشكوك.
في الفصل السادس (ص228-265)، يشرح أنجوم بالتفصيل فكر ابن تيمية السياسي، الذي يقوم بشكل متماسك على مبدأ الفطرة. في هذا الفصل على وجه الخصوص -وهو ذروة البحث- فإن الطريقة المراوغة التي استخدمها أنجوم لربط عدة مقدمات مطولة حول مواضيع مختلفة تحتاج خبرة من القارئ لفهمها واستيعابها. ورغم مسار الجدل المتعرج، يقدم الفصل نظرة جديدة على الفطرة، وهو مفهوم لم تتناوله الأبحاث السابقة سوى من منظور لاهوتي. أنجوم هو أول من ناقش التداعيات السياسية لمفهوم الفطرة، ومن خلال القيام بذلك، فإنه يقدم منظورًا فلسفيًا واسعًا حول موقف ابن تيمية السياسي الفريد. يبسط تحليل أنجوم أيضًا المناقشات اللاهوتية التي لا تنتهي؛ فأولًا وقبل كل شيء، الفطرة هي بمثابة تصريح منحه الله للمجتمع المسلم يرون من خلاله أنفسهم كأمناء على القانون الإلهي، بدلاً من الحكام. وتشبه الفطرة إلى حد ما “حكمة الجماهير”؛ وعلى الرغم من أن أساسها ديني، إلا أنها تشير إلى رؤية ديمقراطية يحق للمجتمع من خلالها أن يقرر مصيره بنفسه.[25] يتعارض مفهوم الفطرة تمامًا مع المفهوم النخبوي للكشف الذي روج له الغزالي.[26] في الواقع، يشير أنجوم إلى فطرة ابن تيمية على أنها النسخة “الديمقراطية” من كشف الغزالي، ومن ثم فإن طريق معرفة وجود الله وصفاته تسع الجميع، وليست حكرًا على القلة القليلة من خواص الأشاعرة.[27]
كان من الممكن أن يخرج الكتاب بصورة أفضل لو وضع مزيدًا من التحرير الدقيق، لا سيما في الحواشي؛ حيث تحتوي هذه الحواشي على مناقشات مناسبة لإدراجها في متن النص؛ وفي حالات أخرى، نجد الكثير من الأخطاء في الإحالات؛ ففي الصفحات 138-139، على سبيل المثال، يستشهد المؤلف بمقطع طويل من شرح النووي لصحيح مسلم؛ ومع ذلك، فإن الحاشية الموجودة في الصفحة 139 تحيل القارئ إلى شرح ابن حجر لصحيح البخاري. بالإضافة إلى أن شرح النووي على صحيح مسلم لم يُدرج في قائمة المراجع. وفي الصفحة 165، اقتبس المؤلف نصًا مطولًا من كتاب الرازي “المطالب العالية”، ولكن الحاشية 89 تشير إلى “التفسير الكبير” له. وفي الصفحة 229، يذكر المؤلف سيف الدين الآمدي -المتكلم الأشعري- وفكره دون أن يوضح من هو. كما حذفت العديد من المصادر التي استشهد بها المؤلف في جميع أنحاء الكتاب (على سبيل المثال: كتاب ومقال بقلم يعقوب ليف يظهران في الحواشي في الصفحتين 102 و104) من قائمة المراجع. هذه أخطاء طفيفة بلا شك، لكنها تشكل صعوبات للقارئ الذي يرغب في تعقب المصادر التي يستخدمها المؤلف. وبشكل عام، فإنها تقلل من مصداقية هذا العمل المهم.
أخيرًا، فإن “اللحظة التيمية” -المصطلح الذي ابتكره أنجوم وظهر لأول مرة في الخاتمة (ص266-273)- ليس واضحًا تمامًا. أظن أن هذه العبارة تعكس تأثر المؤلف بكتاب جون جريفيل أجارد بوكوك “اللحظة الميكافيلية”، لكنه لم يوضح ذلك؛ حيث يُترك القارئ في حيرة من أمر “اللحظة التيمية” ويضطر إلى التكهن بمعناها؛ هل هي اللحظة التي ظهر فيها ابن تيمية وتحدى الفكرة الكلاسيكية للدولة والسياسة في الإسلام؟ أو ربما تكون “اللحظة التيمية” هي “لحظةٌ ما” محددة بشكل انتقائي نظرًا لتسلسل الموضوعات رُفِضت فيها الأنماط القديمة وظهرت الأنماط الأصلية؟ على أي حال، فإذا ظل السؤال عالقًا في ذهن القارئ بعد قراءة الكتاب جيدًا، فيجب على المؤلف بذل المزيد من الجهود لتوضيحه، خاصة وأن “اللحظة التيمية” هي العنوان الفرعي للكتاب.
ومع ذلك، فإن الكتاب يقدم تجربة قراءة محفزة ومثمرة؛ ويعبر بوضوح شديد عن الآثار الجذرية لمفهوم ابن تيمية عن الفطرة. حيث يقود هذا المفهوم إلى رؤية مجتمع متناغم به الكثير من الدعم المتبادل والتضامن، حيث يتعاون كل قطاع (الحكام والعلماء والعامة) من أجل الصالح العام. يعطي هذا الوصف أوضح خلفية لدعوة ابن تيمية للناس لاتباع الخليفة الصالح فقط، على الرغم من تقديم هذه الخلفية أحيانًا بشكل متطور للغاية.
بالتأكيد فإن هذا كتاب “السياسة والفقه والمجتمع في الفكر الإسلامي في اللحظة التيمية” استطاع أن يحجز مكانه في المكتبة التيمية، نظرًا لما بُذل فيه من جهد وما يقدمه من تحليل فريد وما يعكسه من سعة اطلاع مؤلفه.
[1] تنبيه: تعليقاتي على هذه المقالة مبنية على تصوير الكاتبة لأفكار الكتاب الأصلي، وحيث إن الكتاب لم يُترجم بعد للعربية (= هو قيد النشر عند دار جداول)؛ فإن فهمي لكلام مؤلف الكتاب الأصلي متعلق بمدى دقة تصوير رأيه من قبل كاتبة هذه المقالة.
[2] العدالة الإلهية وحرية الإرادة البشرية هما مفهوم مشترك يؤدي إلى عقيدة واحدة، وهي ما يعبر عنه في الأدبيات الكلامية بـ(مسألة خلق أفعال العباد)، وإن كان القدرية -أو العدلية- متفقون على تنزيه الله عن أفعال العباد، إلا أن الخوارج -بمختلف طوائفهم الفرعية- اختلفوا في تحديد موقف موحد حول قضية خلق أفعال العباد. ولو مثّلت الكاتبة بمسألة الإمامة لكانت أدل على كونها عنصرًا رئيسًا في سلسلة الأحداث التي أدت إلى ظهور الفرق العقدية، فلدينا الخوارج والشيعة.
[3] يجب أن يُعلم أن من العقلانيين -حسب تعبير الكاتبة- الذين تبنوا عقيدة خلق القرآن في تلك الحقبة= من لا يؤمن بمبدأ حرية الإرادة البشرية.
[4] في هذا الكلام إشكال، فما العلاقة التي تربط ما بين كتابات عالم في المسائل اللاهوتية بالنظام السياسي في دولة ما؟ الركود السياسي الذي يصيب الدول له عوامل متعددة تتعلق بالظروف المحيطة بالدولة ومنهجها في إدارة شؤون الحكم. ومعلوم أن الدولة المملوكية في القرن السابع وأوائل الثامن خاضت حروبًا منهكة ضد جحافل المغول والصليبيين، وهذه الحروب لها تأثير على الدول. خاصة إذا علمنا أن مشاركات الرازي العلمية انصبت على الجانب اللاهوتي، فهو ليس ناشطًا اجتماعيًا وليس له حضور بارز في الفقه كذلك.
[5] نص عدد من متكلمي الأشعرية على أن مباحث الإمامة ليست داخلة في موضوعات علم الكلام، وإنما هي ألصق بالفقهيات؛ لكنها أُقحمت لتضخيم بعض الفرق الإسلامية لها وتحويلها إلى مسألة أصولية.
[6] المعتزلة يوافقون أهل السنة في مسائل الإمامة بشكل عام، فليس هناك ما يستوجب الرد عليهم، الخلاف في باب الإمامة يدور في مجمله مع طوائف الشيعة.
[7] ماذا يريد المؤلف بالحكم المطلق هنا؟ فالحاكم في البيئة الإسلامية في العصور الوسطى مقيد بأحكام الشرع، وليس في يده إلا السلطة التنفيذية.
[8] لا يختص الأشعرية بشيء من هذا، فهذه ممارسة يقع فيها كثير من العلماء بغض النظر عن مذاهبهم.
[9] هل يقصد المؤلف الصوفية؟ فلعدد من علماء الأشعرية مشاركات في التقعيد لما يُعرف بالفقه السياسي.
[10] اتهام لا يستند لأي دليل، فعز الدين ابن عبد السلام الشافعي أشعري ومعروف مواقفه المناهضة لسياسة بعض السلاطين في عصره، فالأمر في الواقع يتعلق بشخصية هذا المنخرط في السياسة وتقديره لواقع عصره، لا بمذهبه.
[11] كل المذاهب ترى نفسها متفردة ومتفوقة، فالأمر لا يختص بالأشعرية.
[12] يبدو أن المؤلف هنا يتحدث عن الصوفية، وهم مذهب ذو منهج مختلف عن منهج الأشعرية الكلامي، ومعرفة الله تنال بالعقل عند الأشعرية، إلا إن كان يريد الأشعرية هنا الذين جمعوا مع الكلام التصوف، وهم على أية حال لا يمثلون جوهر المذهب الكلامي.
[13] الأشعرية متكلمون وليسوا فلاسفة، وهم لا يؤمنون بمبادئ الأفلاطونية المحدثة.
[14] قد يُفهم من هذا أن سيادة العقل ظهرت مع كتابات الغزالي! والواقع أن تصرفات قدماء الأشعرية مع نصوص الوحي تدل على أنهم يؤمنون بمبدأ تقديم العقل القطعي على السمع الظني، كل ما في الأمر أن المتأخرين منهم فصلوا ووضحوا ما تحدث عنه الأقدمون.
[15] ليس هذا قولًا لهم، ولو كان الأمر كذلك لما أثبتوا كثيرًا من العقائد على مجرد الوحي من دون أن يدل عليها العقل، لكن البعض قد يفهم من قاعدة الرازي في الاحتمالات العشر أنه يرى أن الدليل النقلي لا يفيد إلا الظن، والواقع أنه يفيد اليقين عنده؛ لكن بشروط قد يراها البعض تعجيزية، ومن هنا يُنسب له أنه يرى أن الدليل النقلي لا يفيد إلا الظن.
[16] يجب ملاحظة أن الأمر مقيد هنا بالصحيح من التأمل العقلي.
[17] هذا ليس على إطلاقه، فالرازي يثبت عقائد لا دليل على إثباتها إلا السمع؛ كرؤية الله في الآخرة.
[18] ما من أتباع مذهب إلا وهم يعتقدون في أنفسهم أنهم حراس الحقيقة العقلانية الصافية.
[19] ليس لأساس التقديس ذاك التأثير القوي على أشاعرة ما بعد الرازي، بل بعض كتبه الكلامية أشد حضورًا في الدرس الكلامي من هذا الكتاب؛ ككتاب الأربعين في أصول الدين على سبيل المثال.
[20] ابن تيمية يوافق الأشعرية في الإيمان العام بالقدر خيره وشره؛ بمعنى أن الله شاء وخلق أفعال العباد الاختيارية. لا علاقة تربط ما بين الموقف اللاهوتي من شمول مشيئة الله لجميع الكائنات وبين دور العالم والمفكر في حفظ المجتمع وعدم الانخراط في الفتن السياسية.
[21] عُرّفت الكلبية الحديثة بأنها اتجاه يتمثل بانعدام الثقة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية المزعومة ورفض الحاجة إلى المشاركة الاجتماعية. وهو اتجاه متشائم حيال قدرة البشر على اتخاذ الخيارات الأخلاقية الصحيحة. تعتبر الكلبية الحديثة أحيانًا منتجًا للمجتمع الجماهيري، خاصةً في الحالات التي يعتقد الفرد فيها بوجود تباين بين دوافع وأهداف المجتمع المعلنة والدوافع والأهداف الفعلية. -المترجم.
[22] لا يمكن ادعاء أن أهل الحديث -سلف ابن تيمية- إلى القرن الثالث كانوا كلهم على هذا المنهج، فمنهم من يرفض رفضًا قاطعًا الجدل العقلي. لا يمكن إعطاء أهل الحديث حكمًا عامًا في هذه المسألة ونحن لدينا نصوص صريحة.
[23] لا شك أن موقف ابن تيمية من دور الإنسان في أفعاله مختلف عن موقف عامة الأشعرية الذين ينفون أن يكون لقدرته أي تأثير في حصول مقدوره، وهو ما يعبر عنه بالجبر المتوسط خلافًا للجبر المتطرف الذين كان يؤمن به الجهم بن صفوان وكان ينكر أن يكون للإنسان قدرة أصلًا -بحسب ما يُنقل عنه-، وإن كان الخلاف بين الجبريين في هذا خلاف في الوصف كما يذكر عبد القاهر البغدادي من متكلمي الأشعرية؛ لكن هذا لا يجعل ابن تيمية من أنصار الإرادة الحرة وهو يؤمن بمبدأ أن الله خالق أفعال العباد وأنه لا يقع منها إلا ما يشاؤه. فهو هنا معدود من الجبرية على وفق نظرة المعتزلة؛ الأنصار الحقيقيين للإرادة الحرة.
[24] كل أتباع مذهب ينأون بأنفسهم عن المعتقدات التي لا يدل عليها دليل من وجهة نظرهم، وليس الأمر متعلقًا بالنظرة النخبوية بحسب تعبير المؤلف.
[25] هذه قراءة تأويلية من المؤلف لمفهوم الفطرة عند ابن تيمية.
[26] هذا المفهوم صوفي وليس كلاميًا.
[27] لا ينبغي أن يُفهم من هذا أن الأشعرية يحكرون معرفة الله على المتكلمين، بل بإمكان العامي أن يصل إلى هذه المعرفة إذا سلك الطريق الصحيح من وجهة نظرهم، ومن هنا أفردوا كتبًا مختصرة لكي تسهل على العامي سلوك هذا الطريق، لكن لما كانت مقدمات المتكلمين فيها تفصيل وتقعيد شديد= صعب على العامة تحصيلها، ومن هنا وجه النقد لها، حتى من بعض المتكلمين، واستشهدوا بواقع العامة في عهد رسول الله، وأنه كان يكتفي منهم بإظهار الشهادتين من دون الخوض معهم في دقائق اللاهوت. وإن كان المؤلف يتحدث عن الصوفية من الأشعرية -كما يظهر من سياق كلامه- فإن الأمر في حقيقته يعود إلى منهج التصوف، لا إلى الأشعرية من حيث هو مذهب كلامي مستقل. والتصوف منهج يضم شرائح متعددة من مذاهب المسلمين، فمن المتصوفة شيعة وحنابلة… إلخ.