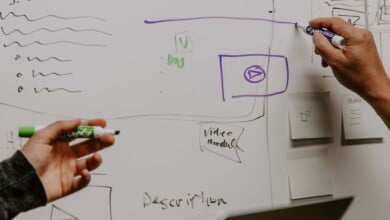قبل أن نتهادى لطرح باقة من الومضات القرآنية في رحاب الفكر الإداري، نمر على ثلاث ركائز أساسية في سياق استخلاص مثل تلك الومضات:
الركيزة الأولى: القرآن هو كتاب “هدايات عامة”
في القرآن الكريم نطالع آيات مبينة عن حكمة التنزيل: “وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ” (النحل، 89)، “مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ” (الأنعام، 38)، “وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ” (الأعراف، 52)؛ “ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ” (البقرة، 2)، ولتأكيد عالمية القرآن جاءت هذه الآية “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ” (البقرة، 185) و“وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ” (القلم، 52)، فهو إذن كتاب “هدايات عامة” للخلق أجمعين في كل مجال يحتاجه الإنسان لدينه ومعاشه وعمارته للأرض، وهذه الهدايات يمكن تصنيفها عموماً في ثلاث هدايات، وهي:
(أ) هدايات دينية: وهي التي تخص الدين والتدين وهي الأصل والأكثر في القرآن (تُغذي العلوم الدينية بمختلف فروعها)،
(ب) هدايات اجتماعية: وهي تلك المتعلقة بالإنسان والمجتمع (تُنير العلوم الإنسانية والاجتماعية بمختلف حقولها)،
(ج) هدايات طبيعية: وهي ذات الصلة بالمادة والطبيعة (تُضيء العلوم الطبيعية كالفيزياء والفلك وعلم الأرض والكيمياء والأحياء).
وهذا يعني أن القرآن الكريم يحمل هدايات للعلم بمختلف فروعه الاجتماعية والطبيعية، ولكنها هدايات عامة، إذ هو ليس نصاً مكرساً بقالب تفصيلي للعلم -غير الديني- وحقوله ومسائله وإشكالياته، بل نصاً باذلاً لهدايات بخطوط عريضة، ومتضمناً لإشارات عالية لمسائل عديدة في العلوم الاجتماعية والطبيعية على حد سواء، على أننا نلفت النظر إلى أن كثيراً من هذه الهدايات إنما هي للخلق كافة، وتكون الهدايات مصحوبةً بالرحمة في حال المؤمنين فقط، فهي خصيصة لهم وحدهم دون سواهم، كما في الآيات الكريمات السابقات وأمثالها كثير، وهذا ما يستحق تأملاً طويلاً، إذ إن الكمال لا يتحقق إلا بتحصيل الهداية والرحمة معاً.
الركيزة الثانية: القرآن يتيح هوامش للإبداع الإنساني والابتكار التطبيقي
كون القرآن هو كتاب هدايات عامة للكافة وكتاب رحمة خاصة للمؤمنين، يعني أننا بحاجة ماسة إلى أن نتلبس بقراءة إيمانية متأنية متلمسة للحكمة الربانية في هذا الحقل أو ذاك، على أن هذا النص العظيم يدع لنا مجالاً شاسعاً للاجتهاد البحثي، وفضاء رحباً للإبداع العلمي، ومجالاً كافياً للابتكار التطبيقي، حيث إنه جاء بالخطوط العريضة للهدايات الاجتماعية وهي التي تهمنا في هذا السياق، بحيث يلتقط الإنسان ما يراه ملائماً للحقل الذي يشتغل عليه، وهو التقاط لمسلمات ومبادئ وأصول عامة، تاركاً -أي القرآن- تفاصيلها وتصاميمها للإنسان، ليبلور ما يعتقد أنه يوائم بيئته ويستجيب لاحتياجاته ويبني مستقبله، وفي هذا توسعة ورحمة أيضاً.
الركيزة الثالثة: الاستدلال المنهجي الدقيق الخالي من الاعتساف
الاغتراف من هدايات القرآن الكريم يتوجب أن يكون بقالب استدلالي منهجي دقيق (من الناحية التفسيرية واللغوية) خالٍ من الاعتساف أو لَي النصوص بطريقة تجعلها توافق قَسراً هذه النظريةَ أو ذلك النموذجَ العلمي، فالنص القرآني أجلُّ من ذلك وأسمى، وهذا لا يعني البتة عدم استخلاص مبادئ عامة أو قواعد رئيسة، شريطة أن يكون ذلك بنهج اجتهادي غير حاسم.
الركائز السابقة، تؤكد إذن على أن ما سأطرحه من ومضات قرآنية إنما هو التماسات اجتهادية عامة في ضوء المبادئ الإدارية الكبرى، فالاشتغالات القرآنية هي اشتغالات على المسلمات والمبادئ والأسس والأصول. وطلباً للاختصار، توسلت بصورة مجازية، حيث جعلتُ الإدارة بمثابة الجسم، مُمرراً ومضاتي على أجزائه الرئيسة: القلب، والرأس، والقدمين، والحواس، ومسدلاً نافذة لسؤال أو أكثر عقب كل ومضة، وذلك كما يلي:
الومضة الأولى: قلب الإدارة: التعاون والعدل!
يولي النص القرآني أهمية بالغة للقلب في تحصيل الإيمان واليقين والعلم كما هو معروف، ويسعنا أن نقول إنه يجعل من التعاون والعدالة قلباً للإدارة، فالقلب الأيمن هو التعاون الذي يعكس “مشروعية الإدارة” (لماذا وجدتْ؟)؛ مجلياً لنا جوهر تعريف الإدارة، حيث إنها التعاون مع الآخرين لتحقيق الأهداف المنشودة كما هو معلوم، والقلب الأيسر هو العدل الذي يعكس “غاية الإدارة”، مظهراً لنا الهدف الجوهر للإدارة، إذ إنها تستهدف تحقيق العدالة الداخلية في محيط المنظمة والعدالة الخارجية في محيط المجتمع، ولا يمكن للقلب أن يعمل إلا إذ تضافرتْ أجزاؤه وتعاضدتْ في نسق تعاضدي تكاملي، فغذَّت العدالةُ التعاونَ، وضمنتْ من ثمَّ الاستمرار والبقاء والنمو للمنظمة، ولنا إذن أن نقول إذا أصلحت الإدارة قلبَها أي تعاونها وعدالتها صلحتْ، وصحَّ جسمُها وسائرُ عملها. وفي صفحة القلب، نجد هذه الآيات الكريمات:
- “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” (المائدة، 2).
- ” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا” (النساء، 58).
- ” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ” (النحل، 90).
وللتأكيد على محورية العدالة في الفكر الإسلامي بعامة، ومنه الفكر الإداري والفكر الاقتصادي، فإن ابن تيمية يشدد على “أن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقة وجله”[1].
نافذة سؤال: كيف يمكن لهذه الومضة أن تعيننا على إعادة شحن منظماتنا بـ “التعاون الخيِّر الدائم” و”العدالة الممتزجة بالإحسان” ؟
الومضة الثانية: رأس الإدارة: الشورى!
بعد الفراغ من تأسيس “قلب الإدارة” وضمان صلاحه عبر تحقيق مقومات التعاون والعدالة بكل استحقاقاتها وتجلياتها في الفضاء الإداري، فإن النص القرآني يسوق لنا الشورى بوصفها “عقل الإدارة”، فهو يحث على الممارسة الشورية للنظر في المسائل وتقليب الأمور واتخاذ القرارات الناجعة، ومن الآيات الدالة على ذلك يلي:
- ” فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ” (آل عمران، 159).
- ” وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ” (الشورى، 38).
وهنا نلحظ أن الشورى القرآنية ليست مجرد “آلية إدارية” جامدة أو خالية من الأبعاد القيمية أو الوجدانية أو القيادية، إذ هي مطعمة بالرحمة واللين في موضعه، كما أنها مزدانة بالعزم القيادي والمضي الإداري في موضعه، مما يجعلها آلية فعالة في تخصيب العقل الإداري بالآراء المتنوعة والأفكار المتجددة. ومن جهة ثانية، يعالج النص الخالد أدواء التفكير والقرار، ومن ذلك أنه يعالج باقتدار ما يسمى بـ التفكير الجمعي Group Think الذي يمكن أن يعصف بالمنظمات من جراء تلبسها بتفكير القطيع، حيث يقول تعالى: “قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا” (سبأ، 46)، فالتوجيه القرآني يشير إلى أن التفكير الفردي أو الثنائي مفيد في الانعتاق من التفكير الجمعي القاتل للحقيقة أو المصلحة!
شاهد عملي على الشورى، وهو ملائم لسياقنا الراهن في وقت جائحة كورونا:
يذكر ابن عباس رضي الله عنهما “أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (وهي قريةٌ بِوَادِي تَبُوكَ مِنْ طَرِيقِ الشَّام) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. (فَإِنِّي مَاضٍ لِمَا أَرَى فَانْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَامْضُوا لَهُ، قَالَ: فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ- فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ” (متفق عليه.)
نافذة سؤال: كيف نطيق ترسيخ نهجي شوري فعال في المنظمات المعاصرة بما يحقق المصالح وبما يحقق الذوات الجماعية والفردية؟
الومضة الثالثة: قدما الإدارة: الأمانة والقدرة!
حينما نستقرئ النص القرآني، نجد أنه يقرر أن الإدارة لا تسير إلا على قدمين اثنين، وهما: الأمانة من جهة، والقدرة من جهة ثانية، وفي هذا نجد العديد من النصوص، ومنها:
- “قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ” (يوسف، 55).
- “إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ” (القصص، 26).
قدم الأمانة يفضي بالإدارة إلى القرارات والسلوكيات الأخلاقية، فلا تضييع لثروات المنظمة، ولا اختلاس لأموالها وأوقاتها ومقدراتها. وقدم القدرة يوصل الإدارة إلى العلم والخبرة والمهارة والقوة والشخصية. والقراءة المتأنية للآيتين السابقتين تجعلنا نظفر بومضة الأولويات، حيث نلحظ أنه في الآية الأولى قُدمتْ الأمانة على القدرة (العلم)، لكون العمل مختصاً بـ “خزائن الأرض”، أي الثروة، مما يجعل الأمانة في رتبة أعلى من جهة أولويتها، في حين أنه في الآية الثانية قُدمتْ القدرة (القوة) على الأمانة، لكون العمل يستلزم القوة أولاً والأمانة ثانياً.
نافذة سؤال: كيف نتمكن من إعادة استنبات الأمانة والقدرة في تربة الإدارة، بما يثمر الكفاءة والفعالية والنمو والنزاهة والحوكمة الرشيدة؟
الومضة الرابعة: أعضاء الإدارة وحواسها: الإتقان والرقابة والعقود والحساب
يُجهِّز النصُ القرآني الفكرَ الإداري بالعديد من الأعضاء والحواس التي تمكَّنه من التقاط المعلومات وتشغيلها بطريقة تفضي إلى العمق والدقة من جهة والنجاعة والفعالية من جهة ثانية، ومن ذلك مثلاً ما يلي:
1- الإتقان
يركَّب القرآن الكريم في جسد الإدارة كل ما يجعلها متقنة لعملها بأحسن ما يمكن، ولهذا نجد آيات محكمات تشدد على ذلك، ومنها: “الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ” (الملك، 2)، “لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا” (الكهف، 7)، وهنا لفتة قرآنية بديعة، حيث إن المفاضلة ليست بين الحسن والردئ، كلا، بل بين الحسن والأحسن، ولهذا تكررت كثيراُ كلمةُ “أحسن” في القرآن الكريم، من قبيل: “وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم” (الزمر، 55)، “وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” (النحل، 125)، “ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” (فصلت، 34)، “وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ” (فصلت، 33). وفي هذا الإطار، شدتني آية كريمة لمعنى نفيس، وهو معنى يمكن أن يعيننا على تطوير منظومة التقييم والمكافآت وفق منظور نفسي عميق. تأملوا معي هذه الآية: “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (النحل، 97)، حيث ذهبت الآية إلى أن الجزاء إنما يكون “بأحسن ما كانوا يعملون”، وهو ما قد يضيف أبعاداً تحفيزية هائلة، وقد يخلق نقطة تحول عند البعض حينما نعامله بمثل هذه المعاملة، وقد يكون ذلك ناجعاً في مجال التعليم أيضاً عبر تبني آليات وممارسات تعول على الأداء الأفضل للطلبة وما إلى ذلك.
2- الوفاء بالعقود
السعي للإتقان لا يعني أن يكون الفكر الإداري خالياً من الأطر التعاقدية الضابطة للسلوك والأداء، ولهذا فإن فكرة “العقد” تلعب دوراً كبيراً في الفكر الإداري، ومن ذلك تعويل إدارة الموارد البشرية على العقود المبرمة مع الموظفين، وهنا نجد توجيهاً ربانياً يؤسس لمبدأ إيفاء العقود، سواء كان في إطار “العقد القانوني” المبني على شروط ومصالح للطرفين بقالب نظامي صريح واضح، كما في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” (المائدة، 1) ، أو في إطار عقد يُرتب على طرف واحد فقط عطاء محدداً وجملة من المهام والمسؤوليات للطرف الآخر كما في قوله: “وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا” (الإسراء، 34)، سواء أكان ذلك من طرف المنظمة أو العامل. وهنا نلفت النظر إلى خطورة ما بات يُسمى بـ “العقد النفسي”، وهو العقد الذي يضمره العامل في نفسه ولا يبديه، وقد يكون حاملاً له على التقصير عن أداء بعض مهامه والوفاء ببعض مسؤولياته، لكونه يعتقد أن المقابل المادي والمعنوي الذي يحصل عليه أقل مما يستحق، ويحدث ذلك في قالب سري غير معلن لصاحب العمل (المنظمة)، وهو ما يعد خرقاً لهذه المبادئ التي يؤسسها قرآننا الخالد.
3– الرقابة
تلمس الإتقان ووجود الإطار التعاقدي لا يغنيان البتة عن الرقابة على الأداء والسلوك في المنظمات. وللرقابة أنوع وأرقاها مرتبة “الإحسان”، كما في قوله تعالى: “لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ” (يونس، 26)، حيث تتضمن الآية معنى العبادة مع مراقبة الله، كما في حديث “الإحسانُ أن تعبدَ اللهَ كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يَراك” (صحيح الجامع). وهذا لون راقٍ من الرقابة، إذ إنها رقابة ذاتية، وهو ما يجعلها شديدة الفعالية، في كل وقت وفي كل سياق إداري. ويجذر القرآن الكريم معاني الرقابة بباقة من الآيات ومنها: “إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا” (النساء، 1)، “وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا” (الأحزاب، 52).
4– الحساب والتكميم
من الأدوات المهمة في الفكر الإداري الحديث المدخل الكمي، حيث يعين على المتابعة والتقييم والرقابة والمكافأة أو العقاب، وقد أولى القرآن الكريم هذا الجانب أهمية بالغة، ومن ذلك قوله تعالى: “لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ” (يونس، 5). على أننا نشير إلى “خرافة” يتناقلها بعض المتخصصين أو القراء في الإدارة ومفادها أن “كل ما لا يُقاس لا يمكن إدارته”، حيث يمثل ذلك تطرفاً شديداً في جانب الكم، وهو نابع من تطرف الفكر الغربي في قالبه العلموي الوضعاني، ونحن لا نقر بهذا ولا نرى له مسوغاً البتة، فالإدارة – مثلها مثل أي فعالية إنسانية- مليئة بالأبعاد التي لا تخضع لمقاييس كمية جامدة، مما يجعلها مفتقرة إلى لون من “الإدارة الكيفية” و”التفكير النوعي”، ويدخل في ذلك الأبعاد ذات العلاقة بالحدوس القيادية والاجتهادات الإدارية التي تتضمن مقاربات كيفية لبعض المسائل والقرارات والمواقف.
نافذة سؤال: كيف نشحذ بطارية الإتقان بوقود الإيمان؟ كيف نجذر لسلوكيات الوفاء بالعقود والعهود من منطلقات جوانية دينية؟ كيف نستثمر في مفهوم الإحسان لتطوير الأداء والفعالية والجودة في المنظمات المعاصرة؟ كيف نزاوج بين التفكيرين الكمي والكيفي في سياق يعضد دقة الكم وحكمة الكيف ونجاعة الإدارة؟
وأخيراً: كيف نطور منهجيتنا في الإفادة من هذا النص القرآني العظيم الخالد في سائر علومنا الدينية والاجتماعية والطبيعية، بما يجعلنا قادرين على الظفر بالهدايات والرحمات معاً، فنكون أقوى في فكرنا وعملنا، وحاضرنا ومستقبلنا؟
[*] هذا النص يمثل محاضرة للكاتب بالعنوان نفسه، كليةُ الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، يوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021م.
[1] تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، السياسة الشرعية، الرياض: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية، ط1، 1418هـ، ص 124.