- عُثمان بن عبدالله العمودي
لعله لا يخفى عليك إذا قلبتَ باب المراثي من ديوان الحماسة لأبي تمام وأزحتَ عن صفحاتِه عقابيلَ الأشجان وبواعثَ الأسى= أن أعظم من رُثي في هذا الباب هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القطعةِ المشهورة المنسوبة للشماخ: (جزى الله خيراً من أميرٍ).. والتي ختمها بقوله:
وما كنتُ أخشى أن تكون وفاتُه
بكفَّيْ سَبنتى أزرقِ العين مُطرقِ
يريد أنه لم يكن يخطر بباله يوماً أن ينال من أمير المؤمنين عبدٌ أعجميٌ جسور غليظ!
فكما أن العرب كانت تُفاضل بين الميتات وترى أن (موتَ الفتى بالسيف أعلى وأفخرُ)؛ فكذلك كانت ترى الرجلَ الشريف العزيز لا يقتلهُ إلا (قِرنه) و(خصمه) و(نظيره) في الشرف والعزة، ولذلك طالت أوصافُهم لخصومهم بالشجاعةِ والإقدام، حتى تسمع الرجل منهم يفخر إذا قتل (فارساً في غِمار الموت منغمِسا)، والآخر يهزُّ سيفَه في عظمِ قِرنه فتتهلَّلُ (نواجذُ أفواهِ المنايا الضواحكِ)، وليس الفتى الشجاعُ فيهم إلا من كان (يسمو إلى الأقران غير مقلّمِ)!
وسيستقرُّ هذا المعنى في نفسك كثيرا وأنت تقلّب ديوان الحماسة.. ولكنك إذا سئمتَ من ذلك التقليب، وتاقت نفسُك للعروج إلى السماء بمعراجٍ من نور النبوة، فأخذتَ صحيح البخاري بكلتا يديك ثم أقبلت عليه تتصفح أوراقَه برفق وشغف؛ فستعجَب لاضطراب ذلك المعنى الذي كان استقر، وستتوقف قليلا مع قصة قتل الفاروق، فلقد كان له ميزانٌ من الإيمان مختلف!
ستقرأ أن الناس لما انصرفوا من صلاتهم بعدما طُعن عُمر رضي الله عنه، (قال: يا ابن عباس! انظر من قتلني، فجال ساعةً ثم جاء فقال: غلامُ المغيرة، فقال عمر: الصّنَع؟ قال: نعم، فقال: قاتله الله! لقد أمرتُ به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجلٍ يدعي الإسلام)[1]! وفي رواية غير الصحيح: (الحمد لله الذي لم يقتلني رجل يحاجُّني بلا إله إلا الله يوم القيامة)!
إن شيئاً ما وقَر في صدر عمر جعلَه ينطق بتلك الكلمات، وأمراً ما وقع في نفسه نقلَه من موقف (ذم تلك الميتة واستهجانها) إلى موقف (حَمدها واستحسانها)..
وأنت إذا نظرتَ إلى المعاني المستقرة عند العرب، وعلمتَ أنهم كانوا يرون القتل على يد العبد الأعجمي مذمة= ضربتَ أخماساً في أسداس وأنت تتساءل عن السر الذي صرفَ نظر الفاروق عن المعاني المادية الدنيوية -كالعبودية والعُجمة- إلى المعاني الشريفة الأخروية -كالإسلام والتوحيد-!
لم يُطِل هذا التساؤلُ جولانَه في خاطري، فلقد تذكرتُ شيئاً من الإجابة عنه في نصٍّ بديعِ التحليل للإمام ابن سيرين يقول فيه: (وانتُدب لهجو المشركين ثلاثةٌ من الأنصار: حسان ابن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة.. فكان حسان وكعب بن مالك يعارضانهم بمثل قولهم في الوقائع والأيام والمآثر، ويذكران مثالبهم.. وكان عبدُ الله بن رواحة يعيرهم بالكفر وعبادةِ ما لا يسمع ولا ينفع.. فكان قولُه يومئذ أهونَ القول عليهم، وكان قول حسان وكعب أشدَّ القول عليهم.. فلما أسلموا وفقهوا كان أشدَّ القول عليهم قول عبد الله ابن رواحة)[2]!
وهذا تحليل لطيف، فهو نوعٌ من الفقه إذن! فقهٌ في النظر والوزن والتقدير، فقهٌ بحقيقة المعاني التي تُناط بها الأحكام.. ولعله هو نفسه المعنى الذي أراده عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل وفاته في حديثه الذي تبكي لكتابته الأقلام، فقال -كما في صحيح مسلم-: (إني قد كنتُ على أطباق ثلاث، لقد رأيتُني وما أحدٌ أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحبَّ إلي أن أكون قد استمكنتُ منه فقتلته، فلو متُّ على تلك الحال لكنتُ من أهل النار.. فلما جعل الله الإسلامَ في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم… فما كان أحد أحبَّ إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجلَّ في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عينيَّ منه إجلالا له، ولو سئلتُ أن أصِفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عينيَّ منه، ولو متُّ على تلك الحال لرجوتُ أن أكون من أهل الجنة)[3].. فيا لله أيُّ معنىً ذلك الذي انطوى عليه قلبُه فانتشلَه من غياهبِ الضلالة إلى نور الهدى، ومن نيرانِ الشتات إلى برد اليقين..
والعجيب أن جوابَ هذا السرِّ كان ظاهراً عندهم كما رأيتَ، ولكن لما بعُدت منا نصوصهم غمُضت علينا أحوالهم، فعمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: (فلما جعل الله الإسلامَ في قلبي…)، وابن سيرين يقول: (فلما أسلموا وفقهوا…)، فالقوم كانوا يعلمون أن مِن أعظم مقاصد الإسلام: تغييرَ موازين النظر للأمور وضبطَ معاييرها في النفوس؛ لتكون إيمانيةً أخرويةً خالصة، وليس يغيبُ عن أدنى ناظرٍ أن الحِكمة كلَّ الحِكمة إنما هي في كون المعيار الذي يُقاس عليه: منضبطا مستقرًّا لا ينخرم، {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} ..
لا عجبَ أن يكون ذلك من مقاصد الكتاب العظيم الذي نزل نوراً وهدىً للناس، وليس بمستغربٍ أن تنقلب تصوراتُ المرء وموازينه عن الذي كانت عليه وهو يقرأ في القرآن قصةَ السحَرة الذين جمعهم فرعونُ لكيده، فأقبلوا وقد امتلأتْ صدورُهم غيظا وأعينُهم طمعا، فجمعوا كيدهم وأتوا صفّا، ثم كان ما كان من نصر الله، ووقَع الحق وبطَل ما كانوا يعملون.. وما هو إلا أن يلج الإسلامُ صدورَهم حتى يستقيم لهم ميزانُ النظر في الحقائق، وينتقل طمعُهم المذموم فيما عند فرعون {أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا}، إلى طمعٍ محمود فيما عند الله {إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا}، ثم يحكي القرآنُ ارتقاءَ غاياتهم وانصرافَ هممهم إلى ما هو أبعد من ذلك: {وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ}، وتأتي الخاتمة بذكر الميزان الحقيقي: {وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ}!
تتلو سورة القصص ثم تتوقف مع قصة قارون، وتقرأ ما أنعم الله عليه به من المتاع والكنوز والفضل والزينة، وتُصوِّر في مخيلّتك خروجَه على قومه ببهرجه وأبّهته، ثم تقرأ أن ناساً اضطرب ميزانُهم فقالوا لما رأوه: {يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}.. فيجيب رجالٌ قد وزنوا كلامهم بالعلم والإيمان: {وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ}..
ولو أخذتَ تتلمس هذا المعنى في أحاديث المصطفى لفاضَت بك كؤوسُ النصوص.. يسألهم مرةً (أتدرون ما المفلس؟) فيقولون: (المفلس فينا من لا درهمَ له ولا متاع)، فينقلهم عن هذا المعنى الدنيوي المبتذل إلى معنىً أخروي شريف: (إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيَت حسناتُه قبل أن يُقضى ما عليه أخُذ من خطاياهم فطُرِحت عليهم ثم طُرح في النار)[4]! فاللهم إنا نعوذ بك من هذا الفلَس.. ويطّلع عليهم مرةً أخرى فيقول: (ما تعدون الرَّقوب فيكم)؟ فيقولون: (الذي لا يُولد له)، فيقول: (ليس ذاك بالرَّقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدِّم من ولدِه شيئا) ثم قال في نفس مجلسه: (فما تعدون الصُّرَعة فيكم)؟ قالوا: (الذي لا يصرعه الرجال)، فقال: (ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسَه عند الغضب)[5]..
فهذه الأحاديث كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم منها (بيان ما هو أحق بأسماء المدح والذم مما يظنونه)[6]، كما يعبر ابن تيمية، وقال في موضع آخر متحدّثاً عن نفي لفظ (المفلس) و(الرقوب) عن حقائقها الدنيوية المتبادرة إلى الذهن: (فهذا نفيٌ لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذي يجب اعتباره)[7]، نعم هو هذا الذي ذكره أبو العباس، ما يجب اعتباره من المعاني وما يجب اطّراحه..
وقلِّب في دواوين السنة تجد عجبا، فمعنى (الهجرة) تجده في الهجرة عما نهى الله، ومعنى (الغنى) يرتفع عن الماديات إلى غنى النفس، وغير هذا كثير، وكأنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معه ميزانَ الإيمان هذا فيزِن به كلَّ معنى في النفوس، وحفظ ذلك عنه الصحابةُ فصاروا يكيلون به أقوالهم وأعمالهم.. وهذا طرَفٌ من أطراف تفضيلهم على من بعدهم، فإنهم كانوا ينظرون إلى الأمور بعدسةِ الوحي، ويعرضون المعاني على ميزان الإيمان.. فكانوا (الصفوةَ من قرون هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله)[8]..
ولا يستقيم هذا الميزان لرجلٍ حتى يعتاد (ممارسة الكتاب والسنة) و(الاستضاءة بنورهما) كما سمى ذلك أبو حامد الغزالي[9]، وكما ترى الرجل الذي طال حبسُه في الظلمة يذهَل فور خروجه وتعرُّضِه لأشعة الشمس، فكذلك ما يلبث المرءُ يكرر على نظره وسمعه آياتِ القرآن وألفاظَ السنة حتى يرفع رأسه ذاهلاً من انقلاب حاله وتغيُّر ميزان النظر عنده.. فيبصر الأمورَ على حقيقتها، ويدرك المعاني على وجهها، ويعرف مآخذَ المدح والذم، ومنازعَ الحق والباطل، ويسلّطَ على ظلام الوقائع نوراً سماوياً يكشف له الخفيات الغوامض.. فأما إذا لم يكن له من النظر في نصوص الوحي حظّ، فلا يحفل كثيرا بميزان نظره، ولا يفرح بوِرده ولا بصدَرِه، فلقد (عُطّلَ ميزانٌ من العِلم راجحُ)!
[1] صحيح البخاري (3700)، والرواية الأخرى في: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (93).
[2] الاستيعاب لابن عبد البر (1/344).
[3] صحيح مسلم (121).
[4] صحيح مسلم (2581).
[5] صحيح مسلم (2608)، ونحوه في البخاري (6114).
[6] مجموع الفتاوى (18/280).
[7] مجموع الفتاوى (25/157).
[8] مجموع الفتاوى (3/156)، وهي كلمة من نص الرسالة الواسطية.
[9] إحياء علوم الدين (3/313)، (3/378).



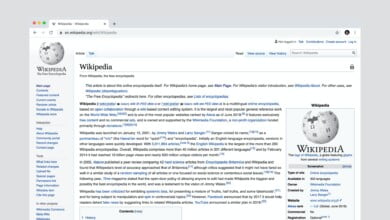

أفدت وأجدت جزاك الله خيرًا أخي الحبيب
لافض فوك