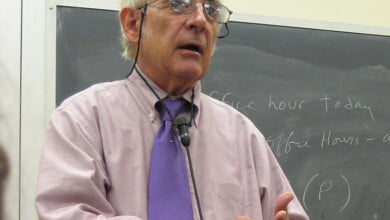د. عائض بن سعد الدوسري
في مرافعته ضد العلوم والفنون والآداب، يَشِنُّ رائد التنوير الفيلسوف التربوي الفرنسي جان جاك روسو (1778م) حربًا ضروسًا عليها، مُبَرْهِنًا على أنَّها تقوم بدورٍ رئيسٍ في إفساد الأخلاق في المجتمع، وأنَّها المسئولة عن انحطاط المجتمع المتمدن؛ بما تُمارسه من ترفٍ ورفاهيَّة مُخَدِّرَةٍ لِمَلَكَاتِهِ، وبهذا تكون العلوم والفنون والآداب سببًا جوهريًّا في انحطاط أخلاق الشعوب!
وقد كانت تلك المرافعة في مقالةٍ كَتَبَها استجابة لإعلانٍ رآه في جريدة عن مسابقة تنظمها أكاديمية ديجون The Academy of Dijon عن دور العلوم في المجتمعات، فَشَرَعَ في كتابة مقالته تلك يثبت فيها رأيه. يقول كريستوفر بيرترام، أستاذ الفلسفة الاجتماعية والسياسية بقسم الفلسفة بجامعة بريستول: “ادعى جان جاك روسو حينها استيعاب فكرة أن البشر بطبيعتهم خَيِّرين ولكن المجتمع يفسدهم. فشرع روسو في أول خطابٍ له حول العلوم والفنون، وفاز بالجائزة الأولى في أطروحته التي تنص على أنَّ التنمية الاجتماعيَّة -بما فيها الفنون والعلوم- قد أدت إلى تآكل وانحسار الفضائل المدنيَّة والصفات الأخلاقيَّة”.
مما قاله جان جاك روسو في تلك المقالة: “هناك رواية قديمة انتقلت من مصر إلى اليونان، تقول إنَّ إلهًا عدوًّا لراحة النَّاس هو مَن أبدع العلوم”، “إنَّ العلوم والفنون تدين بنشأتها لرذائلنا، فلو كانت تدين لفضائلنا لما تشكَّكنا بهذا القدر فيما لها من الفوائد”، “كم من السبل الباطلة في تقصي العلم!”، “وهناك شرور أخرى أعظم، تنتج عن الآداب والفنون؛ كالترف الذي ينشأ عن الفراغ والغرور، إذ يندر أن يوجد الترف في غياب العلوم والفنون”، “وهكذا يفضي فساد الأخلاق -إذ ينجرُّ عن الترف بالضرورة- إلى فساد الذوق”، “ولقد اعترف الرومانيون بأنَّ الفضيلة الحربيَّة بدأت تخمد عندهم بقدر مهارتهم في الرسوم والنقوش والأواني المصوغة، وبقدر إنمائهم للفنون الجميلة”، “إنَّ جمهوريات يونان العريقة، بحكمتها الساطعة في معظم مؤسساتها، قد حرَّمَت على مواطنيها تلك المهن الهانئة الساكنة؛ إذ تضعف الجسم وتفسده، ولا تلبث أن تصيب النَّفسَ بالوهن”، “وإذا كانت الثقافة العلميَّة تضرُّ بالخصال القتاليَّة، فهي تضرُّ بالخصال الأخلاقيَّة أكثر”.
ثم يَكِرُّ جان جاك روسو على انتشار ظاهرة التماثيل والأصنام واللوحات الزيتيَّة في أوروبا المستمدة من الأساطير اليونانيَّة والرومانيَّة، فيقول: “إنَّها تقدِّمُ صورًا لضياع القلب والعقل، انتُقِيَت من الميثولوجيا القديمة وعُرِضَت مبكرًا على أطفالنا المتعطشين للمعرفة، عُرِضَت عليهم بالتأكيد ليقفوا على نماذج من الأعمال القبيحة حتى قبل أن يحسنوا القراءة”، “فهل ترك الفكر الوثني للأجيال اللاحقة، بعدما أوقع عقل الإنسان في شتى الضلالات، ما يجوز مقارنته بالآثار المخجلة التي أعدَّتها لها المطبعة”، “إنَّ الكتابات الملحدة التي ألفها لوقبس ودياغوراس قد فنت بفنائهما، إذ لم يتم بعدُ اختراع فن تخليد شذوذ الفكر الإنساني، لكن بفضل حروف الطباعة ومجالات استخدامها، كُتِبَ لهواجس هوبس وسبينوزا وأمثالهما البقاء أبدًا”. ثم يتنبأ جان جاك روسو بأنَّ الأجيال القادمة في المستقبل سوف تدعو بهذا الدعاء: “يا رب يا قدير، أنت من تملك العقول بين يديك، خلِّصنا من الأنوار ومن الفنون المشؤومة الموروثة عن آبائنا، وأعد إلينا جهلنا وفقرنا وبراءتنا، فهي الخيرات الوحيدة القادرة على إسعادنا، وهي في نظرك أثمن ما تراه عندنا”.
ثم يتوقع جان جاك روسو أنَّ الحكماء والعقلاء من الأباطرة والملوك في أوروبا سيقفون ضد هذه العلوم والآداب والفنون التي ساهمت الأدوات الحديثة في وقته (=المطبعة) في سرعة انتشارها بين النَّاس فتوسع ضررها ودمارها، حيث يقول: “إذا اعتبرنا الفوضى المفزعة التي أحدثتها المطبعة في أوروبا، وحكمنا على المستقبل بالنظر إلى تفاقم الشرِّ يومًا بعد يوم، نتوقع بسهولة دأب الملوك في إقصاء هذا الفن المريع من ممالكهم بعدما كان دأبهم على إيراده”.
ويُقَدِّم جان جاك روسو إلى أباطرة وملوك أوروبا أنموذجًا لكي يحتذوا به، وهو عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، حيث يقول: “يُروى أنَّ الخليفة عمر، عندما استُشير بشأن مكتبة الإسكندريَّة وما يجب أن يكون مصيرها، قَدَّمَ الجواب التالي: (إذا كانت مؤلفات هذه المكتبة تتضمن أمورًا منافية للقرآن؛ فهي رديئة ولا بُدَّ من حرقها، وإذا كانت لا تتضمن إلا ما جاء به القرآن؛ فاحرقوها أيضًا لأنَّها زائدة)”.
وهكذا، فإنَّ جان جاك روسو في سياق حماسته ضد الأضرار الأخلاقيَّة التي تنتجها العلوم والفنون والآداب، استشهد بحكاية حرق كتب مكتبة الإسكندريَّة بأمرِ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه؛ ليثبت صواب رأيه وليؤيد حكمه وأنَّه حكمٌ سديدٌ وحكيمٌ. وهذه الحكاية التي وظَّفَها جان جاك روسو في مخاطبة قومه، حكاية مشهورة جدًا في أوروبا في زمن روسو وقبله بمدةٍ، وكانت تُستخدم ويُستشهد بها لأغراضٍ متباينةٍ، وإن كان الأغراض الأكثر شيوعًا هو من قِبَلِ أصحاب الدعاية المناوئة للإسلام والعرب في الغرب.
مبدأ الحكاية ومصادرها، وانتشارها بين الكُتَّاب:
يكاد ينعقد إجماع الباحثين الذين ناقشوا حكاية إحراق مكتبة الإسكندريَّة من الغربيين والمسلمين وغيرهم -قديمًا وحديثًا- على أنَّ أوَّلَ مرجعٍ أشار إلى هذه الحكاية ونسبها إلى عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه عند فتح مصر سنة (641م)، هو: موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، الذي ولد سنة (557هـ/1162م) وتُوفي سنة (629هـ/1231م).
وقد وردت هذه الحكاية عند موفق الدين البغدادي في إشارة مقتضبة في رحلته إلى مصر، في كتابه المعروف باسم: (الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر)، حيث قال وهو يتحدث عن مشاهداته في مدينة الاسكندريَّة وآثارها الباقية: “ورأيتُ بالإسكندريَّة عمود السواري، وهو عمود أحمر منقط من الحجر…ثم إنِّي رأيتُ بشاطئ البحر مما يلي سور المدينة أكثر من أربعمائة عمود مكسورة…وزعم أهل الاسكندريَّة قاطبة أنَّها كانت منتصبة حول عمود السواري…ورأيتُ –أيضًا- حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة، بعضها صحيح وبعضها مكسور، ويظهر من حالها أنَّها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف، وعمود السواري عليه قبة هو حاملها. وأرى أنَّه الرواق الذي كان يُدَرِّس فيه أرسطوطاليس وشيعته من بعده، وأنَّه دار العلم التي بناها الإسكندر حين بنى مدينته، وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه”.
ثم جاء بعده بقليلٍ جَمَالُ الدَّينِ علي بن يوسف بن ابراهيم القِفْطِي، الذي ولد سنة (568هـ/1172م) وتوفي سنة (646هـ/1248م)، فقَصَّ حكاية طويلة أكثر تفصيلاً وتشويقًا في كتابه (إخبار العلماء بأخبار الحكماء). حيث تضمنت قصة تاريخيَّة رُمَانسيَّة عن جمع مكتبة الكتب الفلسفيَّة في مدينة الإسكندريَّة، ثم في نهاية المطاف حادثة الأمر بإحراقها ونسبة ذلك إلى عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه عند فتح المسلمين لمصر. وقد وَرَدَ كل ذلك عند ترجمة القِفْطِيِّ ليحيى النحوي، وهو هنا يقصد بلا شك الفيلسوف والمنطقي المسيحي جون فيلوبونوس (John Philoponus)، المعروف باسم يوحنَّا النحوي أو يوحنَّا السكندري، حيث ذَكَرَ القِفْطِيُّ في ترجمته تلك أنَّه: “كثير التصانيف، صَنَّفَ في شرح كتب أرسطوطاليس…وكتاب الرد على برقلس القائل بالدهر…وكتاب الرد على نسطورس…وكان قويًّا في علم النحو والمنطق والفلسفة”.
ومما قاله القِفْطِيُّ في تلك الترجمة: “يحيى النحوي المصري الإسكندراني، تلميذ شاواري [ساواري]. كان أُسْقُفًا في كنيسة الإسكندريَّة بمصر، ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبيَّة، ثم رجع عمَّا يعتقده النصارى في التثليث لما قَرَأَ كتب الحكمة واستحال عنده جعل الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً. ولما تحققت الأساقفة بمصر رجوعه عَزَّ عليهم ذَلِكَ فاجتمعوا إِلَيْهِ وناظروه، فغلب وزيف طريقه، فَعَزَّ عليهم جهله، واستعطفوه وآنسوه وسألوه الرجوع عمَّا هو عليهِ وترك إظهار مَا تحققه، وناظرهم فلم يرجع، فأسقطوه عن المنـزلة التي هو فِيهَا بعد خُطُوبٍ جرت. وعاش إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر والإسكندرية، ودخل على عمرو وقد عَرَفَ موضعه من العلم واعتقاده، وما جرى له مع النصارى؛ فأكرمه عمرو ورأى له موضعًا، وسمع كلامه في إبطال التثليث فأعجبه، وسمع كلامه -أيضًا- في انقضاء الدهر [=مسألة حدوث العَالَم] ففتن به، وشَاهَدَ من حججه المنطقيَّة وسَمَعَ من ألفاظه الفلسفيَّة التي لم يكن للعرب بها أنسة ما هَالَهُ. وكان عمرو عاقلاً حسن الاستماع صحيح الفكر، فلازمه وكاد لا يفارقه. ثم قال له يحيى يومًا: إنك قد أحطت بحواصل الإسكندرية، وختمت على كل الأصناف الموجودة بها، فأمَّا ما لك به انتفاعٌ فلا أعارضك فيه، وأمَّا ما لا نفع لكم به فنحن أولى به؛ فامر بالإفراج عنه. فقال له عمرو: وما الذي تحتاج إليه؟ قال: كتب الحكمة في الخزائن الملوكيَّة، وقد أوقعتَ الحوطة عليها، ونحن محتاجون إليها ولا نفع لكم بها. فقال له: ومَن جَمَعَ هذه الكتب وما قصتها؟ فقال له يحيى: إنَّ بطولوماؤس فيلادلفوس، من ملوك الإسكندرية، لما مَلَكَ حُبِّبَ إليه العلم والعلماء، وفَحَصَ عن كتب العلم وأمر بجمعها، وأفرد لها خزائن فجمعت، وولى أمرها رجلاً يُعْرَف بزميرة، وتقدم إليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالغة في أثمانها وترغيب تُجَّارِها، ففعل واجتمع من ذلك في مدة أربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون كتابًا، ولما علم الملك باجتماعها وتحقق عدتها، قال لزميرة: أترى بقي في الأرض من كتب العلوم ما لم يكن عندنا؟ فقال له زميرة: قد بقي في الدنيا شيءٌ كثيرٌ، في السند، والهند، وفارس، وجرجان، والأرمان، وبابل، والموصل، وعند الروم. فعجب الملك من ذلك، وقال له: دم على التحصيل. فلم يزل على ذلك إلى أن مات الملك. وهذه الكتب لم تزل محروسة محفوظة يُراعيها كل من يلي الأمر من الملوك وأتباعهم إلى وقتنا هذا. فاستكثر عمرو ما ذكره يحيى وعجب منه، وقال له: لا يمكنني أن آمر بأمرٍ إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكتب إلى عمر، وعَرَّفَهُ قول يحيى الذي ذكرناه، واستأذنه ما الذي يصنعه فيها، فورد عليه كتاب عمر، يقول فيه: (وأما الكتب التي ذكرتها؛ فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى، وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله تعالى فلا حاجة إليها، فَتَقَدَّم بإعدامها). فَشَرَعَ عمرو بن العاص في تفريقها على حمَّامات الإسكندريَّة وأحرقها في مواقدها، وذكرت عدة الحمَّامات يومئذ وأنسيتها، فذكروا أنَّها استنفدت في مدة ستة أشهر، فاسمع ما جرى واعجب”. وقال في موضعٍ آخر: “يحيى النحوي الإسكندري، الأُسْقُف بِهَا فِي أول الإسلام”.
ثم جاء بعد القِفْطِي العَالمُ والمؤرخُ واللاهوتيُّ النصرانيُّ المعروف غريغوريوس بن هارون الملطي المشهور بابن العبري، الذي ولد سنة (623هـ/1226م) من أبٍ يهوديٍّ اعتنق النصرانيَّة كما تُؤكِّد ذلك الموسوعة اليهوديَّة وغيرها، وتوفي سنة (685هـ/1286م)، في مدينة مراغة من أعمال أذربيجان. نُصِّبَ ابن العبري أُسْقَفًا لليعاقبة في مدينة حلب، ثم ارتقى إلى رتبة جاثليق على كرسي المشرق سنة 1264م.
وقد ذَكَرَ ابن العبري تلك الحكاية، ويظهر واضحًا أنَّه نقلها في كتابه (تاريخ مختصر الدول) حرفيًّا من كتاب القِفْطِيِّ مع شيءٍ من الاختصار والحذف، ولهذا لا صِحَّة لاتهام بعض الباحثين له بأنَّه هو من اختلق تلك القصة، فإنَّما هو ناقلٌ لها من القِفْطِيِّ. أمَّا بشأن حكاية حرق مكتبة الاسكندريَّة، فقد قال ابن العبري وهو يتحدث عن زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “وفي هذا الزمان اشتهر بين الإسلاميين يحيى، المعروف عندنا بغرماطيقوس أي النحويّ، وكان اسكندريًّا يعتقد اعتقاد النصارى اليعقوبيَّة ويشيد عقيدة ساوري، ثم رجع عمَّا يعتقده النصارى في التثليث، فاجتمع إليه الأساقفة بمصر وسألوه الرجوع عمَّا هو عليه، فلم يرجع، فأسقطوهُ من منـزلته، وعاش إلى أن فتح عمرو بن العاص مدينة الاسكندريةَّ. ودخل على عمرو، وقد عَرَفَ موضعه من العلوم، فأكرمهُ عمرو، وسمع من ألفاظه الفلسفيَّة التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هَالهُ ففتن به. وكان عمرو عاقلاً حسن الاستماع صحيح الفكر، فلازمهُ وكان لا يفارقه. ثم قال له يحيى يومًا: إنك قد أحطت بحواصل الاسكندريَّة، وختمت على كل الأشياء الموجودة بها، فما لك به انتفاع فلا أعارضك فيه، وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به. فقال له عمرو: وما الذي تحتاج إليه؟ قال: كتب الحكمة التي في خزائِن الملوكيَّة، فقال له عمرو: لا يمكنني أن آمر فيها إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكتب إلى عمر وعرَّفهُ قول يحيى، فورد عليه كتاب عمر، يقول فيه: (وأما الكتب التي ذكرتها؛ فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله، ففي كتاب الله عنه غنى، وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة إليه، فتقدم بإعدامها). فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمَّامات الإسكندرية وإحراقها في مواقدها. فاستنفدت [وفي نسخة الأب أنطون اليسوعي: فاستيقدت] في ستة أشهر، فاسمع ما جرى واعجب”.
وكتاب ابن العبري هذا –كما ذَهَبَ إلى ذلك كثيرٌ من الباحثين كالمؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون، والمستشرق واشنطن إيرفينغ، وآرثر جلين، والمؤرخ روث ستيلهورن ماكنسن، والعلامة شبلي النعماني– هو المرجع الذي تُرْجِمَ إلى اللاتينيَّة ووصل إلى أوروبا، ومن خلاله انتشرت حكاية حرق عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه للمكتبة بين الفلاسفة والكُتَّاب التنويريين في الغرب، من أمثال جان جاك روسو، وذلك حين نشره بوكوك (1691م) مع ترجمة لاتينيَّة. يقول المستشرق الأمريكي برنارد لويس: “أصبحت هذه القصة معروفة للأوساط العلميَّة الغربية لأول مرة في عام 1663م، عندما نشر إدوارد بوكوك، أستاذ اللغة العربية في جامعة أكسفورد، طبعة من النص العربي مع الترجمة اللاتينية لجزء من موجز (تاريخ مختصر الدول) للمؤلف السُّرياني المسيحي ابن العبري، المعروف أيضًا بأبي الفرج“. ويقول إدوارد جيبون (1794م): “منذ أن قُدِّمَ كتاب ابن العبري إلى العالم في النسخة اللاتينية، تم نسخ الحكاية مرارًا وتكرارًا”. ويقول شبلي النعماني (1914م): “من خلال هذه النسخة اللاتينيَّة وصلت هذه الحكاية إلى كل جزءٍ من أوروبا”. ويقول المؤرخ جيمس هانام، المتخصص في تاريخ وفلسفة العلوم من جامعة كامبريدج: “من أشهر الأساطير عن المكتبة الكبرى [في الإسكندريَّة] أنَّها أحرقت بأمر من الخليفة عمر بعد أن استولى العرب على الإسكندرية. فقد اشتهرت القصة في أوروبا بسبب ترجمة تاريخ ابن العبري، ولكن تم فضح زيفها بنجاح من قبل إدوارد جيبون، وأنَّه من النادر أن تجد من يدافع عن هذه الأسطورة اليوم”.
ثم جاء ابن خلدون (1406م)، فلم يشر بشيءٍ أبدًا في تاريخه إلى حكاية إحراق كتب الإسكندريَّة. قال العالم الهندي شبلي النعماني: “لما ذَكَرَ ابن خلدون فتح مصر وإسكندريَّة -وهو المظنة لذكر هذه الواقعة- لم يتفوه بهذه الرواية أصلاً”. لكنَّ ابن خلدون أشار في مقدمته إلى حادثة إتلافِ كُتُبِ علوم الفرس بأمرٍ من عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه. يقول ابن خلدون: “فالعلوم كثيرة، والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون، وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل، فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضي الله عنه بمحوها عند الفتح”. لكنَّ ابن خلدون -وهو في القرن الثامن/التاسع الهجري- أشار إلى تلك الحادثة إشارة عابرة، ولم يسند كلامه، ولا عزاه لمصدرٍ، ولا رواه رواة.
ثم لما جاء المؤرخ تقي الدين المقريزي (1442م)، نقل ما كتبه موفق الدين البغدادي بصورةٍ شبه حرفيَّة. وهكذا، انتشرت هذه الحكاية وراجت في القرون المتأخِّرَة، وصارت محلَّ جدلٍ واسع بين الغربيين أنفسهم، بين مثبتٍ ونافٍ، وبين الشرقيين والغربيين، وإن كان كثيرٌ من كبار الغربيين يحكم بعدم ثبوتها، من أمثال: ألفريد بتلر، وفيكتور شوفين، وبول كازانوفا، وأوجينيو جريفيني. يقول شبلي النعماني: “والحاصل، أنَّ محققي أهل أوروبا قضوا بأنَّ الواقعة غير ثابتة أصلاً، منهم: جيبون المؤرخ الشهير الإنجليزي، ودريبر الأمريكاني، وسيديو الفرنساوي، وكريل الألماني، والمعلم رينان الفرنساوي”.
ومع ظهور أسطوريَّة الحكاية للناقد، إلا أنَّ هذه الحكاية استخدمت من قِبَلِ كثيرٍ من الكُتَّاب الغربيين للطعن في الإسلام والعرب غالبًا، ووصفهم بأنَّهم من الأجناس التي لا تحترم تراث الحضارة ولا تحتفي بالعلوم والآداب. وتلقاها عنهم بالقبول والتأييد كُتَّابٌ عرب، كالكاتبُ النصرانيُّ جرجي زيدان في كتابه (تاريخ التمدن الإسلامي)، مُبَرْهِنًا على أنَّ الإسلام جاء ليهدم العلوم، وإن كان جرجي زيدان في الحقيقة إنَّما أعاد تدوير استشهادات الكُتَّاب الغريبيين نفسها من المراجع العربيَّة واستخدمها، وزاد عليها تقريراتٍ ضعيفةٍ ومُتَحَيِّزَةٍ ضد العرب. يقول: “أما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله، فَرَسَّخَ في الأذهان أنَّه لا ينبغي أن ينظر في كتابٍ غير القرآن…فتوطدت العزائم على الاكتفاء به عن كلِّ كتابٍ سواه، ومحو ما كان قبله من كتب العلم في دولتي الروم والفرس…فلا غرو إذا قيل: إنَّ العرب أحرقوا مكتبة الإسكندرية”. وحينما أدرك جرجي زيدان الهُوَّة الساحقة بين تاريخ الحادثة وتاريخ أول من أرَّخَ لها، وأنَّ ذلك يتعارض حتمًا مع إثبات الدعوى، قال: “بقي علينا البحث في المصدر الذي نَقَلَ عنه ابن القِفْطِيّ، والغالب أنَّه نفس المصدر الذي نقل عنه عبد اللطيف البغدادي…ولكن لسوء الحظ قد ضاعت تلك المصادر في جملة ما ضاع من مؤلفات العرب”. وقد عَلَّقَ العلامة شبلي أفندي النعماني على مثل مزاعمه تلك، فقال: “لا يخفى على أمثالكم أن إغارات جرجي زيدان على أعراض العرب في كتابه (تاريخ التمدن الإسلامي) أكثر من أن تحصى، وأنَّ كل ما دَسَّهُ وموَّه به لا أصل له أصلاً”. وتَعَقَّبَ كلامه في كتابه (انتقاد كتاب تاريخ التمدن الاسلامي)، وفَنَّدَ شبهاته.
كذلك تلقف تلك الحكاية بحماسٍ كُتَّابٌ من الطائفة الشيعيَّة الإماميَّة، ولم تكن لدى هؤلاء -الذين وقفتُ على كتاباتهم- أدنى أصالة بحثيَّة، وإنَّما نقلوا كلام جرجي زيدان كله حرفيًا تأييدًا له، ودافعوا عن صحة ثبوت حادثة الإحراق؛ للطعن في شخصيَّة عمر بن الخَطَّابِ رضي الله عنه. فمثلاً: قال عبد الحسين الأميني النجفي (المعروف بالعلامة الأميني): “والله يعلم ما خسره المسلمون بإبادة تلك الثروة العلمية في الإسكندرية…[فقد] أعقب ذلك العمل الممقوت تقهقرًا في العلوم، وفقرًا في الدنيا، وسمعة سيئة لحقت العروبة والاسلام، وفي النُّقاد من يحسبه توحشًا، وفيهم من يعده من عمل الجاهلين”. ولم يكتف العالم الإمامي نجاح الطائي بنسبة إحراق مكتبة الإسكندرية إلى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه فحسب، بل نَسَبَ إليه -أيضًا- إحراق مكتبات العراق، وقَرَنَ بين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه وبين زعيم الغزو المغولي هولاكو على بغداد في تدمير مكتبات العراق، وقال: “وهاتان الخسارتان للكتب العلميَّة لم ولن تعوضا أبدًا”.
وهكذا، فقد تَبَيَّنَ أنَّ تلك الحكاية وردت الإشارة إليها أول مرة بصورةٍ مقتضبةٍ عند موفق الدين البغدادي (1231م)، ثم وردت الحكاية في قصة دراميَّة طويلة مُرَكَّبَةٍ عند جَمَال الدَّينِ القِفْطِي (1248م)، ثم نقلها عنه مُختَصِرًا لها ابن العبري سنة (1286م)، ثم حكاها عنهم بعد ذلك من جاء بعدهم، فشاعت في كتب كثيرٍ من الشرقيين والغربيين.
نَقْدُ الحكاية:
وُجِّهَ إلى هذه الحكاية نَقْدٌ في سندها وفي متنها، إذ إنَّ أيَّ روايةٍ لكي تصح لا بُدَّ أن يَسْلَم سندها ومتنها من القوادح، وسوف نستعرض أهم النقود التي يُمكن توجيهها إلى هذه الحكاية سندًا ومتنًا.
أولاً: نَقْدُ سند الحكاية:
يُمكن مُناقشة أهم نقدٍ وُجِّهَ إلى هذه الحكاية من جهةِ سندها من خلال أمرين:
[1] سَنَدُ البغداديِّ والقِفْطِيِّ وابن العبريِّ.
متى حصل حادث الإحراق المفترض؟ قيل في تلك الحكاية إنَّ الحادثة وَقَعَت عندما فُتِحَت مصر سنة (641م/642م) بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. أي أنَّ حادثة إحراق الكتب وَقَعَت في النصف الأول من القرن السابع الميلادي، وأقدم مؤرخ ذكرها كان في النصف الأول من القرن الثالث عشر، أي أنَّ الفاصل الزمني بين الحادثة المفترضة وبين أول من أشار إليها كان تقريبًا: ستة قرون! ولا شك أنَّ الباحث والمؤرخ يتساءل هنا، فيقول: حادثة بهذه الأهميَّة البالغة، تتعلق بتوجيهٍ من الخلافة الراشدة قام بها الخليفة الثاني رضي الله عنه، ونفَّذها صحابيٌّ أميرٌ على مصر، وبهذا الحجم الكبير، والمدة الزمنية الطويلة اللافتة لأنظار جميع النَّاس هناك، واستمرت عمليات الإحراق مدة ستة أشهر في آلاف الحمَّامات العامَّة وأمام مرأى ومشاهدة النَّاس، خاصتهم وعامتهم، فهي بذلك تتوافر بجدارة على جميع مقومات التأريخ والتدوين لها، ومع ذلك لا نجد من يذكرها أو يُشير إليها لا من المؤرخين ولا من علماء الحديث ولا غيرهم في القرون الأولى، ولا نجد الإشارة إليها إلا بعد ستة قرون من وقوعها. ولهذا، يقول المستشرق الأمريكي برنارد لويس: “أقوى حُجَّة ضد القصة -إلى حدٍّ بعيدٍ- هي الدليل الضعيف والمتأخر الذي تستند إليه”.
فهناك مدة زمنيَّة عظيمة من الانقطاع تفصل ما بين وقت الحادثة وبين تدوينها، فلا بُدَّ إذن من وجود أدلةٍ ماديَّةٍ قويَّة أو شهاداتٍ عينيَّة موثوقة وموثَّقة تؤكد وقوع تلك الحادثة حتى يُحكم عليها بالصحة والثبوت. ولم يكن البغداديّ أو القِفْطِيّ أو ابن العبريّ بطبيعة الحال ممن شاهدوا الحادثة بأم أعينهم وأرخوا لها بناءً على ذلك، ولا هم الذين نقلوا تلك الحادثة راوية عن طريق سندٍ متصلٍ بالثقات ينتهي إلى المصدر الأصل الذي عاصر تلك الحادثة، ولا يوجد عند أحدهم مصدرٌ حقيقيٌّ استقوا منه تلك الحادثة فهم ينقلون عنه، بحكم الفترة الطويلة الفاصلة بين حادثة الإحراق وبين تأريخهم لتلك الحادثة في كتبهم، فلم ينص واحدٌ منهم على مصدره الأصل لتلك الحادثة. بل رَجَّحَ جملةٌ من أهل الاختصاص في البحث أنَّ موفق الدين البغدادي أخذ معلوماته أثناء زيارته لمصر من مصدرٍ مجهولٍ مُعَادٍ للإسلام والمسلمين، أو إشاعاتٍ شفهيَّة وحكاياتٍ شعبيةٍ رائجةٍ سمعها من بعض عوام السُّكان هناك، فضلاً عن تطور حجم ومحتوى الحكاية عند القِفْطِيِّ، مما يُوحي بأنَّ القصة جُمِّعَت من قصصٍ متفرقة ثم رُكِّبَت بصورةٍ متعمدةٍ، وزيد عليها بعض التفاصيل التي انفرد القِفْطِيُّ بها.
يقول العالم الهندي شبلي النعماني: “إنَّ البغدادي -وهو أقدمهما- من القرن السادس للهجرة، وذكر الراوية من غير إسناد، ومن غير إحالة على كتاب…[فـ]إنَّ الناقل للرواية لا بُدَّ أن يكون شهد الواقعة، فإن لم يشهد فليبين سند الرواية ومصدرها، حتى تتصل الرواية إلى من شهدها بنفسه…[فـ]البغدادي والقِفْطِي من رجال القرن السادس والسابع، فأيُّ عبرة برواية تتعلق بالقرن الأول يذكرانها من غير سندٍ ولا روايةٍ ولا إحالة على كتاب”.
وعليه، فإنَّ البغدادي والقِفْطِي وابن العبري لم يعتمدوا على أية طريقة تثبت وقوع الحادثة، فلم يعتمدوا على مشاهدةٍ عينيةٍ، ولا على مصادر معتمدة وموثوقة متقدمة، ولا نقلوها عن طريق رواية سندها متصل. ولهذا فإنَّ هذه الحكاية لا يوجد لها أيُّ سَنَدٍ تاريخيٍّ، ولم يتوافر فيها أقل درجات التوثيق التاريخي.
[2] المصَادرُ المُعَاصِرة للحادث.
أكَّدَ كثيرٌ من المحققين والباحثين أنَّ المصادر، سواء العربيَّة أو الأجنبيَّة، المعاصرة للحادثة أو القريبة منها لم تذكرها ولم تُشر إليها. ولهذا يقول المستشرق الفرنسي لويس سيديو: “لم يذكرها أحدٌ من المؤرخين المعاصرين له”. ويقول شبلي النعماني: “أما كتب القدماء الموثوق بها فليس لهذه الرواية فيها أثر ولا عين”، وبعد أن أورد أسماء كثيرٍ منها، قال: “فقد تصفَّحناها وكرَّرنا النظر فيها، ومع أنَّ فتح الإسكندريَّة مذكورٌ فيها بقضها وقضيضها ليس لحريق الخزانة فيها ذكرٌ”. ويقول البروفيسور جاك ريسلر، الأستاذ بمعهد باريس للدراسات الإسلاميَّة: “كانت خمسة قرون ونصف القرن قد مَرَّت وانصرمت ما بين وقوع الحادثة المزعومة وأول إعلانٍ عنها، في حين أنَّ أيَّ معاصرٍ لا يأتي على ذكرها”.
فالمؤرخون المتقدمون من العرب، كالطبري، والكندي، واليعقوبي، والبلاذري، وابن عبد الحكم، لم يذكروها. والمؤرخون الأجانب القريبون من الفتح الإسلامي أو من أتوا بعده، مع سردهم للوقائع والأحداث، وحديثهم عن فتح مصر وغيرها، إلا أنَّهم لم يذكروا شيئًا عن تلك الحادثة، كالمؤرخ يوحنا النقيوسي في كتابه: (تاريخ مصر). ويوحنا النقيوسي عاش في القرن السابع الميلادي، وكان أُسْقُفًا قبطيًّا مصريًّا لأبراشيَّة مدينة نقيوس، وكَتَبَ تاريخًا عن أحداث دخول العرب إلى مصر، ويعتبر كتابًا مهمًا بمثابة رواية قبطية للأحداث. يقول المؤرخ ألفريد بتلر: “لو كان في المدينة مكتبة ٌ عامةٌ كبرى قبل الفتح ثم أحرقها العرب عند فتحهم لها، لما أغفل ذكر هذا الحادث رجل ٌ مثل يوحنا النقيوسي؛ كاتبٌ قريب العهد بالفتح، قد أفاض في ذكر الإسكندرية، وفصَّل في وصف فتحها، وما كان ليُبيح لنفسه أن يدع للنسيان حادثة كان لها عظيم الأثر؛ إذ ذهبت بما كان يمكنه الاعتماد عليه فيَ كتابة تاريخه، وحرمت العالم أجمع من كنـزٍ من أكبر كنوز العلم حرمانًا أبديًّا”. ويقول المؤرخ جيمس هانام: “صمت المؤرخ المسيحي يوحنا النقيوسي عن هذا الموضوع، وهو المعاصر والقريب من الحدث- يجب أن يؤدي إلى رفض علاقة العرب [بإحراق المكتبة]”.
وكذلك المؤرخ المسيحي البطريرك أفتيشيوس المعروف بسعيد ابن بطريق (940م)، في كتابه (التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق)، الذي كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكليَّة من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلاميَّة، ذَكَرَ خلافة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وتحدث عن فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه لمصر والإسكندريَّة، ولم يشر بشيءٍ أبدًا إلى تلك الحادثة.
يقول الدكتور والمؤرخ المعروف ألفرد بتلر: “لم يرد لها ذكر مكتوب قبل مضي خمسة قرون ونصف قرن على فتح الإسكندرية، ويمنع من تصديقها إغفال كل الكتاب لذكرها”. وتقول الدكتورة ديانا ديليا، المتخصصة في التاريخ القديم وتاريخ الإسكندريَّة خصوصًا في جامعة كولومبيا: “ظهرت هذه القصة فجأة على السطح في القرن الثالث عشر الميلادي بعد خمسة قرون ونصف من الصمت”.
ولهذا، يقول المستشرق الأمريكي برنارد لويس: “أسطورة الدَّمار العربي لمكتبة الإسكندرية لا تدعمها حتى وثيقة مزيفة”. وأمام هذا الغياب التَّام لذكر الحادثة أو الإشارة إليها من قِبَلِ المؤرخين المعاصرين للحادثة أو القدماء القريبين منها، اعترف جرجي زيدان بـ”خلو كتب الفتح من ذكر هذه الحادثة”، إلا أنَّه افترضَ أهميَّة وجود سببٍ لخلو تلك الكتب، وهذا السبب في رأيه هو: “الغالب أنَّهم ذكروها ثم حذفت بعد نضج التمدن الإسلامي واشتغال المسلمين بالعلم ومعرفتهم قدر الكتب، فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه”، وهذا في الحقيقة اتهامٌ صريحٌ للمسلمين بالتواطؤ على تزوير كتب التاريخ كلها، والتلاعب في محتواها من أجل عدم تشويه سمعة عصر الخلافة الراشدة! ولو قُبِلَت هذه العلة في حقِّ المسلمين خجلاً من تاريخهم ومجاملة لخلفائهم، فإَّنها لا تسري على المؤرخين الأقباط والسُّريان. ثم يبدو أنَّ جرجي زيدان أدرك تهافت دعواه تلك، فقال: “أو لعل لذلك سببًا آخر”، ثم قال: “وعلى أيِّ حالٍ، فقد ترجح عندنا صدق رواية أبي الفرج“. إذن الحكاية عند جرجي زيدان لا بُدَّ من إثباتها مهما يكن الثمن، فلا حاجة إلى وجود أدلة أو نصوص تثبتها ولا أهميَّة لوجود أدلة أو نصوص تنفيها! يقول شبلي النعماني، في تعليقه على دعوى جرجي زيدان أنَّ المسلمين حذفوها من كتبهم: “لا يستبعد مثل هذا الكلام عن مثل المؤلف، وكيف يقدر ديانة مؤرخي الإسلام، وشدتهم في تحري الصدق، ونزاهتهم عن التغيير والتحريف وبراءة ساحتهم عن الحذف والإسقاط، من صار غريزته تعمد الكذب والتحريف والخيانة والمحو والإثبات”.
ثانيًا: نَقْدُ متن الحكاية:
مع عدم وجود سندٍ تاريخيٍّ لهذا الحكاية، إلا أنَّ متنها –أيضًا- لا يسلم من طعونٍ جوهريَّة تُسقِطُ قيمتها كليَّةً، وتحيلها إلى أسطورة أو مجرد حكايات شعبيَّة ملفقة. وبما أنَّ محتوى كلام موفق الدين البغدادي يختلف عن محتوى كلام القِفْطِي وابن العبري، فسوف أناقش أولاً محتوى البغدادي، ثم أُعَرِّجُ بعد ذلك على محتوى القِفْطِيِّ وابن العبريِّ:
[1] الحكاية عند موفق الدِّين البغداديِّ.
يقول ابن أبي أصيبعة عن كتابه: “ذَكَرَ [البغداديُّ] فيه أشياء شاهدها أو سمعها ممن عاينها تذهل العقل، وسمى ذلك الكتاب كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر…وفرغ من تأليفه في العاشر من شعبان سنة ثلاث وستمائة بالبيت المقدس”. وبتحليل نصِّ البغداديِّ نجد أنَّ المعلومات التي وردت فيه حَصَّلها من خلال ثلاثة مصادر: (أ) مشاهداته عينيَّة، (ب) سماعه من الأهلي الأخبار والمعلومات المتداولة والشائعة، (ج) رأيه وتخمينه الشخصي. وهذه الأمور الثلاثة لا تنطبق فقط على هذا النص، بل تنطبق على معظم ما جاء في رحلته، بالإضافة إلى ما يذكر أنَّه قرأه في كتب الديانات القديمة وغيرها من الكتب -معلومٌ مؤلفها أو مجهولٌ- ما يوافق ما سمعه أو رآه أو زاد عليه، فيضيف تلك المعلومة إلى ذلك.
فأما المشاهدات العينيَّة في هذا النصِّ، فهي الوصف الذي قَدَّمَهُ البغداديُّ للمباني والسور والأعمدة التي لا تزال قائمة، وينصُّ على ذلك بقوله: “رأيتُ”. وهذه الجزئيَّة، أي وجود بقايا الأعمدة التي في مدينة الإسكندريَّة حقيقة مشاهدة وصفها مؤرخون ورحالة قبل البغدادي، بل قبل الإسلام، حيث وصف إيونابيوس (414م)، دمار المكتبة والمعابد وأنَّها “قد تناثرت في الرياح”، ثم قال: “فقط أرضية معبد السيرابيوم لم يأخذوها، ببساطة بسبب وزن الحجارة التي لم يكن من السهل إزالتها من مكانها”.
وأمَّا سماعه من الأهلي الأخبار والمعلومات المتداولة والشائعة، فمثل قوله في رحلته عمَّا سمعه من كلام النَّاس هناك: “وأخبرني صيادوها…”، “ويزعمون أنَّ جثته مدفونة تحت الأرض…”، “خبرني بعض قضاة بوصير أنهم نبشوا ثلاثة قبور…”، “وخبرني الثقة أنهم وجدوا…”، إلخ. وهي معلومات وأخبار يحتاج كل واحدٍ منها إلى فحصٍ ودراسة لبيان مدى صحته ودقته. ومما جاء في هذا الباب في هذا النص الشاهد، قوله: “وزعم أهل الاسكندريَّة قاطبة أنَّها [=الأربعمائة عمود] كانت منتصبة حول عمود السواري”.
وأخيرًا، ما يتعلق برأيه وتحليله الشخصي، وهو ما يهمنا هنا، حيث قال: “وعمود السواري عليه قبة هو حاملها. وأرى أنَّه الرواق الذي كان يُدِّرِس فيه أرسطوطاليس وشيعته من بعده، وأنَّه دار العلم التي بناها الإسكندر حين بنى مدينته، وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه“. فبعد أن وَصَفَ مشاهداته العينيَّة للأعمدة، وأورد ما سمعه من مزاعم النَّاس حول ذلك، ذَكَرَ رأيه في طبيعة هذا المكان، وأنَّه سقيفة الدراسة والمكان التي كان يُدَرِّس فيها الفيلسوف اليوناني أرسطو وتلامذته من بعده، وأنَّه المكان الذي توجد فيه المكتبة التي أحرقها عمرو بن العاص رضي الله عنه.
وهذا الرأي والظَّن من البغداديِّ يتضمن أخطاء فادحة، قائمة على مجرد التخمين. ويدل على ذلك أمور:
أولاً: تاريخ تأسيس ووجود مكتبة الإسكندريَّة.
فالمكتبة لم تُوجد بالاتفاق إلا بعد وجود مدينة الإسكندريَّة، وهي المدينة التي أمر ببنائها الإسكندر الأكبر، تلميذ أرسطو، فنشأة المكتبة متأخرة عن بناء المدينة ووجودها. فالإسكندر أمر بتأسيس مدينة الإسكندرية عند احتلاله لمصر حوالي سنة 331 ق.م، ولم يشهدها حيث لم يلبث في مصر إلا بضعة شهور ثم غادرها إلى فارس، ومات بعيدًا عنها سنة 323 ق.م قبل أن يراها مدينة. أمَّا أستاذه أرسطو فقد مات بعده بعام سنة 322 ق.م، ومكتبة الإسكندرية القديمة إنَّما شُيدت سنة 295 ق.م خلال عهد بطليموس الثاني.
ثانيًا: أرسطو ومصر.
أنَّ أرسطو لم يزر مصر قط، فضلاً أن يزور مدينة الإسكندريَّة، فضلاً أن يُدرِّسَ في المكتبة هو وتلامذته قبل أن تُوجد. وتؤكد ذلك البروفيسورة ماري ليفكوويتز، وهي أستاذة أكاديمية متخصصة في تاريخ اليونان القديمة والرومان، حيث تقول: “الروايات القديمة عن حياة أرسطو لا تقول شيئًا عن زيارته لمصر، ولم تذكر أي من روايات حياة أرسطو أي شيء عن رحلاته هناك”. ثم تقول: “لقد دَرَسْتُ هذا الموضوع، ولم يذهب أرسطو إلى مصر أبدًا، وبينما لا يُعرف تاريخ مكتبة الإسكندرية على وجه الدقة، فمن المؤكد أنَّها بُنِيَتْ فقط بعد بضع سنوات من تأسيس المدينة، أي بعد وفاة أرسطو والإسكندر“. ويُؤكِّد شبلي النعماني أنَّ المؤرخ عبد اللطيف البغدادي لم يقتصر على ذكر حادثة الإحراق كوقائع لا أساس لها من الصحة، بل كل ما ذكره في هذا السياق غير صحيح، ومن ذلك حكاية الرواق، فلم يكن أصلاً هذا الرواق هو المكان الذي كان يُدَرِّس فيه أرسطو. فما ذَكَرَه البغداديُّ عن ارتباط هذا المكان بأرسطو وتلامذته والمكتبة، خاطئٌ تمامًا، ويُشير المؤرخ ألفريد بتلر إلى ما يُمكن أن يكون سببًا لهذا الوهم عند أمثال البغداديِّ، حيث يقول: “وبقي اسم أرسطو متصلاً بالعلم الإسكندري في معهد السرابيوم، كما كان من قبل متصلاً بمعهد المتحف. ومعنى ذلك أنَّ دراسة الفلسفة والعلوم بقيت على عهدها بالإسكندرية…وهذا يُفسر كثرة اقتران اسم أرسطاطاليس ببناء السرابيوم في مؤلفات المسلمين”.
كذلك ما ذَكَرَه البغداديُّ من دعوى الإحراق فلا يستند إلى أيِّ دليلٍ أو مصدر، ويبدو أنَّها مقولة شعبيَّة سمعها من العامَّة في الإسكندريَّة. ويذكر شبلي النعماني أنَّ ذكر البغداديِّ لحادثة إحراق المكتبة جاء عرضًا –وهو أمرٌ يُقِرُّهُ جورجي زيدان– لكنَّها في الحقيقة أشبه بخرافة كانت تتداولها الألسن فساقها عند ذكره لمكان المكتبة المزعوم، وقد تبّيَّنَ أنَّ عبارته بجملتها غير صحيحة. يقول المؤرخ عبد الوهاب النجار: “لم يقل لنا [البغداديُّ] من أيِّ تاريخٍ أخذ، ولا من أيِّ مصدرٍ استقى. والظاهر أنَّه حين علم أنَّه كان في هذا المكان مكتبة عفى الزمان على أثرها، افترض أنَّ الذي دمَّرها إنَّما هو عمرو بن العاص قائد المسلمين، وربما شجعه على ذلك أقوال العامَّة أو نحو ذلك، فظن الأمر حقيقة واقعة”. ومع كل ذلك، يزعم جرجي زيدان عند إشارة البغداديِّ العَرَضِيَّة تلك أنَّها: “تدل على وثوق قائلها بصحتها، كأنَّه أخذها عن مصدر موثوق به ومعول عليه في ذلك العصر”!
ثالثًا: أصول الحكاية ما قبل الإسلام.
إنَّ أصل هذه الحكاية يرجع في الحقيقة إلى تلك الشائعات والأقوال الشعبيَّة التي سمعها البغداديُّ من بعض سُكَّان مدينة الإسكندريَّة، والتي كانت جذورها سابقة على الإسلام، فحقيقة هذه الحكاية الشعبيَّة إسقاطٌ لما في التاريخ المسيحيِّ على التاريخ الإسلاميِّ. فقد جاء في مجموعة من (الدساتير الرسوليَّة) -المكتوبة في أواخر القرن الرابع الميلادي، كتعاليم موثوقة بشأن السلوك الأخلاقي والليتورجيا والتنظيم الكَنَسِيِّ، قُدِّمَت بمثابة دليلٍ لرجال الدِّين- تحذيرٌ واضحٌ للمؤمن من قراءة كتب العلم والتاريخ والقوانين والآداب والشعر والحكمة والفلسفة، وأنَّ عليه الاكتفاء بقراءة الكتاب المُقَدِّسِ فقط. فمما جاء في تلك الدساتير الرسوليَّة: “امتنع عن جميع الكتب الوثنيَّة، فماذا تنتـفع بمثل هذه الخطابات أو القوانين الأجنبية أو الأنبياء الكذبة التي تفسد الإيمان المتزعزع؟ فما الضعف الذي تجده في شريعة الله حتى تلجأ إلى تلك الخرافات الوثنيَّة؟ لأنَّه إذا كان لديك عقل لقراءة التاريخ فلديك كتب الملوك، وفي قراءة كتب الحكمة أو الشعر فلديك كتب الأنبياء وأيوب والأمثال التي ستجد فيها عُمقَ حكمةٍ أعظم من كل الشعراء والسفسطائيين الوثنيين؛ لأنَّ هذه هي كلمات الرب الإله الحكيم الوحيد، وإذا كنتَ ترغب في ترنيمة شيءٍ فلديك المزامير؛ أو كنت تبحث عن أصل الأشياء، فلديك سفر التكوين؛ أو الشرائع والفرائض فلديك شريعة الربِّ الإله المجيدة، ولذلك امتنع تمامًا عن جميع الكتب الغريبة والشيطانيَّة”.
وفي رسالة أرسلها البابا الروماني غريغوري الأول الملقب بالقديس غريغوري العظيم (604م) إلى ديسيديريوس، وهو أُسْقُف بلاد الغال [=فرنسا وبلجيكا ومعظم سويسر]، ينهاه بشدةٍ عن تعاطي آداب الوثنيين ومحاكاتها، حيث قال فيها: “إنَّه لا يجتمع في فمٍ واحدٍ التسبيح بحمد المسيح مع التسبيح بحمد جوبيتر…فيجب أن يكون واضحًا لك ألا تُخَصِّصَ نفسك للتفاهات والأدب الدُّنيوي، ونشكُرُ ربَّنا الذي لم يسمح لقلبك أن يُلَطَّخَ بالتسابيح الكافرة للرجس”. ويُعَلِّق عالم اللاهوت والمؤرخ الكنسي فيليب شاف على رسالة البابا غريغوري العظيم بأنَّ الملاحظة الجديرة بالانتباه هنا هي ما يظهر من رأيه المعارض لدراسة الآداب العَلمانيَّة. ويُشِيرُ الباحث جيمس غراوت إلى التَّشابه بين فحوى تعاليم البابا غريغوري العظيم ومجموعة الدساتير الرسوليَّة من جهةٍ، وبين الحكاية المنسوبة إلى عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه من جهةٍ أخرى، حيث يقول: “لقد كان رأيًا لا يختلف كثيرًا عن قصة يوحنا النحوي الملفقة، التي أشار إليها عبد اللطيف [البغدادي] في حوالي عام 1200م، مُشيرًا إلى أركان السيرابيوم، حيث اعتقد أنَّ أرسطو قد دَرَّسَ هناك، فَذَكَرَ بصورةٍ عابرةٍ أنَّه تم حرق تلك الكتب بأمر من الخليفة. بعده…تم ذُكِرَت تفاصيل للحكاية على يد ابن القِفْطِي، وبدوره تلقفها الأُسْقُف المسيحي ابن العبري، الذي روى أنَّه بعد الفتح العربي للإسكندرية عام 642م، طلب يوحنا النحوي الكتب المليئة بالحكمة…فأجاب الخليفة عمر بأنَّه إذا كانت هذه الكتابات لليونانيين تتفق مع كتاب الله، فهي عديمة الفائدة ولا داعي للاحتفاظ بها، وإذا خالفته فهي خبيثة و يجب تدميرها”. وهكذا، فيظهر أنَّ ذاكرة بعض سُكَّان مدينة الإسكندريَّة كان لديها بقايا حكايات شعبيَّة ترجع بأصولها إلى أحداثٍ وَقَعَت وتعاليم فُرِضَت في التاريخ المسيحي السابق على ظهور الإسلام، وقد تم إسقاطها لاحقًا بعد عدة قرون على أحداث الفتح الإسلامي لمصر ومدينة الإسكندريَّة.
هذا احتمالٌ كبيرٌ واردٌ ومعقولٌ، وهناك احتمالٌ آخر، وهو أنَّ اختلاقها تم بواسطة أفرادٍ داخل الوسط الإسلامي، وذلك على يد المعظمين لأرسطو والفلاسفة والمنطق والتراث اليوناني. يقول المؤرخ روث ستيلهورن ماكنسن: “من المحتمل أنَّ القصة نشأت بين مجموعة من العلماء لكنهم زنادقة مسلمين، فأعجبوا إلى حدٍّ كبيرٍ ببقايا التعاليم اليونانيَّة، وأعربوا عن أسفهم لأنَّ القليل منها نجا، وفي نفس الوقت لم يكن لها فائدة تذكر عند الخلفاء الأوائل”. وفي الحقيقة، قد يُجمع بين الأمرين، بأن يُقال إنَّ أصلها من تلك الشائعات الشعبية في تراث وتاريخ ما قبل الإسلام، وقد تم احتضانه وتبنيه من قِبَلِ بعض المعظمين للتراث اليوناني، وقاموا بتركيب تلك الحكاية وجمعها بصورتها النهائيَّة التي ظهرت لأول مرة عند القِفْطِيِّ.
[2] الحكاية عند القِفْطِيِّ وابن العبريِّ.
لم ترد قصة الإحراق عند القِفْطِيِّ مقتضبة كما هي عند البغداديِّ، بل وردت مطولة وبها تفاصيل دراميَّة مُرَكَّبَة. ولا بُدَّ أن ننبه هنا إلى أمرين، الأول: انحياز القِفْطِيِّ إلى الفلسفة والفلاسفة، وتعظيمه وإعجابه بهم خصوصًا الفلاسفة اليونان، وحرصه على تتبع سيرهم والثناء عليهم. الثاني: أنَّ كثيرًا من معلومات السير التاريخيَّة الواردة في كتاب القِفْطِيِّ غزيرة في بابها، وقليلٌ منها نصَّ على مصادره فيها، وكثيرٌ منها مجهول المصدر، وبعضها أساطير لا أصل لها، وبعضها أوهام وأخطاء بسبب القِفْطِيِّ نفسه لحائل اللغة والترجمة. يقول الباحث سامي التوني، في دراسة موجزة له عن الكتاب: “لم يكن التحقيق هو هاجس المؤلف، الذي لم يُعْرَف عنه الدراية بعلوم الحكمة أصلاً، لذا جاء الكتاب غير محررٍ، وجاءت فيه أخبار وأقوال وآراء تردد ما كان شائعًا من ثقافة عصر المؤلف وما قبله…وقلما أشار القِفْطِيُّ إلى مصادره”. ويقول المستشرق الإيطالي كارلو ألفونسو نَلِّينُو (1938م)، بعد الثناء العطر على القِفْطِيِّ وتعظيم أهميَّة كتابه: “نجد في الكتاب شيئًا من الأساطير والخرافات فيما يختص بالأزمان العتيقة المتقدمة لعصر اليونان…[فـ]تلك الحكايات كانت رائجة بين العرب من زمنٍ طويلٍ، بل قد أخذت العرب بعضها من كتب اليونان والسُّريان. ونجد –أيضًا- أحيانًا أنَّ المؤلف ضَلَّ بسبب الاختلاف والتحريف والتصحيف الوارد في بعض مصادره، حتى جعل أحيانًا رجلاً اثنين…ومن أغرب الأغلاط ما أخذه من كتاب الفهرست، حيث قال في مادةٍ خاصَّةٍ: (بادورغوغيا، هنديٌّ روميٌّ جيليٌّ، له كتاب استخراج المياه…). أمَّا هذا العالم بادورغوغيا فلم يكن له وجود أبدًا وإنَّما هو اسم الكتاب…ومعناه صناعة استخراج المياه”.
وعلى أيَّ حالٍ، فلعل أهم الملاحظات على الحكاية الخاصَّةِ بإحراق المكتبة، ما يأتي:
أولاً: مصادر في القِفْطِيِّ الحكاية المُرَكَّبَة.
أنَّه بتحليل الحكايةِ القِفْطِيِّة نجد أنَّها قصة مركبة من عدة قصص وموارد، تم تجميعها وبناؤها حتى ظهرت بصورتها النهائيَّة لأول مرةٍ في كتاب القِفْطِيِّ. فمما تضمنته الحكاية القِفْطِيِّة: (أ) المقدمة التي أوردها القِفْطِيُّ عن ترجمة يوحنَّا النحوي، وتراجعه عن التثليث، وقصة علماء النصارى معه وإسقاطهم له، وبقائه إلى زمن الفتح ومقابلته لعمرو بن العاص وإكرامه له، فهذا المقدار كله تم نقله من النديم في كتابه (الفهرست)، ولم يُبَيِّن النديم مصدره في ذلك. (ب) كذلك القصة التي رواها يوحنَّا النحوي -بعد سؤال عمرو بن العاص له عن خبر المكتبة وجمع الكتب- عن ملك الإسكندرية طولوماؤس فيلادلفوس، وتكليفه لزميرة بجمع الكتب النفيسة، هذه الجزئيَّة بالتحديد أوردها النديم في كتابه (الفهرست)، وعزاها إلى تاريخ إسحاق الراهب. (ج) إضافة قصة حوار يوحنَّا النحوي مع عمرو بن العاص بشأن طلب تحرير الكتب، ومراسلته لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما، والأمر بحرق الكتب وتوزيعها على آلاف الحمَّامات…إلخ، عُثِرَ عليه كما هي لأول مرة عند القِفْطِيِّ، ولم يشر إلى مصادره.
ثانيًا: يوحنَّا النحوي بطل الحكاية.
إنَّ مدار القصة كلها عند القِفْطِيِّ على شخص جون فيلوبونوس المعروف باسم يوحنَّا النحوي، وهو المنطقي والفيلسوف واللاهوتي المسيحي المشهور. يقول المستشرق الأمريكي برنارد لويس: “يتضمن كتابُ القِفْطِيِّ سيرة يوحنا النحوي، والذي من خلاله يروي القصة التي تستند إليها الأسطورة”.
وقد تضمن نَصُّ القِفْطِيِّ هنا أخطاء واضحة، من أهمها:
(أ) مسألة وجود يوحنَّا النحوي حيًّا أثناء الفتح الإسلامي للإسكندريَّة، وقد أشار برنارد لويس إلى أنَّ من الصعوبات التي تواجه هذه الحكاية، أنَّ يوحنا النحوي ربما عاش ومات في القرن السابق على القرن الذي وقعت فيه الحادثة المزعومة. ويقول المؤرخ روث ستيلهورن ماكنسن: “التناقض الأكثر خطورة [في الحكاية] هو الدور المفترض أن يلعبه يوحنا النحوي؛ لأنَّه من المعروف أنَّه كان يكتب قبل عام 540م، وربما قبل تنصيب جستنيان في عام 527م، أي قبل أكثر من قرن من سقوط الإسكندرية في أيدي العرب في 642م”. أمَّا المؤرخ ألفرد بتلر فيقول: “ولا بُدَّ لنا من النظر في أمرين نرى لهما شأنًا عظيمًا فيما نحن بصدده؛ أولهما: هل كان يوحنا النحوي على قيد الحياة في وقت فتح العرب؟…فأمَّا الأمر الأول فإنَّه أمرٌ مقررٌ لا يكاد يكون فيه شك، فإن يوحنَّا لم يكن حيًّا في عام 642م”.
وفي الحقيقة، فإنَّه من الثابت وما تدعمه الأدلة أنَّ يوحنَّا النحوي مات قبل ظهور الإسلام بعدة عقود، فمن المشهور أنَّه ولد حوالي سنة (490م)، ومات حوالي سنة (570م)، وظهور الإسلام كان سنة (609/610م)، أمَّا فتح المسلمين للإسكندريَّة فكان في سنة (642م). وتاريخ موت يوحنَّا النحوي سنة (570م) تقريبًا، أكَّدَه العلماء والمصادر والمراجع التخصصيَّة. ومما يؤكد أنَّه عاش قبل فتح المسلمين للإسكندريَّة بمدة طويلة، أنَّه يذكر في مؤلفات الفلسفيَّة، مثل: كتاب (شرح السماع الطبيعي)، أنَّه أرَّخَه في سنة 517م. يقول يوحنَّا النحوي في مقدمة كتابه: “نقول إنَّه يوجد عام وشهر ويوم الآن، العام هو 233 من دقلديانوس، والشهر بشنس [=الشهر التاسع للتقويم المصري والقبطي القديم]، واليوم هو العاشر”. تقول مترجمة كتاب (شرح السماع الطبيعي) سارة برودي، الفيلسوفة البريطانية وأستاذة الفلسفة القديمة المتخصصة في أفلاطون وأرسطو: “في التقويم الغريغوري، هذا التاريخ هو الخامس من شهر أبريل، لعام 517 م، عندما كان يوحنَّا النحوي يبلغ من العمر 27 عامًا تقريبًا”. وكذلك ذَكَرَ السير ريتشارد سورابجي -المؤرخ البريطاني للفلسفة الغربية القديمة، وأستاذ الفلسفة الفخري في الكينغز كوليدج بلندن، والمشرف على ترجمة أعمال يوحنَّا النحوي– أنَّ شرحه على أرسطو هذا كتبه في سنة 517م، وأنَّه التاريخ الذي كان فيه شيخه أمونيوس قريبًا من نهاية حياته. ويؤكد ذلك أيضًا البروفيسور ليندرت ويسترينك، المتخصص في تحقيق وترجمة التراث الفلسفي القديم، فوفقًا لعملية إعادة البناء الزمني التي قام بها، فإنَّ التاريخ المحتمل لولادة أمونيوس ما بين 435م و445م، وسيكون عمره ما بين 72 و82 عامًا في عام 517م الذي أَلَّف فيه تلميذه كتابه (شرح السماع الطبيعي). وهذا يعني أنَّ عمر يوحنَّا النحوي عند الفتح الإسلامي للإسكندريَّة سيكون (151) سنة!
وكذلك في كتاب يوحنَّا النحوي: (الر د على برقلس في قدم العالم)، نَصَّ على أنَّه كتبه عام 529م، وقد أكَّدَ ذلك العالم ريتشارد سورابجي، والبرفيسور جون ديلون، أستاذ اللغة اليونانية في كلية ترينيتي بدبلن، والباحث جويل كرايمر، المختص في يوحنَّا النحوي. وهذا يعني أنَّ يوحنَّا النحوي كتب مصنفه هذا قبل الفتح الإسلامي للإسكندريَّة بـ(112) عامًا!
تنبيه مهمٌ: مما تجدر ملاحظته هنا، أنَّ معظم مؤرخي الفلسفة والفلاسفة في الإسلام، وإن كانوا قد عرفوا كثيرًا من آراء يوحنَّا النحوي الفلسفيَّة، ووقف بعضهم على بعض كتبه، إلا أن معرفتهم بحياة يوحنَّا النحوي وسيرته لم تكن دقيقة.
فمثلاً: النديم (994م)، وهو مصدر معظم من جاء بعده من الإسلاميين وغيرهم في يوحنَّا النحوي، فإنَّه نقل معلومات مُفَصَّلةً عن حياة وكتب يوحنَّا النحوي، وليس منها قطُّ قصة إحراق مكتبة الإسكندريَّة، وكثير من معلوماته تدل على اطلاعٍ واسعٍ، ومن ذلك أنَّه قال في كتابه (الفهرست): “وذكر يحيى النحوي في المقالة الرابعة من تفسيره لـ(كتاب السماع الطبيعي) في الكلام في الزمان مثالاً، قال فيه مثل سنتنا هذه: وهي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمئة لدقلطانوس القبطي، فهذا يدل على أن بيننا وبين يحيى النحوي ثلاثمئة سنة ونيفًا”. ومع إطلاع النديم على هذه المعلومة المهمة في كتاب يوحنَّا النحوي، إلا أن نقله للتاريخ كان خاطئًا، وكذلك حسابه للمدة غير صحيح بناءً على ذلك، ولهذا لم يستنكر بقاءه إلى زمن عمرو بن العاص، وسيتتابع من بعده الكُتَّابُ في قبول معاصرة يوحنَّا النحوي لزمن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
ثم جاء المنطقي الفيلسوف أبو سليمان محمد بن بهرام المنطقي السجستاني (1000م)، فقال: “كان يحيى النحوي في أيام عمرو بن العاص ودخل إليه، وقال إنَّ يحيى النحوي كان نصرانياً بالإسكندريَّة، وأنَّه قرأ على أميونيس، وقرأ أميونيس على برقلس. ويحيى النحوي يقول إنَّه أدرك برقلس وكان شيخاً كبيراً لا ينتفع به من الكبر”. مع العلم أنَّ برقلس مات سنة (485م)! ثم جاء الفيلسوف ابن باجة (1138م)، فكان يخلط بين يوحنا النحوي ويحيى بن عدي، ويقول:” يحيى بن عدي النحوي“! وجاء بعده ظهير الدين البيهقي (1169م)، فجعل يوحنَّا النحوي من الديلم، وأنَّه عاش إلى زمن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحكى عنه قصة معه أيضًا! ثم جاء ابن أبي أصيبعة (1270م) وذكر أنَّ يوحنَّا النحوي كان من المعَمَّرِين، حيث قال: “وعمر من هؤلاء الإسكندرانيين يحيى النحوي الإسكندراني الإسكلاني حتى لحق أوائل الإسلام “. وقد أخذ هذه المعلومة وغيرها من النديم. ثم ذَكَرَ معلومات عجيبة، يقول إنَّه وجدها “في بعض تواريخ النصارى”، ومنها: أنَّ يحيى النحوي حَضَرَ وهو في منصبِ أُسْقُفٍ مع أتباعه مجمع خلقيدونية الذي كان في سنة 451م، مع أنَّ ما بين هذا المجمع وبين الفتح الإسلامي للإسكندريَّة ما يقارب القرنين! ثم جاء شمس الدين الشهرزوري (1288م)، وجعل يوحنَّا النحوي حيًّا زمن معاوية رضي الله عنه، وزعم أنَّه كان يُطَبِّب معاوية ويخدمه. ويزعم الشهرزوري في موضعٍ آخر، أنَّ عمرو بن العاص رضي لله عنه زار الإسكندريَّة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره أنَّه رأى “أقوامًا يتطيلسون، ويجتمعون حِلقًا، ويذكرون رجلاً يقال له أرسطاطاليس لعنه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: (مه يا عمرو، إنَّ أرسطاطاليس كان نبيًّا، فجهله قومه)”! هذه هي حصيلة معلومات الفلاسفة ومؤرخي الفلسفة في الإسلام، يصعب الاعتماد عليها والتعويل عليها في حياة وسيرة يوحنَّا النحوي!
(ب) أمَّا ما يتعلق برفض يوحنَّا النحوي عقيدة الثالوث المسيحيَّة، فإنَّ يوحنَّا النحوي –الفيلسوف والمنطقي المسيحي- لم يرفض تلك العقيدة، وإنَّما حاول أن يُقَرِّبَ مفهوم الثالوث بواسطة المفاهيم الفلسفيَّة والمصطلحات الأرسطيَّة. فاعتقاد التثليث الذي يُعزى إلى يوحنَّا النحوي –كما تذكر موسوعة ستانفورد للفلسفة– هو أنَّ الثالوث ليس إلهًا واحدًا في ثلاثة أقانيم (الآب، والابن، والروح)، ولكن في الواقع ثلاثة آلهة منفصلة. لكنَّ من أجل أن يبعد عن نفسه أيَّ ارتباطٍ بمفهوم تعدد الآلهة الوثنيَّة التي تكون أفرادها متمايزة بصورةٍ فرديًّة، فإنَّه يؤكد أنَّ أفراد الثالوث من نفس الطبيعة الإلهية الواحدة بالمعنى ’الشامل للطبيعة= hypostaseis‘. وهذا ما تؤكده البروفيسورة إلين موهلبرغر -الباحثة الأمريكية في مجال المسيحية والعصور القديمة المتأخرة في جامعة ميتشيغان، ومترجمة (رسالة في الثالوث) ليوحنَّا النحوي– حيث تذكر أنَّه يُعزى إلى يوحنَّا النحوي تبنيه بأنَّ هناك ثلاثة آلهة في الثالوث، وليس إلهًا واحدًا، لكن ليس في سياق المفهوم الشائع للثالوث عند كثيرٍ من الفرق المسيحيَّة المبكرة كأشخاص، ولكن في سياق فهم الثالوث فلسفيًا بحسب الفلسفة الميتافيزيقيَّة الأرسطيَّة في (الأنواع). فقد قَدَّمَ يوحنَّا النحوي فهمه للثالوث بحسب المصطلحات المنطقيَّة الأرسطيَّة، فالآب والابن والروح القدس أشياء منفصلة ومختلفة بالفعل بـ”حسب الأنواع”. ويقول العالم اللاهوتي غوستاف باردي، المُعْتَرَف به كواحد من أعظم المتخصصين في عصره في العصور المسيحيَّة والدراسات الآبائيَّة: “كان يوحنَّا النحوي فردًا خاصًّا جدًا من المسيحيين، فبالنسبة إليه كان لا بُدَّ من إثبات تعاليم الكنيسة من خلال الحجج الفلسفية، ولذا فقد بدأ في إعادة بناء عقائد الثالوث والتَّجَسُّد باستخدام التعريفات التي قدمها الفلاسفة كنقطة انطلاق”. ويُبَيِّن الأب صموئيل آخن، فيلسوف وعالم لاهوت ومؤرخ، سبب تميز يوحنَّا النحوي، أنَّه أغرق مفهوم الثالوث في مصطلحات أرسطيَّة منطقيَّة، وذَهَبَ إلى اعتبار الثلاثة كُليات “عامة مجردة، وليست مخصخصة ولا حقيقة محددة”، وأنَّ يوحنَّا النحوي لا يفهم كلمة (طبيعة) بمعنى الأقنوميَّة (hypostaseis)، وإنَّما بمعنى الموجوديَّة (Ousia). يقول يوحنَّا النحوي: “لقد تعلمنا من الآباء أنَّ المسيح واحدٌ في ذات الجوهر مع الله الآب، وواحدٌ في ذات الجوهر معنا. وهم لم يُعَلِّموا أنَّ الابن له ذات الأقنوميَّة مع الآب ولا أن له ذات الأقنوميَّة معنا”.
ولهذا، توجد رسالة مسيحيَّة قديمة كُتِبَت باللغة السُّريانيَّة، تحتوي على مقتطفات من كتابات يوحنَّا النحوي عن الثالوث والرد عليه، وقد وَصَفَت معتقده في الثالوث بأنَّه “سقوطٌ في البدعة التي تعترف بتعدد جواهر الثالوث المقدس”؛ وأنَّ هذه البدعة هي “نتاج الشرك الوثني”. ولهذا يقول عالم اللاهوت الأب أوي مايكل لانغ، الحاصل على الدكتوراه في اللاهوت من جامعة أكسفورد وأستاذ معهد ماريفيل ببرمنغهام ومستشار البابا، إنَّ عقيدة يوحنَّا النحوي هذه لم تكن سببًا لاتهامه بالردة عن الإيمان المسيحي، بل اتهامه بالبدعة، وأنَّ الأدلة الصحيحة تثبت أنَّه ظلَّ مسيحياً على الدوام.
وهذا المفهوم الفلسفي للثالوث عند يوحنَّا النحوي، ليس جديدًا على المسيحيَّة، ويُشابه كثيرًا ما ذهب إليه كثيرٌ من فلاسفة المسيحيَّة وكثيرٌ ممن يسمونهم هراطقة، ويؤكد عدم دقة حكاية القِفْطِيِّ حين قال: “ثم رجع عمَّا يعتقده النصارى في التثليث لما قَرَأَ كتب الحكمة واستحال عنده جعل الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً”، فإنَّه لم يبطل الثالوث ولم يرفضه، ولم ينكر التَّجَسُّد، ولا غيرها من أصول لمسيحيَّة البولسيَّة، وإنكار العاقل جعل الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً، لا يحتاج إلى قراءة كتب الحكمة (=الفلسفة اليونانيَّة)، بل كُتُب الحكمة تلك تعلم وتبرر الثالوث. ففكرة تقديس الرقم ثلاثة وفكرة الثالوث، راسخة في البيئة اليونانيَّة وغيرها من البيئات الوثنيَّة، فقد كان أرسطو يرى أنَّ فكرة الثلاثة مما يُعَظَّم به الله. وكان أستاذه أفلاطون يردد كلامًا يكاد يتطابق مطلع إنجيل يوحنا، وكبار اللاهوتيين المسيحيين يفتخرون بذلك، ويستدلون به على صحة ثالوثهم. يقول أوغسطينوس (430م): “قرأتُ هناك (يعني في كتب أفلاطون [الكلام لتوماس الأكويني]) أنَّه في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله”. ويقول توماس الأكويني (1274م)، الملقب بالمعلم الملائكي عن المسيحيين: “في ثالوث الأقانيم، قال أرسطو في كتاب السماء والعالم: (بهذا العدد –يعني الثلاثي- يُعَظَّمُ الإله الواحد المتعالي عن صفات المخلوقات)”. وكان عالم الدِّين الكاثوليكي ميخائيل سيرفيتوس (١٥٥٣م)، يُؤكِّد أنَّ عقيدة التثليت ليست من تعاليم الله ولا السلف الأوائل من المسيحيين، وإنَّما مأخوذة من تعاليم الفلاسفة اليونان التي دخلت للمسيحية، وأَلَّفَ أكثر من كتابٍ في نقد عقيدة التثليث، وأنَّها من عمل الشيطان. ولعل القِفْطِيَّ وغيره قَصَدَ من إيراد ذلك أن يُزيِّنَ أثر ’الفلسفة المباركة‘ في أعين الوسط الإسلامي. كذلك مما يؤكد عدم صحة حكاية القِفْطِيِّ، أنَّه قال: “ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم، واعتقاده وما جرى له مع النصارى؛ فأكرمه عمرو ورأى له موضعًا، وسمع كلامه في إبطال التثليث فأعجبه”. فما الذي وَجَدَهُ الصحابي الجليل عمرو بن العاص –بحسب مزاعم القِفْطِيِّ وغيره- في تنظيرات يوحنَّا النحوي المنطقيَّة والفلسفيَّة العسيرة في مفهوم الثالوث كي يعجب ثم يقوم بإكرامه وملازمته!
(ج) أنَّه لم يثبت ما ذكره القِفْطِيُّ من أنَّ علماء المسيحيَّة أصدروا إدانة بحقِّ يوحنَّا النحوي في حياته، وإنَّما أدانته الكنيسة في مجمع القسطنطينية الثالث سنة (680-681)، وذلك بعد موته بأكثر من قرن وبأكثر من أربعين عامًا بعد الفتح الإسلامي لمدينة الإسكندريَّة، باعتباره مهرطقًا بسبب مفهوم الثالوث الفلسفي الذي قَدَّمه.
ثالثًا: صحابيٌّ يحب الفلسفة والفلاسفة!
يُشير محتوى الحكاية الواضح أنَّها مُرَكَّبَة لتعظيم شأن كتب المنطق والفلسفة والفلاسفة وتراثهم، وأنَّ هذا الفيلسوف والمنطقي حَظِيَ بإعجاب وانبهار الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولأنَّ عمرو بن العاص يتصف “بالعقل والفكر الصحيح” فكان من الطبيعي أن يهتم بهذا الفيلسوف ويكرمه ويلازمه لينهل من علمه الأرسطي، ويفتتن بمناقشته الفلسفيَّة حول مسائل حدوث العالم وقدمه، وغير ذلك من حججه المنطقيَّة وكلامه الفلسفيَّ. يقول القِفْطِيُّ: “وسمع [عمرو] كلامه -أيضًا- في انقضاء الدهر ففتن به، وشاهد من حججه المنطقيَّة وسمع من ألفاظه الفلسفيَّة التي لم يكن للعرب بها أنسة ما هاله. وكان عمرو عاقلاً حسن الاستماع صحيح الفكر، فلازمه وكاد لا يفارقه”.
رابعًا: أسطورة الحمَّامات المُشْتَعِلَة!
إنَّ قصة إحراق كتب الفلسفة والمنطق والآداب وغيرها في الحمَّامات، واستمرار عمليات الإحراق لمدة ستة أشهر، أسطورة ساذجة أُريد بها التشنيع والمبالغة في فداحةِ فَقْدِ كتب المنطق والفلسفة والآداب، ومختلقها كان يفتقر إلى أدنى المعلومات الضروريَّة الأساسيَّة التي تكشف كذب واختلاق تلك الحكاية، كما يُؤكِّدُ ذلك كثيرٌ من المحققين والباحثين.
ومن ذلك: أنَّ أعظم رقمٍ قيل في عدد كتب المكتبة الكبرى في الإسكندريَّة في أزهى عصورها قبل الإسلام هو (700000) كتاب، وأنَّ عدد الحمَّامات التي في مدنية الإسكندريَّة -كما ذكر ذلك عدة من المؤرخين منهم المؤرخ المسيحي البطريرك أفتيشيوس سعيد ابن بطريق (940م) في كتابه (التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق)- أربعة آلاف حمَّام. فإذا افترضنا جدلاً صحة حكاية القِفْطِيِّ، وأنَّ الكتب بالفعل قد تم توزيعها على تلك الحمَّامات كي تُحْرَقَ من أجل تسخين مياهها، فإنَّ ذلك يعني أنَّ نصيب كل حَمَّام من تلك الكتب هو (175) كتابًا فقط، وهذا العدد القليل جدًا من الكتب لن يستغرق إلا بضع ساعات فقط، وإذا بالغنا فبضعة أيامٍ على أحسنِ حالٍ في عمليات الإحراق تلك، وليس مدة ستة شهور كما تزعم الحكاية!
ثم مع افتراض صحة هذه القصة الدراميَّة، فإنَّه لن يفترض عاقلٌ أنَّ الصحابة رضي الله عنهم قاموا بعمليات الإحراق بأنفسهم، ولا هم الذين حملوا تلك الكُتُب وأوصلوها بأيديهم إلى كل حمَّامٍ من تلك الحمَّامات الكثيرة جدًا، فلا يتصور من لديه شيءٌ من العقل أنَّ الصحابة رضي الله عنهم -ومن معهم من المسلمين هناك- سيتركون أعمالهم الحيويَّة والخطرة، ويهجرون خطوط المواجهات وجبهات القتال التي لا تزال مشتعلة، ويتوقفون عن تمددهم العسكري المستمر والفَعَّال، ويتفرغون لحمل وتوزيع مئات الألوف من الكتب على أربعة آلاف حمَّامٍ، ومراقبة عمليات الإحراق مدة ستة شهور كاملة. وإنَّما المفترض عقلاً أنَّهم أمروا أهل الإسكندريَّة بذلك، وبهذا فقد سهلوا كثيرًا على كلِّ مُحبٍّ لتلك الكتب مهمة أن يتصرف في حمايتها من الإحراق بالقدر الذي يستطيعه، وهذا يعني نجاة كتبٍ عظيمة من تلك المكتبة، وهو ما لم يحدث. يقول ألفرد بتلر: “وما كان عمرو بن العاص -وقد أبى أن يُعطيها لصديقه يوحنا النحوي– ليجعلها في أيدي أصحاب الحمَّامات في المدينة؛ فإنه لو فعل ذلك لاستطاع يوحنا النحوي أو سواه من الناس أن يستنقذواً عدد ا عظيمًا منها بثمن بخس في تلك الشهور الستة التي قيل إنها جُعلت وقودًا للحمامات فيها”. ويقول المؤرخ روث ستيلهورن ماكنسن: “من المستبعد جدًا أنَّ عمرو بن العاص أمر بتدمير الكتب؛ لأنَّه لو فعل ذلك لكان قد تورط في توزيعها على حمَّامات المدينة، وهو ترتيب يستلزم جهدًا كبيرًا وتأخيرًا كان من شأنه أن يمنح عُشَّاق الكتب المتحمسين كل فرصةٍ للنجاة بالعديد من المخطوطات الأعظم قيمة. إنَّ صورة أربعة آلاف حمَّامٍ مُتَوهجٍ بالكتب لمدة ستة أشهرٍ هي تمامًا مادة القصص الخيالية”.
ثم إنَّ كان بالفعل هناك إرادة حقيقيَّة لإحراق تلك الكتب وتدميرها، فإنَّ الفاتحين رضي الله عنهم لم يكونوا بحاجة إلى قصةٍ دراميَّةٍ مثل تلك، فكل الذي يلزمهم هو جمعها في مكان واحدٍ أو أماكن محدودة وتدميرها فورًا حرقًا أو رميها في البحر، وهو أسهلهما.
ويُورد المستشرق الأمريكي برنارد لويس جملة من الانتقادات المُوجَّهة إلى بناء هذه الحكاية المُلَفَّقة، ومنها: أنَّ الورق لم يتم إدخاله إلى مصر إلا بعد الفتح العربي، وأنَّ كثيرًا من الكتب، إن لم يكن معظمها في ذلك الوقت، كانت تكتب على الرق المصنوع من الجلد الذي لا يصلح للإحراق من أجل التدفئة. ويقول ألفرد بتلر: “فمما لا شك فيه أنَّ كثيرًا من الكتب في مصر في القرن السابع كانت من الرق، وهو لا يصلح للوقود…وكان أكثر الكتب القديمة التي كانت في مكتبة السرابيوم مكتوبًا على الرق”. ويُؤكَّد برنارد لويس أنَّ الحفاظ على التدفئة في أربعة آلاف حمَّام لمدة ستة أشهر يتطلب وجود مكتبة خُرافيَّة تضم ما لا يقل عن 14 مليون كتاب. ولهذا يقول ألفرد بتلر: “إنَّ إيراد القصة على هذه الصورة مضحكٌ”.
فالقصة إذن أسطورة وُضِعَت في زمنٍ متأخرٍ يفتقد واضعها إلى معرفة المعلومات الضروريَّة لبنائها، ابتداءً من نوع الورق، وعدد الكتب، وتاريخ المكان، وعدد الحمَّامات، وطبيعة عمل الصحابة والمسلمين هناك ذلك الوقت.
خامسًا: هل توجد مكتبة في الإسكندريَّة أثناء الفتح الإسلامي؟
إنَّ وجود المكتبة المزعوم في الإسكندريَّة قبيل الفتح الإسلامي، لا أساس له من الحقيقة، فالمكتبة الكبرى والصغرى تم تدميرها عدة مرات، ولم يكن ثمة مكتبة قبيل الفتح الإسلامي لمصر ليتم تدميرها، هذا رأي الباحثين المحققين. يقول المؤرخ روث ستيلهورن ماكنسن: “أظهر العلماء أنَّه من غير المحتمل للغاية أن تبقى المكتبة على قيد الحياة حتى تاريخ فتح العرب للإسكندريَّة…ولا يمكن تفسير النقص التَّام لأيِّ إشاراتٍ إلى مثل هذه المكتبات في جميع الكتابات اللاحقة، سواء السابقة على الفتح العربي أو في القرون التي تلته، إلا على أنَّها شهادة صامتة على اختفائها”. ويقول روي ماكليود، مؤرخ أمريكي رائد في التاريخ والدراسات الاجتماعية، وكذلك الباحث روبرت بارنز، المتخصص في الفلسفة القديمة والدِّين: “لا توجد إشارةٌ لأيِّ مكتبة باقية في الإسكندرية في الأدب المسيحي في القرون التالية لهذا التاريخ [القرن الرابع الميلادي]”. وتقول الدكتورة ديانا ديليا: “من المرجح أنَّه من النادر أن تكون العديد من المخطوطات الوثنيَّة من المكتبة الرئيسة والملحقات قد نجت من أعمال النهب التي قام بها المتعصبون المسيحيون خلال العصور القديمة المتأخرة”.
فلقد تعرضت مدينة الإسكندريَّة ومكتبتها الكبرى ومكتبة ومعبد السيرابيوم إلى عدة حوادث تدميريَّة كبرى وصغرى بعد الميلاد. فقد كَتَبَ المؤرخ الروماني أميانوس مارسيليانوس (عاش في القرن الرابع للميلاد) حوالي عام 378م أنَّ الكتب “التي جُمِعَت بقوة البطالمة المتواصلة، قد أُحْرِقَت في حرب الإسكندرية عندما نُهبت المدينة تحت حكم الديكتاتور قيصر”. ويذكر الباحث جيمس غراوت، المختص والمهتم بالتاريخ الروماني، أنَّ اليوناني أفثونيوس الأنطاكي شَاهَدَ بنفسه معبد السيرابيوم في الإسكندريَّة، المُكَرَّس لعبادة سيرابيس وإيزيس، في وقتٍ ما قبل تدميره في عام 391م، وكان به غرف تحتوي على كتبٍ متاحة للدراسة من قبل الجمهور. وأنَّه في عام 391م حَظَرَ ثيودوسيوس الأول (395م) العبادة الوثنية، وفي بيان موجه إلى الحاكم والقائد العسكري في مصر، أمر بعدم قيام أي شخص بتضحيات أو الذهاب إلى المعابد أو تقديس الأضرحة. وذَكَرَ سقراط سكولاستيكوس القسطنطيني (439م)، وكذلك أُسْقُف قورش المؤرخ ثيودوريطس (457م)، أنَّ ثيودوسيوس الأول استجابة منه لطلب بطريرك الإسكندرية ثيوفيلوس، أصدر أمرًا بتدمير المعابد، مما سبب أعمال الشغب، وتم هدم معبد السيرابيوم من قبل حشد متعصبٍ من المسيحي. وحين جاء إيونابيوس (414م)، أعرب عن أسفه بمرارة لأنَّ “عبادة المعابد في الإسكندرية وضريح سيرابيس قد تناثرت في الرياح، وليست فقط احتفالات العبادة، ولكن المباني أيضًا”. وهكذا تم هدم المعبد وتدمير تماثيله وقرابينه، “فقط أرضية معبد السيرابيوم لم يأخذوها، ببساطة بسبب وزن الحجارة التي لم يكن من السهل إزالتها من مكانها”.
وقد تحدث ألكسندر كرافتشوك عن حادثة الإحراق والتدمير التي حصلت لمعابد ومكتبات الإسكندريَّة، ومنها (السرابيوم)، على يد القيصر ثيودوسيوس الأول بطلبٍ من البطريرك ثيوفيلوس، وتحويلها إلى كنائس، وهجرة من تبقى من أساتذها من مصر إلى القسطنطينيَّة. يقول مُتَحَدِّثًا عن أحداث سنة 391م مستندًا على الروايات القديمة: “أعان الحاكم وقائد الجيوش في تدمير المعابد، حوَّلوا المباني إلى أنقاضٍ، وحطَّموا التماثيل أو صهروها لاستخدامها كأدوات لكنيسة الإسكندريَّة…بكل تأكيدٍ أن أمونيوس [شيخ يوحنا النحوي!] الذي أشرنا إليه لتوه، تذمَّرَ كثيرًا وعبَّرَ عن ألمه بسبب ذلك”. ويؤكد الباحث تيم أونيل، المتخصص في التاريخ القديم والعصور الوسطى، على أنَّه “لا يوجد دليل على أنَّ السيرابيوم لا يزال يحتوي على أيِّ مكتبةٍ بحلول عام 391م، وبعض الأدلة الجيدة تشير إلى أنَّها لم تكن كذلك. فلدينا ما لا يقل عن خمس روايات عن تدمير السيرابيوم: روفينيوس تيرانيوس، وسقراط سكولاستيكوس، وسوزومين، وثيودوريت، وأونابيوس الأنطاكي، وهو أمرٌ نادرٌ في التاريخ القديم حيث يجعله في الواقع أحد أفضل الأحداث الموثقة في تلك الفترة. المهم بشأنهم هو أنَّ أحداً منهم لم يذكر مكتبة”.
وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: “وفى عام 391م، مواصلة لاستئصال شأفة الكفرة -أى غير النصارى- يفلح البطريرك ثيوفيلوس فى الحصول على إذن القيصر ثيودوسيوس الأول لهدم (السرابيوم)، كبرى الأكاديميات وآخرها، وموئل حكمة العصور القديمة، والقبلة الذائعة الصيت، [التي] يحج إليها طالبو الحكمة من كل صوب، ويترك مكتبتها بما حوته من ثلاثمائة ألف مخطوطة نهبًا للنيران، قرير العين بتشييده ديرًا وكنيسة على أنقاضها”.
ويذكر بولس أوروسيوس (418م)، في الكتاب السادس من كتابه (سبعة كتب من التاريخ ضد الوثنيين)، حينما تحدث عن أحداث عام 410م، حين خطط القائد العسكري لقتل قيصر، فقاد معركة ضده، فأُحرق الأسطول الملكي على الشاطئ، ومن هذه الحرائق انتشرت النار إلى جزء من المدينة، وبسببها أحرقت بقايا كُتُبٍ صادف أنه تم تخزينها وحفظها في أحد المباني القريبة من موقع الحدث. ويُؤكِّدُ الباحث جيمس غراوت أنَّ مدينة الإسكندريَّة ومبانيها تعرضت بعد عام 391م لعدة حوداث تدميريَّة، إما من قبل البشر وصراعاتهم الدينيَّة والسياسيَّة، أو من بسبب الظواهر الطبيعيَّة كالزلازل والتسونامي، ومع كل ذلك فإنَّ بقايا أعمدة الرواق التي كانت في المدينة قد نجت، ووصفها الرحالة العرب لاحقًا الذين زاروا مصر وذكروا بأنَّها لا تزال قائمة.
ويقول المستشرق الفرنسي لويس سيديو عن مكتبة معبد السيرابيوم: “إنَّ معظمها أُحْرِقَ في عهد الملك تيودوس سنة 390م”. ويقول المؤرخ جيمس هانام عن مكتبة الإسكندرية القديمة الكبرى التي عرفت باسم المكتبة المَلَكِيَّة: “لقد ثبت بشكل مُرْضٍ أنَّ المكتبة الملكيَّة لم تكن قطعًا موجودة بحلول الوقت الذي وصل فيه العرب، فهذا…يجب أن يؤدي إلى رفض علاقة العرب [بإحراق المكتبة]”. ويُؤكِّد ذلك المستشرق الأمريكي برنارد لويس، الذي يقول: “هناك أدلة جيدة على أنَّ المكتبة نفسها دمرت قبل وقتٍ طويلٍ من وصول العرب إلى مصر”. بل إنَّ من يزعم صحة الحكاية يعترف بنفسه أنَّ أعداد الكتب قد نقصت عمَّا كانت عليه في الأصل؛ بسبب عمليات الحرق التي تعرضت لها قبل الإسلام على يد الوثنيين والمسيحيين. يقول جرجي زيدان: “لا ننكر أنَّ بعض هذه المكتبة احترق قبل الإسلام”.
إنَّ الحقيقة تثبت أنَّ مكتبات الإسكندريَّة لم يعد لها وجود قبيل الفتح الإسلامي، وقد دمرت وأحرقت وتفرقت بسبب الحروب بين الوثنيين، ثم لاحقًا بسبب تتبع المسيحيين للوثنيين واستئصال شأفتهم وتدمير معابدهم. ولهذا، يقول غوستاف لوبون: “أمَّا إحراق مكتبة الإسكندرية المزعوم… [فـ]لا شيء أسهل من أن نثبت بما لدينا من الأدلة الواضحة أنَّ النصارى هم الذين أحرقوا كتب المشركين في الإسكندرية قبل الفتح العربي الإسلامي بعناية”. أمَّا المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه فإنَّها بعد أن قامت باستعراض تاريخ المكتبات في مصر قبل الإسلام، وما حصل لها على يد الوثنيين والمسيحيين، قالت: “هكذا نرى أنَّ المكتبات القديمة في مصر جميعًا لم يكن لها أى وجود أيام دخول العرب الإسكندرية عام 642م، فما بالك بزعم الغرب أنَّ رماد الجمر المتبقى من حرق مئات الآلاف من المخطوطات الإغريقيَّة التى ضمتها مكتبة الموسيون، والتى كانت كبرى المكتبات المحتوية على ذخائر الآداب القديمة -والتى أحرقها العرب كما يُصِّرُ الغرب في زعمه- قد استغله العرب وقودا في الحمَّامات العامَّة طوال ستة أشهر!”.
سادسًا: الأصل العربي للحكاية وعدم وجود أصلها السُّريانيِّ والقبطيِّ!
كتابُ ابن العبريِّ الأصل هو مرجعٌ ألَّفَهُ باللغة السُّريانيَّة في عدة أجزاءٍ، وهو كتابٌ مُفَصَّلٌ معظمه عن تاريخ الكنيسة، يُقال إنَّه جمعه من مصادر سُريانيَّة وعربيَّة وفارسيَّة ويونانيَّة، ويذكر المؤرخ جيمس هانام أنَّ عمل ابن العبري في كتابه الكبير للتاريخ الذي كَتَبَهُ بالسُريانيَّة لم يكن إلا تلخيصًا لعمل المؤرخ ميخائيل السُّرياني (1199م)، وبعض كتب التاريخ السُريانيَّة الأخرى. ثم تَرْجَمَ ابنُ العبريِّ بنفسه جزءًا منه إلى اللغة العربيَّة، وهو الجزء الأول فقط، وأضاف إليه ما يتعلق بتاريخ الإسلام والعرب، من مراجع عربيَّة بصورةٍ رئيسةٍ كما يبدو، وهكذا أخْرَجَ كتابه (تاريخ مختصر الدول). يقول ابن العبري عن مصادره في مقدمة كتابه (تاريخ مختصر الدول): “هذا مختصرٌ في الدول، قصدتُ في اختصاره الاقتصار على بعض ما أُوتي في ذكره اقتصاص إحدى فائدتي الترغيب والترهيب، من أمور الحُكَّام والحكماء، خيرها وشرها، على سبيل الالتقاط من الكتب الموضوعة في هذا الفنِّ، بلغات مختلفة سُريانيَّة وعَربيَّة وغيرها”. يقول جرجي زيدان متحدثًا عن حكاية الإحراق التي ينقلها ابن العبري: “وبمقابلة هذه الفقرة بكلام أبي الفرج [ابن العبري]، يتضح لك أنَّ أبا الفرج نقل قول ابن القِفْطِيِّ مختصرًا، ولو قَرَأتَ الكتابين لعلمت أنَّ أبا الفرج نقل كثيرًا من زياداته العلميَّة في كتابه العربي عن كتاب ابن القِفْطِيِّ“. ويقول المؤرخ جيمس هانام: “لا تُوجد هذه القصة إلا في النسخة العربيَّة من عمل ابن العبري، وهذه النسخة أقصر بكثير من النسخة الأصلية السُّريانيَّة، وقد قام ابن العبري بترجمتها إلى العربيَّة في نهاية حياته. إنَّ قيام ابن العبري بإدخال قصة جديدة في نسخةٍ مختصرةٍ يُشير بقوةٍ إلى أنَّه -على الرغم من بحثه-، لم يسمع بها عندما كَتَبَ النسخة الأصليَّة، وبالتالي لم تكن القصة معروفة جيدًا”. ولهذا، فإنَّ غياب تلك الحكاية من المصادر السُّريانيَّة والفارسيَّة واليونانيَّة والقبطيَّة التي استند عليها ابن العبري في كتابه الكبير، يُؤكِّد خلوها منها، وإلا لسارع ابن العبري إلى تضمينها. وعندما نَشَرَ الأب يوسيبي رينو -المستشرق الفرنسي المتميِّز كما يصفه بذلك برنارد لويس– في عام 1713م، تاريخه عن بطاركة الإسكندرية مستندًا إلى مصادر مختلفة، أشار إلى ما يشكك في هذه القصة، قائلاً: “هناك شيءٌ غير موثوق به حول القصة”.
سابعًا: ما السِرُّ في التمسك الشديد بهذه الأسطورة!
وأخيرًا، فإنَّه قد تبيَّنَ أنَّ هذه الحكاية لا أصل لها، وأنَّها خُرافة وُضِعَت بعد قرونٍ من تاريخ الحدث، ومع ذلك فإنَّها حَظِيَت بانتشارٍ واسعٍ، وراجعت بين الكُتَّاب في الغرب في عصر التنوير وحتى عصرنا الحديث، ولا تزال الصحف والكتب الغربيَّة تُكَرِّرُ إعادتها ونشرها والاستشهاد بها، وهي بحقٍّ كما وصفها البروفيسور جاك ريسلر، الأستاذ بمعهد باريس للدراسات الإسلامية: “خُرافة شرسة بوجهٍ خاصٍّ”، تُقاوم الموت، وتُعيد بَعْثَ نفسها من جديد في كل مرة. يقول روي ماكليود: “يظهر أنَّ المكتبتين الإسكندريتين قد دُمِّرتا بنهاية القرن الرابع الميلادي. وعلى الرغم من ذلك، فهناك تقليدٌ مستمرٌ في العصر الحديث -على الرغم من كشف زيفه من قِبَلِ إدوارد جيبون– أنَّ المكتبة دمرها العرب عندما احتلوا المدينة في عام 642م”. ويقول المستشرق الأمريكي برنارد لويس: “على الرغم من الأدلة الدامغة على عدم حدوث تدمير للمكتبة، فلا يزال بعض الكُتَّاب يميلون إلى الاعتقاد بل وتكرار قصة كيف دمر العرب مكتبة الإسكندرية الكبرى بعد احتلالهم للمدينة عام 642 م بأمٍر من الخليفة عمر“.
فما السِّرُّ في ذلك؟
مع وجود كثيرٍ من المنصفين في الغربيين، الذين بذلوا جهودًا علميَّة منصفة لبيان الحقيقة تستحق الشكر والإطراء، إلا أنَّه يظهر أنَّ السبب وراء التشبث بهذه الأسطورة في كثيرٍ من الكتابات الغربيَّة، بعيدًا عن جهل الصحفيين العرب الذين يستشهدون بها كحقيقة، هو التماهي اللاشعوري مع الخلفيَّات والرواسب التاريخيَّة تجاه ثقافة وصورة الآخر الغريب والجحيم والمتخلف والبربري، فالحكاية تُقدِّم مادة دراميَّة رمانسيَّة تغذي وتدغدغ شعور بالأنا المتعالي الذي ضَرَبَ بجذوره في العقليَّة الغربيَّة تجاه كل ما هو عربي وإسلامي.
تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: “حريق مكتبة الإسكندريَّة الكبرى، هذه الفرية المزيفة للتاريخ والتى لا يُراد لها أن تمحى أبدًا. فعلى الرغم من تكرار تأكيد زيفها، تنشرها قبل عام واحد مرة أخرى جريدة يوميَّة ألمانية كبرى…إنَّ هذا الانحطاط الفكري السادر يبين مدى إلحاح الغرب على إلصاق الأحكام المسبقة الظالمة بالعرب، ومدى استمتاعه غيًّا بتزييفة لحقائق التاريخ، متفننًا يخرق ما شاء من المحال، سخيًّا بتفاصيل لا أساس لها سوى الخيال، بحيث تُدفن الحقائق التاريخيَّة كما يود البعض فيما يبدو إلى أبد الأبدين دفنًا، على الرغم من تعدد محاولات فرادى المؤرخين المنصفين، كشف ذلك الزيف المبين. إننا في عام 1989م نرى القوم في ألمانيا يغضون النظر عن الحقائق التاريخيَّة السافرة لكل ذى عينين، ويروجون من جديد -في رضا واقتناع واستنكار أخلاقي- خرافة الحرق الهمجى للتراث الإنساني، والتى اختلقها وروج لها روح الحروب الصليبية”. ويقول المؤرخ روث ستيلهورن ماكنسن: “يعتقد كثيرٌ من العلماء المعاصرين -بعد فحص كل المصادر المتاحة بالتفاصيل- أنَّه لا أساس لهذه القصة على الإطلاق. لكن الكثيرين كانوا على استعداد لقبولها على أنها قصة صحيحة، وربما يرجع ذلك جزئيًا لأنَّها حكاية محبوكة، وظاهريًا مقنعة إلى حدٍّ ما، وجزئيًا إلى التحيز ضد الدِّين المحمدي. وأولئك الذين يقبلون هذه الحكاية للسبب الأخير [=كراهيَّتهم للإسلام]، يتجاهلون الاتهامات المماثلة التي يوجهها المسلمون ضد المسيحيين، مدعومين بأدلة أكثر موثوقيَّة”.
وبالفعل، فإنَّ تاريخ الغرب، قبل الإسلام وبعد الإسلام، يؤكد بأدلة ماديَّة لا تُحصى عددًا ولا تنوعًا على أنَّه تاريخ نفي الآخر، تاريخ حرق مكتبات وتدمير تراث الأمم الأخرى، في مقابل التاريخ الإسلامي الذي يغلب عليه أنَّه تاريخ الرحمة والعدل والتسامح الحقيقي المنصف تجاه الآخرين، ومع كل ذلك كانت صورة الإسلام هي التي تُشَوَّه وتُلَطَّخ، أمَّا صورة الغرب فتُلَمَّع وتُجَمَّل!
يقول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل: “في الصرعات الأولى بين المسيحيَّة والمحمديين، كان المسيحيون هم المتعصبون والمحمديون هم الذين حققوا النجاح. واخترعت الدعاية المسيحيَّة قصصًا عن التعصب المحمدي، ولكنها قصص مزيفة تمامًا إذا تم تطبيقها على القرون المبكرة في الإسلام. لقد تَعَلَّمَ كل مسيحيٍّ قصة تدمير الخليفة [عمر] لمكتبة الإسكندريَّة، وفي الواقع لقد تم تدمير هذه المكتبة وإعادة بنائها مرارًا، وكان أول تدميرٍ لها على يد يوليوس قيصر، وكان آخرها قبل ظهور النبي“.
والحديث عن تاريخ الغرب مع المكتبات يطول جدًا، ويحتاج إلى كتابٍ مستقل، ويكفي هنا أن أورد إشاراتٍ يسيرةٍ إلى ذلك. يقول المؤرخ ألفريد بتلر: “إنَّ الفرنسيين عندما فتحوا مدينة قسنطينة في شمال أفريقيا أحرقوا كل الكتب والمخطوطات التي وقعت في أيديهم، كأنهم من صميم الهمج. ووجد الإنجليز عند فتح مدينة مجدلة مكتبة كبرى من الكتب الحبشية، فحملوها معهم، ولكنهم لم يلبثوا أن تركوا أكثرها في كنيسة على جانب الطريق؛ إذ وجدوا في حملها عناءً لم يقووا على احتماله. ولقد كان اختيارهم للكتب التي أبقوا عليها خبطًا وسيرًا مع الصدفة، ولكن قيمة الكتب التي أنجيت وحفظت تدلنا على فداحة الخسارة التي لحقت العلم بضياع ما تُرك منها”. يقول خوسيه أنطونيو كوندي: “إنَّ مسيحي إسبانيا لما استولوا على مدينة قرطبة حرقوا كل ما طالت إليه أيديهم من مصنفات المسلمين، وعددها مليون وخمسون ألف مجلد، وجعلوها زينة وشعلة في يومٍ واحدٍ، ثم رجعوا على سبعين مكتبة في الأندلس، وأخذوا يتلفون كل ما عثروا عليه في كل إقليم من مؤلفات العرب”.
وكما بدأ حديثنا عن حكاية حرق مكتبة الإسكندريَّة بالفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1778م)، نختمه به، في نصٍّ جميلٍ ومُنْصِفٍ يُبَيِّن الازدواجيَّة الرَّاسخة في العقليَّة الغربيَّة. يقول روسو: “لقد ذَكَرَ علماؤنا هذا الاستدلال [=أَمْرُ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه حرق مكتبة الإسكندريَّة] بوصفه لا معقولاً وفي منتهى التخلف. لكن لو افترضنا غريغوار الكبير [=البابا غريغوري العظيم (604م)] بدلاً من عمر، والإنجيل بدل القرآن؛ لكانت المكتبة أُحْرِقَتْ أيضًا، ولكان ذلك أجمل عمل في حياة هذا الحَبر الشهير”.