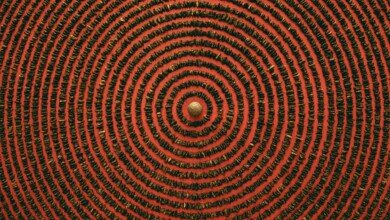- د. نافيد بكالي
- ترجمة: تركية بتار
- تحرير: عبد الرحمن الجندل
مقدمة
إن الإسلاموفوبيا[1*] ظاهرة معقدة وحاضرة في المجتمع الأمريكي في مجالات مختلفة؛ ولذلك كان الهدف من هذا المقال القصير هو: المساعدة في تقديم تحليل تاريخي أساسي لهذه الظاهرة، وفهم ماهيتها وظهورها في السياقات السياسية والاجتماعية، وفي هذا السياق، من المهم التذكير بأن المظاهر العدائية للإسلام، تتأثر إلى حد كبير بالعوامل الجيوسياسية المحلية والثقافية والاجتماعية، وعلى هذا فإن الإسلاموفوبيا ظاهرة سياقية، تختلف باختلاف السياقات المؤطّرة لها، حيث تتباين تجلياتها من كندا إلى فرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، ونظرًا لأن الهدف من هذا المقال عرض مقدمة عن الإسلاموفوبيا وبإيجاز؛ فسنركز في المقام الأول على المجتمع الأمريكي[١].
لقد عرّف عدد من الأكاديميين والمفكرين ومراكز البحوث، الإسلاموفوبيا بتعريفات عديدة، فهي تشير إلى نوع من العنصرية التي تدعم وتديم أي تقييم سلبي موجّه ضد الإسلام والمسلمين، وتُشيد وتؤيد فكرة استثناء المسلمين من المجتمع[٢]، كما تظهر الإسلاموفوبيا جلية في المجال الخاص والعام، أو كما لاحظ الكتّاب البيض أنها تظهر جلية بشكل فردي وتنظيمي أو هيكلي[٣].
ويمكن فهم نشأة الإسلاموفوبيا على أنها: العقبات القانونية التي فرضتها الدولة على الإسلام ومعتنقيه.
وبعبارة أخرى هي: الطريقة التي تمكنت بها سلطة الدولة من استخدام السياسة التشريعية، وإعداد البرامج لإخضاع المسلمين وقمعهم وتشويه سمعتهم، كما تعزز نظرية “صراع الحضارات” صعود الإسلاموفوبيا، فهي تجيز إضفاء الطابع الأمني على مظاهر قمع المسلمين، وبشكل خاص، فالإسلاموفوبيا هي: الخوف وانعدام الثقة في المسلمين، وممارسة الجهات الخاصة العنف ضدهم؛ إذْ أن هذه الجهات الخاصة -أفرادًا كانت أو مؤسسات- لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالدولة؛ ولما كانت مناقشة مظاهر الإسلاموفوبيا المنظمة، تساعدنا على تفسير التجارب الحية والحالية لهذه الظاهرة؛ فسنذكر عدة تجليات لهذه المظاهر فيما يلي:
الإسلاموفوبيا الهيكلية: النظرية العرقية النقدية والقانونية[2*]
لم تكن الإسلاموفوبيا ظاهرة حديثة نشأت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م على أبراج مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وإنما هي واحدة من العديد من التجليات المختلفة لإرث دائم من العنصرية في أمريكا؛ وتُعد نظرية العرق، واحدة من أهم الأطر النظرية الأساسية لفهم هذه الظاهرة؛ فهي إطار نظري يشرح العنصرية باعتبارها قائمة على علاقات القوة، والتي تهدف إلى الحفاظ على امتياز البيض وتفوقهم، وتهميش الأشخاص الملوّنين، وفي إطار هذا النموذج يُفهم أن العرق مبني اجتماعيًا.
وبعبارة أخرى: لا تشير مصطلحات مثل أبيض وأسود إلى هوية فردية أو جماعية، بل تشير بدلًا من ذلك إلى بنية سياسية وقانونية، متجذرة في أيديولوجية تفوق الأوربيين البيض والأثر العالمي للاستعمار[٤]؛ حيث أن فهم العلاقة بين القانون، والسلطة العرقية، هو أحد الاهتمامات الأساسية لنظرية العرق النقدية.
فالقانون -كما يزعم منظرو النظرية العرقية النقدية- هو: أداةٌ تُستخدم للحفاظ على التسلسلات الهرمية العرقية؛ وعلى هذا تصبح الفئات العرقية “الأدنى” في النظام الاجتماعي، مستهدَفة ومعرضة للعقوبات القانونية؛ كما يؤكد أصحاب هذه النظرية أن العنصرية متأصلةٌ في المجتمع دائمة فيه[٥]، والمقصود بكونها متأصلة في المجتمع، أي أنها تبدو عادية بالنسبة لأولئك الذين يشغلون مناصب السلطة والامتياز، ولا يُنظر إليها على أنها أمر غير عادي أو غريب؛ ومن هنا فإن افتراضات تفوّق الأجناس المتميزة، تضرب بجذورها في ثقافات المجتمع السياسية والقانونية والتعليمية، بحيث يتعذر التعرف عليها غالبًا؛ فالعنصرية باعتبارها سمة دائمة في المجتمع، تعني أنه لا يمكن التخلص منها بسهولة؛ فعندما يديم النظام القانوني أوجه التمييز العنصري، تصبح العنصرية راسخةً ومنهجية؛ وبالتالي يصبح القضاء عليها مهمةً شاقة تتطلب النضال والحراك الجماهيري، ومن خلال هذا الإطار النظري، فإن القانون ما هو إلا أداة لإدامة التفاوت العرقي، ولذلك عندما ننظر إلى حال المسلمين والإسلاموفوبيا في عهد ترامب، نجد أن القوانين مثل: “حظر المسلمين”، هي ببساطة نسخة محدّثة من القوانين القديمة، التي استُخدمت لحظر المسلمين من الأماكن العامة في المجتمع الأمريكي قبل أكثر من مائتي عام من فرض الرئيس ترامب قرار: “حظر المسلمين”، والذي ينص على منع المسلمين في سبع دول ذات أغلبية مسلمة، من دخول الولايات المتحدة، وعلى مَنع المسلمين قانونيًا من أن يحصلوا على الجنسية الأمريكية ومنعهم من أن يكونوا مواطنين أمريكيين.
وكما لاحظ باحثون بيض كيف منعت المحاكم المهاجرين المسلمين من أن يصبحوا مواطنين متجنسين من عام ١٧٩٠م حتى عام ١٩٤٤م، لأن القانون يرى أن الهوية الإسلامية مخالفة لقانون التجنيس[٦]؛ ويصنف المهاجرين المسلمين على أنهم عرق “عدو”؛ ونتج عن ذلك اعتبار المسلمين مصدر تهديد، وأنهم غير قادرين على الاندماج في المجتمع الأمريكي وقيمه؛ فقد جرت خلال هذه الحقبة محاولات منتظمة للإبقاء على هذه الصورة، فشُرّع قانون التجنيس عام١٧٩٠م للإبقاء على الأمة الأمريكية الوليدة “بيضاء” مسيحية، وبذلك اقتصرت الجنسية على الأعراق المسيحية “البيضاء”، واستُبعدت غير البيضاء، وحتى عام ١٩٤٤م، كان العرق الإسلامي يعتبر عرقًا غير أبيض، وبالتالي غير أمريكي.
يوضح الحظر المفروض على المسلمين اليوم بوضوح، كيف كان العرق -ولا يزال- مبنيًا على أسس اجتماعية، كاشتراط المسيحية مسبقًا لتكون من العرق الأبيض، وبعبارة أخرى، يُعد قانون التجنيس ١٧٩٠م مثالًا لكيفية تَمكُّن القانون من تحديد اشتراطات العرق الأبيض؛ وبالتالي استثناء البعض من الحصول على الجنسية؛ لذا يمكن اعتبار العرب الذين يعتنقون المسيحية “بيضًا”، في حين أن كتلة العرب المسلمين اعتُبرت عدوًا عرقيًا يهدد ثقافة امريكا وقيمها[٧].
والآن وبعد أكثر من قرنين من الزمان، نشهد نسخة جديدة من هذا الحظر على المسلمين!
كان أحد الأركان الأساسية لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، هو تفانيه في إحداث تغيير كبير في المؤسسة السياسية الأمريكية، فاقتضى هذا التخلص من الشرعية السياسية، مع التمسك بالمواقف العنصرية الوحشة التي تتبناها قاعدة مؤيديه، ففي غضون أسبوع من توليه منصبه، وقّع على أمر تنفيذي يمنع فيه المسلمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول أمريكا؛ ففي ٢٧ يناير ٢٠١٧م صدر الأمر التنفيذي رقم: (١٣٧٦٩)، بعنوان: “حماية البلد من دخول الإرهابين الأجانب إلى أمريكا”، ويشار له أيضًا باسم: “حظر المسلمين”، وكان الغرض المقصود من هذا الحظر، هو منع الإرهاب من خلال تعديل الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات؛ وعلى هذا فقد عَلّق الأمر التنفيذي دخول الأجانب من العراق وسوريا والسودان وإيران والصومال وليبيا واليمن، فضلًا عن ذلك، فقد علّق برنامج اللاجئين الأمريكي دخول اللاجئين السوريين للبلاد إلى أجل غير مسمى، وحدّ العدد الاجمالي لهم ليقتصر على (٥٠٠٠٠) لاجئ لعام ٢٠١٧م[٨]، وقد طعنت المحاكم في هذا الأمر التنفيذي (١٣٧٦٩)، مما أدى إلى تعديل نص الحظر بأمر تنفيذي رقم: (١٣٧٨٠)، فطعنت المحاكم أيضًا في هذا الأمر التنفيذي المعدّل، وفي نهاية المطاف صادقت المحكمة العليا بقرار موافقة خمسة ضد أربعة من أعضاءها، على الإعلان الرئاسي (٩٦٤٥)، الذي أوقف دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة.
وعلى هذا المنوال فقد عملت إدارة ترامب كسابقتها في سياق الحرب على الإرهاب، فشرعت في استهداف المسلمين من خلال فرض التشريعات المناهضة للإسلام.
أدّت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، خلال فترة رئاسة جورج دبليو بوش وما عقبها من حرب على الإرهاب، إلى إصدار عدد من القوانين الصارمة التي استهدفت المسلمين الأمريكيين استهدافًا ساحقًا، وبحجة الحفاظ على مصالح الأمن القومي كذلك، سُنّت تشريعات كقانون “باتريوت” الأمريكي مما أخلّ بعدد من الحقوق الأساسية.
وبموجب أحكام قانون المواطنة الأمريكي سُمح للدولة بمراقبة الجماعات العرقية والدينية، واعتقال المشتبه في ارتباطهم بالإرهاب إلى أجل غير مسمى، وتفتيشهم والتنصت على مكالماتهم من دون سبب محتمل، وكذلك اعتقال أي شخص واحتجازه كشاهد أساسي قد تساعد شهادته في قضية ما، أيضًا يمكنهم استخدام ما يعرف بالأدلة السرية، وعدم السماح للمتهمين بالاطلاع عليها، بالإضافة لمحاكمة تلك الفئة المسماة بالمقاتلين الأعداء، في المحاكم العسكرية بدلًا من المدنية، وترحيل غير المواطنين على أساس الجرم بالتبعية.
ونتيجة لهذه الأحكام اعتُقل الآلاف من المسلمين في الولايات والمتحدة، واحتُجزوا ظُلمًا وأُخذت بصماتهم، بل تم ترحيلهم وتصنيفهم على أساس عنصري، علاوة على ذلك أُغلقت بعض المنظمات الخيرية، ولم يتمكن بعضها الآخر من مواصلة عمله، نظرًا لخشية المسلمين من التحقيق معهم إذا اكتُشف تبرعهم بالأموال لصالح هذه الجمعيات الخيرية[٩]، ويعد قانون “باتريوت” في الولايات المتحدة، مثالًا على كيفية استخدام القانون كأداة لمراقبة مجتمعات عرقية ودينية وثقافية محددة، وبممارسة “العقوبة الاستباقية”، التي تتضمن معاقبة الأشخاص قانونيًا قبل ارتكابهم لأي جريمة أو مخالفة.
ويعد العرق المدعوم -بافتراض أنهم “ليسوا مثلنا”- أمرًا أساسيًا في مفهوم “العقوبة الاستباقية”، فيمكن وصف مثل هذه الحالة -التي يصبح فيها إيقاف العمل بالقانون، وتجريد الإنسان من حقوقه الأساسية” حقًا مشروعًا- بتحول الدولة -بالنسبة لهذه الفئات- إلى معسكر اعتقال كبير![١٠] تلك الأماكن التي تجيز تعليق القانون، وبناء مجتمعات محلية من الناس وسلبهم حقوقهم، “وهي أيضاً تلك الأماكن التي لا تُطبَّق فيها كافة قوانين العالم عن العمل”[١١]، إن خطر المعتقلات والمنطق الذي تقوم عليه، ما هو إلا تطبيعٌ للعنف الذي تمارسه الدولة على هيئة أفعال مرتبطة بالقانون لإضفاء الشرعية عليها، وتطهيرها من مقاصدها الحقيقة؛ فكثيرًا ما تحدث “العقوبة الاستباقية”، من خلال تلك البرامج التي ترمي لمكافحة التطرف العنيف.
ازدهرت برامج مكافحة التطرف العنيف بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، وعلى الرغم من أن هذه البرامج لا تستهدف المسلمين بشكل صريح، لكنها أخطأت في تحديد هوية الآلاف من الشباب المسلمين باعتبارهم تهديدات إرهابية محتملة، حيث أن بعضهم لم يتجاوز الرابعة بعد[١٢]، وقد كان برنامج “مكافحة التطرف العنيف”، -التابع لوزارة الأمن القومي الأمريكية- وثيق الشّبه ببرامج مثل برنامج “بريفينت”[3*] التابع للمملكة المتحدة، فضلًا عن غيره من النماذج الأوربية، ووفقًا لما أخبر به كوندناني وهايز، بأن برنامج وزارة الأمن الداخلي المسمى بـ “مكافحة التطرف العنيف” اتخذ طابعًا جديدًا في ظل إدارة ترامب، وفي حين أن الحكومة البريطانية، وصُنّاع القرار السياسي في الاتحاد الأوربي، بذلوا مؤخرًا جهودًا كبيرة لإعادة صياغة سياستهم في التعامل مع التطرف بجميع أشكاله، إلا أن إدارة ترامب ركزت على ” الإسلام المتطرف”، وقد طرح المسؤولون في الفترة الانتقالية لرئاسة ترامب، فكرة إعادة تسمية برنامج “مكافحة التطرف العنيف” -التابع لوزارة الأمن الداخلي- ليصبح: “مكافحة الإسلام المتطرف” أو “مكافحة الجهاد العدواني”، وكان جميع الحاصلين على المِنح المُقدَّمة من برنامج مكافحة التطرف العنيف، كيانات تحت إدارة ترامب لإنفاذ القانون، بينما أوقف التمويل للمنظمات الإسلامية، والمنظمات التي تتصدى للعنف العنصري الأبيض[١٣].
وبعبارة أخرى، في ظل إدارة ترامب، أعيدت برمجة كل الادعاءات بأن برامج مكافحة التطرف العنيف “موضوعية”، وأُسقط مفهوم التصدي للعنف المتطرف بعيدًا عن المنظور العرقي والثقافي، علاوة على ذلك، فقد شُرّدت المُنظمات الإسلامية التي بإمكانها التصدي بشكل أفضل لقضايا التطرف العنيف داخل مجتمعاتها؛ حيث تؤكد سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب في ظل إدارة ترامب وما سبقها من إدارات، افتراضًا مفاده: أن الإرهاب شكل من أشكال “الآخر”، واردٌ من الخارج عبر بوابة المسلمين إلى حدود الدولة، وعلى ما يبدو فإن المسألة القومية أصبحت في حِلٍ من تهديد التطرف العنيف؛ فقد اعتبر التمويل الذي يُعنى بالتصدي للتطرف على أيدي أتباع التطرف البيض أمرًا ليس له أهمية.
وقد كان هذا هو الحال، على الرغم من أن سيادة البيض ما زالت تشكل التهديد الأكبر على الأمن القومي لأمريكا أكثر من الأفراد الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية باسم الإسلام، فوفقًا للدراسات الحديثة؛ فإن عدد الأعمال الإرهابية الداخلية التي ارتكبتها جماعات اليمين المتطرف، كان أغلبهم من المؤيدين لعنصرية العرق الأبيض، أكثر بكثير من أعمال المتطرفين المسلمين[١٤]، أضف إلى ذلك أنه من عام ٢٠١١م إلى ٢٠١٦م، لم يرتكب المسلمون سوى ١٢٪ من الهجمات الإرهابية في أمريكا، بينما ارتكب الأشخاص المؤيدون لسيادة العرق الأبيض، والنازيون، وجماعات أخرى من اليمين المتطرف، أكثر من نصف هذه الهجمات خلال الفترة نفسها[١٥].
كما أن التشريعات مثل قانون “باتريوت” الأمريكي، وبرامج وزارة الأمن الداخلي لمكافحة التطرف العنيف، وغيرها من أشكال الإسلاموفوبيا الهيكلية، تعزز مفهوم تصنيف المسلم ضمن قالب “الآخر”، وفي جوهرها تخلق الإسلاموفوبيا الهيكلية حيزًا مشروعًا يُطرح فيه الموضوع الإسلامي خارج الحيز القومي؛ فيصبح تعليق الإجراءات القانونية الواجبة والمساواة في الحقوق هو القاعدة وليس الاستثناء، ويُضفي هذا النوع من “تصنيف الناس ضمن الآخر” المزيد من الشرعية على الإسلاموفوبيا التي تسنها الجهات الخاصة.
الإسلاموفوبيا الخاصة “السرية“: مظاهرها من تهديد المسلمين، واضطهاد نساءهم، وتقسيم المسلمين إلى أخْيار وأشرار.
لابد من شرح الإسلاموفوبيا الخاصة مثلما شُرحت الهيكلية من أجل فهم كيفية نشأة مفهوم المسلم بوصفه “آخر” ولماذا؟
فأعمال التعصب والتحيز الأعمى، القائم على أيدي الأفراد والمؤسسات الخاصة، والمدعومة ببعض الافتراضات والمفاهيم المسبقة عن الإسلام والمسلمين؛ ويعد كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد اليوم عمل أساسي، ساهم بشكل كبير في فهم كيفية وسبب ظهور الإسلاموفوبيا في المجتمع الأمريكي، ووفقًا لما كتبه سعيد؛ فإن الاستشراق هو: أسلوب فكري يعتمد على التمييز الوجودي، والمعرفي، بين الشرق والغرب في معظم الأحيان[١٦]، وذكر سعيد في كتابه، عن وجود الفكر الاستشراقي في أعمال العلماء والفنانين والأكاديميين الأوروبيين كان طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، ومن خلال تحليل الأعمال الأدبية الأوربية المتعارف عليها هذا العصر، لاحظ سعيد وجود تحريفات ومبالغات، وكذلك وجود تلك الثنائيات التي بنت الغرب على أنه متعارض تمامًا مع الشرق.
وجادل سعيد في أن المستشرقين يرون أن أهل الشرق أو المشرق عدائيون وبدائيون ومعارضون بشدة للغرب، وهو يرى أن وجهات النظر هذه تجاه الشرق، أدّت إلى استمرار مجموعة من التصورات والنماذج النمطية التي تتجاهل تمامًا التنوع الفعلي في جميع أنحاء الشرق، فأصبحت وجهات نظرهم هذه بمثابة تصورات مجازية أساسية للموضوع الإسلامي، في المخيلة الغربية.
وعلى الرغم من أن عمل إدوارد سعيد هذا، قد سُبق بعدد من الدراسات الأخرى التي تبحث في العنصرية ضد المسلمين، إلا أن حضوره ما زال مؤثرًا وأساسيًا في هذا السياق، وكما لاحظَت كومار -صاحبة كتاب “فوبيا الإسلام والسياسة الإمبريالية”- أنه لا يزال هناك عدد من الشبهات الاستشراقية المستمرة في إهانة الإسلام[١٧]، ومن هذه الشبهات: أن الإسلام دين موحد يديم التمييز على أساس الجنس، وأن المسلمين مشبَعين بميل مضاد للعقلانية والمنطق، وأنهم غير قادرين على تحمل الديمقراطية والحكم الذاتي، وأن الدين الإسلامي عنيف بطبيعته؛ وفي سياق الحرب على الإرهاب أعيد تشكيل عدد من هذه الشبهات لتصبح صورة الرجل المسلم مصدرًا للخطر.
لم تكن الحرب على الإرهاب مجرد حرب انتقامية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، بل كانت حربا ليس لها جدول زمني واضح ولا هدف محدد، وضد عدو غير محدد بوضوح، فقسّمت العالم إلى ثنائيات متعارضة تمامًا، ويجب أن يُصنَّف كل فرد سواء مؤيد أم معارض، وبهذا المنطق صيغ مفهوم “الذات” و” الآخر” كصور مرآة مشوهة للعالم.
لقد أَوْهم المحرضون للحرب على الإرهاب العالمَ بأنهم ليسوا إلا دعاة للحرية والديمقراطية والاستقلال، ضد “الآخر” البدائي والعنيف والجائر! ووفقًا للكاتب رازاك؛ فإن هناك ثلاثة أوصاف لشخصيات مجازية هيمنت على المشهد الاجتماعي في الحرب على الإرهاب وأساسها الإيديولوجي لصدام الحضارات، وهي: الرجل المسلم الذي يمثل مصدر الخطر، والمرأة المسلمة المهددة بالخطر، والأوروبي المتحضر[١٨]؛ وبالتالي وفي هذا السياق صُور الرجال المسلمون على أنهم عنيفون وكارهون للنساء، ويُفهم أن النساء المسلمات ماهن إلا مستضعفات في خطر وفي حاجة إلى انقاذهن من معتقداتهن وثقافتهن القمعية، وفي المقابل كان يُنظر للدول الغربية على أنها مناهضة للدين والثقافة القديمة التي يجسدها الإسلام والمسلمون، فمثلت بذلك المثل العُلْيا التي لم تكن الثقافة الإسلامية قادرة على تمثيلها.
عُمّمت هذه الشبهات، وتم تداولها في وسائل الإعلام، وأفلام المسلمين الثقافية الشعبية؛ وبذلك شقّت طريقها إلى الخطاب العام، والسياسي، المتعلق بالإسلام والمسلمين[١٩]؛ ففي أعقاب غزو أفغانستان مباشرة، كان هناك مشاهد إعلامية مستمرة، لنساء أفغانيات يتحررن من ثقافتهن القمعية، فاحتفل السياسيون الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بحربهم العنيفة على الإرهاب تحت ستار الدفاع عن حقوق المرأة، وبذلك دعمت الجماعات النسوية -مثل المؤسسة النسوية الأمريكية التي مثلت أكثر من ٢٢٠ منظمة لحقوق الإنسان- النساءَ في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم[٢٠]؛ فهذه الحرب على الإرهاب، أيّدت شبهة أن “المرأة المسلمة عرضة للخطر” وهي بحاجة إلى الإنقاذ من الرجل المسلم الذي يشكل مصدر خطر عليها، وبحاجة إلى الإنقاذ من ثقافتها العنيفة الهمجية المفروضة عليها[٢١]، ومع ذلك وفي أثناء هذه المحاولات، وكما أشار موري ويكين: ” كان صوت نساء العالم الثالث نفسه صامتًا فعليًا، ولم يوكل إليهن مسؤولية المشاركة في كيفية إنقاذهن مما ادعي أنه خطر محدق بهن”.[٢٢]
عندما ننظر إلى التمثيل الثقافي الشعبي للمسلمين، وكما لاحظ شاهين؛ نرى أن أكثر من ألف فيلم -خلال القرن العشرين- يتضمن صورًا مهينة للمسلمين، ويعزز كثير منها الشبهات الاستشراقية حول الأنثى المسلمة المظلومة، وحول العنف والثقافة البدائية، والرجل المسلم الوحشي[٢٣]؛ فلا تزال هذه الصور النمطية حاضرة، في سياق ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الأفلام، مثل:
(The Kingdom) [2007]
(Iron Man) [2008]
(Body of Lies) [2008]
(The Dictator) [2012]
(Argo) [2012]
(Zero Dark Thirty) [2012]
(American Sniper) [2014]
وحاضرة أيضًا في الدراما التلفزيونية الشعبية، بما في ذلك (2001-2010, و 2014) و Homeland (2011-2018)
إن هذه النماذج من وسائط الإعلام، توفّر إمدادًا لا نهاية له من الشبهات المتكررة حول الرجل المسلم الخطير، والأنثى المضطهدة! وبالنسبة للرجل المسلم، ففي الغالب تُمثَّل صورته على أنه إرهابي عازم على تدمير الحضارة الغربية، ويسعى لتدبير مؤامرة إرهابية واسعة النطاق، قد يقتل فيها المئات إن لم يكن الآلاف من المدنيين الأبرياء، فيستخدم هؤلاء الإرهابيون الحرب البيولوجية، أو الأسلحة النووية، أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق أهدافهم؛ بينما تُمثَّل صورة الشخصيات النسائية المسلمة بشكل روتيني، كشخصيات مضطهدة، أو سلبية تتواطأ مع المتآمرين في تلك الأفلام الثقافية الشعبية، وفي بعض الحالات تُمثَّل كمشارِكة نشطة في تنفيذ وتخطيط مخططات إرهابية[٢٤].
قد يظن المرء أن هذا دلالة على التقدم، وأن هناك بعض الاستثناءات في تصوير النموذج النمطي للرجل المسلم الذي يشكل مصدر خطر، والمرأة المسلمة المعرّضة للخطر في تلك الأفلام الثقافية الشعبية للمسلمين، غير أن هذه الحالات الاستثنائية، تُمثَّلُ عمومًا من خلال التفريق بين المسلمين، وتقسيمهم لمسلم صالح وغير صالح؛ وبالتالي فهناك إطار آخر مهيمنٌ على المسلمين في سياق الحرب على الإرهاب، ألا وهو “المسلم الصالح والمسلم الطالح”، فوفقًا لممداني صاحب كتاب: المسلم الصالح والمسلم الطالح، أمريكا وصناعة الحرب الباردة وظهور الإرهاب؛ فإن أمريكا تستعمل الخطابات السياسية والإعلامية لتقسيم الناس إلى معسكريْن: الأول، معسكر المسلمين الصالحين، وهم الموالون لها، من علمانيين وحداثيين وغربيين، والثاني: معسكر المسلمين الطالحين، وهم المعادون لها من أصحاب المذاهب المحافظة وغير الحداثيين[٢٥]، وتدعو هذه الخطابات السياسية والإعلامية، إلى تحديث المسلمين الصالحين والتأقلم مع عالم تسوده العولمة، وعلى النقيض من ذلك، يكون المسلمون الطالحون هم من يناهض الحداثة، ولأن هذه الخطابات تعد من أعمال الشرطة يلزم تنفيذها من خلال السلك العسكري؛ فتُشنّ الحرب على الإرهاب ضد المسلمين الطالحين.
إن القاعدة السائدة هي: أن السكان المسلمين المحليين هم “مسلمون فاسدون” ما لم يتمكنوا من إثبات ولاءهم كمسلمين صالحين موالين لأمريكا؛ وعندئذ يكون المسلمون الصالحون هم من يؤيد الحرب على الإرهاب في العراق وأفغانستان وغيرها من الأهداف، وأيضًا هم من يدعم، وربما يشارك، في إقراض الشعوب المسلمة خلال برامج مكافحة التطرف العنيف؛ فلا يمكن لهم أن ينتقدوا الحرب على الإرهاب، بل يجب عليهم -بلا شك- دعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبالنسبة للمسلمين الطالحين، فليس بالضرورة أن يعارضوا الغرب بشدة، ولكنهم ببساطة لا يفضلون تبني تلك الهوية الغربية[٢٦].
إن تصور الدلالات لا سيما في الأفلام الثقافية الشعبية للمسلمين، أمر أساسي لتحديد المسلمين الصالحين والطالحين، فعادة ما يُصوّر المسلم الصالح على أنه غربي ومتعلم، يتقن اللهجة الأمريكية أو البريطانية، أبيض البشرة، يرتدي ملابس غربية، وعلاقاته مع الغربيين جيدة، وقد يحتاجون في كثير من الأحيان أن يظهروا أنهم غربيون أكثر من الغرب نفسه، ليكون لديهم ما يؤهلهم بصورة شرعية كمسلمين صالحين، وأما المسلمون الفاسدون، فعادة ما يُمثَّلون بأشخاص ذوي بشرة سمراء بلهجة أجنبية، ويرتدون ملابس ذات طراز شرقي، والرجال منهم يُظهرونهم مُلتَحين، والنساء بالحجاب أو البرقع.
وبالتالي يكون فهم العلاقة بين هذه الدلالات المرئية للمسلمين، والفصل بين الصالح منهم والطالح، أمر ضروري لفهم تجارب المسلمين وغير المسلمين للإسلاموفوبيا، فعلى سبيل المثال، تَعرّض عددٌ من رجال السيخ للمضايقة والاعتداء والإساءة على أساس أنهم مسلمين فقط لارتدائهم العمائم، وبالنسبة للنساء المسلمات؛ فقد أشارت الدراسات إلى أنهن عندما يرتدين الحجاب، يعانون من اختلاف المعاملة في المواقف وبصورة سلبية في أكثر الأحيان، مقارنة بأقرانهن اللاتي لا يرتدينه[٢٧].
ختامًا
الإسلاموفوبيا ليست ظاهرةَ ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، وليست ظاهرةَ عهد ترامب؛ بل هي شكل منهجي للعنصرية، تمثل التمظهرات العديدة للعنصرية المتأصلة في المجتمع الأمريكي، ولها إرث تاريخي سبق العديد من التّوترات السياسية والاجتماعية الحالية، فأصبحت التجارب الإسلامية مع الإسلاموفوبيا الهيكلية والخاصة من قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أكثر وضوحًا عند استيعاب المفاهيم في كلٍ من: نظرية العرق الانتقادي، والاستشراق، والنماذج النمطية للرجل المسلم الذي يشكل مصدر خطر، والمرأة المسلمة المُعنّفة، وكذلك ثنائية المسلم الصالح والطالح، كل هذه المفاهيم، تمثّل جوانبًا مفيدةً لتطوير فهم شامل وسياقي ومستنير للإسلاموفوبيا.
الهوامش*
[1] -الخوف من الإسلام وإظهار العداء له وكراهية المسلمين. (المترجمة)
[2] – النظرية العرقية النقدية هي إطار نظري في العلوم الاجتماعية يستخدم النظرية النقدية لدراسة المجتمع والثقافة من حيث صلتهما بتصنيفات العرق والقانون والسلطة. بدأت كحركة نظرية داخل كليات الحقوق الأمريكية في منتصف إلى أواخر الثمانينيات كإعادة صياغة للدراسات القانونية المهمة حول قضايا العرق، وهي تدور بشكل خاص حول موضوعين شائعين: أولاً، تقترح النظرية العرقية النقدية أن تفوق البيض والسلطة العرقية يُحافظ عليهما بمرور الوقت، وأن القانون بالتحديد قد يلعب دورًا في هذه العملية. ثانياً، فحص عمل النظرية العرقية النقدية إمكانية تحويل العلاقة بين القانون والسلطة العرقية. كما سعت النظرية بشكل أوسع إلى مشروع لتحقيق التحرر العنصري ومكافحة التبعية. ومن بين الباحثين المهمين في هذه النظرية ديريك بيل، وباتريشيا ويليامز، وريتشارد ديلجادو، وكيمبرلي ويليامز كرينشو، وكامارا فيليس جونز، وماري ماتسودا. بحلول عام 2002، قدمت أكثر من 20 كلية حقوق أمريكية وثلاث كليات قانونية على الأقل في بلدان أخرى دورات أو فصول دراسية عن النظرية وقامت بتغطيتها. (المراجع)
[3] – بريفينت هو برنامج يهدف إلى مكافحة أيديولوجية الإرهاب وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المملكة المتحدة من هذا الإرهاب وتمكين الناس من ممارسة حياتهم بحرية وثقة. -المترجمة.
هوامش المقال
[1] لمزيد من المناقشة التفصيلية والتحليل المقارن للإسلاموفوبيا في سياقات مختلفة، يرجى الاطلاع على: Arun Kundnani’s The Muslim Is Coming! الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب وكتاب تود جرين الخوف من الإسلام: مقدمة للإسلاموفوبيا في الغرب. [٢] ألين، ٢٠١٠، الإسلاموفوبيا، ساري، دار نشر الأشغت. [٣] بيضون، ٢٠١٨، الإسلاموفوبيا الأمريكية: فهم جذورها ونشأتها، أوكلاند: مطبعة جامعة كاليفورنيا [٤] تايلور، ٢٠٠٩، أسس نظرية العرق النقدي في التربية. In E. Taylor, D. Gillborn, & G. Ladson-Billings, أسس نظرية العرق النقدي في التعليم، ١٦-١، نيويورك، روتليدج، ٤. [٥]ماركس، 2008. نظرية العرق الحرجة.In L. Given, The Sage encyclopedia of qualitative research methods, المجلد ١، ١٦٣-١٦٧، Thousand Oaks،كاليفورنيا.
[٦] بيضون،٢٠١٨، ٤٧، الإسلاموفوبيا الأمريكية فهمها ونشأتها: أوكلاند، جامعة كاليفورنيا. [٧] المرجع نفسه [٨] الشيخ، سيسمور، لي، ٢٠١٧، Legalizing othering: The United States of Islamophobia: بيركلي، معهد هاس. [٩] السلطاني، ٢٠١٢، Arabs and Muslims in the media: Race and representation after 9/11، نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك. [١٠] أردنت،١٩٧٣، أصول الشمولية، نيويورك، هاركورت. [١١] رازاك، ٢٠٠٨، ٧،Casting out: The eviction of Muslims from western law & politics، تورنتو، أونتاريو، مطبعة جامعة تورنتو. [١٢] كوندناني، ٢٠١٤، المسلمون قادمون: الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب، نيويورك، فيرسو. [١٣] كونداني، وهايز، ٢٠١٨، ١١،The globalisation of Countering Violent Extremism policies: Undermining human rights, instrumentalising civil society، امستردام، المعهد عبر الوطني. [١٤] جريدة نورت، ٢١ يونيو ٢٠١٧، https://www.revealnews.org/article/home-is-where-the-hate-is [١٥] كيرنز، بيتوس، إيه، ليميو، الولايات المتحدة: لماذا تحظى “الهجمات الإرهابية للمتشددين الإسلاميين” باهتمام إعلامي أكبر؟ ، جامعة جورجيا وجامعة ألاباما. [١٦] سعيد، ١٩٧٩، ٢، الاستشراق، نيويورك، Vintage Books. [١٧] كومار، الإسلاموفوبيا والسياسة الإمبريالية، شيكاغو، Haymarket Books [١٨] رازاك ٢٠٠٨، ٧Casting out: The eviction of Muslims from western law & politics، تورنتو، أونتاريو، مطبعة جامعة تورنتو. [١٩] جوتشالك، غرينبرغ، ٢٠٠٨، Islamophobia: Making Muslims the enemy. Lanham, Maryland: لانهام، ماريلاند، مطبعة Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. [٢٠] توباني،٢٠١٠، White innocence, Western supremacy: The role of Western feminism in the “War on Terror.”، رازاك، سميث، توبان، States of Race: Critical race feminism for the 21st century، ص ١٢٧-١٤٦، تورنتو، Between the Lines. [٢١] للمزيد من المعلومات حول الإسلاموفوبيا المستندة على الأنماط الجنسانية يرجى الاطلاع علىJuliane Hammer’s “Center Stage: Gendered Islamophobia and Muslim Women”، (في كتاب كارل إرنست للإسلاموفوبيا في مجلد أمريكا) ؛ وليلى أبو لغد هل المسلمات بحاجة إلى الإنقاذ؟
[٢٢] موري، ويغن،٢٠١١،١٧٩، Framing Muslims: Stereotyping and representation after 9/11. Cambridge, ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد. [٢٣] شاهين،٢٠٠١، العرب الأشرار كيف تشوه هوليوود أمك، نيويورك، مطبعة غصن الزيتون. [٢٤]السلطاني،٢٠١٢، Arabs and Muslims in the media: Race and representation after 9/11، نيويورك،مطبعة جامعة نيويورك. [٢٥] ممداني، ٢٠٠٤، ٢٤،المسلم الصالح والمسلم الطالح أمريكا وصناعة الحرب الباردة وظهور الإرهاب، نيويورك، مطبعة Three Leaves Press. [٢٦] جوتشالك،غرينبرغ، ٢٠٠٨، Islamophobia: Making Muslims the enemy. Lanham, Maryland:لانهام، ماريلاند، مطبعة Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. [٢٧] باكالي، ٢٠١٦، الإسلاموفوبيا: فهم العنصرية ضد المسلمين من خلال التجارب الحية للشباب المسلم، روتردام،سينس للنشر Sense Publishers.