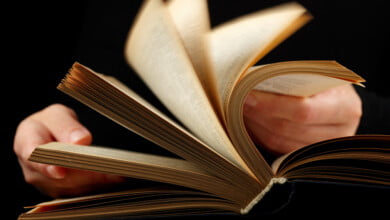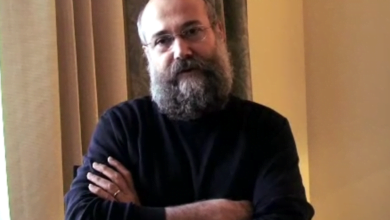- ريتشارد فيشر
- ترجمة: سمية العتيبي
- تحرير: غادة الزويد
بين الحين والآخر، أسأل ابنتي عن المستقبل، عندما كانت في الثالثة كان لديها فقط مفهوم أولي عن الوقت ووعي قليل بالساعات والأيام.
قد تفهم اليسروع النهم، كتاب كلاسيكي للأطفال عن مخلوق يأكل بنهم لمدة أسبوع، لكن عندما تقص عليّ القصة لا تميز بين الأيام، والوقت بالنسبة لها غير منتظم. ومع ذلك في عمر الخامسة فهِمت كيف أن الأمس صار وراءها والغد أمامها. وفي يوم ما على الإفطار سألتها إلى أي مدى يمكن تتخيل المستقبل؟ فأجابت: “عندما أكون بعمر عشر سنوات”. الغد موجود على ما يبدو بالنسبة لها لكن اختفى في الظلام لمدة خمس سنوات قادمة.
هي الآن بعمر سبع سنوات، مؤخرًا سألتها كم بالعادة تفكر في المستقبل؟
قالت “ليس دائمًا، لكن أحيانًا أقلق بشأن ما سيحدث”
“ما الذي تقلقين بشأنه؟”
“أن أتأذى أو يقبض عليّ أو شيء من هذا القبيل”
“هل تستطيعين تخيل نفسك بعمري أو عمر والدتك؟”
“لا”
“هل تتخيلين نفسك مراهقة؟”
“نعم”
“هل تستطيعين تخيل نفسك ولديك أطفال؟”
“هذا يخيفني”
كلما كبرت زاد عدد السنين التي تسكن خيالها، تملأ الثقافة الكثير من هذه اللوحة وأنا عادة لا أعرف من أين التقطتها.
شرحت لي مؤخرًا قائلة: “التفرد التكنولوجي هو عندما يكون الناس بائسين في المستقبل. فيقول شخص ما :” وما المشكلة؟ ستسيطر الروبوتات على الأرض”.
“انتظري، هل تتحدثين عن التفرد التكنولوجي، أين تعلمتِ ذلك؟”[1]
قالت من الفيلم الكرتوني كابتن إندربانتس.
مثلما تتوسع تصورات الأطفال الزمنية كلما كبروا، كذلك فعل جنسنا البشري على مدى آلاف السنين، تمامًا كالأطفال لم يملك أسلافنا ما قبل البشر أي أحساس بالمستقبل البعيد، لذلك كانوا يعيشون فقط في الحاضر، كان مسار البشرية من أشباه البشر مستخدمي الأدوات إلى مهندسي المدن الكبرى متشابكًا مع إحساسنا المتزايد عن الوقت. نحن نملك عقولًا قادرة على تخيل مستقبل عميق ليس مثل الحيوانات الأخرى، كما أننا قادرون على إدراك الحقيقة المثبطة أن مدة حياتنا هي مجرد تجلٍ لخط زمني لا يمكن سبره.
ومع ذلك، بينما قد نملك هذه القدرة إلا أنه من النادر توظيفها في الحياة اليومية؛ فإذا أحفادنا شخصوا علل حضارة القرن الواحد والعشرين، فقد يلاحظوا أن “التفكير قصير المدى” هو مرض خطير يهيمن علينا: إنه ذلك الفشل الجماعي لتجاوز اللحظة الراهنة والنظر والتطلع إلى الأمام. فالعالم متخم بالمعلومات، ومستويات المعيشة ليست أعلى من أي وقت مضى، لكننا بالعادة نجد صعوبة في رؤية ما بعد دورة الأخبار القادمة، أو المصطلح السياسي أو دورات رأس المال في الأعمال.
كيف أشرح هذا التناقض؟
كيف أصبحنا عالقين في الـ “هنا والآن”؟
المستقبل ليس كما كان يبدو
قد تكون القدرة على التلاعب المفهوم بالوقت هي ما تميزنا عن الحيوانات الأخرى، في العصر الجليدي، طور أسلافنا ما يسميه علماء الأحياء التطورية السفر عبر الزمن العقلي، نستطيع تشييد مسارح في عقولنا مما يسمح لنا عرض مشاهد وشخصيات من الماضي بالإضافة إلى قصص افتراضية للمستقبل.
ومع ذلك بينما يملك البشر الأوائل هذه الموهبة إلا أن مفهومهم عن المستقبل البعيد كان بدائيًا. أما في الفكر الغربي فالأمر كان كذلك حتى أواخر العصور الوسطى، سادت لقرون النظرة الدورية للزمن، أي نظرة الفصول والممالك، بعيدًا عن الأطر الزمنية ربما يأتي التغير الرئيسي المتوقع في المستقبل من التعاليم الدينية: نهاية العالم.
وحتى ذلك الحين، يوجد فقط حاضر ممتد. كتب لوسيان هولستشر المؤرخ في جامعة بوخوم في مقال له عام ٢٠١٨: “في العصور الوسطى أخذت كل شؤون البشرية شكل التكرار اللانهائي: البذر والحصاد، المرض والصحة، والحرب والسلام، و صعود الممالك و سقوطها، حيث لم يكن هناك سبب كاف للإيمان بتغير أو حتى تطور في الشؤون البشرية طويلة المدى”.
هذه المخاطر البعيدة تجعل من المهم بشكل متزايد توسيع منظورنا إلى ما بعد الحياة: حيث أفعالنا تموج في المستقبل أكثر من أي وقت مضى.
حتى بناة الكاتدرائيات في العصور الوسطى -غالبًا ما يشاد بهم كأمثلة على التفكير طويل المدى لإنشائهم أبنية من شأنها أن تبقى لأجيال- لم يتخيلوا مستقبلًا مختلفًا جذريًا مع أي درجة كبيرة من النظر. هم يتصورون العالم في الغد كما لو كان مثل عالمهم اليوم فهو ثابت ومعلوم. (كما يجب أيضًا ملاحظة أن بعض الكاتدرائيات انهارت بسبب العمل بنظرة قصيرة المدى. أحد الأدعية التي تقال أثناء العمل “يارب، أسند سقفنا هذه الليلة، حتى لا يسقط علينا بلا حكمة ويخنقنا، آمين”).
في الغرب لم يظهر هناك إحساس عميق بالوقت حتى القرن الثامن عشر، حيث أظهر الجيولوجي جيمس هتون كيف امتد التسلسل التاريخي المكتوب في الصخور الإسكتلندية إلى ملايين السنين في الماضي. كتب الفيلسوف إمانويل كانط أنه سيكون هناك الملايين والملايين من القرون التي سيكون فيها عوالم جديدة وأنظمة عالمية، مضيفًا “أن الخلق لم ينته بعد، هو له بداية لكن لن يكون أبدًا له نهاية”، وبدأ الكُتاب الحلم بعالم مستقبلي. نشر لويس مرسيه في عام ١٧٧٠م رواية L’An 2440، -رواية خيالية عن رجل يستيقظ في باريس المثالية في القرن الخامس والعشرين- حُظر الكتاب من الكنيسة الكثالوكية، وفي أسبانيا من المفترض أن الملك أحرقه بنفسه.
على مدى ٢٠٠ سنة، مهدت هذه الإطالة العلمية والفكرية المدة الزمنية التي يمكن تخيلها الطريق لخطوات كبيرة في فهمنا لأنفسنا وللكوكب، فهي التي سمحت لداروين ليقدم نظريته للتطور وللجيلوجيين ليقولوا إن التاريخ الكربوني هو العصر الحقيقي للأرض وكذلك الفزيائيين لمحاكاة توسع الكون. وأن وعينا بالزمن العميق وجد ليبقى، لكن لا يعني الانتباه إليه.
إن التأمل الأوربي في القرن الثامن عشر لمستقبل طويل ومشرق لم يدُم، كانت وجهات النظر تقصر بشكل دوري، غالبًا من خلال أزمات مثل الثورة الفرنسية، يجادل هولستشر بأنه يمكنك أن ترى هذا التغير في الكتابة من أواخر القرن الثامن عشر إلى مطلع القرن التاسع عشر: حيث أفسحت التوقعات المتفائلة والبعيدة المدى حول العالم الطريق لوصف أكثر حذرًا للمستقبل، مع التركيز على الخطوات التالية والتحسينات القريبة المدى على مستويات المعيشة. ويؤكد أن انكماشًا مشابهًا حدث مع الحرب العالمية الأولى، بعد النظرة المستقبلية المأمولة في أوائل القرن العشرين.
وفقًا للمؤرخ فرانسوا هارتوغ، صاحب كتاب “أنظمة التاريخانية” يقول: نحن في وسط انكماش آخر الآن، ويجادل بأنه في نقطة ما بين أواخر الثمانينات بداية هذا القرن، أخذنا نقارب الاتجاهات المجتمعية إلى نظام زمني جديد سماه “الحاضرية persentism” والتي عرفها “بالإحساس بأن الحاضر هو الموجود فقط والذي يتميز في آن واحد باستبداد اللحظة وبطاحونة “الآن” اللانهائية”.
وكتب في القرن الواحد والعشرين “المستقبل ليس أفقًا مشعًا يوجه خطواتنا المتقدمة، بل هو خط ظل يقترب”.
على نطاق الحضارة، من الصعب اختبار بشكل تجريبي تأكيدات أولئك الذين يقولون نحن نعيش في عصر قصير المدى. وقد يكون لدى المؤرخين المستقبليين رؤية أوضح؛ لكن لا نزال نستطيع رؤية الافتقار لتفكير طويل المدى الذي يعاني منه مجتمعنا.
يمكننا رؤية الآنية في التفكير في الأعمال التجارية، وفي الشعبوية السياسية وفي فشلنا الجمعي لمواجهة مخاطر طويلة المدى مثل الاحتباس الحراري والأوبئة والحرب النووية ومقاومة المضادات الحيوية.
بإمكانك رؤيتها في الأعمال حيث تشجع التقارير ربع السنوية الرؤساء التنفيذيون على إعطاء الأولوية لرضا المستثمرين قصير المدى على الرخاء الطويلة. ويمكنك أن تراها في الشعبوية السياسية في تركيز القادة على الانتخابات المقبلة وطلبات قاعدتهم أكثر من ازدهار الأمة على المدى الطويل. كما يمكنك رؤيتها في فشلنا الجمعي لمواجهة مخاطر طويلة المدى مثل الاحتباس الحراري والأوبئة والحرب النووية ومقاومة المضادات الحيوية.
جعلت هذه المخاطر من الضروري بشكل متزايد أن نمد منظورنا إلى ما بعد الحياة حيث أفعالنا تموج في المستقبل أكثر من أي وقت مضى، لكن الأمر كما يرى فيلسوف أكسفورد توبي أورد بأن هذه القوة لتشكيل المستقبل ليست موصولة ببصيرة أو حكمة.
قد يوجد قوى متعددة تعزز العقلية القصيرة المدى في عصرنا، يشير البعض إلى الأنترنت كآفةٍ غالبًا ما يلقى اللوم عليها. وآخرون يأسفون على تقاطع الإعلام الإخباري والسياسة، مما يشجع صانعي القرار على التركيز على العناوين الرئيسية أو الاقتراع أكثر من الأجيال القادمة. يلقي هارتوغ باللوم على الأعراف الرأسمالية الاستهلاكية التي هيمنت على الثقافة الغربية في أواخر القرن العشرين. فخلال هذه الفترة “استمر التقدم التكنولوجي ونما المجتمع الاستهلاكي، يضيف: ” ومعه فئة الحاضر التي استهدفها المجتمع وإلى حدٍ ما خصصها كعلامة تجارية خاصة به”.
وكما هو الحال مع العديد من الأمراض، لا يوجد مسبب وحيد لها، وبالأحرى إن تقارب العديد من المسببات هو المسؤول، لكن لا داعي لليأس، فإن صح هذا الحساب، فأن الآنية هي خاصية ناشئة للحظة الثقافية والاقتصادية والتكنولوجيا، لا تحتاج لتستمر للأبد وليست خارج السيطرة بالكامل.
الافتراض بأنه يجب أن تظل الأشياء دائمًا على ما هي عليه اليوم هو في الحقيقة شكل من أشكال الحاضر.
ضغوط زمنية
خلال زمالة حديثة في معمهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قمت بالتحقيق في كيف تستطيع تجربتنا النفسية التغيير للمستقبل، حيث كنت أشعر بالفضول لمعرفة ما الدور الذي يلعبه المستقبل البعيد في حياتنا اليومية إن وجد، كما أردت معرفة ما الذي تسببه الضغوط النفسية لنا لنفقد النظرة البعيدة المدى في اتخاذنا لقراراتنا اليومية، و قد اسميت هذه الضغوطات” بالضغوط الزمنية”
ظهرت بعض السمات لها مرارا وتكرار وهي:
- الوفرة
- العادات
- الحمل الزائد
- المسؤولية
- الأهداف
أولًا، البروز تميل الأحداث المدهشة والتي لها صدى عاطفي إلى السيطرة على تفكيرنا أكثر من الأحداث المجردة، إنها أحد جوانب “عملية الوفرة” وهو التحيز المعرفي الذي يعني أنه من المرجح أن يتخيل الناس المستقبل من خلال عدسة الأحداث الأخيرة.
هذا يعني أن المشاكل البطيئة والمتكونة بشكل تدريجي مثل الاحتباس الحراري لن تقفز في وجه رادار الانتباه، حتى يحترق شيء ما أو يفيض، فقبل جائحة كورونا كان حتى علماء الأمراض كانوا أكثر تركيزًا على المخاطر البارزة “لإيبو وزيكا” بدلاً من فيروسات كورونا.
تلعب العادات الراسخة الغير مرئية دورًا هنا.
من الصعوبة التغلب أو تقليل تأثير البروز عندما نتصفح في هواتفنا أخبار الجدل السياسي، أو الجريمة أو الحروب الثقافية أو الكوارث أو الهجمات. فعلى الرغم من أهميتها، هذه الأحداث تملأ تصوراتنا عن المستقبل بدرجة غير مناسبة.
يمكن للسلوك قصير المدى أن يصيب المنظمات أيضًا، على سبيل المثال: قام مركز الأبحاث قلوبال إف سي إل تي مؤخرًا بمراجعة عادات الشركات وحذر من السماح لاجتماعات مجلس الإدارة بالتركيز على الامتثال بدلًا من الإستراتيجة طويلة المدى. أو الفشل في إخبار المساهمين بالخطط الطويلة المدى. ممكن لقادة الأعمال الذين يؤسسون لعادات مختلفه- مثل جيف بيزوس الذي ينقل المبادئ البعيدة المدى لأمازون إلى المساهمين بشكل منتظم- أن ينشؤوا ثقافة بين الموظفين والمستثمرين تعزز الرؤية طويلة المدى.
يضاعف العبء الزائد للحياة المتصلة كل هذا، فلا أحتاج لأسهب في الحديث عن تسارع التغير التكنولوجي وتأثيره في النظام البيئي للمعلومات، لكن إذا كنت تبحث عن أدلة فخذ في اعتبارك أنه استغرق ٧١ عامًا حتى تم استخدام الهواتف من قبل نصف سكان الولايات المتحدة. وعلى النقيض أخذت الهواتف الخلوية ١٤ عامًا فقط لتصل إلى نفس العدد والأنترنت كذلك أخذ مجرد عقد من الزمن.
صاحب تسارع وتيرة التكنولوجيا تسريع الحياة والعمل والمعلومات مما أدى إلى زيادة عبء انتباهنا، اقترح بحث أجري في عام ٢٠٠٥ أن صورة الناس للمستقبل تصبح “قاتمة” حوالي من ١٥ إلى ٢٠ سنة من الآن، كما أشار عالم الكونيات مارتن ريس من الصعوبة أن تكون -مفكرا كاتدرائي- عندما تعد حيوات أطفالنا بأن تكون مختلفة تمامًا عن حياتنا، وهي مشكلة لم يواجها بكل بساطة أسلافنا في العصور الوسطى.
كما أدت الطبيعة المتسارعة لحياة القرن الحادي والعشرين إلى إضعاف المسؤولية عن أفعالنا، فالعالم الحديث جعل من السهل فصل أنفسنا عن عواقب أفعالنا والمساءلة عليها. فكر في ساندويتش البيرغر، يشترك مستهلك واحد فقط في سلسلة التوريد العالمية المعقدة في جزء من المسؤلية عن العلل التي يسببها إحضار تلك الساندويتش إلى الطاولة: انبعاثات كربونية، وزراعة المصانع، وتلوث المياه وغيرها..
” إن المشاكل البطيئة والمتكونة بشكل تدريجي مثل الاحتباس الحراري لن تقفز في وجه رادار الانتباه حتى يحترق شيء ما أو يفيض”
عندما كانت المجتمعات صغيرة كانت الأمور مختلفة فالبضائع محليه، والالتزامات المجتمعية ملموسة أكثر، منذ قرون مضت، لم يكن على الناس التفكير بشأن الأضرار التي تسببها الزراعة الصناعية ولا النفايات الذرية، أو لدائن المحيطات أوالكربون الجوي أو غير ذلك من الموروثات الخبيثة التي نتحمل مسؤليتها بشكل جماعي ولسنا مذنبين بشأنها بشكل فردي. (وحتى في هذا العالم الأبسط بكثير، كانت الحضارات تنهار أحيانًا بعد استنفاد مواردها الطبيعية من بين المنعطفات الأخرى الخاطئة).
نحن بحاجة إلى طرق لجعل تلك المسؤوليات مرئية أكثر والأهم من ذلك محاسبة الناس.
الضغط الزمني الأخير -وهو ضغط رئيسي- هو الأهداف حيث تسيطر المقاييس اليوم على كل مجالات الحياة. إذا تم تأطير إحصاءات النمو، ودرجات الكفاءة، وعودة المساهمين ومؤشرات الأداء الرئيسية والناتج المحلي الإجمالي والعائد الاستثماري بشكل سيئ فإن ذلك سيعزز من الحاضرية أو حتى تشجع السلوك السيئ.
وصف عالم الاجتماع روبرت جاكال سيناريو واحد يحدث فيه هذا بانتظام اسماه “حلب المصنع”: حيث يصل المدير لمعمل أو مصنع مع مجموعة من الأهداف الطموحة على لوحته وعلى الفور يقوم بتطبيقها بصرامة بالغة على موظفيه؛ وفقًا لذلك الإنتاجية ستزيد، فبعد أشهر ستتحقق الأهداف وسيترقى المدير أو ستمضي قدمًا، مخلفًا وراءها فوضى: عمال وآلات يتساقطون على الأرض من الإعياء. وبعد ذلك سيتعين على المدير التالي تجميع القطع المتناثرة بمجموعة جديدة من الأهداف القصيرة المدى، وهكذا تتكرر الدورة.
اختيرت مشكلة المقاييس من قانون قودهارت، الذي سمي على اسم خبير اقتصادي بريطاني، والذي يصاغ على النحو التالي:”عندما تكون المقاييس هي الهدف، تتوقف أن تكون مقاييس جيدة”. لذلك للهروب من الآنية لابد أن نعيد تقييم الأهداف التي نقيس بها النجاح. هل يشجعون التفكير طويل المدى، أم يولون أولوية للمكاسب الحالية فقط؟
قد نبدأ بالتفكير في كيف يمكن للشركات أن تفعل المزيد لتحقق التوازن بين الأهداف السنوية أو الفصلية والتطلعات طويلة المدى التي تستمر -أو حتى تتجاوز- الحياة، مثل الالتزامات التي تعهدت بها بعض شركات النفط للوصول الصفري لصافي الانبعاثات، نحن بالفعل نجحنا في هذا على المستوى الشخصي إلى حد ما، من خلال أهدافنا المهنية أو التعليمية أو العائلية، كما تبذل بعض المحاولات في المجال السياسي لتحديد المقاييس التي تمتد لعقود أو قرون، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تم استيعاب جزء منها في قوانين وسياسات المنظمة حول العالم.
(أقرت ويلز على سبيل المثال قانون رفاهية الأجيال القادمة، يستند بشكل واسع على أهداف الأمم المتحدة، لذلك يتطلب من الهيئات العامة بعض الأهداف طويلة المدى في عملية صنع القرار).
قد تكون محاربة الضغوط الزمنية بمثابة كفاح، لكن الأهداف التي نختارها متروكة لنا تمامًا، لإعادة صياغة ذلك القول المأثور: أنت تبالغ فيما يمكنك تحقيقه في يوم، لكنك تقلل من شأن ما يمكنك تحقيقه في قرن.
توقف التاريخ
إن تحديد الضغوط الزمنية التي تعزز الآنية في حياتنا هي فقط نقطة البداية، لذلك تحدينا الكبير في هذا القرن هو تغيير علاقتنا بالوقت. يشير التاريخ إلى أن آفاقنا قصرت من قبل- لكن يمكن أن تتوسع مرة أخرى أثناء الجائحة، أصبح “واقعنا” أكثر تطرفًا، لكن الأعراف الثقافية تحديث أيضًا لذلك؛ قد لا يوجد أبدًا وقت أفضل من التساؤل عن المستقبل الذي نريده بالفعل.
يلمح البعض أننا ربما نعيش في “توقف التاريخ” وهو وقت مؤثر بشكل فريد لمستقبل البشرية، فلم يكن لدينا مطلقًا الكثير من الطرق لتدمير أنفسنا من خلال الأسلحة النووية إلى مسببات الأمراض البيلوجية، لكن إذا تمكنا من رسم طريق خلال هذه الفترة عن طريق تبني فكرة المدى البعيد، حسب البرهان، فإن جنسنا البشري -مثل الثديات الأخرى- لديه القدرة على البقاء لملايين السنين.
إذا كان تصور الزمن المتطور للبشرية يعكس تصور طفل كابنتي، فإن نضجنا الزمني كنوع لم يأت بعد.
ربما نكون نحن في مرحلة مضطربة من المراهقة، والعمر سيجلب إحساسًا أعمق بالمستقبل مثل المراهقين الذين واجهوا بشكل مفاجئ عواقب أفعالهم، فإننا نواجه أزمة نتجت عن الآنية، لذا دعونا نأمل أن تكون مجرد الصدمة التي نحتاج لكي ننمو.
[1] هو فرضية أن اختراع أجهزة ذكاء اصطناعي خارقة ستؤدي إلى نمو تكنولوجي سريع، مؤديةً إلى تغيرات غير معقولة في الحضرة البشرية. طبقًا لهذه الفرضية، ستدخل أدوات ذكية (مثل جهاز كومبيوتر يعمل على أساس برنامج مبني على فكرة الذكاء الاصنطاعي) في تفاعلات سريعة من الدوائر المطورة لأنفسها؛ مع كل جيل أحدث وأذكي يعمل بسرعة أكبر وأكبر، مؤديةً إلى انفجار معرفي وإلى ذكاء صناعي خارق، يتجاوز كل الذكاء البشري. (الإشراف)