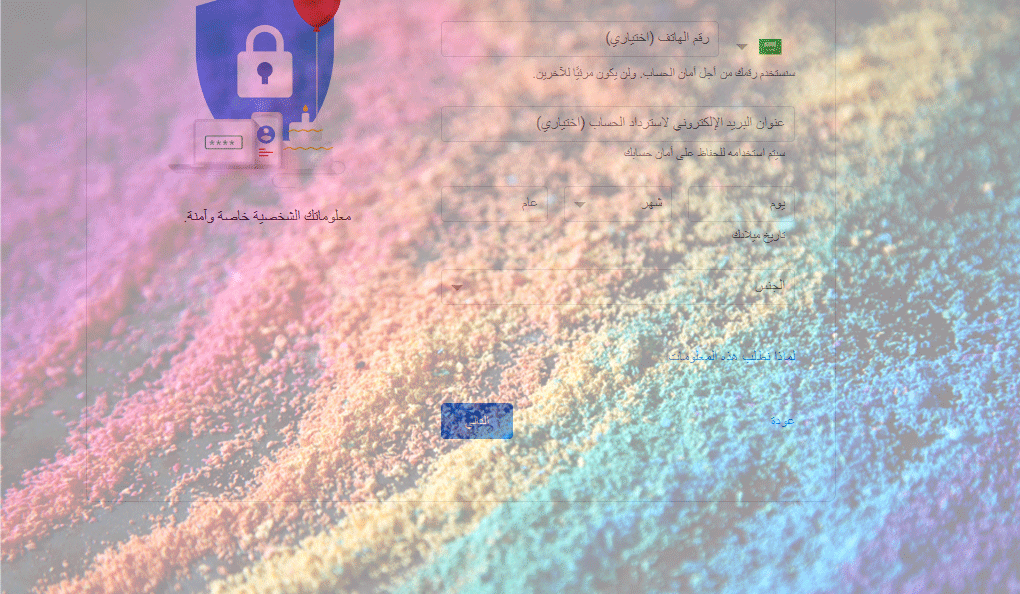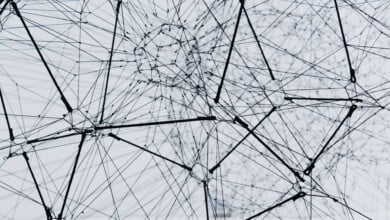عبد الرحمن بن فهد الموسى
ذات مساء شتوي وديع، اتصل بي صديق عزيز لم يتصل بي منذ مدة بعيدة من كتابة هذه الأحرف -ولا أعلم في الحقيقة حاله اليوم وتصاريف الدهر به- فسألني حينها عن المعجزة التي تثبت صحة الإسلام! لقد كان سؤالاً مباشراً وكان يسترسل في تساؤله قائلاً: أنك تجد القرآن يحكي معجزات الأنبياء كهود وصالح وموسى وغيرهم، فما هي إذاً معجزة الإسلام الخالدة التي تثبت صحته لأتباعه، وتقطع الشك باليقين؟! قلت له يومها: إنها القرآن، فأخبرني بأنه قد بحث حقاً ووجد هذه الإجابة إلا أنه يتساءل عن كيفية إثباتها للآخرين فضلاً عن كيفية التأكد من إعجاز القرآن بنفسه؟
كنت يومها قد استأنفت السنة الثانية من دراستي في كلية الشريعة، وبقدر ما حرت جواباً لسؤاله يومها وتشبثت ببعض الأجوبة العامة، بقدر ما أهمني آنذاك وازداد كلفي بالأمر، تخرجت من كلية الشريعة وعلمت بعد ذلك أن المعجزات ليست الطريق الأوحد لإثبات صحة دين من الأديان، وأن النبوات تثبت بعدد من الدلائل والبراهين لا يسع المقام لذكرها، إلا أن سؤاله ما زال يلحّ علي يومئذ؛ فعزمت على جرد جملة من بعض المؤلفات التي ورثناها عن السلف وتلقيناها عن الخلف في معالجة هذه المسألة حتى يستشفي قلبي، ويجلو همي، فقرأت ودرست حينها عدداً من الكتب والمؤلفات التي أولت الأمر عناية واهتماماً ثم انقطعت عن ذلك سنيناً حتى كان شهر رمضان الفائت، فبينما كنت أعبث في بعض أرفف المكتبة وقعت عيني على عدد من الرسائل والكتب في إعجاز القرآن؛ فخطر لي يومها أن أجمع تلك المعالجات في مقالة متوسطة الحجم تؤسس لهذا الموضوع وتعالج الإشكالات الواردة عليه بأسلوب يسع غير المتخصص، وليتها تصل لصاحبي الذي انقطع عهده بي فيسقط عني رهق السؤال ومغبته.
مدخل
“حكى ابن أبي هريرة عن أبي العباس بن سريج قال: سأل رجل بعض العلماء عن قوله تعالى: “لا أقسم بهذا البلد “(البلد/1) فـ (كيف) أخبر سبحانه أنه لا يقسم بهذا البلد، ثم أقسم به في قوله “وهذا البلد الأمين“ (التين/3)؟
فقال ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؛ أجيبك ثم أقطعك؟ أو أقطعك ثم أجيبك؟
فقال: بل اقطعني ثم أجبني.
قال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحضرة رجالٍ وبين ظهراني قوم، وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً، وعليه مطعناً، فلو كان هذا عندهم مناقضة لعلّقوا به وأسرعوا بالرد عليه. ولكنّ القوم علموا وجهلتَ، فلم ينكروا ما أنكرت.
ثم قال: إن العرب قد تدخل ” لا ” في أثناء كلامها وتلغى معناها، وأنشد فيه أبياتاً”. [١]
لقد نزل القرآن على قوم هم أهل فصاحة وبلاغة ومروءة ونجدة وبصيرة ورأي، فلم تنجدهم بصيرتهم ولا آراؤهم ولا فصاحتهم عن أن يعارضوه أو ينافروه؛ لما بهَتهم ببلاغته وأوقفهم بين سوره وآياته، فكان القوم بين مؤمن به مسلّم له عارف بعجزه عن مثله منقادٍ لما جاء به مدهوشٍ لما يسمعه، وبين جاحد به متعصب لآبائه متنكّب كل عسير متجشّم كل شاق عصيب مُصرٍ في معاندته حتى وهن وعجز عن طمسه فرغم أنفه وقتل بعناده نفسه.
وهذا العجز في حقيقته هو مفهوم الإعجاز القرآني، أي: العجز عن الإتيان بالمثل أو ما يفوقه مع توفر الممكنات له وانتفاء الموانع، فالقرآن إنما جاء بلسان عربي مبين، ونزل على أهل عروبة وفصاحة وبلاغة يتفاخرون فيما بينهم بفصاحتهم وبلاغتهم، ويتفاضل بعضهم على بعض بخطبهم وأشعارهم، فلما سمعوا القرآن كبر عليهم ما دعاهم إليه، فأعرضوا عنه واتهموه بالفرية والسحر ونسبوه إلى أساطير الأولين، فتحداهم الله إلى أن يأتوا بمثله فعجزوا عنه، على أنه مؤلف من حروف هي حروف لغتهم (“آلم“)، ومفردات هي من اشتقاق مفرداتهم، فشق عليهم لما وهنوا عنه، وأدركوا شأوه ورفعته، فكان معجزاً لهم بمجرد ما سمعوه، وأبلغ في الإعجاز لما تحداهم إلى أن يأتوا بمثله.
وقد ذكر أهل العلم للإعجاز وجوهاً عديدة ينحصر مجملها في بلاغة القرآن وما يستتبعها: كالفضل في الموضوع، والتنسيق الحرفي، والجرس الصوتي، ونحو ذلك، وذكروا غيره مما لا صلة له بالبلاغة كالإخبار بالغيوب السابقة واللاحقة ونحوه، وليس هذا هو الإعجاز المراد تبيينه، فالإخبار عن الغيوب السابقة واللاحقة هو أحد وجوه الإعجاز التي لم يقع عليها التحدي أصالة، فالغيوب السابقة واللاحقة ليست مما يوجد في كل سورة لذا لم يقع عليها التحدي تعييناً، على أن إعجازها ظاهر بين، بخلاف بلاغة القرآن التي وقع عليها التحدي أصالة وابتداء، وهذا الذي أدهش مشركي العرب، وبهت شرفاءهم، وحيّر زعماءهم؛ لما له من الحلاوة، ولما عليه من الطلاوة، فأثمر أعلاه وأغدق أسفله[2]، وأنت إذا تأملت مطلق الكلام -أي جنس الكلام كله- رأيته يتفاضل فيما بينه، ففيه الحلو المستعذب، وفيه السمج المستوحش، وفيه ما هو بين هذا وذاك، ولكلٍ درجات في نفسه من التفاضل والتمايز، وقد درج العلماء على تمييز الكلام البليغ عن غيره، واصطلحوا عليه بأنه “الكلام الفصيح الذي طابق لفظه لمعناه بأحسن صورة وأتمها دون زيادة ولا نقصان”، “فإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى قائم، ورباط ناظم”[3]، وأنت إذا تأملت ذلك؛ علمت أن كلام العرب الذين نزل فيهم القرآن في جملته كلام فصيح، وأن خطب بلغائهم وقصائد شعرائهم من جملة الكلام البليغ، وأن كلامهم في ذاته متفاضل فيما بينهم ومتباين، فلما أنزل الله كلامه على خلقه جاءهم بشاكلة من كلامهم الفصيح البليغ لم يخالفهم في ضروبه وسننه، إلا أن كلامه -جل جلاله- قد فضل على كلامهم في الفصاحة والبلاغة “لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم التأليف مضمناً أصح المعاني”[4] وأبلغها، ففضل على كلامهم -الذي هو متفاضل فيما بينهم-، فكان بذلك معجزاً لهم وإن لم يتحداهم إلى الإتيان بمثله، وهذا معنى من معاني الإعجاز ، فلما اتهموه بالفرية تحداهم إلى مثل كلامه، فقطع لسانهم وأبهت قائلهم، وعجزوا عن أن يعارضوه بمثله، وهذا معنى آخر من معاني الإعجاز ، “فإذا عرفت ذلك تبينت أن القوم كاعوا وجبنوا عن معارضة القرآن لمِا قد كان يؤودهم ويتصعدهم، … فتركوا المعارضة لعجزهم وأقبلوا على المحاربة لجهلهم” [5]، وهذا هو عين الإعجاز حقيقة؛ أنه جاء بكلام من مادة كلامهم، فبهرهم وأدهشهم وأشعرهم بعجزهم عنه، فلما تحداهم إلى مثله خاروا وكُسروا عن الإجابة إلى هذا التحدي ويئسوا منه لعلمهم السابق بعجزهم عنه.
والوقوف على إعجاز القرآن -أي إدراك وتعقل حقيقة إعجاز القرآن- يتأتى بطريقين:
الطريق الأول: وهو طريق من لا يعرف أساليب العرب ولا وجوه تصرف اللغة ووجوه الفصاحة وضروب البلاغة ونحو ذلك، فهذا والأعجمي في منزلة سواء، وإنما يتبينون ويقفون على إعجاز القرآن بالنقل والخبر الصادق عن عجز العرب عنه [6]، وهذا ليس في القرآن وحده، بل هو عام في غيره، فالوقوف على عيون القصائد وأفصحها وإدراك بلاغتها وتفوقها من جاهل بأساليب العرب وتصرف اللغة ووجوه الفصاحة أمر متعذر لا يتأتى لمثله إلا بالنقل عن غيره، وهو في غير الشعر وعلوم اللغة اليوم -كالفن والعلوم التطبيقية- متحقق مدرك بالعقل والواقع، فلا يدرك تفوق عمل فني على غيره من جاهل بهذا الفن غير عالم به، ولا يكاد يدرك المرء تميز بناية ْعن أخرى وصناعة عن صناعة وهو جاهل بأسس هذه العلوم عاميٌ عنها، وإنما يكتفي الناظر بالنقل الصادق عن تفوق عمل فني على غيره، وحسن صناعة على أخرى وهكذا، وكذلك الأمر نفسه في بلاغة الكلام وفصاحته وتفوقه وتميزه، فالنقل الصادق يخبرنا عن عجز العرب عن مضاهاة كلام الله، والأخبار متواترة على ذهولهم من فصاحته وبلاغته، والعقل الصريح يؤكد أن لو كان للعرب مقدرة على مضاهاة كلامه -جل وعز- وقطعه والتفوق عليه لكان هذا أسهل وأيسر من قتال أبنائهم وأرحامهم ومفارقة آبائهم وإخوانهم ومعاناة الهجر والجهد وغير ذلك، “ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة، ولم يركبوا تلك الفوارق المبينة، ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الوعر من الفعل، وهذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لب” [7] فلا يُظن أن القوم قد وجدوا المعاجلة بالقتال أيسر من المعارضة بالقول، فقد “كان قومه (أي محمد ﷺ) -قريش خاصة- موصوفين برزانة الأحلام، ووفارة العقول والألباب، وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون، وقد وصفهم الله -تعالى- في كتابه بالجدل واللدد، فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة -أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه، وأن يضربوا عنه صفحاً، ولا يحوزوا الفلح والظفر فيه، لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع عنه” [8]،والقوم على ما فيهم من الأحلام ووفرة العقول إلا أن “الأحوال دلت من حيث المتعارف من عادات الناس، وطبائعهم التي لا تتبدل بأن لا يسلموا لخصومهم الفضيلة وهم يجدون سبيلاً لدفعها، ولا ينتحلون العجز وهم يستطيعون قهرهم والظهور عليهم” [9]، فكيف يجوز أن يظهر فيهم من يدعي النبوة ويقول بأن: “حجتي أن الله تعالى قد أنزل علي كتاباً عربياً مبيناً تعرفون ألفاظه وتفهمون معانيه، إلا أنكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور منه، ولا بسورة واحدة، ولو جهدتم جهدكم واجتمع معكم الجن والإنس، ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى أن يعارضوه ويبينوا سرفه في دعواه، مع إمكان ذلك، ومع أنهم لم يسمعوا إلا ما عندهم مثله أو قريب منه؟ هذا وقد بلغ بهم الغيظ من مقالته ومن الذي ادعاه أن تركوا معه أحلامهم الراجحة وخرجوا له عن طاعة عقولهم الفاضلة، حتى واجهوه بكل قبيح ولقوه بكل أذى ومكروه ووقفوا له بكل طريق، وكادوه وكل من تبعه بضروب من المكايدة، وأرادوهم بأنواع الشر، وهل سُمع قط بذي عقل ومسكة استطاع أن يخرس خصماً له قد اشتط في دعواه بكلمة يجيبه بها فترك ذلك إلى أمور يُسفّه فيها ويُنسب معها إلى ضيق الذرع والعجز، وإلى أنه مغلوب قد أعوزته الحيلة وعز عليه المخلص؟” [10]، فهذا هو الطريق الأول الذي يسع كل جاهل بالفن غير عارف به، وهو الذي دل عليه الخبر الصادق والعقل الصريح بعجزهم عن أن يأتوا بمثله فكان معجزاً لهم لا محالة.
فإن زعم زاعم أنه إنما لم ينقل لنا سوى معارضات القرآن الضعيفة، بينما أخفيت عن عمد جميع المعارضات المتينة للقرآن؛ حفاظاً على مكانة القرآن في نفوس المسلمين وتعمية لهم عن ذلك: فإن هذا الزعم لا دليل عليه سوى الرجم بالغيب والعته والظن، وزاعم ذلك متكئ على أريكته يرمي بظنونه ويشرّق بها ويغرّب ظاناً منه أن مجرد الزعم والظن والتشكيك يقوم مقام التدليل والحجاج والنقض والجدل، فلا يقوم زعم بدون دليل يستند إليه، أما الرجم بالغيب فهذا يقوى عليه الطفل والجاهل قبل الرجل العاقل، ثم إن هذا زعم ينقضه العقل ويدحضه النظر، فكيف يمكن أن تخفى معارضة متينة صحيحة للقرآن تتناقلها الألسن وتضج بها الأفواه في وقت كان مجرد المعارضة الصحيحة والإجابة للتحدي الصريح والإتيان بمثل هذا القرآن كاف لإبطاله ودحضه، وعلى أي شيء يفارق المرء أهله وأحبابه ويقاتلهم في وقت كانت وشائج العصبية القبلية أشد ما تكون، ويتجشم الجوع والفراق والهجرة وهو على علم بباطل ما يؤمن به فضلاً عن جدته عليه، وكيف تتمكن عُصبة ضعيفة من كتمان هذه المعارضة ومحاصرتها وهي أقل ما تكون آنذاك وأضعف ما تستطيع من أن تدافع عن نفسها، ثم لا تقوى العصبة القاهرة الغالبة على بيان معارضته الصحيحة وتجبن عن إذاعتها وينأى أجلاؤها إلى قتال الأبناء والأحباب ومفارقة الأهل والإخوان، هذا ما لا يدركه عقل ولا يتأتّاه نظر، ولا ينبغي أن يفوت بصير ذو تأمل أن أدنى معارضة هي أحرى بالذيوع والانتشار في عصر زهوّ الإسلام وضعفه على كلا الحالين، والتكتم عليها ومحاصرتها من الفشو وملاحقة قائلها أو مذيعها متعذر ممتنع في ظل تربص أعداء هذا الدين بكل ما يمكن أن يُنقض به ويحارب فيه، فضلاً عن كونها جملاً معدودة لا تحتاج إلى حرز تحفظ به، أو دابة تنقل عليها، ولا يُعلم بوجودها في صدر ناقلها من عدمها، فأي عاقل يظن هذا الظن، وأي بصير يزعم هذا الزعم.
ولو جاز ذلك الرجم بالغيب لجاز عكسه، فجاز أن يكون قد بُعث من الأنبياء والرسل وأُنزل عدد من الكتب فكتم الخير فيها معارضة لها، ولو استرسلنا لقلنا بأنه جاز ألا يكون وجود للعرب والعربية أصالة وما بين أيدينا إنما هو مخترع حادث لمجرد الزعم والرجم بالغيب بلا برهان ولا دليل، وأنت ترى أن هذه المغالطة تحيل كل ما يجوز عقلاً إلى جوازه واقعاً وهو أمر باطل وساقط. [11]
أما الطريق الثاني: وهو طريق ” أهل الفصاحة والبلاغة والذين يعرفون أوجه الفصاحة والبلاغة في اللغة ويتبينونها، فهؤلاء سيدركون ويقفون على وجه إعجاز القرآن ولا شك بمجرد استماعه” [12]، وقد تتابع فصحاء العرب طبقة عن طبقة مسلمهم وكافرهم بالإقرار بإعجاز فصاحة القرآن لعلمهم بأوجهها ومسالكها، وهذا أمر مبثوث ليس ذا موضع نقله، فمن اطلع على أوجه الفصاحة وتبصر بأساليب العرب وأدرك مضايق تصرف اللغة ووقف على كلام العرب فعبّ منه وانهمك فيه، علم شأو القرآن وفصاحته وتجلّته ورفعته في أسلوبه وبيانه وبلاغته، وأنه “لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد“.
فإذا أدرك المرء فصاحة القرآن بأحد هذين الطريقين، أمكن أن يستفهم عن القدر الكمي والكيفي اللذان يتحقق بهما وصف إعجاز القرآن للبشر، فالقدر –الكمّي– الذي يتحقق به إعجاز القرآن للبشر : هو ما ذكره -جل وعلا- في كتابه بقوله: “فأتوا بسورة مثله“، فـ” كل سورة ثبت عجز العرب عنها فهي معجزة”[13] ، لصريح منطوق كلام الله -عز وجل- في كتابه بأن يأتوا بسورة مثله، فهذا هو القدر الكافي في بيان إعجاز القرآن وثبوته وقصور القوم عنه وتمام التحدي به، فإن سمعت أحدهم يعترض بقوله: إن كان هذا هو القدر المعجز من كلامه فهو قدر يسير هيّن يمكن عقلاً معارضته والإتيان بمثله؟ فاعلم أن هذا توهم سقيم، وظن بليد، فليست البلاغة بقصر أو طول، وإنما هي في الكلام ذاته قصيراً كان أم طويلاً، ومن يزعم هذا الزعم فهو إما جاهل لا علم له بأساليب العرب ووجوه تصرف اللغة ومسالك البلاغة وضروب الفصاحة فسقط في جهله ونُكب باغتراره ففضح نفسه بين قومه وأهل عصره، أو أنه فصيح ذو علم بأوجه البلاغة، حصيف ذو أدب ومعرفة، عالم بوجوه تصرف اللغة ومفرداتها وأحوالها، يدرك من نفسه قدرته على معارضة القرآن والإتيان بمثله، فهذا الأخير ونحوه لا وجود لهم إلا في عقل من يتوهم وجودهم، والتاريخ حاسم في قطع النزاع حول هذه المسألة، فلا وجود لأديب بليغ فصيح توهم قدرته على معارضة القرآن إلا سقط في عين نفسه وأعين غيره -إن وجد-، وكل من ذكرهم أهل التراجم ونقلوا معارضتهم -مذ مسيلمة الكذاب وحتى عصرنا هذا- فإن من له أدنى علم بالبلاغة وأقل معرفة باللغة يدرك فشلهم وخيبتهم، فلا يُظن أن إعجاز القرآن إنما هو بقصر أو بطول، وأن معارضة السور القصار أسهل من معارضة السور الطوال، فهذا وهم وجهل وسقم في فهم من يظن ذلك، فمن يعلم أن وجه إعجاز القرآن في بلاغته يدرك أن طول الكلام البليغ وقصره ليس عين البلاغة والإعجاز.
أما القدر الكيفي المعجز فهو الكلام البليغ بلاغة كبلاغة القرآن وفصاحة كفصاحته، وينبغي أن تتنبه إلى أن بلاغة القرآن ليست محصورة في أوجه التشبيه والكناية والاستعارة وغيرها من فنون علم البيان أو البديع ونحوه، بل بلاغة القرآن مشتملة على ذلك كله حاوية لكل كلام فصيح طابق لفظه معناه بأبلغ صورة وأتمها وأبدعها، إذ فنون علم البيان أو البديع بذاتها ممكنة بالتدرب والتعلم، وللعرب كلام فائق المعنى والبلاغة في بعض الأمثلة والأشعار، لكنه لا يوازي القرآن من حيث القدر المعجز الذي يتم التحدي به، ولا يستقيم معه، وانفراد القرآن بشيء من ضروب التشبيه والكناية ليس هو وجه الإعجاز، لأن من فنون البلاغة ما تتعلم كالجناس والطباق ونحوه، ومنها ما لا ينضبط بضابط كالمبالغة، ولكن باجتماع هذه الضروب والتأليف بينها، ولكون هذه الضروب المؤلفة تعد من الطبقة العالية من البلاغة حصل إعجاز القرآن البلاغي، والشاعر قد يقع له كلام بليغ بلاغة غير عادية ويتفق ذلك للأديب أيضاً، ولكن؛ لأن هذا ليس هو كل كلامه وشعره، ولم ينفرد بقدرته عليه دون غيره، ولو كان ذلك لقلنا أنه معجز، واتفاق ذلك له لا يقع به الإعجاز[14]، فإن قيل بأن أحداً لو تعلم البلاغة بفنونها وضروبها اليوم هل يمكنه أن يأتي بمثل القرآن بلاغة وفصاحة؟ فقد سبق البيان أن بلاغة القرآن ليست في علم البديع وحده أو علم البيان وحده فضلاً عن علم المعاني ونحو ذلك من علوم البلاغة مما قد يقع في الكلمة والكلمتين والجملة ونحوها، وإنما بلاغة القرآن في فصاحته ونظمه كله، وما يقع له من المحسنات البلاغية والبيان الرفيع فهو جزء منه لا ينفرد عنه، وتوهم تعلم ذلك لمجاراة القرآن ومعارضته أمر ممتنع على أهل الفصاحة والبلاغة وأساطين الفن وجهابذته، فليست البلاغة بالعلم الرياضي الذي يتعلم ويبازّ فيه أهله، والقرآن قد تحدى وقرّع أفصح العرب فكلّوا ووهنوا، فلا يظن متأخر استعجمت لغته ويتوهم قدرته على تعلم ذلك ظاناً منه أن الأمر على هذا السبيل، فإن كان أهل الفصاحة والبلاغة في عصر الجاهلية وصدر الإسلام قد جبنوا وقعدوا عن معارضته، فغيرهم من العصور اللاحقة أولى بعد كثرة الفتوحات واختلاط العرب بالعجم وفساد اللغة وتبدلها [15]، وأنت ترى المتنبي الشاعر قد يتفق له في البيت الواحد من التفوق والتميز والبراعة، ولا ترى في بقية قصيدته ما يوازي ذلك أو يقاربه فضلاً عن بقية كلامه، وكذلك ترى الجاحظ الأديب قد تتفق له في نصوصه العبارة الواحدة براعة وفصاحة، ولا تتفق له في بقية كلامه، وهما أهل الصنعة وأربابها، أوليس غيرهم أولى بعجزه عن أن يتعلمها فيتقنها ليستحيل كلامه فصيحاً بليغاً؟ فإن قيل بأن الجاحظ قد فاق أهل عصره في زمانه، والمتنبي فاق شعراء عصره بشعره، فهل يعد هذا معجزاً لهم؟ فإننا نخبر القائل بأن هذا ظن من لم يتبين له حقيقة المراد بالإعجاز البلاغي في القرآن ومعارضته، فليس كل بلاغة محمودة هي بلاغة معجزة، ولا كل معنى يسبق إليه الشاعر أو يفطن إليه هو معنى معجز، ولا كل نظم يبتكره هو نظم يقوم به الإعجاز، فليس الإعجاز في إتيان الشاعر أو الأديب بنظم أو نثر لم يسبق إليه، فالسبق ليس معجزاً بحد ذاته، والقرآن لم يتحد العرب بأن يأتوا بمعنى لم يسبقهم أحد إليه، بل قد تحداهم إلى أن يأتوا بمعنى يوافق القدر المعجز كماً وكيفاً، فليس الإعجاز بالسبق إلى معنى في التشبيه والكناية ونحوه، وإنما الإعجاز أن يبين ويتميز كلامه عن كلام سائر أهل عصره تميزاً لا يشك الواحد منهم في عجزه عن الإتيان بمثله، ويجد فيه من البلاغة ما لا يهتدى لكنهه، وييأس من أن يأت بمثل ما جاء به الناظم أو الكاتب، فإذا فقهت ذلك علمت أن هذا الاعتراض اعتراض ساقط لا يتأتى إلا ممن لم يفقه فحوى التحدي ومراد الإعجاز ومقصوده [16]، ولو اتفقت تلك المعاني لذلك الأديب وهذا الشاعر وعجز أهل عصره أن يساووه أو يأتوا بمثله وبما يعارضه لعلمنا بينونة كلامه عن غيره، وشهدنا له بإعجاز كلامه لغيره وهذا لا يتأتى لمثله، فإن قيل: أليس البشر قادرين على أن يأتوا بحكمة رفيعة أو عبارة بليغة كقولهم: “سبق السيف العذل” وقولهم “القتل أنفى للقتل” ونحوه؟ فلا ننكر مثل ذلك، بل هو واقع مروي ومشاهد، وإنما ينكر أن يبلغ ذلك إلى القدر المعجز الذي تحداهم الله إليه، “ونحن لم ننكر أن يستدرك البشر كلمة شريفة، ولفظة بديعة؛ وإنما أنكرنا أن يقدروا على مثل نظم سورة أو نحوها، وأحلنا أن يتمكنوا من حد في البلاغة” [17]، والشاعر قد يتفق له شطر فيذهب مثلاً في البلاغة والبراعة، وكذا البليغ قد تقع في نثره القطعة الشريفة في سبكها وصياغتها، إلا أن هذا لا يتفق له دائماً، ولا يبلغ به القدر المعجز الذي هو فحوى التحدي وضابطه كما سيأتي بيانه، وليس كل كلام سالم من العيوب فإنه يبلغ حد الإعجاز في الفصاحة والبلاغة، وإنما يبلغ ذلك إذا عُلم العجز عن مثله كما سبق تحقيقه، فإن قيل: أن من الآيات مالا يوجد فيها من البلاغة ما يوجد في غيرها من آيات القرآن فكيف تكون معارضتها؟ فإننا نقول بأن هذا واقع بين، والقدر المعجز لم يكن في آية بعينها، وإنما هو في سورة من سوره كما بينا ذلك، “فمن الآيات ما لا يوجد فيها من البلاغة والبراعة كقوله “حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم …” وهذه الآيات ليست من قبيل ما يمكن إظهار البراعة فيه، وإنما تجري مجرى ذكر الأسماء والألقاب، ومن الجهل طلب البراعة فيها، وإنما المعتبر فيها هو: تنزيل الخطاب وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى” [18].
والقرآن بذاته معجز وإن لم يتحدّ الله به العرب، فهو “الكتاب لا ريب فيه“ معجز بذاته لما احتوى عليه من الكلام البليغ الفصيح الذي بلغ درجة وشأواً رفيعاً، والتحدي إليه إنما هو إمعان في إظهار العجز عنه بعدما اتهموه بالفرية والسحر ونسبوه لأساطير الأولين، وتقرير لهم بذلك، وتحقيق لظهور الإعجاز لغير عالم به، وليس كل معارضة للقرآن وإجابة للتحدي تبلغ مبلغ القرآن أو تقاربه، فتحقيق التحدي في الإتيان بسورة من مثله، لا مجرد المعارضة السمجة له، فقد ثبت ونقل إلينا معارضة عدد من الأراذل لكلام الله -جل وعلا-، فباتت معارضتهم سذاجة يتندر بها، وأضحوكة يتلاعب بها، ولم يُنقل عن فصحاء العرب وبلغائهم يومئذ من همّ بمعارضة القرآن لعلمهم بعجزهم عن ذلك، ولو كان العرب قد أجابوا إلى هذا التحدي لنقل ذلك واستفاض ذكره وتواتر العرب على روايته والإشارة إليه، ولعجزت ثلة المسلمين آنذاك عن طمسه وكتمه وإنكاره -كما سبق بيانه-، فالقرآن معجز بذاته وإن لم يتحد الله به، والتحدي كاشف لإعجازه لمن لا يدركه، وتقرير على من استخف به بعجزه عنه، وهذا هو وجه العلاقة بين التحدي والإعجاز، فمن الناس من ظهر له إعجاز القرآن وعلمه ساعة سماعه له، ومنهم من لا يدرك إعجاز القرآن لجهله، ولا يقدر أن يستدل له إلا بعجز غيره عنه بعد التحدي إليه والتمكين من معارضته والتقريع به، فيصبح من رأى عجز غيره عن معارضته بمنزلة من رأى اليد البيضاء لموسى والأفعى التي تسعى وغيرها من المعجزات، وهذا أثر التحدي وعلاقته بالإعجاز والفرق بينهما [19]، أما مفهوم التحدي فهو الإتيان بمثل هذا القرآن ولو بسورة واحدة، ومنطوق التحدي شامل لأي سورة من سور القرآن قصيرة كانت أم طويلة، على أن في القرآن سور قصار لا تزيد عن آيات ثلاث، إلا أن القوم جبنوا وكاعوا ما استطاعوا لذلك سبيلاً، وضابط التحدي في ذلك هو: أن يأتوا بحروف منظومة كنظم القرآن متتابعة كتتابعه مطردة كاطراده فصيحة كفصاحته حاوية من المعاني البليغة المتناسبة المتناسقة المطابقة للحال مطابقة تامة غير زائدة ولا ناقصة [20] بقدر سورة من سور القرآن، ويقع التحدي بالمعارضة، والعرب كانوا على علم بالمعارضة بين الخطب والقصائد وأهل معرفة بها، فليست المعارضة أن يأتي المعارض بكلام مماثل لكلام صاحبه، وإنما “سبيل من عارض صاحبه في خطبة أو شعر: أن ينشئ له كلاماً جديداً يحدث له معنى بديعاً فيجاريه في لفظه ويباريه في معناه ليوازن بين الكلامين فيحكم بالفلج لمن أبرّ منهما على صاحبه، وليس بأن يتحيّف من أطراف كلام خصمه فينسف منه ثم يبدل كلمة مكان كلمة فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق، ثم يزعم أنه وافقه موقف المعارضين” [21]كما فعل مسيلمة في أكاذيبه وتلفيقاته، وهذا هو مفهوم المعارضة وضابط الإتيان بالمثل، “فإن التحدي كان إلى أن يجيئوا في أي معنى شاءوا من المعاني بنظم يبلغ نظم القرآن في الشرف أو يقرب منه، يدل على ذلك قوله تعالى: “قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات” أي مثله في النظم، وليكن المعنى مفترى لما قلتم، فلا إلى المعنى دعيتم ولكن إلى النظم”. [22]
ولا يفوت في هذا السياق ذكر بعض ما ذكره أهل العلم من معالم بلاغية كثيرة لإعجاز القرآن يعز حصرها ويطول ذكرها، فمن جملة ما ذكروا من معالم إعجاز القرآن في بلاغته: أن بلاغته تتجلى رغم اختلاف موضوعاته وتفرقها وتبيانها في تصاريفها، فلم يتفاوت فصله ووصله وخروجه من معنى لآخر، وتجد السورة الواحدة تحوي آيات متنوعة المعاني بين إنشاء وإخبار وإظهار وإضمار وجملة اسمية وفعلية ومضيّ وحضور واستقبال وغيبة وخطاب، وخروج وخلوص من موضوع لآخر، وفي المعنى الواحد تجد فيه قصداً ووفاء وإجمالاً وبياناً ومنطقاً وعاطفة ووجداناً، مع وحدة موضوعية جامعة للسورة رغم نزولها منجمة وفي أزمنة مختلفة وأحداث متغيرة من قصار السور وطوالها، حتى لكأنها نزلت جملة واحدة، وإنك لتجد فيها فضلاً في الموضوع يستوي فيه الخاصة والعامة والكبير والصغير في الخطاب، كما تجد فيه بلاغة في المعنى ولو كان غير محمود كوصف حال المنافقين وحكاية أقوال الكافرين، وهو أسلوب مستقل فريد بذاته، وله إيقاع صوتي فذ، ونغم وحيد، وتنسيق لحروفه بين الرخاوة والسهولة وتقارب المخارج ونحوه، وتنوع جرسي، وهو بذلك كله بليغ بلاغة معجزة لسامعه، وجامع لهذه المعاني والأساليب والألفاظ ومؤلف بينها تأليفاً لا تباين فيه ولا اختلاف رغم طوله، فهو سهل في الفهم ممتنع الوضع وللناس كافة [23] ، أفلا يدرك المتأمل بذلك قدر دهشة العرب ورهبتهم؟ وسبب تولي الجنّ إلى قومهم وإنذارهم لهم بقولهم: “يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به!”.
خاتمة:
“إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً“، لقد نزل القرآن على جبريل في السماء، فنزل به جبريل من السماء إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- في الأرض، فكان خير ملك نزل به لخير بشر من خير شهر في خير ليلة لخير أمة! إن كل ما يحفّ به هذا الكتاب الذي لا ريب فيه هو بركة ورحمة لمن احتفّ به فـ “بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون“، إن قوماً تنزل عليهم كلام ربهم فكأنما نشطوا من عقال، وبرئوا من أسقام، فنشطت قلوبهم وطربت نفوسهم وعاشوا مع كلام ربهم فكادت قلوبهم أن تطير حباً، ونفوسهم أن تسير شوقاً، ففي الليل يترنمونه ويتلونه ويسبلون الأدمع تجلة له وتلذذاً به، وفي النهار يتدبرونه ويتدارسونه ويعملون به ويبذلون الأنفس والمهج له، فكانوا خير جيل لخير أمة، إذ فيه” أحسن القصص” وخير الهدي، وأعذب الكلام، وهو “شفاء ورحمة للمؤمنين“، وهو “كتاب عزيز“، “،ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله“، و”لئن اجتمعت الإنس والجن ْعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً“، فما من قول “أصدق من الله قيلاً” ولا من حديث “أصدق من الله حديثاً” إذ هو “من لدن حكيم عليم” لو أنزل على جبل “لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله“، “أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟“، “أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً“.
1 بيان إعجاز القرآن للخطابي ص٤٧، البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢/٤٦.
2 مستل من وصف عتبة بن ربيعة.
3 الخطابي ص٢٧، وهذا الاصطلاح منثور في كتب البلاغة.
4 الخطابي المرجع السابق.
5 الخطابي ص٣٥.
6 انظر: الباقلاني في إعجاز القرآن ص١١٣.
7 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الخطابي ص٢٢.
8 المرجع السابق.
9 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الجرجاني ص119،
10 المرجع السابق.
11 للاستزادة انظر: الخطابي ص55.
12 المرجع السابق.
13 إعجاز القرآن للباقلاني ص٢٤٥، ويرى الباقلاني أن الإعجاز يثبت في أقصر سورة وأطول آية.
14 انظر: الباقلاني مرجع سابق ص٢٥٢.
15 للاستزادة: الباقلاني ص250.
16 انظر: الجرجاني ص133 للاستزادة.
17 انظر: الباقلاني ص 286 للاستزادة.
18 الباقلاني ص٢٠٨.
19 للاستزادة انظر: النبوات لابن تيمية ص٦٤٣، الباقلاني مرجع سابق ص٢٥١.
20 الباقلاني ص260.
21 الخطابي مرجع سابق ص٥٨.
22 الجرجاني ص١٤١.
23 فصل دراز في كتابه النبأ العظيم تفصيلاً ماتعاً في كثير من هذه الأوجه البلاغية وضرب لها أمثلة من القرآن الكريم يحسن الرجوع إليها للاستزادة.