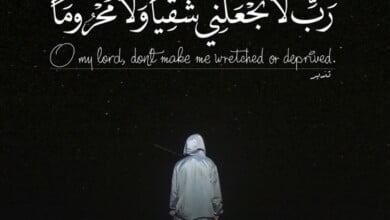- آن ماري سلوتر (*)
- ترجمة: زينب عبد المطلب
- مراجعة: مصطفى هندي
- تحرير: عبير الشهري
لقد آن الأوان لنَكُفَّ عن خداع أنفسنا؛ تقول امرأة قد تنحّت عن منصبٍ ذي نفوذ: إن النساء اللّاتي تمكنّ مِن أن يكُنّ أمّهات ومِهنيّات متفوقات في نفس الوقت، خارقات وثريّات ولديـهن أعمالٌ حرة. إذا كُنّا نؤمن حقاً بتكافؤ الفُرَص لكل النساء، فإليكم ما ينبغي أن يتغيَّـر.
بعد ثمانية عشر شهراً من عملي كأول امرأة تُدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية -وظيفة الأحلام في السياسة الخارجية التي ترجع أصولها إلى جورج كينان- وجدتُ نفسي في نيويورك، في التجمُّع السنوي للأمم المتحدة لكل وزير خارجية ورئيس دولة في العالم.
في مساء يوم أربعاء، استضاف الرئيس أوباما وزوجته حفل استقبال مبهر في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي. ارتشفت الشمبانيا، ورحّبت بكبار الشخصيات الأجنبية، واختلطت مع الموجودين، إلا أنني لم أتمكن من التوقف عن التفكير في ابني الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، والذي كان قد بدأ الصف الثامن قبل ثلاثة أسابيع وكان قد استأنف عادته في إهمال الواجبات المنزلية، وتضييع الحصص الدراسية، والرسوب في الرياضيات، وتجاهل أي شخص بالغ يحاول التقرب منه. على مدار الصيف، بالكاد تكلمنا مع بعضنا البعض، أو بشكل أكثر دقة، بالكاد تكلم هو معي.
كما كنت قد تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية العاجلة في الربيع الماضي -التي تأتي دائماً في يوم اجتماع مهم- تطلب مني أن أستقل أول قطار عائد من واشنطن العاصمة، حيث كنت أعمل، إلى برينستون، نيوجيرسي، حيث كان هو يعيش. كان زوجي، الذي بذل كل ما في وسعه لدعم مهنتي، يتولى رعايته هو وشقيقه البالغ من العمر 12 عاماً خلال الأسبوع؛ وما خلا حالات الطوارئ هذه في منتصف الأسبوع، كنت أعود إلى منزلي في عطل نهاية الأسبوع فقط.
عندما حلّ المساء، هرعت إلى زميلة لي كانت قد شغلت منصبًا رفيعًا في البيت الأبيض، ولديها ولدان من أعمار أبنائي بالضبط، ولكنها اختارت أن تنقلهما من كاليفورنيا إلى واشنطن عندما حصلت على وظيفتها، وهو ما يعني أن زوجها يذهب إلى كاليفورنيا ويعود دوريًا. أخبرتها عن مدى صعوبة بقائي بعيدة عن ابني وهو بحاجةٍ ملحّةٍ إلي، ثم أردفت القول: “عندما ينتهي الأمر، سوف أكتب مقالة بعنوان “لا تستطيع النساء أن تجمع بين الأشياء كلها”.
أصابها الهلع. قالت لي: “لا يمكنك كتابة ذلك، لاسيما أنتِ، من بين كل الناس”؛ ما كانت تعنيه هو أن تصريحًا كهذا، صادر عن امرأة في مهنة رفيعة المستوى -قدوة-سيكون بمثابة رسالة مريعة إلى الأجيال الشابة من النساء. مع حلول المساء، كانت قد صرفتني عن التفكير بالأمر، ولكن في بقية مدة إقامتي في واشنطن، كنت أدرك على نحو متزايد أن المعتقدات النسوية التي بنيتُ عليها حياتي المهنية بالكامل كانت تتغير بشكل جذري. كنت أفترض دومًا أنني لو تمكنت من الحصول على وظيفة في السياسة الخارجية في وزارة الخارجية أو البيت الأبيض أثناء تولي حزبي للسلطة، لكنت سأواصل مسيرتي ما دامت الفرصة متاحة لي لأداء العمل الذي أحببته. ولكن في يناير/كانون الثاني 2011، عندما أنهيت إجازة الخدمة العامة من جامعة برينستون الممتدة لعامين، سارعت بالعودة إلى المنزل بأسرع ما يمكن.
صُدمت باكتشاف صادم بعد وصولي إلى هناك. عندما سألني الناس عن سبب تركي العمل في الحكومة، وضحت لهم أنني لم أعد إلى المنزل بسبب قوانين برينستون فقط (بعد عامين من الإجازة، ستفقد مدة خدمتك)، ولكن أيضًا بسبب رغبتي في أن أكون مع عائلتي، والنتيجة التي توصلت إليها هي أن الجمع بين العمل الحكومي رفيع المستوى واحتياجات صبيين مراهقين لم يكن ممكنًا. لم أترك صفوف النساء العاملات بدوام كامل تماماً: فأنا أقوم بتدريس فصل كامل؛ وأكتب مقالات مطبوعة وإلكترونية حول السياسة الخارجية بانتظام؛ وألقي من 40 إلى 50 خطابًا في السنة؛ وأظهر بانتظام على شاشة التلفزيون والراديو؛ وأعمل على كتاب أكاديمي جديد. إلا أنني تلقيت بشكل دائم ردود فعل من نساء أخريات في عمري أوأكبر تراوحت بين خيبة الأمل “إنه لأمر مؤسف أنكِ اضطررتِ إلى مغادرة واشنطن” والتعالي “لن أعمم تجربتك، لم يكن عليّ أبدًا المساومة، وأطفالي أصبحوا رائعين”.
كانت أول مجموعة من ردود الفعل، التي تفترض ضمنيًا أن اختياري كان حزينًا أو مُؤسفًا نوعاً ما، مزعجة بما فيه الكفاية. لكنها كانت ثاني مجموعة من ردود الفعل -تلك التي تدل على أن رعايتي لأولادي أو التزامي بمهنتي كان دون المستوى إلى حد ما- هي التي أثارت غضبًا أعمى. وأخيراً توصّلتُ إلى يقين تام بشكل مفاجئ: طوال حياتي كنت على الجانب الآخر من هذا السِّجال، لطالما كنت المرأةَ التي تبتسم ابتسامةً باردة ومتعالية، بينما تُخبرني امرأة أخرى أنها قررت أن ترتاح لبعض الوقت، أو أن تسعى إلى مسار وظيفيٍّ أقلَّ تنافسية، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع عائلتها. كنت المرأة التي تهنِّـئ نفسها على التزامها الذي لا يتزعزع من أجل القضية النسوية، والتي تدردش بشكل متعجرف مع عدد متضائل من أصدقاء الجامعة أو كلية القانون الذين وصلوا وحافظوا على مكانهم في أعلى درجات مهنتهم، كنت أنا من يخبر النساء الشابات في محاضراتي بأنه يمكنهم الجمع بين الأشياء كلها والقيام بكل شيء، بغضّ النظر عن المجال الذي يعملن به، مما يعني أنني كنت جزءًا مساهماً -وإن كان عن غير قصد- في جعل ملايين النساء يشعُرن بأنه يجب عليهن أن يُلقين اللّوم على أنفسهن إذا لم يتمكنَّ من صعود السُّلَّم بنفس سرعة الرجال، ومن تكوين عائلة أيضًا وحياةٍ منزلية طبيعية (وأن يكنّ بالتأكيد نحيلات وجميلات بكل معاني الكلمة).
في الربيع الماضي، سافرت إلى أكسفورد لإلقاء محاضرة عامة، بناءً على طلب أحد الباحثين من منحة رودس([1]) الذين أعرفهم، وافقت على التحدث في مؤتمر منحة رودس حول “التوازن بين العمل والأسرة”، انتهى بي الأمر بالتحدث إلى مجموعة من حوالي 40 رجلًا وامرأةً في منتصف العشرينات من العمر. ما أخبرتهم به كان عبارة عن مجموعة من التأملات الصادقة للغاية عن مدى الصعوبة غير المتوقعة وراء الجمع بين قيامي بنوع العمل الذي أردت القيام به كمسؤول حكومي رفيع، وكوني الوالدة التي أردت أن أكونها في وقت حاسمٍ وحسّاسٍ بالنسبة إلى أولادي (على الرغم من أن زوجي، وهو أكاديمي، كان على استعدادٍ لتحمل نصيب الأسد من رعاية الأولاد لمدة عامين أمضيتهم في واشنطن). وختمت بالقول؛ إن وقت عملي في المنصب جعلني أقتنع بأنه من غير المحتمل أبدًا أن أؤدي خدمة حكومية أخرى في حين أن أبنائي لا يزالون في المنزل. كان الجمهور يترقب باهتمام، وطرحَ العديد من الأسئلة العميقة.
طرحتْ إحدى أوائل هذه الأسئلة، امرأة شابة بدأت بشكري على “عدم إلقائي خطاب آخر سخيف من نوع يمكنك الجمع بين كل شيء” خططت كل النساء في تلك الغرفة تقريبًا للجمع بين الوظائف والعائلة بطريقة ما، لكن جميعهن تقريباً افترضن ووافقن على أنه سيتعين عليهن تقديم تنازلاتٍ من الصعب جدا أن يوافق على تقديمها أوتحمّلها الرجال الذين يعيشون معهم.
دفعتني الفجوة المذهلة بين الردود التي سمعتها من هؤلاء الشابات (وغيرهن من أمثالهن) وبين الردود التي سمعتها من أقراني وزملائي إلى كتابة هذا المقال. لقد تشبثت نساء جيلي بالعقيدة النسوية التي نشأنا عليها، مع أن مناصبنا تقلصت بشكل مطّرد، بسبب التوترات غير القابلة للحل بين الأسرة والعمل، لأننا مصمّمون على عدم إسقاط الراية من أجل الجيل القادم. ولكن عندما توقف العديد من أفراد الجيل الأصغر عن الاستماع، على أساس أن تكرار “يمكنك الجمع بين الأشياء كلها” ببلاهة هو مجرد تزييف للحقيقة، فقد حان الوقت للتحدث.
ما زلت أعتقد اعتقادًا راسخًا بأنّ النساء يمكنهن “الجمع بين كل شيء” (وأنّ الرجال أيضاً يمكنهم ذلك). أؤمن بأننا قادرات على “الجمع بين كل شيء في نفس الوقت”، ولكن ليس اليوم، ليس بالطريقة التي يعمل بها الاقتصاد الأمريكي، والمجتمع الأمريكي حالياً. لقد أجبرتني تجربتي على مدى السنوات الثلاث الماضية، على مواجهة عدة حقائق غير مريحة يجب الاعتراف بها على نطاق واسع، وتغييرها بسرعة.
قبل خدمتي في الحكومة، كنت قد أمضيت حياتي المهنية في الأوساط الأكاديمية: كأستاذ للقانون ثم بصفتي عميد كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون. كلتاهما وظيفتان مضنيتان، إلا أنني تمكنت من وضع جدولي الخاص في أغلب الأحيان. كان بإمكاني أن أكون مع أطفالي عندما احتجت إلى ذلك، وأنجز العمل في نفس الوقت، وكان يتوجب عليّ السفر بشكل متكرر، لكنني وجدت أنني أستطيع تعويض ذلك من خلال البقاء فترة مطوّلة في المنزل أوقضاء عطلة عائلية.
أدركت أنني كنت محظوظة في اختياري الوظيفي، ولكنني لم يكن لدي أدنى فكرة كم كنت موفقة إلى أن أمضيت عامين في واشنطن في إطار بيروقراطية جامدة، حتى مع رؤساء متفهمين مثل هيلاري كلينتون ورئيس أركانها، شيريل ميلز. كان أسبوع العمل يبدأ الساعة 4:20 صباح الإثنين، عندما استيقظت لأتمكن من اللحاق بقطار الـ 5:30 من ترينستون إلى واشنطن، وانتهى في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث أعود إلى منزلي عبر القطار. بين الفترتين، كانت الأيام تغص بالاجتماعات، وعندما تنتهي الاجتماعات، يبدأ العمل الكتابي، وهو سلسلة لا تنتهي من المذكرات والتقارير والتعليقات على مسوّدات أشخاص آخرين. على مدار عامين، لم أغادر مكتبي قط في وقت مبكر بالقدر الكافي للذهاب إلى أي متجر غير المتاجر المفتوحة على مدار 24 ساعة، وهو ما يعني أن كل شيء من الذهاب إلى محل التنظيف، إلى مواعيد تصفيف الشعر، إلى التسوق في أعياد الميلاد، لابد وأن يتم في عطلات نهاية الأسبوع، في أوقات فعاليات الأطفال الرياضية، والدروس الموسيقية، والوجبات العائلية، والمؤتمرات عبر الهاتف. كان يحق لي -أربع ساعات-عطلة لكل فترة أتلقى فيها أجرًا، مما يمنحني يومًا واحدًا من العطلة في الشهر. وكان حالي أفضل بكثير من العديد من أقراني في واشنطن العاصمة؛ فقد تعمدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن تأتي في حوالي الساعة الثامنة صباحًا وأن تغادر حوالي الساعة السابعة مساءً، للسماح لموظفيها المقربين بالحصول على وقت مع أسرهم في الصباح والمساء (رغم أنها كانت تعمل بطبيعة الحال في وقت مبكر من المنزل).
باختصار، اللحظة التي وجدت فيها نفسي في وظيفة نموذجية بالنسبة للغالبية العظمى من النساء العاملات (والرجال)، حيث أعمل لساعات طويلة وفقاً لجدول أعمال شخص آخر، لم يعد بإمكاني أن أكون الأم والموظفة اللتان أردت أن أكونهما، على الأقل ليس مع طفل يمر بمراهقة صعبة. لقد أدركت ما كان يجب أن يكون واضحًا منذ البداية: أن الجمع بين الأشياء كلها، على الأقل بالنسبة لي، كان يعتمد بالكامل تقريبًا على نوع الوظيفة التي أشغلها. أما الجانب الآخر فهو الحقيقة الأصعب: أن الجمع بين كل شيء لم يكن ممكناً في العديد من أنواع الوظائف، بما في ذلك المناصب الحكومية العليا، على الأقل ليس لمدة طويلة للغاية.
لست وحدي من أدرك ذلك. تنحّت ميشيل فلورنوي عن منصبها بعد ثلاث سنوات كوكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، ثالث أعلى وظيفة في الوزارة، من أجل قضاء المزيد من الوقت في المنزل مع أطفالها الثلاثة، اثنان منهم في مرحلة المراهقة. وتخلت كارين هيوز عن منصبها كمستشار للرئيس جورج دبليو بوش بعد عام ونصف في واشنطن لتعود إلى تكساس من أجل عائلتها. وكتبت ماري ماتالين التي قضت عامين كمساعد لبوش ومستشار نائب الرئيس ديك تشيني قبل أن تتنحى، لكي تقضي المزيد من الوقت مع ابنتيها: “إن قدرتهن على التحكم بجدولهن هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها النساء اللاتي يرغبن في الحصول على وظيفة وأسرة أن ينجحن”.
غير أن قرار التنحي عن مركز سلطة -أي تقديم العائلة على التقدم المهني، حتى ولو لفترة من الوقت-يتعارض بشكلٍ مباشرٍ مع الضغوط الاجتماعية السائدة على المهنيين المختصّين في الولايات المتحدة. يوجد عبارة واحدة تختصر كل الاتجاهات الحاليّة في التعامل مع العمل والأسرة، وخاصة بين النخب.
في واشنطن، تُعد “الاستقالة من أجل قضاء وقت مع العائلة” غطاءً للطرد من العمل. هذا الفهم متأصل إلى حدٍّ أنه عندما أعلنت فلورنوي استقالتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قامت صحيفة نيويورك تايمز بتغطية قرارها على النحو التالي:
فاجأ إعلان السيدة فلورونوي الأصدقاء وعددًا من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، ولكن جميعهم قالوا: أنهم أخذوا سبب استقالتها على ظاهره، وليس كعذر نموذجي لمسؤولي واشنطن الذين يُطردون من العمل في واقع الأمر. “أستطيع أن أصرّح على نحوٍ قاطعٍ لا لبسَ فيه بأن قرارها بالتنحي لا علاقة له بأي شيء غير التزامها بعائلتها” حسب دوج ويلسون، كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية. “لقد أحبت هذه الوظيفة، والناس هنا يحبونها”.
تأمل ما يعنيه “عذر نموذجي لمسؤولي واشنطن”: فمن غير المتصوّر أن يتنحّى أحد المسؤولين لكي يقضي بعض الوقت مع أسرته/ها فعلياً، فلا بد أن يكون ذلك غطاءً لشيءٍ آخر. كيف يمكن لأي شخص أن يترك دوائر السلطة طواعية من أجل مسؤوليات الأبوة؟! حسب كل شخص، فإنه إما أن يكون مثيرًا للسخرية أو للجنون أن يسود هذا التصور في عاصمة الولايات، على الرغم من التعهدات التي تبلغ حد الطقوس الدينية بالالتزام بـ “القيم الأسرية” التي تشكل جزءاً من كل حملة سياسية. على أية حال، إن هذا الفهم يجعل التوازن الحقيقي بين العمل والحياة أمرًا بالغ الصعوبة، ولكن لا يمكن أن يتغير هذا الأمر ما لم تتحدث النساء البارزات بصراحة.
لم أفهم إلا مؤخراً مدى شعور نساء عاملات صغيرات، بأنهن يتعرضن للإهانة من قبل نساء من عمري أو أكبر. بعد أن ألقيتُ كلمة في نيويورك مؤخراً، أتتني عدة نساء في أواخر الستينات أوأوائل السبعينات ليخبرنني عن مدى سعادتهن وفخرهن لرؤيتي أتكلم كخبيرة في السياسة الخارجية. ومضت اثنتان منهن إلى المقارنة بين حياتي المهنية والمسار الذي تسلكه “النساء اليافعات اليوم”، أعربت إحداهن عن انزعاجها إزاء “عدم رغبة العديد من النساء اليافعات في أن ينطلقن ويقمن بالأمر”، وقالت أخرى وهي لا تعرف ملابسات تغيير عملي الأخيرة: “فهن يعتقدن أنه لابد وأن يخترن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية”.
يوجد افتراض مماثل، يشكّل أساس خطاب كبيرة مسؤولي التشغيل في فيسبوك شيرل ساندبيرج عام 2011 الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق في بارنارد، وحديثها السابق عبر منصة TED، والذي أعربت فيه عن أسفها إزاء العدد الضئيل والمخيب للآمال من النساء في المناصب العليا، ونصحت الشابات بعدم “الاستقالة من العمل قبل الاستقالة من الحياة”. حين تبدأ المرأة في التفكير في الإنجاب، قالت ساندبيرج: “تتوقف عن المشاركة، وتبدأ في التراجع إلى الوراء”، رغم أن نصيحة ساندبيرج قد صيغت بهدف التشجيع، فإنها تحتوي على أكثر من مجرد نبرة توبيخ. نحن الذين وصلنا إلى القمة، أو نسعى جاهدين إلى الوصول، نقول بكل صراحةٍ لنساء الجيل الذي سبقنا: “ما خطبكن؟”
لديهن إجابة، لكن لا نريد سماعها. بعد الخطاب الذي ألقيته في نيويورك، ذهبت إلى العشاء مع مجموعة مما يقارب 30 شخصاً جلست في مواجهة امرأتين نابضتين بالحياة، إحداهما عملت في الأمم المتحدة، والأخرى في شركة كبيرة للقانون في نيويورك. وكما يحدث دائماً تقريباً في مثل هذه المواقف، فإنهن سرعان ما بدأن يسألنني عن التوازن بين العمل والحياة. عندما أخبرتهن بأنني أكتب هذا المقال، قالت المحامية: “إنني أبحث عن قدوات ولا أستطيع أن أجد أيا منهن”، وقالت إن النساء في شركتها، اللاتي أصبحن شريكات وتولّين مناصب إدارية، قدّمن تضحيات هائلة: “ويبدو أن العديدات منهن لا يدركن حتى الآن، فهنّ يأخذن عامين إجازة، عندما يكون أطفالهن صغارا، ولكنهن يعملن كالمجانين من أجل اللحاق بالمسار المهني، وهذا يعني أنهن يرين أطفالهنّ صغاراً، ولكن لا يرينهم وهم مراهقون، أوبالكاد يرينهم على الإطلاق”. أومأت صديقتها برأسها مشيرة إلى أفضل النساء المهنيات اللاتي عرفتهن، وكل واحدة منهن كانت تعتمد بشكل أساسي على مربيات على مدار الساعة. كانتا كلتاهما واضحتان جداً بأنهما لا تريدان تلك الحياة، ولكنهما لا تستطيعان أن يعرفن كيفية الجمع بين النجاح المهني والرضا والالتزام الحقيقي بالأسرة.
أدرك أنني محظوظة، لأنني ولدت في أواخر الخمسينات بدلاً من أوائل الثلاثينات، مثل أمي، أو بداية القرن العشرين، مثل جداتي. أسست أمي مهنة ناجحة، ومجزية، كفنانة محترفة إلى حد كبير في السنوات التي تلت مغادرتنا أنا وإخوتي المنزل ــ وبعد أن قيل لها عندما كانت في العشرينات من العمر أنها لا تستطيع ارتياد المدرسة الطبية، كما فعل والدها، وكما سيفعل شقيقها، لأنها ستتزوج بطبيعة الحال. أنا مدينة بحريتي وفرصي إلى جيل النساء الرائد الذي سبقني، النساء اللواتي هنّ الآن في عمر الستين والسبعين والثمانين واللواتي واجهن تحيزًا جنسيًا علنيًا لا أراه إلا عندما أشاهد مسلسل Mad Men، واللواتي أدركن أن الطريقة الوحيدة للنجاح كامرأة هي التصرف كرجل. ومجرد اعترافهن -ناهيك عن أن اتخاذ إجراءات بشأن-واجبات الأمومة؛ كان كفيلا بقتل مهنهن.
لكن بفضل تقدمهن على وجه التحديد، بات من الممكن الآن، إجراء نوع مختلف من النقاشات. لقد حان الوقت لكي تدرك النساء في المناصب القيادية أننا على الرغم من أننا ما زلنا نشق الطريق ونتخطى الأسقف، إلا أن العديد منا يعمل أيضاً على تعزيز زيفٍ زائل: ألا وهو أن “الجمع بين الأشياء كلها” هو عزيمة شخصية أكثر من أي شيء. كما قالت كيري روبين وليا ماكو، مؤلفة كتاب Midlife Crisis at 30، ومناشداتهم الشغوفة من أجل الجيل إكس (من ولد في الستينات والسبعينات) والجيل واي (من ولد في الثمانينات والتسعينات):
ما اكتشفناه في بحثنا هو أنه على الرغم من الاحتفاء بـ “تمكين المرأة” في معادلة الحقوق، لم يكن هناك إلا نقاشات صادقة قليلة جداً بين النساء من عمرنا بشأن الحواجز والعيوب الحقيقية التي لا تزال قائمة في النظام على الرغم من أن الفرص التي ورثناها قليلة جداً.
أنا على وعي كامل بأن أغلب النساء الأمريكيات يواجهن مشاكل أعظم بكثير من أي مشكلة نوقشت في هذه المقالة. أنا أكتب للمحيطات بي من النساء ذوات التعليم العالي وميسورات الحال واللاتي يتمتعن بالامتيازات الكافية ليتمكنّ من الاختيار في المقام الأول. قد لا يكون لدينا خيار فيما إذا كنا بحاجة إلى عمل مدفوع الأجر، حيث أصبح الدخل المزدوج أمراً لا غنى عنه. لكننا نملك خيار نوع ومدة العمل الذي نقوم به. نحن النساء اللاتي يمكنهن أن يقدن، وينبغي أن يتم تمثيلهن في المناصب القيادية على قدم المساواة.
تواجه ملايين النساء العاملات الأخريات ظروف حياة أكثر صعوبة. فالبعض منهن ترعى أطفالها بمفردها؛ وتكافح الكثيرات من أجل العثور على أي وظيفة؛ وأخريات يدعمن أزواجهن الذين لا يستطيعون العثور على وظائف. فالعديد منهن يتأقلمن مع حياة مهنية، حيث الرعاية النهارية الجيدة إما غير متاحة أو باهظة التكاليف؛ وحيث أن الجداول المدرسية لا تطابق جداول العمل؛ والمدارس نفسها تفشل في تعليم أطفالهن. الواقع أن العديد من هؤلاء النساء لا يبالين كثيراً بامتلاك كل شيء، بل بالتمسك بما يملكنه بالفعل. ورغم أن مجموع النساء كن قد حصلن على مكاسب كبيرة في الأجور والتحصيل التعليمي والمكانة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فقد أظهر الخبيران الاقتصاديان جوستين ولفرز، وبيتسي ستيفنسون، أن النساء أقل سعادة اليوم مقارنة بأسلافهن في عام 1972، سواء بالأرقام المطلقة أو بالنسبة إلى الرجال.
إن أفضل أمل في تحسين وضع كل النساء، وردم ما يسميه ولفرز وستيفنسون “فجوة جديدة بين الجنسين” ــ قياساً على الرفاهية وليس الأجورــ يتلخص في سد فجوة القيادة: انتخاب امرأة رئيس و50 امرأة في مجلس الشيوخ؛ ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في صفوف المسؤولين التنفيذيين في الشركات والقادة القضائيين. لن يتسنى لنا أن ننشئ مجتمعاً يعمل بصدق لصالح كل النساء إلا عندما تمارس النساء السلطة بأعداد كافية. سوف يكون هذا مجتمعاً صالحاً بالنسبة إلى الجميع. [2]
أنصاف الحقائق التي نملكها عزيزتي
دعونا نستعرض بإيجاز القصص التي نخبر بها أنفسنا، والعبارات المبتذلة التي كثيراً ما نستند إليها أنا والعديد من النساء الأخريات، حين تسألنا النساء اليافعات كيف تمكنّا من “الجمع بين الأشياء كلها”، فهذه العبارات ليست أكاذيب بالضرورة، بل هي حقائق جزئية في أحسن الأحوال. يجب أن ننحّيها جانباً لكي نوجد مجالاً لمناقشات أكثر صدقاً وإنتاجية بشأن الحلول الحقيقية للمشاكل التي تواجهها النساء المهنيات.
“إنه ممكن، فقط إن التزمتِ بما فيه الكفاية”
نقطة البداية المعتادة، سواء قلناها صراحة أولم نقلها، هي أن كل شيء يعتمد في الأساس على عمق وشدة التزام المرأة بحياتها المهنية. هذا هو على وجه التحديد، الشعور خلف استياء العديد من النساء المهنيات المسنات إزاء الجيل الأصغر سناً. فنحن نقول إنهن لسن ملتزمات بالقدر الكافي لإجراء المفاضلات والتضحيات التي قدمتها النساء اللاتي سبقنهن.
لكن بدلاً من التوبيخ، فربما كان من الواجب علينا أن نواجه بعض الحقائق الأساسية. يصل عدد قليل جداً من النساء إلى مناصب قيادية. إن مجموع المرشحات لأي وظيفة عليا ضئيل، وسيستمر هذا العدد بالتناقص إذا قررت النساء اللاتي يأتين بعدنا أن يأخذن بعض الوقت للراحة، أويتخلين عن المنافسة المهنية تمامًا، في سبيل تربية الأطفال. هذا هو على وجه التحديد ما أزعج شيريل ساندبيرج إلى هذا الحد، ولها الحق في ذلك. على حد تعبيرها فإن “النساء لا ينجحن في الوصول إلى السلطة؛ هناك مائة وتسعون رئيس دولة، تسعة منهم نساء. ومن بين جميع الأشخاص في البرلمان في العالم، 13 في المائة منهم نساء. وفي قطاع الشركات، تتفوق نسبة النساء في المناصب العليا ـ وظائف الإدارة التنفيذية ومقاعد مجلس الإدارة ـ لتصل إلى 15، 16 بالمائة”
علاوة على ذلك، لاتزال الحياة المتوازنة في أوساط الذين تمكنوا من الوصول إلى السلطة بعيدة المنال بالنسبة للنساء أكثر من الرجال. لقياس ذلك بشكل بسيط يمكننا النظر إلى عدد النساء في المناصب العليا اللاتي لديهن أطفال مقارنة بزملائهن من الرجال. لكل قاضي من قضاة المحكمة العليا من الذكور عائلة، في حين أن قاضيتين من بين كل ثلاثة قضاة نساء هن عازبات وليس لديهن أطفال. وبدأت الثالثة، روث بدر جينسبرغ، مسيرتها المهنية كقاضية فقط عندما كان طفلها الأصغرسنًّا يافعاً تقريبًا. هذا النمط يتكرر في مجلس الأمن القومي: فكونداليزا رايس، أول امرأة مستشار للأمن القومي والوحيدة، هي أيضاً مستشار الأمن القومي الوحيدة منذ خمسينيات القرن العشرين التي ليس لديها أسرة. ولكن هل من الممكن أن يفسر “الالتزام غير الكافي” هذه الأرقام بشكل واضح؟ لا شك أن النساء اللاتي يتمكن من الوصول إلى السلطة ملتزمات بشدة بمهنهن. لكن بعد دراسة أكثر دقة تبين أن أغلبهن يشتركن في شيء آخر: فهن نساء خارقات فعليات. لنتأمل هنا عدد النساء اللاتي شغلن مؤخراً مناصب عليا في واشنطن ـ سوزان رايس وإليزابيث شيرود راندال وميشيل غافين ونانسي آن ديبارل ـ وهن من الحاصلين على منحة رودس. فازت سامنثا باور، مسؤولة كبيرة أخرى في البيت الأبيض، بجائزة بوليتزر عن عمر 32 سنة. أو لنتأمل حالة ساندبيرج، التي تخرجت حاصلةً على جائزة الطالب الأول في الاقتصاد بجامعة هارفارد. من غير الممكن أن تكون هؤلاء النسوة هن المعيار الذي ينبغي حتى للنساء المهنيات الموهوبات جداً أن يقسن أنفسهن به، فمن شأن معيارٍ كهذا أن يدفع أغلب النساء إلى الشعور بالفشل.
الواقع أن الاتجاه إلى تعيين النساء في المناصب العليا في إدارة أوباما لم يسفر إلا عن تعيين امرأة واحدة. كل من تنحت منا عن منصبها تقريباً قد خَلَفَها رجال؛ أما البحث عن نساء لخلافة الرجال في مناصب مماثلة فقد انتهى خالي الوفاض. تقريبا كل امرأة تستطيع العمل تحت الضغط بصورة معقولة تعمل بالحكومة بالفعل. إن بقية عالم السياسة الخارجية ليس أفضل بكثير؛ قام هايتي زينكو، وهو زميل في مجلس العلاقات الخارجية، بدراسة أفضل البيانات التي استطاع العثور عليها في مختلف أنحاء الحكومة، والمؤسسة العسكرية، والأكاديمية ومراكز البحوث، ووجد أن النساء يشغلن أقل من 30 في المائة من المناصب العليا في السياسة الخارجية في كل من هذه المؤسسات.
هذه الأرقام أكثر إثارة للدهشة عندما ننظر إلى الثمانينات، عندما كانت النساء اللاتي هنّ الآن في أواخر الأربعينات والخمسينات من العمر يتخرجن من كليات الدراسات العليا، وتذكروا أن فصولنا الدراسية كانت تتكون من نصف رجال ونصف نساء تقريباً. كنا على يقين آنذاك من أننا بحلول هذا الوقت سوف نعيش في عالم من الفرص المتساوية بين النساء والرجال، أمرٌ ما أخرج ذلك الحلم عن مساره.
تعتقد ساندبيرج أن هذا “الأمر” هو “فجوة الطموح”، وأن النساء لا يحلمن بالقدر الكافي. أنا أؤيد تماماً تشجيع النساء الشابات على أن يطمحن للوصول إلى النجوم. لكنني أخشى أن تكون العقبات التي تحول دون وصول النساء إلى السلطة أكثر صلابة من معاول طموحهن. راسلتني مساعدتي العزيزة لفترة طويلة، وهي تحمل شهادة الدكتوراه وتقوم بعدة مهام في نفس الوقت وهي أم لتوأم من المراهقين، عبر البريد الإلكتروني بينما كنت أعمل على هذا المقال، قائلة: “هل تعلمي ما قد يساعد الغالبية العظمى من النساء على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة؟ جعْل الجداول المدرسية مطابقة لجداول العمل” وأشارت إلى أن النظام الحالي يستند إلى مجتمع لم يعد له وجود، حيث كانت الزراعة تمثل المهنة الرئيسية وكان وجود الأمهات في المنزل هو القاعدة، ورغم ذلك فإن النظام لم يتغير.
لنستعرض هنا ردود بعض النساء اللاتي قابلهن زينكو بشأن الأسباب التي تجعل “النساء غير ممثلات بشكل كافٍ في مجال السياسة الخارجية، ومناصب الأمن الوطني في الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والمراكز البحثية” صرحت جولييت كاييم، التي عملت كمساعد وزير في وزارة الأمن الداخلي من 2009 إلى 2011، والتي تكتب الآن عمود السياسة الخارجية والأمن القومي في The Boston Globe، لزينكو قائلة:
الحقيقة الأساسية هي أن: السفر مريع. وبما أن أصغر أطفالي الثلاثة هو الآن في عامه السادس، أستطيع أن أسترجع السنوات عندما كان جميعهم صغاراً، وأدرك كم كان السفر مُدمّراً. كانت هناك أيضاً رحلاتٍ لم أستطع القيام بها، لأنني كنت حاملاً أوفي عطلة، ومؤتمراتٍ لم أتمكن من حضورها لأن الأطفال (ملاحظة لمنظمي المؤتمرات: عطلات نهاية الأسبوع هي اختيار سيء) سوف يكونون قد عادوا من المدرسة إلى بيوتهم، ورحلات مختلفة أتيحت لي ولكن لم يكن من الممكن الذهاب إليها.
أيدت ذلك جولين شوميكر، مديرة قسم المرأة في الأمن الدولي: “إن الجداول الزمنية غير المرنة، والسفر المستمر، والضغوط المتواصلة التي تفرض على المرء أن يكون متواجداً في مكتبه، من السمات الشائعة لهذه الوظائف”.
إن هذه القضايا “البسيطة” ــ الحاجة إلى السفر بشكل مستمر لتحقيق النجاح، والتعارضات بين الجداول المدرسية وجداول العمل، والإصرار على إنجاز العمل في المكتب ــ من غير الممكن أن تُحَل بالاستعانة بمواعظ ونصائح ردم فجوة الطموح. أتمنى لو أن تتطرق الخطب والمواعظ عن الطموح إلى سياسات أمريكا الاجتماعية والتجارية، وليس مستوى طموح المرأة، لتفسير ندرة وجود النساء في السلطة. لكن تغيير هذه السياسات يتطلب ما هو أكثر من مجرد خطابات. هذا يعني محاربة المعارك البسيطة ـ كل يوم وكل عام ـ في أماكن العمل الفردية، وفي الهيئات التشريعية، وفي وسائل الإعلام.
“إنه ممكن، إذا تزوجتِ الشخص المناسب”
الرسالة الثانية التي وجهتها ساندبيرج في خطاب البدء الذي ألقته في بارنارد هي: “إن أهم قرار مهني سوف تتخذيه هو ما إذا كان لديك شريك حياة أم لا، ومن يكون ذلك الشريك”. قامت ليزا جاكسون مؤخراً، وهي مديرة هيئة حماية البيئة، بإيصال هذه الرسالة إلى جمهور من طلاب وخريجي جامعة برينستون الذين تجمعوا للاستماع إلى الخطاب الذي ألقته بمناسبة قبولها ميدالية جيمس ماديسون، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، سألها أحد أعضاء الجمهور عن كيفية موزانتها بين مهنتها وعائلتها، فضحكت وأشارت إلى زوجها في الصف الأول قائلة: “هذا هو مصدر موازنتي بين العمل والحياة”. لم يكن من الممكن أن أحصل على الوظيفة التي أشغلها لولا زوجي أندرو مورافيسك، وهو بروفيسور مثبت في السياسة والشؤون الدولية في برينستون. لقد أمضى آندي وقتاً أطول مع أبنائنا مقارنة بالوقت الذي أمضيته أنا معهم، ليس فقط من أجل الواجبات المنزلية، بل وأيضاً في لعب البيسبول، ودروس الموسيقى، والتصوير الفوتوغرافي، وألعاب الورق، وغير ذلك الكثير. عندما احتاج كل منهم إلى إحضار طبق أجنبي من أجل العشاء في الصف الرابع، أعد آندي طبق جدته المجرية كاسينتا؛ عندما أراد ابننا الأكبر سناً حفظ دوره الرئيسي في مسرحية مدرسية، لجأ إلى آندي ليساعده.
ومع ذلك، فإن الطرح القائل بأن المرأة يمكنها أن تشغل وظائف عالية المستوى، ما دام زوجها أو شريكها على استعداد لتقاسم عبء الأبوة بالتساوي) أو على نحو غير متناسب (يفترض أن معظم النساء سيشعرن بالارتياح ذاته، الذي يشعر به الرجال إزاء ابتعادهن عن أطفالهن، طالما كان شريكهن معهم في المنزل. من واقع تجربتي، الحال ليس كذلك ببساطة.
إنني أخطو هنا على أرض وعرة، ملغومة بالقوالب النمطية، لكن بعد أعوام من النقاشات والملاحظات، أصبحتُ أؤمن بأن الرجال والنساء يستجيبون بشكل مختلف تماماً عندما تجبرهم المشاكل في المنزل على إدراك حقيقة مفادها أن غيابهم يسبب الضرر لأطفالهم، أوعلى الأقل أن وجودهم من المرجح أن يكون ذا جدوى. لا أعتقد أن الآباء يحبون أطفالهم بقدر أقل من الأمهات، لكن يبدو أن الرجال أكثر ميلاً إلى اختيار وظيفتهم على حساب عائلاتهم، في حين يبدو أن النساء أكثر ميلاً إلى اختيار عائلاتهن على حساب وظائفهن.
هناك العديد من العوامل التي تحدد هذا الاختيار بطبيعة الحال. لا يزال الرجال ملتزمين اجتماعياً باعتقاد أن واجبهم العائلي الأساسي هو أن يكونوا المعيلين؛ بينما تلتزم النساء باعتقاد أن واجبهن العائلي الأساسي هو أن يكن مقدمات الرعاية، لكن قد يكون الأمر أكثر من ذلك، عندما تكلمت عن الاختيار بين أطفالي ووظيفتي مع عضو مجلس الشيوخ جين شاهين، قالت على وجه التحديد ما كنت قد شعرت به: “ليس هناك خيار حقاً” فهي لم تكن تشير إلى التوقعات الاجتماعية، بل إلى شعور عميق بضرورة الأمومة مما يجعل “الخيار” مُلِحّاً.
يبدو أن الرجال والنساء أيضاً يصوّرون الخيار بشكل مختلف. في كتابها Midlife Crisis at 30، تستذكر ماري مالين الأيام التي كانت تعمل فيها كمساعد للرئيس بوش ومستشار نائب الرئيس تشيني:
“حتى عندما كانت الضغوط هائلة ـ في تلك الأيام التي كنت أبكي فيها في السيارة وأنا في طريقي إلى العمل أسأل نفسي “لماذا أقوم بهذا العمل؟” ـ كنت أعرف دوماً إجابة ذاك السؤال: أنا أؤمن بهذا الرئيس”.
لكن ماتالين تتابع لتصف خيارها بالاستقالة بكلمات تشبه إلى حدٍّ غير عادي، التوضيح الذي أخبرتُه للعديد من الناس منذ مغادرتي وزارة الخارجية:
“سألت نفسي أخيراً: “من الذي يحتاجني أكثر؟” وعندها أدركت أنه قد حان الوقت ليقوم أحد ما غيري بهذا العمل. فأنا لا غنى عني بالنسبة إلى أطفالي، ولكنني لا أقارب حتى أن أكون أمرًا لا غنى عنه بالنسبة إلى البيت الأبيض”.
إلا أنه بالنسبة إلى العديد من الرجال، يبدو خيار قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم بدلاً من العمل لساعات طويلة، على قضايا تؤثر على حياة العديد من الناس خياراً أنانياً. إن الزعماء الذكور كثيراً ما يُمدحون بسبب تضحيتهم بحياتهم الشخصية على مذبح الخدمة العامة أوخدمة الشركات. بطبيعة الحال، تشمل هذه التضحية أسرهم عادة، كما أن أطفالهم أيضاً معتادين على تقديم أداء الخدمة العامة على المسؤولية الخاصة.
في حفل تأبين الدبلوماسي ريتشارد هولبروك، قال أحد أبنائه للجمهور إنه عندما كان طفلاً، كان كثيراً ما يكون والده خارج المنزل، فهو لم يكن متواجداً ليعلّمهُ كيفية رمي الكرة، أو ليشاهد ألعابه، لكنه أضاف أنه أدرك مع تقدم العمر أن غياب هولبروك كان ثمن إنقاذ الناس في مختلف أنحاء العالم، وهو ثمن يستحق أن ندفعه.
لا أفهم كون هذا الإطار الأخلاقي منطقياً بالنسبة إلى المجتمع، لماذا ينبغي علينا أن نرغب بزعماء يقصّرون في تحمل المسؤوليات الشخصية؟ لعل الزعماء الذين استثمروا الوقت مع أسرهم يدركون بشكل أكبر حدة الخسائر التي قد تلحق بالحياة الخاصة، نتيجة لاختياراتهم العامة في قضايا الحرب والسلام.
تقول كاتي مارتون، أرملة هولبروك ومؤلفة كبيرة: “على الرغم من حب هولبروك لأطفاله، إلا أنه لم يقدّر القيمة الحقيقية لعائلته قبل الخمسينات من عمره فقط، وعندها أصبح أبًا وجداً مُتفانيا للغاية، في حين واصل مهنته الحكومية الاستثنائية. بصرف النظر عن هذا، فمن الواضح أية مجموعة من الاختيارات يقدرّها المجتمع اليوم أكثر من غيرها”. عادة ما يُكافأ العاملون الذين يضعون حياتهم المهنية في المرتبة الأولى؛ بينما يتم تجاهل العاملون الذين يختارون أسرهم ويتم التشكيك بهم، واتهامهم بعدم المهنية.
خلاصة القول هي: أن وجود شريك داعم قد يكون شرطاً ضرورياً إذا كانت النساء سيتمكنّ من الجمع بين الأشياء كلها، ولكنه ليس كافياً، إذا شعرت النساء بعمق، بأن رفض الترقية التي تنطوي على مزيد من السفر، على سبيل المثال، هو التصرف الصحيح الذي ينبغي القيام به، فإنهنّ سيواصلن القيام بذلك.
في نهاية المطاف، يتعين على المجتمع أن يتغير، وأن يقدّر الخيارات التي تُقدِّم الأسرة على العمل بقدر ما يُقدّر الخيارات التي تُقدِّم العمل على الأسرة، إذا قدّرنا تلك الخيارات بالفعل، فإننا سنُقدّر الناس الذين يتخذونها؛ وإذا قدّرنا الناس الذين يتخذونها، فإننا سنبذل كل ما في وسعنا لتوظيفهم وحمايتهم؛ وإذا فعلنا كل ما في وسعنا للسماح لهم بالجمع بين العمل، والأسرة بالتساوي مع مرور الوقت، فإن الخيارات سوف تصبح أكثر سهولة.
“إنه ممكن، إذا رتبتِ الأمور بالتسلسل الصحيح”
على النساء اليافعات أن يتوخين الحذر من العبارة التي تؤكد أنه “بوسعك أن تجمعي بين كل شيء؛ ولكن ليس دفعة واحدة” تقدم النساء الكبيرات في السن الآن إضافة القرن الحادي والعشرين على هذه العبارة الأصلية لمنصوحاتهنّ الأصغر سناً، إلى درجة أنها أصبحت تعني، على حد تعبيرِ أمٍّ عاملة: “سوف أبذل قصارى جهدي، وسوف أضع في الحسبان أهداف المدى الطويل وأنا أعلم أنّه لن يكون من الصعب إيجاد التوازن دوماً”، إنها نصيحة سديدة، ولكن إلى الحد الذي قد يعني أن النساء بوسعهن أن يجمعن بين كل شيء إذا ما وجدن التسلسل الصحيح للحياة المهنية، والأسرة، فهذا خطأ بلا شك.
أهم مسألة تتعلق بالتسلسل هي وقت إنجاب الأطفال، كانت العديد من القيادات النسائية العليا في الجيل الذي سبقني ـ مادلين أولبرايت، وهيلاري كلينتون، وروث بدر جينسبرج، وساندرا داي أوكونور، وباتريشيا وولد، ونانيرل كوهان ـ قد أنجبن أطفالهن في العشرينات وأوائل الثلاثينات من أعمارهن، كما كانت العادة في الخمسينيات، وحتى السبعينيات من القرن العشرين.
الطفل الذي يولد عندما تكون أمّه في الخامسة والعشرين من العمر، سوف ينهي المدرسة الثانوية عندما تكون أمّهُ في الثالثة والأربعين، وهي لا يزال لديها الوقت الكافي والطاقة للتقدم، مع الانغماس بدوام كامل في مهنتها.
إلا أن هذا التسلسل لم يعد محبذاً من قبل العديد من النساء ذوات الإمكانيات العالية، وهو أمر يمكن فهمه، يميل الناس إلى الزواج في سن متأخرة الآن، وعلى أية حال، إذا كان لديك أطفال في وقت سابق، فقد تجدين صعوبة في الحصول على شهادة جامعية، وفرصة عمل أولى جيدة، وفرص التقدم في السنوات الأولى الحاسمة من حياتك المهنية، وما يزيد الطين بلة أنك ستحصلين على دخل أقل، بينما تقومين بتربية أطفالك، وبالتالي قدرة أقل على استئجار المساعدة التي قد يكون لا غنى عنها من أجل تحقيق التوازن.
عندما شغلت منصب العميد، أطلقتْ مدرسة وودرو ويلسون برنامج تحت مسمى مسارات الخدمة العامة، وكان الهدف منه تقديم المشورة للنساء اللاتي كاد أطفالهن أن يبلغوا سن النضج حول كيفية الالتحاق بالخدمة العامة، ولا تزال العديد من النساء يسألنني عن أفضل “الطرق المختصرة” نحو تأسيس مهنة في منتصف الأربعينات من أعمارهن، بصراحة، لست متأكدة مما يجب عليّ إخبار معظم هؤلاء النسوة به، على عكس النساء الرائدات اللاتي أصبحن عاملات بعد إنجاب الأطفال في سبعينيات القرن العشرين، تتنافس هذه النساء مع ذواتهن الأصغر سنّاً.
إن الوظائف الحكومية، ووظائف المنظمات غير الحكومية، تشكّل خيارًا متاحًا، ولكن العديد من المهن أصبحت غير متاحة فعلياً. شخصياً، لم أرَ امرأةً في الأربعينات من عمرها، تدخل المجال الأكاديمي بنجاح، أوشركة قانونية كمحامية مبتدئة، لا تستثنى من ذلك سوى أليسيا فلورريك من مسلسل The Good Wife .
هذه الاعتبارات هي السبب في أن العديد من النساء المهنيات من جيلي، اختاروا أن يؤسسن حياتهن المهنية أولًا، وأن ينجبن في منتصف إلى أواخر الثلاثينات، لكن هذا يزيد من احتمالية المرور بسنوات مرهقة طويلة، وإنفاق ثروة صغيرة في محاولة إنجاب طفل. لقد عايشت ذلك الكابوس: فعلى مدار ثلاث سنوات، بدءاً من سن الخامسة والثلاثين، فعلت كلّ ما في وسعي لكي أنجب، وكنت مذعورةً من فكرة أني تخليت عن إنجاب طفل إلى أن فات الأوان.
لكن متى كان كل شيء على ما يرام؟ أنجبت طفلي الأول في سن 38 (وعددتُ نفسي محظوظة) والثاني في سن الـ 40، وهذا يعني أنني سأكون في الـ 58 عندما سيغادر ولداي المنزل علاوة على ذلك، يعني هذا أن العديد من أفضل فرص العمل ستتزامن مع سنوات مراهقة الأولاد على وجه التحديد، عندما يكون وجود الآباء إلى جانب أطفالهم على نفس القدر، من أهمية تواجدهم معهم في سنين طفولتهم الأولى، كما ينصح آباء متمرسون.
العديد من نساء جيلي وجدن أنفسهن، وهنّ في أوج تألقهن المهني، يرفضن الفرص التي كن من الممكن أن يقفزن فرحاً بها ذات يوم، ويأملن أن تتكرر هذه الفرص مرة أخرى في وقت لاحق. أخريات كثيرات من اللواتي قررن التنحي لبعض الوقت، أو تولي مناصب استشارية، أو العمل بدوام جزئي يسمح لهن بقضاء المزيد من الوقت مع أطفالهن (أوآباءهن المسنين)، يشعرن بالقلق إزاء الوقت الذي يمكنهن أن يبقين فيه “متنحَين” قبل أن يخسرن ميزة المنافسة التي عملن جاهداتٍ من أجل الحصول عليها.
بالنظر إلى الطريقة التي تسير بها ثقافة العمل اليوم، أوصيك بأن تثبتي نفسك في مهنتك أولاً، ولكن مع ذلك حاولي أن تنجبي قبل أن تصلي إلى سن الـ 35، أوأن تجمدي البويضات، سواء كنت متزوجة أم لا. يمكن أن تكوني أماً أكثر نضجاً، وأقل إحباطاً وأنت في الثلاثينات والأربعينات من العمر؛ ومن المرجح أن تكوني قد عثرتِ على شريك دائم. الحقيقة هي أن أيّاً من التسلسلين ليس هو الأمثل، وكل منهما يشتمل على تنازلات لا يضطر الرجال إلى تقديمها.
يجب أن تكوني قادرة على تكوين عائلة إذا أردت ذلك، مهما كانت الظروف التي تسمح بها حياتك، وكذلك على الحصول على الحياة المهنية التي ترغبين بها.
إذا تمكنت المزيد من النساء من تحقيق هذا التوازن، فإن المزيد من النساء سوف يصلن إلى مناصب قيادية، وإذا شغلتْ المزيد من النساء مناصب قيادية، فسوف يكون بوسعهن أن يجعلن بقاء النساء الأخريات ضمن القوى العاملة أسهل، بقية هذا المقال يفصل كيفية تحقيق هذا الأمر.
تغيير ثقافة المقابلات الشخصية
في زمن إدارة ريجان، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عن مدير الميزانية، الذي يتمتع بقدرة تنافسية شرسة، ديك دارمان، يقول التقرير: “تمكن السيد دارمان في بعض الأحيان من نقل انطباع بأنه كان آخر من يعمل في البيت الأبيض، في عهد ريجان بتركه سترة بذلته على كرسيه، وترك إنارة مكتبه مشتعلة، بعد أن يغادر إلى منزله.” (زعم دارمان أن ترك سترة بذلته في المكتب كان يجعل ارتدائها مرة أخرى في الصباح أكثر سهولة، ولكن سجله في التلاعب النفسي يشير إلى غير ذلك).
إن ثقافة “جنون الوقت” -المنافسة الشرسة للعمل أكثر، والبقاء حتى وقت متأخر، وإمضاء المزيد من أيام العمل طوال الليل، والسفر حول العالم، وتوثيق الساعات الإضافية، التي يوفرها لك خط التوقيت الدولي ـ تظل سائدة إلى حدّ صادم بين المهنيين اليوم، لا شيء يدلنا على الإعتقاد السائد، بأن المزيد من الوقت يعادل منفعة أكبر، أفضل من تقديس الساعات المدفوعة الأجر، التي تتفشى في شركات القانون الكبرى في مختلف أنحاء البلاد، تقدم هذه الشركات حوافز خاطئة تماماً للموظفين الذين يأملون في الجمع بين العمل والأسرة، لكن حتى في الصناعات التي لا تكافئ صراحة على عدد الساعات الكبير التي تنفق في العمل، فإن الضغط الممارس لكي تصل في وقت مبكر، وتبقى حتى وقت متأخر، وتكون متاحًا دوماً للاجتماعات الشخصية في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت، قد يكون شديداً.
الواقع أن المشكلة تفاقمت بمرور الوقت وفقاً لبعض المقاييس: تفيد دراسة أجراها مركز التقدم الأمريكي بأن حصة جميع المهنيين -النساء والرجال -الذين يعملون أكثر من 50 ساعة في الأسبوع، في جميع أنحاء البلاد قد ازدادت منذ أواخر السبعينات.
لكن إمضاء المزيد من الوقت في المكتب، لا يعني دوماً رفع “القيمة المضافة”، كما أنه لا يؤدي دائمًا إلى مؤسسة أكثر نجاحاً. في عام 2009، كلفت ساندرا بشارسكي، وهي شريكة كبيرة في شركة مونيتور غروب ورئيسة ممارسات الشركة القيادية والتنظيمية، أستاذاً من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، بتقييم العوامل التي ساعدت أو أعاقت فعالية المرأة وتقدمها في شركة مونيتور. توصلت الدراسة إلى أن ثقافة الشركة اتسمت بأسلوب العمل “الدائم”، وكثيراً ما كان يتم ذلك دون إيلاء الاعتبار الواجب لتأثير ذلك على الموظفين. لاحظت بشارسكي:
العملاء دائماً أولاً، ويؤدي العمل طوال الليل أحياناً إلى إحداث الفرق بين النجاح والفشل، لكن في بعض الأحيان، كنا نلجأ بصورة افتراضية إلى سلوك يثقل موظفينا فقط من دون تحسين النتائج كثيراً، إن كان هناك أية تحسن أصلاً، قررنا أننا نحتاج إلى مدراء لتحسين التمييز بين هذه الفئات، ولإدراك التكاليف الخفية وراء افتراض أن “الوقت غير ذو قيمة كبيرة.” عندما لا يجلب الوقت منفعة كبيرة ويأتي بتكاليف باهظة على الموظفين الموهوبين، والذين سيغادرون عندما تصبح التكاليف الشخصية غير محتملة ــ حسناً، من الواضح أن هذه نتيجة سيئة بالنسبة للجميع.
لقد عملتُ لساعاتٍ طويلة جداً وأمضيتُ الكثير أيام الدوام الليلي خلال مسيرتي المهنية، بما في ذلك بضع ليال أمضيتها على أريكة مكتبي خلال السنتين التي عملتُ بهما في العاصمة. الاستعداد لتنظيم الوقت بينما يجب إنجاز العمل ببساطة هي السمة المميزة للمهنيين الناجحين حقاً. لكن بالنظر إلى الوراء، لا بد لي من الاعتراف بأن افتراضي بأنني أستطيع أن أعمل حتى وقت متأخر، جعلني أقل كفاءة مما كان ممكناً على مدار اليوم، وبالتأكيد أقل كفاءة من بعض زملائي الذين تمكنوا من إنجاز نفس القدر من العمل والذهاب إلى المنزل في ساعة مبكرة. لو كان ديك دارمان يحظى بمديراً يقدر الأولويات وإدارة الوقت بشكل واضح، كان من الممكن أن يجد سبباً لإطفاء الأضواء وأخذ سترته إلى المنزل.
الساعات الطويلة هي أحد الأمور، وحقيقةً، كثيراً ما تكون أمراً لا مفر منه. لكن هل يجب حقاً إمضاء هذه الساعات في المكتب؟ لا شك أن التواجد في المكتب لبعض الوقت مفيد. يمكن أن تكون المقابلات الشخصية أكثر فعالية من المكالمات الهاتفية، أو البريد الإلكتروني بكثير؛ حيث يكون بناء الثقة والزمالة بالجلوس حول نفس الطاولة أسهل بكثير؛ كما أن المحادثات العفوية غالباً ما تولد أفكاراً جيدة وعلاقات دائمة، مع ذلك، كوننا مزودين بالبريد الإلكتروني، والمراسلة الفورية، والهواتف، وتقنية عقد المؤتمرات عبر الفيديو، ينبغي أن نتمكن من التحول إلى ثقافةٍ يكون فيها المكتب قاعدةً للعمليات أكثر من كونه مكاناً ضرورياً من أجل العمل.
إن القدرة على العمل من المنزل – في المساء بعد أن يخلد الأطفال إلى النوم، أو خلال أيام مرضهم أو أيام تراكم الثلج، ولبعض الوقت على الأقل في عطلات نهاية الأسبوع – يمكن أن يكون المفتاح بالنسبة للأمهات من أجل القيام بجميع المهام، في مقابل خذل فريقهن في العمل في اللحظات الحاسمة. يمكن أن تقلّل تقنيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو الحديثة بشكل كبير من الحاجة إلى رحلات عمل طويلة. الواقع هو أن هذه التقنيات تُحرز نجاحات كبيرة وتسمح بدمج العمل والحياة الأسرية بشكل أسهل. وفقاً لمركز الأعمال التجارية النسائي، فإن 61% من أصحاب الأعمال من النساء يستخدمن التكنولوجيا “لدمج مسؤوليات العمل والمنزل”؛ و44% منهن يستخدمن التكنولوجيا للسماح للموظفين “بالعمل خارج مكان العمل أوللحصول على جداول عمل مرنة.” مع ذلك، لا تزال ثقافة العمل ترتكز على العمل في المكاتب أكثر مما ينبغي، ولا سيما في ضوء التقدم التكنولوجي.
تتمثل إحدى طرق تغيير ذلك في تغيير “القواعد الافتراضية” التي تحكم العمل في المكتب — التوقعات الأساسية حول وقت، ومكان، وكيفية إنجاز العمل، كما يدرك خبراء الإقتصاد السلوكي تمام الإدراك، فإن هذه الأسس من الممكن أن تحدث فارقاً هائلاً في الطريقة التي يعمل بها الناس، من بين تلك الأمور، أن تسمح منظمة ما على سبيل المثال باستقبال المكالمات أثناء الاجتماعات حسب قوانين خاصة، حين تتعارض رعاية الأطفال وجداول العمل، نظام أفضل من لا شيء، ولكنه من المرجح أن يولد شعوراً بالذنب بين أولئك الذين يتصلون بالاجتماع، وربما الشعور بالاستياء بين أولئك الموجودين في غرفة الاجتماع. أمر آخر هو أن تعلن تلك المنظمة أن سياستها ستقوم بجدولة اجتماعات شخصية، كلما أمكن، خلال ساعات الدوام المدرسي — وهو نظام قد يجعل إجراء الاتصالات في تلك الاجتماعات (الأكثر ندرة) التي لا تزال تُعقد في وقت متأخر بعد الظهر أمراً طبيعياً.
إليكم مثال واقعي من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، وهو مكان غالباً ما يرتبط في ذهن معظم الناس برجال موقرون، يرتدون البذلة أكثر من ارتباطها بالتفكير التقدمي عن الموازنة بين العائلة والعمل، لكن، مثل العديد من الأماكن الأخرى، تشعر وزارة الخارجية، وشؤون الكومنولث البريطانية بالقلق إزاء فقدان أعضاء موهوبين من أزواج يشغلون مهنتين في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما النساء، بناء على ذلك، غيرت سياستها الأساسية مؤخراً من قاعدة افتراضية تقضي بأن الوظائف لابد أن تتم في مكان العمل إلى أخرى تفترض أن بعض الوظائف قد يتم تنفيذها عن بُعد، وتدعو العمّال إلى السعي لصالح العمل عن بُعد.
كتبت كارا أوين، وهي موظفة في السلك الخارجي، وكانت مديرة التنوع في وزارة الخارجية البريطانية وستصبح قريباً نائب للسفير البريطاني في فرنسا، أنها شغلت حتى الآن وظيفتين عن بعد. قبل إجازة الأمومة الحالية، كانت تعمل في لندن من دبلن لكي تكون مع شريكها، باستخدم تقنية عقد المؤتمرات عن بُعد وبمزامنة رحلاتها إلى لندن “مع اجتماعات هامة حيث كنت في حاجة إلى أن أكون في غرفة الاجتماع (أو أن أدردش في ردهة المقهى ما قبل الاجتماع) لكي أتمكن من أن أترك أثر، أو للمحافظة على’ علاقات راسخة‘.” وتتابع قائلة: “في الواقع، لقد وجدت أن وجود المسافة والهدوء من المزايا الحقيقية للقيام بدور استراتيجي، شريطة أن أعطي الأولوية للاستثمار في تطوير علاقات شخصية قوية للغاية مع شركات تملك زمام الأمور.”
تدرك أوين أنه لا يمكن القيام بكل عمل بهذه الطريقة، لكنها تقول إنها من جانبها تمكنت من الجمع بين متطلبات الأسرة ومسيرتها المهنية.
لا ينبغي للتغييرات التي تطرأ على القواعد المكتبية الافتراضية أن تقدم الآباء على غيرهم من العمّال؛ إن تمت هذه التغييرات على الوجه الصحيح، يمكنها أن تحسن العلاقات بين زملاء العمل من خلال رفع وعيهم بالظروف، التي يعيش فيها زملائهم وغرس الشعور بالعدالة. قبل عامين، قررت مؤسسة اتحاد ماساشوستس للإجازة الأسرية أن تستبدل سياسة “الإجازة الأبوية” بسياسة “الإجازة الأسرية” التي تنص على ما قد يصل إلى 12 أسبوعاً من الإجازة، ليس فقط للآباء الجدد، بل وأيضاً للموظفين الذين يحتاجون إلى رعاية الزوج والطفل أوالآباء ممن هم في حالة صحية خطيرة. وفقاً للمديرة كارول روز: “كنا بحاجة إلى سياسة تضع في الحسبان حقيقة مفادها أن حتى الموظفين الذين ليس لديهم أطفالاً، لديهم التزامات عائلية.” صيغت هذه السياسة وفقاً لاعتقادٍ مفاده أن منح النساء “معاملة خاصة” من الممكن أن يؤدي إلى “نتائج عكسية إذا لم تتغير القواعد الأوسع، التي تنظم سلوك كل الموظفين.” عندما كنت عميداً لكلية ويلسون، كنت أدير تحت شعار “الأسرة أولاً” ـ أية أسرة ـ ووجدت أن العاملين لدي كانوا منتجين ومخلصين للغاية.
لن تحدث أيًّا من هذه التغيرات من تلقاء نفسها، ونادراً ما يصعب العثور على أعذار لتجنبها، لكن يمكن التغلب على العقبات، والقصور الذاتي عادة إذا كان القادة منفتحون على تغيير افتراضاتهم حول مكان العمل، فاستخدام التكنولوجيا في العديد من الوظائف الحكومية الرفيعة المستوى، على سبيل المثال، أمرٌ معقد بسبب الحاجة إلى الحصول على المعلومات السرية. لكن في عام 2009، تمكن نائب وزير الخارجية جيمس شتاينبرغ، الذي يرعى ابنتيه الصغيرتين على قدم المساواة مع زوجته، من جعل الوصول إلى هذه المعلومات من المنزل أولوية فورية، حتى يتمكن من مغادرة المكتب في وقت معقول، والمشاركة في الاجتماعات الهامة عن طريق عقد المؤتمرات عبر الفيديو إذا لزم الأمر. أتساءل عن عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب مماثلة واللاتي يخشين أن يطالبن بذلك، خشية أن يُنظَر إليهن على أنهن غير ملتزمات بالقدر الكافي بمنصبهن.
إعادة تثمين القيم العائلية
رغم أن أرباب العمل لا ينبغي لهم أن يميزوا الآباء والأمهات عن غيرهم من العمال، إلا أن الحال ينتهي بهم في كثير من الأحيان إلى فعل العكس، وعادة ما يكون ذلك بشكل خفي، وبطرقٍ تجعل من الصعب على مقدم الرعاية الأولية أن يتقدم. يبدو أن العديد من الأشخاص في مواقع السلطة يولون قيمة متدنية لرعاية الأطفال مقارنة بالأنشطة الخارجية الأخرى، لنتأمل الفرضية التالية: صاحب عمل لديه موظفان موهوبان ومنتجان بنفس القدر، أحدهما يتدرب، ويركض في سباقات العَدو (المارثونات) خارج أوقات العمل. أما الآخر، فيعتني بطفلين. ما الانطباعات التي يحتمل أن يشكلها صاحب العمل بشأن العدّاء؟ أنه يستقيظ كل يوم في الظلام ويمضي ساعة أو ساعتين وهو يركض، قبل أن يأتي إلى المكتب، أو يتحامل على نفسه للذهاب إلى هناك حتى بعد يوم طويل، وأنه منضبطٌ جداً، ومستعدٌ لإحرازِ تقدّم، بالرغم من التشتيت والإجهاد والأيام التي لا يبدو فيها أي شيء وكأنه يسير على ما يرام في خدمة هدف بعيد المنال، وأنه بلا شك يدير وقته بشكل استثنائي حتى يتمكن من ضبط كل تلك الأمور.
بصدق: هل تعتقد أن صاحب العمل يكوّن هذه الافتراضات نفسها حول الوالدة؟ على الرغم من أنها على الأرجح تستيقظ في ساعات الظلام قبل وقت ذهابها إلى العمل، وتنظم يوم أطفالها، وتحضر الإفطار، وتجهز وجبات الغداء، وتعدّهم للذهاب إلى المدرسة، وتحضّر قائمة التسوق، وغير ذلك من المهمات، حتى ولو كانت محظوظة بالقدر الكافي للحصول على مدبرة منزل، وتقوم بالعمل نفسه غالباً في نهاية اليوم.
الواقع أن شيريل ميلز، رئيس أركان هيلاري كلينتون التي لا تكلّ ولا تملّ، لديها توأم في المدرسة الابتدائية، وحتى مع زوجها المتعاون بشكل كامل، اشتهرت بأنها تستيقظ في الرابعة فجراً لتقوم بتفقد وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، قبل أن يستيقظ أطفالها. جمعت لويز ريتشاردسون، نائب مستشار جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، بين عملها كأستاذ مساعد في الشؤون الحكومية في هارفارد ورعاية ثلاثة أطفال صغار، فقد نظمت وقتها بشكل دقيق جداً، حتى أنها كانت تحرص دوماً على ضغط مفاتيح الميكروويف في الساعة 1:11 أو 2:22 أو 3:33 بدلاً من الساعة 1:00 أو 2:00 أو 3:00، لأن ضغط نفس الرقم ثلاث مرات استغرق وقتاً أقل.
لدى إليزابيث وارن، التي تترشح الآن لمجلس الشيوخ الأمريكي في ماساتشوستس، قصة مماثلة، عندما كان لديها طفلان صغيران وكانت تمارس المحاماة بدوام جزئي، كافحت للعثور على وقت كافٍ لكتابة المقالات والأوراق البحثية، التي من شأنها أن تساعدها في الحصول على منصب أكاديمي. على حد تعبيرها:
كنت بحاجة إلى خطة، وعلمت أن وقت الكتابة يجب أن يكون نفس وقت نوم أليكس، لذا في اللحظة التي أضعه فيها ليأخذ قيلولة، أو ينام في أرجوحته، أذهب إلى مكتبي وأبدأ بالعمل على شيء ما الحواشي، القراءة، وضع الخطوط العريضة، الكتابة…. تعلمت أن أفعل كل شيء آخر بينما يجلس طفلي في حضني.
إن الانضباط، والتنظيم، والقدرة الكبيرة، على التحمّل الذي يتطلبه النجاح على أعلى المستويات مع أطفال صغار في المنزل يمكن مقارنتها بسهولة بالركض لمسافة تتراوح بين 20 و40 ميلاً في الأسبوع، لكن نادراً ما يرى أرباب العمل الأمور كذلك، ليس فقط عند قبول الطلبات، بل وأيضاً عند إجراء الترقيات، ربما لأن الناس يختارون بأنفسهم أن ينجبوا أطفالا؟ لكنهم يختارون بأنفسهم أيضاً الركض في سباقات الجري.
مثال أخير: عملت مع العديد من اليهود الأرثوذكس، الذين يحتفظون بقداسة يوم السبت فلا يعملون من غروب يوم الجمعة حتى غروب يوم السبت، الشاهد هنا هو جاك ليو، المدير الذي شغل منصب مكتب الإدارة والميزانية مرتين، ونائب وزير الخارجية السابق لشؤون الإدارة والموارد، والذي يتولى الآن منصب رئيس موظفي البيت الأبيض. كانت زوجة جاك تعيش في نيويورك عندما عمل في وزارة الخارجية، لذا فقد كان يترك المكتب في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة، ليستقل الحافلة إلى نيويورك وسيارة أجرة إلى شقته قبل الغروب، لا يعمل يوم الجمعة بعد الغروب، ولا يعمل طوال يوم السبت، كان كل من عرفه، وأنا من بينهم، معجباً بالتزامه الديني، وقدرته على تخصيص وقت له، حتى في ظل وظيفة متطلبة للغاية.
لكن من الصعب تخيل أننا سيكون لدينا نفس ردة الفعل، إذا أخبرتنا أمٌّ أنها تريد أن تتغيب بعد ظهر يوم الجمعة حتى نهاية يوم السبت كل أسبوع لقضاء وقت مع أطفالها، أتوقع أننا سنعتبر هذا تصرفًا غير مهنيّ، وهو ما من شأنه أن يفرض تكاليفاً غير ضرورية على زملاء العمل. في الحقيقة، بالطبع، واحدة من القيم العظيمة للسبت -سواء اليهودي أو الأحد المسيحي-هو بالضبط أنه يمنحنا واحة عائليّة، مع طقوس وتنحية إجبارية للعمل.
هذه هي افتراضاتنا: أشياء نعتقدها وهي ليست بالضرورة كذلك، لكن ما نفترضه له تأثير هائل على تصوراتنا واستجاباتنا، من حسن الحظ أن تغيير افتراضاتنا أمر عائد لنا.
إعادة تعريف منحنى الحياة المهنية الناجحة
التعريف الأمريكي للمهني الناجح هو: شخص يستطيع تسلق السلم أبعد ما يمكن في أقصر وقت، ويصل إلى الذروة عموماً بين عمر الـ 45 و55. إنه تعريف ملائم جداً لمنتصف القرن العشرين، الحقبة حين كان الناس ينجبون في العشرينات من عمرهم، ويبقوا في وظيفة واحدة، ويتقاعدوا في سن الـ 67، ويتوفوا في المتوسط في سن الـ 71.
يبدو هذا غير منطقياً أبداً اليوم، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع للأشخاص في العشرينات من عمرهم إلى 80 عاماً؛ وبوسع الرجال والنساء الذين يتمتعون بصحة جيدة أن يعملوا بسهولة إلى أن يصبحوا في الـ 75 من العمر، بإمكانهم الحصول على وظائف متعددة، بل وحتى مسارات مهنية متعددة طيلة حياتهم المهنية. يتزوج الشركاء في وقت لاحق، وينجبون الأطفال في وقت لاحق، ومن الممكن أن يتوقعوا العيش مع دخلين، وقد يتقاعدون في وقت مبكر ـ حيث انخفض متوسط سن التقاعد من 67 إلى 63 عاماً ـ ولكن هذا “تقاعد” فقط من حيث تحصيل استحقاقات التقاعد، يتابع العديد من الناس “تجديد” حياتهم المهنية.
إذا افترضنا توفر العطايا التي لا تقدر بثمن من صحة، جيدة وحظ جيد، يمكن أن تتوقع المرأة العاملة بالتالي أن تمتد حياتها المهنية إلى 50 عاماً، من أوائل أو منتصف العشرينات إلى منتصف السبعينات، من المنطقي أن نفترض أنها ستبني مؤهلاتها وتثبت نفسها، على الأقل خلال حياتها المهنية الأولى، بين عمر الـ 22 و الـ 35، وستنجب أطفالا، إذا أرادت، بين الـ 25 والـ 45؛ وستحتاج إلى أقصى قدر من المرونة وتنظيم الوقت في السنوات العشر التي يكون فيها أطفالها في عمر الثمانية إلى الثمانية عشر، ويتعين عليها أن تخطط لتولي وظائف السلطة القصوى المتطلبة بعد أن يغادر أطفالها المنزل. بوسع النساء اللاتي ينجبن في أواخر العشرينات، أن يتوقعن الانغماس التام في حياتهن المهنية في أواخر الأربعينيات، ويتبقى لديهن الوقت الوفير ليصلن إلى السلطة في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات. فالنساء اللاتي يصبحن شريكاً، أو مديراً، أو نائباً أولاً لرئيس، أو يحصلن على تثبيت في وظيفة، أو يؤسسن عيادات طبية، قبل إنجاب أطفال في أواخر الثلاثينات، لابد أن يعدن إلى العمل فيما يخص الوظائف الأكثر تطلباً في نفس العمر تقريباً.
طوال حياتهن المهنية، ينبغي للنساء أن ينظرن إلى الوصول إلى القيادة، ليس كمنحدر صاعد ومستقيم، بل كدرجات سلم غير منتظمة، مع فترات ركودٍ دورية (بل وحتى منخفضات) عندما يرفضن الترقيات لكي يبقين في وظيفة تناسب وضعهن العائلي؛ عندما يتخلين عن الوظائف رفيعة المستوى ويُمضين عاماً أو اثنين في المنزل مع جدول مقلص؛ أو عندما يتنحين عن المسار المهني التقليدي، لشغلُ منصبٍ استشاريٍّ أو عملٍ قائمٍ على مشاريع لعدة سنوات، أحبّ أن أعتبـر فترات الركود هذه على أنها “فواصل للاستثمار”. أمضيت وزوجي إجازة في شنغهاي، من أغسطس/آب 2007 إلى مايو/أيار 2008، في خضم عام انتخابي، حيث كان العديد من أصدقائي ينصحون مرشحين مختلفين بشأن قضايا السياسة الخارجية، اعتبرنا هذه التجربة من جانب كفرصة ” لتوفير المال في بنك الأسرة”، واغتنمنا الفرصة لإمضاء عام تقريباً مع بعضنا البعض في ثقافة أجنبية، لكننا كنا نستثمر أيضاً في قدرة أطفالنا على تعلم اللغة الصينية الشمالية، وفي معرفتنا الخاصة بآسيا.
إن بلوغك الذروة في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، بدلاً من أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات أمر منطقي بشكل خاص بالنسبة للنساء اللاتي يعشن أكثر من الرجال العديد من الأفكار النمطية عن العاملين الأكبر سناً غير مثبتة ببساطة. أظهرت دراسة أجريت عام 2006 من قبل متخصصين في الموارد البشرية أن 23 في المائة فقط يعتقدون أن العمال الأكبر سناً أقل مرونة من العمال الأصغر سناً؛ 11 في المائة فقط يعتقدون أن العمال الأكبر سناً يحتاجون إلى تدريب أكثر من العمال الأصغر سناً؛ و7 في المائة فقط يعتقدون أن العمال الأكبر سناً لديهم قدرة قيادية أقل من العمال الأصغر سناً.
لكن ما إذا كانت النساء سيتمتعن حقاً بالثقة اللازمة، لصعود سلم مهنهن درجة درجة، يعتمد مرة أخرى جزئياً على التصورات. إن إبطاء معدل الترقيات، مع أخذ بعض الوقت للراحة بشكل دوري، اتباع مسار مهني بديل خلال سنوات الوالدية أو سنوات رعاية الوالدين العصيبة، كل ذلك لابد أن يصبح أكثر وضوحاً وأن يكون مقبولاً بشكل ملحوظ، كتوقفٍ مؤقت أكثر من كونه انسحابا. (في إشارة مشجعة، يطرح كتاب Mass Career Customization، من تأليف كاثلين بينكو وآن فايسبرج والصادر عام 2007، فكرة أن “مهن اليوم لم تعد عبارة عن ارتقاء سلم الشركة بشكل مستقيم، بل عبارة عن مزيج من الارتقاءات، والتحركات الجانبية، والانحدارات المخطط لها”، كان هذا الكتاب الأكثر مبيعاً في صحيفة وول ستريت جورنال).
بوسع المؤسسات أيضاً أن تتخذ خطوات ملموسة لتعزيز هذا القبول، على سبيل المثال، في عام 1970، وضعت برينستون سياسة تمديد مدة الخدمة، التي سمحت للأساتذة المساعدين من النساء، اللاتي يتوقعن الإنجاب بتقديم طلب تمديد لمدة سنة واحدة لساعات خدمتهن، وقد امتدت هذه السياسة فيما بعد لتشمل الرجال، ثم توسعت لتشمل حالات التبني. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كشف تقريران عن وضع أعضاء الهيئة التدريسية من الإناث أن نحو 3 في المائة فقط من الأساتذة المساعدين طلبوا تمديد مدة خدمتهم في عام معين، وتظهر ردود على سؤال استطلاعي أن النساء أكثر ميلاً من الرجال إلى الاعتقاد بأن تمديد فترة الخدمة من شأنه أن يُلحق الضرر بالمسار المهني للأستاذ المساعد.
لذا ففي عام 2005، تحت حكم الرئيس شيرلي تيلغمان، غيرت برينستون القاعدة الافتراضية. أعلنت الإدارة أن جميع الأساتذة المساعدين، الإناث والذكور، الذين سيحظون بطفل جديد، سيحصلون تلقائياً على تمديد لمدة سنة واحدة في مدة خدمتهم، دون السماح لهم بالتخلي عنها، بل ويمكن للأساتذة المساعدين أن يطلبوا النظر في مدة خدمتهم في وقت مبكر إذا رغبوا في ذلك، تضاعف عدد الأساتذة المساعدين الذين يحصلون على تمديد مدة الخدمة ثلاث مرات منذ أن طرأ التغيير.
واحدة من أفضل الطرق لتحريك الأعراف الاجتماعية في هذا الاتجاه، هي اختيار قدوات مختلفة، والاحتفاء بهم. أنا وحاكم ولاية نيو جيرسي كريس كريستي متباعدان سياسيًا، لكن ارتفعت مكانته عندي عندما أعلن أن أحد أسباب قراره بعدم الترشح للرئاسة في عام 2012 هو تأثير حملته على أطفاله، بحسب ما ورد فإنه أوضح في حفل خيري في لويزيانا أنه لا يريد الابتعاد عن أطفاله لفترات طويلة من الزمن؛ بحسب مسؤول جمهوري كان في الحفل، قال إن “ابنه [افتقده] بعد أن كان قد رحل لثلاثة أيام، وأنه اضطر لأن يعود” قد لا يحصل على صوتي إذا ما رشح نفسه للرئاسة، لكنه بالتأكيد يحظى بإعجابي (إذا افترضنا أنه لم يلتف وينضم إلى قائمة مرشحي الحزب الجمهوري هذا الخريف).
إن كنا نبحث عن قدوات نسائية بارزة، نستطيع البدء بميشيل أوباما، بدأت السيدة بالسيرة الذاتية نفسها التي بدأ بها زوجها، لكنها اتخذت مراراً، وتكراراً قرارات وظيفية تسمح لها بالقيام بالعمل الذي أحبته، وبأن تكون الأم التي ترغب أن تكونها. انتقلت من شركة قانونية عالية المستوى أولاً إلى حكومة مدينة شيكاغو ثم إلى جامعة شيكاغو قبل أن تنجب بناتها بوقت قصير، وهي الخطوة التي جعلت مكان عملها على بعد 10 دقائق من المنزل فقط، فقد تحدثت علناً في كثير من الأحيان عن مخاوفها الداخلية من أن يكون دخول زوجها عالم السياسة أمراً سيئاً بالنسبة لحياتهم الأسرية، وعن عزمها على الحد من مشاركتها في الحملة الانتخابية الرئاسية لكي تمضي المزيد من الوقت في المنزل، حتى كسيدة أولى، كانت مصرة على أنها قادرة على موازنة واجباتها الرسمية بالوقت العائلي، ينبغي علينا أن ننظر إليها باعتبارها امرأة عاملة بدوام كامل، لكنها امرأة تأخذ فترة استثمارية واضحة للغاية، يجدر بنا أن نحتفي بها ليس فقط باعتبارها زوجة، وأم ومناصرة لتناول الغذاء الصحي، بل وأيضاً بوصفها امرأة تتمتع بالشجاعة، والحكمة للاستثمار في بناتها عندما كنّ في أشد الحاجة إليها، كما ينبغي أن نتوقع منها مهنة متألقة، بعد مغادرتها البيت الأبيض، وذهاب بناتها إلى الجامعة.
إعادة اكتشاف السعي إلى تحقيق السعادة
أحد أكثر أجزاء رحلتي تعقيدًا ومفاجئة خارج واشنط، هو إدراكي لما كنت أريده حقًا، لقد أتيحت لي الفرصة للبقاء في العمل، وكان من الممكن أن أحاول التوصل إلى ترتيب يسمح لي بقضاء المزيد من الوقت في المنزل، ربما كنت قادرة على حمل أسرتي على الانضمام إلي في واشنطن لمدة عام؛ وربما كنت قادرة على تثبيت تكنولوجيا سرية في بيتي، كما فعل جيم شتاينبرغ؛ ربما كنتُ قادرة على السفر أربعة أيام فقط في الأسبوع بدلاً من خمسة أيام. (رغم أن هذا التغيير الأخير كان ليظل يمنحني وقتاً قليلاً للغاية في المنزل، نظراً لضغط وظيفتي، ربما كان ليجعلني قادرة على الاستمرار بالعمل لمدة عام أو عامين). لكنني أدركت أنني لم أكن بحاجة إلى العودة إلى الديار فقط. في أعماقي، أردت العودة إلى المنزل، كنت أريد أن أقضي بعض الوقت مع أطفالي في السنوات القليلة الأخيرة التي ربما يعيشونها في المنزل، وهي سنوات مهمة جداً لنموهم إلى بالغين مسؤولين، ومنتجين، وسعداء، وعطوفين. لكن هي أيضاً سنوات لا يمكن تعويضها بالنسبة لي لأستمتع بمتع الأبوة البسيطة؛ ألعاب البيسبول، حفلات البيانو، وجبات إفطار الوافل، والرحلات العائلية، والطقوس الحمقاء. يُبلي ابني الأكبر سناً بلاءً حسناً هذه الأيام، لكن حتى عندما يعطينا وقتاً عصيباً، كما يفعل كل المراهقين، فإن كوننا في البيت لِبلْورة اختياراته، ومساعدته في اتخاذ قرارات جيدة، أمر مُرضٍ للغاية.
الجانب الآخر من إدراكي لهذه الحقيقة، يكمن في تأملات ماكو وروبين حول أهمية الجمع بين الأجزاء المختلفة من حياتهن كنساء في الثلاثين من العمر:
إذا لم نبدأ في تعلم كيفية دمج حياتنا الشخصية، والاجتماعية، والمهنية، فإننا على بعد خمسة أعوام تقريباً من التحول إلى امرأة غاضبة، تجلس على مكتب خشبِ الماهوجني وتشكك في أخلاقيات العمل لدى موظفيها بعد 12 ساعة عمل، في كل يوم عمل، قبل أن تتوجه إلى المنزل لتتناول لحم الخنزير في شقتها وحيدة.
لقد أسهمت النساء في تكوين صنم الحياة أحادية البعد، ولو بحكم الضرورة. إن الجيل الرائد من الحركات النسوية كن يحجبن حياتهن الشخصية عن شخصياتهن المهنية ليضمنّ عدم تعرضهن للتمييز أبداً بسبب افتقارهن إلى الالتزام بعملهن. عندما كنت طالبة قانون في ثمانينات القرن العشرين، أخبرتني العديد من النساء اللاتي كن يصعدن آنذاك التسلسل الهرمي القانوني في شركات نيويورك، أنهن لم يعترفن قط بأخذ إجازة للذهاب بطفل إلى الطبيب، أو لحضور حفل مدرسي، ولكنهن اخترعن بدلاً من ذلك أعذاراً أكثر حيادية.
بيد أن في يومنا هذا، يمكن للنساء في السلطة، بل وينبغي عليهن، أن يغيرن هذه البيئة، رغم أن التغيير ليس سهلاً. عندما أصبحت عميداً لكلية وودرو ويلسون في عام 2002، قررتُ أن إحدى مزايا العمل كامرأة في السلطة، هي أنني أستطيع أن أساعد في تغيير الأعراف من خلال التحدث عمداً عن أطفالي، ورغبتي في الحياة المتوازنة. وهكذا، فإنني أنهي اجتماعات أعضاء هيئة التدريس في الساعة السادسة مساء بقولي أنني مضطرة إلى الذهاب إلى البيت لتناول العشاء؛ كما أوضح لجميع المنظمات الطلابية أنني لن آتي لتناول العشاء معها، لأنني كنت بحاجة إلى أن أكون في البيت من السادسة إلى الثامنة، ولكني على استعداد للعودة بعد الثامنة لحضور اجتماع في كثير من الأحيان. كما أخبرت اللجنة الاستشارية، أن العميد المساعد سوف يترأس الجلسة التالية حتى أتمكن من الذهاب إلى اجتماع المعلمين بالآباء.
بعد بضعة أشهر من ذلك، أتت عدة أستاذات مساعدات إلى مكتبي، وكن منزعجات إلى حد كبير. فقالت إحداهن: “يتعين عليك أن تتوقفي عن التحدث عن أطفالك.” “أنت لا تظهرين الوقار الذي يتوقعه الناس من عميد الكلية، مما يلحق بك ضررا، لأنك أول عميد امرأة للكلية”. قلت لهم إنني أقوم بذلك عمداً وواصلت فعل ذلك، ولكن من المثير للاهتمام ألا تبدو الوالدية والوقار على أنهما ينسجمان معاً.
بعد عشر سنوات، كلما تم تقديمي في محاضرة، أو أي خطاب، أصرّ على أن يشير الشخص الذي سيقدمني إلى أني أم لطفلين. يبدو غريباً بالنسبة لي أن أعدد الشهادات، والجوائز، والمناصب، والاهتمامات، وألا أضع في قائمة أبعاد حياتي الأمر الأكبر أهمية بالنسبة لي، والذي يستحوذ على فترة طويلة من وقتي. كما قالت وزيرة الخارجية كلينتون ذات يوم في مقابلة تلفزيونية أُجريت معها في بكين، عندما سألها المحاور عن حفلة زفاف ابنتها تشيلسي القادم: “هذه هي حياتي الحقيقية” لكنني ألاحظ أن المقدّمين الذكور لا يشعرون بالراحة عادة عندما أطلب منهم ذلك. كثيراً ما يقولون أموراً مثل “وطلبت مني بشكل خاص أن أذكر أن لديها ولدان” ــ وبذلك يلفتون النظر إلى الطبيعة غير العادية لطلبي، بينما يكون كل غرضي من ذلك هو جعل الإشارات الأسرية روتينية، وعادية في الحياة المهنية.
هذا لا يعني أنه يجب أن تُصر على أن يقضي زملاؤك وقتاً وهم يترنمون بصور طفلك، أو يستمعون إلى الإنجازات الرائعة لطفلك في الحضانة. إنما يعني أنك إذا تأخرتِ في الحضور في أحد الأسابيع، لأنه دورك في توصيل الأطفال إلى المدرسة، أن تكوني صادقة فيما كنت تفعلينه. الواقع أن شيريل ساندبيرج لم تعترف مؤخراً فقط بأنها تغادر العمل في الخامسة والنصف لتناول العشاء مع أسرتها، بل اعترفت أيضاً بأنها لم تجرؤ لسنوات عديدة على الإقرار بذلك، بالرغم من أنها سوف تعوض بطبيعة الحال وقت العمل في وقت لاحق من المساء. إن استعدادها للتكلّم عن الأمر الآن، يشكل خطوة راسخة في الاتجاه الصحيح.
إن السعي إلى تحقيق حياة أكثر توازناً ليست قضية خاصة بالمرأة؛ بل إن التوازن سيكون أفضل بالنسبة لنا جميعاً. تقول بروني وار، وهي مدونة أسترالية عملت لسنوات في مجال الرعاية المسكنة ومؤلفة كتاب The Top 2011 Five Regrets of the Dying، إن كلمات الندم التي كثيراً ما سمعتها كانت “أتمنى لو أنني تحليت بالشجاعة لكي أعيش حياة صادقة مع نفسي، وليس حياة كما يتوقعها الآخرون.” أما ثاني أكثر ندم شيوعاً فكان: “أتمنى لو أنني لم أعمل بجهد.” تكتب: “سمعت هذا من كل رجل مريضٍ كنت قد قمت برعايته، فقد افتقدوا أطفالهم وهم شباب وفي صحبة شركائهم”. تقول جولييت كاييم التي غادرت وزارة الأمن الداخلي منذ عدة سنوات بعد أن ترك زوجها ديفد بارون منصباً مرموقاً في وزارة العدل، أن قرارهم المشترك بمغادرة واشنطن والعودة إلى بوسطن، كان نابعاً عن رغبتهم في العمل على “مشروع السعادة”، وهو قضاء وقتٍ جيدٍ مع أطفالهم الثلاثة. (كانت تقترض المصطلح من صديقتها جريتشن روبين، التي كتبت كتاباً من الكتب الأكثر مبيعاً وتدير الآن مدونة تحمل هذا الاسم).
لقد حان الوقت لتبني مشروع السعادة الوطني. كابنة مدينة شارلوتسفيل، فرجينيا، موطن توماس جيفرسون والجامعة التي أسسها، نشأتُ وإعلان الاستقلال يجري في دمي. عندما قرأتُ الأمر آخر مرة، وجدت أنه لم يعلن عن استقلال أميركا باسم الحياة والحرية والنجاح المهني. فلنُعِد اكتشاف السعي وراء سعادتنا، ولنبدأ من المنزل.
ولاية الابتكار
بينما أكتب هذا المقال، أستطيع سماع رد فعل بعض القراء إزاء العديد من المقترحات الواردة في هذا المقال: فمن الجيد أن يكتب أستاذ مثبت عن ساعات عمل مرنة، وفواصل زمنية للاستثمار، وعن إدارة تحت شعار العائلة أولاً. لكن ماذا عن العالم الحقيقي؟ لا تستطيع أغلب النساء الأمريكيات أن يطالبن بهذه الأمور، وخاصة في ظل اقتصاد سيء، ولا يملك أرباب عملهن إلا أقل القليل من الحوافز لمنحهن إياها طواعية. الواقع أن أكثر ردة فعل أتلقاها عند طرح هذه الأفكار، هي أنه عندما يكون الخيار، هو توظيف رجل يعمل كلما وحيثما لزم الأمر، أو امرأة تحتاج إلى المزيد من المرونة، فإن اختيار الرجل سوف يضيف المزيد من المنفعة إلى الشركة.
في الواقع، في حين أن العديد من هذه القضايا يصعب تقديرها وقياسها بدقة، يبدو أن الإحصائيات تروي قصة مختلفة، تشير دراسة مهمة لـ 527 شركة أمريكية، نُشرت في مجلة Academy of Management Journal عام 2000، إلى أن “المنظمات ذات سياسات شاملة لتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل تتمتع بأداء أعلى على مستوى الشركة” بين أقرانها في نفس المجال. هذه النتائج تتوافق مع دراسة لعام 2003 أجرتها ميشيل آرثر في جامعة نيو مكسيكو. عند فحص 130 إعلانًا عن سياسات صديقة للأسرة في صحيفة وول ستريت جورنال، وجد آرثر أن الإعلانات وحدها، حسنت من أسعار الأسهم بشكل كبير. في عام 2011، أظهرت دراسة حول المرونة في مكان العمل من قبل إلين غالينسكي وكيلي ساكاي وتايلر ويجتون من معهد الأُسرة والعمل، أن زيادة المرونة ترتبط بشكل إيجابي بالمشاركة في العمل، والرضا الوظيفي، ورفع الروح المعنوية للموظف، وصحة الموظف.
هذه مجرد عينة صغيرة من دراسات كثيرة، ومتزايدة، تحاول أن تتحقق من العلاقة بين السياسات الصديقة للأسرة، والأداء الاقتصادي. خلص علماء آخرون، إلى أن السياسات الأسرية الجيدة، تجتذب مواهب أفضل، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية، لكن السياسات ذاتها لا تؤثر على الإنتاجية، يزعم آخرون أن النتائج المنسوبة إلى هذه السياسات، هي في واقع الأمر تابعة إلى الإدارة الجيدة بشكل عام، لكن من الواضح أن العديد من الشركات التي توظف، وتدرب نساء مهنيات، متعلمات جيداً، تدرك أنه عندما تترك المرأة العمل بسبب التوازن السيئ بين العمل، والأسرة، فإن الشركة تخسر المال، والوقت الذي استثمرته فيها.
حتى قطاع القانون، الذي بني على أساس الساعة القابلة للفوترة، يعي ذلك. تترأس ديبورا إبشتاين هنري، متقاضي سابقة في شركة كبيرة، شركة Flex—Time Lawyers، وهي شركة استشارية وطنية تركز جزئياً على استراتيجيات استبقاء محامين إناث. في كتابها Law and Reorder، الذي نشرته نقابة المحامين الأمريكية في عام 2010، تصف مهنة المحاماة “حيث لم تعد الساعة القابلة للفوترة تجدي نفعاً”؛ حيث يتفق المحامون، والقضاة، والموظفون، والأكاديميون جميعهم على أن نظام التعويض هذا قد أفسد المهنة، مما أدى إلى ساعات عملِ قاسية، وعدم كفاءة هائلة، وتكاليف مبالغ فيها للغاية. الجواب الذي يتم اعتماده بالفعل في زوايا مختلفة من المجال؛ هو مزيج من هياكل أتعاب البديلة، وشركات افتراضية، وشركات تملكها نساء، ونقل وظائف قانونية منفصلة، إلى ولايات قضائية أخرى. تدافع النساء، ومحاميات من الجيل إكس والجيل واي بشكل عام، عن هذه التغييرات من جانب العرض. بينما يشد العملاء المصممون على تخفيض الرسوم القانونية، وزيادة الخدمة المرنة من جانب الطلب، ببطء، يحدث التغيير.
في صميم كل هذا، هناك مصلحة ذاتية. إن خسارة نساء ذكيات، ومتحمسات لا تقلص مخزون المواهب لدى أي شركة فحسب؛ بل إنها تحد أيضاً من العائد على استثماراتها في التدريب والتوجيه.
في محاولةٍ لمعالجة هذه القضايا، تكتشف بعض الشركات أن طرق عمل النساء قد تكون مجرد طرق أفضل للعمل، سواء بالنسبة للموظفين أو الزبائن.
يؤكد خبراء الإبداع والابتكار على قيمة تشجيع التفكير غير المحدود، وغرس العشوائية من خلال المشي لمسافات طويلة، أو النظر إلى بيئتك من زوايا غير معتادة.
في كتابهما الجديد A New Culture of Learning: Cultivating the Imagination for a World of Constant Change، يكتب لنا معلما الإبداع جون سيلي براون، ودوغلاس توماس: “نعتقد أن الربط بين اللعب والخيال، قد يكون الخطوة الوحيدة الأكثر أهمية في إطلاق العنان لثقافة التعلم الجديدة.”
إن المجال المتاح للعب والخيال، هو على وجه التحديد ما نحصل عليه عندما تصبح جداول العمل الجامدة، والتسلسلات الوظيفية أقل صرامة، يتعين على المشككين أن يفكروا في “تأثير كاليفورنيا.” إن كاليفورنيا هي مهد الابتكار الأمريكي في التكنولوجيا، والترفيه، والرياضة، والطعام، وأنماط الحياة. هي أيضاً المكان حيث يأخذ الناس أوقات الفراغ على محمل الجد، كما يأخذون العمل؛ حيث تشجع شركات مثل جوجل اللعب عمداً، بالاستعانة بطاولات تنس الطاولة، وسيارات خفيفة، والسياسات التي تلزم الموظفين بقضاء يوم واحد في الأسبوع في العمل على أي شيء يرغبون فيه. كتب تشارلز بودلير: “إن العبقرية ليست أقل ولا أكثر من استعادة الطفولة عند الرغبة بذلك.” ويبدو أن جوجل أحاطت علماً بذلك.
لن يخطئ أي والد في التمييز بين رعاية الأطفال، والطفولة. رغم ذلك، فإن رؤية العالم جديداً من خلال عيون الطفل قد يكون مصدر تحفيز فعّال، فعندما كتب توماس شيلينج الحائز على جائزة نوبلThe Strategy of Conflict، وهو نص كلاسيكي يطبق نظرية اللعب على الصراعات بين الأمم، كان كثيراً ما يعتمد على رعاية الأطفال في طرح أمثلة عن متى ينجح الردع، أو يفشل. فقد كتب: “قد يكون من الأسهل أن نُعبّر عن الصعوبة الخاصة المتمثلة في سعي -حاكمٍ ما-للتشديد باستخدام التهديدات، عندما نكون حديثي عهد بمحاولة عقيمة، لاستخدام التهديدات لمنع طفل صغير من إلحاق الأذى بكلب، أو كلب صغير من إلحاق الأذى بالطفل.”
الكتب التي قرأتها مع أطفالي، والأفلام السخيفة التي شاهدتها، والألعاب التي لعبتها، والأسئلة التي أجبتها، والأشخاص الذين التقيت بهم أثناء رعاية الأطفال، قد وسّعوا نطاق عالمي. من المسلّمات الأخرى بين دراسات الإبداع أنه كلما ازداد عدد مرات اجتماع الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر مختلفة معاً؛ كلما كان احتمال نشوء أفكار إبداعية أكبر. إن منح العمال القدرة على دمج حياتهم غير المهنية مع عملهم — سواء أمضوا ذلك الوقت في تربية الأطفال أو الركض في سباقات العَدو الرياضة — من شأنه أن يفتح الباب أمام نطاق أوسع بكثير من التأثيرات والأفكار.
انضمام الرجال
لعل النبأ الأكثر تشجيعاً على الإطلاق فيما يتصل بتحقيق ذلك النوع من التغييرات، التي اقترحتها هو أن الرجال ينضمون إلى القضية، تعليقاً على مسودة هذا المقال، كتبت لي مارثا مينو، عميد كلية الحقوق في جامعة هارفارد، أن تغييراً واحداً لاحظته خلال ثلاثين عاماً من تدريس القانون في جامعة هارفارد، هو أن العديد من الشباب اليوم يطرحون أسئلة حول كيفية إدارة التوازن بين العمل، والحياة. كما تؤكد أبحاث منهجية أخرى أجريت على جيل الألفية، أن عدداً أكبر بكثير من الرجال مقارنة بالماضي، يطرحون أسئلة حول كيفية دمج الأبوة الفعالة مع حياتهم المهنية.
إنّ التطلُّعاتِ المجرّدة أسهلُ من المفاوضات الملموسة بالطبع. لم يُواجِه هؤلاء الشباب حتى الآن سؤال ما إذا كانوا مستعدين للتخلي عن هذا المنصب، أو الزمالة المرموقين، أو لرفض الترقية، أو لتأخير أهدافهم المهنية من أجل قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم ودعم مهنة شريكهم.
لكن بمجرّد أن تبدأ ممارسات العمل، وثقافة العمل في التطور، فمن المرجَّح أن تكتسب هذه التغيرات زخمَها الخاص.
كتبت لي كارا أوين، ضابط الخدمة الخارجية البريطاني الذي كان يعمل في لندن من دبلن، عبر بريد إلكتروني:
“أعتقد أن ثقافة العمل المرن بدأت تتغير في الدقيقة التي بدأ بها مجلس الإدارة (الذي كان جميعه من الرجال في ذلك الوقت) في العمل بمرونة؛ حيث بدأ عدد قليل منهم بالعمل يوماً واحداً في الأسبوع من المنزل”.
بطبيعة الحال، أصبح الرجال آباء أكثر مشاركة على مدى العقدين الماضيين، وهو ما يشير أيضاً إلى دعم واسع النطاق للتغيرات الكبيرة، في طريقة إيجادنا للتوازن بين العمل والأسرة. من الجدير بالذكر أن كلّاً من جيمس شتاينبرغ نائب وزير الخارجية، وويليام لين نائب وزير الدفاع، تنحيا عن منصبهما بعد عامين من تولي إدارة أوباما، حتى يتسنى لهما قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهما (حقيقة).
للمضي قدماً، سيكون من حسن عمل المرأة أن تحقق التوازن بين العمل، والأسرة في ضوء القضايا الاجتماعية، والأقتصادية الأشمل، التي تؤثر على كل من المرأة والرجل.
في النهاية، لدينا جيلٌ جديد من الشباب، الذين ربّتهم أمهات عاملات بدوام كامل. لنفترض، كما أفعل مع أبنائي، أنهم سيفهمون “دعم أسرهم” ليعني ما هو أكثر من مجرد كسب المال.
لقد كنت محظوظة إذ عملت مع بعض النساء الاستثنائيات وتم إرشادي من قبلهن. إن مشاهدة هيلاري كلينتون وهي تعمل يجعلني فخورة على نحو لا يصدق؛ لما تتمتع به من ذكاء، وخبرة مهنية، وجاذبية شخصية، وقدرة على قيادة أي جمهور. ينتابني شعور مشابه، عندما أرى صورة كريستين لاغارد على الصفحة الأولى، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، وهي تتحدث بعمق عن بعض أهم القضايا على الساحة العالمية، أو سوزان رايس، السّفير الأمريكيّ لدى الأمم المتحدة، التي تقف بقوة من أجل الشّعب السّوريّ في مجلس الأمن.
تشكل هؤلاء النساء قدوات استثنائية. لو كان لي ابنة، لكنت شجعتها على التطلع إليهن، كما أنني أريد عالماً تكون فيه هؤلاء النساء استثناءيات، ولكن ليس غير عاديات، وأريد أيضاً عالماً، كما تقول ليزا جاكسون: “أن تكوني فيه امرأة قوية، لا ينبغي عليك التخلي عن الأمور التي تكوّنك كامرأة”. هذا يعني الاحترام، والتمكين، والاحتفاء بكل الخيارات المتاحة أمام النساء. في كلمتها في برينستون، قالت جاكسون: “إن تمكينك نفسك لا يعني بالضرورة رفض الأمومة، أو تنحية الجوانب التربوية، أو الأنثوية التي تكوّنك.”
لقد ألقيت خطابًا في جامعة فاسار في نوفمبر الماضي، ووصلت في الوقت المناسب للتجول في الحرم الجامعي في ظهيرة لطيفة من فصل الخريف، إنه مكانٌ مفعمٌ بروح الجماعة والكرم، ومليء بالمقاعد والممرات، والفن الشعبي، والأماكن الهادئة التي تبرعت بها الخريجات، سعياً منهن إلى تشجيع التأمل والاتصال. وأنا أقلب صفحات مجلة الخريجين (فسار أصبحت الآن مختلطة)، أدهشتني كلمات الخريجات القديمة، الذين حيين زميلاتهن بكلمة “Slave” (الكلمة اللاتينية المقابلة لكلمة “مرحبا”) وكتبن تذكارات بارعة مليئة بالإشارات الأدبية. كان ذلك عالمهم، حيث أمضت النساء وقت تعليمهن بخفة؛ وكانت أخبارهن في الأغلب عن إنجازات أطفالهن. ينظر العديد منا إلى ذلك العصر السابق باعتباره الوقت الذي كان لا بأس فيه أن تقول مازحاً أن النساء ذهبن إلى الكلية، للحصول على درجة الماجستير. تخلت العديد من نساء جيلي عن كليات الأخوات السبع الخاصة بالإناث، بمجرد أن أصبحت جامعات رابطة اللبلاب، التي كانت خاصة بالذكور سابقاً، مختلطة. لن أعود أبداً إلى عالم الفصل بين الجنسين، والتمييز المتفشي. لكن حان الوقت الآن لإعادة النظر في افتراض أنه لابد أن تسارع النساء إلى التكيف مع “عالم الرجل” الذي حذرتنا منه أمهاتنا، ومعلماتنا.
أنا أضغط باستمرار على النساء الشابات في فصولي الدراسية، لكي يتكلمن أكثر، يتعين عليهن أن يكتسبن الثقة اللازمة ليثمنّ أفكارهنّ، وأسئلتهنّ، وليعرضوهنّ مباشرة، يوافق زوجي على ذلك، ولكنه يحاول في الواقع حمل الشباب في صفوفه على التصرف بشكل أكثر شبهاً بالنساء، يتكلموا أقل ويستمعوا أكثر. وإذا كانت النساء سيحققن المساواة الحقيقية كقائدات، فيتعين علينا إذاً أن نكفّ عن قبول سلوك الذكور، واختيارات الذكور، باعتبارما هو طبيعي ومثالي.
يجب علينا أن نصر على تغيير السياسات الاجتماعية، وثني المسارات المهنية، لتستوعب اختياراتنا، أيضاً لدينا القدرة على القيام بذلك إذا قررنا، ولدينا العديد من الرجال إلى جانبنا.
سوف ننشئ مجتمعاً أفضل لكل النساء من خلال هذه العملية، قد نحتاج إلى امرأة في البيت الأبيض قبل أن نتمكن من تغيير أوضاع النساء العاملات في الوول مارت، لكن عندما نفعل ذلك، سنتوقف عن الحديث عما إذا كان بوسع النساء أن يجمعن بين الأشياء كلها، سوف نركز بشكل صحيح على الكيفية التي يمكننا بها مساعدة كل الأمريكيين، للحصول على حياة صحية، وسعيدة، ومنتجة، ولتقديرهم الناس الذين يحبون، بقدر ما يسعون إلى نجاح ما.
(*) آن ماري سلوتر هي رئيس مؤسسة أمريكا الجديدة، وتشغل كرسي برت ج. كيرستيتر ’66 كأستاذ السياسة، والشؤون الدولية، بجامعة برينستون. شغلت سابقاً منصب مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، وعميد كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في برنستون.
[1] هي منحة دراسية دولية تتيح لطلبة الدراسات العليا الأجانب الدراسة بجامعة أكسفورد البريطانية. سميت بهذا الاسم نسبة إلى السياسي البريطاني سيسل رودس، وكانت ـ وقت إنشائها ـ أول برنامج موسع للمنح الدراسية الدولية في العالم. وما زال يُنظر لهذه المنحة باعتبارها واحدة من أرفع برامج المنح الدراسية على مستوى العالم. (الـمُراجع)
[2] بطبيعة الحال هذا لن يحل المشكلة، لأن زيادة أعداد النساء في المناصب العليا، هو توسيع لنطاق المأساة، وليس حلا لها، بالإضافة إلى أن عامل الكفاءة في الترشح لهذه الوظائف -لاسيما منصب الرئيس- لن يرحم نساء تريد تربية أطفالهن، ولا يستطيع أن يفي بمتطلبات هذه الوظائف سوى عدد قليل جدا من النساء.