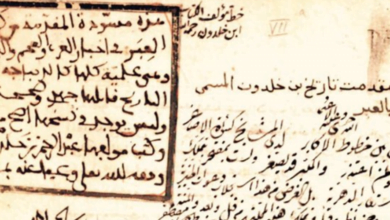- لورنس جروسبرج
- ترجمة: مصطفى هندي
- تحرير: سهام سايح
هذه التعليقات هي باكورة ما أنشرهُ من تأملاتي الفكرية حول بعض الأسئلة المعقدة والمثيرة للجدل التي تتعلق بالتحولات في المجتمع الأمريكي. ولأنّ التفكير هو نشاط عام، فإنّني أقدم أفكاري على أنّها أطروحة مبدئية، تقبل الأخذ والرد. آمل أن تصلوا إلى أنّ الأسئلة التي أطرحها هي أسئلة مهمة، لأنّني أعتقد أنّه من المهم أن نسأل لماذا لا تُطرح هذه الأسئلة في مكان آخر غير مجتمعنا، كما يجب أن نقدم إجابات على هذه الأسئلة نفسها.
اسمحوا لي أن أبدأ بشرح معنى “الحرب” المشار إليها في العنوان. أريد استخدام صورة الحرب للإشارة في وقت واحد إلى حدثين مختلفين ولكنهما مترابطان، ويعملان على مستويات مختلفة من التجريد. أولاً، تشير الحرب إلى التحوُّل الجذري للمجتمع الأمريكي الذي يعتبر السِّمة العامة للربع الأخير من القرن العشرين؛ ذلك التحول -أو بالأحرى تلك الثورة- التي مكنت النيوليبراليين والمحافظين الجدد من العمل معًا في قضية مشتركة بعيدًا عن الأضواء الرسمية. أعتقد أنّها ثورة محتملة على نطاق واسع، وموجة ثانية من الإصلاح العلماني، على حد تعبير عالم الاجتماع زيجمونت باومان.[1] كما يرى الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان الوضع على النحو التالي:
“منذ انتخاب رونالد ريغان، أصرّ المتطرفون اليمينيون على أنّهم بدأوا ثورة في أمريكا؛ وإنهم في ذلك لم يصيبوا كامل الحقيقة. إذا كنا نعني بالثورة تغييرًا جذريا في السياسة والاقتصاد والمجتمع بحيث تتغير شخصية الأمة= فهناك بالفعل ثورة تعتمل في الخفاء؛ لكن لم يكن اليمين الراديكالي هو من قام بهذه الثورة، على الرغم من أنّه بذل قصارى جهده لمساعدتها على الدوام. على كل حال، يمكننا أن نقول أنّ الثورة خلقت اليمين الجديد؛ ولكن مهما كان السبب، فقد أصبح من المُلحّ أن نقدِّر عمق وأهمية هذه الثورة الأمريكية الجديدة، ونحاول إيقافها قبل أن يصبح من المستحيل الرجوع عنها”.[2]
ما يحاول كروغمان لفت الانتباه إليه هو ما حاولتُ إثارته منذ عدة سنوات: لا يمكنك محاربة ما لا تفهمه. هذا هو السبب في أهمية العمل الفكري والتنظير. ولكن، حتى إذا كنت لا تريد محاربته، فأقترح أنّه من الجيد التوقف والتفكير في ما يحدث، لأنّ التاريخ لديه طريقة ماكرة للتحرُّر من نوايانا، وآثار أفعالنا، ونضالاتنا، و حتى مؤامراتنا، حتى تكاد الأحداث لا تشبه ما بيتناه من نوايا. إنّ الثورة الحالية هي نتاج صياغة العديد من الصراعات المتميزة وغير المتجانسة في مجموعة متنوعة من المجالات على مستوى الحياة الاجتماعية؛ والنتيجة هي -على ما أعتقد- تفكيك الموضوع الليبرالي وتفكيك المجتمع الحديث كما عُرف في شمال الأطلسي من خلال الإفصاح عن أشكال الرأسمالية والديمقراطية والمجتمع المدني والدولة القومية والاستعمار والتاريخ. هل هذا ناتج عن نيّة وقصد أي شخص؟ لا أدري، ليس لدي فكرة. هل هناك رؤية واضحة ومشتركة لما وراء الثورة؟ أشك في ذلك. لكنني أعتقد أنّه عبر مجموعة واسعة من المجالات، فإنّ النيوليبراليين والمحافظين الجدد يعملون على افتراض أنّ المشاكل الحالية التي تواجه مجتمعنا هي نتيجة حتمية للتناقضات التي لم تُحل والمُصاحبة لهذا التمفصل الحديث.
الصورة الثانية للحرب هي الصورة التي أريد التركيز عليها هنا. على وجه الخصوص، أود أن أثبت أنّ هناك في الولايات المتحدة اليوم حرب على الشباب، وضد الشباب.[3] أستخدم مصطلح “الشباب” هنا للإشارة إلى كلٍّ من الأطفال والمراهقين، أي الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة (سأقبل التعريف التعسفي داخل ثقافاتنا)، لأنني أعتقد أن كليهما عرضة لهذا الهجوم. سأناقش أنّه: على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي، فإن وضع الشباب في الولايات المتحدة لا يطاق ولا يغتفر، خاصة بالنسبة لأمة يُفترض أنّها “متقدمة”، وفي ظل ما يسمى بالازدهار الاقتصادي. ولكن ليس فقط حقيقة حال الشباب هي ما يجب فحصه، بل أيضًا حقيقة أن هذا الوضع الذي لا يطاق= مقبولٌ، ليس فقط من قبل السياسيين، بل من قبل العامة أيضًا. وهذا يتطلب أن نأخذ في الاعتبار الخطابات المتغيرة التي يُكوِّن بها الشباب عقليته ويدخل من خلالها في تضاعيف الحياة اليومية في مجتمعنا. أريد أن أقترح أنّ الشباب يعامَلون كمواطنين غير شرعيين بشكل متزايد، وأعني بذلك حرمانهم من أي مكانة ذات تأثير في جغرافية الحياة الاجتماعية في الولايات المتحدة (قد يمكّننا هذا من فهم أفضل لكيفية قيام الشاب ببناء جغرافيته الخطابية الخاصة بالحياة اليومية). بالحديث عن الأطفال والشباب، لا أقصد أن أبدو وكأنني أميز هذا المحور على محاور التمييز الأخرى مثل العرقية أو الإثنية أو الجندرية أو الجنسانية؛ صحيحٌ أننا نشهد في كل من هذه المحاور هجمات مكررة من حيث الصياغة والفعالية، إلا أنني أعتقد أن معرفة أن هناك شيئًا جديدًا بشأن الهجوم على الأطفال، وأن ذلك الجديد لم يُتناول إلا بشكل ضئيل سواء في الحياة العامة أو الفكرية= يشير إلى أن هناك مفتاحا ما لفهم الثورة التي تحدث على مستوى أكبر.
سأختتم هذه الورقة بإثارة مسألة العلاقة بين هاتين الثورتين: لماذا تتحول محاولة تغيير المجتمع الأمريكي إلى حرب ضد الشباب أو حتى تتضمنها؟ من أجل القيام بهذه الخطوة -من الحرب الموجهة ضد الشباب إلى الثورة الأوسع- يجب أن أشير بسرعة إلى بعض أجزاء اللغز الأخرى، وبعض جبهات النضال الأخرى، وبعض الحروب الجزئية الأخرى الجارية الآن. على وجه الخصوص، سأربط الحرب ضد الشباب بتغيرين آخرين يحدثان: ما يسمى اختفاء السياسة نفسها، والمركزية المتزايدة لرأس المال والتمويل كأساس للهجوم على قيمة العمالة اليدوية. أدرك أن محاولة توضيح هذه الأحداث معًا قد تبدو بعيدة المنال إلى حد ما، وبالتأكيد ليست واضحة من الناحية التجريبية، وربما لا يجد المرء صعوبة في أن يعتقد أن حجتي مبنية على نظرية المؤامرة إلى حد ما؛ اسمحوا لي أن أعترف في البداية أنني أؤمن بالمؤامرات. (لقد كنت من محبي سلسلة “الملفات X” لفترة طويلة جدًا وذلك لعدم تصديق المؤامرات) ومع ذلك، فإنّ الشيء الذي لم يفهمه كريس كارتر [مخرج السلسلة] أبدًا هو أنّ ما ينقذنا من أي مؤامرة هو أن هناك دائمًا مؤامرات أخرى. قد تعمل المؤامرات مع بعضها البعض، أو ضد بعضها البعض، أو قد تبدو -على الأقل لفترة من الوقت- أنها تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض؛ لكن في النهاية لا يمكن أن تستقل مؤامرة واحدة بالمحصلة. يصنع الناس التاريخ، لكن هذا لا يعني أنهم يسيطرون على التاريخ الذي يصنعونه.
أكرر: أنا لا أدعي أن الحرب على الشباب هي إستراتيجية واعية -أترك السؤال مفتوحًا على الأقل في الوقت الحالي- لكنني أعتقد أنّها جزء فعال من هجوم أكبر على جوهر الحداثة الأطلسية.
على الرغم من القفزة الكبيرة التي قد تنطوي عليها حجتي، أريد أن أضع إطار محاولتي بالاتفاق مع المفكرة الأسترالية وأستاذة الدراسات النسوية والثقافية ميغان موريس، التي اقترحت أن “الأمور الآن حرجة للغاية لدرجة تفرض علينا التخلِّي عن خيالنا”.[4] أريد للإشارة إلى أنه لا توجد طريقة أخرى سوى التخيل لفهم ما يحدث؛ وأريد أن أقترح أنه في النهاية، أن قدرتنا على التخيُّل هي التي على المحك في ظل الصراع السياسي الحالي.
الحرب على الشباب
إذن، ما الذي يحدث؟ ما الحرب التي تشنُّها الولايات المتحدة على الشباب؟ ضع في اعتبارك حالة شباب أمريكا في التسعينيات، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن تكون هذه لحظة “المعجزة الاقتصادية الأمريكية” العظيمة. من المهم أيضًا أن نتذكر أن هذه الحالة موجودة على الرغم من قوة وهيمنة التيّار الممجد لقيم الأسرة على الخطاب السياسي.
لنبدأ بالوضع الاقتصادي؛ إليك هذه الإحصائيات المتعلقة بالشباب (الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) في الولايات المتحدة[5]: 33٪ سيكونون فقراء في مرحلة ما من طفولتهم، و25٪ من جميع الأطفال يولدون فقراء؛ ما يقرب من 20 ٪ من أطفال أمريكا يعيشون حاليا تحت خط الفقر؛ يمكننا مقارنة هذا الرقم على سبيل المثال بنسبة 13.5٪ في كندا، و 2.7٪ في السويد. وتستند هذه الأرقام إلى تعريف الأسرة الفقيرة بأنّها تلك التي لا يتجاوز دخلها 16600 دولار ومكونة من أربعة أفراد. الآن، أي شخص لديه أي خبرة اقتصادية في الولايات المتحدة يدرك أنّ هذه سخافات؛ حتى مكتب التعداد السكاني أعلن مؤخرًا عن رغبته في رفع خط الفقر إلى 19500 دولار. وقد وضع العديد من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع -الذين يعملون على تحديد الأجر المناسب للمعيشة- خط الفقر بين 22000 دولار و 28000 دولار. في هذه المستويات، من الواضح أن معدلات فقر الأطفال المختلفة ستزداد بشكل ملحوظ، وربما تتجاوز 33٪. لك أن تتخيل أن أغنى دولة في العالم يعيش أكثر من ثلث أطفالها تحت خط الفقر. طوال عقد التسعينيات بأكمله، كان معدل فقر الأطفال دائمًا أعلى بنسبة 50 ٪ على الأقل من معدل الفقر لجميع السكان. حاليًا -حتى بمقياس الفقر الحالي- يعيش 10٪ من أطفال أمريكا في فقر مدقع، وهو الذي يُعرف بأنه أقل من نصف مستوى خط الفقر. وإذا كنت تعتقد أن ذلك الرقم يتحسن، فقد زاد هذا العدد في عام 1998 بمقدار 400000. هناك ما يقارب 15٪ من الشباب الأمريكي ليس لديهم تأمين صحي، وبفضل الرئيس السابق كلينتون وإصلاحاته في الرعاية الاجتماعية، أُدرج 207 مليون طفل إلى هذا الرقم منذ عام 1992.[6] ويجب أن تعرف 40٪ من الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر في الولايات المتحدة شباب.
في الواقع، الأطفال تحت سن 18 عام هم الجزء الأسرع نموًا ويشكلون أكبر جزء من المشردين الذين لا مأوى لهم في أمريكا، وذلك بمتوسط عمر 9 سنوات. إذا نظرت إلى الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر -وذلك فقط لمحو أي تصورات مسبقة قد تكون لديك- فإن 60 ٪ منهم بيض، و33 ٪ يعيشون في الضواحي، و 33 ٪ يعيشون في عائلات مع والدين متزوجين، و 66 ٪ يعيشون في أسر حيث يعمل أحد الوالدين على الأقل بدوام كامل. لا أقصد إنكار أن الحرب على الشباب مرتبطة بطرق معقدة بإعادة هيكلة العلاقات العرقية والإثنية في الولايات المتحدة، كما قرر هنري جيرو بقوة. في الواقع –من الناحية الاقتصادية والإحصائية– تأتي الولايات المتحدة في آخر قائمة دول العالم الصناعي المتقدم من حيث الوضع الاقتصادي والصحي للأطفال.
ثانيًا، قد أقترح أنّ الشباب في الولايات المتحدة يعانون مما لا يمكن تسميته سوى بـ “وباء العنف”. معدل وفيات الرضع في الولايات المتحدة أعلى من أي دولة صناعية في العالم. والأهم من ذلك أن 75٪ من جميع وفيات عمليات العنف (بما في ذلك القتل والانتحار والوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية) في العالم الصناعي تقع في الولايات المتحدة. معدل انتحار الأطفال تحت سن 14 هو ضعف معدل بقية دول العالم الصناعي. الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن هذا الوباء هو الذعر الأخلاقي الأخير حيال عنف الشباب والجرائم؛ نسمع في كثير من الأحيان أنّ معدل الجرائم العنيفة بين المراهقين آخذ في الارتفاع، وأن التغطية الإخبارية لعنف الشباب قد زادت بشكل حاد على مدى العقد الماضي؛ على الرغم من أنّه في الواقع كان قد انخفض بشكل كبير لمدة عقد تقريبًا. في الواقع، وفقًا لدراسة حديثة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، انخفض عدد الاعتداءات العنيفة وامتلاك الأسلحة وحتى المعارك البسيطة بين طلاب المدارس الثانوية بشكل كبير في الولايات المتحدة. يمكن للمرء أن يتساءل، بعد هذه النتيجة: بما أنّ وسائل الإعلام والسياسيين سارعوا إلى مهاجمة موسيقى الراب والميتال لأنها تشجع على العنف، ألا نتوقع منهم الآن أن يهنئوا ويشكروا هذه الموسيقى على تراجع العنف؟ نادرًا ما يقال لنا أن الزيادة في معدل الجرائم العنيفة بين الشباب (65٪ منذ 1980) هي في الواقع أقل من الزيادة في معدل الجرائم العنيفة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 35 عامًا، ولكن يبدو أنه لا يوجد ذعر ممن يرتكبون الجرائم في عمر الثلاثين.
ورغم صعوبة الحصول على إحصاءات، إلا أن مقابل كل جريمة عنف وأخرى جنسية يرتكبها شاب دون سن 18، هناك 3 جرائم من هذا القبيل يرتكبها البالغون ضد الشباب. أريد أن أؤكد هذا! ما نقرأ عنه هو عنف الشباب ضد الشباب (الذين أصبحت حادثة مدرسة كولومباين رمزًا لهم)، ولكن في كل حالة يهاجم فيها شاب أو يقتُل شبابًا آخر في هذا البلد، يُهاجَم أو يُقتَل ما يقرب من 3 شباب آخرين من قبل البالغين؛ يرتكب البالغون 75٪ من جرائم قتل الشباب في أمريكا.
أي شخص يستمع إلى خطاب الحرب على المخدرات يعتقد أن الشباب هم الممثل الأول لمتعاطي المخدرات؛ ولكن هناك القليل من الأدلة لدعم مثل هذا الاستنتاج. انظر إلى الذعر المنتشر حول الأمهات المراهقات غير المتزوجات، ومع ذلك لا يبدو أن أي شخص في وسائل الإعلام أو السياسة مهتم بالسؤال عن كيف أصبحت حاملاً؟ هناك في كل عام ما بين 400000 و 500000 شاب مقطوع بكونهم ضحايا الاعتداء الجنسي والعنف من قبل البالغين في أمريكا. 62% من جميع ضحايا الاغتصاب في الولايات المتحدة تحت سن 18 عامًا. هناك بعض الأدلة، على الرغم من أنها متناثرة (لأنه لم يتم جمعها على ما يبدو) تشير إلى أن نسبة عالية جدًا من المراهقات الحوامل هي نتيجة العلاقات الجنسية (سواء كانت طوعًا أو كرهًا) مع ذكر بالغ. المثير للاهتمام هو تلك التغطية القليلة لعنف البالغين ضد الشباب. في الواقع، قام مايك ماليز، في برنامجه The Scapegoat Generation ، بتوثيق اتجاه ملحوظ طوال عقد التسعينيات لتزوير البيانات حول الشباب في وسائل الإعلام.[7] يقول مايك إن معدل الانتحار بين المراهقين مبالغ فيه، لأنه استخدم لإضفاء الشرعية على الميل الجمعي لإلزام المراهقين مستشفيات الطب النفسي بغرض التشخيصات الغامضة إلى حد ما مثل “الاغتراب” بناءً على عاداتهم في الاستماع للموسيقى وعادات اللباس. ويرى أن معدل المواليد السنوي للأمهات غير المتزوجات مبالغ فيه، وذلك لإضفاء الشرعية على الهجوم على الرفاه. وقد تم تضخيم عدد وفيات المراهقين بسبب المخدرات لإثارة المشاعر للحرب عليها.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الافتقار إلى الغضب الذي تثيره هذه الأرقام والحقائق والاتجاهات. يبدو أنّ هذا الافتقار إلى الغضب يتطلب منا أن نتفق مع هنري جيرو على أن “المجتمع الأمريكي ينضح بعداء عميق الجذور ولامبالاة شديدة تجاه الشباب“.[8] كيف نبدأ في مواجهة أو حتى فهم التهمة التي نعيشها في عالم يكره الأطفال؟ لاحظ أنه ليس لدينا حتى كلمة تستطيع أن تعبِّر عن هذه العلاقة.
بدأ العديد من هذه الاتجاهات -بالإضافة إلى الاتجاهات والممارسات الأخرى ذات الصلة- في الثمانينيات: على سبيل المثال؛ خفض ميزانية الحكومة الفيدرالية للتعليم؛ ردود فعل شعبية ضد الضرائب المحلية وقضايا السندات لدعم التعليم (بحيث ننفق على كل طالب أقل بكثير مما كان في العقود السابقة، مع أخذ التضخم في الاعتبار)؛ الخطاب المذعور المندد بفشل التعليم الحكومي؛ تزايد سجن الأطفال على حد سواء في السجون ومؤسسات الصحة العقلية؛ التضييق المُمنهج للحريات المدنية للشباب، والتي اكتسبوا الكثير منها في الستينيات. تتقمص العديد من الجامعات -عمليًا إن لم يكن حرفيا- دور الأب المحافظ، متذرعة بواجبها بإبلاغ الآباء عن سلوك الطلاب؛ والمدارس على جميع المستويات تشارك بشكل متزايد في تنظيم الحياة اليومية للطلاب؛ كما بدأ التعليم العالي ينحصر بشكل متزايد على الطبقات المتوسطة العليا. وعلى الرغم من استجابتنا المذعورة لتزايد النشاط الجنسي للشباب، فقد وقفنا مكتوفي الأيدي لنشاهد التسليع الجنسي للشباب في وسائل الإعلام والشركات. لقد شهدنا -كما أشار العديد من النقاد- عملية تسليع ومتاجرة فظيعة بالشباب، والتي من رأيي أنّها لا تغتفر. في الواقع، من المدهش أن الولايات المتحدة –نحن– نبيع –أو ربما بعنا بالفعل– أطفالنا لأصحاب الإعلانات، والأعمال الخاصة؛ لقد بعناهم لرأسمالية الشركات.
لقد بدأت هذه الاتجاهات في الثمانينيات، لكنني أعتقد أنها اتخذت منعطفًا أسخف وأحلك في التسعينيات. نظرًا لأن المنح الدراسية والتعليم الحكومي قد أفسح المجال لقروض الطلاب، فإننا ننتج جيلًا من الأشخاص المكبلين بالديون. في معظم الولايات في الولايات المتحدة، في سن 16 اليوم، لا يمكنك أن تخطو خطوة -ولو صغيرة- بدون إذن والديك. لا يمكنك الحصول على وشم، ولا يمكنك شراء السجائر. في الواقع، لا يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الذهاب إلى مول أمريكا في مينيسوتا (أكبر مركز تسوق في البلاد) بعد الساعة 6 مساءً يوم الجمعة أو السبت بدون أحد الوالدين؛ ولكن في نفس السن، يمكن أن تتم محاكمتك وسجنك تمامًا كما لو كنت بالغًا، وهناك المزيد والمزيد من الأطفال الذين تعرضوا للمحاكمات والسجن. وفي عدد متزايد من الدول، يمكن أن تصل العقوبة إلى القتل. فكر في ذلك: لا يمكنك الحصول على وشم، لكن يمكن أن تُقتل.
على نحو متزايد، صارت كل لحظة من حياة الشباب تحت منظار الاحتراس والانضباط. أصبحت المراقبة الشاملة المستمرة هي القالب التأديبي المُرحَّب به للشباب. تفرض المدارس بشكل متزايد لوائح حول كل جانب من جوانب الحياة اليومية للأطفال، وخياراتهم الثقافية والاستهلاكية، وهوياتهم وعلاقاتهم. تنظم المدارس لون الشعر، وتفرض قواعد اللباس. حظرت مدارس إحدى المقاطعات أشرطة الذراع السوداء؛ كما دعت AMA والجمعية الأمريكية لطب الأطفال الأطباء وأولياء الأمور لمراقبة معروضات وسائل الإعلام الخاصة بالأطفال وأثرها عليهم، كما لو كانت هذه المؤثرات بطريقة ما يمكن ربطها بشكل موثوق بعلم النفس والسلوك.[9] على الرغم من حقيقة أننا نعلم أن مثل هذه الارتباطات غير موثوق بها، إلا أنه يبدو أن المحاكم مستعدة بشكل متزايد لقبول مثل هذه الأدلة، خاصة بالنسبة لإجراءات الالتزام القضائي. إذا كنت تحب الموسيقى الخطأ، فهذا بحد ذاته دليل على أنك بحاجة إلى الحبس. فرضت المزيد والمزيد من المدارس اختبار تعاطي المخدرات عشوائيًا وإجباريًا. وبعض المدارس -كوسيلة للتغلب على القيود القليلة المتبقية في المحكمة على هذا الاختبار- تختبر بصيلات الشعر، على الرغم من حقيقة أن خبراء المخدرات يتفقون بالإجماع على أنه غير موثوق به. في عام 1999، استبعدت المدرسة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في ولاية بنسلفانيا عندما قالت في الفصل -بعد مذبحة كولومباين- إنها تفهم كيف لشخص ما قد تعرض للمضايقات والتعذيب بلا رحمة أن يرتكب هذه الجرائم. وحُكم على صبي في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا بالسجن لمدة ثلاثة أيام بسبب أنه كتب على حواسيب مدرسته: “النهاية قريبة”. من المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة الشرعية المتزايدة لمظاهرات نفاد صبر الجمهور من الأطفال وحتى إعلان العداء تجاههم، ليس فقط من قبل الأفراد، بل من خلال الصناعات الخدمية أيضًا.
أو انظر إلى حالة الذعر الأخيرة من لعبة البوكيمون. على ما يبدو، حظرت عدد من المناطق التعليمية بطاقات البوكيمون من المدارس. المثير للاهتمام حقًا هي أسباب هذا الحظر.[10] ليس المبرر أن لعبة البوكيمون تسبب سلوكًا عنيفًا (على الرغم من أن البطاقات التجارية قد أدت على ما يبدو إلى بعض المعارك)؛ بدلاً من ذلك، يبدو أن الحجتين الرئيسيتين أنها تسلية ممتعة، أو أنها تجارية. لذا يقول أحد مديري ولاية ويسكونسن: “من توصل إلى هذه الإستراتيجية التسويقية هو عبقري؛ تلك الإثارة، وذلك الانتشار عبقري حقًا. أتمنى أن يركز الأطفال على الرياضيات” هو أو هي حظرت اللعبة لأنها إلهاء؛ أو -بعبارة أخرى- لأنها ممتعة، أو تُلعب بكثرة. لطالما كان لدى الأطفال بدعهم، وألعابهم، ومقتنياتهم، التي أحضروها إلى المدرسة لعرضها واللعب بها، سواء كانت قبعات ديفي كروكت أو أطواق هولا أو بطاقات البيسبول. ولكن الآن، على ما يبدو، يجب تنظيم مثل هذه الانحرافات وضبطها. لكن المبرر الذي قدمه مدير المدرسة في ماساتشوستس أكثر إزعاجًا ونفاقًا: “البعد المالي هو ما يميز جنون الأطفال بلعبة البوكيمون عن جنونهم باليويو أو حتى بيني بابيز”. يظهر النفاق من حقيقة أن هذا المشرف نفسه وافق على صفقة تمنح كوكا كولا السيطرة الحصرية على سوق المشروبات الغازية والسماح بآلات البيع في المدارس؛ من الذي تاجر ببيئة الأطفال مثل لعبة بوكيمون؟ ومن الذي قام بتسليع الحياة اليومية للأطفال حتى في مجال التعليم؟.
السؤال هو ما الذي تغيّر بين الثمانينيات والتسعينيات؟ يأخذنا الجواب إلى عوالم الجيل والثقافة. في الثمانينيات، كانت مناقشات الشباب -من حيث أنهم شغلوا اهتمام الجمهور- إلى حد كبير مناقشات حول الجيل X. هذا الجيل صغير نسبيًا، حيث يبلغ إجمالي عدد السكان 55 مليون نسمة؛ لكن عندما أصبح هذا الجيل موضوع التدقيق الإعلامي، تم تحديد عشرين سمة في هذا الجيل. بشكل عام، وُصف الجيل X بأنه كسول، ممل، وغير متحمس، ويشعرون أنّهم يستحقون كل شيء، وأنهم كثيرو التذمر، ويرغبون في الحصول على الترفيه بدلاً من التعليم، وأنهم محافظون بشكل متزايد. كل هذا وُضع بوضوح في مقابل أطفال جيل طفرة المواليد، هؤلاء الجيدون، الذين وطنوا أنفسهم على أنهم كانوا متطرفين إلى حد ما في شبابهم وتعقَّلوا في مرحلة البلوغ.
كان الخطاب الرئيسي الآخر حول الطفولة والشباب جزءًا من ثقافة عامة نشطة (وأحيانًا شعبية) كانت تنظر إلى الشباب وتعاملهم على أنهم “أبرياء”. بداية من أفلام ستيفن سبيلبرغ وانتهاء بمجلس الآباء لمراقبة موسيقى الأطفال(PMRC)، كانت الطفولة دائمًا تواجه خطر الإتلاف -وربما الاختفاء- إما نتيجة الثقافة الشعبية أو تدهور الأسرة (ولكن -بالطبع- ليس بسبب البالغين أو الرأسمالية!). استمر هذا الخطاب في التسعينيات، حتى وصل الأمر إلى توطينه وتلقينه للشباب، وذلك للقضاء على أي إحساس بفعاليته وإمكانياته. على سبيل المثال، وفقًا لمقال نشر في USA Today في عام 1998 تحت عنوان “الكفاح من أجل تربية أطفال جيدين في أوقات عصيبة”[11] صرح 9 من أصل 10 أمريكيين أنه من الصعب تربية الأطفال ليكونوا أناسًا طيبين في هذه الأيام، والأمر قد أصبح أصعب مما كان عليه قبل 20 عامًا. ويقول 2 من كل 3 أمريكيين إن الآباء يقومون بعمل سيء تجاه أطفالهم. يلقي كاتبو المقال باللائمة على شيء يسمونه “الثقافة السامة”، والتي يبدو أنها تشير إلى الوجود المتزايد لأجهزة الكمبيوتر والإعلانات والتسويق التجاري وما إلى ذلك في حياة الأطفال، مع عدم مناقشة من أين تأتي هذه الأشياء. وبالمثل، فإنّ تقرير عام 1999 للجنة القضائية المعنية بالأطفال والعنف ووسائل الإعلام (برئاسة أورين هاتش)[12] يدعي أن التليفزيون وحده مسؤول عن 10٪ من عنف الشباب؛ ليس لدي أي فكرة كيف يمكن لأي شخص أن يطرح تلك الفكرة، لكنني أفترض -إذا كان صحيحًا- فليس هناك سوى الكتاب المقدس الذي يمكن أن يتحمل الـ 90 ٪ المتبقية. وفقًا للتقرير، “يظهر البحث الحالي دون شك أن هناك علاقة بين العنف في وسائل الإعلام وعنف الشباب؛ ويستشهد التقرير بخبير مجهول -ويجب على المرء أن يحذر دائما عند تقديم ادعاءات استنادًا إلى خبير مجهول الاسم- يدعي أن “معارضة هذه العلاقة، يشبه إنكار الجاذبية” لذا فإن هؤلاء الـ “خبراء” في العنف الإعلامي سيقولون أن الأدلة بالتأكيد تقول أننا حمقى بشكل قاطع، فقط لأننا ننكر أمرًا هو في بداهة الجاذبية. وبالطبع، يكرر التقرير الادعاء بأن تفضيل موسيقى الميتال هو “علامة مهمة على الاغتراب، وتعاطي المخدرات، والاضطرابات النفسية، ومؤشر للانتحار، والصور النمطية لدور الجنس، والسلوكيات المنحرفة الأخرى لدى المراهقين”.
أريد أن أدلي بتصريحين حول خطابات الشباب في الثمانينيات. أولاً، كانت كلتا الخطتين الرئيسيتين من الجدل حول الشباب (الجيلX، والشباب الأبرياء في خطر) من الحجج الثقافية المساعدة على التوطين الاجتماعي “المناسب” للشباب، والطريقة المناسبة ليكونوا شبابًا. وبالتالي، كان يُنظر إلى المسافة بين هذين التيارين -من الناحية الثقافية- كحجة مؤيدة لتوطين ثقافة معينة وتنظيم الاستهلاك الثقافي. فمن ناحية، ما كان على المحك هو هذا المشروع الذي نسقه إلى حد كبير المحافظون الجدد لإنقاذ النسيج الأخلاقي للأمة؛ لقد كانت محاولة للتراجع -تحت مسمى الطفولة البريئة- عن التغييرات التي حدثت في المجتمع الأمريكي منذ الستينيات من القرن الماضي، والتغيرات التي ارتبطت بحركة الحقوق المدنية، والنسوية، وتحرير المثليين، والمخدرات، والثقافة الشعبية…إلخ. ومن ناحية أخرى، كانت محاولة للاحتفال بالتمرُّد الشبابي في الستينيات، مع إضفاء الشرعية على تخلي الأجيال عن تلك المثل العليا في الثمانينيات.
ثانيًا، في كتاب سابق عن الولايات المتحدة في الثمانينيات، كتبتُ:
“أصبح الشباب نفسه ساحة معركة يقاتل فيها الجيل الحالي من المراهقين -من جيل طفرة المواليد- ضد الآباء والأمهات والمصالح الإعلامية للشركات الساعية للسيطرة على عقولهم وقدراتهم وأفكارهم؛ إنّهم يكافحون من أجل التعبير عن تجاربهم وهوياتهم وممارساتهم وخطاباتهم وسماتهم الاجتماعية المختلفة. ضم طيف الشباب مجموعة متشظِّية ومتناقضة في كثير من الأحيان من التكوينات الاجتماعية، لا يتم تحديدها فقط من خلال انتشار أجيال ما بعد الحرب، ولكن أيضًا من خلال توهين العلاقة بين العمر والشباب لصالح الشباب، باعتباره هوية مؤثرة في تاريخ الأجيال. الشباب اليوم عالقون في تناقض بين أولئك الذين يعانون من عجزهم نتيجة سنهم… وأجيال من طفرة المواليد الذين ربطوا مصطلح “الشباب” بمسار حياتهم، من خلال إعادة تعريفه على أنه تصرف (أنت عجوز فقط بمقدار ما تشعر بذلك). بالنسبة لجيل طفرة المواليد، فإنّ الشباب شيء يجب الحفاظ عليه بالجهد الثقافي والبدني”.[13]
أي أنّه في ثمانينيات القرن العشرين، كان جيل طفرة المواليد -وهو جيل نشأ على أن يعرف نفسه من خلال شبابه- يكافح من أجل التمسك بشعوره بأنه جيل “شاب”. على الرغم من حقيقة أن معنى الشباب -كما تم تعريفه- هو حقيقة أنه ليس عليك أن تبذل جهدًا كي تبقى شابًا، إلا أن جيلاً كاملاً قد كرس نفسه للعمل الجسدي والثقافي والنفسي فقط لتحقيق ذلك. هذا جعل الصراع بين الأجيال أمرًا لا مفر منه تقريبًا، حيث حاول جيل طفرة المواليد ترسيخ ثقافة شبابهم على أنّها تعريف الشباب -بالألف واللام. وبالتالي، تم الحكم على الجيلX باستمرار -ليس فقط على أنه قديم- بل الأهم من ذلك أنه لا يلائم الشباب. وبالتالي، كانت هناك تصريحات مستمرة ضد الجيلX من الأعضاء الذين كانوا كبارًا قبل وقتهم، وأنهم كانوا مملين، دون أي شعور بالرغبة في التغيير، أو شغف المقاومة.
لكن هذا الصراع على من أحق بالشباب انتهى في مكان ما في التسعينيات، وقد ضاع جيل طفرة المواليد بمعنى ما. يواجه جيل طفرة المواليد الآن تهمة “شيخوخة أمريكا”. وبالتالي، لم يكتسب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أهمية عامة وسياسية غير مسبوقة فحسب، بل تمّ تحدِّي العديد من الممارسات القياسية لهذه البرامج (بما في ذلك كيفية تمويلها وعلاقتها باحتياجات الميزانية الأخرى) لصالح جيل طفرة المواليد. يمكن للمرء أن يقول أنه على الرغم من أنهم خسروا المعركة على الشباب، إلا أنه يبدو أن هذا الجيل قد فاز في معركة الحفاظ على هيمنتهم الاجتماعية. ومع ذلك، لا أعتقد أن جيل طفرة المواليد قد تعافوا من خسائرهم؛ فهم على الأقل، قد أصبحوا طرفًا (إن لم يصبحوا خصمًا لدودًا) فيما وصفته بالحرب ضد الشباب.
بعد هذا، لا أريد اختزال هذه الحرب إلى ادعاء تافه بأننا نشهد “حالة ذعر” طبيعية من الشباب نتيجة للشيخوخة المتوسطة بين جيل طفرة المواليد. في تلك المناسبات النادرة عندما يجد المرء تعليقات على حالة الشباب، من المحبط بشكل خاص إدراك مدى سهولة ادعاء شخص ما أن “ما هو محبط في ’الحملة الصليبية’ الحالية للسيطرة على المراهقين هو أنها موجهة للمراهقين بشكل خاص. إن ضوضاء القلق حيال الشباب الضال مليئة بالحيوية الدفاعية والتناقض الذي يتسبب في تشوش الذهن، كما يفتقر هذا الخطاب إلى الواقعية بشكل لافت للنظر”[14] لا أعتقد أن الأمر كان مقصورًا على الأطفال الذين عانوا من عواقب ذلك الخطاب. إنني أرفض مثل هذه الإحالة إلى علم النفس المادي للشيخوخة البيولوجية -ليس فقط لأنه يسخر من الحرب- ولكن أيضًا لأنني أحجم عن إلقاء اللوم على جيل طفرة المواليد مباشرة، أو افتراض أنهم العوامل الأساسية المسؤولة عن الحرب. القول بأنهم غالبًا ما اتفقوا معها، أو حتى أن بعض الكسور ساعدت في منحها الشكل والواقع، لا يمكّننا من تحديد قصدهم أو توجيه اللوم لهم. لا أعتقد أن الحرب ضد الشباب هي مشروع دشنه جيل طفرة المواليد. بدلاً من ذلك، أعتقد أنها مسألة كيف يتم التعبير عن بعض الميول والالتزامات والاهتمامات للجيل والمشاريع والتوجهات الاجتماعية الأكبر. أي أنه لا يزال يتعيّن علينا الاستمرار في التساؤل عن ماهية المشروع والغرض الذي يخدمه.
قبل أن نتمكن من معالجة مثل هذه الأسئلة، أحتاج إلى تقديم لمحة على الأقل عن التغييرات التي دعت إلى الحرب على الشباب. على وجه الخصوص، أريد تحديد تغييرين طرءا على موضوع وخطاب الهجوم. لقد تغير هدف الهجوم، ومن هذه الناحية على الأقل يمكننا أن نقول أن الاقتباس أعلاه صحيح للإشارة إلى أن أطفال جيل طفرة المواليد هم محور التركيز الآن. لم يعد الجيلX البالغ من العمر 20 عامًا هو الذي يثير القلق في وسائل الإعلام؛ بل ما يسمى بـ “جيل الألفية”، الذين يعيشون في دولة أنفقت فيها الحكومة على آبائهم أكثر بكثير مما أنفقت عليهم. إنه الجيل Y، أطفال جيل طفرة المواليد الذين ولدوا بعد عام 1980. ينصب التركيز الآن على جيل من المراهقين؛ وكما قالت مجلة ماكلينس “للمرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي عادت ثقافة الأطفال؛ ثقافة الأطفال تفوز”.[15] من المتوقع أن تتجاوز طفرة المواليد الجديدة -الجيل Y- أعداد طفرة المواليد بعد الحرب من حيث الحجم (77 مليون) والمدة، حيث في الفترة بين عامي 2006-2010، يقدر أنه سيكون هناك 35 مليون مراهق في الولايات المتحدة، وهو أكثر من أي وقت مضى خلال حقبة والديهم من جيل طفرة المواليد.
مع تغير الموضوع والهدف، فقد تغير خطاب الهجوم، وهذا التغيير في الطريقة التي وُصِف بها الشباب أمر مزعج بشكل خاص. تأمل مرة أخرى، تقرير اللجنة القضائية: “خلف قشرة رفاهيتنا المادية، هناك مأساة وطنية؛ أطفال أمريكا يقتلون ويؤذون بعضهم البعض”، هكذا عبّر حاكم ولاية كولورادو بيل أوينز عن أسفه في أعقاب مذبحة مدرسة كولومباين، “إنه فيروس موجود في ثقافتنا، وهذا الفيروس يقتل ثقافتنا”. في الواقع، على الرغم من أنه لا الحاكم أوينز ولا السناتور هاتش -الذي كتبت لجنته التقرير- صرحوا بذلك، إلا أن لسان حالهم ناطق بأن الفيروس هو الأطفال أنفسهم.
وقد لاحظ هنري جيرو ذلك:
“أصبح الأطفال في أدنى سلم أولوياتنا؛ إنّ أزمة الشباب لا تعكس ببساطة فقدان الرؤية الاجتماعية، واستمرار مشاركة الشركات في الفضاء العام وتآكل الحياة الديمقراطية، بل تشير أيضًا إلى الكيفية التي نظر بها المجتمع إلى الأطفال عبر مجموعة واسعة من المواقف الأيديولوجية، والخالية من أية جديّة حقيقية، فبدلاً من اعتبارهم مجموعة مضطهدة أو أنهم في خطر، صاروا هم الخطر على الحياة العامة الديمقراطية“.[16]
يقلِّل مايك ماليس من قيمة وأهمية ادعاء جيرو أن الشباب صار يُعامَل كـ “آخر” على نحو متزايد؛ بحجة أن وسائل الإعلام والجمهور “يستخدمون نفس القوالب النمطية التي تطبق بشكل مستمر المجموعات العرقية والإثنية التي لا تحظى بشعبية. إن الأطفال عنيفون ومتهورون ومدمنو جنس، ويستنزفون الرفاه، إنهم بغيضون وجاهلون”[17] أو مرة أخرى -كما يقول جيرو- “يتم تصوير الأطفال إما على أنهم أشخاص معتلون يمارسون العنف الاجتماعي لشعورهم بأنهم منبوذون، أو مجرد باحثين عن المتع المبتذلة لقلة عقلهم”.[18] لقد انتقلنا من القلق من “أننا لا نقوم بعمل جيد في تربية أطفالنا … وأن الأطفال لا يتم تعليمهم ما يحتاجون إلى معرفته ليكبروا ويصبحوا بشرًا صالحين”[19] إلى “الناس في ذعر من أطفال العالم الذين يعيشون بينهم”،[20] وذلك لإلقاء اللوم على الأطفال أنفسهم. في عام 1967، أعلنت مجلة التايمز أن “الشباب” هم رجل العام؛ هل يمكنك تخيل حدوث ذلك الآن؟ والنتيجة أنه أصبح من الشائع أن يُنظر إلى الشباب على أنهم تهديد للنظام الاجتماعي القائم، وأن يُلام الأطفال على المشاكل التي يواجهونها (كما هي الحال مع “الأقليات” الأخرى).
لقد وَسَّعت هذه الخطابات نطاقها وقوتها طوال العقد الماضي. زعمت مجلة نيوزويك (في عدد 10 مايو 1998) أن “شباب الضواحي البيض لديهم جانب أسود”، وتابعت “ثقافة الشباب بشكل عام تمثل ’ملك الذباب’ على نطاق وطني واسع”[21] وفي مقال نشر في صحيفة جورج (يونيو 1996) بعنوان “الأطفال يدمِّرون أمريكا”، كتب بريت إيستون إليس -رمز الجيلX من الثمانينيات: “المراهقون يعيثون فسادًا في هذا البلد، إنهم يقتلون ويغتصبون ويقامرون، وهم بذلك يدمرون مستقبل الأمة، ولدينا ما يثبت ذلك من مستندات السجن. بالتأكيد ليس كل الأطفال سيئين، ولكنهم على مستوى الجماعة أصبحوا أسوأ؛ لماذا يجب أن نلوم أنفسنا؟” وفي صحيفة Education Week (5 يونيو 1996) له مقالة على الصفحة الأولى بعنوان: “ثقافة المراهقين تعيق الإصلاح المدرسي”.
من أجل تحقيق ذلك ، يتم تمثيل الشباب بشكل متزايد على أنهم مختلفون جوهريًا عن المقياس الطبيعي، تمامًا مثل النزوات الغامضة للطبيعة. في مقال تايمز لوس أنجلوس (9 ديسمبر 1993) جاء ما يلي “من هم أطفالنا؟ في يوم ما يكونون أبرياء كالملائكة، وفي اليوم التالي قد يحاولون تفجير رأسك”. هكذا صار أطفالنا مصدرًا للرعب تمامًا مثل شخصية فريدي كروجر. لقد أصبح الأمر سيئًا بما فيه الكفاية عندما كان فريدي في الحجرة المجاورة، الآن، هو داخل غرفة نوم أطفالك. لم تعد الحاضن هي التهديد بعد الآن، إنه الطفل الذي سيقتل حاضنته ثم ينزل الدرج لقتلك. أصبحت ليزي بوردين المعيار الجديد لأطفال أمريكا. قد يفسر هذا التكرار المتزايد للنداءات والمخاوف والخطابات التي يتم تلخيصها في مقال US News في أغسطس 1999 “داخل الدماغ في سن المراهقة؛ السبب وراء سلوك طفلك الغريب هو دماغه” من المقبول ألا ينصاع الأطفال لتوقعاتنا حول السلوك المدني والحضاري، لكن لا بأس في أننا فشلنا في ترويضهم لأنهم من الأساس نوع مختلف؛ فهم بطريقة ما، تختلف أدمغتهم نوعيًا عن الأدمغة البشرية للبالغين، وبالتالي فإن كل سلوكهم الغريب مفهوم؛ وبذلك نزيح عن أنفسنا عبء مسؤوليتنا تجاههم. لم يعد الأطفال أبرياء يجب حمايتهم، وهذه هي النظرة السائدة للطفولة في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في القرن العشرين؛ كما أنهم ليسوا بالغين صغار يمكن تحميلهم المسؤولية؛ بل هم نوع آخر، نوع من الحيوانات، ونحن نفشل في تنشئتها وترويضها اجتماعيًا.
هناك حرب ضد الشباب، والمثير للدهشة أن هناك القليل من النقاش حول الوضع، سواء في وسائل الإعلام أو داخل الأكاديميات. أنت لا تقرأ شيئًا تقريبًا عن الجيل Y باستثناء مدى سوئه وصعوبة ترويضه؛ ولا تقرأ عن طفرة المواليد الجديدة بنفس الطريقة التي لا تزال تقرأ بها عن طفرة المواليد القديمة.
وضع الشباب في مكانه الصحيح
السؤال هو: كيف نفهم هذا؟ أريد أن أبدأ في الإجابة على هذا بالإشارة -بسرعة كبيرة- إلى تطورين أو اتجاهين آخرين يحوِّلان فضاء الثقافة وثقافة السياسة في الولايات المتحدة. أولاً، أشار الكثير من الناس إلى وجود أزمة في السياسة، وعلى الرغم من وجود العديد من الأوصاف المختلفة للظروف الفعلية، فخلاصة القول التي سيوافق عليها معظم الناس: هي حقيقة فقدان الثقة في العمل السياسي وفي دورنا كمواطنين. وكما قال أحد المراسلين (19 أكتوبر 1997) :
“كيف لا يتظاهر أحد في واشنطن هذه الأيام؟ أين اللافتات والحواجز؟ الرئيس على استعداد لالتقاط صورة مع أي أجنبي سيعطيه المال بكل سهولة؛ الفجوة بين الأغنياء والفقراء أكبر مما كانت عليه منذ أيام البارونات اللصوص. الأطفال يُهملهم والداهم، وتضطهدهم حكومتهم. ومع ذلك، لا يبدو أن أحدًا يهتم؛ أين الغضب في أمريكا؟”.[22]
يتحدث المؤرخ البارز لورنس جودوين من جامعة ديوك عن “عمق الاستقالة [الذي يميزه عن اللامبالاة، التي تعتمد على الإحساس بالعجز] التي تنتشر في قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى الأمريكية والفقراء العاملين. إنه إرهاق وضجر يتجاوز في بعض الحالات حدود اليأس، ومثل هؤلاء الناس، يصلون إلى مرحلة من العجز الكلي والشلل التام”.[23]
في الواقع، هناك جانبان أو بُعدان لمشكلة “اللامبالاة” المتزايدة تجاه السياسة. الأول، الذي تمت ملاحظته على الأقل منذ أواخر السبعينيات وفي العديد من البلدان إلى جانب الولايات المتحدة، هو الفجوة المتزايدة بين ما يعتقد الناس أنهم يؤمنون به وصورة تصويتهم في الانتخابات. هناك تفاوت حقيقي للغاية بين المعتقدات السياسية والأيديولوجية الظاهرة للمواقف، وبين المواقف الفعلية التي يتخذونها أو بالأحرى يجدون أنفسهم مؤيدين لها، سواء في سلوكهم الانتخابي (أو بالأحرى افتقارهم إلى السلوك الانتخابي) أو -في بعض الأحيان- في خطاباتهم، حيث يُسحبون في اتجاه كانوا ينكرونه صراحة. على هذا الأساس، جادل المعلقون بأن الثقافة السياسية المحافظة بشكل متزايد والمؤيدة للشركات في الولايات المتحدة قد تبوأت مكانتها دون أساس تقليدي من “القبول الشعبي”.
والجانب الثاني الأكثر إثارة للاهتمام هو سحب الاستثمارات العامة والراديكالية من السياسة تمامًا، ليس فقط الافتقار الواضح لأي اهتمام بالنشاط السياسي، بل التجنب النشط للسياسة والخطاب السياسي. السياسة تنحسر كجزء حيوي ونشط من الحياة العامة. لا أقصد إنكار أو تجاهل الوجود الحقيقي لمجموعة واسعة من الأنشطة. في الواقع، أعتقد أنه يوجد نشاط أكثر اليوم مما كان عليه في الستينيات؛ لكنه اختفى إلى حد كبير من الرأي العام، جزئياً لأن جانبه الآخر هو فك الارتباط الجذري بالسياسة، وجزئيًا بسبب الإيكولوجيا الاجتماعية لمختلف المجموعات والحركات. أو بعبارة أخرى، لا توجد حتى الآن حركة سوى مجموعة من القضايا والناخبين المستقلين نسبيًا، مع عدم وجود مبادئ مشحونة مؤثرة قادرة على إنشاء واستدامة الالتزامات والتحالفات طويلة الأجل. [24] ولكن حتى الاعتراف بمثل هذه النشاطات لا ينفي حقيقة أن الغالبية من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة في الولايات المتحدة تسخر وتستهزئ ولا تبالي بهموم الحكومة وممارساتها. قد نقول إننا نشهد “اختفاء السياسة”. وكما قال عالم الاجتماع زيجمونت باومان “إذا فاز الناس بالحرية، فكيف يمكن ألا تصبح قدرة الإنسان على تخيل عالم أفضل والقيام بشيء لتحسين عالمه من بين غنائم هذا النصر؛ وأي نوع من الحرية ذاك الذي يثبط الخيال ويتسامح مع عجز الناس الأحرار عن تحقيق الأمور التي تهمهم جميعًا“.[25]
هناك العديد من التفسيرات لذلك؛ يرى البعض أن نقل سيطرة الحكومة من الشعب إلى الشركات – من خلال التلاعب المالي بالانتخابات- هو إستراتيجية مقصودة للأحزاب السياسية؛ في حين يرى آخرون أنه تعبير أوسع عن سخرية ما بعد الحداثة. في هذه الحالة، عندما لا يوجد إلا صوت واحد في السياسة، فإنّ المرء ببساطة يتخلى عن السياسة. يحاول بعض الناس إثبات أن الأمر راجع إلى عدم وجود مجتمع عام (وغالبًا ما يعود هذا الغياب إلى حقبة الستينيات). يقول بعض الناس ذلك لأننا خائفون للغاية ولا نأمن عواقب الانخراط في السياسة؛ ويرى آخرون أن السبب هو أننا نعتقد أن الاقتصاد والتكنولوجيا قد حلا محل السياسة. يُظهر إعلان حديث لمجلة فوربس مجموعةً متعددة الأعراق والإثنية لأناس يحملون لافتات حمراء مع أيقونات عملتهم الوطنية، ونص العنوان الرئيسي “رأسماليو العالم يتّحدون”. لقد حل رأس المال محل النضال السياسي للإطاحة برأس المال. ويرى البعض أن انعدام الإرادة السياسية هو نتيجة انهيار المجتمع المدني وتدمير الوسط المدني.
كل هذه التفسيرات صحيحة بوجه ما، لكن كيف يعقل ذلك؟ لأنني أريد أن أزعم أن النضال الذي يجري هنا هو على وجه التحديد محاولة لجعل عامة السكان يسخرون من “اختفاء” السياسة كما كانت. هناك شيء من المؤامرة التي يمكن أن تستخدم، وهي تفصح عن نفسها في جميع التفسيرات المذكورة أعلاه، لأن هدفها هو جعل السياسة تختفي من خلال جعل “السخرية” سمة سائدة بين الشعب. لم يعد السياسيون يخفون اعتماداتهم المالية، كما أنهم لا ينفون حقيقة أنهم يديرون حملات إعلانية؛ لم تعد شعارات الحملات تشتق من أي التزامات مبدئية، بل من خلال محللات التصور التي تقيس استجابة الجهاز العصبي للمنبهات، دون أي اعتبار لمعنى الشعار، لأنه -كما اعترف أحد الباحثين- إذا كنت تنشد استجابة عاطفية بحتة فإن المعنى لا قيمة له، بل ربما كان عائقًا. لكن ما هو أكثر دلالة هو أننا لسنا بحاجة لإخفاء مثل هذه الأشياء بعد الآن، لأنني أرى أنها لا تسهم في بناء هوية سياسية أو دائرة انتخابية بقدر ما تسهم في خلق فراغ سياسي.
بالطبع، على المرء أن يسأل لماذا؟ لماذا تريد أي حكومة أن تجعل سكانها لا يجيدون إلا السخرية؟ الجواب الأكثر وضوحا: هو أن ذلك يمكَّنها من الحفاظ على السلطة دون الاضطرار إلى مواجهة سلسلة مستمرة من التحديات والمقاومة. إنني أعتقد أن هذا صحيح بالتأكيد، لكنني مقتنع أيضًا أن هناك المزيد على المحك. أعتقد أن الجواب يتعلق بمحاولة تحدي ما يمكننا تسميته – على حد تعبير مايكل ج. سانديل- الاقتصاد السياسي الحديث للمواطنة.[26] إننا موجودون كمواطنين، والمواطنة هي واحدة من الركائز الأساسية للغاية لفردانيتنا وذاتيتنا، وهي أحد أحجار الزاوية في المجتمع الحديث الذي بُني في شمال الأطلسي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أي أن أحد العناصر الأساسية الحاسمة لشخصيتنا هو علاقتنا بالدولة مع وجود مجال مدني محدد خارج نطاق تأثير الدولة (على الرغم من أن الدولة عليها التزام بدعم وجوده). إننا نحدد وجودنا كمواطنين، مواطنون لهم حقوق، ولهم هوية (وطنية)، ولدينا سلطة تاريخية؛ إننا نُعرَّف كمواطنين من خلال التزاماتنا تجاه الدولة، وإننا كمواطنين نطالِب بحماية بعض مجالات الحياة (لفئة معينة من السكان على الأقل) من هيمنة بعض أنواع السلطة على الأقل.
كتب توماس مان ذات مرة أنه “في عصرنا، لم تعد مسألة مصير الإنسان يُنْظَرُ إليها من الناحية الدينية بل من الناحية السياسية“.[27] إن مسألة المصير والمستقبل أمر محوري في بناء المواطنة الحديثة؛ فمن المهم لكل من الدولة الحديثة والمواطن الحديث أن يُعرَّف الحاضر من خلال مساره نحو المستقبل. التاريخ والمواطن كلاهما غير مكتملين بالضرورة، ولا يتحققان إلا في وجود مستقبل مؤجل دائمًا. هذه هي الطريقة التي يُؤطَّر بها مفهوم الوقت، حيث إن التقدم أساسي جدًا للبناء الحديث لكل من المجتمع والفرد. هذا الإيمان بالتقدم يتجسد بالطبع في مفهوم الحلم الأمريكي، ومؤخرًا في الاحتفال بالطفولة في الولايات المتحدة في القرن العشرين.
الاتجاه الثاني للتحول الذي أريد طرحه (في عجالة) يشمل المجال الاقتصادي. من الواضح أن هناك الكثير مما يمكن قوله حول التحول الرأسمالي على مدى العقود الماضية. يمكن للمرء أن يتحدث عن ما يسمى بالمعجزة الأمريكية والازدهار الاقتصادي الواضح، أو ربما يجب أن نقول أن السؤال الحقيقي هو لماذا يبدو أن الجميع يعتقدون أنها طفرة بينما تشير الأدلة في الواقع إلى أن الحياة الاقتصادية الحقيقية لغالبية الناس تحولت إلى شيء مختلف تمامًا. بين عامي 1947 و 1979، زاد دخل الأسرة في أمريكا بالتساوي إلى حد ما عبر جميع مستويات الدخل في هذا البلد؛ لكن ما بين عامي 1977 و 1998، شهد ما بين 66 ٪-75 ٪ من العائلات الأمريكية انخفاضًا حقيقيًا في الدخل على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسر ذات الدخل المزدوج، والزيادة الحقيقية في عدد ساعات العمل. لذلك، بالنسبة للعديد من العائلات -حتى مع الدخول المزدوجة والعمل لساعات أطول- فإنها ما تزال تجني أموالًا أقل من عائلة مماثلة قبل 20 عامًا. 90% من جميع الزيادة في الثروة التي تولدت في السنوات العشرين الماضية ذهبت إلى أغنى 1٪ من الأسر الأمريكية؛ كما شهدت هذه النخبة زيادة في دخلها السنوي بنسبة 120٪ سنويًا، وهم يشترون سلعا بعد خصم الضرائب بنفس دخول أدنى 100 مليون من السكان الأمريكيين. انخفض صافي دخل الأسرة المتوسطة في الولايات المتحدة، فبالنسبة لأدنى 40 ٪ من سكان أمريكا انخفض الدخل بنسبة 80 ٪ في السنوات العشرين الماضية. والدخل الصافي لأدنى 50٪ من السكان الأمريكيين يساوي القيمة الصافية لثروة بيل جيتس. يشير أحد التقارير إلى أنه إذا فرضت ضرائب على أغنى 225 شخصًا، فإن 4 ٪ فقط من ثرواتهم ستوفر ما يكفي من المال لطعام وملبس وإقامة وتعليم وتوفير الرعاية الطبية لجميع سكان العالم.[28] طوال السنوات العشرين الماضية، كنا نبتعد عن مجتمع الطبقة الوسطى، مجتمع الحلم الأمريكي.
هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن للمرء أن يقولها عن الاقتصاد، حيث يحاول المرء أن يفهم ما الذي يتغير في تنظيم رأس المال. يمكن للمرء أن يتحدث عن الانتقال من الإنتاج والاستهلاك بالجملة إلى ما يسمى أنظمة ما بعد فورد أو أنظمة الإنتاج والتراكم المرنة، وعن نمو تكنولوجيا المعلومات واقتصاديات الخدمات، وعن عولمة نظام السوق ونمو الشركات متعددة الجنسيات. من المؤكد أن أحد أهم سمات الاقتصاد الحالي هو أن العديد من الاقتصاديين -بما في ذلك آلان جرينسبان ،أقوى اقتصادي في العالم- يعترفون أنهم لا يفهمون ذلك. أريد أن أتحدث عن جانب مختلف من المعجزة الاقتصادية للسنوات العشرين الماضية ألا وهي الأهمية والقوة المتزايدة للتمويل ورأس المال. لا أقصد أن أقترح أن هذا هو كل ما يحدث أو أنه يمكن أن وراء -بشكل متزامن كما كان- كل شيء يحدث في الرأسمالية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم الثروة التي أنتجت في السنوات العشرين الماضية قد بنيت اعتمادًا على رأس المال والتمويل وليس على العمال أو إنتاج السلع؛ إنه المال ينتج المزيد من المال؛ لقد بُنيت تلك الثروة على الاستهلاك والائتمان وليس على العمالة والإنتاج.[29]
يبدو أننا نعيش في اقتصاد يشجع إما البطالة المرتفعة بشكل خطير (ضع في الاعتبار عدد السجناء أو العاطلين عن العمل) أو انتشار الوظائف التي لا تساعد على العيش الكريم. يمكننا أن ننظر إلى كلا الظاهرتين على أنهما استمرار للتقاليد الطويلة من استغلال العمال، لكن أيضًا يمكننا استكشاف شيء آخر يحدث؛ يمكننا أن نرى دليلاً على ذلك في ظهور الخطابات والممارسات التي لا تركز كثيرًا على استغلال العمالة أو ترويعهم بالبطالة، في حين تتجه إلى تقليل العمالة الضرورية فعليًا إلى حد لا يمكن تصوره حتى الآن. يمكن للمرء الآن أن يبدأ في تخيل المجتمعات الرأسمالية المتقدمة بمستويات توظيف متدنية لا يمكن تخيلها؛ في الواقع -في المجلة الألمانية دير شبيجل- تكهن خبيران اقتصاديان أوروبيان بارزان بأنه من الممكن أن تتوفر كل العمالة الضرورية من نسبة 20٪ فقط من القوى العاملة الآن[30] وهذا يعني معدل بطالة 80٪ في العالم. إن زيادة الأرباح من خلال خفض تكاليف العمالة (إما من خلال الاستغلال النسبي أو المطلق وإنتاج فائض القيمة) شيء واحد. ولكن هناك شيء آخر لمحو العمالة نفسها كما لو كان خفض التكلفة المطلقة للعمالة -عن طريق الاستثمار في الإنتاج أو تقليصه- يكفي لزيادة الأرباح؛ ومع ذلك، هناك شعور بأنه كافٍ، على الأقل في الاقتصاد النقدي النيوليبرالي، على الرغم من أنه يعني التخلّي عن الاتصال بإنتاج السلع. تكشف المعجزات الاقتصادية لشركات التكنولوجيا العالية من Amazon و com (التي لم تحقق ربحًا على الرغم من زيادة المبيعات) إلى Red Hat شيئًا عن الطبيعة المتناقضة لهذه الطفرة الاقتصادية. على الرغم من ادعاءات المستثمرين، تشير الدلائل إلى وجود علاقة عكسية بين نمو سوق الأسهم في العقود الأخيرة وتزايد أعباء ديون الشركات (الناتجة عن عمليات الاستحواذ، وإعادة شراء الأسهم، وزيادة المدفوعات للمساهمين، وما إلى ذلك) من ناحية، والمستوى الفعلي للاستثمار في الإنتاجية من ناحية أخرى.[31] في الواقع، لم تحدث زيادة كبيرة تقريبًا في الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية؛ إن جزءًا كبيرًا من أرباح سوق الأسهم خلال العشرين عامًا الماضية نتج عن قيام الشركات بإعادة شراء أسهمها الخاصة أو بيع الأسهم من أجل شراء شركات أخرى. لكن البنية التحتية -الأساس الاقتصادي الذي سيدفع أطفالَ اليوم إلى بناء اقتصاد المجتمع بعد 30 عامًا من الآن- لم تشهد أي استثمار كبير. هناك نوع من عدم الاستثمار في المستقبل؛ يبدو الأمر كما لو أن الرأسمالية لم تعد تهتم بتحقيق ربح يمكنها إعادة استثماره في مستقبل الرأسمالية، ولكنها بالأحرى تهتم فقط بتوليد ربح هائل قصير الأجل لنسبة صغيرة جدًا من السكان، ومن الواضح أن ذلك يعود في بعض النواحي إلى النماذج القديمة ما قبل القرن العشرين؛ لكن أعتقد أن هناك المزيد على المحك.
أعتقد أن النيوليبرالية -من خلال وضع رأس المال التمويلي في المركز- تحاول -مهما بدا ذلك صعب التصديق- أن تنكر –أو على الأقل تعدل وتتراجع جزئيًا- فرضية كون العمالة مصدرًا للقيمة. أي أننا نشهد خفضًا حقيقيًا وجذريًا لقيمة العمالة. ببساطة، إذا كانت العمالة هي الحد الأولي للربحية (وتراكم الثروة)، سواء كتكلفة رأسمالية متغيرة أو كمصدر رئيسي للطلب في الاقتصاد الحديث، فيبدو أن النيوليبرالية تقترح إجابة بسيطة: استبعاد العمالة من معادلة الربح من خلال تحويل العمالة إلى تكلفة رأسمالية ثابتة، كما كانت، وعن طريق ربط الطلب بالائتمان بدلاً من الأجور. ما هو على المحك هنا هو خلق مساحة يمكن فيها (أو بالأحرى يكون من المحتوم) تحدي قيمة العمالة بشكل جذري. إنها تحقق ذلك من خلال -وليس لدي شك في أن هذا مقصود- إعادة تشكيل جذرية للإنتاج الرأسمالي للثروة. وبالتالي، أعتقد أن إعادة التقييم والامتيازات اللاحقة للمال والاقتصاد النقدي (ولكن في شكل مختلف عن التشكيلات السابقة) يتم التعبير عنها (على الرغم من أنه ليس من الواضح أن هذا هو الحال) تخفيض قيمة العمالة وقوتها كمصدر للقيمة وبالتالي للثروة.
ليس من قبيل الصدفة أن العمل -مثل المواطنة- كان أيضًا أحد الركائز التي بنيت عليها الفردانية الذاتية الحديثة في شمال الأطلسي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. في الواقع، يمكن للمرء أن يجادل بأنه على وجه التحديد بسبب الحاجة إلى بناء العامل، باعتباره الشخص الذي سيبيع قوته العاملة في السوق، كان على الرأسمالية الحديثة أن تربط نفسها بمشروع الدولة الحديثة وإنتاج المواطنة. وهذان النمطان للفردانية – العمل والمواطنة – يحددان ركيزتين من ركائز الفرد في المجتمع الحديث.
الآن، أخيرًا، أريد العودة إلى الحرب على الشباب، وأريد أن أسأل كيف يمكن التعبير عنها أو ربطها بهذين النضالين الآخرين. كيف نتصور أن تكون الحرب على الشباب مرتبطة بهجمات على اثنين من الهياكل التأسيسية للفردانية والذاتية الحديثة؟ يعيدني هذا السؤال إلى الصورة التي ذكرتها في البداية وهي أننا نشهد موجة ثانية من الإصلاح. تضمَّن إصلاح أوروبا بناء ما يسمى عادة بـ “الحداثة”، وبناء المواطن العامل، وبناء الدولة القومية الحديثة، وتنظيم المجتمع وفقًا لمبادئ الاستعمار وعقلنة الإنتاج. إليكم نظرية المؤامرة الخاصة بي: أعتقد أن هناك قوى (ومن الواضح أن الرجل المدخن جزء منها) تحاول إعادة اختراع الحداثة ووضع نوع مختلف من التنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وتحاول إعادة تعريف إحساسنا بالفردية وعلاقة الفرد بالقوى التي تنتج حياته أو تشكل واقعه. بالطبع، ليس هناك ما يضمن نجاح هذه المؤامرة لأن الأمور لا تجري دائما كما هو مخطط، كما أن هناك مشاريع أخرى قيد التقدم، ومؤامرات أخرى تحت التنظيم. أعتقد أن الأمر كما لو أن أجزاء معينة من الرأسمالية والقوى كانت تحاول رسم طريقها للخروج من سلسلة التنازلات الجارية منذ قرون: ماذا لو لم تربط الرأسمالية نفسها بالديمقراطية وتثمين العمالة؟.
أين يلتقي الشباب مع نظرية المؤامرة السياسية؟ بعد كل شيء، هناك شيء غريب حول وضع الشباب في هذه السردية. هناك شيء مثير للقلق بشأن تسييس الشباب. إن الخطاب التقليدي (الحديث) للشباب -لا محالة و بالضرورة- يضع الشباب خارج عالم السياسة، كما لو أن الحالة الطبيعية للشباب هي أنهم خارج المجتمع. يبدو الأمر كما لو أن الشباب يجب حمايتهم من تدهور المجتمع، لأن الشباب “يصبح دائمًا اجتماعيًا”. كما يقول لي إيدلمان، فيما يتعلق بمناقشات الأطفال، يبدو أن قضية الطفولة لها جانب واحد فقط. بعد كل شيء، من يمكن أن يكون (وماذا يعني أن يكون) ضد الأطفال. “لا نزاع حول الطفولة، لأنها غير مثيرة للجدل، إنها قيمة ثقافية”[32] في مجتمعنا، فلن يقف أي سياسي ويقول “أنا ضد الأطفال”؛ ومع ذلك أعتقد أن هذا هو بالضبط ما تقوله أعمال وخطابات مجتمعنا وسياسيينا. هذا هو، لقد كنت أحاول أن أجادل بأن الشباب (والطفولة) لم يعد محل نزاع، ولكن لدينا صعوبة في التعرف على النزاع، جزئيًا لأننا لا نستطيع البدء في تخيل ما هو على المحك.
يكمن المفتاح في اعتقادي في الاعتراف بأن هناك حجر زاوية آخر لبناء الحداثة والفرد الحديث إلى جانب العمل والمواطنة. وقد اقترحت بالفعل أن ذلك ينطوي على بناء معين واستثمار معين في الوقت المناسب، وبشكل خاص في المستقبل؛ إنه ينطوي على بناء معين للتاريخ، وبناء شعور بالانتماء مبني على إيمان بالتقدم، والخيال والاستثمار في المستقبل؛ إنه ينطوي على افتراض مسار من الماضي إلى المستقبل، وعلى فكرة عن التقدُّم على أنه اكتمال ذاتي، وتحقيقٌ لذاتية الفرد والأمة وكذلك التاريخ نفسه. علق العديد من العلماء المختلفين على دور المستقبل في الحداثة.
ولكن ما لم تتم ملاحظته هو الدور الذي لعبه الشباب (وفكرة معينة من الأسرة) في تشكيل التصور عن العمالة في هذا الاقتصاد في تلك اللحظة من التاريخ في الولايات المتحدة. لقد لوحظ مرارًا وتكرارًا أنه في المجتمع الأمريكي في القرن العشرين -أكثر من أي ثقافة أخرى في العالم- أصبح الشباب علامة مميزة وتجسيدًا للمستقبل؛ لقد أصبح الشباب مجرّد إيمان عالمي في المستقبل، وتجسد ذلك في جيل طفرة المواليد مواليد أكثر من أي جيل آخر. كان هذا هو الجيل الذي سيحقق نهاية التاريخ، لأنه سيحقق الحلم الأمريكي. أصبح الأطفال، في الواقع، نوعًا من الضمان الرمزي بأن أمريكا ما زالت تملك مستقبلًا، وما زالت تؤمن بمستقبل، وأنه من الضروري لأمريكا أن تستثمر إيمانها في ذلك المستقبل.
أريد أن أقترح أن الإيمان بالمستقبل، المتجسد في صورة الطفولة نفسها، هو الاستثمار في الشباب وفي قدرة الشباب على تجسيد هذا الالتزام بالمستقبل، الذي هو محل التنافس في الحرب على الشباب. الحرب على الشباب هي حرب ضد قدرته على تجسيد ضرورة الالتزام بالمستقبل، وبمستقبل معين، بقدر ما تنطوي على أنواع معينة من الرؤى السياسية والاقتصادية للحلم الأمريكي. الحرب على الشباب هي محو المستقبل؛ أو بشكل أفضل، يتعلق الأمر بتغيير الوضع الذي يعمل به المستقبل. إن الإيمان بالمستقبل التقدمي ضروري لإمكانية بناء هوية فردية مبنية على العمل والمواطنة، وإن رفض الطفولة باعتبارها جوهر هويتنا الاجتماعية هو -في الوقت نفسه- رفض المستقبل كاستثمار عاطفي. يتم تعريف المستقبل بشكل متزايد على أنه إما ما لا يمكن تمييزه عن الحاضر[33] (وبالتالي هو خادم للحاضر وليس العكس)، أو أنه نهاية العالم (شيء مختلف تمامًا عن الحاضر).
قد نشهد محاولة إعادة اختراع الفرد وعلاقة الفردانية بالقوى التي تنتج الواقع وتنتج مستقبلنا الجماعي، وظهور نمط جديد ومتميز من التفرد والارتباط. تتضمن هذه “الثورة” نواقل اقتصادية وسياسية وأيديولوجية واجتماعية ونظرية وثقافية وإعلامية معًا، ومفاهيمها المتعددة. وهو ما يجمع بين قوى المحافظين الجدد والنيوليبرالية، ولكنه اجتماع مؤقت. إن ما هو على المحك هو إنتاج حداثة جديدة واستحالة مفاهيم التأثير التي دعمتنا طوال قرون؛ يبدو أن هذه الحداثة الجديدة تبطل الواقع، بل تبطل حتى إمكانية الفاعلية الاجتماعية، أو بشكل أدق التأثير الاجتماعي. إن ما نشهده -وهو ما كنت أحاول وصفه وتصوره- هو إنتاج سياق جديد، وحداثة جديدة، بدلاً من القديمة. يبدو أن هذا الإنتاج يتطلب ويسعى إلى نفي العديد من أشكال فاعلي الفردية والجماعية، بما في ذلك إمكانية تخيل مستقبل بديل.
أي أن الهجوم على الشباب يدور حول العلاقة بين الفردانية والزمن. إنه صراع لتغيير استثمارنا وإمكانية تخيل المستقبل. وهو -كما يقول باومان- صراع من أجل الهروب من الحاضر.[34] لأنه طالما كنت تؤمن بالمستقبل، فهناك دائمًا طريق للهروب، هناك دائمًا طريقة للانتقال من هنا إلى هناك. وطالما أن هناك طريقا للهروب، فهناك دائمًا احتمال وجود مجتمع محدد في مواجهة المجتمع الحاضر. هذا النضال ضد الحداثة (باسم الحداثة الجديدة) يجب أن يبطل إمكانات الخيال، وقوة المستقبل الخيالية. وفي الواقع، يبدو أن الحداثة الجديدة تتطلب منا إنكار أهمية المستقبل؛ ولكن إذا أردنا استعادة سيطرتنا على حاضرنا، وإذا أردنا استعادة إمكانية تخيل المستقبل= فيجب علينا بطريقة ما أن نعيد إلى أطفالنا إمكانية تجسيد الأمل لأنفسهم ولأنفسنا.
[1]– Zygmunt Bauman, In Search of Politics (Stanford: Stanford University Press,
1999). p. 157.
[2]– Paul Krugman, “The Spiral of Inequality,” Mother Jones, November/December
1994, p. 44.
[3]– أريد أن أشكر هنري جيرو على دوره معي كما فعل هيوم مع كانط، فقد أيقظني من سباتي الاعتقادي ودفعني إلى الانخراط في هذه القضية. للحصول على أهم بيان حول هذا الموضوع حتى الآن، انظر أحدث كتاب له “سرقة البراءة: قوة الشركات الشابة وسياسة الثقافة” (نيويورك: مطبعة سانت مارتن ، 2000)
[4]– Meaghan Morris, The Pirate’s Fiancee: Feminism Reading Postmodernism (London: Verso, 1988), p. 186.
[5]– لقد أخذت هذه الإحصائيات -وتلك التي تظهر في نقاط أخرى في هذه الورقة- من مجموعة متنوعة من المصادر. وكلما أمكن، حاولت التحقق من الأرقام؛ وعند الضرورة، اخترت الرقم الأكثر تحفظًا. بالطبع، تتغير هذه الأرقام بسرعة كبيرة ولكن أعتقد أن الاتجاه العام كما هو.
[6]– تشير التحقيقات الأخيرة إلى أن العديد من الولايات لا تطالب بأموال فيدرالية لتوفير الرعاية الصحية للعائلات والأطفال الذين أجبروا على الخروج من قوائم الرعاية الاجتماعية.
[7]– Mike Males, The Scapegoat Generation (Monroe, ME: Common Courage Press, 1996).
[8]– Henry Giroux, “Beating Up On Kids,” Z Magazine (July/August 1996), p. 15.
[9]– من المثير للدهشة، أن موقع أطباء الأطفال على الإنترنت لديه الكثير ليقوله عن استهلاك وسائل الإعلام من قبل الشباب أكثر من الاستخدام الواسع النطاق للعقاقير المؤثرة عقليًا (مثل ريديلين) لعلاج المشاكل المبهمة عند الأطفال.
[10]– الأمثلة والاقتباسات التالية مأخوذة من تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز ، أعيدت طباعته في The News and Observer ، في 17 أكتوبر 1999.
[11]– Delrdre Donahue, October 1, 1998, p. Dl.
[12]– http://www.senate.gov/- judiciary/medlavio.htm
[13]– Lawrence Grossberg, We Gotta Get Out of This Place: Popular Conservatism and Postmodern Culture (New York and London: Routledge, 1992).
[14]– Ann Hulbert, So’s Your Old Man.” Slate Magazine (November 4, 1996). www.slate.com
[15]– Andrew Clark, “How Teens Got The Power,” Macleans (March 22, 1999), p. 42.
[16]– Henry Giroux, “Public Pedagogy and the Responsibility of Intellectuals: Youth, Littleton and the Loss of Innocence,” JAC 20-1 (2000). p. 11.
[17]– Mike Males, “Bashing Youth: Media Myths About Teenagers,” Extra! (March/ April 1994).
[18]– Henry Giroux, “Beating Up On Kids,” p. 14.
[19]– David Blackenhorn of the “nonpartisan” Institute for American Values, cited in The News and Observer (September 1. 1996).
[20]– J. Walker Smith of Yankelovlch Partners, cited in The News and Observer (September 1, 1996).
[21]– Cited In Giroux (2000), p. 20.
[22]– John Powers, “Beyond prosperity, outrage simmers.” The News and Observer, October 19, 1997, p. 25A.
[23]– Takes More Than Anger to Fuel Mass Movement,” The News and Observer, October 19, 1997, p. 25A.
[24]– Obviously, the very recent green-red alliance mobilized against the international institutions of global capitalism points to at least a new possibility.
[25]– Bauman, p. 1
[26]– Michael J. Sandel, “America’s Search for a New Public Philosophy,” The Atlantic Monthly (March 1996), p. 59.
[27]– Cited in Bauman, p. 92.
[28]– Cited in Bauman, p. 176.
[29]– من الجدير بالذكر أن الحركة الطلابية الحالية ضد الرأسمالية تقوم -كما كانت- على تجربة تسييس الاستهلاك. في حين أن الكثيرين يرفضون هذه الحركة الجديدة المناهضة للرأسمالية ضد الدراسات الثقافية، والتي تجد نفسها فجأة في مواجهة مع سياسات الهوية، من المهم أن ندعي أن هذه الحركة الحالية تعتمد جزئيًا بشكل أساسي على الحركة، التي يتم الترويج لها في الدراسات الثقافية، للاعتراف بأهمية الاستهلاك وصداه السياسي.
[30]– Cited in Bauman, p. 20.
[31]– Doug Henwood, lecture. Duke University, February 19, 1999
[32]– Lee Edelman, “The Future is Kid Stuff: Queer Theory, Disidentiflcation and the Death Drive,” Narrative 6-1 (January 1998)
[33]– على سبيل المثال، في إعلان تلفزيوني حديث يتحدث فيه زوجان شابان، تتساءل المرأة: “هل أنت قلق بشأن المستقبل؟” يقول الرجل “نعم؛ أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن السيارة التي نشتريها، نريد أن نتأكد من أن سيارتنا يمكن أن تتغير في المستقبل”.
[34]– Bauman, p. 11.