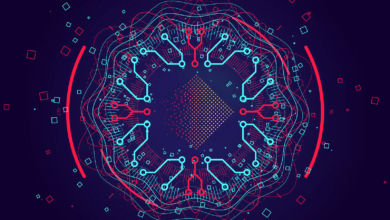- رايان أندرسون
- ترجمة: عثمان الشهيل
- مراجعة: مصطفى هندي
- تحرير: عبير الشهري
الأفكار الرئيسية
1-يشير ماكهيو إلى حقيقة أنه لما كان تغيير الجنس أو إعادة تعيين الجنس مستحيل من الناحية الجسدية؛ فإنه لا يوفر في كثير من الأحيان الكمال طويل الأمد والسعادة المنشودة التي يبحث عنها الناس.
2- لسوء الحظ، ينظر العديد من المتخصصين الآن إلى الرعاية الصحية -بما في ذلك الصحة العقلية- في المقام الأول كوسيلة لتحقيق رغبات المرضى، مهما كانت تلك الرغبات.
3- إن أدمغتنا وحواسنا مصممة لجعلنا على اتصال بالواقع، سواء واقعنا الخارجي أوالداخلي.
لا جدوى من إعادة تعيين الجنس؛ ومن المستحيل “إعادة تشكيل” الهوية الجنسية لشخص ما من الناحية الجسدية، ولا تؤدي تلك المحاولة إلى نتائج محمودة نفسياً واجتماعياً. وكما أوضحت في كتابي “عندما تحول هاري إلى سالي”، تشير الأدلة الطبية إلى أن تغيير الجنس لا يعالج بشكل كاف الصعوبات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأشخاص الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم متحولون جنسيًا. وحتى عندما تكون الإجراءات ناجحة من الناحية الفنية والتجميلية، وحتى في الأوساط التي تعتبر “صديقة للمتحولين” نسبيًا، فإن النتائج المخيبة للآمال لازالت تلاحق المتحولين جنسيا.
يشرح الدكتور بول ماكهيو، أستاذ الطب النفسي والحاصل على وسام التميز في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز:
“الرجال المتحولون جنسيا لا يصبحون نساء، ولا النساء المتحولات جنسيا يصبحن رجالا. الكل (بما في ذلك بروس جينر) يصبحون رجالًا متأنثين أو نساء مترجلات؛ إنهم نسخٌ مزيفة أومحاكية للجنس الذي يسعون إليه؛ وهنا مأزق مستقبلهم المبهم والمثير للجدل”.
عندما لا يكون هناك “فوضى وضجيج”[1]، فإنه ليس من السهل ولا من الحكمة العيش في رداء جنسي مزيف. توثق المتابعة الأكثر شمولًا للأشخاص الذين أعادوا تعيين جنسهم -التي تمتد لأكثر من 30 عامًا، وتُجرى في السويد، حيث الدعم الشديد للمتحولين جنسياً- الاضطرابات النفسية التي يعانون منها طوال حياتهم. بعد 10 إلى 15 سنة من إعادة تعيين الجنس جراحيا، تضاعف معدل انتحار أولئك الذين خضعوا لجراحة تغيير الجنس 20 مرة مقارنة بنظرائهم.
يشير ماكهيو إلى حقيقة أنه لما كان تغيير الجنس أو إعادة تعيين الجنس مستحيلاً من الناحية الجسدية؛ فإنه لا يوفر في كثير من الأحيان الكمال طويل الأمد والسعادة المنشودة التي يبحث عنها الناس.
في الواقع، إن أفضل بحث علمي يدعم حذر وقلق ماكهيو هو التالي:
إليك كيف لخصتْ صحيفة الجارديان نتائج مراجعة “أكثر من 100 دراسة متابعة للمتحولين جنسيًا بعد الجراحة” من قبل مكتب استخبارات أبحاث العنف بجامعة برمنغهام:
“خلُص [مكتب استخبارات أبحاث العنف]، الذي يجري مراجعات لعلاجات الرعاية الصحية لـ[خدمة الصحة الوطنية]، إلى أن أيا من الدراسات لا تقدم دليلا قاطعا على أن تغيير الجنس مفيد للمرضى. ووجدت أن معظم الأبحاث كانت مصممة بطريقة سيئة، مما أدى إلى تحريف النتائج لتشير ظاهرا إلى إمكانية تغيير الجنس جسديا. لم يكن هناك تقييم لما إذا كانت العلاجات الأخرى -مثل المتابعة والتوجيه طويل المدى- قد تساعد المتحولين جنسيًا، أوما إذا كان الالتباس الجنسي لديهم قد يقل بمرور الوقت”.
يقول مدير المنشأة كريس هايد: “هناك شكوك كبيرة حول ما إذا كان تغيير جنس شخص ما نافع أم ضار. وحتى إذا كان الأطباء حريصين على تنفيذ هذه الإجراءات فقط على “المرضى المناسبين، فلا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص الذين خضعوا للجراحة يعانون من الصدمة التي غالبًا ما تؤول إلى الانتحار”.
ومما يثير القلق بشكل خاص هو: الأشخاص الذين “لم تتمكن هذه الدراسات من تتبع مسارهم”، فكما لاحظت الجارديان “إن نتائج العديد من دراسات تغيير الجنس غير سليمة لأن الباحثين لم يتمكنوا من تتبع مسار أكثر من نصف المشاركين” في الواقع يقول د.هايد “إن المعدل المرتفع للمفقودين يمكن أن يعكس مستويات عالية من عدم الرضا أوحتى الانتحار بين المتحولين بعد الجراحة”.
وخلاصة قول هايد هي “أنه على الرغم أنه من الواضح أن بعض الأشخاص يجيدون ممارسة الحياة بعد إجراء جراحة تغيير الجنس، فإن الأبحاث المتاحة لا تقدم إلا القليل من البيانات المطمئنة حول عدد المتضررين من التحول الجنسي، ومدى سوء حالتهم، وهذا إن استطعنا العثور عليهم”.
راجع المكتب النتائج عام 2004، فهل تغيرت الأمور في العقد الماضي؟
ليس تمامًا؛
في عام 2014، أجرت شركة هايز -وهي شركة أبحاث واستشارات-مراجعة جديدة للأبحاث العلمية التي تقيم نتائج السلامة والصحة للتكنولوجيات الطبية. وجدت هايز أن الأدلة على النتائج طويلة المدى لتغيير الجنس كانت بعيدة تماما عن أن تقدم نتائج ذات مغزى، وأُعطيت هذه الدراسات أدنى تصنيف للجودة:
“لم تتمكن أي من الدراسات المتعددة بنتائجها المخلتفة من تقديم دليل متسق من الناحية الإحصائية على التحسُّن التالي لعمليات التحول الجنسي. وكانت الأدلة الداعمة لجودة الحياة والوظيفة لدى البالغين المتحولين من الذكور إلى الإناث قليلة جدا؛ كما كان الدليل المؤيد لوجود معدلات منخفضة من السعادة لدى البالغين الذين تلقوا العلاج الهرموني للتحول الجنسي قابلاً للتطبيق مباشرةً على مرضى اضطراب الهوية الجندرية، ولكنه كان متناثرًا ومتضاربًا. من ناحية أخرى، لا تسمح تصميمات الدراسة باستخراج استنتاجات سببية، كما كان للدراسات عمومًا؛ نقاط ضعف مرتبطة بتنفيذ الدراسة. هناك مخاطر محتملة طويلة المدى مرتبطة بالعلاج الهرموني، ولكن لم يتم إثبات أيٍّ منها، كما لم يتم استبعادها بشكل قاطع”.
توصلت إدارة الرئيس الأمريكي أوباما إلى استنتاجات مماثلة. وفي عام 2016، قامت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية بإعادة النظر في ما إذا كان يجب تغطية جراحة تغيير الجنس ضمن خطط الرعاية الطبية؛ وعلى الرغم من تلقي طلب بأن تغطيتها إلزامية، إلا أن الإدارة قد رفضت، وعللت ذلك بأننا نفتقر إلى أدلة تفيد أن عمليات التحول الجنسي مفيدة للمرضى.
وإليك كيف صيغت “مذكرة القرار المقترحة في حزيران/يونيو 2016 لعلاج الاضطراب الجندري وجراحات إعادة تعيين الجنس”:
“استنادًا إلى مراجعة شاملة للأدلة السريرية المتاحة في هذا الوقت، لا توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كانت جراحة تغيير الجنس تعمل على تحسين الحالة الصحية للمستفيدين من الرعاية الطبية المصابين باضطراب الهوية الجندرية. كانت نتائج هذه الدراسة متضاربة –رغم أنها من أفضل الدراسات التي صممت- حيث أكد بعضها فوائد هذه الجراحات بينما لم يشر بعضها الآخر سوى إلى الأضرار. كانت الأدلة ضعيفة ودون الجودة المطلوبة بسبب تصاميم الدراسة القائمة على الملاحظة في الغالب مع عدم وجود مجموعات مقارنة، ووجود تضاربات محتملة، واستخدام أحجام عينات صغيرة. لقد كانت العديد من الدراسات التي أكدت وجود نتائج إيجابية؛ دراسات استكشافية (تعتمد على تتبع الحالات والتحكم بالحالات) مع عدم وجود متابعة تأكيدية”.
كانت المذكرة النهائية لشهر أغسطس 2016 أكثر وضوحًا. وأشارت إلى الآتي:
“بشكل عام، كانت جودة وقوة الأدلة منخفضة بسبب: تصاميم الدراسة القائمة على الملاحظة في الغالب مع عدم وجود مجموعات مقارنة ونقاط مرجعية ذاتية، ووجود التأثير الخارجي المحتمل (حالة يتأثر فيها الارتباط بين السبب والنتيجة بعامل آخر مثل التدخل المشترك)، واستخدام أحجام العينات الصغيرة، ونقص أدوات التقييم المعتمدة، وفقدان كبير للمتابعة”.
وتجدر الإشارة إلى أن “فقدان المتابعة” يمكن أن يشير إلى الأشخاص الذين انتحروا.
وعندما يتعلق الأمر بأفضل الدراسات، لا يوجد دليل على حدوث “تغيرات سريرية ذات أهمية” بعد جراحة تغيير الجنس.
“كانت غالبية الدراسات غير طولية، ودراسات استكشافية (أي لازالت في بداية التحقيق أو توليد الفرضيات)، أو لم تتضمن ضوابط واختبارات متزامنة قبل الجراحة وبعدها. أفادت العديد من الدراسات عن النتائج الإيجابية، ولكن المشاكل المذكورة أعلاه قللت من قوة وموثوقية هذه الدراسات. بعد التقييم الدقيق، حددنا ست دراسات يمكن أن توفر معلومات مفيدة؛ أربعٌ من بين هذه الدراسات الأفضل من ناحية التصميم، والتي قيَّمت جودة الحياة قبل وبعد الجراحة باستخدام دراسات القياس النفسي المصدق عليها (وإن كانت غير محددة)؛ لم تُظهر تغيرات أواختلافات سريرية يُعوَّل عليها في نتائج الاختبار النفسي بعد [جراحة تغيير الجنس].
في مناقشة لأكبر وأقوى دراسة -الدراسة التي أجريت في السويد التي ذكرها ماكهيو في الاقتباس أعلاه- أشارت مراكز أوباما للخدمات والرعاية الطبية إلى احتمال أكبر 19 مرة للانتحار، ومجموعة أخرى من النتائج السيئة بعد إجراء جراحة تغيير الجنس.
“رصدت الدراسة زيادةً في معدل الوفيات واللجوء إلى العلاج النفسي مقارنة بالمعدلات الطبيعية. كان معدل الوفيات في المقام الأول بسبب حالات الانتحار التامة (معدل أكبر بـ 19 مرة من المعتاد)، في حين تضاعفت الوفيات بسبب الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار 2 إلى 2.5 مرة. نلاحظ أن الوفيات من هؤلاء المرضى لم تظهر إلا بعد 10 سنوات. كان خطر دخول المستشفى النفسي أكبر بـ 2.8 مرة مما كان عليه حتى بعد تعديل المرض النفسي الأولي (18 في المائة). كان خطر محاولة الانتحار أكبر في المرضى المتحولين من الذكور إلى الإناث، بغض النظر عن الجنس المهيمن على المريض. علاوة على ذلك، لا يمكننا استبعاد التدخلات العلاجية كسبب للاضطراب النفسي والزيادة الملحوظة في عدد الوفيات. ومع ذلك، ليس هناك دراسة مخصصة لتقييم تأثير جراحة تغيير الجنس في حد ذاتها”.
هذه النتائج مأساوية؛ وتتناقض بشكل مباشر مع الروايات السائدة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى العديد من الدراسات التي تلتقط لحظة معينة في حياة المتحولين ولا تتتبعهم بمرور الوقت. وكما أوضح مركز أوباما للرعاية والمساعدات الطبية، فإن “الوفيات من هؤلاء المرضى لم تظهر إلا بعد 10 سنوات”.
لذلك عندما نرى الدراسات التي تُجرى فقط لغرض الدعاية والبروباجندا تعتمد النتائج التي أُخذت فقط بعد بضع سنوات لتدعي أن جراحات إعادة تعيين الجنس قد نجحت نجاحا مذهلا؛ فحريٌ بنا أن نشك فيهم.
كما أوضحت في كتابي، يجب أن تكون هذه النتائج كافية لإيقاف الاندفاع المتهور إلى جراحات تغيير الجنس؛ يجب أن تدفعنا تلك النتائج إلى تطوير علاجات أفضل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون اضطرابا في هويتهم الجنسية؛ ولا يبدأ أي من هذا بالعلاجات الجذرية والتجريبية بالكامل التي تجرى على أجساد الأطفال لتحويلها.
استحالة تغيير الجنس من الناحية الجسدية
لقد رأينا بعض الأدلة على أن إعادة تعيين الجنس لا تؤدي إلى نتائج جيدة على الصعيد النفسي والاجتماعي، وكما اقترح ماكهيو أعلاه، جزءاً من السبب هو أن تغيير الجنس مستحيل، و”ثبت أنه ليس من السهل ولا الحكمة العيش في رداء جنسي مصنوع”.
ولكن ما هو أساس الاستنتاج بأن تغيير الجنس مستحيل؟
على عكس ادعاءات الناشطين، فلا يتم “تعيين” الجنس عند الولادة، ولهذا السبب لا يمكن “إعادة تعيينه”. كما أوضحت في كتابي “عندما تحول هاري إلى سالي”، أصبح الجنس فعالية جسدية يمكن التعرف عليها جيدًا قبل الولادة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية؛ كما يمكن التعرف على جنس الكائن الحي وتحديده من خلال الطريقة ينظم بها تكاثره الجنسي.
هذا ليس إلا مظهر واحد من حقيقة أن التنظيم الطبيعي هو “السمة المميزة للكائن الحي”، كما أوضحت عالمة الأعصاب مورين كونديتش وشقيقها الفيلسوف صموئيل كونديتش، في الكائنات الحية، “يتم تنظيم الأجزاء المختلفة، كي تتفاعل بشكل تعاوني من أجل رفاهية الكيان ككل، ويمكن أن توجد الكائنات الحية على مستويات مختلفة، من الخلايا المجهرية إلى حيتان العنبر التي تزن العديد من الأطنان، ومع ذلك تتميز جميعها بأن الجزء يوظف من أجل الكل”.
تحتوي الكائنات الحية من الذكور والإناث على أجزاء مختلفة مدمجة وظيفياً لتحقيق تكاملها، وتعمل من صالح كيانها ككل، أي اتحادها الجنسي وتكاثرها. لذلك فإن جنس الكائن الحي -ذكر أو أنثى- يتحدد من خلال تنظيمه لأعمال التكاثر الجنسي. والجنس كوصف – ذكر أو أنثى – هو اعتراف ببنية جسدية يمكنها ممارسة الجنس كعمل.
هذه البنية ليست فقط هي الطريقة الوحيدة والأفضل لمعرفة جنسك، بل إنها الطريقة الوحيدة لإدراك مفاهيم الذكور والإناث وأدوارهم على الإطلاق. ما الذي يمكن أن تعنيه “الذكورة” أو “الأنوثة” إن لم يكن: قدرتك البدنية الأساسية على واحدة من وظيفتي التكاثر الجنسي؟
يوفر التمييز بين مفهومي الذكور والإناث على أساس البنية التناسلية الطريقة المتماسكة الوحيدة لتصنيف الجنسين. بصرف النظر عن ذلك، فإن كل ما لدينا هو الصور النمطية.
هذا لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل؛ يُفهم الجنس بهذه الطريقة عبر الأنواع التي تتكاثر جنسيًا. لا يجد أي شخص صعوبة بالغة -ناهيك عن الجدل- في تمييز الذكور والإناث من أفراد فصيلة من الأبقار أو أنواع الكلاب. ويعتمد المزارعون والمربون على هذا التمييز السهل في معيشتهم. في الآونة الأخيرة فقط -ولدى البشر وحدهم- أصبح مفهوم الجنس نفسه مثيرًا للجدل!
ومع ذلك، وفي تصريح خبير محكمة مقاطعة فيدرالية في ولاية كارولينا الشمالية بشأن قانون الولاية الذي يتعلق بالوصول إلى المراحيض متعددة الجنس، قالت الدكتورة ديانا أدكنز “من منظور طبي، فإن المحدد المناسب للجنس هو الهوية الجندرية”. أدكنز هي أستاذ في كلية الطب بجامعة ديوك ومدير مركز ديوك لرعاية النوع الاجتماعي للأطفال والمراهقين (الذي افتتح في عام 2015).
قررت آدكنز أن الهوية الجندرية ليست الأساس المفضل لتحديد الجنس فحسب، بل “المحدد الوحيد للجنس المدعوم طبيًا”، وكل طريقة أخرى هي علم زائف، وقالت “إن استخدام الكروموسومات أوالهرمونات أو الأعضاء التناسلية الداخلية أوالأعضاء التناسلية الخارجية أوالخصائص الجنسية الثانوية للقفز على الهوية الجندرية بغرض تصنيف شخص ما على أنه ذكر أو أنثى؛ يتنافى تماما مع العلوم الطبية”.
في إعلانها المحلف أمام المحكمة الفيدرالية، قالت آدكنز عن الأطروحة القياسية للجنس – القائلة بأنه بنية جنسية للكائن الحي- “نظرة عتيقة للغاية للجنس البيولوجي”.
و في رده، قال د. لورانس ماير “هذا التصريح صادم؛ لقد بحثت في عشرات المراجع في علم الأحياء والطب وعلم الوراثة -حتى ويكي!- ولم أجد أي تعريف علمي بديل. في الواقع، إن الإشارات الوحيدة لتعريف أكثر مرونة للجنس البيولوجي هي في أدبيات السياسة الاجتماعية”.
ويجدر القول أن ماير هو باحث مقيم في قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز وأستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة ولاية أريزونا.
يُظهر العلم الحديث أن نظامنا الجنسي يبدأ بحمضنا النووي وتطورنا في الرحم، وأن الاختلافات الجنسية تظهر في العديد من الأجهزة والأعضاء الجسدية، وصولاً إلى المستوى الجزيئي. وبعبارة أخرى، إن تنظيمنا الجسدي الذي يؤدي واحدة من وظيفتي التكاثر هو ما يشكل بنيتنا العضوية منذ بداية الحياة، وعلى كل مستوى من كياننا الإنساني.
لا يمكن للجراحة التجميلية وهرمونات التحول الجنسي أن تنقلنا إلى الجنس المقابل؛ يمكنها أن تؤثر على المظاهر، يمكنها أن تعوق أوتعرقل بعض التجليات الخارجية لبنيتنا التناسلية، لكنها لا تستطيع تغييرها، لا يمكنها ببساطة تحويلنا من جنس إلى آخر.
وكما أوضح ماير “من الناحية العلمية التجريبية، فإن الرجال المتحولين جنسياً ليسوا رجالاً من الناحية البيولوجية، والنساء المتحولات جنسياً ليسوا نساءً من الناحية البيولوجية؛ إن ادعاءات “العكس” لا تدعمها الأدلة العلمية”.
وكما قال الفيلسوف برنستون روبرت جورج ، “تغيير الجنس هو استحالة ميتافيزيقية لأنه استحالة بيولوجية”.
ما الغرض من وراء الطب والعاطفة والعقل؟
ما المبتغى من وراء الجدل القائم حول علاج الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجندرية؟ هناك سؤالان مترابطان: بماذا نقيس الصحة العقلية والرفاه البشري؟ وما هو الغرض من الطب وخاصة الطب النفسي؟
تتضمن هذه الأسئلة العامة أسئلة أكثر تحديدًا: إذا كان لدى الرجل إحساس داخلي بأنه امرأة، فهل هذا مجرد مجموعة متنوعة من الوظائف البشرية العادية، أم أنه مرض نفسي؟ هل يجب أن نشعر بالقلق حيال الانفصال بين الشعور والواقع؟ أم فقط حيال الاضطراب العاطفي أوالصعوبات الوظيفية التي قد يسببها؟
ما أفضل طريقة لمساعدة المصابين باضطراب جندري على إدارة أعراض اضطرابهم؟ أهي قبول إصرارهم على أنهم من الجنس الآخر، ودعم الانتقال الجراحي؟ أم تشجيعهم على إدراك أن مشاعرهم لا تتماشى مع الواقع وتعلُّم كيفية التعرف على أجسادهم؟
تتطلب كل هذه الأسئلة تحليلاً فلسفيًا وأحكامًا عالمية حول شكل “الأداء البشري الطبيعي” وما الغاية من الطب.
تتطلب تسوية الجدل حول الاستجابة المناسبة للاضطراب الجندري أكثر من الأدلة العلمية والطبية؛ العلوم الطبية وحدها لا يمكن أن تخبرنا عن الغرض من الطب.
لا يمكن للعلم التجريبي أن يجيب على أسئلة حول المعنى أو الغاية بالمعنى الأخلاقي؛ يمكن للعلم أن يخبرنا عن وظيفة هذا النظام الجسدي أو ذاك، ولكن لا يمكنه أن يخبرنا ماذا نفعل بهذه المعرفة. لا يمكنه أيضا أن يخبرنا كيف يجب أن يتصرف البشر، إن هذه أسئلة فلسفية، كما أوضحت في كتابي “عندما تحول هاري إلى سالي”.
في حين أن العلوم الطبية لا تجيب على الأسئلة الفلسفية، فإن كل ممارس طبي لديه رؤية فلسفية للعالم، سواء كانت واضحة للعيان أم لا. قد يعتبر بعض الأطباء أن المشاعر والمعتقدات المنفصلة عن الواقع جزءًا من الأداء البشري الطبيعي، وليست مصدرًا للقلق ما لم تتسبب في الضيق. في حين سيعتبر الأطباء الآخرون هذه المشاعر والمعتقدات مختلة في حد ذاتها، حتى لو لم يجدها المريض محزنة، لأنها تشير إلى وجود خلل في العمليات العقلية.
لكن الافتراضات التي قام بها هذا الطبيب النفسي أو ذاك لأغراض التشخيص والعلاج لا يمكن أن تحل الأسئلة الفلسفية: هل من الجيد أو السيئ أو المحايد إيواء المشاعر والمعتقدات التي تتعارض مع الواقع؟ هل يجب أن نقبلها على أنها الكلمة الأخيرة، أم نحاول فهم أسبابها وتصحيحها، أو على الأقل تخفيف آثارها؟
صحيح أن النتائج الحالية للعلوم الطبية -كما هو موضح أعلاه- تكشف عن نتائج مخيبة للآمال على الصعيد النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين خضعوا لعلاجات تغيير الجنس، لكن لا ينبغي أن نقف عند هذا الاستنتاج. يجب علينا أيضًا أن ننظر بشكل أعمق إلى الحكمة الفلسفية، بدءًا من بعض الحقائق الأساسية حول رفاهية الإنسان والأداء الصحي.
يجب أن نبدأ بالاعتراف بأن إعادة تعيين الجنس أمر مستحيل جسديًا. تعمل عقولنا وحواسنا بشكل صحيح عندما تكشف لنا الحقيقة وتقودنا إلى معرفة الحقيقة، إننا نزدهر كبشر عندما نتبنى الحقيقة ونعيش بها. قد يجد الشخص بعض الراحة العاطفية في اعتناق الزيف والوهم، لكن القيام بذلك لن يجعله أفضل حالًا من الناحية الموضوعية. إن العيش بالوهم يمنعنا من الازدهار الكامل، سواء كان ذلك يسبب الضيق أم لا.
هذه النظرة الفلسفية لرفاهية الإنسان هي أساس الممارسة الطبية السليمة. تؤكد د. ميشيل كريتيلا، رئيسة الكلية الأمريكية لأطباء الأطفال -وهي مجموعة من الأطباء الذين شكلوا نقابتهم المهنية الخاصة بهم كرد فعل على تسييس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال- على أن رعاية الصحة العقلية يجب أن تسترشد بالمعايير القائمة على الواقع، بما في ذلك واقع الذات الجسدية.
وتقول: “إن قاعدة التنمية البشرية هي أن تتماشى الأفكار مع الواقع الجسدي، وأن تتماشى الهوية الجنسية للمرء مع الجنس البيولوجي”. ولكي يزدهر البشر، يحتاجون إلى الشعور بالراحة في أجسادهم، والتعرف بسهولة على جنسهم، ويعتقدون أنهم كما هم في الواقع. بالنسبة للأطفال بشكل خاص، يتطلب التطور الطبيعي والأداء قبول كيانهم الجسدي وفهم أنفسهم المتجسدة كذكر أوأنثى.
لسوء الحظ، ينظر العديد من المتخصصين الآن إلى الرعاية الصحية -بما في ذلك رعاية الصحة العقلية- في المقام الأول كوسيلة لتحقيق رغبات المرضى، مهما كانت تلك الرغبات. على حد تعبير ليون كاس، الأستاذ الفخري في جامعة شيكاغو “اليوم يُنظر إلى الطبيب غالبًا على أنه ليس سوى’ حقنة مستأجرة’ ذات كفاءة عالية”.
“فالنموذج الضمني (والصريح في بعض الأحيان) للعلاقة بين الطبيب والمريض هو العقد؛ فالطبيب: حقنة مستأجرة ذات كفاءة عالية، يبيع خدماته عند الطلب، ولا يتقيد سوى بالقانون (على الرغم من أنه حر في منع خدماته إذا كان المريض غير راغب أوغير قادر على دفع أجره). ها هي الصفقة: التحكم الذاتي والخدمة للمريض؛ وللطبيب المال، الذي تشرف المريض بمنحه إياه مقابل الخدمة التي يريد. إذا أرادت مريضة إصلاح أنفها أو تغيير جنسها، أو تحديد جنس الأطفال الذين لم يولدوا بعد، أو تناول عقاقير محفزة للدوبامين فقط بغرض اللهو؛ فللطبيب أن يقوم بذلك، وسيفعل -بشرط أن يكون السعر مناسبًا وأن يكون العقد صريحا بشأن ما سيحدث إذا كان العميل غير راضٍ”.
يقول كاس إن هذه الرؤية الحديثة للطب والمهنيين الطبيين فاسدة. يجب أن يعترف الممارسون بإخلاصهم للقيم والمثل التي يعملون بها؛ ينبغي أن يكرس المعلمون جهدهم للتعليم، والمحامون للعدالة، ورجال الدين للأشياء الإلهية، والأطباء من أجل “شفاء المرضى، والتطلع إلى الصحة والكمال”؛ وكتب كاس أن الشفاء هو: “النواة المركزية للطب”، “الشفاء والتعافي هو العمل الأساسي للطبيب”.
لتقديم أفضل رعاية ممكنة، تتطلب خدمة المصالح الطبية للمريض فهمًا للكمال والرفاهية البشرية. يجب أن تسترشد رعاية الصحة النفسية بمفهوم سليم للرفاه البشري. ويجب أن يبدأ الحد الأدنى من الرعاية بمعيار من الحياة الطبيعية. تشرح كريتيلا كيف ينطبق هذا المعيار على الصحة العقلية.
“واحدة من الوظائف الرئيسية للدماغ هي إدراك الواقع المادي، فالأفكار التي تتوافق مع الواقع المادي طبيعية، والأفكار التي تنحرف عن الواقع المادي غير طبيعية -كما أنها قد تكون ضارة للفرد أو للآخرين. هذا صحيح سواء شعر الفرد الذي يمتلك الأفكار غير الطبيعية بالضيق أم لا”.
صُمِّمت أدمغتنا وحواسنا لجعلنا على اتصال بالواقع، وربطنا بعالمنا الداخلي والخارجي؛ والأفكار التي تخفي الواقع أوتحرفه مضللة، ويمكن أن تسبب الأذى. في كتاب “عندما تحول هاري إلى سالي” أزعم أننا بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون هذه الصراعات.
اقرأ ايضاً: لا وجودَ لما يُسَمى بـ “جينِ المِثْلِيَّةِ الجِنسية”
[1] – شطر بيت قصيدة للشاعر روديارد كلبنج: (عندما تذهب الفوضى والضجيج … فهذا أوان افتراق القادة والملوك)، والمعنى المقصود: عندما لا يكون هناك معركة ولا ضرورة، فليس من الحكمة اختراع معركة مع جسدك والدخول فيها. (المراجع)