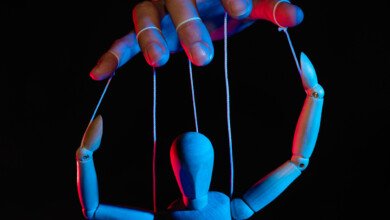منذ الستينيات، تزايدت في الغرب البحوث والدراسات التي تفحص العلاقة بين «الصلاة» -بمفهومها المسيحي- والصحة، كانت تلك الدراسات في بداياتها قد أخذت منحى انطباعيًا، وإن تلبست بما يشبه المنهجية العلمية،
ودعمت الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية هذه الأبحاث ماديا معنويا، وأصبح خطاب “الإعجاز العلمي” في صلب اهتمامات الواعظين والمبشرين، تماما كما هو حال بعض المسلمين هذه الأيام.[1]
وتأثرًا بهذه النقلة ظهر في التسعينيات وأوائل الألفية حقلُ “الإعجاز العلمي” اعتمادًا على آيات القرآن الكريم،
وكان لهذه الموجة صدى واسع بين مؤيد ومعارض، ولست هنا بصدد تحليلها فقد كُتبت فيها أبحاث موسعة[2]
ونحن في شهر القرآن، رأيت كثيرا من الأفاضل يتحدثون عن تفاسير “علمية” لبعض الآيات، سواء نقلها عن غيره أو”اكتشفها” بنفسه، و لستُ هنا أيضا بصدد تتبُّع تلك الجزئيات،
سأشير فقط إلى قواعد عامة لضبط التعامل القرآن في هذه المسألة مع التدليل بأمثلة مشهورة:
أولا: القرآن ليس كتابا في الفيزياء أو الأحياء… أوغير ذلك من العلوم، و لم يكن من أهداف إنزاله بيان شيء من ذلك.
تلك قاعدة يعرفها القاصي والداني، ويجب أن تكون حاضرة في ذهن كل من يتعرض لتفسير آيات القرآن.
وعموم قوله تعالى (وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) لا يخالف هذه القاعدة، فالمقصود هنا “عموم عرفي، من دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع: من إصلاح النفوس، وإكمال الأخلاق، وتقويم المجتمع المدني، وتبيان الحقوق… وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصف أحوال الأمم، وأسباب فلاحها وخسارها، والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ، وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم” [3] ويشهد لذلك قول مجاهد بأن معنى الآية: تبيان الحلال والحرام[4]. وهذا المعنى معروف لدى المفسرين، لكن المشكلة “أن كثيرا ممن كتب في الإعجاز العلمي ليس ممن له قدم في التفسير”[5] لذا، لم يأت كلامهم عن الآيات على سنن ومنهاج المفسرين.
ثانيا: عناية الأمة بالقرآن تفسيرًا وفهمًا واستنباطًا= فاقت عناية أي أمة بكتابها، حتى احتاجت الكتب المصنفة عن القرآن إلى كتبٍ لتصنيفها و ترتيبها![6] وما هو منشور من كتب سواء في التفسير خصوصا أوفي علوم القرآن عموما= لا يبلغ عُشر المخطوط منها.[7]
وعناية الأمة بالقرآن بدأت والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فلم تكن الأمة غافلة عن كتابها حتى بداية القرن العشرين والثورة العلمية.
تلك مُسلَّمات يجب أن تكون حاضرة لدى كل متكلم في القرآن.
ثالثا: و هو مترتب على ما قبله، لا يصح عقلا و لا شرعا الافتئات على ذلك الجهد الذي لا مثيل له و الإتيان بجديد “شاذ” عن معنى الكلام في لغة العرب أوطرق المفسرين.
وهنا منشأ الغلط؛ فإذا كانت عناية الأمة بكتابها على هذا القدر من العمق، فإن تجاوز ما سطره العلماء وتتابعوا عليه إما نقلا أو استنباطًا، والإتيان بقول “شاذ” عن منهجهم، ولا تعرفه العرب من كلامهم= أمرٌ غير مقبول.
بل إن أي متخصص لو افتأت عليه أحدهم في تخصصه وجاء بقول يخالف به معهودَ المتخصصين ما قُبِل ذلك منه، فكيف تصير الآيات كلأً مستباحا يخوض فيه كل من قرأ ورقتين في علم من العلوم دون أدنى دراية بأبجديات القول في كتاب الله!
والمسألة هنا ليست مجرد الإتيان بجديد، بل الجديد “الشاذ” الذي لا تعرفه العرب ولا يحتمله الكلام هو الذي يُرَد على صاحبه؛ فالتفسير له طرق ومناهج، والإعجاز العلمي يدخل في باب التفسير بالرأي[8] وقد وضع العلماء ضوابط وأصول يجب على كل متكلم في كتاب الله اتباعها، كما يتبع أي أحد قواعد وسنن أي تخصص آخر يريد أن يتكلم في مسائله.
رابعا: هذا القرآن خوطبت به قريش والصحابة رضوان الله عليهم، فلا يمكن عقلا أن يخاطب الله هؤلاء بما لا يمكنهم فهمه وإدراكه، أوبما لم يكن معهودًا لديهم؛
بمعنى: أن لو كان قوله تعالى (كانتا رتقا ففتقناهما) محمولا على نظرية الانفجار العظيم، وهم لا سبيل لهم للعلم بتلك النظرية كما هي اليوم، لجاز أن يخاطب الله الناس بما لا تقوم به الحجةُ عليهم، وهو معلوم الفساد؛ فما لا تعرفه العرب من كلامهم لا يجوز حمل الآية عليه.
حيث “يلاحظ على أصحاب الإعجاز العلمي عدم مراعاة مصطلحات اللغة والشريعة، ومحاولة تركيب ما ورد في البحوث التجريبية على ما ورد في القرآن، ومن الأمثلة على ذلك: أن القرآن يذكر عرشا وكرسيا وقمرا وشمسا وكواكب ونجوما… ومصطلحات العلم التجريبي المعاصر زادت على هذه، وذكرت لها تحديدات وتعريفات لا تُعرف في لغة القرآن ولا العرب، فحملوا ما جاء في القرآن عليها، وشطّ بعضهم فتأول ما في القرآن حتى يوافق ما عند الباحثين المعاصرين؛ فبعضهم جعل السماوات السبع هي الكواكب السبع السيارة، وجعل الكرسي هي المجرات التي بعد هذه المنظومة الشمسية والعرش هو كل الكون”[9] ولا شك أن ذلك كله شطط وليٌّ لأعناق النصوص وإن لم يسمه أصحابه كذلك.
خامسا: إن ربط معاني الآيات بالنظريات العلمية هو جهل بالوحي وبحقيقة المعرفة العلمية.
فإن طبيعة المعرفة العلمية نفسها مغايرة تماما لما يتصوره البعض. فلو قلنا أن آية الأنبياء محمولة على الانفجار العظيم، فإن ملابسات النظرية مختلفة تماما عن ظاهر الآية، وأصحابُها لا يعنيهم شيئا لو ثبت خطؤها بعد عام أوبعد مئة، لكن من سيقع في المحظور هو من ربط معنى الآية بنظرية علمية تتغير بين ليلة وضحاها.
فالمتفق عليه هو أن الكون حادث، لكن تفسير حدوثه ليس من المتفق عليه بين الفيزيائيين، كما أن تفاصيل النظرية لا تحمل المعنى الذي يرمي إليه هؤلاء، فلا يوجد ما يمنع عقلا من تفنيد نظرية الانفجار العظيم وأن تحل محلها نظريةٌ أخرى؛ فتفسير حدوث الكون ليس مقصورا على نظرية بعينها.
كما أثير على هذه النظرية إشكالات عدة من بعض علماء الفلك، مما جعل بعضهم يرفض هذه النظرية.
كما فُسِّر حدوث الكون بنظريات أخرى غيرها. ومع أن النظرية فيها بعض الحقائق -كدلالتها على الخالق، وإبطال أزلية الكون- إلا أن فيها ما ينافي الشرع كالصدفة في الخلق، ونفي أن يكون ثمة خلق لله قبل خلق السماء والأرض، ولازالت معضلة المفردة singularity التي جاء منها الكون تقف حجر عثرة أمام النظرية.[10]
فالنظرية ليست كما يتخيل البعض، والشيء المؤكد: أن المفسرين عندما وصلوا إلى هذه الآية لم يقولوا “أمروها كما جاءت”حتى يأتي لومتر عام 1927 ويقدم لنا الفرضية التي تفسر الآية، بل إن المفسرين لم يجدوا مشكلة أصلا في التعامل مع هذه الآية اعتمادا على سياق السورة ومعهود العرب من كلامهم، كما هي عادة المفسرين عموما.[11]
وللمفسرين في الآية ثلاثة اتجاهات:
الأول: أن السماء والأرض كانتا ملتصقتين، فرفع الله السماء عن الأرض، وفصل بينهما بالهواء.
وهو مروي عن ابن عباس وقتادة والحسن وسعيد بن جبير.
الثاني: أن الفتق حصل بجعل السماء سبع سماوات طباقًا بعضها فوق بعض، وجعل الأرض سبع أرضين بعضها تحت بعض؛ وهو مروي عن مجاهد، والسدي، وأبو صالح الحنفي.
الثالث: أن فتق السماء بالمطر بعد أن كانت رتقًا لا تمطر، وفتق الأرض بالنبات بعد أن كانت رتقًا لا تنبت؛ وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعكرمة، وعطية العوفي، وابن زيد، ومجاهد، ورجحه الطبري وابن عطية.[12]
وما قيل عن الانفجار العظيم يقال عن علاقة الثقوب السوداء بقوله تعالى (الجوار الكنس)[13]، فكيف تكون الآية مُعطَّلة عن مفهومها حتى تقديم فرضية الثقوب السوداء في القرن العشرين؟ بل لن نكون مبالغين لو قلنا أن عامة التفاسير في هذه الآية تتجه اتجاها آخر غير الذي وجهها إليه من فسرها بالثقوب السوداء، ولم يكن من الممكن أن تدل الآية على معنى خارج عما تتابع عليه المفسرون لولا سطوة وهيمنة النزعة التي تريد تطويع كل نص للمخرج العلمي.
فعامة التفاسير تدور حول أن “الكنوس” في الآية من كِناس الظبي أي بيته، أما جعله من كَنَسَ يكنِس بمعنى الاختفاء الكامل ليتوافق مع النظرية= فهو معنى لم يقل به أحد[14].
ولو كان هناك فهمٌ مستقيم للمنتج العلمي وطبيعته ولمعاني الوحي ودلالاته= لكُفِينا تلك التأويلات.
والمقصود: أن ما لم يكلفك الله به فلا تتبعه؛ ابحث عن عمر الكون في كتب الكوزمولوجيا والفلك، و ابحث عن الثقوب السوداء في الفيزياء الكونية، أما البحث عن ذلك في القرآن فهو بحث في غير محله.
سادسا: هل نحتاج الإعجاز العلمي أصلا؟
بداية، هذه التسمية مشكلة في ذاتها، وتنم عن إشكالية أخرى وهي: أن ما لم يكن من جنس التجريب، لا يسمى علمًا. فلماذا تُخص موافقة آيات من القرآن ونصوص من السنة لمفاهيم ومكتشفات تجريبية حديثة بمفهوم الإعجاز “العلمي”؟ فماذا نسمي الإعجاز اللغوي الذي هو أبين وأظهر؟ فهو إعجاز أيضًا، بل بابه أعظم وأضبط من ذاك. ولماذا لا تُدرج معالجة القرآن الفريدة لدواخل النفس البشرية وقدرة تشريعاته على الموازنة بين أبعاد النفس المختلفة مما ظهر مؤخرًا في علم النفس وعلم الاجتماع، لماذا لا تُدرج هذه ضمن الإعجاز العلمي؟ لماذا لا يقال أن كتابًا أُنزل قبل خمسة عشر قرنا ولازال قادرا على معالجة وهداية إنسان القرن الحادي والعشرين هو بحد ذاته معجزة علمية؟
كل هذه الإشكالات تنم عن صدوع داخل المنهجية “العلمية” في التعامل مع آيات القرآن، وتدل على أن إعجاز القرآن أوسع بكثير مما ضيقه مفهوم الإعجاز التجريبي.
وأما عن السؤال “هل نحتاج الإعجاز العلمي؟” فالجواب أنه لا يتوقف شيء من صحة الوحي ثبوتًا و دلالة على أي نظرية علمية، كما أنه من المفترض ألا يتوقف إيمانك واتباعك على شيء من ذلك، فما الفائدة منه؟
إن دلائل صحة الرسالة والوحي أعظم وأكبر من ربطها بالنظريات العلمية الظنية، بل إن في هذا الربط بين الآيات والنظريات العلمية نزولا بها عن مرتبتها في اليقينية والثبوت، وإن ما تولده براهين الوحي بمفردها من اليقين أضعاف ما يولده ربطها بأمور علمية.
فمن الناحية الدينية: ليس هناك نص في القرآن ولا في السنة يتوقف العلم بمقصوده ومعناه على نظر من بيولوجي أوفلكي أوفيزيائي أوغيرهم، ولا يتوقف شيء مما كلف الله به عباده تجاه وحيه -حتى التدبر- على معرفةٍ بشيء سوى فطرة سليمة ودراية بلغة العرب.
سابعا: لو كان هناك آيات قد يحتمل ظاهرها الإعجاز العلمي، فإن الإعجاز العددي على ما هو عليه الآن= قد تلبس بمفاسد عظيمة مثل خرق الإجماع ومخالفة الرسم العثماني والخروج عن المعهود في طرق عد الآي، و ليس ذلك من العلم ولا من الدين في شيء.
فعدد آيات سورة يوسف لا يدل على عمره، ورقم الآية التي ذكر فيها إنزال الحديد لا علاقة لها بالعدد الذري لعنصر الحديد، ورقم ٧ ليس له دلالة خاصة في القرآن، وغير ذلك من الأعداد لا يدل دلالة خاصة على شيء؛
ومرة أخرى: ثبوت القرآن والرسالة لا يتوقف ولو واحد بالمئة على هذه التأويلات، بل لا يُفترض أن يزيدك إيمانًا أصلا.
وختاما
“لا شك أن القرآن الكريم جاء بما يعجز البشر عن الإتيان به، وما يسمى الآن “الإعجاز العلمي” بصورته الحالية= فيه خلل كبير من الناحية الشرعية؛ ومن الناحية التجريبية كذلك؛ وأكثر التفسير الواقع بالإعجاز العلمي هو محض جهل وتخرص؛ وعدم مراعاة لحقوق السلف وتفسيرهم، مع الخلل الشديد والمفاسد المترتبة على تطبيق العلم التجريبي على نصوص الوحي…
ولو تأملت أكثر الذين اهتدوا بسبب القرآن؛ ستجد أنهم لا يذكرون (الإعجاز العلمي) إلا على سبيل الندرة!؛ بل بعضهم يهتدي بمجرد السماع، وبعضهم بفهم المعاني، وأسباب كثيرة ليس الإعجاز منها”[15].
[1] – العلاقة بين الصحة والدين والإعجاز العلمي، يوسف الصمعان، مقال منشور في جريدة دنيا الوطن.
[2] – انظر على سبيل المثال (الإعجاز العلمي إلى أين) للدكتور مساعد الطيار.
[3] – التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، 15/253.
[4] – تفسير القرآن العظيم، بن كثير، 4/277، و جامع البيان، الطبري، 14/ 333.
[5] – الإعجاز العلمي إلى أين، مساعد بن سليمان الطيار، ص20.
[6] – انظر: الدليل إلى القرآن، عمرو شرقاوي، ص123 ومابعدها.
[7] – المحرر في علوم القرآن، مساعد الطيار، ص35.
[8] – الإعجاز العلمي إلى أين، مساعد الطيار، ص19.
[9] – المرجع السابق، ص22.
[10] – للاطلاع على بعض إشكالات الانفجار العظيم انظر: https://science.howstuffworks.com/dictionary/astronomy-terms/big-bang-theory7.htm .
[11] – يراجع تفسير الآية في مظانه فللمفسرين تحرير لطيف لمعنى (الرتق) و(الفتق).
[12] – انظر: جامع البيان، الطبري، 18/431.
[13] – الإعجاز العلمي إلى أين، مساعد الطيار، ص59 ومابعدها.
[14] – المرجع السابق، ص60.
[15] – الدليل إلى القرآن، عمرو الشرقاوي، ص83.