تحرير: عبد الرحمن الجندل
يعيشون حياتهم في أمان الله، بين منازلهم ومقرات أعمالهم، يتذمرون من الروتين أحيانا، فإذا بهم يُحبسون في منازلهم، وتغلق عنهم أماكن عملهم، فيتمنّون الروتين الممل ويعتذرون له عن تذمرهم منه. هذا بعض ما فعله كورونا بسكّان العالم!
ذكر ستيف ألبرت في كتابه “إدارة الأزمات” ست سمات للأزمات، وهي: المفاجأة، ونقص المعلومات، وتصاعد الأحداث، وفقدان السيطرة، وحالة الذعر، وغياب الحل الجذري السريع. ولا يخفى أن أزمة فايروس كورونا قد أخذتنا -على غفلة منا- في رحلة إلى هذه المحطات الست وما زلنا عالقين في بعضها.
انهمك الكثير في متابعة أخبار الأزمة خائفًا يترقّب، وقلّة استمرت حياتهم كما هي، وكأن العطالة والجلوس في البيت أصبح ميزة للمرة الأولى في الحياة! وبين هؤلاء وأولئك، ثلّة استطاعت التأقلم مع الأوضاع، فكوّنوا حياة جديدة متصالحة مع الخوف ومكتفية بالمنزل، مع بعض العادات التي أسعفهم تكوينها قديمًا.
يُعرّف إدغار موران الثقافة بأنها “ألا تكون مجردًا من السلاح حين تواجهك المشكلات”، فإذا لم تنفع الثقافةُ المرءَ بمثل هذه الأوضاع فمتى ستنفعه؟!
ملجأ القراءة
أود الحديث عن القراءة كملجأ في الأزمات، عن الكتب التي تتحول من ورق على أرفف المكتبة، إلى أغطية تحميك من العواصف وتربّت على كتفك في المآسي.
يحكي الناقد العراقي عبد الله إبراهيم في سيرته “أمواج” الكثير من المواقف الصعبة التي كانت فيها الكتب ملاذه الأول، منها علاقته الوطيدة مع رواية ماركيز الشهيرة “مئة عام من العزلة” إذ يقول: “آخر قراءاتي للرواية، وهي الرابعة، كانت في صيف عام 84م حينما أُمرتُ بالتوجه إلى جبهة الحرب بين العراق وإيران، وأنا ضابط مُجنّد، فأتيت عليها بشغف القراءة الأولى بين تلك الجبال الشاهقة فيما وراء مدينة «قلعة دِزَه» آخر مدينة بمحاذاة الحدود مع إيران ليس بعيدًا عن جبال «قنديل» حيث يتمركز «حزب العمال الكردستاني التركي» في شعابها. وما نسيتُ الظهيرة التي غمرت فيها قدمي في مياه النهر المثلجة في شق عميق بين الجبال، وأنا أقرأ الفصل الذي يصور نجاح (أورليانو) في فك رموز رقاق «ملکیادیس» في وقت أحدثت فيه مدافع الإيرانيين عاصفة ترابية بقنابلها على قمة جبل «بيرنك» بارتفاع أكثر من ستة آلاف قدم فوق هامتي. وبتأثير من «مئة عام من العزلة» تغيرت تصوراتي عن الكتابة السردية، فطفقت أتخيل مكانًا تدور فيه أحداث قصصي ورواياتي الآتية على غرار «ماکوندو». وعلى هذا سوّدت عشرات الصفحات، أرسم شخصيات سرابية، كلها ذهبت أدراج الرياح، ولم يبق منها سوى خواطر ملأت يومياتي، ووعود ما تحققت قط، سوى ما جاء في كتابي «رمال الليل» الذي تدور وقائع قصصه كلها في مكان واحد دعوته «الخشم الأحمر». وصدر في عام 1988م إبان عملي باحثًا في وزارة الخارجية لأربعة أشهر أو دون ذلك”.
وفي 1990م بعد انتهاء الحرب العراقية وخروج الجيش العراقي من الكويت، يصف الدكتور المشهد المحلي: “لم تصبح الحرب ذكرى ككل الحروب، إنما آلت كابوسًا، فقد ضرب العوز والذل مجتمعًا بأكمله؛ فتولى الناسَ إحباطٌ استحال سخطًا مدمدمًا، لكن النظام كبح الغضب. لم يترك الحلفاء بلدًا مُزّق أشلاؤه، إنما جرّدوه من قوته العسكرية، والاقتصادية، والسياسية، وضُرب طوق خارجي وداخلي على البلاد، وفيما نبذ العالمُ العراقيين في الخارج، أمعن النظام داخليًّا في قمعهم، فكان أن تشكل ضدهم حلفُ كراهية بين الخصوم”.
ماذا كانت ردّة فعل عبد الله إبراهيم في تلك الأوقات العصيبة؟ يقول: “أمسكت أنا عن متابعة الشؤون العامة لمئة يوم كاملة، فلم أكتب حرفًا واحدًا عن تداعيات الأحداث، إنما انصرفت إلى قراءات تُنسيني هواجس القلق خلال الأشهر الفائتة”. وهكذا تكون الكتب الملجأ والملاذ هربًا من العصف المتبادل من حولك.
وفي 2003م وهو في الدوحة، تتفجّر الألعاب النارية في الطرقات، وتتناثر أوراق البارود على السيارة ومن حولها، وكُتل الانفجارات المضيئة تملأ السماء وتصم الآذان. وفي الوقت الذي كشفت فيه العراق عن وثائق خاصة، ومواد كيماوية أنكرت وجودها من قبل، ووقت انهمكت فيه الدول الكبرى في صراعات دبلوماسية حول شروط تجريد العراق من قواته، يقول: “عشت حال القلق بحدّها الأقصى، الحال التي مررت بها عشية حرب 1990م، فانكببت على القراءة كما فعلت من قبل”.
تكثر في مثل هذه الأوقات التي يمنع الخروج فيها من المنزل الفعاليات الثقافية عن بعد، محاضرات، لقاءات، أمسيات شعرية، إصدارات أدبية تحاول معالجة موضوعات الوباء، وقد يجد القارئ المهتم بمثل هذه الفعاليات أُنسًا وأمانًا يُبعده عن التفكير في الحياة الصعبة التي يمر بها العالم.
كتب فاضل العزاوي سيرته الذاتية “الرائي في العتمة” عن الغربة والمنفى مع استذكار لمراحل الصبا والمراهقة والتكوين الثقافي، ويستحضر من ذلك نشاطه الثقافي في مختلف المجالات وفي أحلك الأوقات، ومن ذلك قوله: “كان عملي في مجلة ألف باء الثقافية نوعًا من “البحث عن ملجأ آمن في زمن الحروب”. وهو عين ما فعله الأديب المصري علاء الديب الذي لجأ إلى الإكثار من كتابة مراجعات الكتب في الجرائد والمجلات الثقافية هربًا من الانشغال السياسي الذي جذب كثيرًا من مجايليه المثقفين، لكنه وجد أمانَهُ -حسب تعبيره- في التعريف بالكتب والحديث عنها، فذلك أكثر جدوى من الصراخ مع الصارخين حيث لا مستمع، ليُخرج لنا بعد ذلك مؤلفًا من أجمل ما كُتب في مراجعات الكتب بعنوان: “عصير الكتب” في جزأين.
كرم الكتب ليس محصورًا في أوقات الأزمات العامة كالحروب والجوائح الصحية؛ قد تكون الأزمة فردية، اضطراب أفكار، صراع آراء، غربة وطن، فتلجأ لأحضان الكتب. وهو ما حصل مع الدكتور عبد الواحد الحميد في مراهقته بمدينة سكاكا الجوف، شمال السعودية والتي يصفها بأنها مرحلة تحوّل حرجة، ويقول: “لقد كنت أجد فجوة واسعة بين بيئتي الجغرافية والاجتماعية المحدودة وبين العالم اللامحدود الذي أجده في الكتب والقراءات المختلفة. ولم يكن من الممكن، في تلك البيئة، أن يتحدث المراهق عما يجول في خاطره من أفكار قد لا تكون مقبولة، كما كان من المستحيل طرح أسئلة صريحة تجيب على الشكوك والتناقضات والأفكار التي تضطرب وتغلي داخل النفس الحائرة المتسائلة عن قضايا وجودية كانت تؤخذ كمسلمات لا يجرؤ أحد على التعمق في معانيها ودلالاتها وأسرارها. وكان أسوأ من يمكن مناقشته في هذه القضايا هم كبار السن ومعلمي المواد الدينية، فهؤلاء إجاباتهم جاهزة مستمدة من نصوص دينية لا يجوز مناقشتها.
ولكن، مرة أخرى، تبرز القراءة كملجأ ظليل يلتقط فيه الإنسان أنفاسه ويبحث بنفسه عن الإجابة عما يعتمل داخله من تساؤلات بكل صراحة ومن دون مواربة، وعندما تكون الإجابة غير مقنعة يبحث عن إجابات أخرى في كتب أخرى”.
الاختيار الصعب
اختيار الكتاب من أكثر مراحل القراءة صعوبة، وخاصة بعد كتاب ماتع، إذ تضطرب المعايير وتتباين الأذواق، فكيف باختيار الكتاب المناسب للأوقات الصعبة، إذ يشتد الحذر خوفًا من كتاب يزيد الأرق أرقًا، ويُعتم الليل أكثر، ويتحول إلى عاصفة شعواء، بدل أن يكون غطاء دفء يستلذ به القارئ.
يحكي الشاعر أدونيس في كتابه “المحيط الأسود” عن واحدة من حالات معاناة اختيار الكتاب في الأزمات، ويقول: “في البيت، في الليلة (…حزيران 1982)، في زاوية كنا نحسب أن الصواريخ قد تخطئها وإن أصابت البيت. كيف خطر لي أن أقرأ شعر المجنون، وما الذي كان يقرّب إلي قيس بن الملوح في تلك اللحظات المرعبة؟ أهي صداقة الانفراد والسفر في فضاء الأعماق؟ أم هي صداقة الشعر الذي يتجاوز الزمن؟ أم لعلها ذاكرة الحب وقد اسْتُنفِرت لكي تجابه الموت الذي يهدد ويطوّق ويهجم؟”
ويُكمل المقال محاولًا اكتشاف سر جاذبية المجنون الذي دفعه لقراءته في هذه الليلة العصيبة دون أن يضع يده على موضع الجرح بل تستمر الأسئلة المفتوحة والمقاربات المتوقعة. لكنها تدفعه للتنظير لكيفية قراءة الشعر إذ يقول: “أظن أن لحظة الشعر، إبداعًا وقراءةً، هي كلحظة الولادة والموت: جسد؛ فلا يُقرأ الشعر حقًّا إلا كما يكتب، بنبض القلب وحركة الجسد، حيث اللغة طاقة، والكلمة عضلة، وإخصابٌ، وتفجّر.
ومن يقرأ الشعر ببرودة الذهن لن يقرأ: لن يرى من الغابة إلا رؤوس الشجر، ومن الوردة إلا مادتها المادية-الورق والعود؛ لن يرى الغابة ولن يرى الوردة.
والجسد حالات-زمن متقطع. أنت في حالة معينة تقرأ شاعرًا بتعاطف تفقده في حالة مغايرة؛ لذلك تستلزم قراءة شعر معين حالة معينة، وتستلزم القدرة على قراءته بالجسد كله. دون ذلك تكون القراءة باردة برودة اليوميّ المبتذل. تكون أنت -قارئ الشعر- أول من يقتل الشعر”.
الكتب أمان، ملاذ، مهرب، وطن. عدّد ما شئت من الأوصاف التي ستعرف حقيقتها بعد أن تعيشها، وستظل تعتقد بمبالغتها طالما كنت بعيدًا عن أجوائها. لا تنتظر أن تعصف بك الأزمات حتى تلجأ للقراءة؛ فالكتب نعم كريمة على أصحابها لا على الغرباء عنها، تحتاج إلى ألفة ومودة بعد طول صحبة ورفقة حتى تستفيد من دفئها.
يقول ابن المقفع: ”العِلم زينة في الرَّخاء، وملاذ عند المِحن”.
اقرأ وقت الرخاء تأمن بالكتب وقت الشدّة.

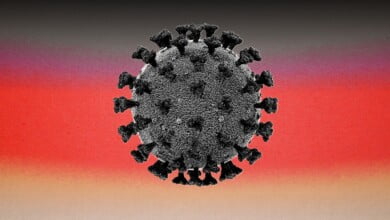



مقال جميل ورائع جعلت من القراءة كشمس تشرق للقارئ وظلمة وليل لمن يجهلها فهي تلك المتعة لمن أردها وهي الأنيس لمن كان وحيدا وهي العلم لطالبها وهي العالم الآخر لمن يعشق السفر. نفع الله في علمك ومعرفتك.
?