فريد أكوزال
شيءٌ أوّل مؤكّد هو أننا-بحقّ-فُقراء إلى القرآن، فُقراء إلى كلامِ الله، كما أن وجودَنا افتقَر قبلُ، ويفتقرُ الآن وسيفتقرُ بعدُ، إلى الله وحده. وليسَ يكتملُ للإنسانِ وعيُه بتلكم اللحظات المفترقةِ من وجودِه، إلا بشيءٍ من كلام الله، ذلك الحين الذي لم يكن الإنسان فيه شيئاً مذكوراً، الذي حولَه نقرأُ قولّ ربّنا:﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾؛ وهذه الساعة، ونحنُ في الدنيا، التي حولَها نقرأ قولّ ربّنا:﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾إلى هنالك حيثُ مرجعنا، الذي حولَه نقرأُ قولَ ربّنا:﴿ إليَّ مَرْجِعُكُمْ فأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فكيفما قُرئَ القرآن، ومِمَن قُرئَ القرآن، إلا وكانَ رجوعُه إليه؛ كافياً في حمدِه ومدحِه، ولا يمنعُ هذا بدورِه في تقليب النّظر في علاقتِنا بقراءِته وتلاوَتِه، طلباً للتحسين والتجويد.
ولهذا المقصد بالذات، طرحتُ سؤالَ العنوان وأنا متعمّد الحديثَ “عنّا” نحنُ، دونَ من سبقونا من أجيال المسلمين إلى غايةِ عصر النبوّة. ذلك أنّ التساؤل عن “قراءة القرآن”، مع ما لها من خصائص ثابتة لا تتغيّر؛ تستحقّ أحياناً قدراً من الخصوصيّة، والعصريّة، حينَ تناوُلنا إياها. تماماً، كما تستحقّ ذلك جميع الأسئلة الأخرى المتّصلة بها، كالتي تروجُ بالخصوص مع حلول شهر رمضان، باعتبارِه موسماً من مواسم الطاعات، وباعتباره بالخصوص موسمَ القرآن، فيكثر السؤال حولَ الطريقةِ المثلى لاغتنام الأجر في قراءتِنا للقرآن الكريم، بعبارات وأساليب مختلفة : تارةً نشهدُ موازنةً بين “كثرة الختمات” و”الختمة الواحدة”، وتارةً بين “القراءة التعبدّية” و”القراءة التدبّرية”، وتارةً بين “الترسّل” في التلاوة و”الإسراع” فيها، وأحياناً أخرى بين “الترتيل” نفسِه و”التدّبر”، دون غيرها من التفضيلات، التي تقابل تلاوة القرآن نفسه بأعمالٍ أخرى فاضلة كطلبِ العلمِ، باعتبارِه ألصق الأعمال به.
ولستُ أقرأ هذا السؤال -مستحضراً سياقَ ما نعيشُه في علاقتنا العامّة بالقرآن- إلا وأجدني أُخَطِّئ الخطابَ المركّز على “الإكثار من الختمات” في مقابل التدّبر، لا لأني أرى أولويّةً آنية في الدّعوةِ إلى التّدبّر (فليسَ هذا مناطاً للحكم، مع كونِه تقديراً للظرف)، وإنما لما أجدُه في هذا القولِ من إساءةِ فهمٍ للسؤال في نفسِه. ذلك أني أتساءل: هل ثمةَ مدخلاً أو إمكانيّةً ما، حتى نفهمَ فعلاً هذا الاستفسار من شخصٍ متلفّظ به في القرن الواحد والعشرين، بنفس طريقة فهمنا لعين السؤال، وبنفسِ العبارةِ، لكن هذه المرّة من أشخاصٍ من القرون الأولى الهجرية؟ لا أتصوّر هذا إطلاقاً. وكيفَ يكونُ هذا، وقِراءتُنا الآن للقرآن، حتى مِمّن يُحسنُ العربيّة مّنا، لا تبلُغ به مبلغَ زعم كونِ قراءتِه للآية أو السورة من القرآن، مماثلة لقراءة عربِ القرون الأولى لهُ. هؤلاء الذين، حتى لو عمَدوا إلى السّرد، والإسراع في التلاوة، لكانت قراءتُهم باقيةً على فهمِ الحدّ الأدنى، مما تنطقُه ألسنتهم، ولا تتجاوز شفاههم إلا ويكون لهم قدرٌ من معانيه في أذهانهم. فكان السؤال إذ ذاك، في المقارنة بين الإسراع والتّرسّل، لا عن القراءةِ الدّنيا -الموصلَةِ للحدّ الأدنى من قراءَته-إذ كانَتْ -ولابدّ-حاضرة، سواء مع التأني أو مع الإسراع، وإنما عن القراءة العليا، الحامِلةِ على تحريك القلبِ مع كلّ مشهدٍ من مشاهِد القرآن تدبّراً وتفكّراً. أمّا الآن، فالسؤال دائرٌ حولَ القراءة الدّنيا، الذي يكونُ الإسراع مانعاً من موانِع حصولِها.
ينبغي لهذا أن نفهمَ أننا في عصرنا، حينما نتخيّر بين “الختمات المتعدّدة بلا تدبّر” وبين “الختمة الواحدة بتدبّر”، فإننا لا نضحّي في حقيقة الأمر بالمعاني اللطيفة والدقيقة -بعيدة المنال-طلباً للقراءة الدنيا المحقّقِة للمعاني الظاهرة من قراءة القرآن، وإنما نضحّي بالقراءة نفسِها، في أدنى مستوياتِها. وأكثرُ ما يُفهمُ الآن حينَ وضعِ “التدبّر” جانباً، هو وضعُ الفهمِ المبدئي الأوليّ والأساسي جانباً. هكذا نكونُ قد ترجمنا السؤال ترجمةً لا يكونُ معها الجوابُ بـ “نَعم”، إلا ممّن يرى فضلَ فهمِ كلامِ الله نفسِه، أقلّ فضلاً من نُطقِ حرفٍ من حروفِه، وليسَ يوجدُ نصّ وحيدٌ يُصرّحُ بتفضيلٍ كهذا فيما نسمَعُ من ترجيحات، بل جميعُها مؤكّدة على الفضلِ العظيم للتلاوة، فلا هيَ تُقارنُ بين هذا الفضل العظيم، وفضلِ تعلّم وفهمِ الحدّ الأدنى من القرآن، ولا هي تخرُج بالقراءة عمّا هو معروفٌ من معنى القراءة في اللفظِ الشرعيّ، من كونِه “تلفّظاً بنيّة” –أي: القراءة الدنيا التي نتحدث عنها ههنا.
وإنما جاءتَ دعوى “الإكثار من الختمات” من مدخلِ إنزال الخلافِ القديم (بين فقهائنا الأوائل) على الاستفسار المعاصر عن التفضيل والتخيير بين التلاوة بلا تدبّر، والتلاوة بتدبّر، لافتراضها تماثل معنى “القراءة” لدى المستفسرين المعاصرين، والمستفسرين من السلف. فـ”القراءة” بمعنى مجرّد النطق اللساني دونَ الوعي بأدنى معاني ما ننطقُه، لم تكُن يوماً مما يقوم عليه معنىً واحِدٌ من معاني التعبّد الشّرعي، بدايةً بـ “اقرأ” التي كانتْ أوّل ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلّم، وصولاً إلى كافّة العباداتِ التي لا يكونُ النّطق فيها، إلا وتكونُ “النّية” فيها مقام فهمٍ للحدّ الأدنى من إدراكِ منطوقها. ولهذا كانت المقابلة أصلاً بين “القراءة التعبّدية” والقراءة التدبّرية” فيها ما فيها من الإبهام. إذْ إرجاع الإكثار من القراءة والتلاوة لدى السلف، في موسم كموسم رمضان للتعبّد، لم يكُن إرجاعا لانتفاءِ عقليّتها، وإنما فقط في كونِ الإكثار لا مدخل تفسيريّ له، إلا من مدخلِ اغتنام أجر الحرف بعد الحرف. بعبارةٍ أخرى: إنّ هذا ينطوي على إساءة فهمٍ لمعنى “التّعبّد”. ذلك أن المتحدثين من السابقين عن علاقة التعبّد بالمعنى العقلي لم يكُن من ناحيّة حضور عقلِ، وفهمِ، وذهن المتعبّد نفسِه، وإنما من ناحية التأسيس العقلي للعبادات فيما يقابلها من المعاملات مثلا. وإن قال قائل أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها) [رواه الترمذي:2910] ؛ تعليقٌ للأجر بالحرف بالنطق وبلا مزيد . فجوابُ ذلكَ: أن الحديث عن أجر النطق في نفسِه؛ نعم، لكن أجر الفهم هو الآخر ثابت، وحديثنا نحنُ ههنا عن الأفضل، لا عن نفي الأجر عن النطق في نفسِه. وهذا الخلطُ من جديد هو الذي يأخذ في الغالبِ إلى إجراء النصوص والآثار، حول الإكثار، والإسراع في التلاوة على أحوالنا المعاصرة. والذي أزعمه هنا -وقد أكون مخطئًا في هذا -هو أن: قراءة السابقين مع سرعتِها لا تخلو من فهمِ الحدّ الأدنى من المقروء والمتلو، فمقارنتُنا بها؛ فيها من هضم واجبنا من تفهّم القرآن خصوصاً خلال رمضان، ما فيها.
ما المطلوب إذاً؟ المطلوب: أن تكون سرعةُ قراءةِ كلٍّ ما بقيَ معنى “القراءة الدنيا” حاضراً في تلاوَتِه. فمن أوتيَ أوّلا: حظّا من فهمِ كتاب الله، واستحضار معانيه، وثانيا: قدرةً ذهنية؛ كان الإسراعُ في حقّه أولى، ومن كان لا يقوى على تفهّم كلامِ الله إلا بقدرٍ من التأني والتّرسّل، كان بقاؤه وطلبُه للحدّ الأدنى من القراءةِ أجدَرَ وأحسن في حالِه. والمطلوب على الأمد البعيد، أن يعملَ الفردُ ويشتغل على تحسين فهمِه لكتاب الله، رمضان بعد رمضان، حتى يقوى على الإسراع دونَ تأثر فهمِه بسرعَة تلاوتِه.

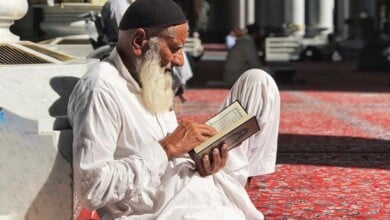

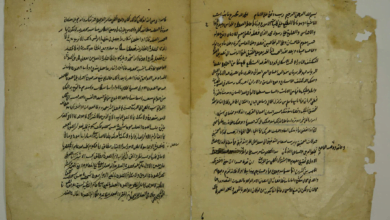

مثلها مثل المثقف والمبتئ في القراءة التثقيفية في سرعة القراءة.
رضي عنكم الباري وأرضاكم.