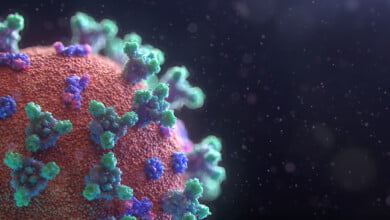- في.فرنانديز V. Fernandez
- ترجمة: عبد الرحمن فتحي وأسماء صبري.
ملخص الورقة:
في هذه الورقة سأستعرض -فاحصًا الطرق المختلفة- كيف أن لغتنا ومصطلحاتنا التي نستخدمها تحدد لنا بشكل مسبق المقاربة المنهجية التي نتخذها للعلّة النفسية وكذا استكشافها وتقصّيها وتكوين تصوراتٍ عنها. وأعرض لهذه الزاوية من وجهة نظر الفينومينولجيا التأويلية، وسيكون موضوع الاستقراء الأساسي في البحث هو الظاهرة التي تُعرَف بـ”الهوس” “Mania”. وسأعتمد فيها على مصادر من الفينومينولجيا الكلاسيكية؛ لأبين كيف أن الفينومينولجيين يسعون إلى التغلب على افتراضاتهم المسبقة وتحيزاتهم الكامنة، فيتسنى لهم حينها الاقتراب من “الشيء في ذاته”. بعبارةٍ أخرى: إن الفينومينولجيين ملتزمون بفكرة أننا ننتهج سلوكًا طبيعيا يوميًا، يتمثل في أنّا نسلّم بعدد من التحيزات والافتراضات التي تحدد مسبقًا تصوراتنا وفهمنا لما نعايشه من خبرات. ولكي نقترب من الظاهرة نفسها/في ذاتها، فإننا بحاجة إلى إيجاد وسيلة تمكنّا من تحييد تحيزاتنا وافتراضاتنا المسبقة فنخرج بتقارير جديدة (وأكثر دقة كما نأمل) للظواهر محل البحث والدراسة. وأحد أبرز الأمثلة على هذا السعي لتحييد التحيزات الكامنة هو ما أطلق عليه إدموند هوسرل: «تعليق الحكم»[1] “Epoché” وهي ممارسة عقلية يعلق فيها الشخص الأحكام والافتراضات [منتظرًا اكتمال الحقائق]. ولكن الفينومينولجيين قد طوّروا مع ذلك مقاربات منهجية بديلة فيما يخص هذا السياق. فعلى سبيل المثال: نجد أن مارتن هايدغر قد انصرف إلى ممارسة تحليلية اِشتقاقية/ إِتِيمُولُوجِيّة[2] للكشف عن المعاني الكامنة في لغتنا ومصطلحاتنا. وكذلك عكف هانز جورج غادامير على التحليل التاريخي، موضحًا كيف أن تقاليدنا تترسب في صورة تحيزات كامنة. وبعد أن أنهي مناقشة الطرق المختلفة التي انتهجها الفينومينولجيون في سعيهم الحثيث إلى تحييد التحيزات الكامنة والأحكام المسبقة قبل البدء في استقراء الظواهر، سأطبق بعض هذه المبادئ والطرق في حقل الباثولوجيا النفْسِيَّة مناقشًا بعض التحيزات المتأصلة في النقاشات العصرية لظاهرة الهوس.
ومن ثمّ أفحص المحاولات الأخيرة للربط بين الظاهرة التي نسمّيها الآن «بالهوس» وبين المفهوم اليوناني للهوس “μανία” زاعمًا أن هذا الربط بين كلٍ من المفهوم المعاصر والمفهوم التاريخي قد يكون ضارًا بمحاولات إعادة تصنيف الاضطرابات النفسية. كما سآخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على تبديل المصطلح من «الهوس الاكتئابي» إلى «الاضطراب ثنائي القطب» -خصوصًا عندما آتِ لبيان أن الهوس قد حُكِم عليه أنه واحد من “قطبين” مما يعني أن كل من الأطباء والمرضى قد حددوا وصفه مسبقًا.
وفي الختام، سأتطرق إلى الآثار المترتبة على اختيار العناوين التي يناقش في إطارها اضطرابيّ الهوس وثنائي القطب ضمن الأدلة التشخيصية. فمثلًا: سأناقش مسألة حذف عناوين الاضطرابات العاطفية والمزاجية من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5) مع القرار الصريح لواضعي الدليل بأن يضعوا اضطراب ثنائي القطب بين اضطرابات الاكتئاب وبين الفِصام (شيزوفرِنيا).
وما أصبو إليه في هذه الورقة ليس تقديم بحثًا فينومينولجيًا بقدر ما هو بحث “ما قبل- فينومينولجي”. أي أنني سأوفر بحثا للظاهرة (أو الظواهر) المعروفة باسم “الهوس” في الخطاب المعاصر بنيّة أن أضع اللبنة الأولى لبحوثات نفسية وفينومينولجية أوسع.
مقدمة:
ما هو «الهوس» وما علاقته بالأمزجة “moods”؟ وهل هو نفسه مِزاج من نوع ما؟ أم لربما هو شكل من أشكال التغيّر في حالاتنا المزاجية؟ وهل ينبغي أن نعتبره الطرف النقيض للاكتئاب؟ أم أن العلاقة بين الظاهرتين أدّق وأعقد مما نظن؟ هذه بعض الأسئلة الموجّهة لمسار الورقة والتي نرى من المهم إثارتها قبل المضي قدما في البحث الفينومينولجي لظاهرة الهوس. وواحدة من المبادئ الأساسية في حقل الفينومينولجيا هي أنه لا يمكننا تفسير ظاهرة ما قبل السؤال عنها على الوجه الصحيح. وفي ضوء هذه المقدمة، أرى أنه لازمًا عليّ توضيح ما تهدف إليه المقالة، وكذا ما لا تهدف إليه. فإنني في الواقع لا أقدم بحثا نفسيا فينومينولجيا عن الهوس يُفهَم على أنه سعيٌ لوصف الظاهرة وصفًا غنيًا ومنهجيًا يحيط بها ويشرح ما تمثله حالة المهووس أو ماهية شعوره. ولكني بدلًا من ذلك سأقدّم فينومينولجيا فلسفية للهوس أو لأكون أكثر دقة: سأقدم بحثا ما قبل فينومينولجي لما نشير إليه باسم “الهوس”. وبينما تُفهم الفينومينولجيا الفلسفية عادة على أنها تقرير للخصائص الجوهرية لماهية الإنسان أو الوجود أو الوجود في العالم، إلا أن هناك مرحلة تحضيرية لأي مبحث فينومينولجي، ويمكن إجراء تدابير هذه المرحلة التحضيرية بطرق مختلفة، ولكنها في العموم تدور حول التعطيل المؤقت للتحيزات الكامنة التي تهدد بأن تضلل البحث وتقوده إلى طريقٍ خاطئ.
وعند تطبيق ذلك على حقل الباثولوجيا النفسيّة -وخصوصًا على الظاهرة المعنية وهي الهوس- نجد أن بحثًا كهذا يهتم بأن يجلّي تحيزات الباحثين والأطباء السريريين الكامنة وكذلك افتراضاتهم المسبقة، كاشفًا عنها بوضوح. والأمر بالمثل بالنسبة لمتلقي الرعاية الصحية العقلية وعامة الناس. وبالكشف عن هذه الافتراضات، سيتسنى للمرء إماطة اللثام عن الظاهرة نفسها والتفاعل معها، عوضًا عن التفاعل مع أفكارنا المسبقة التي تحول دون الوصول لماهية الظاهرة المعنية.
تتألف هذه المقالة من أربعة أجزاء. الجزء الأول سأفرق فيه بشكلٍ موجز بين الفينومينولجيا الفلسفية وبين الفينومينولجيا النفسية حتى أحرر موقع مشروعي في خريطة مجال الباثولوجيا النفسية الفينومينولجية المتعدد تخصصاته.
والجزء الثاني سأشرح فيه كيف يحضّر الفينومنولجيين أبحاثهم بأن يتولوا أمر تحيزاتهم الكامنة التي من الممكن أن تحدد سلفًا نتائج الأبحاث بطريقة مشكِلة.
والجزء الثالث: سأشرح كيف يتعامل الفينومينولجيين مع مثل تلك الافتراضات المسبقة مستعرضًا -باختصار- الطرق التي اتبعها كل من هايدغر وسارتر في اتكائهم على التحيزات اللغوية قبل ممارسة العملية البحثية الفينومنولجيّة.
والجزء الرابع والأخير: سأطبق فيه بعض هذه الطرق على الظاهرة المعنية (أو الظواهر) التي تسمى “بالهوس” في الخطاب النفسي المعاصِر، مناقشًا بعض الأحكام المسبقة التي تحدد سلفا الكيفية التي نتصوّر بها الهوس بنية إرساء الأساس لبحوثات فينومينولجية للطابع الذاتي الهوَسي.
معنيان للفينومينولجيا:
قبل أن نتمكن من التعاطي على نحوٍ صحيح مع البحث الفينومينولجي أو ما قبل الفينومينولجي لظاهرة الهوس، نرى أن نوّضح ماهية الفينومينولجيا ابتداءً. وهناك الكثير من الطرق التي يمكننا التفريق بها بين أنواعها المختلفة. ومع ذلك؛ يظل التفريق الأكثر مركزية لهذه الورقة هو التفريق ما بين الفينومينولجيا الفلسفية وبين الفينومينولجيا النفسية[3] مشيرًا من خلاله إلى الفينومينولجيا كما مورست في العلوم الإنسانية والاجتماعية وبما في ذلك العلوم الطبية. وكلا النوعين يستخدمان لعمل مقاربة منهجية لوعي الإنسان وذاتيّته. وكلاهما يصنعان المقاربة على نحوٍ نوعي لا كمي. إلا أنهما يختلفان في الأساليب والأهداف.
فالفينومينولجيا النفسية عادة تتألف من دراسات نوعية للخبرات المَعيشة جمعت من خلال عدة تقارير: كالتقارير بصيغة المتكلم والمقابلات المنسّقة وشبه المنسّقة أو الاستبيانات. والهدف الأساسي لهذه الدراسات هو الخروج بتقرير وصفي غني «لماهية الشعور» الذي يعايشه المرء مع نوع معين الخبرات؛ كأن نسأل: كيف هو شعورك كونك أمًا عزباء في أمريكا أو ما هو شعورك كناجٍ من السرطان. فهنا الفينومينولجي النفساني سيتناول البيانات النوعية من التقارير التي قدمها المشاركون في الدراسة ومن ثم ينصرف إلى بلورة تفسير نسقي “thematic interpretation” باحثًا عن الأنساق الأساسية التي تظهر في أغلب التقارير إن لم تكن كلها.
أما الفينومينولجيا الفلسفية فهي على النقيض من ذلك؛ فهي تتألف من عدد من الأدوات المنهجية تشمل: “تعليق الحُكم” أو الإيبوخي epoché، والاختزال، والتباين الخيالي. وهذه الأدوات وظيفتها أن تحدد بدقة السمات الأساسية للذاتية البشرية: كالتأثرية الوجدانية، والفهم، والزمنية، والهوية الفردية والتوافق البين ذاتي.[4] فعلى سبيل المثال؛ تركز العديد من الدراسات الفينومينولجية للشيزوفرانيا على الطرق التي يمكن أن تصبح بها السمة الهوياتية الفردية -والتي تفهم عادةً على أنها سمة أساسية لصيقة بالذاتية البشرية- ممزقة أو مضطربة (2,4) ولتوضع هذه الاضطرابات في الحسبان -على نحوها اللائق- فإن الفينومينولجيين يفرقون بين مستويات مختلفة من الفردية، ومن ثم يحددون المستوى الذي يحدث عنده الاضطراب. كما أنهم -إضافةً لذلك- قد يبحثون الآثار المترتبة لهذا التشرذم في الهوية الفردية على سمات وجوانب أخرى من الوعي، بما فيها علاقات التوافق الذاتي والإدراك والتأثّر الوجداني.
وعلى الرغم من أوجه الاختلاف المذكورة بين كل من الفينومينولجيا النفسية والفلسفية؛ إلا أن المجالين ليسا منفصلين تمامًا؛ حيث يمكن توضيح علاقتهما بالاتّكاء على التمييز بين الدليل وموضوع البحث في كلا التخصصين.
ففي حالة الفينومينولجيا النفسية، نجد أن موضوع البحث هو ماهية الشعور المصاحب لمعايشة خبرة من نوع خاص. وعلى الناحية الأخرى، يوجد الدليل في طيات البيانات التي قدمتها التقارير بصيغة المتكلم، والمقابلات والاستبيانات ونحوه. أما بالنسبة للفينومينوليجا الفلسفية، فإنه -على النقيض من ذلك- يكون موضوع البحث متألفًا من السمات الأساسية للوجود البشري، وذاتيته ووعيه. أما عن الدليل فإنه في بعض الأحيان يتكون من تقارير صيغة المتكلم لخبرات مَعيشة، ولكنها قد تتكون من تقارير نسقية عمّا يشعر به المرء من معايشة خبرات معيّنة، مثل تلك التي ينتجها الباحثون النوعيون. بعبارةٍ أخرى؛ يمكن لموضوع البحث في المجال الأول أن يلعب دور الدليل في المجال الثاني.
وإنه لمن المهم أن نضع بعين الاعتبار هذه التمايزات بين المجالين، وخاصة في ضوء الطبيعة متعددة التخصصات للباثولوجيا النفسية الفينومينولجية، والتي غالبا ما تجمع المجالين معًا (وفي بعض الأحيان يكون الجمع شديد السيولة إلى حد ما)
والأهداف الرئيسية لهذه المقالة تقع تحت مظلة المجال الثاني، حيث سأميل أكثر إلى المعسكر الفلسفي عن النفسي في بحثي للظاهرة المعنية. كما يمكن تصنيف بحثي على أنه بحث ما قبل فينومينولجي بالقدر الذي يسمح فيه لبلورة الهدف الأساسي وهو تحضير الأرضية لبحث صحيح ومناسب لظاهرة الهوس. بيد أنه لطالما شكلت هذه النوعية من الأبحاث التحضيرية المكون الأساسي للبحث الفلسفي الفينومينولجي.
ما بين الأحكام المسبقة والتاريخ والترسيب:
لقد بدأ الانشغال بالتحيزات مع سعي إدموند هوسرل لتعطيل تأثير تحيزاته الميتافيزيقية (وخاصة الطبيعية والعلمية) أو استبعادها عند تناول طبيعة العقل أو الذاتية البشرية. وقد أنجز ذلك بتطوير]الأداة الإجرائية[ التي سمّاها “تعليق الحكم”(5) the epoché. وعلى الرغم من أن مفهومه حول إرجاء الحكم قد تطور وتغير شكله عبر حياته المهنية كفيلسوف؛ إلا أنه يمكن أن نصفه بالتبدل من الموقف الطبيعي (حيث نميل إلى اعتبار تحيزاتنا الميتافيزيقية مسلّمات) إلى الموقف الفينومينولجي (وفيه نتأمل بحسٍ نقدي السمات الأساسية التي لابد وأن تكون في محلها حتى يبدو لنا عالمنا على النحو الذي هو عليه بالفعل). وهذا التغيّر في الموقف يوصف كذلك بالتحول (النموذجي) من الاهتمام بالأشياء (بمعناها الواسع) إلى الاهتمام بالسمات الأساسية للظاهرة محل السؤال والنظر.
وعلى الرغم من مركزية آلية “تعليق الحكم” في متن هوسرل، إلا أن من جاء من بعده لم يؤسس عليها أو يتبنى نفس المفهوم، أعني مارتن هايدغر وغادامير وجان بول سارتر وموريس ميرلو بونتي. ولكنهم مع ذلك قد أبقوا على نفس الاهتمام العام بالحكم المسبق مع تبني السلوك النقدي تجاهه، وخصوصا عند بحث سؤال: كيف يهدد الحكم المسبق بأن يقود البحوث الفينومينولجية والعلمية إلى الطريق الخطأ؟ .
كما أن التقليد الما بعد-هوسرلي الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بالتحيزات والحكم المسبق كان هو الفينومينولجيا التأويلية (أو الهيرمينوطيقا الفلسفية) كما طوّرها كل من هايدغر وغادامير. ففي الوقت الذي درس فيه الفينومينولجييين كيفية ظهور موضوعات وأشياء العالم الخارجي في الوعي، نجد أن الفينومينولجيين التأويليين وجهوا اهتمامهم بالخصوص إلى أن كيف أن إدراكنا وظهور موضوعات العالم في وعينا محدد مسبقا بطرق معينة. وبعبارةٍ أخرى؛ يهتم الفينومينولجيون كافة بحالات وشروط تشكل المعنى بشكل عام، بينما التأويليون -مع اهتمامهم بشروط تشكل المعنى كذلك- إلا أنهم يهتمون بالشروط التاريخية والثقافية واللغوية ]المكونة[ لأنواع معينة للمعنى.[5]
وفي حين يشار عادة إلى شروط المعنى/الحقيقة على أنها هياكل متعالية -ترنسندنتالية- أو أنطولوجية/وجودية، إلا أن المعاني المعينة في هذه الحالة السالفة ما هي إلا أحكام مسبقة.[6]
وفي خطابنا اليومي، عادة ما نفهم الحكم المسبق على أنه تحيزاتنا السلبية إزاء أناس معيّنين أو ثقافات معينة أو تصورنا المسبق عنهم. وعلى الرغم من أن هذا المعنى متضمن في مفهوم الهرمنيوطيقا عن الحكم المسبق؛ إلّا أن المفهوم الهرمنيوطيقي أوسع وأعمق بكثير من هذا التصور الشائع للمصطلح. فالحكم المسبق بالنسبة للفينومينولجيين التأويليين ليس مفهوما سلبيًا بحد ذاته. فنجد أن غادامير مثلا يعرّف الأحكام المسبقة بأنها: “تحيزات انفتاحنا على العالم”11 فالعالم من هذه الزاوية مفتوح لنا ومتاح للنظر عبر أحكامنا المسبقة نفسها، وبدون هذه التحيزات، سيكون من المستحيل أن تتشكل لدينا أية خبرات سابقة. وفي حين أن بعض التحيزات قد يكون لها عواقب وخيمة بكل تأكيد -علينا وعلى الآخرين بحدٍ سواء- إلّا أن العديد منها محايد عياريًا أو إيجابي حتى.[7]
والمثال الصريح والمباشر على هذا الدور للحكم المُسبق نجده عند مناقشة ميرلوبونتي لفكرة الطفل الذي جذبه لهيب الشمعة فاقترب منها أكثر ولمسه. (12) وبعد أن أحرق اللهيب إصبعه الصغيرة أصبح للّهب (في المجمل) معنًا آخر ومظهرًا جديدًا في ذهن هذا الطفل – ولعل هذا التصور سيظل قائما في ذهنه مدى الحياة. فلهب الشمعة الذي كان فتّانًا للحظة واحدة بات منفّرًا إلى الأبد. وفي هذه الحالة، يكون لدى الطفل سببًا وجيهًا للنفور من لهب الشمعة، ولكن هذا لا يجعل علاقة الطفل الجديدة باللهب أقل تحيزًا.
وإذا أردنا تفسيرًا أعمقًا لأصل الأحكام المسبقة، فإننا سنجده في مقالة يونغ تحت عنوان: “الرمي كفتاة: في فينومينولجيا سلوك الجسد الأنثوي، وحركته، ومكانيته”(13). في هذه المقالة، تتناول يونغ دراسة شتراوس الفينومينولجية والنفسية لسلوك الجسد الأنثوي بما في ذلك الكيفية التي تتصرف بها الفتيات والنساء حين يمارسن الرياضة. فبعد نظر شتراوس في عددٍ من الأسباب البيولوجية للاختلافات في السلوك الجسدي بين الأولاد وبين البنات؛ خلُص إلى الاستنتاج التالي: لا يكفي التشريح في تفسير الاختلافات السلوكية بين النوعين. ومن ثم يزعُم أنه لا مناص من وجود جوهر أنثوي في المعادلة. (14)
وفي نقد يونج لأطروحة شتراوس، تزعُم أن تفسيره الأساسي غير وافٍ، ومن ثم تقدم تفسيرًا بديلًا ينطوي على تمرير أعراف وقيم معينة تحكُم دستور السلوك والتصرفات الأنثوية فيما بعد. وعلى هذا النحو؛ تعالج أطروحة يونج الحُكم المسبق من زاويتي نظر. الأولى تتمثل في نقدها لأحكام شتراوس المسبقة نفسها التي تحدد له سلفًا نوعية الإجابات التي يكون على استعدادٍ لأخذها بالاعتبار. ومن الزاوية الثانية، يتعامل جوابها البديل بجديّة مع الدور الذي تلعبه التحيزات الثقافية في التحكم في سلوكنا وتصرفاتنا.
مصطلح آخر يستعمله الفينومينولجيين عادة عند مناقشة الانتقال التاريخي للأحكام المسبقة وهو “الترسيب”. فبينما نتأثر باستمرار بالبيئات الثقافية وكذا الأحداث الحياتية؛ فإن بعض السمات الحاملة للمعنى الخاصة بهذه البيئات تصبح سمات راسخة، وتأسيسية لعالمنا المعيش، على نحو أنها تحدد مسبقا فهمنا للعالم والمعنى الذي سيظهر لنا.
أو بحد قول ميرلوبونتي: لو كان من الممكن الكشف في كل لحظة عن الافتراضات المسبقة التي أسمّيها “منطقي” الخاص أو “أفكاري” الخاصة، حينئذٍ سيتسنى لي على الدوام اكتشاف ما لا يقتصر دوره فقط على نشأة فكرتي، بل إنه ما يحدد معناها أيضًا مثل: خبراتي السابقة التي بالكاد أذكرها، والمساهمات الثقيلة من الماضي والحاضر “والتاريخ الرسوبي” برمته.12
وفي هذا الإطار، نجد أن مفهوم “الترسيب” في الفينومينولجيا والهرمنيوطيقا له معنى يناظر تمامًا “الترسيب” في علم طبقات الأرض. فعلى نفس النحو الذي يحمل به مسطح مائي الجسيمات على طوله، فإن التدفق الزمني والتاريخي للحياة البشرية يحمل معه مجموعة من المعاني والأحداث ذات المغزى. وكما تترسب بعض هذه الجسيمات وتتحول إلى رواسب طبيعية تعيد تشكيل المنظر الطبيعي، فإن بعض الأحداث الحاملة للمعنى في رواسب حياتنا تتحول إلى أحكام مسبقة وتحيّزات تعيد تشكيل عالمنا المعيش.
وإنه لمن المهم أن نؤكّد على التالي، فبينما يعيد مصطلح “الترسيب” إلى الذهن معنى تشيؤي مجرّد، إلا أنه لا يعني أبدًا أن ما يترسّب مادة خاملة. أو بحد قول ميرلوبونتي: “لا ينبغي أن تخدعنا كلمة “الترسيب”؛ لأن هذه المعرفة التعاقدية المترسّبة ليست مجرد كتلة خاملة في أساس والوعي”12. وعوضا عن ذلك الفهم، نقول إن المعاني والأحكام المسبقة التي ترسّبت لتشكّل العالم المعيش؛ توجّهنا بطرق معيّنة وتحدد لنا مسبقًا المفاهيم والمعاني التي ستكون متاحة لنا [فنُفصح عن العالم من خلالها].[8] ففي حين أن مغزى خبراتنا الحياتية في العموم يمكنه أن يترسب في هيئة أحكام مسبقة عن عالمنا المعيش، إلا أن أحد الطرق الأساسية لتمرير مثل هذه التحيزات يكون عبر اللغة. فكما زعم غادامير، كل من اللغة والخطاب متموضع داخل سياق تاريخي وثقافي معين. ومصطلحاتنا لا تحتفظ بمعانيها نفسها عندما تهاجر من بيئة ثقافية إلى أخرى. لأن معانيها خاضعة للسياق على الدوام، وأي تغيّر سياقي يعني -ضرورةً- تغيّر في المعنى.
ولهذه الإضاءة نتائج هامة على المفاهيم التاريخية بما في ذلك الأفكار التاريخية حول العلل النفسية. ولكن قبل الولوج إلى بحث الطرق التي تتسبب فيها اللغة والمصطلحات في تشكيل الفهم المسبق، نرى من المفيد لو ألقينا نظرة على دراستين كلاسيكيتين في الفينومينولجيا.
دراستان للحكم المسبق: “الذاتية” “والتخيّل”:
ولنشرح كيف ولماذا يعتني الفينومينولجيون بالتحيزات اللغوية، سأتناول هَهنا -باختصارٍ- مثالين بالشرح. المثال الأول سأتناول ضبط وتقييد هايدغر لمصطلح “الذاتية”. والمثال الثاني سأتناول فيه اهتمام سارتر بالفرضيات المسبقة مستندًا إلى مصطلح “التخيّل”.
غالبا ما يشار إلى مفهوم “الذاتية” بوصفه موضوع علم الفينومينولجيا. ومع ذلك، حتى هذا المفهوم “المركزي” ليس محصنًا من تمريرات متحيزة بلا نقد. فنحن حينما نضع أنفسنا موضع الدراسة أي عندما ندرس الذاتية البشرية؛ فإننا نحدد مسبقًا نهجنا في التعامل مع هذه الظاهرة بثلاثة طرق على الأقل. أولا، تشير إحالتنا إلى مفهوم “الذاتية” أننا نستحضر على الفور ثنائية هي ثنائية الذات-الموضوع، والتي قد تصنف على أنها ثنائية العقل-الجسد. ثانيا، قد تستجلب الذاتية معها حسًا باللا علمية بشكلٍ ما. فبقدر ما أن أهداف العلوم الطبيعية هي دراسة الظواهر الموضوعية، فإن دراسة الذات تُوصف فورًا بأنها بحثٌ لا يفي بالمعايير الصارمة المتأصلة في العلوم الطبيعية. ثالثا، يحمل المصطلح حسًا بالتفرّد أو الفردية. فهو يفترض “أنا” منعزلة كنقطة انطلاق للبحث، مما يعني أننا مطالبين بتقديم حجة واضحة حول الكيفية التي تسوّغ لهذه “الأنا” الاتصال بالعالم والاتصال مع “أنا” الآخرين.
فبينما تجنَح التفسيرات النفسية لوجود الإنسان بل وحتى التفسيرات الفلسفية إلى أن تفترض مسبقًا شرعية البدء من الأنا المنعزلة، إلا أن الفينومينولجيين في العادة ينتقدون هذا المنحى المبدئي. فهوسرل على سبيل المثال تحول خلال مسيرته المهنية من تفضيل الذاتية إلى تفضيل البين-ذاتية.[9] وهايدغر من ناحيته كان يعارض بشدة استخدام مصطلحات مثل “الذاتية” و”الوعي”. وقد استبعد في عمله -في أغلب الأحيان- أية مصطلحات تحمل في طياتها أحكاما مسبقة. مفضلًا استخدام مصطلحات مثل “الكينونة في العالم” أو “الدازاين” “Dasein” الذي يترجم إلى “هذا الذي هناك”(15) ونشير هنا إلى أن استبعاده لمصطلح مثل “الذاتية” من مفرداته الفلسفية لم يكن لأن موضوعه كان شيئًا مغايرًا، ولكنه استبعده لأن قدرته على الوصف الدقيق للظاهرة التي نحاول الإشارة إليها بمصطلح “الذاتية” تضع -هذه القدرة- في خطر إذا ما اعتمد هذا المصطلح. (للأسباب المذكورة أعلاه).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام المسبقة الخفية الملازمة لمصطلح “الذاتية” تؤدي حتما إلى تصور غير دقيق للوجود البشري. بل إن ما يقلق الفينومينولجيين هو أننا بقدر جهلنا لهذه الأحكام المسبقة وسماحنا لها بالتسرب دون تمحيص إلى قتاعتنا الفينومينولجية حول الوجود البشري، بقدر ما نعرض أنفسنا للوقوع باستمرار في المزيد من التصورات غير المبررة – وربما غير الدقيقة – للظاهرة المعنية. يعارض الفينومينولجيون هذا النوع من المجازفة بشكل جذري، كما يشتغلون على طرق متنوعة طورت للكشف عن هذا النوع الأحكام المسبقة وتوضيحها، من أجل تعليق تأثيرها أو تحييدها.
مثال آخر لاستقصاء تمهيدي فينومينولجي يوجد في كتاب سارتر، التخيل. يقدم فيه سارتر دراسة فينومينولجية ونفسية مفصلة للخيال والصور والتصور، بهدف توضيح التخيل بشكل يتجاوز بكثير التصوير الفلسفي والنفسي المعتاد لهذه الظاهرة. لكن الفينومينولجي لا يستطيع الخوض في استقصاءه عن الخيال ببساطة هكذا دونما استعداد – كما يوضح سارتر نفسه في الفصل الافتتاحي. والقيام بذلك سيكون حتما غير موضوعي (عكس أطروحة الفينومينولجيا)، لما يؤدي إليه ذلك من مخاطرة بتكرار الأفكار المسبقة الكامنة والمترسبة حول التخيل، والتصور، واللا موضوعية بشكل عام. وإذا كان الهدف من الفينومينولجيا هو تقريبنا من “المسائل نفسها”، فإن مثل هذا الاستقصاء القاصر لا يستطيع حتى أن يرقى لتسميته بالفينومينولجي، حيث إنه لا يعد بإيجاد أي شيء في الظاهرة أكثر مما وجده الشخص المستقصي نفسه.
لا يفتتح سارتر كتابه بالتحدث عن ظاهرة التخيّل، بل حول ما قيل عن التخيّل وكيف تطور المفهوم وتكرر. حيث يقول:
“من الضروري أن نذكر هنا ما كان معروفا منذ عهد ديكارت: الوعي التأملي ينتج بيانات يقينية ومؤكدة. كل من يصبح واعيا، خلال تأمله، أنه “استحضر صورة ما” لا يمكن أن يكون مخطئا. ومما لا شك فيه أن هناك علماء نفس يؤكدون أننا لا نستطيع، في الحالة المحدودة، تمييز صورة مكثفة من ضعف التصور 16.
وباختصار، فقد وُصف التخيّل ــ في الفلسفة وعلم النفس على حد سواء ــ بأنه تصور متدن أو ضئيل. إنه ببساطة تصور حيويته ووضوحه. ويمكن التوصل إلى هذه الأوصاف بسهولة وتكرارها وقبولها لأنها منغرسة في صميم المصطلحات المستخدمة في استقصاءاتنا. من خلال ادعائنا بأننا نقوم باستقصاء “التخيّل” أو استقصاء “صورة ذهنية”، نحدّد موقفنا مسبقًا بافتراض علاقة وعي بموضوعه. والصورة، في نهاية المطاف، تبقى صورة لشيء ما. والصورة تدل على ما هي صورة له. إذا تناولنا هذه الأحكام المسبقة دون تمحيص، فستكون رؤيتنا حتما للتخيّل على أنه “طريقة معينة يظهر بها الشيء للوعي، أو طريقة معينة يعرض بها الوعي نفسَه للشيء” 16. بعبارة أخرى، سيتم التعامل مع التخيّل على أنه تصور زائف، ينطوي أساسا على علاقة مقصودة بين ذات وموضوع. ما يحاول سارتر أن يوضحه هو أن هذا الطرح المتعلق بالتخيّل هو افتراض مبني على تحيزات ضمنية، وليس نتيجة تفكير فلسفي سليم في الظاهرة نفسها. وإلى حين إدراك هذه الأحكام المسبقة، فالأمل ضئيل في اكتشاف أي شيء حول الخيال عدا ما مهدت له تحيزاتنا. انطلاقا من هذا المثال التوضيحي للاستقصاء التأويلي يمكننا أن نبدأ في تطبيق هذه الأدوات على مجال علم الأمراض النفسية، وتحديدا على الظاهرة أو الظواهر التي تسمى “الهوس”.
الهوس: استقصاء تمهيدي:
لماذا نحتاج إلى تفسير للهوس؟ فما يبدو هو أنه لدينا بالفعل مؤلفات وصفية كثيرة حول الهوس، من أطباء يونانيين قدامى إلى Kraepelin 17، إلى الأعراض المبينة في الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات العقلية DSM-5 18. لكنني أزعم أن هذه الروايات هي التي تحتاج إلى نظر تمحيصي صحي، وتحليل أوصاف الأعراض، وأيضا الأحكام المسبقة التي بنيت عليها هذه الأوصاف. سأركز على ثلاث نقاط اصطلاحية وآثارها الضارة المتعلقة بإنتاج علم ظاهرة الهوس. سأتطرق أولاً إلى تعريف “الهوس” في عصرنا كما هو مبين في DSM-5 تحت اسم “μανία” [هوس] الذي تُناوِل في النصوص الطبية اليونانية القديمة. ثانياً، سأحلل الآثار المترتبة على التحول الاصطلاح من “مرض الاكتئاب الهوسي” إلى “الاضطراب ثنائي القطب”. ثالثاً، سأتفحص كيف تحدد العناوين التي نوقش الهوس تحتها – مثل “الاضطرابات العاطفية” و “اضطرابات المزاج” – طبيعة العناصر التي نستحضرها في استقصاءاتنا.
أصبح استحضار 2500 سنة من تاريخ “μανία” شائعا في خطاب علم النفس والعلاج النفسي. كما يوضح ديفيد هيلي، غالبا ما تُقدم مثل هذه الاستحضارات في الخطابات الافتتاحية للمقالات العلمية والمناهج الدراسية حول الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات المزاج. تضفي هذه المناقشات طابعا شرعيا إلى هذا الاضطراب ونوباته الهوسية والاكتئابية (يرتبط الاكتئاب بنفس الطريقة مع روايات السوداوية أو اليونانية القديمة). في الوقت الذي يبدو فيه أن كل إصدار لـ الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات العقلية يمطرنا بمجموعة جديدة من الاضطرابات، لا يزال الكثيرون في ريب من واقع هذه المفاهيم النفسية. على ضوء ما سبق، من المهم جدا التثبت حول حقيقة المفاهيم النفسية، التي قد تُراهَن عليها حياة مهنية (دون ذكر النجاح المادي، الذي تعتمد عليه صناعة الأدوية النفسية). في حين أن للعديد من هذه الاضطرابات تاريخ يعود إلى عقود فقط (أو أقل من ذلك)، يبدو أن اضطراب ثنائي القطب قد تأسس كظاهرة صاحبتنا لآلاف السنين. نهدف من خلال الإشارة إلى “μανία” في النصوص اليونانية القديمة إلى تأسيس شرعية مهمة لأسلوب الحياة المرضي هذا.
ولكن إذا أخذنا هذا التاريخ من الهوس على علاته، فإن ذلك قد يعرض نهجنا لأن يكون محددا مسبقا بطريقة معقدة جدا إزاء هذه الظاهرة. وكما يشير هيلي، فمن أجل تمحيص صفاء السلسلة التي تبلغ 2500 عاما من “μανία” إلى “الهوس”، غالباً ما ستضطر رواياتنا التاريخية إلى الخضوع لاختبار يفصل بين الحقيقة والخيال. وكما يوضح، فإن إحدى الحكايات الأولية المشار إليها في سياق تأسيس سلسلة لنشأة مصطلح “الهوس”، تُشَذب عادة من معظم الخصائص المتعارضة مع معايير التشخيص المعاصرة. في التقديم القياسي للاقتباس، يقال أن امرأة تعاني من الأرق، وفقدان الشهية، والعطش، والغثيان، والهذيان، الاكتئاب المزاجي، وعدم اتساق الكلام. من وجهة نظر القارئ المعاصر، الأعراض الوحيدة التي قد تكون غير معتبرة في نوبة هوسية هي العطش والغثيان. لكن هنالك أعراضا أخرى يتم استبعادها من الاقتباس القياسي، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة، والتعرق الغزير، والألم الشديد، والبول الداكن، وزيادة تدفق الحيض. عندما تناقش كل هذه الأعراض مع بعضها البعض، سيتبين لنا تصور آخر عن أعراض الهوس. ويكون بذلك احتمال تعرض مريض أبقراط لما نسميه اليوم نوبة هوس فرضية غير متماسكة بالتأكيد.
توجد “قصص” مماثلة في الكتابات المعاصرة لأريتايوس القبادوقي. على سبيل المثال، يعترف إنغست ومارنيروس، خلال نقاشهما الموجز حول تاريخ اضطراب ثنائي القطب، بأن “الهوس” في السياق اليوناني القديم مفهوم يصعب ضبطه. لم يُعثَر على هذا المصطلح في مؤلفات الأطباء مثل أبقراط وأريتايوس فحسب، ولكن أيضا في الكتابات الدينية والأسطورية، فضلا عن المؤلفات الفلسفية. لكن حتى مع اعترافهما بالتباين الشاسع بين تعريفات هذا المصطلح، فإن إنغست ومارنيروس يقولان:
“ادعى بعض المؤلفين أن مفهوم الهوس والسوداوية كما وصفهما أبقراط، وأريتايوس، وغيرهم من الأطباء اليونانيين القدماء يختلف عن المفاهيم الحديثة، ولكن هذا ليس صحيحا. والأصح أن هاته المفاهيم الكلاسيكية من الكآبة والهوس كانت أوسع من المفاهيم الحديثة (حيث كانت تشمل السوداوية أو الهوس، والحالات المختلطة (تزامن أو تداخل أعراض الهوس والاكتئاب)، والاضطرابات الفصامية العاطفية، وبعض أنواع الفصام وبعض أنواع الذهان العضوي الحاد والذهان ‘غير النمطي’) 20.
إن الادعاء بأن هذه المفاهيم المبكرة أوسع نطاقا من المفاهيم المعاصرة التي نوقشت تحت تسمية مشتركة قد لا يكون خاطئا تماما، لكن الادعاء الإضافي بأن هذه المفاهيم لا تختلف فيما بينها نتيجة لذلك يعد إشكالا حقيقيا. حيث يبدو أنه إذا كانت المفاهيم القديمة للهوس والسوداوية تتضمن فعلا ما نصطلح عليه اليوم بالاضطرابات الفصامية العاطفية والفصام وغيرهم، فإنها تُعد بذلك السابقات المفاهيمية لنظيراتها المعاصرة كذلك. وعلى الرغم من ذلك، فمن الصعب العثور على مقال يزعم أن المفهوم المعاصر للفصام هو نفسه الذي صاحب البشرية لمدة 2500 سنة، بدعوى أنه يبدو مشابها لبعض الأوصاف الموجودة في النصوص الطبية اليونانية القديمة حول “μαία”. في المقابل، ما يجعل النسب الاصطلاحي الممتد من “μανία” إلى “الهوس” قابلا للتصديق هو اشتراكهما في المصطلح المستعمل، أكثر من أي شيء آخر. وفي غياب هذا المصطلح، من المستبعد استساغة تقديم مثل هذه القصص المزعومة الزائفة كحجة لترسيخ شرعية المفهوم المعاصر لـ”الهوس”. إن إنتاج مثل هذه القصص لا يهدد فقط فهمنا للمفاهيم اليونانية القديمة للاضطراب العقلي، بل يهدد أيضا قدرتنا على تطوير مفاهيمنا المعاصرة والتعبير عنها بشكل سليم. إذا كنا نعتقد أنه يمكننا رسم خط واضح نسبيا لانحدار مصطلح”μανία” من “الهوس”، فإن ذلك سيؤدي لترسب المفهوم المعاصر أكثر؛ نحن ننسى أن الهوس اليوم هو في حد ذاته مصطلح أثري بُني في سياق علمي وثقافي خاص. هذا لا يعني أننا عندما نستخدم مصطلح “الهوس” لا نشير إلى شكل حقيقي من المعاناة، أو حتى إلى ظاهرة ذات مرتكزات بيولوجية-عصبية. لكن ما نخاطر به من خلال التأكيد المستمر لهذه السرديات والنسيان غير النقدي الذي يتبعهما هو إضفاء طابع مادي لتصوراتنا المعاصرة. عندما نرضى بتصنيف مسبق للاضطرابات لا جدال فيه ولا شك، فإننا نحكم على أنفسنا بالفشل في أي انخراط بَناء في التفكير النقدي اللازم لإعادة تصنيف صائبة.
بالإضافة إلى الآثار المترتبة على هذا التاريخ المفبرك للهوس، يجب أيضا أن نشارك في التحولات المصطلحاتية الحديثة التي تشير إلى الاضطراب الذي ينتمي إليه الهوس. يسهل جداً أن ننسى اليوم أن مصطلح “الاضطراب ثنائي القطب” لم يبرز إلا في العقود القليلة الماضية، ليحل محل مفاهيم سابقة مثل “جنون الاكتئاب الهوسي” و”رد الفعل الهوسي الاكتئابي” و”الاكتئاب الهوسي”. يبدو هذا التحول غير ضار، لكن يجب علينا أن نكون منتبهين إلى أن أي تحول في المصطلحات (خاصة عندما ينسى تاريخ هذا التحول) يمكن أن يعيد تشكيل المشهد المفاهيمي بشكل غير صريح للظاهرة المعنية.
في حالة التحول إلى “اضطراب ثنائي القطب” تحديدا، من الجدير التأمل في كيفية تصورنا اليوم للعلاقة بين نوبات الاكتئاب والهوس، وكيف تغير هذا التصور جنبا إلى جنب مع مصطلحاتنا المستعملة. عندما نتحدث اليوم عن “اضطراب ثنائي القطب”، تُقدم صورة فورية لاضطراب يتكون من نقيضين متعارضين؛ والاكتئاب والهوس أضداد متناقضة. حسب وصف أحدث طبعات الدليل التشخيصي DSM، يتميز الاكتئاب بحالة من الحزن أو اليأس أو الشعور بالذنب، في حين يتميز الهوس بالنشوة (أو في بعض الحالات التهيج). وبعبارة أخرى، يتصوَر الاكتئاب والهوس في حد ذاتهما على أنهما مزاجان متناقضان، أو على الأقل على أنهما مجموعتان متناقضتان من الأمزجة.
قد يكون وصف العلاقة بين الهوس والاكتئاب بالأمزجة المتناقضة دقيقا، لكن استخدام مصطلح “اضطراب ثنائي القطب” نفسه يدفع بالباحثين والأطباء لتبني هذا المفهوم مسبقا. المصطلحات السابقة مثل “مرض الهوس الاكتئابي” – مع إدماج هذين الكيانين المرضيين لكونهما مرتبطين أساسا بصلة جوهرية – هي إلى حد ما أقل تقييداً إزاء طبيعة هذه العلاقة. ومن خلال دراسة النماذج المنافسة لهذا الاضطراب، يمكننا أن نفهم بصورة أفضل كيف تمكننا اصطلاحاتنا من التسليم بالعلاقة بين الاكتئاب والهوس. على سبيل المثال، في الستينات، وتقريباً في نفس الوقت الذي بدأ فيه بعض الباحثين 21 22 في تطوير نموذج القطبية الثنائية الذي سيحل محل المفهوم المرن لمرض الهوس الاكتئابي، طُور نموذجان بديلان وعُرضا. ويشار إلى هذين النموذجين باسم “نموذج الاستمرارية” و”النموذج الثلاثي”.
حسب نموذج الاستمرارية، لا يُحدَد مفهوما الاكتئاب والهوس كظاهرتين متقابلتين تتسوطها الإيوثيميا أو الصحة العقلية.[10] بل يُعتبر الهوس رد فعل أكثر حدة من الاكتئاب. خط الاستمرارية إذن هو بين الإيوثيميا والهوس، بحيث يتوسطهما الاكتئاب. ومن خلال هذا التفسير للعلاقة بين الاكتئاب والهوس، من المفترض أن يتفوق نموذج الاستمرارية على التصور المتناقض للحالات المتداخلة. عوض الاضطرار إلى إيجاد العلة وراء ظهور خصائص لظاهرتين متضادتين في نفس الوقت، يستوعب هذا النموذج ببساطة الحالات المتداخلة من خلال اعتبار الحركة من الإيوثيميا إلى الهوس (والعكس بالعكس) تمر من خلال الاكتئاب 23 24.
في المقابل، يفترض النموذج الثلاثي أن كل حالة من هذه الحالات الثلاث ــ الاكتئاب والهوس واليوثيميا ــ تتموقع في زوايا مثلث متفرقة. يمكن إذن الانتقال بين اليوثيميا والاكتئاب دون المرور من الهوس، وبين اليوثيميا والهوس دون المرور من الاكتئاب، وبين الاكتئاب والهوس دون المرور من اليوثيميا. ويقدم هذا النموذج كذلك تصورا أقل تناقضا من الحالات المتداخلة، دون وصف الاكتئاب والهوس كأضداد متقابلة بالضرورة 25.
لا أقول هنا أن مفهوم العلاقة بين الاكتئاب والهوس، المنغرسة في صلب مصطلح “اضطراب ثنائي القطب”، غير دقيقة بالضرورة. ولا أزعم أن نموذج الاستمرارية أو النموذج الثلاثي يصور العلاقة بين الاكتئاب والهوس بشكل أدق. لكن النقطة التي أريد التركيز عليها هي أن استخدام مصطلح “اضطراب ثنائي القطب” يضر بتطوير وتوضيح مفاهيمنا للهوس والاكتئاب من حيث التحيزات المسبقة التي يشكلها لدينا. من خلال الحفاظ على وعي واضح للافتراضات المسبقة ال مرتبطة بنيويا بهذا المصطلح، يمكننا أن نحقق في ظاهرتي الاكتئاب والهوس والعلاقة التي تربطهما بشكل أدق. وفي حالة تضَمن المصطلح تحيزات متأصلة في بنيته، مما يغطي سمات هامة للظاهرة التي يشير إليها، فقد يكون تعطيل هذا المصطلح (ولو مؤقتاً)، واستخدام مصطلح لا يشمل أحكاما مسبقة، أكثر نجاعة أحياناً. وكما نوقش أعلاه، فقد فعل هايدغر نفس الشيء باستخدامه لمصطلح “دازاين” بدلاً من “الذاتية” (نقيض الموضوعية)، رغم أن العديد من الفلاسفة قد يشيرون إلى “موضوع” تحقيقه دون تردد أو تمحيص بـ “المسألة” (حرفيا: “الذات”). قد يفعل الأطباء النفسيون شيئًا مماثلًا (وإن كان أقل راديكالية) بمجرد الرجوع إلى مصطلحات مثل “مرض الهوس الاكتئابي”. مثل هذا المصطلح، مع احتفاظه بافتراضات مسبقة حول العلاقة بين الوثيقة بين الاكتئاب والهوس، يُبقي طبيعة هذه العلاقة مفتوحة لمزيد من التحقيق، عكس ما يفعله مصطلح “اضطراب ثنائي القطب”.
أخيرا، تجدر بنا دراسة تسمية الهوس في المراجع التشخيصية، وكيفية تحدد هذه التسميات مسبقا تصورنا لسماتها الأساسية. على سبيل المثال، في DSM-III ، تدرج مادة الهوس تحت عنوان “الاضطرابات العاطفية” 26. أما في DSM-IV، تدرج تحت عنوان “اضطرابات المزاج” 27. لكن في DSM-5، فأزيلت عناوين “العاطفية” و”اضطرابات المزاج”؛ وأُدرجت عناوين “ثنائيّ قطب والاضطرابات المتعلقة به” و”اضطرابات الاكتئاب” بشكل مستقلّ، دون عنوان شامل يستوعبهما معا [18].
عموما، لا يهتم الباحثون والأطباء كثيرا بتحقيق العناوين التي يندرج تحتها الهوس والظواهر الاضطرابية الأخرى. لكن مع ذلك، يعترف مؤلفو DSM-5 بشكل صريح أن تغيير العناوين يهدف إلى تيسير إعادة تصور اضطراب ثنائي القطب. وفيما يلي العبارة الافتتاحية للفصل المتعلق بـ “الاضطرابات ثنائية القطب والاضطرابات المتصلة بها”:
فُصلت الاضطرابات ثنائية القطب والاضطرابات المتصلة بها عن الاضطرابات الاكتئابية في DSM-5 ووُضعت بين فصلي طيف الفصام وغيرها من الاضطرابات الذهانية وبين الاضطرابات الاكتئابية، باعتبار مكانتها كجسر بين المرتبتين التشخيصيتين المذكورتين من حيث الأعراض، وباعتبار التاريخ العائلي، وعلم الوراثة 18.
كان كل من إزالة التسميات القديمة من “العاطفية” و”اضطرابات المزاج”، ومن وضع “اضطراب ثنائي القطب” بين “الفصام” و “اضطرابات الاكتئاب” نتيجة لقرارات صريحة اتخذها مؤلفي DSM-5 من أجل تسهيل إعادة تصور هذه الظواهر الاضطرابية. ويؤكد هذا العرض الجديد ضمنيا على الروابط بين أعراض اضطراب ثنائي القطب وأعراض الاضطرابات الاكتئابية، وأيضا على الروابط بين الاضطرابات ثنائية القطب وبعض أنواع الفصام.
قد تساهم إعادة التشكيل هذه لمفهوم “اضطراب ثنائي القطب”، فضلا عن مفهومي “الهوس” و”الاكتئاب”، في فتح أو توسيع مجموع الأعراض والظواهر ذات الصلة التي يتم تناولها في الدراسات النفسية والعقلية. لكن يجدر الذكر بأن أشد نقاط التناقض البالغة بين علماء الأمراض النفسية الظاهرية وبين الباحثين النفسيين التقليديين هي التنوع النسبي للظواهر التي تتناولها الفئة الأولى وتأخذها على محمل الجد. في حين أن أغلب البحوث التقليدية حول الهوس تتناول سماته العاطفية والشعورية، يركز علماء الأمراض النفسية الظاهرية على مجموعة أواس من السمات، والتي تغيب عن مجموع الأعراض المدرجة في الدليل التشخيصي. DSM
على سبيل المثال، قال ساس وبيينكوس مؤخرا أن الاضطرابات الذاتية تعتبر مركزية ليس فقط للفصام، ولكن للاكتئاب والهوس كذلك 28 29. إلى جانب ذلك، قال فوكس أنه، بالإضافة إلى السمات العاطفية للهوس، فإن الهوس في العالم يتضمن تحولات ملحوظة في نمط التجسيد للشخص وتدفقه الزمني وتوافقه الذاتي 30
ولكن على الرغم من استعداد علماء الباثولوجيا النفسية الفينومينولجية المعاصرين لتناول الظواهر الجديدة – خاصة تلك التي لا تزال مهملة في مجموع الأعراض المدرجة في DSM – فإنهم لا يخلون بأي حال من آثار التحيز (اللغوية أو غيرها). لنأخذ مثالا واحدا فقط ، في دراسة فينومينولجية الحديثة، حيث افتتح فوكس نقاشه حول الوجود الهوسي أو كينونته في العالم بقوله: “الهوس نقيض الاكتئاب بالطبع” 30. وكما سبق وأشرت أعلاه، فإن العلاقة المضادة (أو الثنائية القطب) بين الاكتئاب والهوس تكون واضحة فقط إذا نسينا كيف أننا تبنينا مؤخراً مصطلح “اضطراب ثنائي القطب”. ويمكن العثور على تبنيات غير نقدية مماثلة لتحيز مفاهيمي (لغوي أو غير لغوي) في شتى الكتابات النفسية والعقلية والفينومينولجية. وقد اقترفت هذا الإثم في عملي الشخصي أيضا، باتخاذي القطبية بين الاكتئاب والهوس كنقطة انطلاق مسلم بها في تحقيقاتي الفينومينولجية 8 9.
خلاصة:
يمتلك المنهج الفلسفي لعلم الظواهر القدرة على فتح أعيننا على تعقيد وتنوع الظواهر التي قد تغطيها أحكامنا المسبقة المضمرة. لقد أسدت البحوث الفينومينولجية الكثير بالفعل في سبيل توسيع آفاق تصورنا وفهمنا للعلل النفسية، إلا أن الطريق لا زالت طويلة. إحدى الطرق التي تمكن للظواهر الفلسفية من دعم الدراسات النفسية هي البحوث التحضيرية للظواهر التي ستتم دراستها واستنطاقها وتوضيحها. ورغم ذلك، أهمل جدا هذا الجانب من البحوث الفينومينولجية بالضبط في الكتابات المعاصرة. وكلي أمل أن تساهم هذه المقالة في هذا المجال البحثي، ليس فقط من خلال وضع الأساس لمزيد من البحث والتحقيق حول ظاهرة الهوس، ولكن أيضا عن طريق إقناع الآخرين بالانخراط في مشاريع تفسيرية مماثلة من شأنها أن تمهد الطريق لبحوث فينومنيولجية ونفسية أكثر عناية ودقة في المستقبل.
شكر وتقدير: أود أن أشكر برادلي س. وارفيلد، وآنا دي برويكير، وهاري لويندون – إيفانز على ملاحظاتهم المفيدة حول المسودات السابقة لهذه الورقة.
اقرأ ايضًا: فينومينولوجيا العزلة
[1] – تعليق الحكم أو إرجاء الحكم أو الإيبوخي: “وفي هذا المستوى يتوقّف الفينومينولوجي عن الاعتقاد، أو في الحقيقة يقوم بتعليق حكمهِ إزاء العالم، أي يمتنع عن إصدار أحكام إزاء الموضوعات القصديّة. وهذا الحياد إزاء إبداء الموقف، “يسمّيه هوسرل تعليق الحكم، الإيبوخي. موقف الإيبوخي إزاء العالم هو الّذي يميّز الموقف الفلسفي عن الموقف الطّبيعي، وهو ما يتيح للفنومينولوجيا إرجاع الموضوعات والعالم إلى كيفيات عطائها، هذا الإرجاع يسمّيه هوسرل الإرجاع الفنومينولوجي أو الترنسدنتالي، وهو ما يسمح بدراسة الموضوعات في تعالقها مع الكيفيات الذاتيّة لعطائها”. أزمة العلوم الأوربيّة، منقول من مقدمة المترجم إسماعيل المصدق، ص21. -المترجم.
[2] – الإتيمولوجيا: أو علم أصول الكلمات وهو علم يبحث عن العلاقات التي تربط كلمة بوحدة قديمة جدا تعد هي الأصل. بالمعنى القديم، هي البحث عن المعنى الأصلي للكلمة، وهي عملية لسانية تعتمد المقارنة بين الصيغ والدلالات لتمييز الأصول والفروع. -المترجم.
[3] – هناك أيضًا شكل من أشكال الفينومينولوجيا يُشار إليه أحيانًا باسم “علم النفس الفينومينولوجي”؛ يوصف هذا عادةً بأنه فينومينولوجيا فلسفية تتفق مع الطبيعانية وعلوم العقل (بدلاً من أن تكون متسقة مع الفلسفة الترنسندنتالية). ولأن هذا النوع من الفينومينولجيا ليس له صلة خاصة بالبحث الحالي (ويخاطر بخلط لا لزوم له مع الظواهر النفسية) فلن أناقشه أكثر في سياق هذا المقال. لمزيد من القراءة حول هذا الموضوع راجع علم النفس الفينومينولوجي لهوسرل (المرجع رقم 1). -المؤلف.
[4] – التوافق البين-الذاتي أو توافق الذوات أو الذاتية المشتركة intersubjectivity: هو مصطلح صاغه علماء الاجتماع ويعني بشكل عام الإشارة لإتفاق في مجموعة معينة من المعاني بين الناس على مجموعة من المفاهيم (يشار لهذا بالحس السليم أي المعنى الفطري المشترك بين البشر) أو قد يأتي التوافق بمعنى المشاركة لنفس الحالات بين شخصين وأكثر. ويمكن وصفه بأنه جسر بين المفهوم الشخصي والمفهوم المشترك، أي بين الذات والآخر. -المترجم.
[5] – هذه الفكرة تتطلب مزيدا من التوضيح: يمكن القول أن الدراسة الظاهراتية للأحكام المسبقة قد اتخذت بالفعل شكلًا كاملاً في عمل هوسرل الوراثي والتوليدي (المراجع 6،7) حيث درس كيف قدم عالم حياتنا إمكانيات جديدة للتحقيقات العلمية في ضوء الخلفيات المفاهيمية الموروثة. على الرغم من أنني لا أختلف مع هذا الادعاء، إلا أن التحول الهريمينوطيقي لهيدجر وغادامير لا يزال وثيق الصلة بالمشروع الذي أشارك فيه، حتى لو كان ذلك بسبب اهتمامه الواضح باللغة. -المؤلف.
عطفا على ما سبق يقول محمد شوقي الزين في تحليله لقراءة غادامير “منطق “الافتراض المسبق” يعتبر أن “قبل” النص هناك نص آخر “نص قبلي” و”قبل” الفهم هناك فهم آخر “فهم قبلي” و”قبل” التأويل هناك تأويل آخر، “تأويل قبلي”. وهذه التأسيسات القبلية تعتبر أن المواضيع التي يقصدها الوعي وأن النصوص التي يؤولها القارئ ليست مواضيع أو نصوص مستقلة ومعطيات مطلقة، وإنما هي “آفاق منصهرة” من تأويلات وقراءات آنية تشكلت في الحاضر هنا والآن وأخرى تأسست في الماضي. وعليه ينخرط “التراث” Tradition بكل إمكانياته وكموناته الدلالية والرمزية والتأويلية والتاريخية في آنية الحاضر. تصبح كل قراءة لنص أو أثر فني هي قراءة وتأويلا للتراث، ما دام هذا النص أو هذا الأثر هو نسيج علاقات تأويلية وخطابية مثبتة تشكلت في التاريخ. يتخذ النص أو الأثر بذلك صورة وعاء قد احتوى على تأويلات وخطابات ورؤى ومناهج سابقة ليحتوي أيضا على افتراضاتنا الخاصة وتأويلاتنا وقراءاتنا الراهنة”. انظر: http://www.aljabriabed.net/n16_07azinl.(2).htm -المترجم.
[6] – هناك أيضًا طبقة أخرى من البحث في علم الظواهر يشار إليها عادةً باسم الأنماط. بينما لا يمكنني تقديم وصف مفصل للأنماط الموجودة في فضاء هذا المقال ، فقد قدمت روايات عن الأساليب في عدد من المقالات الأخرى (انظر المراجع: 8-10). -المؤلف.
“الخطاب الفلسفي كخطاب ميتافيزيقي يهدر وينخر جسد اللفظ لينتصر لروح الدلالة، ويضمن تواصل الحقيقة المتوارية والسعي عن كشفها ضمن مقولات لاهوتية وقيم أخلاقية متعالية” -انظر المصدر السابق. -المترجم.
[7] – يقول غادامير في معرض تفسيره لهيدغر في “الحقيقة والمنهج” متناولا مسألة حتمية المعرفة المسبقة في مواجهتنا مع النصوص بأننا لا يمكن أن نقرأ النص إلا بتوقعات معينة. أي بإسقاط مسبق. غير أن علينا أن نراجع إسقاطاتنا المسبقة باستمرار في ضوء ما يمثل هناك أمامنا. وبإمكان كل مراجعة لإسقاط مسبق أن تضع أمامها إسقاطا جديدا من المعنى. ومن الممكن أن تبزغ الإسقاطات المتنافسة جنبا إلى جنب إلى أن تغدو وحدة المعنى أكثر وضوحًا ويتبين كيف يمكن أن تترابط الرموز والعالم. هذه العملية الدائمة المستمرة من الإسقاط الجديد هي حركة الفهم والتأويل. وعلى المؤول لكي يبلغ أقصى فهم ممكن ألا ينخرط فحسب في هذا الحوار مع النص. بل أن يفحص على نحو صريح منشأ المعنى المسبق الذي بداخله ومدى صحة هذا المعنى. يقول غادامير: “وإدراك أن كل فهم لا بد له من أن يشتمل على بعض “التحيز” أي المعنى المسبق” هو ما يمنح مشكلة الهرمنيوطيقا زخمها الحقيقي” وجدير بالذكر أن غادامير يعتبر سعي “التنوير” إلى التخلص من كل التحيزات هو نفسه “تحيزًا” (تحيز ضد التحيز!) إنه تحيز يحجب عنا تاريخيتنا الجوهرية وتناهينا الصميم. من كتاب فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى غادامير، د. عادل مصطفى، صـ18. -المترجم.
[8] – انظر في نقد نظرية تاريخيّة الفهم عند غادامير مقال: الإنسان ليس تاريخًا محضًا. https://www.iicss.iq/?id=40&sid=384 -المترجم.
[9]– انظر: الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية، د. الطيّب بو عزة، صــ571-572. -المترجم.
[10] – إيوثيميا: الطمأنينة، بحسب الفلسفة الإغريقية (باليونانية :εὐθυμία، إيوثيميا)، وتعني”الفرح، والمزاج الجيد، والصفاء و”حرفيا ” التومس الجيد”) هو مصطلح استخدمة ديموقريطس ليشير إلى واحدة من جذور جوانب أهداف حياة الإنسان. -المترجم.
المراجع:
- Husserl E. Phenomenological psychology: lectures, summer semester, 1925. The Hague: Springer 1977.
- Sass LA, Parnas J, Zahavi D. Phenomenological psychopathology and schizophrenia: contemporary approaches and misunderstandings. Philos Psychiatr Psychol 2011;18:1-23.
- Sass LA. Self and world in schizophrenia: three classic approaches. Philos Psychiatr Psychol 2001;8:251-70.
- Sass LA, Parnas J. Explaining schizophrenia: the relevance of phenomenology. In: Chung MC, Fulford KWM, Graham G, editors. Reconceiving schizophrenia. Oxford: Oxford University Press 2007, pp. 63-95.
- Husserl E. Ideas for a pure phenomenology and phenomenological philosophy. First book: general introduction to pure phenomenology. Indianapolis-Cambridge: Hackett Publishing Co. Inc. 2014.
- Husserl E. The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: an introduction to phenomenological philosophy. Evanston: Northwestern University Press 1970.
- Husserl E. Cartesian meditations: an introduction to phenomenology. Dordrecht: Martinus Nijhoff 1977.
- Fernandez AV. Depression as existential feeling or de-situatedness? Distinguishing structure from mode in psychopathology. Phenomenol Cogn Sci 2014;13:595-612
- Fernandez AV. Reconsidering the affective dimension of depression and mania: towards a phenomenological dissolution of the paradox of mixed states. J Psychopathol 2014;20:414-20.
- Fernandez AV, Wieten S. Values-based practice and phenomenological psychopathology: implications of existential changes in depression. J Eval Clin Prat 2015;21:508-13.
- Gadamer H-G. Philosophical hermeneutics. Berkeley: University of California Press 2008.
- Merleau-Ponty M. Phenomenology of perception. New York: Routledge 2013.
- Young IM. On female body experience: “throwing like a girl” and other essays. New York: Oxford University Press 2005
- Straus EW. Phenomenological psychology: the selected papers of Erwin W. Straus. New York: Basic Books 1966.
- Heidegger M. Being and time. New York: Harper Perennial Modern Classics 2008.
- Sartre J-P. The imaginary: a phenomenological psychology of the imagination. New York: Routledge 2010.
- Kraepelin E. Dementia praecox and paraphrenia, together with manic-depressive insanity and paranoia. Birmingham: Classics of Medicine 1989.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 5th edition. Washington, DC: American Psychiatric Publishing 2013.
- Healy D. Mania: a short history of bipolar disorder. Baltimore: Johns Hopkins University Press 2011.
- Angst J, Marneros A. Bipolarity from ancient to modern times: conception, birth and rebirth. J Affect Disord 2001;67:3-19.
- Angst J. Zur ätiologie und nosologie endogener depres siver Psychosen. Eine genetische, soziologische und klinische studie. Berlin: Springer 1966.
- Perris C. A study of bipolar (manic-depressive) and unipolar recurrent depressive psychoses. Acta Psychiatr Scand 1966;194:1-89.
- Court JH. The continuum model as a resolution of paradoxes in manic-depressive psychosis. Br J Psych 1972;120:133-41.
- Court JH. Manic-depressive psychosis: an alternative conceptual model. Br J Psych 1968;114:1523-30.
- Whybrow PC, Mendels J. Toward a biology of depression: some suggestions from neurophysiology. Am J Psych 1969;125:1491-500.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 3rd edition. Washington, DC: American Psychiatric Association 1980.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 4th edition. Washington, DC: American Psychiatric Association 1994.
- Sass L, Pienkos E. Varieties of self-experience: a comparative phenomenology of melancholia, mania, and schizophrenia, Part I. J Consciousness Stud 2013;20:103-30.
- Sass L, Pienkos E. Space, time, and atmosphere: a comparative phenomenology of melancholia, mania, and schizophrenia, Part II. J Consciousness Stud 2013;20:131-52.
- Fuchs T. Psychopathology of depression and mania: symptoms, phenomena and syndromes. J Psychopathol 2014;20:404-1