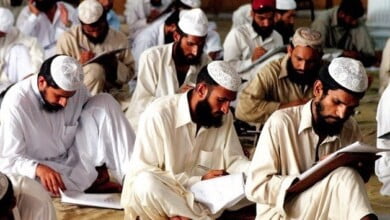- حسين نور
- تحرير: غادة الزويد
كل الجنس البشري يشترك فيما يسمى “مرور الوقت” كل فرد منهم، بذات الطريقة. إلا أن دراسة الحياة وكيف يجب أن تكون، أضحت أقل المواضيع التي تهتم بها العقول البشرية اللامعة.
فالإنسان القديم وجّه معارفه نحو أهم عامل يؤرق الإنسان وهو”مرور الوقت” وكيف يمكن أن ننجح في الاستفادة من أعمارنا على الأرض، فكان الموضوع الأسمى كجسد الشجرة والتي تحمل أغصان متنوعة تمثل المعارف بالعالم الطبيعي من حولنا فكانت القصص والأساطير والأديان والمعتقدات وكلها تتمحور حول “كيف نستفيد من أعمارنا” فراكمنا خبرات متعددة منحتنا سلاحا نتميز به عن كل أشكال الحياة الأخرى، رغم أن الطير يولد وهو يعرف طرق سفره وبعضها يمشي من أول ثانية إلا أن الكائنات الأخرى تراكم الفعل والآلية فيما نحن نراكم المعرفة، ومن هنا كانت الحضارة البشرية في تقدم وتطور مستمر.
ولكن ما الذي يحدث إذا كف الإنسان عن مراكمة خبراته في علم “مرور الوقت ” واستبداله بمراكمة الآلية والفعل كما يحدث اليوم؟
حيث إن الاقتصاد أصبح هو محور العلوم كافة والأنشطة كافة، لدرجة أن أواصر العائلة والأصدقاء وكل ماله قيمة في “أوقات حياتنا” أصبح ثانويًا أمام الاقتصاد. فقد يكون الأب في دولة أخرى ولا يرى أبنائه وهم يمرون بمراحل الحياة المختلفة، أو يكون في ذات المكان ومع ذلك يستغرق العمل حياته فلا يجد وقتا يستطيع مشاركته مع عائلته، أو يعيش الأبن بقرب مكان عمله فلا يملك وقتا لمشاركة أصدقائه والاحتفال بشبابه، أو تعيش الزوجة بعيداً عن زوجها وتضطر الابنة إلى اللحاق بزوجها ومكان عمله وبذلك تصبح وحيدة في مواجهة المشاكل العائلية بعيدا عن عائلتها!
إن مانسميه اكتئاباً وكل مايمت له بصلة ليس إلا نتاجاً لغياب علم “مرور الوقت ” فقد يكون أحدهم راضيا وسعيدا “بمرور الوقت ” في قرية صغيرة تقوم فيها العادات والتقاليد بإعطاء التعليمات الواضحة في طريقة التعامل مع الحياة في مختلف الأعمار ومراحل الحياة، فيما يكون رجل أعمال في مدينة عالمية يجني الكثير من الأموال حزيناً ومكتئباً فالمدينة تقيس الحياة بما يملكه الفرد من أشياء وأموال، لا ما يملكه من شخصية.
فالأمور تكون ضبابية في مرحلة المراهقة ولكن لا يكون الأمر كذلك في مرحلة الشباب حيث يبدأ الفرد بملاحظة ملامح الحياة المجهدة والمتعبة والمملة وأحكامها القسرية ومعاناتها، فيصبح المستقبل قاتما أمامه فلا يجد مثالاً جيداً يتحدث عن هذه الأمور أو يبدد كل هذه الظلمة..
الجامعة والمهنة
لم تكن الجامعات في بادئ الأمر مجرد مبنى مقسم إلى فصول وغرف ادارية وتراتيبية تبدأ بمدير الجامعة وتنتهي بالطالب، لم تكن مجرد وقت يرى فيه المحاضر أنه يمارس عملاً يوفر له قوت يومه، فيما الطالب يرى في هذا الوقت مجرد وقت انتظار ممل عليه عبوره لممارسة الحياة الحقيقية.
فالجامعة وفترة الحياة فيها أضحت فترة غير واقعية تخرج كل فرد من عائلته وطبقته الاجتماعية-في بعض الأحيان فالطبقات العليا ترتاد جامعات معينة فتصبح مرحلة الجامعة مجرد إعداد لهم للبقاء في تلك الطبقات- وتجعله يحتك مع بشر من مختلف مناطق العالم دون توجيه لكيفية الاستفادة من هذه المرحلة حقا.
فالجامعة كانت مكاناً يعد قادة كل مجتمع، مكاناً للفكر والنقد وإبداء الرأي وخلق شخصية خاصة، مكاناً يلعب فيه الطالب دوراً أهم من مدير الجامعة ويلعب فيه المحاضر دور معلم حياة لا معلم مادة، فكانت مباني الجامعة مباني الحرية والشباب والتغيير والقوة ومنها يعرف كل مجتمع ماذا يجب تغييره.
ولكن كل ذلك تغير مع دخول الرأسمالية في كل المجالات، كما حذر ماركس سابقاً فأصبحت الجامعة جزءا مهما في الاقتصاد فهي تخرج عمالا جددًا بمهارات أفضل فيما الجامعة أضحت شركة تريد استهداف عدد أكبر من الطلاب، فتجذبهم بطرق تسويقية مثل الشركات الأخرى تارة بتوفير سبل الترفيه والراحة حتى وإن كان منح الشهادة مقابل المال والانخراط في تمثيلية محاضرات لا تهدف لتعليم بل فقط لتطبيق معايير التخرج قبل منح الشهادة!
هذه الحالة السطحية التي تمر بها الجامعات رفعت من قيمة مدير الجامعة الذي لم يعد أكثر الناس علماً في المجتمع؛ بل مجرد شخص قادر على جلب الأموال للجامعة وفرض النظام فيها، فأصبحت الدولة والأجهزة الرقابية والقدرات المالية هي أهم مايساهم في اختيار المدير، وبذلك أصبح المحاضر مجرد عامل آخروالطالب مجرد زبون أخر.
إذن، ماذا يفعل الشباب إزاء هذا الوضع الذي تبقى ملكاتهم الفكرية فيها كما كانت وتجاربهم مازالت كما هي؟
الجامعة أخرجتهم من طرق تفكير مجتمعاتهم في مواضيع الإبداع ومايطمح له الفرد والجنس وطرق فهم الحياة الاجتماعية، ولكن لم يجدوا في الجامعة سوى وقت من الانتظار، بلا معلم يخبرهم كيف يمكن أن يكتشفوا ذواتهم وماهم بارعون فيه وكيف يجب أن تكون شخصياتهم وكيف “يلعبون ويعملون ” !
هذه الأخيرة تشكل ماضي ومستقبل كل طالب جامعي، فلم يكن في الماضي مطالباً بشيء كبير حتى وإن قست الظروف عليه، وعمل منذ صغره لم يكن مطالباً بالكثير ولن يتم تعريفه بما يملكه وماذا يعمل، فيما في المستقبل سيكون العمل هو أكثر ما يحدده؛ نظراً لان الاقتصاد أضحى أهم مافي الكرة الارضية وكل مافيها يسخر لأجله حتى حياتنا الخاصة..
فالانسان القديم كان يجمع احتياجاته اليومية، ومن ثم ينفق طاقته في بناء منزل ما أو مركب خشب بطريقة يتعلمها ومن ثم يضيف إليها لذلك اليوم نحن نأكل مجموعة من الخضروات والفواكه، تم وضعها على قائمة الطعام منذ آلاف السنين ولم نضف الكثير لهذه القائمة، حتى حين نرى الحيوانات الأليفة اليوم فعلينا ألا ننسى أنها لم تكن كذلك، حتى أتى مجموعة من المبدعين وابتكروا طريقة تمنحهم السيطرةعلى هذه الحيوانات !
وحتى طرق المتعة والطقوس الروحية، لم تختلف كثير بل انتكست بشدة، وكل هذا حدث لأننا أصبحنا نركز على أغصان الشجرة من العلوم الأخرى وننسى جسد الشجرة، وكما أنه لا وجود لأغصان بلا جسد الشجرة فإن تركيزنا على العلوم الأخرى يشبه وضع أوزان على الاغصان وفي النهاية لن تتحمل وستتحطم بلا شك!
فالمهنة كانت ترتبط بفائض الإبداع لدينا، وليس أمر يجلب المال وهذا أمر يتعرف إليه المبدعون بشكل خاص؛ حيث إنهم ما أن يكتشفوا مايحبونه ويبدعون فيه حتى يمحوروا الحياة حول هذه النقطة، فلا يهتم العازف بنوعية الطعام بقدر مايهتم بنوعية أداته الموسيقية ووقته، ولن يهتم الكاتب بروعة مكتبه بقدر مايهتم بالوقت الذي يقضيه في القراءة والكتابة. وحتى العاشق ينسى طعامه حين يكون بجانب من يعشق. ومن هنا كان الحب الدافع الأساسي للحياة في الأساطير القديمة كأسطورة متاهة كريت، حيث يمكت الميناتور في قلب المتاهة الصعبة وعلى أهل كريت إرسال الشبان والشابات لمحاولة عبور المتاهة، فتنتهي حياتهم مرة تلو الأخرى حتى جاء ثيسيوس ابن ملك كريت وأراد قهر المتاهة فأعجبت به “اريادني ” وأعطته كرة خيطا حتى لا يتيه في هذه المتاهة ونجح في مهمته ولكنه كان قد أتفق مع والده أنه سيرفع الشراع الأبيض إن نجح، وإن لم يفعل ذلك وبقي الشراع الأسود فهذا يعني أنه لقي مصرعه. ولسبب أو لآخر نسي أن يرفع الشراع الأبيض وكان والده من الجانب الآخر يراقب الشراع كل صباح وحين لم ير الشراع الأبيض أصابه الحزن، فألقى بنفسه في البحر ومات.
وبما أن الأساطير والقصص القديمة تفهم بالمجاز لا بالإيمان بأنها حدثت أو بإنكار حدوثها وهنا يكون المؤمن بإيمانه لم يفهم المغزى من القصة، والملحد بإلحاده وإنكاره لم يفهم القصة ويستفد منها أيضا!
كلاهما وجهان لعملة واحدة ووحده من يتقن لغة المجاز يفهم ذلك. ولنعد لقصة المتاهة والتي تمثل الحياة وأن ثيسيوس شاب وكان والده ينتظره وهذه هي مرحلة الشباب حيث ينتظر الوالد نتاج بذوره وتعليمه لابنه، وحين ينطلق الابن في متاهة الحياة، عليه بأن يملك خطة وأيضا أن يكون دافعه الحب فقد وعد ثيسيوس “أريادني” بالزواج فمنحته كرة الخيطان ليستدل بها على طريق العودة..
إن دخول مرحلة العمل والمجتمع يمثل المتاهة في هذه القصة والحياة الخادعة في المعتقدات السماوية الإبراهيمية و”المايا ” في البوذية وتعني الوهم، وهذه الحياة هي حياة الرغبات والممتلكات والقوانين والتي تتأثر بالبيئة وتملك الكثير من القيود الخادعة، فمن يأتي من عائلة فقيرة عليه إما أن يرى الواقع كما هو فيترك أحلامه ويصبح مجرد عامل آخر، أو أن يأخذ بالأسباب ويفهم أن وضعه مجرد نتيجة ولكن ليس أمراً مطلقا فإذا امتلك خطة ورغبة وشجاعة سيخرج من المتاهة ويحقق حلمه، وأيضا الأمر كذلك عند من يأتي من عائلة غنية حيث تكثر العادات والضوابط وتحد من مساحة حريته واختياراته، فإنه قادر على عيش الحياة التي يريدها بعيداً عن وضعه الاجتماعي.
فمرحلة العمل “المهنة ” هي مرحلة نراها بطرق العائلات التي أتينا منها، سنخاف إن كنا نرى الجيل الأكبر مُمِلا لأننا سنصبح مثلهم مالم نملك خطة ودافع أمام هذه المتاهة.
حرب المال والوقت
في مرحلة الشباب نملك الكثير من الوقت الذي لا ننتج فيه مالاً عكس عالم الكبار حيث الوقت إما لإنتاج المال أو استهلاكه. وفي العقود السابقة لم يكن وقت الشباب جزءا من الاقتصاد بل كان يخصص للأنشطة الإبداعية فيتعرف العازف على قدراته ويتعرف على من يشاركونه ذات التوجهات وكذلك الرياضي والمهتم بالعلوم، إلا أن ذلك تغير، حيث الاقتصاد بات يعتمد على الاستهلاك أكثر من الإنتاج!
وقتاً مثالياً للاستهلاك سواء استهلاك الملابس والأجهزة واستهلاك تجارب المتعة بمختلف أشكالها واستهلاك الصور الغرامية والقصص الرومانسية، فيجد الفرد ذاته غير راض وراغباً دائما بشيء آخر وأن يكون في مكان آخر مع أشخاص آخرين، وهذا بحق ما يحتاجه الاقتصاد للاستمرار “إنسان غير راض”..
فالإنسان الذي لا يشعر بالرضا عن حياته هو لا يشعر بالرضا عن كيفية “مرور الوقت” عليه وعدم راحته يدل على أنه إما لا يملك معرفة عن كيفية الاستفادة والاستمتاع بوقته، أو أنه يتبع طرق وتعاليم لا تمت له بصلة، تخبره كيف يمكن له قضاء وقته اليومي، فينعكس ذلك على شكل عدم رضا وبرود في يومه أو يقاوم ذلك بالانخراط بسلوك إدماني والمصيبة أنه يشعر بكل الضيق ولكن -معرفته- قاصرة عن رؤية السبب!
لذلك هو يشعر بالخواء لأسلوب الحياة الاستهلاكي المفروض عليه، ويشعر بخواء أكبر وهو ينظر للمستقبل حيث سيعمل 40 ساعة ستجعله نسخة مثل كل الكبار الآخرين وأساليب حياتهم المملة، حيث إن نظام العمل لثماني ساعات صُمم كيف يقسم وقت الإنسان إلى أوقات ينتج فيها المال وأوقات أقل يستهلك فيها المال بشكل أكبر مدفوعاً برغبته في تبرير انشغاله الدائم عن نفسه وما يريده حقا عن طريق صرف مبالغ أكبر على رفاهيته في وقت الراحة، وهكذا يدور الإنسان في دولاب لا يقدر على الخروج منه ويضيع في المتاهة ويخسر نفسه شيئاً فشيئا حتى يتصالح مع خسارته بدلاً من روح الثورة التي كان يملكها في شبابه ورغباته الواضحة.
ما يريده المجتمع وما يريده الفرد
في السابق كان المجتمع معروفاً ومرئياً لكل فرد من أفراده والتراتبية فيه كانت تعود لمهارات كل فرد سواء العقلية أو الجسدية، فكانت القرية بمثابة عالم كامل متكامل بقصصه وأحداثه، فكانت العادات والتقاليد تخبر الصغير كيف يكون والشاب كيف يكون والرجل مسؤولياته.
في المدينة لا شيء من هذا، جماعات غير متجانسة اجتمعت لأجل العمل صباحاً ومن ثم استهلاك المال مساء، قد تكون عازفاً كبيراً ولكن جارك لا يعرف عنك شيئا، وقد تكون كاتباً وروائياً أو طبيباً أو مهندساً بقدرات رائعة، ولكن ما لم تكن هناك ممتلكات كبيرة فلا أحد سيعترف بشيء لك، ومن هنا خلق التوق للامتلاك وحب الظهور والاستعراض، وهذا ما يريد المجتمع خلقه، مسرح استعراض لا مسرح حقيقي يكون فيه الفرد بطل دائرته الصغيرة ويتناغم معها.
الفرد يرغب في ممارسة ما يحب في وسط هادئ وآمن دون مطالبات وقيود، فيما المجتمع يخرج هؤلاء من يهتمون بالوقت وكيف “يمر الوقت” عليهم ويسميهم حالمين وكسالى، فيما يحييّ ويحترم ذاك الذي لا تخرج سماعة الأذن من أذنه فيتحدث لهذا ويبيع لذاك طوال الوقت، وذاك الذي يخدع ويكسب الكثير والمدير الذي لا يهمه سوى الربح وإن اضطر لفصل كل من يعملون تحته، وهكذا يستحيل العالم إلى مسرح استعراض ممل، بلا قيم وبلا أخلاق ولا شيء يهم سوى المال.
الإنجاب والخلق
كل الكائنات الحية تشترك في القدرة على الإنجاب ولكن بعد أن تكون قد وصلت لمثاله الأكبر، فبذرة الليمون ليست ليمونا بقدر ماهي تحمل -إمكانية- وجود الليمون في المستقبل. ولكي تصبح ليموناً ستحتاج إلى بيئة خاصة وعناية خاصة، ومن ثم تنمو ببطء حتى يظهر اللحاء ومن ثم الأوراق، وفي كل هذه المراحل تتعرف على بيئتها الخاصة وتستفيد من فرص الماء والضوء وتنمو حتى يكثر شجرها فيكون الليمون مجرد نهاية ونتيجة لمراحل متعددة، وأيضا بداية لمرحلة جديدة حيث في كل ليمونة هناك بذرة تحمل إمكانية خلق ليمون آخر، وهكذا من شجرة واحدة تخلق آلاف الأشجار.
وكذلك الإنسان الكامل الذي أخذ وقته كاملاً ومر بجميع المراحل سيكون أهم من ألف إنسان عادي آخر، والفرق بين الإنسان العادي والكامل يكمن في الظروف والبيئة التي ساعدت الأول على الازدهار والأخر على خنق إمكانياته.
البيئة بالنسبة للإنسان ستكون المجتمع وكلما كان المجتمع راقياً في أفكاره وتعاليمه كلما كان قادراً على خلق أعداد أكبر من البشر الكاملين، وهذا جل ما تدور حوله التعاليم الكبرى للإنسان، كيف نكون بيئة حاضنة تجعل من الإمكانيات التي نحملها داخلنا تظهر، وكيف نقلل من العوامل التي تخنق كل هذه الإمكانيات، إلا أننا توقفنا منذ مدة عن التفكير في هذا الموضوع، بل إن شركات الترفيه الكبرى تستهدف تبديد الوقت للأطفال والشباب كونهم أقل حكمة في معرفة أهمية الوقت حيث صرح ريد هاستنغز صاحب منصة نتفليكس أن منافسه الوحيد هو “النوم “!
وبهذا لم يعد الفن يحمل الإبداع والابتكار؛ بل مجرد معادلات لدقائق تبدأ بالإثارة في بداية الحلقة ومن ثم إلى قصة رومانسية في العشر دقائق الثانية، ومن ثم خلق أحداث ذات إثارة بصرية في العشر الدقائق الثالثة، ومن ثم إنهاء الحلقة قبل انتهاء الإثارة وبذلك تبدأ الحلقة الأخرى والممثل يصوب مسدسه وهكذا!
معادلة تستهدف إثارة المشاعر لدينا بطريقة مدروسة تجعلنا نتوق لمتابعة الأحداث ليس لأن القصة تستحق؛ بل لأن المعادلة العصبية ناجحة. فيما رأى أنييلي رئيس نادي يوفنتوس أن كرة القدم أصبحت تنافس الألعاب الالكترونية لأخذ وقت مشاهدة من الصغار والشباب ولذلك دعا لخلق دوري تجتمع في الأندية الكبرى في مواجهات متكررة!
وبهذا لم تعد الرياضة مجالا للهمة والأهداف وإظهار الإرادة الصلبة؛ بل مجرد مجال ترفيهي، واللاعبون ليسوا في مهمة كتابة التاريخ بل تقديم متعة، وكان قد صرح الراحل كوبي براينت في إحدى مقابلاته، أنه رجل عرض وعليه أن يقدم عرضاً ممتعا للجمهور، وهذا كان دافعه حتى ذهب للأولمبياد وعلم أنه رياضي ودافعه البقاء على أعلى مستوى!
ولكن ما علاقة هذا في الخلق والإنجاب؟
إن الإنجاب أمر موجود ونشترك فيه مع كل المخلوقات الأخرى فيما الخلق هو نتاج شخصياتنا وطباعنا إذا منحت وقتاً كافياً للنضج، ستظهر على شكل انجازات واكتشافات أو حتى جودة في صناعة ما.
لكي ينتقل الإنسان لمرحلة الإبداع والخلق يحتاج إلى بيئة تناسب شخصيته وتجارب تنميه وإن نجح في توفير ذلك لنفسه، سيكون مبدعًا في مجاله. ولذلك نرى أصحاب المهارات غالباً ما يعيشون في عالم يتمحور حول ما يحبونه فينجحون لهذا السبب، فيما الإنسان العادي يتم خنق إمكانياته عن طريق تسميم بيئته بأكثر من شكل أهمها الزواج المبكر الذي يحمل الإنسان لمرحلة لم يصل إليها بعد ويظن أنه بفعله هذا اختصر الطريق، ولكن كل ما فعله هو أنه أهدر وقتاً ثميناً كان يجب أن يستغله في تثمين وتنمية تجاربه كما تفعل بذرة الليمون وهي تكبر وتنمو شيئا فشيئا.
إن الإنسان يمر بمراحل الابن\ة الصغير ومن ثم الابن \ة الشاب فيكون عما \ة وخالا \ة ويفهم الكثير من ديناميكية التعامل مع العائلة وصديقاً ومبدعاً، فيشترك مع الآخرين وما إن يتقن هذا الدور حتى ينتقل طواعية إلى مستوى الأب والأم تماماً كالشجرة المثمرة، ومن ثم يصبح جدًّا أو جدة في نهاية عمره، وأي نقص في مرحلة من المراحل ستظهر سلبياتها في المرحلة التي تليها.
فكل شخص منا باب لعالم وحين نتعرف على أحدهم فنحن نفتح بابا قد يرينا جنة من التجارب والأفكار والمشاعر وقد يرينا عالما سوداويا قد تجد خلف أحدهم عوالم متنوعة من التجارب والحكمة تفوقك آلاف المرات فتستفيد منه، وقد تجد بابًا ما إن تفتحه حتى تجد غرفة صغيرة مليئة بالأفكار البالية فصاحبها لم يخرج من بيئته أبدا ويرى العالم كما يراه كل من حوله .
كطفل نعلم أن صوتنا الداخلي هو ما يقودنا ويحدث ذلك لأن العقل مازال ضعيفاً، والإنسان العادي يقوده عقله لذلك تكون حياته ما بين هبوطٍ وارتفاع، تارة يقاومها وتارة يستسلم لها، فيما المبدع ينمو عقله ولكن يبقى صوته الداخلي هو من يقوده.
الوقت لدينا ليس إلا هذه اللحظة، وحياتنا ليست إلا مجموعة لحظات، كلما كانت اللحظة رائعة وجميلة تكوّن المستقبل من لحظات ممتعة، وكلما كنا نطير من هدف لآخر ونخاف المشاكل المستقبلية كان مستقبلنا مليئا بالأمراض وعدم الرضا.
علم مرور الوقت ليس إلا الهدوء والتأمل والاحتفال مع من نحب، وتكاد كل الأفكار والمعتقدات تؤكد على هذا الجانب، ومع ذلك لا أحد يصل للحظات الهدوء والمعرفة. طريقة تعليمنا أورثتنا التفكير الزائد ومنحت العقل مكانة القيادة رغم أننا نشعر بالسعادة في قلوبنا فيما السعادة التي في عقولنا هي سعادة الإدمان، فرق بين الطمأنينة والهدوء وبين تأثير الدوبامين الذي يحول الفرد إلى مدمن.
فالعقل أداة للاستفادة من الحاضر وفي اللحظة التي نفكر فيها في المستقبل سيجر أكثر التوقعات شؤماً أو أكثرها خيالية، فالعقل يفهم كل شيء ببعدين اثنين، خير وشر، إيجابي وسلبي، ممتع وممل، جميل وقبيح وهكذا، يحصرنا في زاوية نظر واقعية تجعلنا نفقد الإيمان بأنفسنا وننظر للآخرين لكي نقلد حلولهم ونسير في طرقهم؛ لذلك يتشابه الناس في طرق زيجاتهم واختياراتهم للمنازل وغيرها، لأن التشابه مع الآخرين طريق آمن وهذا ما يفهمه العقل “الآمن”
اليوم نحن نحتاج لتلك الأمثلة التي تعمل فيما تحب، تلك الأمثلة التي لا تعرف نفسها بما تملك ولا تسعى لأن تكون منشغلة على الدوام، تلك الأمثلة التي تفضّل أن تنظر إلى غروب الشمس على الشاطئ بشكل طبيعي، لا أن تنظر إلى لوحة عن غروب الشمس في متحف اللوفر في باريس!
إلى من يقول لا ويعيش حياته كفنان ويكون كل شيء فيه مختلف فنهاره، ومساؤه، وليله، وحبه، وعداوته، كل شيء في مكانه، نحتاج إلى من لا يرى في الأشياء أكثر من كونها أداة استخدام فتمكث معه حتى آخر قطرة لا أمراً يفاخر به، من لا يحاول إمساك المستقبل على حساب الحاضر،من لا يترك مايحبه ويرفض ويتقبل النبذ والعزلة ولا يخسر نفسه وآماله. من يعرف أن الحياة مغامرة فلا يخاف ويظل يحاول مراراً وتكراراً، نحن بحاجة إلى الكثير منهم في عالمنا اليوم..
اقرأ ايضًا: الوقت والتقلبات