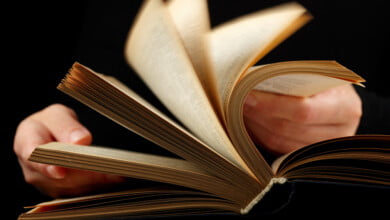- عبدالعزيز بن سعود الجاسر
الحديث عن الطباع والعادات يستفز أصحاب الهمم العالية والنفوس الأبية، وإني أحلف بالله غير حانث أن خلف الجِلّة ممن حققوا وجبة في التاريخ مشرقةً، طباعاً وعادات راضوها وارتاضوا عليها، فزمّوا بها زمام المجد والنصر، وذلك كله بعد توفيق الله تعالى.
لذا صرت أتتبع في سير هؤلاء العظماء وصفحات حياتهم ومجدهم، عن هذا السر البديع، فوجدت عامة هؤلاء بعد توفيق الله تعالى، إنما وفقوا بطبعٍ لحوح أو همة جموح، همة تكسر فطام العادة المستحكمة أو الطبع القاهر، فالعادة السيئة أو الطبع البليد، لابد لهما من فطام، وإلا لأردت صاحبها، وهكذا فقل في اكتساب الأخلاق العالية والطباع الشريفة.
فقيمة الإنسان وثقله في موازين الفضل والسبق، هو بما اعتاده من الأحوال والأمور والخصال، فخليق إذن بالمرء أن يفتش عن عاداته التي لزمها ولزمته، لينظر ثقله في موازين الفضل والشرف، ولينظر أين تقع قدماه…
ومن فوائد هذا البحث أن الإنسان غالباً يسير وفق عاداته وطباعه، فالغالب من الناس إنما هم رُهناء لما طُبعوا عليه أو تعودوا عليه من الأخلاق، ويعسر عليهم النزوع عنها، “لتمكن العادة القديمة منهم، وإذا حملوا أنفسهم على تلك الحالات المحمودة تصنّعاً أو حياءً من الناس في الظاهر لم يعدموا أن يرجعوا إلى المذاهب الأولى المتمكنة فيهم للعادة”[1].
فالذي اعتاد التسويف، أو الكسل، تجده غالباً يحتاج إلى دفعة غير معتادة لينجز عمله كخوفه من المسؤول مثلاً، وغالب هؤلاء يأتي بالعمل متأخراً وفيه ما فيه من التقصير، فالذي دفعه إليه هو خوفه من فوات الوقت والعقاب المترتب عن هذا، بعكس من اعتاد أداء العمل في وقته، فغالب من هذا حاله الاطمئنان وإحسان العمل، وهكذا فقل في جميع أمور الحياة، من اعتاد التردد والخوف من الاقدام، تجده يرضى بحاله التي هو عليها على مرها وشقائها، ولا يسعى في التغيير للأفضل.
ولكم طربت لابن حزم رحمه الله حين حكى عن نفسه كيف عالج اثني عشر عيباً نفسياً خفياً فيه،كالإفراط في الغضب، والعجب الشديد، والحقد المفرط وغير ذلك، فقال: “كانت فيّ عيوب فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم، والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق، وفي آداب النفس، أعاني مداواتها، حتى أعان الله على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه” ثم انظر واستشعر في قول ابن حزم التالي، الطريق الذي سار عليه القوم في رحلة التغيير: “وتحملت من ذلك ثقلاً شديداً، وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني“.
فمن كانت له همة عالية وطموح واسع وأراد أن يكون رقماً صعباً في ساحة العز والمجد، فلينفض عن نفسه طبائع وعوائد كبلته عن بلوغ مراده، فكم والله رأيت من أناس لو كسروا سدود الطبائع الآخذة في دواخلهم لتحدرت قدراتهم كالسيل تملأ وديان المعرفة، وتسقي أرضها، فيا أسفاً على تلك القدرات المكبلة، وأي عيبٍ هو أشد من نقصها عن التمام، وما كانت والله بعيدة عنه ولا دونه البتة.
فالطباع والعادات قاهرات، وإنما ينفك عن هذا زمرة قليلة كانت هممهم أشد بأساً مما طُبعوا عليه واعتادوه، ولذا وجدت من أنعم العطاء أن يجعل الله لك سلطاناً على نفسك.
فكن شغوفاً في البحث عن طباع نفسك وعاداتها، لتنظر الحسن منها فتذكيه، والسيئ منها فتهذبه وتنفيه، وخلاصة الكلام أن تعلم من أين تؤتى مقاتلك، وأن تسد ثغور مجدك، وتجتهد في ترويض نفسك…
إذا تأملت ما قلته لك جيداً ودفعتك نفسك دفعاً للتغيير، فاعلم أن الطريق يحتاج إلى صدق واجتهاد، وصبر ومصابرة ورباط ومرابطة، فليست مهمتك سهلة، ولكنها مهر نجاحك، وفكاك أسرك، ولكني سأقول لك كلمات تنفعك بإذن الله في طريقك اللاحب فاستمع:
اعلم أنك قد نويت السير بخلاف ما تشتهيه نفسك، ولن تلق منها التسليم والإذعان، وأن تكون لك مذللة منقادة إلا بأن تستعين الله عليها أولاً، ثم تفطمها فطاماً يأخذها عن عادتها، وإذا كانت الوحوش بالعادات تروض فالنفس كذلك، “فإذا كان شره الكلب يتحول بالتأديب إلى أن يمسك لصاحبه لا لنفسه، وأن يخلِّي عن الفريسة لمن أطلقه في الصيد، ولا يأكل هو، وإذا كانت الفرس يمكن ترويضها حتى تنقلب من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وإذا كان البازي يمكن ترويضه حتى ينقلب من الاستيحاش إلى الأنس، وهكذا يوجد في ترويض هذه المخلوقات التي هي أدنى من الإنسان بكثير، فكيف إذن بالإنسان وما وهبه الله من الإمكانات” ومن تلك الأسباب المعينة :
أولاً: دعاء الله تعالى دائماً، أن يعينك على هذه النفس وأن يهديك الصراط المستقيم، ووالله ما لزمت هذا النوع من الدعاء إلا وجدت انشراحاً في صدري، وقوة وعزيمة قطعت بها ما تراكم من الأعمال.
ثانياً: مكّن العبادات من قلبك ونفسك، فمن مغازي العبادات ترويض النفوس، وكبح جماحها، وكسر العادات القبيحة فيها، فمن أراد أن يرى أثر العبادة عليه وأن ينظر استقامته عليها، فليحاكم نفسه على مقتضياتها وآثارها في نفسه، انظر مثلاً إلى الصيام كيف يدربك على ترويض نفسك ومنعها ما تشتهيه، “ويطلقها من أسر العادات، ويحررها من فساد الطباع، ويجتث منها رعونة الغرائز. فهذه الأمور وغيرها من أعظم ما يعين على اكتساب حسن الخلق”[2]، وقد قيل:
الصَّومُ يُعْلِي مَنْ وَضيع غرائز
وطبائع سُودِ الوجُوهِ قِبَاح
تلك الغرائز كمْ لها مِنْ صوْلة
مسْعُورَةِ الأنيَابِ ذاتِ نُبَاح!
وانظر إلى الحج أيضاً كيف يزرع في النفوس الإيثار والتعاون، ويبعدها عن الرفث والفسوق والشقاق، وهكذا بقية العبادات، ” والعجب أن الأمر بين النفس والبدن له دور، إذ بأفعال البدن تكلفاً، يحصل للنفس صفة. فإذا حصلت الصفة فاضت على البدن فاقتضت وقوع الفعل الذي تعوده طبعاً، بعد أن كان يتعاطاه تكلفاً”[3]
ثالثاً: خذ نفسك بالتخلق شيئاً فشيئاً، واحذر أن تهملها، ولا تحاول أن تعدلها على عجل، فلن تنجح، فعليك بالمزاولة والمداراة كما تداري الطفل الصغير، فبالمزاولات تعطَى الملكات، ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة.
فـ”العوائد تنقل الطبائع غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث وقد يكون قوياً، ولكن إن لم ينقل الطبع فقد يعود إلى طبعه إذا قوى الباعث واشتد، وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذى انتقل عنه”[4]، «وإن كان نقل الطباع عسيرا، فبالرياضة والتدريج يسهل منها ما استصعب، ويحبب منها ما أتعب …كما قال أبو تمام الطائي:
فلم أجد الأخلاق إلا تخلقا
ولم أجد الأفضال إلا تفضلا»[5]
وقال الجاحظ: «واعلم أن أكثر الأمور إنما هو على العادة وما تضرى عليه النفوس، ولذلك قالت الحكماء: العادة أملك بالأدب، فرض نفسك على كل أمرٍ محمود العاقبة، وضرِّها بكل ما لا يذمّ من الأخلاق يصر ذلك طباعاً، وينسب إليك منه أكثر مما أنت عليه.»[6].
فعليك بإحياء العادات الحسنة في نفسك، لتزاحم العادات القبيحة، وهذه المزاحمة من أنفع ما يعينك فاحرص عليها، ” حتى إذا صار ذلك-الخلق- معتاداً بالتكرر، مع تقارب الزمان، حدث منها هيئة للنفس راسخة تقتضي تلك الأفعال، وتتقاضاها بحيث يصير ذلك له بالعادة كالطبع، فيخف عليه ما كان يستثقله من الخير، فمن أراد مثلاً أن يحصّل لنفسه خلق الجود، فطريقة أن يتكلف تعاطي فعل الجواد، وهو بذل المال، ولا يزال يواظب عليه حتى يتيسر عليه، فيصير بنفسه جواداً. وكذا من أراد أن يحصّل لنفسه خلق التواضع، وغلب عليه التكبّر، فطريقه في المجاهدة أن يواظب على أفعال المتواضعين مواظبة دائمة، على التكرر مع تقارب الأوقات”[7].
«قال العتبي: كان عمي ينفق ماله كأنه مال أعدائه، فكلمته زوجته في ذلك فقال:
هبت تلوم وتلحاني على خلق
عودته عادة والخير تعويد
قلت اتركيني أبع مالي بمكرمة
يبقى ثنائي بها ما أورق العود
إنا إذا ما أتينا أمر مكرمة
قالت لنا أنفس عتبية عودوا»
“والطاعة الواحدة، قد لا يُحس أثرها في النفس وكمالها في الحال، ولكن ينبغي ألّا يستهان بها، فإن الجملة مؤثرة، وإنما جمعت من الآحاد، فلكل واحد تأثير. ثم ما من طاعة إلا ولها أثر ما وإن خفيى”[8]
وهكذا في العلوم والمعارف، عليك باعتيادها حتى تقبلها نفسك وتستعذبها، فإذا أردت العلم فاصبر على التعلم، وإن أردت الحفظ فاصبر عليه حتى تقبله نفسك وتعتاده.
فالعلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحفظ بالتحفظ، قال ابن عثيمين: ” قد يَشُقُّ عليه في أوَّل الأمر أن يَحبِس نَفْسَه على العِلْم، لكن إذا اعتاد حَبْس نَفْسه على العِلْم صار ذلك سَجِيَّةً له وطَبيعةً له؛ حتى إنه إذا فقَدَ ذلك الحَبْسَ انحَبَس، وجَرِّبْ تَجِدْ؛ فأنا قد جَرَّبْتُ وغيري قد جرَّب، فإذا حبَسْت نَفْسَك على العِلْم فإنك تَفقِد ذلك الحَبْسَ لو تَأخَّرْت عنه”[9]، فانظر للقوم وقد جربوا الاعتياد وظفروا…
وقال الغزالي: ” فإن من أراد أن يصير له الحذق في الكتابة صفة نفسية ثابتة فطريقه أن يتعاطى ما يتعاطاه الكاتب الحاذق، وهو حكاية الخط الحسن متكلفاً متشبهاً. ثم لا يزال يواظب على تعاطي الخط الحسن، حتى يصير له ذلك ملكة راسخة، ويصير الحذق فيه صفة نفسانية، فيصدر منه بالآخرة بالطبع ما كان يتكلفه ابتداء بالتصنع. فكأن الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناً، ولكن الأول متكلف والآخر بالطبع، وذلك بواسطة تأثر النفس.
وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس، فلا طريق له إلا ممارسة الفقه وحفظه وتكراره. وهو في الابتداء متكلف، حتى ينعطف منه على نفسه وصف الفقه، فيصير فقيهاً، بمعنى أنه حصل للنفس هيئة مستعدة، نحو تخريج الفقه، فيتيسر له ذلك طبعاً مهما حاوله. وكذلك الأمر في جميع صفات النفس”[10].
وهكذا من شق عليه الحفظ وأراد تسهيله، فعليه باعتياده حتى يألفه، قال أبو هلال العسكري: ” أول الحفظ شديد، يشق على الإنسان، ثم إذا اعتاد سهل،”[11]، وقال أبو السمح الطائي: “كنت أسمع عمومتي في المجلس ينشدون الشعر، فإذا استعدتهم زجروني وسبوني، وقالوا: تسمع شيئا ولا تحفظه قال الشيخ: وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه، ثم عودته نفسي، إلى أن حفظت قصيدة رؤبة (وقاتم الأعماق خاوي المخترق … ) في ليلة وهي قريب من مائتي بيت.»[12] وقد سئل البخاري رحمه الله: ما أفضل دواء للحفظ؟ قال “إدامة النظر” فطوع نفسك على ذلك تطعك…
رابعاً: احذر المعاصي والذنوب، والركون إلى الراحة والدعة، فإنها بريد العادات القبيحة!، ومن اعتاد الجرأة ” على الشبهات، أَفضَت به إلى المحرمات بطريق اعتياد الجرأة، والتساهل في أمرها، فيحمله ذلك على الجرأة على الحرام المحض”[13].
فليس الشأن في معصية شاردة، أو كسل عابر، وإنما الشأن أن ذلك يدعو إلى مثله، ثم” يتداعى قليلاً قليلاً، حتى تأنس النفس بالكسل وتهجر التحصيل فيفوته فضيلة الفقه، فكذا صغائر المعاصي، بعضها يدعو إلى بعض.
وكما أن تكرار ليلة لا يحس بأثره في تفقه النفس، فإنه يظهر شيئاً فشيئاً، مثل نمو البدن وارتفاع القامة… وكم من فقيه موفق لا يستهين بتعطيل يوم وليلة، فهكذا على التوالي، فيحرز كمال النفس والعلم. فكذا من لا يستهين بصغار المعاصي ينتهي به الأمر إلى درجات السعادة، إذ القليل يدعو إلى الكثير”[14]
فالتهاون في الأمور الصغيرة قد يجر إلى ما هو أجل وأخطر، وإذا تسللت يدك إلى هاتفك عند مزاولة بحث ما، فما هو إلا تطلب النفس الانفلات من المشاق والركون إلى الراحة، فإن أنت أعطيتها مشتهاها ولو قليلاً تقوّت بهذا عليك وتأبّت، وإن أنت فطمتها تملكتها فاختر لنفسك.
فإن خشيت من المباحات أن تكون لك عادات، ولم تأمن ” تألّه قلبك وتوقان نفسك إليها ومنازعتها إياك، وكان العبد مبتدئًا غرّاً لا يعرف خبء النفس ودواهيها ولا يفطن لمكرها وآفاتها؛ فإن ترك ذلك أفضل… ليملك بذلك نفسه قبل أن تملكه، ويفطم عادتها قبل أن تهلكه، ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يكونا بالشهوة يغلبانه، كما قال بعض الحكماء: إن لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون أروح لنفسي”[15]
قال بعضهم:
وَمَا النَّفْسُ إلَّا حَيْثُ يَجْعَلُهَا الْفَتَى
فَإِنْ تُوَقِّتْ تَاقَتْ وَإِلَّا تَسَلَّتْ
فالزم ما تحب أن يكون لك عادة، واجعله هجيرك وصاحبك، حتى تملكه ويملكك، قال ابن القيم رحمه الله: ” فمن اعتادَ شيئًا في سرِّه وخلوته ملكه في علانيته وجهره”[16]، وإن أردت ترويح نفسك، فعليك بالنافع من المباحات، والذي يفيدك ولا يضرك، ويعينك ولا يخذلك، والذي لا يكون وقوداً يذكي ما يضرك!، وقد اغرى الجاحظ كثيرا بملازمة الكتاب في كل حين ثم قال: ” ولو لم يكن في ذلك إلّا أنّه يشغلك عن سُخف المنى، وعن اعتياد الراحة، وعن اللعب، وكلّ ما أشبه اللعب”، فاستأنس بالنافع، وروض نفسك عليك، ولا تمدن عينيك وقلبك إلى متع الدنيا وزهرتها فتهلك. والله اعلم
[1] «لباب الآداب لأسامة بن منقذ» (1/ 326).
[2] «فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب» (6/ 370).
[3] ميزان العمل للغزالي (252).
[4] عدة الصابرين لابن القيم ص 21.
[5] «أدب الدنيا والدين» (ص272).
[6] «الرسائل للجاحظ» (1/ 112)
[7] ميزان العمل، الغزالي 56.
[8] المرجع السابق (252).
[9] «تفسير العثيمين – الأحزاب» (ص392).
[10] ميزان العمل للغزالي (252).
[11] «الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه» (ص71).
[12] المصدر السابق.
[13] «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (4/ 493)
[14] ميزان العمل للغزالي (252).
[15] «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» (2/ 291).
[16] «مدارج السالكين – » (3/ 106).