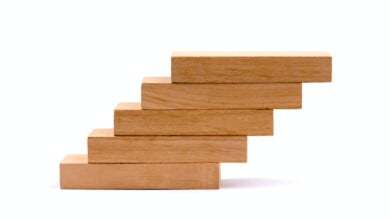- ديفيد جرايبير
- ترجمة: سهام محمد
- تحرير: لطيفة الخريف
في عام ١٩٣٠ توقع جون ماينارد كينز أننا لن نبلغ نهاية القرن إلا وقد قفزت التقنية قفزة هائلة تسمح لدول مثل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة بتحقيق ١٥ ساعة عمل أسبوعيًا، ومع كل التطور الذي شهدناه بدا للجميع أنه كان محقًا، وأننا سننعم بذلك، إلا أن ما توقعه لم يحدث، وبدلًا عنه سُخرت التقنية لجعلنا نعمل أوقاتًا أطول، وفي سبيلها أُنشئت وظائف بلا قيمة جوهرية.
لهذا بتنا نرى جموعًا غفيرة من الناس -في أوروبا وأمريكا الشمالية خاصة- يفنون حياتهم في وظائف لا يرون في داخلهم جدوى من إنجازها. وينجم عن ما يعيشونه أضرار روحية ومعنوية لا يتطرق لها العالم أبدًا.
والسؤال المطروح هو: لماذا لم ننعم باليوتوبيا التي تحدث عنها كينز؟ والتي انتُظرت بلهفة في الستينيات.
إن مربط الفرس اليوم هو عدم استيعاب الزيادة الهائلة في النزعة الاستهلاكية، فقد اخترنا الغرق في المتع والملذات حين كنا مخيرين بين العمل لساعات أقل أو طلب مزيد من الترفيه. وكأننا نعيش مسرحية أخلاقية لطيفة، إلا إن وقعها حتى الآن لا يُصدق.
نعم، لقد شهدنا خلق مجموعة من الوظائف والصناعات التي لا تحصى منذ العشرينيات، ولكن أغلبها لا علاقة له بالإنتاجية أو توزيع السوشي والآيفونات أو حتى الأحذية الرياضية.
إذن، ماهي هذه الوظائف بالضبط؟
تطرقت إحدى التقارير الحديثة في الولايات المتحدة إلى المقارنة بين الوظائف في عام ١٩١٠ وعام ٢٠٠٠، وألهمتنا تصورًا واضحًا عن الأمر (نفس الأمر تكرر في المملكة المتحدة كما لاحظت)، ففي القرن الماضي انخفض بقوة عدد العاملين في مهن مثل خدمة المنازل، والقطاع الزراعي، والصناعة، وتزامن هذا الانخفاض الحاد مع تضاعف كبير في شغل الوظائف الفنية، والإدارية، والمكتبية، والمبيعات، والخدمات إلى ثلاثة أضعاف “أي قفز من ربع إلى ثلاثة أرباع مجموع العمالة”.
وبعبارة أخرى، أقصيت أغلب الأعمال المنتجة بعيدًا (حتى لو أحصينا عمال الصناعات العالمية، بما فيهم من الجماهير الكادحة في الصين والهند، فهم تقريبًا لا يشكلون نسبة كبيرة من عدد سكان العالم كما كانوا).
وبدل تخفيض ساعات العمل لينعم الناس بأوقات إضافية لمتابعة مشاريعهم الخاصة، وعيش أفراحهم، وتحقيق رؤاهم، وأفكارهم، شهدنا نموًا واسعًا للقطاع الإداري، لم نشهده حتى في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء صناعات جديدة تمامًا مثل خدمات التمويل، والتسويق الهاتفي، أو التوسع الهائل للقطاعات مثل قانون الشركات، والإدارة الصحية والأكاديمية، والموارد البشرية، والعلاقات العامة.
ولا تنطبق هذه الأرقام على جميع من يشغلون مهمة توفير الدعم الإداري أو التقني أو الأمني لهذه الصناعات، ولا حتى الصناعات المساعدة (كخدمة تنظيف الكلاب وخدمة توصيل البيتزا ليلًا) والتي لم تكن لتوجد لولا انخراط الآخرين في الأعمال الأخرى.
هذا ما أسميه بـ “الوظائف التافهة“. كما لو أن هناك من يختلق وظائف بلا قيمة، ليبقينا في عمل مستمر، وهنا بالضبط يكمن الغموض، حيث يفترض أن لا يحدث هذا تحت ظل النظام الرأسمالي تحديدًا. فتقديس العمل واعتباره حقًا واجبًا كان من سمات الأنظمة الاشتراكية التي تنقصها الكفاءة مثل الاتحاد السوفيتي الذي خلق العديد من الوظائف مضطرًا(وهذا ماجعل شراء قطعة لحم من متاجرهم يتطلب المرور على ثلاثة كتبة).
ولكن يجب التعامل مع هذا النوع من مشاكل التنافس في السوق وحلها وفقًا للنظرية الاقتصادية على الأقل، فلا شك أن آخر ما تريده الشركات التي تسعى للربح هو تسديد رواتب العمال الذين لا تحتاجهم فعلًا، والغريب أنها مازالت تسدد!
ومع أن الشركات تسعى جاهدة لتخفيض نفقاتها، فإن التسريحات المستمرة للعمال لا تمس إلا الموظفين المؤثرين الذين يتحركون ويبذلون جهدًا حقيقيًا لإصلاح الأشياء، ولا يوجد إطار واضح يستوعب أسباب فصلهم حتى. وفي نفس الوقت نرى ارتفاع أجور أصحاب الوظائف المكتبية الهامشية، الذين لا يعملون ٤٠ أو ٥٠ ساعة على الورق كما حدث مع موظفي الاتحاد السوفيتي، بل يمضون ١٥ ساعة فقط كما توقع كينز، ويقضون بقية أوقاتهم في تنظيم أو حضور ندوات تحفيزية، أو تحديث صفحاتهم على الفيسبوك، أو يحملون شيئًا من tv box.
ومن الواضح جدًا أن المشكلة ليست اقتصادية، بل هي أخلاقية وسياسية في المقام الأول، فقد تنبهت الطبقة المسيطرة إلى أن الشعب المُنتج السعيد، حين يحظى بفراغ كبير يصبح أشبه بقنبلة موقوتة (نسترجع ما كاد يحدث في الستينيات). ومن جهة أخرى، فإنه يناسبهم جدًا ترميز العمل المكثف وكأنه قيمة أخلاقية بذاته، وثم التحقير من كل من يرفض قضاء يومه غارقًا فيه.
وبعد تأملي في التضخم الكبير للمسؤوليات الإدارية في الأقسام الأكاديمية البريطانية، اتضحت لي رؤية مرعبة عن واقع أشبه بالجحيم، ذلك الجحيم الذي يعيشه مجموعة من الأفراد في وظائف لا يحبونها ولا يتقنونها. كما لو أننا أمام مجموعة اختيرت بسبب مهارة أفرادها في النجارة، ثم اكتشفوا أنهم سيقضون جل وقتهم في مهمة قلي السمك، وبعيدًا عما إذا كانت مهمة تستحق الإنجاز أم لا، فعدد الأسماك محدود كذلك، وهكذا يجدون أنفسهم في قمة الاستياء من فكرة أن يقضي زملائهم وقتًا أكثر في النجارة ولا يشاطرونهم مسؤولية القلي بالتساوي. ومع مرور الوقت تتضاعف أكوام الأسماك التي لم تطهى جيدًا وتغطي كل مكان في ورشة العمل. وهذا ما يفعله كل فرد منهم حقًا.
أظن أنه وصف دقيق لدينامية الأخلاق في نظامنا الاقتصادي.
أدرك طبعًا أني سأقابل باعتراضات سريعة مثل: من أنت لتحدد الوظائف المهمة من غيرها؟ وما هو المهم أصلًا؟ لست إلا أستاذ أنثروبولوجيا، لم قد نحتاج وظيفتك؟ (ومن المتوقع أن تُرى وظيفتي عند قراء الصحف الشعبية كتعريف لهدر النفقات الاجتماعية) وعلى جانب واحد فإن هذا صحيح تمامًا، وليس هناك أي معيار موضوعي للقيمة الاجتماعية.
لن أستبق القول وأخبر أحدهم أن وظيفته بلا مغزى بينما هو يرى أهميتها، لكن ماذا عن هؤلاء الذين يؤمنون فعلًا أن لا قيمة لوظائفهم؟ منذ مدة تواصلت مجددًا مع صديق قديم لم أره مذ ١٢ سنة، وقد أذهلني أنه أصبح شاعرًا، وثم الرجل الأساسي في فرقة إيندي الموسيقية. وقد سمعت أغانيه في الراديو سابقًا ولم يخطر ببالي أنه صوت مألوف.
لقد بدا لي عبقريًا، ومبتكرًا وكان لعمله دور في تحسين وتلطيف حياة الكثير من الناس حول العالم.
ولكن، بعد عدة ألبومات فاشلة أُلغي عقده، ووجد نفسه غارقًا في الديون، وأمام طفلته الرضيعة التي تحتاج إلى نفقات. ثم انتهى به الحال على حد تعبيره “سالكًا الطريق المعروف الذي يعبره كل تائه: كلية الحقوق”. وهو الآن محام بارز يعمل في شركة معروفة في نيويورك، وكان من أول المقرين بأن وظيفته بلا قيمة، ولم تفد العالم بشيء، ويرى أنه ينبغي أن لا توجد.
نقف هنا أمام عدة تساؤلات قد تخطر ببال المرء، ومنها: مالذي يجعل المجتمع مقبلًا على المختصين في قانون الشركات، ولا يجعله مهتمًا بالشعراء والموسيقيين؟ (الإجابة: إذا سيطر ١% من السكان على الثروة، فإن السوق يعكس ما يرونه مهمًا ومفيدًا، وحدهم دون الجميع) وفي النهاية فإن هذا لا يخفى على أغلب الموظفين. وفي الحقيقة لا أظنني قابلت محاميًا للشركات إلا وجدته يحقر من وظيفته ويعتبرها بلا قيمة. ونفس الأمر ينطبق على من يشغلون الصناعات الجديدة المذكورة أعلاه. هناك فئة كبيرة ممن يتقاضون رواتب على الوظائف المهنية، ومع ذلك يتحاشون الحديث عن أعمالهم إذا صادفتهم في حفلة وفتحت حوارًا عن عملك الذي تراه مهمًا (الأنثروبولوجيا على سبيل المثال)، وبمجرد أن تقدم لهم مشروبًا ستجدهم يسهبون في ازدراء وظائفهم والتقليل من جدواها.
وهذا يشكل ضغطًا نفسيًا عميقًا عليهم، فكيف لشخص أن يتحدث عن مكانة وظيفته إن كان يرى في قرارة نفسه عدم جدواها؟ كيف له أن يتجاوز مشاعر الغضب والاستياء؟
ومع هذا، فإن الطبقة المسيطرة قد حددت لمجتمعنا طرقًا عبقرية لتفادي الأمر، تمامًا على غرار قصة قلي الأسماك، ولضمان توجيه الغضب إلى العاملين الذين يشغلون وظائف ذات مغزى. ويبدو أن هناك قاعدة عامة تقول إنه كلما كان عمل الشخص مفيدًا بوضوح للناس، قل أجره. ومجددًا أقول إنه قد يكون من الصعب العثور على معيار موضوعي يحدد الأمر، ولكن هناك طريقة سهلة لنمسك بطرف الخيط، وهي أن نسأل: ما الذي سيحدث لو اختفت هذه الفئة بأكملها؟ قل ما تريد عن الممرضات، وعمال النظافة، والميكانيكيين، فلا شك أن اختفائهم سيُحدث كارثة مباشرة. إن عالمًا بلا معلمين، أو عمال الموانئ سيكون في مأزق كبير، وحتى كاتب الخيال العلمي أو موسيقي السكا يضيفون معنى للعالم وسيكون ناقصًا دونهم. ولكن ليس واضحًا كيف ستعاني البشرية لو تلاشى مدراء التنفيذ في أسواق الأسهم الخاصة، وجماعات الضغط (اللوبي)، والباحثين في العلاقات العامة، والاكتواريين(المختصين بحسابات التأمين وتقديراتها)، أو المسوقين الهاتفيين والمستشاريين القانونيين. (بل هناك من يشك أن العالم سيتحسن دونهم).
وبغض النظر عن الاستناءات القليلة (الأطباء) ، فإن القاعدة ثابتة.
ومما يزيد الطين بلة، أن هناك إجماعًا واسعًا على هذه الطريقة واعتبارها أفضل الطرق لسير الأمور وهذه إحدى نقاط القوة التي يعتمدها اليمين الشعبوي، مثل الاستياء الذي ظهر في صفحات الصحف الشعبية ضد عمال الأنابيب واتهامهم بشل الحركة في لندن خلال نزاعات العقود، وطبعًا فإن حقيقة قدرتهم على شل لندن هو خير دليل على أهمية عملهم، ولكن يبدو أن هذا هو ما يزعج الناس فيهم. بل كان ذلك أوضح في الولايات المتحدة حين نجح الجمهوريين في حشد مشاعر التحريض والاستياء ضد المعلمين، أو عمال السيارات بسبب معاشاتهم ومستحقاتهم المتضخمة (ولم يفعلوا الأمر ذاته مع مدراء المدارس، أو مدراء صناعة السيارات الذين يسببون المشاكل فعلًا).
وكأنهم يقولون لهم “لقد نلتم مهنة تعليم الأطفال! أو صناعة السيارات! وفوق هذا تتوقعون بكل صفاقة وجه أن تحظوا بالمعاشات التقاعدية للطبقة المتوسطة والرعاية الصحية!”
ومع نظام يجعل الأولوية للحفاظ على قوة رأس المال، فإنه من الصعب جدًا أن نرى وظائف أفضل. بل إن الموظف المُنتج يواجه كثير من العقبات والاستغلال الدائم. والبقية يُقسمون بين طبقة العاطلين عن العمل والمشبوهين عالميًا وطبقة أكبر ممن يتقاضون أجرًا على أعمال هامشية، وهي نفس الفئة التي صممت مناصبها لتتماهى مع وجهات نظر وحساسية الطبقة المسيطرة (المدراء، الإداريين.. إلخ) ولا سيما في تصوراتها المالية. وفي الوقت ذاته تعزز من السخط العام تجاه شاغلي الوظائف القيمة والهامة اجتماعيًا. باختصار يبدو أن النظام لم يصمم بعناية، لقد مر على وجوده قرن كامل من المحاولات والأخطاء. وعمومًا يبدو أن هذا هو التفسير الوحيد الذي يشرح لنا سبب عملنا لساعات طويلة رغم التطور التقني.