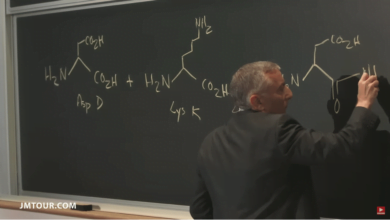في فترةٍ من العمرِ المنصرم كنتُ مولعًا بقراءةِ الرَّسائلِ التي يتبادلها الكتَّاب، والأدباء، ومن برَّحَ بهمُ العشق.. كنتُ أشعرُ أنها تتحدثُ عني، تتحدثُ باسمي، لولا أنَّ ختامها ممهورٌ باسمِ صاحبها. لا يستطيعُ الزَّمنُ أن يوقفَ تدفقها عندَ المتلقي فحسب؛ وإنما تخرجُ كالنُّور مبددة حُجُز الزَّمان، تتلقفها الأنظار، وتشعر بمدىٰ الحنين الذي يدثرها، والصِّدق الذي يتدلى من كلِّ حرفٍ وكلمةٍ في بنيتها.
لعلكَ تتساءل، وأنتَ محقٌّ في ذلك:
لماذا خَفَتَ هذا النَّوع من التَّأليف؟! وإذا أطلَّ علينا كاتبٌ برسائله؛ وجدتها منزوعةَ الحنين، خالية من تباريحِ الشَّوق، فاقدة للروحِ التي تراها في كتبِ الرَّاحلين؟! والسببُ فيما أرى؛ ليسَ ضعفًا في الكاتبِ المعاصر، وإنما الرؤية المتكررة للآخَر، فإنَّ العينَ إذا ألِفتَ النَّظر؛ فقَدَ القلبُ توهجه، وإذا خمدتْ جمرة القلبِ خرجَ المسطور فاقدًا للحياة!
بإمكانكَ أن تكونَ في طرفِ العالم، لكنَّ الشَّوق لم يعد الشوق الذي كانَ قبلًا.. لقد سحقت الأدوات الحديثة مسمَّى الاغتراب بالمعنىٰ السَّابق، فصديقكَ أو زوجكَ أو والداك؛ الجميع يكونُ معك في أدقِّ تفاصيلِ حياتك، وأنتَ هناك في مكانٍ بعيدٍ عنهم.. ولهذا، إذا فكرتَ أن تكتبَ رسالة لأحدهم؛ طغت عليكَ رؤية الواقع الافتراضي، على قدسيةِ الخيال الذي عاشه غيرنا عندما لم يكن بينهم رؤية ولقاء إلا من خلالِ القلمِ وعلى دكَّةِ رسالة!
تجدُ ذلكَ مثلًا في الرَّسائلِ المتبادلة بينَ “غسَّان كنفاني” و”غادة السَّمَّان”، وبين الأخيرة و”أنسي الحاج”، ورسائل “مي زيادة” إلى “جبران” المجتبىٰ البعيد، ورسائل الرَّافعي إلى “مي” قريبة القلب، وبعيدة المنال! وقريبٌ من ذلكَ وإن بملمحٍ آخر، وبصورةٍ مختلفة؛ الرَّسائل المحترقة التي كانت بينَ عمومِ القرَّاء “المجهولين”، والأستاذ عبد الوهاب مطاوع!
وتجدها بصورةٍ خاضعة، بريئة، في رسائلِ “ولي الدِّين يكن” وأشعاره الموجهة إلى الآنسة “مي” في علاقةٍ تستحقُّ الذِّكر والنَّظر بصفاء. كتبَ إليها: “سيدتي ملكة الإلهام، ما أسكتَ هذا القلم عن مناجاتك إلا حرب الأيام، إنه منذ أيام كثيرة أسيرها الذي لا يُرجى فكاكه، غير أني كنتُ أناجي روحك كلما بدت لعيني أشياء من محاسنِ هذا الوجود”، وهي رسالة تطفحُ بالوجدِ والتَّوق، والخضوع إلى الأديبةِ “مي”، فكانت خاتمة رسالته تحت تأثير العِشق وغضاضته، إذ قال: “والآن عندي قُبلة هي أجمل زهرة في ربيعِ الأمل، أضعها تحتَ قدميك. إن تقبليها تزيدي كرمًا، وإن تردّيها فقصاراي الامتثال. وبعدُ فإني في انتظارِ بشائر رضاكِ وطاعة لكِ وإخلاص”[1]. ولي الدين يكن.
لكنَّ الحقيقة أنَّ “مي” ما أحبت إلا “جبران” البعيد، وكل من كانَ بجانبها، وتوهَّم الحب بينهما، كان حبًّا من طرفٍ يتيم، لأنَّ “مي” حسمت أمرها منذ زمنٍ وتعلقت بجبران، لكنَّ اللطف الذي فُطرت عليه، كان سببًا في إيهامِ لآخرين بأنها تُبدي لهم شيئًا من الحبِّ الذي يبحثونَ عنه.. وفي الحقيقة ما أحبَّت سواه.. وحبهما أعني “جبران ومي”، شيء فريد، بل نادر، لقد دامت تلك العاطفة العارمة بينهما زهاء عشرين عامًا دونَ أن يلتقيا إلا في عالمِ الفِكر والرُّوح والخيال الضبابي، إذ كان جبران في مغارب الأرض مقيمًا، وكانت “مي” في مشارقها، بينهما “سبعة آلاف ميل” كما قال جبران، و “البحار المنبسطة” كما قالت “مي”.. وبيان ذلك في “الشُّعلة الزرقاء” الذي احتفظَ بحكايتهما الخالدة[2]. ورغمًا عن البعدِ الذي كان بينهما، كانا أقرب قريبين، وأشغف حبيبين. وعامل البعد يؤكدُ ما قلته عن فاعليةِ الرِّسالة في الزمنِ المنقضي، وتأثيرها، ودهشتها، وانسحاقها في الزَّمنِ الرقمي الذي لم يَعُدْ للرسائل فيه كثير معنى، لأنَّ الحياة تضجُّ برسائل سائلة لا حياة فيها!
وفي كتاباتِ الأديب “طاهر الطناحي”[3] بيانٌ لأخبارِ من وقعوا في حبِّ “مي” من الأدباءِ والكتَّاب، وكيفَ انتهى بهمُ المطاف إلى قبضِ الرِّيح، وباتت كشيءٍ من الذِّكرى يلوحُ لهم كلما هموا بكتابة رسالة أو نصٍّ عظيم، إذ أضحت رمزًا للإلهام وطاقة شعورية تمنحُ القلم قوة دافقة في تحريرِ الخيباتِ والآلام والأشواق الممتنعة! وبإمكانك أن تكتشفَ هذا الأمر عند قراءة “أوراق الورد” للرَّافعي، إذ يقول في مطلعها: “وما أريدُ من الحبِّ إلا الفن، فإن جاءَ من الهجْر فنٌّ فهو الحب..”[4].
يقول البروفيسور أنوراغ براكاش: “من أعظمِ الآلام والمعاناة وقوع الإنسان في حبِّ شخص ما من جانبٍ واحد”. إنّها ظاهرة “الحب من طرفٍ واحد” التي رافقت الإنسان في مشوارِ حياته عبر العصور، وألهمت كبار الأدباء في العالمِ للتعبير عن أعنفِ التَّجارب، وأرقِّ المشاعر، وأصدق النِّيات، وأطهرِ الميول.
كتبَ عن ذلك الشَّاعر الإنكليزي الشهير وليم شكسبير في “السونيت الـ87″، في قوله: “وداعًا: إنك أغلى من أن أستحوذَ عليك، ويكفيني أنك تعرف قيمتك. فامتيازك بهذه القيمة يعفيك من الالتزام؛ فتنتهي كل دعاوى حقي فيك، كيف أدعي لنفسي حقًّا فيك بلا ضمانة منك، وكيف الطَّريق إلى استحقاق ذلكَ العطاء؟ بذلك أكون اتخذتك كالحلم المخادع، كنتُ في الحلمِ ملكًا، وحينما صحوتُ لم أجد أثرًا”[5]. وتناوله جون كلير في قصيدة “السِّر”، وعانى من ويلاته كتَّاب وشعراء في كلِّ أنحاءِ الدنيا، فخلفوا لنا آثارًا أدبية نادرة تنبضُ بالعواطفِ الرقيقة، والمعاني العميقة، والكلمات الصَّادقة، على حدِّ تعبير الكاتب مولود بن زادي.
لقد أسهمت أدواتُ التَّواصل الاجتماعي في الحدِّ من هذا الضَّربِ من ضروبِ الأدبِ بشكلٍ كبير.. لقد استطاعت أن تجعلَ البعيد بينَ يديك، لم تعد بحاجةٍ إلى النَّظر في النجومِ تسترقُ منظرًا يعيدُ لك شيئًا من الذِّكرى، لن تسعى في تذكر ملامحِ وجه من تحب، ونبش الذَّاكرة عن تفاصيل دقيقة لا يعرفها سواك، ولحظات الحنين التي كانت في لحظةٍ غابرة، كل ذلك باتَ مشاهَدًا؛ فلم تعد الحاجة ملحة لأن يفترَّ الكاتبُ ورقة يسكبُ فيها متاهاتِ السِّنين والأيام، وآلام الغربة، وأوجاعَ الرحيل!
وبإمكانكَ أن تجدها في كتاباتٍ عديدة، سطَّرت الشَّوق والحنين، ولوعة الاغتراب، في سطورٍ تحملُ صورة مرسومة، تفيضُ بالحياة، أرادَ كاتبها أن تصلَ إلى من يشتاقُ ويحبُّ ويهوى! وبإمكانكَ أن تقفَ على شيءٍ من ذلكَ في الرسائل بينَ “درويش والقاسم”، ورسالة والد إلى ولده، وكذا رسائل “تشيخوف الشهيرة إلى عائلته”، والرسائل التي حملت عنوان “ورد ورماد” بين محمد برادة ومحمد شكري صاحب الخبز الحافي![6].
وواحدة من أجمل المراسلات كانت بين الأديب الروسي الشهير “مكسيم جوركي”، وبين “أنطون تشيخوف”، الذي استقبل رسائل جوركي بكلِّ اهتمامٍ وصدق، ثم امتدَّ بينهما الزمن ليكونا صديقين، يثقُ أحدهما بالآخر، ولهذا، نجد أنَّ “جوركي” كتبَ في مراسلاته التي كان يفشي فيها شيئًا من أسرارِ حياته، إذ يقول: “وما تحدثت عن هذه النَّفس إلا لمخلوق أضمر له الحب، إني أطلق على هذا النوع من الحديث اسم «غسل الرُّوح بدموعِ الصمت» ، ذلك لأنَّ الكلام ضربٌ من العبث، فالمرء يتكلم كي لا يقول شيئًا، ولن يتفوه المرء بما تبكي منه الروح”[7]. قراءة هذه المكاتبات تعرفنا على الفنان أي الإنسان، الإنسان في حالات قوته وضعفه ونضاله ويأسه، وإيمانه وقلقه. وبتعبير جوركي: “ما نحن في الحقيقة إلا غير كائنات جديرة بالشفقة”.
ويجدر ألَّا أنسى في هذا المقام، ما يقومُ به الأديب محمد بركات[8]، من إحياءٍ لهذا الفن، بفضلِ كتاباته المتتابعة في هذا الحقْلِ العزيز.. فقد كتبَ كتابًا بعنوان: “ما لم يقله الرَّافعي في رسائلِ الأحزان”، وحُقَّ له ذلك؛ لأنه سليل هذه المدرسة، وامتداد لها، ثم شرعَ في كتابةِ رسائله إلى الأدباء، بلغةٍ أدبيةٍ عالية، يستثير فيهم مكامنَ الجمال، إمعانًا منه في اتساعِ رقعةِ الإبداع، وعرفانًا لفنِّ الرَّسائل الذي كان أسلوبًا أثيرًا عند أساطينِ الأدب والفكر في القديمِ والحديث. لكن يبدو أنه يعيش احتضارًا بفعلِ أدواتِ التَّواصل التي لم تعد تعرفُ للرسائلِ المتبادلة معنى، لأنَّ الشيء إذا تحول إلى أمرٍ مشاع، يتوهم استطاعته كلّ أحد؛ يفقدُ بريقه، وتنكشفُ عنه حجُبُ الدَّهشة التي كانت تلفُّ الرسائل المختبئة في أوراقِ الحبِّ النبيل في زمنٍ منصرم!
الذي يظهر أنَّ أدبَ الرسائل يتجه إلى تكرار سيناريو فنّ المقامة، الذي تخلى عن مكانه لفنون إبداعية أخرى مثل المسرح والشعر، لكن تخلي أدب الرسائل، لن يكون لمصلحة فنٍّ إبداعيٍّ جديد، بقدر ما سيكون لأجهزة ذكية وشاشات مضيئة، “تجمد الإحساس وتقتل الإبداع” بحسب تعبير محمد طيفوري.
إنَّ مجرد الانحناء على ورقةٍ بيضاء لكتابة “رسالة” إلى أحدهم، باتَ مشهدًا محذوفًا في مسرحِ حيواتنا المتسارعة.. لم تعد تلكَ الصورة قائمة، من يحملُ القلمَ ويكتبُ على الورقِ في دجى الليل، ثم يجيلُ فيها النَّظر مرارًا، قبل الختم باسمه، لتصل زاهية إلى القلبِ المنتظِر!
إنها عمل مرهقٌ كسائرِ الأعمال البنَّاءة إلا إنه عملٌ لذَّته لا تفوقها لذَّة كما يقول ميخائيل نعيمة “في مهبِّ الريح”[9]. وهي لذة قلما يتذوقها الكسالى وفاتروا الهمة، فإن شئتم بلوغ القمم الأدبية حيث “الخالدون “؛ فعليكم ألَّا تشركوا في محبتكم للقلمِ محبة أي سلطانٍ سواه، وأن تنبذوا كثيرًا من ملذَّات العالمِ وأمجاده. وأنتم متى أدركتم أي مجد هو مجد القلم هانت لديكم من أجله كل أمجاد الأرض!
في الختام، أستطيعُ القول: إنَّ كتابة الرَّسائلِ من أرقِّ صنوفِ الأدب وأجملها وأعذبها، وفيها متعةٌ لا تضاهى، وفي تفاصيلها كثيرٌ من الحنين، والبوح، وملامحِ الحزن، وعلى أسوارها تطفحُ دلائلُ الود والحب، وغليل الشوق، ولهفة اللقاء!
[1] مجلة الهلال , العدد 12, ديسمبر 1947م .
[2] ينظر كتاب “الشعلة الزرقاء رسائل جبران خليل إلى مي زيادة”, تحقيق سلمى الحفار, د. سهيل بشروني , مؤسسة نوفل, بيروت, 1984م .
[3] مثل كتاب: “أطياف من حياة مي, طاهر الطناحي”.
[4] أوراق الورد رسائلها ورسائله, مصطفى صادق الرافعي, ط10, 1982, ص5 .
[5] ينظر: سونيتات شكسبير الكاملة, ترجمة الشاعر: بدر توفيق, ط1: أخبار اليوم, إدارة الكتب والمكتبات, 1988م, ص111 .
[6] ومن تراث الرسائل: ما تركه شيخ العربية الجاحظ في “رسائل الجاحظ”، و”رسائل ابن المقفع”، و”رسالة الغفران”، و”رسائل ابن زيدون” وفي العصر الحديث: “الرسائل بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي”.
[7] ينظر: جوركي و تشيخوف مراسلات, ترجمة: جلال فاروق الشريف, دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر, دمشق.
[8] أديبٌ وشاعرٌ مصري, باحثٌ بتحقيقِ التراث بمشيخةِ الأزهر الشَّريف.
[9] ينظر: في مهب الريح, ميخائيل نعيمة, مؤسسة نوفل, بيروت, ص176 .