- مشاري الإبراهيم
- تحرير: ريم الطيار
يتسرّبُ صنفٌ مزعجٌ من الأسئلةٌ إلى أذهاننا كل صباح، ويتغلغل حتّى يمسك بتلابيب فكرنا:
- ها قد اقترب عيد ميلادي، فماذا حقّقت في هذه الحياة؟
- ما إنجازاتي التي يمكنني مشاركتها مع الآخرين؟
- كيف استطاع زميلي الأقل مني أن يكون أكثر حظوة أو شهرةً مني؟
- ما رأي الآخرين فيني، وكيف أتصرّف أمامهم لأكون ذا حُظوة عندهم؟
آلان دي بوتون يرى حياة كل شخص بالغ تحكمها قصتي حب كبيرتين؛ الأولى قصّة الحب العاطفي، ويتغنّى بها الإنسان، ويستلهم منها الشّعر والروايات، وهو حبٌّ مُحتَفىً به اجتماعيا.
أما القصة الثّانية فهي سعينا لبلوغ حب الناس، هذا الحب حكايةٌ مخجلة نتحرّج من الاعتراف بها.
إلا أنَّ هذا السّعي فطري، فقد أنعم الله على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-برفع شأنه: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)، وعاقب المستهزئين بقطع سمعتهم في قوله: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ)، بل يتعدى ذلك حينما قال الله -جل وعلا-لإبراهيم -عليه السلام-: (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا)، فأجاب إبراهيم يطلبُ تلك المكانة لأبنائه: (قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي)؟
لكن، إن كان سعينا لبلوغ حبّ النّاس مورّثًا للقلق، فما الذي يجبرنا على قبول أن نكون أسرى لآراء الآخرين؟
إن كنّا سنتجاوز التفسير القائل بأنَّ السّعي فطريًا، فقد قدّم بعض الدّارسين تفاسير أخرى، اخترتُ لكم منها أربعة:
1- فقدان المعيار
هل يستطيع المرء قول: ‹‹أنا خفيف دم، وذكي وذو قيمة اجتماعية عالية›› بناءً على تقييمه لشخصه؟ أم لابد أن يستعين بتقييم الناس له؟ من الصعب جدًّا تكوين صورة صحيحة عن ذواتنا كتحديد مثلاً مستوى ذكائنا، أو إنجازاتنا، أو قدراتنا، أو حتّى خفّة دمنا بشكل مستقل عن الآخرين، ولذلك نستخدم حظوتنا عندهم كمؤشّرًا محدّدًا لقيمتنا الذّاتية.
بل يصف آلان دي بوتون تقييمنا لذاتنا بالبالون الذي دومًا يحتاج إلى هيليوم القَبُول الخارجي ليرتفع، وأي إهمال أو تجاهل من الآخرين يصبح كالشوكة التي تفجر ذلك التصوّر الهش عن ذواتنا.
2- مجموعة الأقران
مجموعة الأقران هم أصدقاء العمل أو زملاء الدراسة أو الأقرباء وغيرهم ممن نقضي معهم وقتًا طويلاً، وحال ما نرى لهم نجاحًا لفتوا به أنظار الآخرين، يتولّد في نفوسنا قلقًا منبعه: ‹‹كان بإمكاني تحقيق ذات الشّيء، ولأني لم أستطع، فأنا فاشل››.
يكاد يعجز الإنسان عن تحديد سقف تطلّعاته بشكل مستقل عن أقرانه، فيلجأ إلى استقراء أوضاعهم ليقوم بعدها بتحديد الحد الأدنى لمستوى السّمعة المقبولة وما يعرِّفه “الأقران” بأنه نجاح، فإن كان امتلاك مرسيدس موديل 2020 يعد رقيًا أو نجاحًا ماليًا عند مجموعتي المعيارية فإن مرسيدس موديل 2020 تُطرح عليّ كإحدى لوازم النجاح، وإن كانت سيّارة من نوع الشاص هي السّائدة عند مجموعة الأقران فيصبح الشّاص حينها مظهر النجاح المطلوب تحقيقه.
وتقوم مواقع التواصل بغشّنا إذ تبثُّ ما يعتبره الأقران نجاحًا، بالإضافة إلى أنّها تقوم بإبراز مظاهر نجاح الآخرين بغض النظر عن نجاحِهم، فولّد ذلك ضغطًا إضافيًّا لتحقيق المزيد من الإنجازات.
3- الأثر المادّي
قد يجادل بعضهم بأن تكوين انطباعًا إيجابيًا لدى الآخرين يؤدي إلى وصولنا إلى مساحة كبيرة من الفرص سواءً كانت مهنية أو تجارية أو زوجية، ومن الطبيعي أن يولّد ذلك ضغطًا علينا يتمثل في قلقنا للسعي نحو المكانة.
وبات العالم يكافئ من يملك مظاهر النجاح كالمال أو الشّهرة بدلا من الإنجاز ذاته. يقول فرانسوا السادس دو لاروشفوكو: ‹‹إن كنت تقوم بعملٍ مهمّ فواجبٌ عليك إخفاء فشلك وتضخيم نجاحك؛ لأنّ مستقبلك يعتمد على آراء الآخرين أكثر من الحقيقة››، فبالإضافة إلى ضغوط تحقيق المنجزات، صار الإنسان تحت ضغط تسويق منجزاته.
4- متلازمة الحرباء
لعل معضلة قلق السعي نحو المكانة تكمن في وجود تناقض بين قِيَم المرء ومتطلّبات نيل رضا الجموع، إذ يرى الإنسان بوضوح الفائدة المكتسبة من المكانة الاجتماعية، لكنّه أحيانًا لا يستطيع استشعار فائدة المحافظة على قيمه، فيعيش بين مطرقة فقدان هويّته، وسندان عدم تقدير الآخرين له. بل عندما نصل إلى شاطئ القَبول، نكتشف أنَّ النّاس قد ارتحلوا إلى شاطئٍ آخر علينا الإبحار نحوه؛ لأن متطلّبات قبول الآخرين في تغيّر مستمر، فنمسي كالحرباء، في حالة تلوّن مستمرّة.
الحلول:
قد نتصوّر أنَّ مصيرنا البقاء أسرى دون أن نرى نهايةً لهذه الرّحلة المضنية، وسيكون السلام الداخلي رابع المستحيلات بعد الغول والعنقاء والخل الوفي، ولكن من يعتقنا من هذه السلاسل؟
1- ضبط معادلة روسو
الشعور بالغنى الذّاتي والرّضا الدّاخلي يخلق خط دفاع صلب أمام قلق السعي نحو المكانة الاجتماعية. ‹‹هناك طريقتان تجعلان الإنسان غنيًّا..›› كما يقول جان جاك روسو: ‹‹..إمّا أن يحقق المزيد من رغباته، أو أن يقلل رغباته. فكلّما يرنو الإنسان نحو ما لا يملك يزدد فقرًا – مهما كانت ممتلكاته-. وكلّما زاد رضاه بما يملك، يزدد غنىً – مهما قلّت ممتلكاته-››.
فلنتأمّل في معادلة روسو على النحو التّالي:

لنتخيّل أنّ أحدنا لديه قائمة طويلة من الأهداف كتحقيق ثروة طائلة، أو جسدًا رياضيًا مثاليًا، أو شهرةً، أو منصبًا، وإلى آخره من قوائمنا التي لا تنتهي. وبالنّظر إلى معادلة روسو، هل سيملك هذا الفرد أملاً في تحقيق الرضا المنشود؟ لو بدأنا في تقليص تلك القائمة الطويلة المشتّتة إلى مجموعة محددة من الرّغبات، تزداد احتمالية تحقيقنا لأهدفنا والحصول على الغنى المنشود، لكن لماذا من الأساس ينتهي بنا الحال إلى قائمة طويلة جدًّا من الأماني؟
بعضنا يقضي عمره ينظر إلى ما عند الآخرين ثم يضيفها إلى “عربة تسوّقه” دون أن يتوقّف ويسأل نفسه: هل فعلاً أريد هذه الأمور؟ وبعضنا قد يحيلنا إلى الفطرة كمبرر لهذا التصرف، وآخرون قد يقولون إنّها من نتائج الاقتصاد الرّأسمالي أو الفكر الفرداني، وأيًّا يكن السبب، ربّما يكمن الحل في التوقّف، وتأمّل اللحظات التي تتخلّق فيها قائمة الرّغبات هذه، ومن ثم إدارة هذه القائمة بوعي وحذر شديدين قبل أن تودي بنا إلى الهلاك.
2- أبقِ على المقارنة، ولكن راجع العيّنة
يقول شوبنهاور: ‹‹لو صفّقت الجماهير لأداء الموسيقار، فهل سيشعر بنشوة لو علم أنّهم صمٌّ لا يستطيعون السّمع››؟ إن كنّا سنرضى بالعيش في قلق ونضع وزنًا لقبول الآخرين لنا، أليس من باب أولى أن نقيّم الأشخاص قبل أن نضع وزنًا لرأيهم فينا؟
قد تكون الخطوة الأولى للتخفيف من وطأة الشعور بالقلق، هو النظر بعين فاحصة تجاه تلك الجموع التي نسعى خلف رضاهم ونسمح لهم بتقيمينا. إن من الحكمة أن نسأل: أليسوا بشرًا أيضـًا؟ ألم يخطئوا من قبل؟ ألا يتقلّب بعضهم في مستنقع الجهل أو الخطيئة؟
الخطوة الثّانية تكون بتقسيم مجموعة الأقران إلى فئات: فهناك مثلاً المهرّجون والمفكّرون، وهناك المشاهير والمغمورون، وهناك الاقتصاديّون والواعظون، ومن ثم تحديد الفئة التي نريد أن نسعى للحصول على قَبولهم. ربّما علينا الاهتمام بآراء أولئك الذين يصطبغون بالخلق، أو الدين، أو السماحة، أو التواضع، أو غيرها من الفضائل التي فعلاً نراها مهمّة، فنتنافس معهم على ما يستحق المنافسة. يقول الله تعالى: ‹‹وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا››.
ربّما نكتشف أنّنا نتسابق مع مجموعة أقران ونحن غير مدركين أنّنا نتّبعهم إلى الهاوية.
3- معيار من نوع آخر
وبما أننا في صدد تقليص المعايير، لمَ لا يكون الحل في تجاوزها والبحث في مكان آخر. ربّما نجد حبًّا تتضاءل أمامه عواطف البشر، ربّما نجد حبًّا يكسر دائرة هذا القلق، بل يحفّزنا للمحافظة على ذواتنا وعتقها من سلاسل رأي الآخرين فينا.
ويصعب علينا تعزيز المنظور الأصيل دون تناول الحديث النبوي: ‹‹من التمس رضى الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس››.
ويقول الدكتور محمد راتب النابلسي: ‹‹محبة الله عز وجل للمؤمن تعني حِفظه، وتأييده، ونصره وإكرامه، وإنزال الرحمة على قلبه، وإنزال السكينة، وإغناءَه بكل ما يحتاج، هذا هو الحب الإلهي، والإنسان إذا أحب الله مالَ إليه، وخَلَدَ إلى ظِلِهِ وإلى أنوارهِ وإلى تجليّاتهِ وإلى سكينته، وإلى الشعور بأن الله يحميه ويحفظه››.
وهذه النّزعة – أي نزعة ترك اللهث خلف قبول الناس-تجد أنَّ هناك موقفًا قرآنيًا ثابتًا في قصصه تجاهه: القبول ليس هدفًا أو معيارًا للنجاح، بل قبول الله لك هو كل شيء. فتقرأ آية التّالي: {وكان عند ربه مرضيا} أو {وكان عند الله وجيهاً} ونجد في ذلك سلوانًا من شأنه أن يطفئ حرّ القلق. المهم العلاقة مع الله جل وعلا.
ولا تأتي محبّة الله إلا بمعرفته، ومعرفته لا تأتي من خلال الذهاب إلى ويكيبيديا وقراءة أسماء وصفاته. إنما المعرفة تأتي نتيجة لسير حثيث مستمر نحوه سبحانه، والمداومة على ذكره، والتفكّر في أسمائه وصفاته وأنّه العادل الودود، والالتزام بالأعمال المورّثة لحبّه ونصره من صلاة وصدقة هو مفتاح الانعتاق من الآخرين ومن هذا القلق المزعج.
4- فتّت القلق إلى شذرات
ما يمكننا فعله حيال هذا القلق هو التفريق بين نوعين من آثار المكانة الاجتماعية: (أ) الأثر المعنوي، و(ب) الأثر المادّي.
- الأثر المعنوي: لو افترضنا أن الصيت والشهرة والمكانة الاجتماعية المرتفعة تؤثّر علينا ماديًا، فإن ذلك لا يعني أنّ تلك المكانة لها أي أثر على إنسانيّتنا، أو على غنانا الرّوحي الذي نحمله في صدورنا.
- الأثر المادّي: مهما اعتمد الفرد على شهرته ليفوز بالفرص المهنية أو التجارية، فإن أثر الشّهرة سيتوقّف حالما يبدأ العمل الحقيقي، ومن يجيد عمله ويكتسب المهارات الممكّنة للإنجاز ستأتي له الفرص تباعًا ولو بعد حين ولو لم يكن مشهورًا.
5- الموت فَرَج
في رواية قصيرة للأديب الروسي ليو تولستوي اسمها (موت إيفان إيليتش) يتحدّث فيها تولستوي عن محورية فكرة الموت في محاربة هذ القلق، وللوهلة الأولى تبدو هذه الدعوى غريبة، ولكن فكرة الموت تستصحب معها قدرةً هائلة على إعادة تقييم الحياة. تودي حالة إيفان الصحيّة به إلى فراش الموت، فأخذ حينها يتساءل: مَن مِن أقرانه -الذين طالما كان قلقًا بشأن نظرتهم تجاهه-سيزورونه وهو على فراش الموت، بل كم من هؤلاء العشرات والمئات سيزورون قبره؟ بل كم منهم يستطيع أن يدفع عن نفسه ذات المصير (الموت). وحينها اهتدى إلى أنَّ وجع القلق الذي عاشه طوال هذه السنين كان لأجل اكتساب محبّة لا وجود لها أساسًا، وإن وُجدت فهي هشّة مؤقّتة غير باقية، وإن كانت قويّة فإن أصحابها لا يستطيعون أن يحدثوا أثرًا خارقًا كما ظنّ ابتداءً.
6- الانعتاق
نظنُّ أن حياتنا تتطلّب مجموعة من الاحتياجات كرضا النّاس، والمال، والمنصب، والشهرة. لكن هل تفحّصنا هذه الفرضيات؟ ربما طريقنا نحو السلام والرضى هو (الانعتاق) ويتمثل في التوقّف عن اللهث خلف الحياة والانقطاع عنها ولو لمدّة بسيطة، لنعيد بعدها ترتيب حياتنا. فالتاجر الذي يراجع حساباته نهاية كل سنة مالية يكتشف احتياجاته ومكامن الخلل لديه. لعل ذلك يشحذ هممنا لأن نجفل ونبتعد وتتمثل أمامنا فرصة لتشخيص حالنا، وأن نعيش من جديد، منعتقين عن تلك السلاسل التي وثّقتنا سنين، وربّما.. ربّما نكتشف أنّه لم يوثّقنا أحد سوى مخيّلاتنا.
7- ما المشكلة في القلق أساسًا؟
يسعى إنسان اليوم نحو اللذّة أكثر ممّا يسعى للحياة العظيمة، وهما خطّان قد لا يلتقيان، كما يطرح عالم النفس الكنديّ البروفيسور جوردن بيترسون؛ لأنّ الحياة العظيمة مدفوعة بالقلق الذي لا ترحّب به حياة اللذّة، وتراه سبب إزعاج لا حاجة له، وهذا يتّفق مع أطروحة العالم والطبيب النفسيّ النمساويّ فيكتور فرانكل عن ضرورة التوتّر والقلق لأنهما من محرّكات الحياة السويّة.
هذه المقدّمة الترحيبيّة بالقلق، لا تنزع عنه صفته الحارقة، لذا ربّما توجّب علينا وضعه في سياق آمن يشعل طموحنا دون أن يحرق حياتنا.
هذا السياق هو تصوّرنا الكلّي عن الكون والحياة، واستحضار ملحمة الإنسان من قبل وجودنا، وحتّى ما بعد مماتنا، ونستصحب أيضـًا لوازم الملحمة التصوّراتيّة والسلوكيّة اليوميّة، تلك التصوّرات التي تساعدنا على إدارة ملفّ القلق بطريقة صحّيّة، فنقل تركيزنا حول المكانة من الألقاب الدنيويّة، وأرصدتنا البنكيّة ومرتبتنا الوظيفيّة إلى لقبنا في عالم الخلود، ورصيد حسناتنا ومرتبتنا في الجنّة.
بعد غزوة حنين أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عطايا لقريش وقبائل العرب، ولم يكن للأنصار منها شيء. فنظرت فئة من الأنصار إلى أقرانهم من المهاجرين، وقد تحصّلوا على مكاسبًا كان بإمكانهم أن يتحصّلوا عليها، ثم غضبوا، فلّما بلغ ذلك رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، قال لهم كلامًا منه: ‹‹ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله -صلى الله عليه وسلم-في رحالكم››؟
توقّفتُ كثيرًا وأنا أقرأ هذا الحدث، وأحاول ربط أحداثها بقلق السعي نحو المكانة، وكأنّه -صلى الله عليه وسلّم-يعيد ضبط الأولويات، ولسان حاله يقول: هل يهمّ الحصول على الوسيلة (المال) إن تحصّل المرء على الغاية (صحبة رسول الله)؟
هذا التحوّل المحوريّ يغمس خواطرنا في بحور الرضا الباردة، التي لا تمنع من حرارة الطموحات العالية، بل تهذّبها وتعالجها من داخل أعماق النفس، إذ المشكلة ليست في سلوكيّات السعي نحو المكانة، بل في ماهيّة نيّة هذا السعي؟ فلو كانت نيّة هذا السعي متّجهة نحو المكانة الحقيقيّة؛ المكانة في السماء، فيكفي حينها النيّة مصحوبةً بالسعي دون الوصول؛ لأنّ السعي هو الوسيلة المطلوبة فقط، أمّا الوصول فهو يوم توزيع النتائج بعد نهاية الاختبار، بعد الموت، أمّا التعثّر في السعي فهو الأصل (كل بني آدم خطَّاء، وخير الخطَّائين التَّوابون) بل (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم! وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)، هذا التصالح مع حالة النهوض المستمر، والدعوة للسعي في سياقٍ آخر، مع تصحيح مفهوم المكانة، هو الضمانة دون إحباطات الفشل؛ لأنّه حتميّ، ولأنّ الماضي كلّه ليس فقط مقدّرًا في علم الله بحكمته، بل برحمته بنا.
اقرأ ايضاً: معتقلات الانطباعات

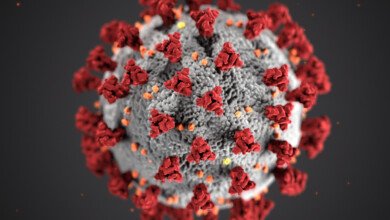



رائع جدا .. أبدع الكاتب في الانطلاق من نصوص الوحيين مع توظيف لكلام حكماء الغرب وفلاسفتهم
تنبيه : كلام الشيخ راتب النابلسي حفظه الله في صفة الحب تحتاج مراجعة وفق كلام متقدمي العلماء والسلف .. فلم يكن من دأب أحدهم تفسير الصفات هكذا .. فلتراجع كتبهم ككتاب ابن خزيمة والطبري والمروزي والخلال وعبدالله بن الإمام أحمد وقبلهم كتب ابن قتيبة وأبي عبيد وعثمان الدارمي وغيرهم
وفقكم الله