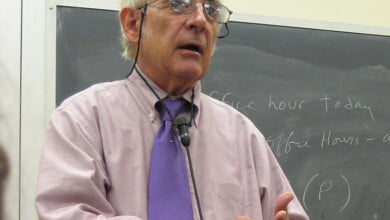د. عائض بن سعد الدوسري
“الطبيعة الحقيقية للصراع، صراع المشروعيَّة الفكريَّة في قلوبِ وعُقُولِ النَّاس، وليس القوة العسكريَّة. إنَّ الحروبَ تُخَاضُ ويتم فيها تحقيقُ النَّصرِ أو الهزيمةِ في عُقُولِ النَّاس، قبل وقتٍ طويلٍ من بُلُوغِها نِهايتها في ميدانِ قِتَالٍ بعيدٍ”. روبرت رايلي، مدير إذاعة صوت أمريكا، كَتَبَ ذلك في مقالٍ له بعنوان (كَسبُ حَرْبِ الأفْكَارِ)، صحيفة واشنطن تايمز، بتاريخ 28/1 / 2002م.
لِمَ نقدُ الأفكارِ وفَحْصُها؟
وهل هناك أهميَّة لنقدِ الأفكارِ؟ وهل نحن بحاجةٍ إلى ذلك؟
من الحقائق التي يجب أن تُدْرَك جيدًا، أنَّ الإنسان لا يتحرك في تصوراته المختلفة، ومواقفه المتنوعة، وأفعاله المتباينة، ومشاعره المتناقضة، وخواطره وأحاسيسه، إلا من خلال الأفكار، التي تعمل في عقله من خلال عمليَّة التفكير، الواعية أو غير الواعية، المباشرة أو غير المباشرة، إنَّ خطورة الأفكار تَتَجَسَّد قي أنَّها هي التي تصنع الأفعال. ففي كل لحظة أنت تُفَكِّر في حياتك وعملك وفيمن معك أو تربطك بهم صلة، تفكر في الماضي وتحمل قلق الحاضر وهم المستقبل، وهذا التفكير سيولِّد تلقائيًا مشاعرك السلبيَّة والإيجابية، ثُمَّ يُنْتِجُ ذلك أفعال، وفي نهاية اليوم أنت رهينة لأفكارك وطريقة تفكيرك. يقول الفيلسوف الصيني لاوتسي (Lao-Tze): “راقب أفكارك، فإنَّها تصبح كلمات، راقب كلمات، فإنَّها تصبح أفعالاً، راقب أفعالك؛ فإنَّه تصبح عادات، راقب عاداتك، فإنَّها تصبح طبيعةً، راقب طبيعتك، فإنَّها تصنع مصيرك”.
هناك أفكارٌ كثيرة من حولنا، تجري في سيلٍ مُنْهَمِرٍ في كُلِّ لحظةٍ، تطرق مسامعنا وعقولنا وأعيوننا، ونتلقاها بأشكالٍ مختلفة ومتنوعةٍ، ولهذا فنحن في كُلِّ لحظةٍ بحاجة لتمييز هذه الأفكار، الصحيح منها والسقيم، والحقيقي والمُضَلٍّل، والمفيد والضار، لأنَّنا بحاجة إلى الاستفادة من الصحيحِ والحقيقيِّ والمفيد، وفي الوقتِ نفسهِ بحاجة إلى الحَذَرِ من السقيم والمُضَلِّل والضار. ومن هنا تأتي أهميَّة الوعي بتلك الأفكار، وأهميَّة نقدها وفحصها قبل أن تتسلَّلَ إلى عقل الإنسان، ومن ثَمَّ تتمكَّن من صناعة تصوراته ومشاعره، وفي النهاية تُنتِجُ مواقفه وقراراته وأفعاله.
قد ينظر بعض الأشخاص باستهانة إلى بعض الأفكار في بدايتها، ويعتقد أنَّها أحقر من أن تترك أثرًا في فكره، وهو لا يستوعب كيف تعمل الأفكار، وأنَّ فكرة صغيرة قد يترب عليها من العواقب ما لا يتوقعه من مثلها، وربما باستطاعتك في البداية إشعال حريق الأفكار في رأسك، من خلال فكرةٍ قَدَحت ذلك، لكنكِ حتمًا لن تكون قادرًا على إيقافها. نحن نتحكم –بمشيئة الله- في البداية بما يدخل إلى عقولنا، لكننا لاحقًا إذا سمحنا له بالدخول نعجز عن إيقافه والتحكم به، خصوصًا في عالم الأفكار، حينما نقوم بإشعالِ عودِ ثقابٍ واحدٍ بجلبِ فكرةِ واحدةِ، وإذا بنا فجأة نشعل غابات التفكير كلها في عقولنا بهذه الفكرة. يقول الكاتب السياسي الأمريكي بروس بارتون (Bruce Barton): “أحيانا عندما أتأمل العواقب العظيمة التي تتمخض عن صغائر الأمور، أميل إلى التفكير في أنه لا وجود لصغائر الأمور”. ربما تستطيع أن تتوقف عن القراءة –مثلاً- وأن تضع الكتاب جانبًا في أي لحظة تريدها، لكنَّك في كثيرٍ من الأحيان سيصعب عليك أن تتوقف عن التفكير فيما قرأتَهُ لو أردتَ ذلك، إذا صادفتَ فكرةً لا تزال تُلِحُّ عليك، قد هَزَّت عقلك أو استحوذت على وجدانك.
ولهذا، فمن أخطر الأمور الاستهانة بالأفكار دون فحصها، مهما ظننت أنَّك في مَنَعَةٍ منها، فالأفكار لها سلطان على العقول، ولها قابليتها الكبيرة في التأثير وسُرْعَة الانتشار لدى العقول التي تتلقاها دون فحصٍ أو نقد. يقول هاينرش هاينه (Heinrich Heine): “إنَّ الأفكارَ الفلسفيَّة التي يطرحها أستاذٌ من مكتبهِ الهادئ قادرة على إبادةِ حضارةٍ بكامِلِها”. ويقول يقول فكتور هوغو (Victor Hugo): “لا يوجد جيشٌ يستطيع أن يَصمُدَ أمامَ قُوةِ فكرةٍ حانَ وقتها”. ويقول الفيلسوف الاجتماعي-السياسي البريطاني أيزايا برلين (Isaiah Berlin) محذرًا من مغبة ترك الأفكار دون نقدٍ وفَحْصٍ لها: “إن إهمال الأفكار من قِبَل الذين ينبغي أن يعتنوا بها -أي من قِبَل مَن تدربوا على تبني نظرةٍ ناقدةٍ للأفكارِ عمومًا- قد يؤدي أحيانًا إلى اكتسابها قوة كاسحة، لا يمكن مقاومتها أو كبحها، تُفْرَض على أعدادٍ هائلةٍ من البشر”.
ومن أجل هذا، فنحن نهتم بالأفكار ونقدها وفحصها وتمحيصها، فهي تُؤَثِّر على حياتنا بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشرٍ، وعلى حياة من يعيشون بقربنا ومعنا، وآثارها الإيجابيَّة والسلبيَّة لا حدود لها، تشمل الآثار: الفكريَّة، والدينيَّة، والنفسيَّة الوجدانيَّة، والسياسيَّة ، والاقتصاديَّة، النظريَّة والعمليَّة.
ما أخطر فكرة؟
هي دون تَرَدُّدٍ المعلومة الأولى عن قضية ما؛ وسبب خطورتها وقوتها أنَّها تأتي العقل وهو خالٍ عنها، خالٍ عما يُضادها أو يُوافقها، فلا يملك ما يدفعها به أو ما يُميزها، وبما أنَّ الأصل في الإنسان أنَّه (كائنٌ تصديقيٌ) فإنَّه يسهل على تلك الفكرة الأولى الجديدة أن تستقر في عقله، وقد تكون -بسبب إهماله وتكاسله عن فحصها ونقدها- القاعدة التي ينطلق منها فكره، بل قد تصبح تلك المعلومة أو الفكرة الأولى هي التي يُحَاكم إليها بقية المعلومات اللاحقة. وأخطر ما يُضَلِّل تفكير الإنسان هو تتابع المعلومات والأفكار الأولى، حتى تُكَوِّن منظومة محكمة، يصعب عليه لاحقًا زحزحتها من عقله.
كيف تعمل الأفكار؟
تعمل الأفكار في تغيير القناعات وصنع التَّصَوُّرات، من خلال قوتها الذاتيَّة أو من خلال ضعف المُتَلَقِّي أو جهله. فالفكرة إما أن تكون أولى وجديدة أو مسبوقة، وإما أن تكون ضعيفة (دعوى) أو قويَّة (مُبَرْهَنَة). والمفترض أنَّ الأفكار القويَّة تعمل مع سائر الأشخاص بقوةٍ وحيويَّةٍ، لأنَّها تملك قدرة إقناعيَّة كبيرة، والأفكار الضعيفة المفترض أنَّها تفتقد القُدرة على تغيير قناعات الأشخاص الأقوياء فكريًا بل أحيانًا تعجز عن تغيير الأشخاص الضعفاء أيضًا. لكن عالم الفكر والأفكار لا يسير وفق مُعادلاتٍ رياضية مُطردة، فالتغيير الذي تملكه الأفكار (القويَّة والضعيفة) يخضع لاعتباراتٍ كثيرة: طبيعة الشخص نفسه، والحالة العقليَّة والنفسيَّة والاجتماعيَّة لذلك الشخص، وسياق الزمان، والمكان، وزخم الإثارة المصاحبة للأفكارِ نفسها، ووسائل عرض تلك الأفكار، إلى غير تلك العوامل والظروف المختلفة والمتنوعة. لكنَّ عادة الأفكار التي تُغَيِّر القناعات وتَصْنَع التَّصَوُّرات، أنَّها تمتلك قوة وجاذبيَّة أمام الشخص، بصرف النظر عن قوتها الحقيقيَّة وجاذبيتها الذاتيَّة، فتلك مسألة تتفاوت بتفاوت قدرات تفكير الأشخاص.
وإذا ما دخلت فكرةٌ إلى النطاقِ الفكريِّ للشخصِ ، فهي تأخذ عدة حالات:
* أن تكون الفكرة القادمة هي الفكرة الأولى، وعادة تملك قوة على الأشخاص، وتُحْدِثُ تأثيرًا كبيرًا، خصوصًا إذا أُهْمِلَت، وقد تصبح قناعة يتبناها الأشخاص.
* أن تكون الفكرة ليست هي الأولى، وهنا ينقسم تأثيرها إلى عدة احتمالات:
– أن تكون الفكرة الوافدة أقوى من الفكرة السابقة، وعادةً هنا يحدث الشك والصراع بينهما، لكن في النهاية، تستطيع الفكرة القادمة أن تزيح الفكرة السابقة عن مركزها السابق، وتحل مكانها.
– أن تكون الفكرة الوافدة أضعف من الفكرة السابقة، وعادةً تصطدم بما قبلها، لكنَّها نادرًا ما تُحدث آثارًا سلبيَّة، بل أحيانًا يكون لها أثر إيجابي، يَتَمَثَّل في تعزيز وتقوية الفكرة السابقة، وتدعيمها وزيادة القناعة بها.
– أن تكون الفكرة الوافدة مساوية من الفكرة السابقة، وعادةً هنا يحدث صراع محتدم بينهما، إما أن يؤدي إلى ترجيح إحدى الفكرتين، أو يقود صاحبه إلى الشك أو التوقف أو اللاأدريّة حين يجد التكافؤ بين الفكرتين.
تأملاتٌ حول تأثير الأفكار:
هناك مُلاحظاتٌ مُهِمَّةٌ وتأملاتٌ حول الأفكارِ وتأثيرها، (مُختلف الأفكار الدينيَّة والثقافيَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة، الإيجابيَّة والسلبيَّة)، يحسن الوقوف عليها، ويُمكن تلخيصها في عدة أمور، ومنها:
الملاحظة الأولى: يتفاوت النَّاس كثيرًا في مدى سرعة قابليتهم في قَبُولِ الأفكارِ والتَّأثُّرِ بها، وذلك بحسب ما لديهم من الحصانة الفكريَّة (=العلميَّة)، والنُّضج العقلي والوجداني، فهم ما بين مُحَصَّنٍ يقبل أو يرفض بوعيٍ، أو مُتّذَبْذِبٍ مُتَشَكِّكٍ حائرٍ يصعب عليه القبول أو الرفض، أو سريع القبول والرفض والاعتناق والانعتاق، يتغيَّر سريعًا بالمقارنة مع غيره عند كُلِّ فكرة تَطْرُقُ باب فكره.
الملاحظة الثانية: تأثير الأفكار غالبًا لا يكون مُباشرًا وسريعًا يُمكن ملاحظته، فطبيعة تأثير الأفكار أنَّها غير مُباشِرَة وغير مُعْلَنَة، بل بطيئة وتدريجيَّة، ولذلك ففي أحيان كثيرة لا يُدرك الإنسان أنَّ تلك الفكرة أو مجموعة الأفكار قد أثَّرَت عليه أو نقلته من مربعه الذي كان فيه إلى مُرَبَّعٍ آخر جديد.
الملاحظة الثالثة: صُنَّاع الفِكْر في سائر العَالَم، الذين يحملون مختلف الأجندات والخلفيَّات، ويرغبون في تقديم فِكرةٍ جديدة، يتعاملون مع تفكير النَّاس وفق هذا الأساس السابق، ولهذا يَتِّبِعُون منهجيَّة “القَطَرات“، القائمة على التغيير والإزاحة الفكريَّة البطيئة لكن المُواجَّهة، عبر جميع المُخرَجَاتِ والمُنْتَجَات الفكريَّة، من الروايات والمسلسلات والأفلام السينمائية وأفلام الكرتون، والأخبار…إلى آخر ذلك، وهكذا يتحوَّل المُتَلَقِّي تدريجيَّا -ودون أن يعي تمامًا بهذا الخطوات التي يسير فيها أو تلك القطرات التي يتلقاها- من حالة القَبُول التَّامِ بالشيءِ إلى حالةِ الرَّفضِ التَّام، أو العكس.
الملاحظة الرابعة: كثيرٌ من الأفكار السلبيَّة المتراكمة (مثلاً: الشبهات في العقيدة والإيمان)، عبارةٌ عن قطراتٍ صغيرةٍ من الأفكارِ والخَواطرِ، عادة لا تستصحب معها دليلاً أو بُرْهَانًا، لكنَّها تَمْتَلِك قوة (التراكم)، في ظلِّ غياب النقد والفحص، وهكذا تظلُّ مؤثرة في تصورات العقل بشكلٍ تدريجي لكنه مُستمر، وخطورتها أنَّها حتى لو كان هذا الشخص الذي يُعاني منها يعلم أنَّها بلا دليلٍ أو برهانٍ ومع ذلك فإنَّه يبقى مُتأثرًا بها، لأنَّها لم تَصنَع فكرةً أو نُقْطَة مُحَدَّدَةً بدليلها وبرهانها، يُمكن أن ين يضع يده عليها ويناقشها ويدحضها، وإنَّما صَنَعَت لديه، من خلال عملها البطيء والمتراكم، تَوجُّهَاً عميقًا في التَّصَوُّرات ومنظومة تفكيره، فأصبح من الصَّعْبِ عليه التَّخَلٌّص والانعتاق منها، وهكذا هي النتيجة المتوقعة من الدخول في السياق الذي يَتِمُّ فيه التَّعَرُّض والتَّلقِّي المُتَكَرِّر لسيلٍ من الأفكار المُنَظَّمَة ذات التَّوجُّهِ والمضمون المُتَشَابِه من خلالِ أشكالٍ مُتَنَوِّعَةٍ ومُتَلَوِّنَةٍ من المُنْتَجاتِ الفكريَّة.
الملاحظة الخامسة: تصحيح التَّصَوُّر والموقف تجاه الفكرة قبل دخولها إلى العقل، أسهل وأنجح وأقوى من تصحيحها بعد دخولها العقل والتَّأثُّرِ بها فضلاً عن الاقتناع بها وتَحَوُّلها إلى جزءٍ من مَنْظُومة الفَرْد الفكريَّة. ومن هنا تأتي أهميَّة نقد الأفكار وفحصها، وتَكْوين (حصانة فكريَّة قبليَّة).
الملاحظة السادسة: إذا دَخَلَت فكرةٌ جديدةٌ إلى النِّطَاقِ والمجالِ الفكريِّ لأيِّ عقلٍ بشريٍّ، ثُمَّ نَجَحَت في احتلالِ مساحة فيه، فإنَّه يصعب حينئذٍ طرد تلك الفكرة وإزاحتها من مكانها في عقله، وستصبح تلك المُهِمَّة (التَّصحِيحيَّة) مُهِمَّةً صعبةً وشاقةً للغاية، مُقارنةً بِمُهِمَّة (الحصانة الفكريَّة القبليَّة)، وقد لا تَتَكَلَّلُ المُهِمَّة (التَّصحِيحيَّة) بالنجاح دومًا، فضلاً عن النَّجاحِ التَّام، فعادة ما يَظَلُّ ويبقى تشويش الفكرة الوافدة وتعكيرها للتفكير والتَّصَوُّرات. فالفكرة الجديدة التي تأتي إلى عقلٍ خالٍ منها تُحدِثُ فيه تأثيرًا كبيرًا قد يقود إلى تحولات محوريَّة في حياته، مليئة بطريقٍ من الآلام والتَّوجعات. يقول الاقتصادي البريطاني والتر باغوت (Walter Bagehot): “أحد الآلام الكبيرة التي تعاني منها الطبيعة الإنسانيَّة هو ألمُ فكرةٍ جديدةٍ”.
الملاحظة السابعة: المشاعر السلبيَّة، كالحزن والغضب والرغبة في الانتقام، في الغالب ليست مجرد مشاعر بالدرجة الأولى، بل هي في الحقيقة أفكار سلبيَّة نشأت في العقل، ومصدرها السماع أو التفكير، ثم تحولت إلى مشاعر سلبيَّة. إنَّ الأفكار الإيجابيَّة أو السلبيَّة التي نَضَعها في عقولنا هي الرحم التي تُولَد منها المشاعر الإيجابيَّة أو السلبيَّة، وهذه الأفكار تُولَد إمَّا من مجرَّدِ الخيال أومن موقفٍ نواجهه، أو فكرة أوحى بها أحد الأشخاص، فطريقة تعاملنا مع تلك الأفكار يترتب عليها النتيجة، وهي: المشاعر. يقول الكاتب أوج ماندينو (Og Mandino): “إنَّ نقاط ضعفك الوحيدة هي تلك التي تضعها في ذهنك، أو تسمح لغيرك بأن يضعها لك”. ولهذا، فإنَّ الذين يتحكمون بطريقة التعامل مع أفكارهم ينجحون في التعامل مع مشاعرهم بشكلٍ أفضل. ولهذا، فإنَّ من يستطيع -بعد توفيق الله- أن يتحكَّم بالأفكار الواردة إليه، يستطيع أن يُخَفِّف من مشاعره السلبيَّة. ومن أجل هذا فإنَّه من الخطأ أن تفتح عقلك لجميع الأفكار، فبعض الأشخاص يجعل من عقله سلة للمهملات، مُشْرَع الأبواب لكل من هَبَّ ودَبَّ، يلقي فيه سمومه وأفكاره السلبيَّة والهدامة، ولذلك فمن الطبيعي أن يسمم عقله ثم مشاعره، وهكذا يكون في حالة مزاجيَّة متقلبة، يغلب عليها الحزن والهم والاضطراب. والعقل ما عودته عليه، وقد يصير كالمغناطيس، تنجذب إليه الأفكار والخواطر التي اعتاد عليها، فإن اعتاد على التفكير الإيجابي انجذبت إليه الأفكار الإيجابية، وإن اعتاد على التفكير السلبي انجذبت إليه الأفكار السلبية. إنَّ عقلك هو مغناطيس أفكارك، فدربه على اجتذاب الأفكار والخواطر الإيجابية وتجاهل وطرد الأفكار السلبيَّة أو التوقف عن الاسترسال معها. وأنت –بمشيئة الله- تستطيع أن تتعلم مهارة التوقف عن التعاطي مع الأفكار السلبيَّة، بل أنت بالفعل تُمارس ذلك في كُلِّ يومٍ دون أن تَشْعُرَ، فأنت حين تنام في فراشك، فتنعم بالراحة والهدوء والاسترخاء، فإنَّ هذا لا يعني أنَّ جميع الأشياء التي كانت في اليقظة تزعجك وتقلقك وتبعث في نفسك الخوف والحزن قد اختفت وتلاشت، بل ما برحت مكانها ولم تتغير أو تتبدل، كل الذي حصل أنك في نومك توقفت عن التفكير فيها وتركت التحديق فيها، فلم لا تجرب ذلك أيضًا في يقظتك، وتتعلم ممُارسته؟
الملاحظة الثامنة: إذا كانت الأفكار السلبيَّة قد تصنع المشاعر السلبيَّة ومن ثَمَّ تصنع الأفعال السلبيَّة، فإنَّ الأفعال السلبيَّة أيضًا تصنع وتُعَمِّق الأفكار السلبيَّة، فالعلاقة بين الأفكار والأفعال علاقة تبادليَّة في جانب الإنتاج الإيجابي أو السلبي، وإن اختلفت المستويات، فالأفعال السيئة تُعتبر من أَهَمَّ مُوَلِّدَات الأفكار السلبيَّة، وهي من أخطر ما يقود إلى تعميقها في العقل، وتَمنحها رسوخًا وثباتًا واستمرارًا، وقد تدفع الأفعالُ السلبيَّة الأفكارَ السلبيَّة إلى مستوى أخطر مما كانت عليه في السابق. ومن الأفعال السلبيَّة، المُتَعَلِّقَة بالإيمان، ممارسة الشهوات المُحَرَّمَة، فمثل هذه الأفعال وإدمانها تُلقِي بضلالها السلبيَّة على الأفكار التي تُشَكِّل عقله، وقد تنقل الشخص الذي كان يُمارسها وهو يعرف أنَّها سيئة إلى شخصٍ يُمارسها ويستسيغها ويقبلها ولا يرى بها بأسًا، بل قد تفتح على قلبه بابًا إلى الشبهات العقديَّة. قال الوزير ابن هُبَيْرَة: “احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات”. فانسياق الإنسان للشهوات، يضعف الإيمان الذي في قلبه، وقد كان يحرسه ويحميه ويحيطه، وقد يُغَيِّر فكره الذي كان حَصَانَةً له، فإذا أَخْلَدَ إلى الشهوات ضعفت حراسته وحصانته التي تُحيطُ بقلبِهِ وتَمْنَعُ وتَصُدُّ عنه الأفكار المُنحَرِفَة والسلبيَّة، فأصبح حينئذٍ عاجزًا عن مواجهة الشبهات ودفعها عن نفسه. ولذلك من أراد أن تتوقف عنه الأفكار السلبيَّة، بأنوعها، فعليه أن يتوقف عن الأفعال السلبيَّة، قال سريّ السَّقطي: “لا يقوى على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات”.
الملاحظة التاسعة: الفكرة (المضمون) وطريقة التفكير (المنهجيَّة)، فيما يتعلق بالإنسان، ليست معادلات رياضيَّة جادة أو منطقيَّة مُنْتِجَة بشكلٍ حَتْمِيٍّ، فالإنسان يخضع لعدة عوامل وظروف وسياقات تأثر على عقله، وطريقته في التفكير، ومن ثَمَّ فكون الفكرة صحيحة أو قويمة أو فاسدة خاطئة، لا يعني ذلك أنَّ الإنسان سيتخذ تجاهها القرار الصائب والحكيم تلقائيًّا، فالفكرة بذاتها لا تُنتج ولا تُثمر في الإنسان ما لم تكن طريقة تفكيره سليمة، والمؤثرات الأخرى معزولة أو ضعيفة، كالعواطف التي تُؤثِّر كثيرًا في عقل الإنسان وطريقة تفكيره، وتحمله على الانحياز أثناء عمليَّة اتخاذ قرارته، ومن ثَمَّ انحرافها.
فمثلاً: يقول روبن دنبار (Robin Dunbar)، أستاذ علم النفس التطوري البريطاني: “في هذه الأيام لدينا آلاتٌ تسمح لنا بمشاهدةِ الدماغِ حينما يعمل. بعض الأجزاء المختلفة من الدماغ تُضيء على الشَّاشة اعتمادًا على ما يفعله الدماغ. وعندما يكون النَّاس في حالةِ حبٍ [عشقٍ]، فإنَّ الأجزاء العاطفيَّة لأدمغتهم تكون نشطةً للغاية، وتُضيء. أما الأجزاء الأخرى من الدماغ المسئولة عن التفكير الأكثر عقلاً فتكون أقل نشاطًا من المعتاد. لذا سيتم إيقاف تشغيل المعلومات التي عادة ما تقول: (لا تفعل ذلك؛ لأنَّه سيكون مجنون!)، وسيتم تشغيل المعلومات التي تقول: (أوه، إنه سيكون رائعًا!). لماذا يحدث هذا؟ لسببٍ واحدٍ: هو أنَّ الحبَّ ينشر بعض المواد الكيميائيَّة بأدمغتنا، وأحد هذه المواد اسمه الدوبامين (Dopamine)، الذي بدوره يعطينا إحساسًا بالإثارة. وكذلك آخر اسمه الأوكسيتوسين (Oxytocin)، ويبدو إنَّه مسئول عن الطيش والمتعة. وعندما تذهب هذه المواد بكميات كبيرة فإنَّها تذهب إلى أجزاء من الدماغ تستجيب لها بشكلٍ خاصٍ”.
إنَّ الأفكار الضعيفة بذاتها قد لا تكون مؤثرة ولا فاعلة ولا تعمل بشكلٍ فَعَّالِ إلا حينما تكون بمواجهة فراغٍ معرفيٍّ أو عاطفيٍّ، وحينها ستقوم تلقائيًا بالتسلل إلى ذلك الفراغ أو من خلاله، لتقوم بالحلول في العقل والاستحواذ على قناعات الشخص.
الملاحظة العاشرة: أنَّ الأفكار والثقافات في صراعٍ دائمٍ وحربٍ، حتى في أوقات إعلان السلام، وكُلُّ فكرةٍ تسعى إلى إزاحة أختها والحلول محلها. ففي كتابه (American Idol After Iraq)، الذي يتحدَّ عن (حرب القوة الناعمة) أو كما يُعَبِّر هو بكلماته: (Competing for Hearts and Minds in the Global Media Age)، يقول نيثان غردلز (Nathan Gardels): “الميدان العام هو مجال القوة الجديد، حيث تتنافس الصور وتُحاجج الأفكار، حيث تكسب القلوب والعقول أو تخسر، وحيث يُؤسس الشرعية”. ولذلك، فَصُنَّاع الأفكار يُدركون جيدًا أنَّ حماية الفكرة ليس فقط بتعزيزها وإنَّما بنقد وتحميص ودحض خصومها، ولذلك يقول المفكر والمؤرخ صموئيل فرانسيس (Samuel Francis): “أوَّلُ شيءٍ يجب أن نتعلمه حول القتال والانتصار في حرب الثقافة هو أنَّنا لا نقاتل لنحمي ونحافظ على شيءٍ ما، نحن نقاتل لإسقاط شيءٍ ما”. وكذلك لكي تنج فلن يكون عملك فقط محصورًا في الانشغال بحربِ الأفكار الأخرى في عقول النَّاس دون الحرص على إيجاد الفكرة البديلة. وذلك لأنَّ العقل لا يبقى في فراغٍ، فلو نَجَحْتَ في هدمِ فكرةٍ ما فإنَّك لن تجح بذلك فقط، بل لا بُدَّ من وجود فكرة بديلة تحل محلها، فالعقل البشريُّ لا يُمكن أن يعمل في فراغٍ ولا أن يبقى فارغًا، فهو بطبيعته يبحث عن الفكرة المناسبة التي تملأ مساحاته، ومن ثَمَّ تمنحه التصورات عن نفسه وعن العَالَم. ولذلك يُدرك صُنَّع الأفكار أهميَّة هذه الحقيقة، وأنَّ الفكرة الخاطئة يصعب مواجهتها أو هدمها دون تقديم فكرة أخرى عِوضَاً عنها. يقول الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت (Auguste Comte): “لا يُهْدَمُ حقَّ التَّهدِيم إلا ما يُعَوَّض”. فإذا لم يتم فعل ذلك فإنَّ الفكرة الخاطئة لن تذهب، بل قد تتطوَّر وتنمو وتنتشر، بل قد تحل في محل الفكرة الصحيحة التي تؤمن بها، فالأفكار المُضَلِّلَة لا يُمكن أن توقفها إلا أذا أوقفتَ تطورها وتماديها، وذلك من خلال مواجهتها بالنقد والتمحيص، فتطورها يعني أنَّها حيَّة وتعمل ومن ثَمَّ تكتسب مساحات جديدة. يقول كولن ولسون (Colin Wilson): “إنَّ هنالك قانونًا في التاريخ يمكننا أن ندعوه (قانون الأخطاء)، وهو: أنَّه لا يمكن القضاء على خطأ ما إلا بعد أن يكف عن التطور”.
ولكي تَهزِمَ فكرةً فلا بد أن تُقَدِّم أخرى، ولا بد أن تكون من جِنْسِها وأقول (وأقوى) منها، وإلا خَسرْتَ في (معركة الأفكار)، فالأفكار لا تُواجَهُ بأضعف منها أو من غير جِنْسِها، كما يُريد مواجهة انتشار المذاهب العقائديَّة الرساليَّة بأفكار ليست أقوى منها، أي بأفكارٍ من غير جِنِسِ العقائد، فيريد أن يواجهها بلا عقيدة لديه، فهذا لا شك سيفشل، ولن تكون مساحاته الفكريَّة في مناعةٍ من اختراقِ تلك المذاهب العقائديَّة الرساليَّة لها. يقول باتريك بوكانن (Pat Buchanan)، وهو سياسيُّ أمريكيٌّ كبيرٌ، عمل مستشارًا كبيرًا لثلاثة رؤوساء أمريكيين: “لكي تَهْزِمَ إيمانًا يجب أن تمتلك إيمانًا”. وهذا حقيقيٌّ، فالإيمان لا يُواجه إلا بإيمان، وإذا ما تم مواجهة الإيمان بفكرةٍ لا إيمان فيها، ستفشل، وربما تنجح مؤقتًا في تشويشه وهزِّه، لكن سرعان ما تنقشع هذه الفكرة ويبقي الإيمان كما كان.
ولهذا، فإنَّ من (قواعد الأفكار) أنَّه إذا تَقَلَّصَت الفكرة الجيدة وانسحبت من ساحاتٍ معينةٍ فلن تظل تلك الساحات فارغة، بل ستسارع الأفكار الزائفة إلى احتلال مكانها بأسرع مما نتصور، وفي أماكن قد لا نتصور أبدًا أن تحتل فيها تلك الأفكار الزائفة مكانًا راسخًا. فالمجتمعات الإنسانيَّة لا تبقى بدون فكرة تعتنقها وتهديها وترشدها، فإمَّا أن تكون الفكرة الهادية هي الحق وإما أن تكون الزائفة. وكل ساحة تنسحب منها الأفكار الجيدة أو يتكاسل أصحابها أو يفقدون الانجذاب إليها، تحتل مكانهم الأفكار الزائفة أو أفكار أخرى. أن مبدأ صراع الأفكار حقيقة وجوديَّة لا يمكن الهروب منها، وبقدر ما تنجح فكرة ما باحتلال مكانٍ ما؛ بقدر ما تزيح غيرها من الأفكار في ذلك المكان نفسه، وكلما تمددت فكرة ما تقلصت بقيَّة الأفكار، وكلما تقلصت فكرة ما وانزاحت -بسبب ضعفها الذاتي أو ضعف مناصرة أصحابها- من مكانها الذي كانت مُهَيْمِنَة عليه؛ حَفَّزَت وشَجَّعَت بقيَّة الأفكار الأخرى وأغرتها بأخذ مكانها، مهما كانت تلك الأفكار الجديدة ضعيفة ومشوشة ومشوّهة ومرتبكة. فالانسحابُ والتخلي عن الفكرة التي تؤمن بها وكانت هي مصدر قوتك؛ ضعفٌ، و”الضعفُ يُحَرِّضُ عليك الآخرين”، كما يقول ذلك وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد (Donald Rumsfeld)، وجعل ذلك قاعدةً مهمةً من قواعد السياسة والقوة.
الملاحظة الحادية عشرة: الأفكارُ المُتَسَلِّلَةُ: إنَّ الأفكار المباشرة الواضحة تصدم الإنسان في بدايتها، فيرفضها أو يقبلها. غير أن بعض الأفكار وإن كانت ضعيفةً في بنائها، لكن تأتي خطورتها من جهة كونها (الأفكارُ المُتَسَلِّلَةُ). وتَكْمُنُ خطورتها في عدم مُباشرتها ومُصادمتها للشخص، وفي طبيعة وعائها الذي تأتي فيه، وعدم دقة ووعي وملاحظة المُتَلَقِّي لها، ومن هنا تأتي أهميَّة وصعوبة، مراقبة وفحصِ سيل تلك الأفكار الجديدة المُتَدَفِّقَة التي تأتي شائعة ومُنْتَشِرَة في المُخْرَجَاتِ والمُنْتَجَاتِ الفكريَّة المُتَنَوِّعَة، خصوصًا ذات المُمَيِّزات المُمتِعَة والشيِّقَة والمُسَلِّيَة والمُضْحِكَة السَّاخِرَة، كالروايات والأفلام والمسرحيات…إلخ، التي تَنْصَبُّ بأفكارِها كَالسَّيلِ الهادرِ الذي يحمل معه طوفانًا من (الدعاوى) غير المُبَرْهَنَةِ والعارية عن الدليل والبرهانِ، تسوقها بِتكْرَارٍ وتتابعٍ، في صِيَغٍ مختلفة ومتنوعة، تَلْتَبِس حينًا بالعاطفيَّة الوجدانيَّة (=غضب/حب/سخط/يأس)، وتركب في حينٍ آخر مركب ‘العقلانيَّة’ (=حكمة/واقعيَّة/ترفع النخبة/ازدراء وسخرية)، فيتم تَعْرِيض المُتَلَقِّي لها بهذا الكم الكبير، وإذا به ينتقل دون أن يكتشف ذلك من الموقف الأول (الرفض/القبول) القويِّ، إلى موقفٍ أقلَّ قوة من السابق، موقفٍ رماديٍّ، وهكذا فكلما تَعَرَّض المُتَلَقِّي لهذا الكمِّ المُتَكَرِّرِ من (الدعاوى) الخالية من البرهان، تَشَبَّعَ بها وتَطَبَّعَ، حتى غدا كالإسْفَنْجِ، وصار أكثر قابليَّة للتَّحَوُّل، وفي بعض الأحيان قد يتزحزح شيئاً فشيئاً عن موقفة السابق، إلى موقفٍ مناقضٍ لموقفه الأول.
وفي مثل هذا السياق، يقول الباحث الأكاديمي الأمريكي رضا أصلان: “في أمريكا، تحولنا من أغلبية ساحقة كانت ضد الشذوذ الجنسي، إلى أغلبية ساحقة مؤيدة للشذوذ الجنسي خلال بضعِ سنينِ. ما الذي غَيَّرَ عقول النَّاس؟ مشاهدتهم للشواذ بصورةٍ عاديَّةٍ وطبيعيَّةٍ في المُسَلسَلاتِ التلفازيَّة”. وهذه حقيقة يجب إدراكها، فكثرة تكرار الشيءِ حتى لو لم يكن طبيعيًّا يُحَوُّلْهُ إلى شيءٍ طبيعيٍّ، وهو ما يعرف بـ(Normalization)، فمهما كان الأمر غريبًا وشاذًا، فإنَّه بكثرة فعله وتكراره تألفه النفس شيئًا فشيئًا حتى يعود عندها طبيعيًا، بل ربما تستنكر ما هو خلافه. ولذلك يقول المفكر الاقتصادي كلاودي بوريو (Claudio Borio): “يصبح غير الطبيعيِّ بدرجةٍ كبيرةٍ طبيعيَّا بشكلٍ غيرِ طبيعيٍّ”.
ولهذا فإنَّه يحسن الانتباه إلى خاصيَّة مُهِمَّة في المُنتجات الأدبيَّة والفنيَّة ذات الطابع الفكريِّ الثقافيِّ، المشحونة في الروايات والمسرح والأفلام وغيرها، حيث تمتلك بطبيعتها المُشَوِّقَة القدرة على تغيير تصورات عموم النَّاس وقناعاتهم، أكثر من الأفكار الفلسفية والأيديولوجيات المباشرة. والسبب يعود إلى أنَّهما لا تخاطب العقل مباشرة، بل تبث حمولتهما الفكريَّة الفلسفيَّة بطريقة مغلفة وجميلة، ومحببة للنفس، لما فيهما من التشويق والإغراء والإثارة، فتلج إلى الوعي كأحدِ مكوناته تلقائيًّا، والإنسان في دهشته ومتعته تلك لا يعي أنَّه قد تم إعادة صياغته تدريجيًّا وفق تلك الحمولات الفكريَّة. وقد أشارت صحيفة الغارديان (The Guardian) إلى مدى التأثير الكبير (Normalization) الذي أحْدَثَتُهُ مسلسلات وبرامج، من مثل: (Desperate Housewives)، وبرنامج (My Next Guest Needs No Introduction) الذي يُقدِّمه ديفيد ليترمان (David Letterman)، في تغيير أفكار وقناعات المُتَلَقِّي، ليس فقط المُتَلَقِّي الغربي، بل المُتَلَقِّي العالمي بمن فيهم المُتَلَقِّي العربي خصوصًا، وأشارت (The Guardian) إلى أنَّ مثل هذه المواد الثقافيَّة الفكريَّة هي في حقيقتها أداةٌ للصراعِ في “ساحةِ حربِ الأفكارِ [التي] لا تزالُ محتدمةً”! ولهذا، يُدرك العقلاء أنَّ معركة اليوم معركة فكريَّة بالدرجة الأولى، يدور رحاها في ساحات عديدة، وتحاول إعادة صياغة التاريخ والثقافة والذاكرة، وتوظيف ذلك لنصرة الأفكار الجديدة وتوليدها وتثبيتها داخل ساحة غريبة عليها، بل مضادة لها.
فهذا النَّوعُ من (الأفكارُ المُتَسَلِّلَةُ)، يُعتبر عند أصحابه من عوامل القوة، ويُسمى (القوة النَّاعِمَة)، التي تَتِمُّ عن طريق صِناعةُ الجاذبية في القيم والأخلاق والثقافة، التي ينتمي إليها صُنَّاع الأفكار، وترويجها (=أي جعلها قادرة على اختراق المُجتَمَعات الأخرى المُستَهدَفَة) عبر المُخْرَجَاتِ والمُنْتَجَاتِ الفكريَّة المُتَنَوِّعَة. وكان من الطبيعي أن تحرص معظم الدول الكبرى، والمؤسَّسات عابرة القارات، والفرق المذهبيَّة الفَاعِلة والنَّاشِطة، والأحزاب الحَرَكِيَّة السياسيَّة، والجماعات المُتَطَرِّفَة، والمذاهب الوضعيَّة، على الاستفادة من تلك الجاذبية التي تَخْلِقها (القوةُ النَّاعِمَة) للأفكار والقيم، فتقوم بتمديد نفوذها وتأثيرها السياسيِّ والجغرافيِّ والبَشَريِّ من خلال تَمَدُّدِ نفوذها وتأثيرها الثقافيِّ أو الدينيِّ. يقول جومو كينياتا (Jomo Kenyatta)، رئيس وزراء كينيا: “عندما وَصَلَ المُنَصِّرون [=إلى إفريقيا]، كان لدى الأفارقة الأرض، وكان لدى المُنَصِّرين الكتاب المُقَدَّس. لقد علمونا كيف نصلي وأعيننا مغمضة، وعندما فتحناها، كانت لديهم الأرض ولدينا الكتاب المُقَدَّس”. وهذه حقيقة تتكرَّر في أزمان وأماكن كثيرة، فالسيطرة التَّامة تبدأ بامتلاك الأرض، وامتلاك الأرض يبدأ بكسب ولاء الناس، وكسب ولاء الناس يبدأ باقتناعهم بأفكارك (=أفكار صاحب الفكرة المسيطر)، فإذا نَجَحْتَ في إقناعهم بفكرتك أصبحوا طوع أمرك. ومن تأمل تاريخ الاستعمار وحرب الأفكار، سيجده أنَّ الجيوش العسكريَّة للدول العظمى والمؤثرة والمؤسَّساتيَّة التي تُريد إلحاق الهزيمة بخصمها أو الاستحواذ على ما يملك، تبدأ في الغالب حربها بجيوش الأفكار، حتى إذا كسبت عقول النَّاس أو هزمتهم احتل أرضهم وسيطرت عليهم، وسخرتهم لخدمة أغراضها!
ولهذا، ذََكَرَ جوزيف ناي (Joseph Nye) -مدير مجلس المخابرات الوطني الأمريكي- أنَّ تلك القوة النَّاعِمَة (=الأفكارُ المُتَسَلِّلَةُ) هي التي أَسْقَطَت جدار برلين، وذلك حين تم اختراقه بالتلفاز والأفلام السينمائية (=مطارق الثقافة)، قبل زمنٍ طويلٍ من سقوط الجدار في عام 1989م! ويُعَلِّقُ جوزيف ناي على هذه الحَدَثِ الهامِّ بقوله: “برغم أنَّ الاتحاد السوفييتي قد فَرَضَ قُيودًا ورقابةً على الأفلام الغربيَّة، فإنَّ الأفلام التي نفذت عَبْرَ مصفاة القيودِ والرقابةِ، كانت مع ذلك قادرة على أن تُحدِث آثارًا سياسيَّة مُدَمِّرَة، وكانت بعض الآثار السياسيَّة مباشرة أحيانًا، ولو غير مقصودة…إنَّ قوتنا الناعمة قُيض لها أن تُساعدَ على تحويل الكتلة السوفييتية من الداخل”. إنَّ الأفكار في هذا العصر لا تعترف بالحدود ولا بالجنسيات والأعراق، ومن سبق بتقديم فكرته إلى النَّاس سبق إلى كسب عقولهم وقلوبهم.
و(الأفكارُ المُتَسَلِّلَةُ)، عادتها أن يكون تأثيرها بطيئًا وتدريجيًا (القطرات)، لكنَّها في بعض الأحيان قد تكون سريعةً وصادمةً، ولا يحتاج في تأثيرها سوى كتابٍ واحدٍ، أو فيلمٍ سينمائيٍّ واحدٍ فقط، حين تكون العقول القوابل لها مستعدة ومهيَّأة. وقد يجد بعض القُرَّاء صعوبة في فهم واستيعاب أو تصديق أنَّ رواية أو مُسَلسلاً أو فيلمًا يُمكن أن يؤثِّرَ فكريًا أو يُغَيِّرَ قناعات المشاهدين، لكنَّ الشواهد على ذلك كثيرة، ويُمكن هنا يُقَدَّمَ هذا الأنموذج كعينة على ما يُمكن أن تُحدِثَهُ المُخرجات والمُنتجات الفكريَّة المُمْتِعَة على عقولِ وعقائدِ المُتَلَقِّينَ لها. فمن أشهر الأفلام، وهو في أصله رواية خياليَّة (Fiction) كتابه دان براون (Dan Brown)، فيلم شيفرة دافينشي (The Da Vinci Code)، هذا الفيلم الخيالي الممتع أَحْدَثَ هَزَّةً هائلةً في الأوساطِ الدينيَّةِ المسيحيَّةِ، يصعب معها تصور أو استيعاب كيف أنَّ روايةً أو فيلمًا قد ينجح في هَزِّ قناعات شريحة واسعة من المؤمنين المسيحيين، وأن يشَكِّكَهم في إيمانهم؟ وهذا ما دَفَعَ رجال الدين المسيحيين من الطوائف المسيحيَّة المختلفة إلى تحريم مشاهدة الفيلم ومهاجمته صاحب الرواية. يقول الكاردينال الكاثوليكي تارسيزيو بيرتوني (Tarcisio Bertone) وزير خارجيَّة الفاتيكان: “لا تقرأوا ولا تشتروا شيفرة دافنشي”. ويقول الأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك: “شاهدتُ الفيلم مع مجموعة من أهل العلم والنقد لفنون السينما، وأعلن بصراحة وأمانة أنَّه فيلمٌ شيطانيٌّ ملعونٌ بِكُلِ المقاييس، الفيلم يحاول هدم العقيدة المسيحية من أساسها، أي شيطان وراء هذا العمل؟ وأي فكرة جهنميَّة تريد أن تغزو العقول البريئة والبسيطة؟”. وقد تَحَدَّثتُ عن أثر هذا الفيلم على المسيحيَّة في مقالة مستقلة بعنوان: (المسيحيَّة: من شيفرة دافينشي إلى كتاب Zealot)، يُمكن الرجوع إليها.
الملاحظة الثانية عشرة: قولبة الأفكار وجعلها طبيعيَّة: تَكْمُنُ خطورة تأثير الأفكار حين تنتقل الأفكار الجديدة والغريبة إلى حالة طبيعيَّة بواسطة (Normalization)، ثم تتطوَّر داخل المجالِ الفكريِّ والثَّقافيِّ، فتأخذ شكلاً أكثر عُمْقًا وبساطةً ورسوخًا من أجل أنَّ تُلَبِّي حاجة عَقْلِيَّة لدى عامَّة النَّاس، تلك الحاجة تَتَمَثَّلُ في القولبة الفكريَّة (intellectual molding) أو التنميط، وذلك لأنَّ العقل بطبيعته يحب وضع الأشياء والأشخاص في قوالب، فالقولبةُ سلوكٌ بشريٌّ، يتم استخدامه من قِبَلِ صُنَّاعِ الأفكار بمهارةٍ عاليةٍ، حيث يتم وضع الشخصيَّة في قالبٍ معينٍ بلغة سهلة ومُباشرة، لِيُجَسَّدَ في هيئة (ساخر، تافه، شرير، أو طيب، خَيِّر، مُتَقدِّم، متسامح، معتدل)، لتنميط تصورات النَّاس عنه، وكذلك الأمر نفسها تجاه الأفكار، فيتم وضع الفكرة التي يُراد القضاء عليها أو نشرها في قالبٍ مُعَيِّن (مثلاً: فكرة راقية وحضاريَّة، أو فكرة مُتَخَلِّفَة تجاوزها الزمن). وهذه الاستراتيجيَّة تتجاوب بل توظِّف عَمِلَ أغلب عقول الخلق، لميل الفئة الأعظم من النَّاس إلى التبسيط، فعدم القولبة تستدعي التفصيل، والتفصيل نوعٌ من التعقيد لا يرتاح له -وربما لا يقوى عليه- معظم النَّاس. وعلماء الأفكار يقرِّرون أنَّ العقلَ لا يعمل بدون مرجعيَّة، ولذلك فالعقل عند معظم النَّاس يقوم بإدخال الأفكار أو الشخصيَّات -الذين يريد أن يتخذ تجاههم موقفًا- في نظامه في إطارٍ محددٍ أو في قالبٍ بسيطٍ يجعل من السهل عليه تصنيفها. والغرض من التصنيف سهولة التَّعَرُّف عليها، ومن ثم الحكم عليها تبعًا للقالب الذي تَمَّت صناعته، فالإنسان غالبًا ما يريد معرفة وتحديد حقيقة الأفكار والشخصيَّات التي حوله أو سمع عنها، هل هي مع أو ضد. وكلما ضاق أفق المُصَنِّف زادت بساطة القوالب التي يمتلكها، ولا يمكن أن يرتاح بوجود شخصٍ مستعصٍ خارج عن قوالبه التصنيفيًّة، ومن هناك يأتي صُنَّع الأفكار ويُقَدِّمون المساعدة اللازمة في صناعة هذه القوالب وجعلها بسيطة وواضحة، يسهل على عقول عامَّة النَّاس فهمها ومن ثَمَّ قبولهم وتبنيها، فإذا ما التصقَت هذه التصورات بالأفكار وتلازمت، فإمَّا أن تكون الملازمة حسنة فحينئذٍ يكفي الإشارة إليها لفظة مُفردة للدلالة على حُسنها، وإمَّا أن تكون الملازمة قبيحة فحينئذٍ يكفي الإشارة إلى تلك الفكرة لإهدار أي قيمة لها. ويجب الانتباه إلى أنَّ القوالب إذا شاعت وقُبِلَت أصبح من العسير تغييرها أو تبديلها، فالإنسان يحب أن يرتاح في تصوراته التي تمنحها له هذه القوالب، وأي تغيير لها يسبب له إزعاجًا كبيرًا.
وهكذا يتم تقديم الأفكار إلى النَّاس وتثبيتها في العقول، من خلال عدة مستويات، تبدأ بعرض الفكرة، بصورة تدريجيَّة إيجابية، ثم يتم تكرار هذا العرض حتى تصبح الفكرة مقبولة، ومن ثَمَّ تصير فكرة طبيعية (Normalization)، والوصول إلى هذا المستوى من عمليات التفكير يعد إنجازًا ناجحًا واختراقًا متقدمًا في (حرب الأفكار)، فإذا ما صارت طبيعيَّة، يتم الانتقال لمرحلة أكثر عمقًا، لضمان بقاء الفكرة ثابتة ومهيمنة لأطول فترة ممكنة، وذلك من خلال، ليس فقط عرضها المتكرر، بل بتبسيطها وتنويعها، بحيث يتم تحولها إلى قالبٍ فكريٍّ يتحكم في الصور الذهنيَّة للمُتَلَقِّي وأَحكامها، وفق نظريَّة الاستجابة الشرطيَّة (Conditioned Response)، فترتبط لديه الصور المَصْنُوعَة بالأحكام الموضوعة لها، وكلما وردت عليه تلك الصور حضرت معها أحكامها الجاهزة (المُعَلَّبَة)، وهذا سيصبح أحكامه راسخة تجاه الأفكار المُحَدَّدَة بفضل القوالب الفكريَّة (التصورات) التي تمت صناعتها له، من خلال (التطبيع والقولبة).
الملاحظة الثالثة عشرة: القوة المادية تُضعف التفكير، وهو ما يُمكن أن يُعَبَّر عنه بـ(الصدمة الحضاريَّة)، حيث يكون للعمران والشاهق من البنيان والتَّقَدُّم المدني ما يُبهر النفوس ويأسر العقول، فيقفز الفكر عَبْرَ قياسٍ مُضَلِّلٍ إلى نتيجةٍ خاطئةٍ، ليقول إنَّ الحضارة هذه متقدمة عُمرانيًّا، ومن تَقَدَّم مثلها في هذا المجال تَقَدَّم في غيره، إذن هي مُتقَدِّمةٌ في بقيَّة المجالات، ومن ذلك في أخلاقها وآدابها. وهذا الجانب لا يُؤثِّر فقط على العوام الذين يُستَلبون عادةً بسبب الجانب المادي، بل أيضًا النخب الثقافيَّة والعلميَّة. تقول الكاتبة جورج إليوت (George Eliot): “لا يوجد مخلوقٌ تكوينه الداخليّ قويٌّ جدًا إلى درجةِ أنَّه لا يتحدد كثيرًا بما يوجد خارجه”.
ولهذا، من يدرس حالة الطَّبَقة المُثَقَّفَة في العالَم الإسلاميِّ، في القرنين التاسع عشر والعشرين، سيُلاحظ مدى وحجم الانبهار في عقول فئة من هذه الطَّبَقة، حملتهم على أن يقفزوا من الحُكم بتقدُّم الأمم الغربيَّة مادِيًّا إلى الحكم بتقدُّمهم معنويًّا، وتفاوت حجم استلابهم الفكريِّ (العقلي) بحجم انبهارهم الماديِّ (العاطفي)، واختلفت درجات تغير توجهاتهم الفكريَّة بحسب ما لديهم من الحصانة والقناعات. ومن هؤلاء: أبو طالب خان، وميرزا صالح، ورفاعة الطهطاوي، وإبراهيم شناسي، ونامق كمال، ومحمد بك الألفي، وخير الدين التونسي، وقاسم أمين.
ويكفي هنا أن تتأمل ما قاله المُبْتَعَث ”الشيخ والفقيه الأزهري” رفاعة الطهطاوي، عن باريس حين أقام فيها، يُقارنها ببلده مصر:
لقد ذكروا شموس الحُسْنِ طرَّا
وقالوا إنَّ مطلعها بمصر
ولكن لو رأوها وهـي تبـدو
بباريس لخصوها بذكر
وما قاله شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق، أثناء دراسته في باريس سنة ١٩٠٩م، حيث قال تحت الانبهارِ الماديِّ بتلك المدينة: ”باريس عاصمة الدنيا، ولو أنَّ للآخرة عاصمة لكانت باريس، وهل غير باريس للحور والولدان والنيران، والصراط والميزان، والفجار والصالحين، والملائكة والشياطين”.
إنَّ وطأة التمدنِ الماديِّ في أوروبا، في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت شديدة جدًا حتى على بعض فقهاء المسلمين وعلمائهم وشيوخهم. وهكذا، فإنَّه يجب الانتباه إلى سُنَنِ التَّغَيُّر، فإنَّ البنيان والعمران أشد تأثيرًا وقهرًا لعقول ونفوس العامة وبعض الخاصَّة من الأفكارِ، فأكثر النفوس تهزها الصروح الماديَّة أكثر من الصروح الفكريَّة. وحينما يتفاوت البنيان بين أرضِ المُفَكِّرِ وأرض المِثَال، وتزداد الفجوة الحضاريَّة والماديَّة بينهما، ينحاز المُفَكِّرِ المُسْتَلَب ماديًّا إلى أرضِ المِثَال فكريًّا، ويتماها مع حضارة ليست حضارته، ولغة ليست لغته، وأمة ليست أمته، ويشعر بالعار والخجل كُلَّما حَدَّقَ بعينيه في حال أمته، ولم يُقَدِّم إلى أمته سوى المديح في الأمم الأخرى والذم في أمته. يقول التنويري التركي إبراهيم شناسي (١٨٧١م): “عبرتُ أراضي الكُفَّار، فرأيتُ مُدنًا وقُصورًا، وتجولت في مملكة الإسلام، فلم أر سوى الأنقاض”.
إنَّ الهزيمة الماديَّة عادةً تولد انكسارًا داخليًّا وهزيمة نفسيَّة، وذلك بدوره يولد هزيمة عقليَّة، ثم تكون المحصلة النهائيَّة لتلك الهزائم والانكسارات النفسيَّة والعقليَّة المتتابعة هزيمة روحيَّة إيمانيَّة، تُفْقِدُ اليقينيات جاذبيتها وحَيَويَّتها، وتُنْتِجُ في قلبها الشُّكُك، لكنَّها تَشْكِيكَات قد يرغب بها صاحبها، لأنَّها تمثل له أرضيَّة ضروريَّة لبناءِ قناعاتِهِ الجديدة، فالهزيمة النفسيَّة العقليَّة الروحيَّة قد مَهَّدَت الطريق في قلبه وعقله للتخلي عن أفكاره واستقبال أفكارٍ جديدةٍ ملائمة لمرحلة ما بعد الانكسار!
إنَّ الفكرة (وإن كانت ماديَّة) لا تؤثر في طريقة تفكير العقل إلا إذا أحدثت في النفس انبهارًا يورث فيها انكسارًا، حينها تكون قادرة على هدم ما قبلها من الأفكار الموجودة في العقل، وستصبح جاهزة للبناء على الأنقاض السابقة. إنَّ تصور العقل لدى الأذكياء والعقلاء آلة قويَّة في مَنَعَةٍ من الذوبان والضعف أمام الأفكار القويَّة أو الضعيفة، هو تصورٌ خاطئٌ لأنَّه مبنيٌّ على أساسِ أنَّ العقلَ لديه استقلالٌ حقيقيٌّ وحصانةٌ ذاتيَّةٌ، ينظر إلى الأشياء بموضوعيَّة وعلميَّة. تقول كاثلين تايلر (Kathleen Taylor)، عالمة علم وظائف الأعضاء والتشريح وعلم الوراثة في جامعة أكسفورد “إنَّ تصوير العقول بأنَّها صلبة وكامنة؛ صورة مضللة. فالعقول أشبه بالطين اللين منه بالألماس، لسنا نحن البشر أشخاصًا مستقلين استقلالاً حازمًا يمكن بناءً على عقلانيتنا التي لا يمسها خلل تقرير كثير من العواقب. إنَّ البشر يُشَكَّلُون إلى درجةٍ كبيرةٍ بفعل الظروف الاجتماعيَّة، خاصة الأفكار التي نستمدها من مجتمعاتنا والمشاعر التي نحيطها بها، نحن نقلل من أهميَّة مدى التغيير الذي تحدثه حتى الصور البسيطة من التأثير في طريقة تفكيرنا وتصرفنا”.
الملاحظة الرابعة عشرة: لا تلازم بين قوة الفكرة أو ضعفها وبين بقائها، فكثيرٌ من الأفكار، الجيدة والرديئة، الحقيقيَّة والزائفة، لا يعتمد بقاؤها على قوتها الذاتيَّة أو ضعفها، فالبقاء والانقراض لا يعود إلى الفكرة ذاتها فقط، بل إلى من يحملها ويؤمن بها، وإلى سياقات الواقع وإمكاناته. فحين يضعف أصحاب فكرةٍ ما، وهي فكرة جيدة وإيجابيَّة، ويتوقفون عن حملها والدفاع عنها، تصبح ضعيفة ومشوهة، ويصورها خصومها -عمدًا أو خطأً- في غاية الرَّكاكة والبساطة. وفي المقابل، فإنَّ كثيرًا من الأفكار الساذجة والركيكة في نفسها، تغدو برَّقة ومغرية حين يوجد من يحملها ويدافع عنها. وقد يعمد الخصم الذي يمتلك فكرةً ضعيفةً ويريد إحلالها محل الفكرة القويَّة إلى خَلقِ حالةٍ من الوهم والتضليل لأصحاب الفكرة القويَّة، بتصويرها أنَّها فكرة هزيلة وضعيفة، وغير صالحة للبقاء، ولا بد من تركها واستبدالها. كذلك هناك عوامل أخرى كثيرة تتحكَّم في بقاء أو اضمحلال الأفكار بعيدًا عن صحتها وقوتها وسلامتها، ولهذا يقول الباحث الفرنسي المعاصر رودي ريتشتاد: “إنَّ الفكرة الليبرالية القائلة: بـ(أنَّ الأطروحات الأكثر صحة والأكثر عقلانية تنتصر في نهاية المطاف على الأطروحات المزيفة وتزيحها على نحوٍ طبيعي)، فكرة تتعارض مع الواقع، بل إنَّ العكس هو ما يحدث، فأشد الأفكار غرابة ترفض أن تموت”.
الملاحظة الخمسة عشرة: التفكير السليم والإيجابي هو التفكير المُنتج، الذي يعود عليك بالنفع والصحة النفسيَّة، ويُنتج العمل الجيد. لكنَّ الاستغراق في التفكير كثيرًا دون توجِّهٍ مُحَدَّدٍ وترتيبٍ للأفكار يحوله إلى تفكيرٍ سلبيٍّ (دوامة الحيرة والتردد)، فليس كل أمرٍ بسيط يجب أن نغرق في التفكير فيه، وكما يقول بيت كوهين (Pete Cohen): “التفكير الزائد عن الحد يمكن أن يعوقنا عن التمتع بحياتنا، فحديث النفس والتحليل الدائم يمكن أن يغشى على حواسنا”. فالتفكير الزائد عن الحَدِّ في أيِّ شيءٍ هو مثل أن تحفر حفرةً وأنت فيها، وكلما ازددتَ في الحفر جعلت خروجك من تلك الحفرة أصعب. إنَّ الحياة قصيرة، فلا تعود نفسك المكوث كثيرًا عند كل الأشياء تفكر فيها، فكثير من الأشياء يجب أن تدعها تمر وتدعها ترحل، والتمسك بها يعيق حياتك العمليَّة الواقعية، فتفكير الذي لا ينتهي سوف يعزلك عن العَالَم، ويسجنك في تلك الأفكار التي توجد في عقلك فقط، ولهذا يجب أن تُمَيِّزَ بين الأفكار التي يجب أن تقف عندها بعمق، والأفكار التي تقف عندها سريعًا، والأفكار التي تُعْرِض عنها منذ لحظتها الأولى، فإنَّه لا توجد آلة أخطر من أن تعمل على نفسها بشكلٍ مستمر مثل العقل، لأنه سيقوم بعملية تدميرٍ ذاتيٍّ. وبواسطة الإخفاقات والخيبات أو الأفعال الخاطئة والممارسات السيئة والمنحرفة، يُقادُ العقلَ إلى نوعٍ من التفكير المُتَأزِّم السلبيِّ المريض (=الدَّوامة)، يجد المُصَابُ به نفسه عاجزة عن الخروج من أسره. يقول الكاتب البريطاني كولن ولسن (Colin Wilson) واصفاً توماس إدوارد لورنس (Thomas Edward Lawrence) المعروف بلورنس العرب: “كان يفكر أكثر مما يجب، ولم يكن قادراً على الكف عن التفكير، وقد جرده هذا التفكير من كل مفاهيمه المباشرة عن العَالَم، وجعله غير قادرٍ على تجربة أي كائنٍ آخر غير نفسه، فصار سجيناً في عقله”. ويسوق كولن ولسن الكلام أيضًا إلى الشاعر آرثر رامبو (Arthur Rimbaud)، الذي يَنْطَبِقُ عليه الوصف نفسه، حيث مَرَّ الاثنان بأزمة مُتشَابِهَةٍ وتجارب وخبرات خاطئة، قادتهما إلى هذا النوَّع من التفكير المُتَأزِّم.
كيف نُمَحِّصُ الأفكار؟
إذا عَلِمنا تلك الملاحظات السابقة، وكيف تعمل الأفكار في تغيير القناعات وتصنع التَّصَوُّرات، نأتي هنا إلى سؤالٍ مهمٍ: كيف نتعلم نقد الأفكارِ وتَمحيصها؟
بدايةً، يجب أن يُقال بِكِلِّ وضوحٍ أنَّ ذلك ليس بالأمر السهل، وإنَّما يحتاج إلى جُهْدٍ ووعيٍ ودُربَةٍ وتعَودٍ، حتى يصير ذلك عادة ومَلَكة في الإنسان، فالعادات الإيجابية والسلبيَّة لا يُولد الإنسان بها فقط، بل يتعلمها ويكتسبها، وإذا كَرَّرَها وأدمن عليها صارت عادة له، وجزءًا من طريقة تفكيره، ومنهجيَّة راسخة في التعامل مع الأفكار الجديدة.
ولعل هذه الخطوات المُخْتَصَرَة تُقَرِّب الطريقة التي يحسن العمل وِفْقَها تجاه الأفكار الجديدة الواردة:
(1) المعرفة والعلم: وجود الخَلفيَّة العلميَّة المعرفيَّة الثقافيَّة، العامَّة أو الخاصَّة في المجال المعرفي المُحَدَّد، أمرٌ له الأهميَّة القصوى، ولا يُمكن الاستغناء عنه، فالعلم والمعرفة أهم أداة كاشفة ومَيِّزة تُمَكِّن صاحبها من فَحْصِ الأفكارِ ونقدها. ولهذا فمن الطبيعي أن تُلاحظ رواج الأفكار الجديدة الخاطئة والمُضَلِّلَة على الجهلة، بشكلٍ عامٍّ أو في التَّخَصُّص المُحَدَّد، فذلك أمرٌ في غاية السهولة، وهو مُلاحظ ومعروف ومنتشر جدًا، فالجهلُ أرضٌ خصبةٌ وخَاليةٌ، تُسْتَزرع بأيِّ شيءٍ، ومن جاء إليها أولاً وَضَعَ فيها بذوره وزَرَعَ فيها أشجاره. ويُمكنك أن تُدرك فداحة الجهل وخطورته، وسرعة انتشار الأفكار الخاطئة والمُضَلِّلَة بسببه، بملاحظة وسائل التواصل فقط، وخصوصًا (WhatsApp)، وكيف تنتشر المعلومات الدينيَّة والطبيَّة الصحيَّة المُزَيَّفة، وغيرها من المعلومات الأخرى، ولا يُشارك الأُمْيُّ والجَهَلةُ في ذلك فقط، بل يُشاركهم بعض المتعلِّمين، بل وحَمَلَة الشهادات العليا، الذين يُساهمون في نشر الوعي الزائف والمعلومات المغلوطة، في غير تَخَصُّصاَتِهم.
(2) القياس والاستنباط: العلميَّة المعرفيَّة السابقة ضروريَّة في فحص ونقد الأفكار، فهي تُولِّد بطبيعتها معرفةً أخرى، وهي القدرة على (القياس والاستنباط)، فحتى لو لم تكن لديك معلومة مباشرة أنَّ تلك الفكرة خاطئة ومشكوك فيها أو صحيحة وموثوق بها، فإنك قد اكتسبت مهارة (القياس) بما لديك من خلفيَّة علمية تُساعدك على ذلك. فأصبحت تعرف، بشكلٍ أوَّليٍّ أنَّ مصدر هذه المعلومة الجديدة (وكالة أنباء أو قناة أو كتاب أو كاتب أو مؤسَّسة أو موسوعة…إلخ)، ليس ثقة أو يحتاج إلى توقفٍ وفَحْصٍ، وذلك لأنَّك قد جرَّبْتَ ذلك من قبل، فأصبحت لديك خبرة سابقة تستطيع من خلالها أن تقيس عليها وتستنبط من ذلك نقدًا أوَّليًّا يحميك من سلطان الفكرة الجديدة.
(3) التوقفُ والفَحْصُ الذَّاتيُّ للأفكارِ: عند وُرودِ فكرةٍ جديدةٍ مُفْرَدَةٍ ومباشرةٍ، يجب حينها عدم الاسترسال في تلقيها، (=قَبولها أو رفضها)، دون فَحْصِ حقيقتها (مضمونها)، ونقد حجتها (دليلها). فلا بُدَّ من التَّأكُّدِ أولاً هل هذه المعلومةُ الجديدةُ المُفْرَدَةُ دعوى مجردة؟ أي أنَّها مُجَرَّد تقريرٍ لمعلومةٍ بلا دليلٍ ولا برهانٍ؟ (=خالية من الدليل السمعي أو العقلي أو الطبيعي، ومن أيِّ مصدرٍ علميٍّ مُعْتَمدٍ وموثوقٍ)، فهذا المعلومة أو الفكرة (الدعوى) لا قيمة لها ما لم يُثبتها الدليل والبرهان، ولا حاجة إلى تطويل الكلام حولها. أما إذا كنت الدعوى (معلومة/فكرة) مَصْحُوبة “بحُجَّتِها”، فلا بُدَّ من فَحْصِ تلك الحُجَّة. فإن كان الدليل شرعيًا سمعيًا فلا بد من أمرين: صحته وتمامه (ثوبته وثبوت الشاهد منه)، وسلامة معناه المُراد إثباته. فقد يصح الدليل (يكون ثابتًا)، لكنَّ المعنى الذي يُراد إثباته غير صحيح، فلا تلازم بين ثبوت الدليل وصحة الدعوى، فالدليل قد يكون ثابتًا لكنَّ الدعوى باطلة، لاقتطاع الدليل وبتره، أو لخطأ في الاستدلال. كذلك قد لا يثبت الدليل الواحد، ولا يعني ذلك انتفاء المعنى الصحيح الذي يدل عليه، لأنَّه قد ثبت بأدلة أخرى، وهنا يجب التمييز بين صحة الدليل ثبوتًا وصحة المعنى الذي يُدعى أنَّه يدل عليه. أما إن كان الدليل عقليًّا فلا بد أن يكون صريحًا واضحًا ومقبولاً، وليس مُجَرَّد دعوى أو هوى (=عقله هو)، والعاقل يعلم أنَّ ما يدل عليه العقل الصحيح الصريح لا يأتي مُعارضًا للشرع الثابت، وقد قال ابن تيميَّة: “ما عُلم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة؛ بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملتُ ذلك في عامة ما تَنازع النَّاسُ فيه، فوجدتُ ما خالف النصوصَ الصحيحةَ الصريحةَ شبهاتٍ فاسدةً يُعلَم بالعقلِ بطلانها؛ بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع…والقول كلما كان أفسد في الشرع، كان أفسد في العقل، فإنَّ الحقَّ لا يتناقض”. أما إن كان الدليل طبيعيًا فلا بد أن يكون حقيقة علميَّة، وليس نظريَّة فضلاً أن تكون فَرَضِيَّة. إنَّ قوة الإيمان أساسها وأصلها قوة المبدأ الذي يقوم عليها ذلك الإيمان، ثم قوة وسلامة التفكير الذي يُعطي هذا الإيمان حقه. قال الله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ). قال الحافظ ابن كثير: “إَّنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنَّه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفاتِ الكمالِ المنعوتِ بالأسماءِ الحسنى، وكلما كانت المعرفة به أتم، والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر”.
ومن أَخطَرِ السلوكيات الخاطئة في البحث العلميِّ والقراءة المعرفيَّة، أن تَمُرَّ الدعاوى (المعلومة/الأفكار) بالمُتَلَقِّي ومعها أدلتها، دون أن يُمَحِّصَها وينقدها، فإنَّها بتكرار ذلك تَتَرَسَّخُ في عقله وتصبح حقائق ثابتة يصعب إزالتها، فقد تكون تلك الدعاوى (المعلومة/الأفكار) تستند إلى “حُجَجٍّ” مُزَوَّرَة أو مُشَوَّهة أو مُقْتَطَعَة، أو غير ثابتة، أو مجرد فرضيات أو نظرات لم تكتمل بعد، لكنَّ المُدَّعِي يسوقها أمام المُتَلَقِّي كأنَّها حقائق سليمة لا غُبَار عليها، فَكُلُّ مُدَّعٍ يطلب إقناع غيره بدعواه، وأنَّ ما قدمه عبارةٌ عن حُجَجٍ وبراهين. ولعلَّ من الأمثلة النظريَّة والعمليَّة الجيدة في مثل هذا السياق، ما كان يفعله ابن قَيِّم الجوزيَّة مع أستاذه وشيخه ابن تيميَّة، مما جعل شيخه ينصحه نصيحة قال عنها ابن قَيِّم الجوزيَّة: “ما أعلم أني انتفعتُ بوصيِّةٍ في دفعِ الشبهاتِ كانتفاعي بذلك”. ويشرح ابن قَيِّم الجوزيَّة تلك القصة، فيقول: “قد جعلتُ أورد عليه [=ابن تيميَّة] إيرادًا بعد إيراد”. يقصد أنَّه أخذ يعرض الشبهات واحدة بعد واحدة، فأوقفه شيخه ابن تيميَّة ليعلمه قبل الجوابِ العلميِّ على آحاد تلك الشبهات، الجواب المنهجي المُتَمَثِّل في فَحْصِ الأفكارِ وتمييزِها من خلال العلم الصحيح. فقال له: “لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته”. ثم يقدم ابن تيميَّة هذا التوجيه المنهجي والتحذير المحوري، فيقول: “إذا أَشربتَ قلبكَ كُلَّ شبهةٍ تمرُ عليه؛ صارَ مقراً للشبهاتِ”.
ولهذا يُؤكِّدُ المختصون والخبراء في مجال نقد الأفكار، ومنها (الشبهات)، أنَّ الإنسان إذا علقت في قلبه شبهةٌ ما فيجب عليه عدم تركها وإهمالها لأشغاله الأخرى، لأنها حينئذٍ قد تتمكن من عقله وقلبه فتضله، بل عليه التوقف فورًا عن كل شيءٍ، وليجعل همته كلها منصبة نحو اقتلاع تلك الشبهة الواحدة، من خلال البحث بنفسه إن كان مؤهلاً، أو بالرجوع لأهل العلم والتخصص، لأنَّ الاستهانة والاستهتار بتلك الشبهات في بدايتها يُشبه كرة الثلج الصغيرة، إذا تركتها تَدَحْرَجَت داخل عقلك وتفكيرك، وسوف تكبر وإن كانت بطيئة، كالطوفان الجارف، أو كالمارد القابع في أعماقك، يعيش في الظِّلِ وقد لا تُحِسُّ بوجوده، ثم يخرج من قُمْقُمِهِ فجأة في أيِّ لحظة. وما يصدق على الأفراد يصدق على الجماعات والمؤسَّسات، فطبيعة عمل الأفكار في هذه المساحات كلها غالبًا أنَّها بطيئة لكنَّها فَعَّالة، تقوم تدريجيًّا بالحلول مكان الأفكار السابقة وإزاحتها عن مكانها، وكما يقول فريدرك نيتشه (Friedrich Nietzsche): “انقلاب الأفكار لا يليه مباشرة انقلاب المؤسَّسات, فالأفكار الجديدة تسكن ولوقتٍ طويلٍ بيت الأفكار السابقة المقوض, لا بل تُعنى به إذ ليس لها مكان تنام فيه”. ولهذا فإنَّ مراقبة ونقد وفحص المعلومات والأفكار الأولى ليس فقط عادة علميَّة حميدة، بل ضروريَّة، لأنَّها تُكسب صاحبها مَلَكَة نقديَّة، ولياقة معرفيَّة، وقوة في التفكير، تمنحه التمييز بين الأفكار الجيدة والرديئة.
(4) فَحْصُ الأفكارِ بالاستعانة بخيبرٍ ومُتَخَصِّص: الفَحْصُ الذاتيُّ يعتمد على علميَّة الشخص نفسه أو قدراته البحثيَّة الخاصَّة في استقصاء تلك المعلومة أو الفكرة، ومن ثَمَّ نقد ما تستند إليه، لو لم تكن لديه الخلفيَّة اللازمة لنقدها وقتَ ورودها إلى عقله. ولأنَّ المُتَلَقِّي -بطبيعة الحال- لن يكون عالمًا في كُلِّ مجالٍ، وربَّما لا يكون مُتَخَصِّصًا في مجالٍ واحدٍ، ولذلك فمن المتوقع أنَّه سيصعب عليه البحث بنفسه، لعدم امتلاكه أدوات البحث والفحص في التَّخَصُّصَاتِ الأخرى، عن دِقَةِ تلك الدعوى (المعلومة/الفكرة) المتعلقة بقضية أو فكرةٍ خارج مجاله، ولأجل ذلك، ومن باب احترام التَّخَصُّصَاتِ، فلا بُدَّ أن يَلجأَ إلى المُتَخَصِّصِ العَالِمِ والثِّقَة في مجال الدعوى، أو أكثر من واحدٍ، لِيَفْحَصَها وينقد دليلها، ويُبَيِّنَ حالها ومدى علميتها وصحتها، فيدفع عن نفسه الأفكار الخاطئة والضالة، قبل أن تصير حقائق ثابتة بالنسبة إليه، وتلك هي (مُدافعة الأفكار) وعدم الاستسلام لها والجمود عند كُلِّ واردٍ جديدٍ أو قديمٍ. يقول ابن قَيِّمِ الجَوْزِيَّة: “دَافع الخَطرة، فإن لم تفعل، صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل، صارت شهوة، فحاربها، فإن لم تفعل، صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدفعها، صارت فعلاً، فإن لم تتداركه بضده، صار عادةً، فيصعب عليك الانتقال عنها”. ومما يحسن التنبيه له في هذا المقام خطورة ذلك الطرح الشائع الذي يعيب -باسم الاستقلال في التفكير-الرجوع لأهل الخبرة التخصص، فالعاقل -مهما اتسع عقله وفهمه-يدرك محدودية علومه ومعارفه، فلذلك لا يجد غضاضة في الاستعانة بغيره فيما لم يحط به، ولا يترفع عن هذا النهج العقلاني الناضج إلا من قلَّ إدراكه، أو تعاظم غروره.
(5) تمييزُ مُسْتَوياتِ المعلومات والأفكار: من الأمور الضَّروريَّة أن يكون المُتَلَقِّي على وعيٍ بمستويات المعلومات والأفكار التي تتعلَّق بالعلوم والمعارف، فهناك: حقائق (إثبات)، وهناك شكوك (نفي). والحقائق درجات، فهناك حقائق راسخة أثبتتها الأدلة والبراهين، وهناك نظريات علميَّة تفسيريَّة تدعمها جزئيًّا حقائق ولا تزال في تطورها، وهناك فَرَضِيَّات تحت الفَحْصِ والاختبار. ولكلِّ واحدةٍ من تلك المستويات الموقف الذي يُناسبها، من التسليم والقبول أو الترجيح أو التوقف والفحص. وهناك أيضًا الشكوك، فالشكوك درجات، فهناك شك يستند إلى دليل، وهناك شك يستند إلى قرينة، وهناك شك لا يستند إلى شيءٍ. ولكلِّ واحدٍ من تلك الشكوك الموقف الذي يُناسبه، فالذي يقف معه الدليل الصحيح يُقبَل، والذي معه القرينة يُفحَص ويُمَحَّص، والذي بلا دليلٍ ولا قرينة لا يُلتَفَتُ إليه، فلا قيمة له.
هذا فيما يخص العلوم والمعارف عمومًا، أما فيما يتعلق بالإيمان، فإنَّ الشكوك التي تلتبس بالقرائن أو الشبهات، قد تعرض للمؤمن، فكون المسلم معه إيمان لا يعني امتناع ورود الشبهات والشكوك عليه، لكنَّ المؤمن بطبيعته المسئولة واليقظة، وبما معه من إيمانٍ وعلمٍ، ينقدها ويدفعها عنه، ولا يجمد أو يستسلم لها ويخضع لسلطانها. يقول ابن تيميَّة: “المؤمن…تعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه، فإن هذا لا بُدَّ منه”.
أما الشكوك المُجَرَّدة والخواطر العابرة التي تعرض للمؤمن تجاه ربه أو علاقاته، فهي في حقيقتها وَسْوَسَة، وأفضل سبيلٍ لطرد الوَسَاوِس هو التوقف عنها والانصراف عن الاشتغال بها، وعدم الاسترسال معها، لأنَّ الاسترسال مع هذا النوع من الشكوك (=الوساوس) هو في الحقيقة المُغَذِّي لها، وهو الطاقة اللازمة التي بها تحيا وتنمو وتكبر وتتضخم. فالإنسان إذا صنع في عقله من الوهم (=الوساوس) تصورًا، أو قَبِلَ بفكرة زائفة خطرت له ثم استرسل معها، فسوف تستعبده، وسيُحاكم بناءً عليها ليس فقط نفسه بل من حوله، وستخلق في تفكيره صورًا سلبية عن النَّاس (=سوء الظن بهم)، وستجعله يخافهم أو يُشَكِّك فيهم، ليخضع لهذه الأفكار التي صنعها بنفسه دون أن يشعر!
ويجب أن يُدرك الإنسان المؤمن أنَّه لا أحد من النَّاس يسلم من هذا النوع من الوَسْوَسَة، لكنَّ المؤمن العاقل لا يندفع خلف سرابٍ لا محصل من ورائه، ولا يسترسل وراء أوهامٍ لا حقيقة أو فائدة تعود منها، بل يفعل كما أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال: “يَأْتي الشَّيْطَانُ أحَدَكُمْ فيَقولُ: مَن خَلَقَ كَذَا، مَن خَلَقَ كَذَا، حتَّى يَقُولَ: مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ باللَّهِ ولْيَنْتَهِ“. رواه الإمام البخاري في صحيحه. وقال ابن تيميَّة: “وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس…بل متى فَكَّرَ العبدُ ونظر؛ ازداد ورودها على قلبه، وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه، كما يعجز عن حَلِّ الشبهة السوفسطائية“.
اقرأ ايضًا: ضياع البوصلة والتبدد في عوالم المعرفة