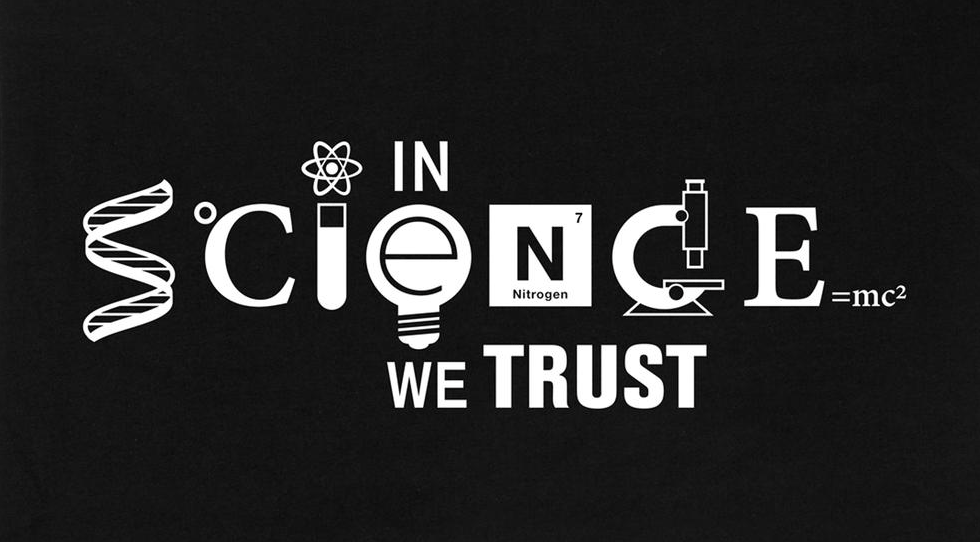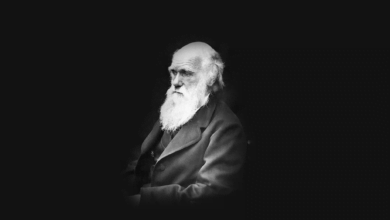- سوزان هاك1
- ترجمة: زينب بنت فؤاد عبد المطلب
- تحرير: آسية الشمري
“لا بد أن يكون الإنسان قد بلغ درجة عالية من الجنون ليُنكر أن العلم قد حقق العديد من الاكتشافات الحقيقية”
– سي إس بيرس (1903) 2
“تُوظِّف العلموية مكانة العلم بهدف التنكر والحماية”
-إيه إتش هوبز (1953) 3
العلم شيء جميل، ومنذ قرون ماضية، وعندما كان “العلم الحديث” في مهده، تنبأ فرانسيس بيكون بأن عمل العلوم قد أنار لنا الطريق، وقدم لنا مجموعة متنامية من المعارف عن العالم وطريقة سيره، وأثمر لنا القدرة على التنبؤ بالعالم والتحكم فيه بطرق أدت إلى إطالة حيواتنا وتحسينها، كتب بيكون عن العلم “كأنه قاضي القضاة” 4 أو “كأنه مروّج” أو “مسوّق”، ويبدو أنه كان أكثر وعيًا بفضائل العلم من وعيه بمحدوديته وأخطاره المحتملة.
بيد أن العلم ليس مستحسنًا بإطلاق، العلم -كجميع المشاريع البشرية – قابل للخطأ وغير كامل بشكل لا يمكن تغييره، وفي أحسن الأحوال، يكون تقدمه غير مترابط وغير متوازن ولا يمكن التنبؤ به؛ وعلاوة على ذلك، فإن كثيرًا من الأعمال العلمية تفتقر إلى الخيال أو بالأحرى مبتذلة، وبعضها ضعيف أو غير مبال، وبعضها خاطئ تمامًا، وغالباً ما تنطوي الاكتشافات العلمية على احتمالية الضرر بالغير بجانب الفائدة التي تقدمها، والمعرفة قوة -كما اعتقد بيكون – ويمكن إساءة استخدام القوة. والعلم ليس الشيء الوحيد الخيّر، وليس هو الشكل الوحيد المقبول للبحث. هناك العديد من الأنواع القيمة الأخرى للنشاط البشري إلى جانب البحث -الموسيقى، الرقص، الفن، رواية القصص، الطبخ، البستنة، الهندسة المعمارية، على سبيل المثال لا الحصر؛ والعديد من أنواع البحث القيّمة الأخرى: التاريخية والقانونية والأدبية والفلسفية، إلخ.
كما أشرتُ عند تسمية كتاب5 (Defending Science – Within Reason) بعنوان فرعي: بين العلموية والسخرية Between Scientism and Cynicism ، نحتاج إلى تجنب كل من: التقليل من قيمة العلم، والإفراط في تقديره. ما قصدته بكلمة “السخرية” في السياق كان نوعًا من الموقف النقدي المستهجِن للعلم، وعدم القدرة على رؤية أو عدم الرغبة في الاعتراف بإنجازاته الفكرية الرائعة، أو إدراك الفوائد الحقيقية التي أتاحها. وما قصدته بكلمة “العلموية” هو القصور النقيض: هذا النوع من الحماسة المفرطة والموقف التفضيلي غير الناقد تجاه العلم، وعدم القدرة على رؤية أو عدم الرغبة في الاعتراف بقابليته للخطأ، ومحدوديته، ومخاطره المحتملة. جانب ينحّي العلم بتسرّع؛ ينصاع الآخر له بتسرّع. حاليًا أنا بصدد الحديث عن القصور الأخير بالطبع.
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة “العلموية” لم تكن دائمًا -كما هي الآن-ازدرائية. ففي منتصف القرن التاسع عشر – بعد فترة قصيرة من الاستخدام الأقدم والأوسع لكلمة “علم”، حيث يمكن أن تشير إلى أي مجموعة منظمة من المعرفة بغض النظر عن موضوعها، فإن مجال الاستخدام الحديث الأضيق يجعلها تشير إلى الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها، دون فقه القضاء والتاريخ واللاهوت وغيره 6-كانت كلمة “العلموية” محايدة، وتعني ببساطة “عادة وأسلوب تعبير رجل العلم”، ولكن بحلول العقود الأولى من القرن العشرين، بدأت “العلموية” تتخذ نبرة سلبية؛ كان هذا التغيير استجابة للأفكار الطموحة حول كيفية تغيّر فهمنا للسلوك البشري إذا قمنا فقط بتطبيق الأساليب التي أثبتت نجاحها في العلوم الفيزيائية؟.7 وبحلول منتصف القرن العشرين،صار يُنظَر إلى العلموية على أنها “تحيُّز،”8 “خرافة،”9 “انحراف” للعلم.10 هذه النبرة السلبية هي السائدة الآن؛11 في الواقع، أصبحت الدلالات الإزدرائية لـ “العلموية” راسخة تمامًا لدرجة أن المدافعين عن استقلالية الأخلاق، أو شرعية المعرفة الدينية وغيرها، يعتقدون أحيانًا أنه من الكافي وبدلاً من الانخراط فعليًا في حجج منتقديهم، رفضها بكلمة واحدة: “علموي”.
لذا، كما يُستخدم مصطلح “العلموية” حاليًا، وكما سأستخدمه، فإن حقيقة اللفظ البديهية هي أنه ينبغي تجنب العلموية. و السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو:ما الذي يجب تجنبه؟متى ولماذا يكون احترام العلوم مناسبًا؟ ومتى ولماذا يكون غير مناسب أو مبالغًا فيه؟ هدفي الأساسي هنا: هو اقتراح بعض الطرق لمعرفة متى تم تجاوز هذا الخط؟، متى تحول احترام إنجازات العلوم إلى نوع من الاحترام المبالغ فيه للعلموية. هذه هي “علامات العلموية الست” التي يشير إليها عنواني. بشكل مختصر وتقريبي، وهي:
- استخدام كلمات “علم” و “علمي” و “علميًا” و “عالم” وما إلى ذلك، بشكل فخري، كمصطلحات عامة للمديح المعرفي.
- اعتماد أساليب العلوم وتأطيرها للمعرفة ومصطلحاتها الفنية … إلخ، بغض النظر عن فائدتها الحقيقية.
- الانشغال بترسيم الحدود بين العلم الحقيقي والعلوم الحقة وبين المحتالين أصحاب العلم الزائف.
- الانشغال المماثل بتحديد “المنهج العلمي”، الذي يفترض أنه يفسر النجاح المدوي للعلوم.
- التطلع إلى العلوم للحصول على إجابات لأسئلة خارج نطاقها.
- إنكار أو الإساءة إلى شرعية أو قيمة الأنواع الأخرى من البحث باستثناء العلمي، أو التقليل من قيمة الأنشطة البشرية -عدا البحث العلمي- مثل الشعر أو الفن.
سأتناول هذه العلامات الست تباعاً، أحاول دائمًا، إبقاء العلاقات المتبادلة بينهم على مرأى البصر، والإشارة إلى الأفكار الخاطئة التي يعتمدون عليها حول العلوم، وتوجيه الخط الدقيق جدًا أحيانًا بين النبذ الصريح للعلموية، ونبذ العلم خلسة. وبعد ذلك – بالاستفادة من الفرصة التي توفرها آخر علامات العلموية هذه – سأعلق بإيجاز على بعض التوترات بين الثقافة العلمية المعاصرة والتقاليد الأقدم التي حلت محلها الآن جزئيًا على الأقل في معظم أنحاء العالم.
- الاستخدام الفخري لـمصطلح “العلم” وما يقاربه
على مدى القرون العديدة الماضية، أثرت أعمال العلوم وصقلت معرفتنا بالعالم بشكل كبير. ومع تنامي مكانة العلوم، اتخذت كلمات مثل “علم” و “علميًا” وما إلى ذلك نبرة فخرية، حيث يقفز إلى الذهن مباشرة معناها التقديسي، وتحتل دلالاتها الإيجابية مركز الصدارة. ويتباهى المروّجون لهذه الفكرة عادةً بأن “العلم” أظهر تفوق منتجهم، أو أن “الدراسات العلمية” تدعم ادعاءاتهم. فغالبًا ما يتم رفض العلاجات الطبية التقليدية أو غير التقليدية تمامًا؛ ليس لأنها غير صحيحة أو غير مختبرة، ولكن باعتبارها “غير علمية”. وإزاء شكنا في بعض الادعاءات، لن نسأل “هل هناك أي دليل جيد على ذلك؟” بل “هل هناك أي دليل علمي على ذلك؟” حتى وصل الأمر إلى أننا أصبحنا بحاجة إلى صياغة اختبار لمساعدة القضاة على تحديد ما إذا كانت شهادة الخبراء موثوقة بدرجة كافية ليتم قبولها أم لا، حيث تقترح المحكمة العليا الأمريكية أن هذه الشهادة يجب أن تكون “معرفة علمية”، يتم الحصول عليها من خلال “المنهج العلمي.”12 ويتتابع المؤرخون -مثلًا- على القول بأنه لا أساس لفكرة استعارة الفلسفة اليونانية القديمة من المصريين القدماء، ويصفون هذه الفكرة بأنها “غير علمية”.13 كما تتناول عناوين المؤتمرات والكتب “العلم والعقل” 14 كما لو أن العلوم احتكرت العقل ذاته. تصف مقالة افتتاحية حديثة في صحيفة “وول ستريت” دراسات المدارس المستقلة حيث يتم اختيار الطلاب من خلال القرعة على أنها “علمية وأكثر موثوقية” من دراسات المدارس التي تختار طلابها على أساس الجدارة.15 ومن هنا نرى أن الاستخدام الفخري واسع الانتشار.
وبطبيعة الحال، أصبحت مصطلحات “العلم” و”العلمي” مصطلحات فخرية، حيث يقلق الممارسون بشأن مكانة تخصصهم أو نهجهم ويفضلون استخدامها بشكل توكيدي ومتكرر. قدم البروفيسور هوبز عام 1953 قائمة رائعة لمقتطفات من تعريف الناشرين التسويقي بنصوص علم الاجتماع ونجد فيها: “نهج علمي”‘ “يواجه مشاكل الزواج بطريقة علمية”، “يتعامل مع المشاكل الاجتماعية من وجهة نظر علمية … [واستنتاجاته] لا غبار عليها”، وإنه نموذج “علمي صارم”؛ وهكذا دواليك16. وفي الوقت الحاضر – على الرغم من أن أقسام الفيزياء والكيمياء لا تشعر بالحاجة إلى التأكيد على أن ما تقوم به هو علم – تقدم الجامعات محاضرات ودرجات علمية في “علم الإدارة” و 17 “علم المكتبات”، و “العلوم العسكرية” وحتى “علم الجنائز”.18
لكن هذا الاستخدام الفخري لـمصطلح “العلم” وما يقاربه يؤدي إلى مشاكل عديدة، فهو يجعل من السهل نسيان أنه: على الرغم من أن إنجازات العلوم الطبيعية كانت رائعة، فليس فقط العلماء هم الباحثون الجيدون والصادقون، وليس كل العلماء باحثين جيدين صادقين، كما أنه يغرينا برفض العلم الزائف بعدم اعتباره علمًا على الإطلاق؛ ويغوينا لنؤمن بالافتراض الخاطئ بأن كل ما ليس علمًا ليس جيدًا، أو أنه أدنى منه بأي حال. نعم، أفضل عمل علمي هو إنجاز معرفي إنساني ملحوظ. ولكن حتى هذا العمل العلمي الأفضل غير معصوم من الخطأ، وهناك الكثير من العمل الجيد والجاد في التخصصات غير العلمية مثل التاريخ والمنح القانونية ونظرية الموسيقى وما إلى ذلك – ناهيك عن الكم الهائل من المعرفة المفيدة عمليًا التي تراكمت من قبل المزارعين، البحارة، وبناة السفن، والحرفيين من كل نوع، والمصادر العظيمة في العلم بالأعشاب، وما إلى ذلك، الواردة في الممارسات الطبية التقليدية.19
ومن المؤكد أن الاستخدام الفخري لكلمة “العلم” يشجع على سرعة التصديق غير الناقدة بشأن أي فكرة علمية جديدة تظهر في المشهد. لكن الحقيقة هي أن جميع الفرضيات التفسيرية التي توصل إليها العلماء هي – في بادئ الأمر- تخمينية للغاية، وقد وُجد أن معظمها في النهاية غير مقبول، وتم التخلي عنها. من المؤكد أنه يوجد الآن قدر كبير من النظريات العلمية المثبتة جيدًا، وبعضها مثبتة جيدًا لدرجة أنه سيكون من المدهش أن تظهر أدلة جديدة تثبت أنها خاطئة – وحتى هذا الاحتمال لا ينبغي استبعاده تمامًا. (الدوغمائية الصارمة دائمًا ما تكون غير مرغوب فيها من الناحية المعرفية، وذلك يتضمن الدوغمائية الصارمة حتى حول أفضل النظريات العلمية المثبتة.)20 لكن هذه المجموعة الهائلة من النظرية المثبتة جيدًا هي البقية الباقية من مجموعة أكبر بكثير من الفرضيات التخمينية، والتي استحال معظمها إلى لا شيء – وهي حقيقة لا بد من أن يحجبها عنا ربط كلمة “علمي” بشكل تبادلي إلى حد ما مع “موثوق، مثبت، ومحكم” وما إلى ذلك.
- الزخارف العلمية المستعارة بصورة خاطئة
إلى جانب تشجيع الاستخدام الفخري لمصطلح “العلم” وما يقاربه، فإن نجاحات العلوم الطبيعية قد دفعت الكثيرين أيضًا إلى استعارة طرائق وزخارف هذه المجالات على أمل أن يظهروا “علميين” كما لو كانت المصطلحات التقنية والأرقام والرسوم البيانية، والجداول والأدوات الفاخرة، وغيرها، كافية بحد ذاتها لضمان النجاح. عندما كتب فريدريك فون هايك عن “الاستبداد” الذي قامت “أساليب وتقنيات العلوم بممارسته على مواضيع أخرى”21 كان يفكر في جهود علماء الاجتماع لكي يظهروا بقدر الإمكان مثل الفيزيائيين -على الرغم من اختلاف مواضيع بحثهم جذريًا. ومن المؤكد أن هناك شيئًا علمويًا مرفوضاً حول تبني الزخارف المرتبطة بالفيزياء والكيمياء وغيرها، ليس كأدوات مفيدة قابلة للتحويل، ولكن كستارة دخانية تخفي تفكيرًا ضحلًا أو بحثًا نصف مكتمل. حتى أولئك الذين يعملون في تخصصات لن يتردد أحد في تصنيفها كعلوم يركزون كثيرًا على الشكل ونادرًا ما يركزون على الجوهر. مثلًا يقوم مختص علم الأوبئة باختبار الآثار الجانبية لعقار الغثيان الصباحي بحساب دقيق للدلالة الإحصائية لنتائجه، لكنه يفشل في التمييز بين النساء اللائي تناولن الدواء أثناء فترة الحمل عندما كانت أطراف الجنين تتشكل من اللواتي تناولنه لاحقًا،22يقوم آخر بإرفاق جداول حالات تبدو رائعة، ولكنه لا يتحقق مما إذا كانت المعلومات الواردة في الجداول تتطابق مع المعلومات الواردة في النص.23
لكن هذا النوع من إساءة استخدام الأدوات والتقنيات العلمية يكون أكثر شيوعًا في العلوم الاجتماعية، و – تبعًا لروبرت ميرتون – فغالبًا ما يستخدم الممارسون إنجازات الفيزياء كمعيار للتقييم الذاتي، “إنهم يريدون فرض المقاربات الفيزيائية على أخواتها الأكبر حجمًا” 24 إن الفصول التمهيدية المطولة حول “المنهجية” في نصوص علم الاجتماع هي في بعض الأحيان مجرد منظر خادع. وفي كثير من الأحيان- أكثر مما قد يرغب المرء به – تركز الرسوم البيانية والجداول والإحصاءات في العمل الاجتماعي العلمي الانتباه على المتغيرات التي يمكن قياسها على حساب تلك التي تهم حقًا، أو تقدم متغيرات غير محددة بوضوح بحيث لا يمكن استخلاص أية نتيجة معقولة منها. يعتبر القانون الثاني للسلوك الإجرامي لديفيد أبراهامسون مثالًا تقليديًا: فـ “الفعل الإجرامي هو مجموع الميول الإجرامية للشخص بالإضافة إلى وضعه الإجمالي، مقسومًا على مقدار مقاومته أو: “C = (T + S) / R.”25 لقد ساهم الطابع الرياضي الحاد للنظرية الاقتصادية المعاصرة في الفكرة الغريبة القائلة بأن الاقتصاد هو “ملك العلوم الاجتماعية” – وهو لقب يبدو أن لعلم النفس 26 شرعية أكبر بادعائه. ولكن في كثير من الأحيان، يتبين أن هذه النماذج الرياضية الأنيقة تستند إلى افتراضات حول “الإنسان الاقتصادي العقلاني” وهو الأمر الذي لا ينطبق على أي فاعلين اقتصاديين في العالم الحقيقي.27 وللأسف، غالبًا ما تكتسب توصيات السياسة المستندة إلى إحصائيات اجتماعية خاطئة أو نماذج اقتصادية خاطئة مكانة غير مستحقة عندما يُنظر إليها على أنها “قائمة على أساس علمي.”
إن الزخارف العلمية المستعارة بشكل غير سليم شائعة أيضًا في الفلسفة، حيث تبنت العديد من المجلات والناشرين ممارسات مثل: أسلوب التوثيق المكون من الاسم والتاريخ ورقم الصفحة الذي يستخدمه علماء النفس وعلماء الاجتماع وغيرهم، وتفضيلهم للتواريخ الأحدث بدلاً من التواريخ الأصلية (غالبًا ما يكون مضللاً حتى في مجاله الخاص، و مضللاً أكثر في تخصص يكون فيه الاعتماد على المصدر في غير محله تمامًا، ويكون كارثيًا عندما يكون التطور التاريخي لفكرة ما مهمًا). حتى إعطاء الأولوية للمنشورات الخاضعة لمراجعة الأقران، وهي ممارسة أخرى تسربت من العلوم إلى الفلسفة، وهي نوع من العلموية؛ لأن مراجعة الأقران بالكاد تكون محكمة كأداة تقنين حتى بالنسبة للمساحات النادرة في المجلات العلمية، 28 وهي بطبيعتها أكثر عرضة للفساد كلما زادت هيمنة الجماعات والأحزاب والمدارس على مهنة مثل الفلسفة.29 وبالطبع، في الفلسفة كما في العلوم الاجتماعية، غالبًا لا تكون المصطلحات التقنية – كما يمكن ويجب أن تكون – علامة مصاغة بعناية على التقدم الفكري الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، بل المصطلحات المتبجحة فقط المصممة لجذب الآخرين هي التي تكون على شاكلة “ما يطلبه المشاهدون” 30
لا شيء من هذا ينكر، فإن فالأدوات والتقنيات العلمية تكون مفيدة حقًا للباحثين في مجالات أخرى: يستخدم المؤرخون المسرّع الدوراني لتحديد ما إذا كان تكوين الحبر في نسختين مطبوعتين سابقًا من الكتاب المقدس هو نفسه المستخدم في “إنجيل غوتنبرغ” من 1450 إلى عام 1955، 31 يستخدمون تقنيات تحديد الحمض النووي لاختبار الفرضية القائلة بأن توماس جيفرسون كان والد الأطفال المولودين من أمته سالي همينجز؛ 32 إضافة استعارة أجهزة تصوير طبية لتمييز آثار الكتابة على “البطاقات البريدية” التي أرسلها الجنود الرومان إلى ديارهم من العلامات التي خلفتها قرون من التجوية؛33 كما تستخدم جنرال موتورز نموذجًا صممته مراكز السيطرة على الأمراض لتتبع “وباء” الخلل في سياراتها وشاحناتها،34 وهلم جرا. ما هو علموي ليس مجرد استعارة الأدوات والتقنيات العلمية في حد ذاتها، بل استعارتها -كما هي- للاستعراض بدلاً من الاستخدام الجاد.
- الانشغال بـ “إشكالية الفصل”
بمجرد أن يصبح مصطلح “علمي” مصطلحًا فخريًا، و تخفي الزخارف العلمية النقص في الدقة الحقيقية يكون من الحتمي- تقريبًا – أن تلوح في الأفق “إشكالية الفصل”: أي تحديد الخط الفاصل بين العلم واللاعلم، ومشكلة تحديد واستئصال “العلم الزائف” أكثر مما ينبغي.
ليس مستغربًا، مع بدء الاستخدام الفخري لمصطلح “العلم” في العقود الأولى من القرن العشرين، تزايد الانهماك بمسألة الفصل في الحركة الوضعية المنطقية (حيث كان الموضوع الرئيسي لها هو الفصل بين العمل العلمي المجدي تجريبيًا وبين التكهنات الميتافيزيقية الرنّانة التي لا معنى لها)، وظهر الأمر بشكل أكبر في فلسفة العلم لكارل بوبر.35 اقترح الوضعيون إمكانية التحقق كعلامة على الجدوى التجريبية، لكن بوبر قلب هذا رأسًا على عقب؛ حيث قال أنه لا يوجد عدد محدد من الأمثلة الإيجابية يمكن أن تثبت يقينًا أن قضية ما صحيحة، فمثال واحد مضاد يكفي لتفنيدها، ومن هنا اقترح بوبر قابلية التزييف أو قابلية التخطئة أو (كما يقول أيضًا) قابلية الدحض كمعيار لترسيم الحدود بين ما هو علمي وما هو غير علمي. 36 وفقًا لبوبر، يمكن أن تخضع النظرية العلمية الحقيقية لاختبار التجربة، وإذا كانت خاطئة، يمكن إثبات أنها خاطئة، بينما النظرية التي لا تستبعد أي شيء ليست نظرية علمية على الإطلاق.
يبدو هذا بسيطًا بما فيه الكفاية. ولكن في الواقع، لم يتضح ما هو معيار بوبر بالضبط، ولا ما يُعنى باستبعاده بالضبط، أكثر ما يخص السياق الحالي، ما هو بالضبط – إلى جانب الاستخدام الفخري لـ “العلم” – الدافع وراء الرغبة في معيار الفصل في المقام الأول، أصبح الأمر غير واضح بشكل متزايد. على سبيل المثال، بدا الأمر في البداية كما لو أن بوبر كان ينوي استبعاد “الاشتراكية العلمية” الماركسية، جنبًا إلى جنب مع نظريات التحليل النفسي لفرويد وأدلر، باعتبارها غير قابلة للدحض. لكن في كتابه The Open Society and Its Enemies (1945) أقر بوبر أن الماركسية قابلة للدحض، وقد تم ذلك بسبب أحداث الثورة الروسية.37 فلم يكن خطأً اعتبار النظرية غير قابلة للدحض، ولكن الماركسين أجروا تعديلات عاجلة عليها لإنقاذها بدلاً من التخلي عنها في مواجهة الأدلة المخالفة؛ لذا فقد تم تحويل ما يفترض أن يكون معيار بوبر المنطقي إلى اختبار منهجي جزئيًا، وهو اختبار يعتبر العلم الذي يُتوصل إليه بشكل خاطئ ليس علمًا على الإطلاق.
مرة أخرى: ادعى بوبر لفترة طويلة أن معياره للفصل يستبعد نظرية التطور، وهي تبعًا لذلك ليست نظرية علمية حقيقية، ولكن “برنامج بحث ميتافيزيقي.”38 ثم عدل عن رأيه فقال: أن التطور علم، في نهاية المطاف.39 ومرة أخرى -متحولاً بهدوء من الكتابة عن قابلية الدحض كمعيار لما هو علمي إلى الإيحاء بأنها معيار لما هو تجريبي- أقر بوبر أن تصنيف “علم زائف” لا يشمل فقط العلوم الزائفة، ولكن أيضًا مجالات بحثية شرعية ولكنها غير تجريبية مثل الميتافيزيقا والرياضيات.40 وبمرور الوقت تلاحظ أنه يصف معياره بأنه “تقليد”41 ففي مقدمة الطبعة الإنجليزية من كتاب “منطق الكشف العلمي” The Logic of Scientific Discovery، كتب أن المعرفة العلمية متصلة بالمعرفة التجريبية اليومية، 42 وبالكاد تستطيع تجنب استنتاج أن الفكرة البسيطة التي بدأ بها أصبحت أقرب إلى المسخ الفكري.
مما تبين بعد ذلك، يبدو أن معيار بوبر للفصل أثبت أنه جذاب جدًا للكثيرين، وبشكل جزئي لأنه غير متبلور- أو بالأحرى متعدد الأشكال – بما يكفي ليبدو أنه يخدم مجموعة كاملة من الأجندات: مثل مصلحة المحاكم الفيدرالية في التمييز بين الشهادات العلمية الموثوقة و “العلوم غير الهامة”، 43 أو في تحديد ما إذا كانت “نظرية الخلق” علم حقًا، ومن ثم يمكن تدريسها بموجب الدستور في المدارس الثانوية العامة.44 وقد تم اقتراح معايير أخرى، فالعلم الحقيقي يعتمد على التجارب المضبوطة، على سبيل المثال (لا يستبعد الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع فقط، ولكن أيضًا – وهو الأمر الذي يصعب تصديقه – علم الفلك). في اعتقادي إن أفضل ما قد نأمله، هو قائمة تتضمن “علامات على العلمية” التي لن تتشارك جميع العلوم في أي منها، ولكن يمكن العثور على كل منها بدرجات متفاوتة في بعض العلوم. الحقيقة هي أن مصطلح “العلم” ليس له حدود واضحة للغاية: دلالة المصطلح غامضة وغير محددة ومتنازع عليها كثيرًا.
هذا لا يعني أننا لا نستطيع التمييز بين العلوم والأنشطة البشرية الأخرى، ولكن هذا يعني أن أي تفريق من هذا القبيل لا يمكن إلا أن يكون تقريبيًا ومحدودًا. كتقريب أولي يمكنني القول أن أفضل فهم للعلم، لا يكون باعتباره مجموعة من المعارف، ولكن باعتباره نوع من البحث (بحيث لا يكون طهي العشاء أو الرقص أو كتابة رواية علمًا، أو المرافعة في قضية أمام المحكمة). ثانيًا، نظرًا لأن كلمة “علم” أصبحت مرتبطة بالبحث في موضوع تجريبي، فإن التخصصات الصورية مثل المنطق أو الرياضيات البحتة لا تتأهل كعلوم، ولا التخصصات المعيارية مثل القضاء أو الأخلاق أو علم الجمال أو نظرية المعرفة. وثالثًا، لنُقر أن العمل المختار بوصفه “علم” بعيد عن أن يكون موحدًا أو متجانسًا. فمن المنطقي أن نقول أنه من الأفضل التفكير بالتخصصات التي نطلق عليها “العلوم” على أنها تشكل اتحاد فضفاض لأنواع البحث المترابطة.
ولكن إذا أردنا الحصول على رؤية واضحة لمكانة العلوم بين أنواع البحث العديدة، ومكانة البحث بين أنواع النشاط البشري العديدة، والعلاقات المتبادلة بين مختلف التخصصات التي يصنفها العمداء وأمناء المكتبات على أنها علوم، سنحتاج إلى البحث عن الاستمرارية و الاختلاف؛ فهناك صلات ملحوظة بين (ما يُسمى) بالعلوم “التاريخية” مثل علم الكونيات وعلم الأحياء التطوري، وبين ما نصنفه عادةً بأنه بحث تاريخي. لا توجد حدود قاطعة بين علم النفس وفلسفة العقل، ولا بين علم الكونيات والميتافيزيقا.45 ولا يوجد أي خط واضح جدًا بين مجموعة كبيرة جدًا من المعارف التي نشأت من أنشطة بشرية بدائية مثل الصيد والرعي والزراعة وصيد الأسماك، والبناء، والطبخ، والمداواة، والقبالة، وتربية الأطفال… إلخ، وبين المعارف الأكثر انتظامًا للمهندسين الزراعيين، وعلماء نفس الأطفال… إلخ.46
يتصل البحث العلمي بأنواع أكثر ألفة وأقل منهجية من البحث التجريبي، كالبحث في أسباب تلف المحاصيل، وتصميم قوارب الصيد، والخصائص الطبية للأعشاب، وما إلى ذلك. صحيح أنه أكثر منهجية وتنظيما ودقة، وثباتًا، ولكنه في بعض الأحيان يعيد اكتشاف المعارف التقليدية ويبني عليها، فمثلًا: عالم النبات لينيوس الذي اعتمد على التصنيفات المرحلية التقليدية للنباتات والحيوانات، 47 أو كما تم اشتقاق العديد من الأدوية – التي هي الآن جزءًا من ترسانة الطب العلمي الحديث – من ما كان في الأصل علاجات شعبية، (كالديجيتال digitalis )المستخرج من نبات يسمى القِمَعية أو قفاز الثعلب: استُخدِم كعلاج شعبي لفترة طويلة، وسمي الديجيتال لأول مرة في عام 1542،وقد وصف خصائصه السريرية لأول مرة ويليام ويذرنغ عام 1785، وبحلول منتصف القرن العشرين كانت شائعة الاستخدام من قبل الأطباء لعلاج أمراض القلب.48
يُمكّننا إظهار الدافع إلى ترسيم الحدود في الرؤية البوبرية: بأنه يجب على النظرية أن تستثني شيئًا ما، وبألا تكون متوافقة تمامًا مع أي شيء وكل شيء قد يحدث على حقيقته، بكونه علامة تفسيرية حقًا لا بكونه علامة على علمية النظرية. ويمكن تلَمحُ الاستعداد لأخذ الأدلة المخالفة على محمل الجد : أي ليس على أنه سمة -كما يفترض بوبر- على العالِم تحديدًا، بل علامة على الباحث الصادق في أي مجال. (المؤرخ الذي يتجاهل أو يتلف مستندًا يهدد بتقويض فرضيته المفضلة يكون مذنباً بنفس نوع التضليل الفكري مثل العالم الذي يتجاهل أو يفشل في تسجيل نتائج تجربة تهدد بإبطال نظريته). “العلموية” كما يلاحظ هايك بذكاء تخلط بين “الروح العامة للبحث النزيه” وأساليب ولغة العلوم الطبيعية .49
كما أن قمع الدافع التفريقي له تأثير صحي يتمثل في إلزامنا بالاعتراف بالعلوم التي يتم تنفيذها بشكل سيء على أنها علم سيئ التنفيذ، وفي تشجيعنا على تحديد الخطأ الدقيق في العمل الذي ننتقده بدلاً من مجرد الاستهزاء بـ “العلم الزائف” : قد يكون غامضًا للغاية بحيث لا يمكن أن يكون تفسيريَا حقيقيًا، وقد يستخدم الرموز الرياضية أو الرسوم البيانية أو الأدوات الفاخرة إلا أنها تزيينية بحتة ولا تؤدي أي عمل حقيقي، وقد يقدم الفرضيات التي هي مجرد تخمينات بثقة كما لو كانت مثبتة بالأدلة، وهلم جرا. إذا كان استخدامنا لمصطلح “العلوم الزائفة” متاحًا فقد يكون من الأفضل أن نحتفظ به للإشارة إلى ممارسات علنية مثل حركة علم الخلق، (حركة) يالها من كلمة كاشفة! والتي لا تتضمن في الواقع أي بحث حقيقي من أي نوع.
- السعي إلى “منهج علمي”
إن الانشغال بترسيم الحدود يشجع فكرة أن البحث العلمي الحقيقي – الأداة الحقيقية – تختلف عن أنواع الأبحاث الأخرى بحكم أسلوبها أو إجرائها الفعال الفريد: كالمنهج العلمي المفترض، فنحن لا نزال بحاجة إلى أن نتوصل إلى اتفاق حول ماهية المنهج المفترض بالضبط. وقد اقتُرِحت مجموعة من المرشحين المختلفين وغير المتوافقين:ابتداءً من أشكال مختلفة من الاستقراء (من نسخة أقدم وأقوى يتوصل العلماء وفقًا لها إلى فرضياتهم عن طريق استقراء الحالات المرصودة إلى الإصدارات الأحدث والأضعف التي يتوصل العلماء وفقًا لها إلى الفرضيات من خلال عملية توصف بأنها تخيلية أكثر من كونها استنباطية، ثم يتم اختبارها بشكل استقرائي)، وانتهاءً بأشكال مختلفة من الاستنباط (مفهوم بوبر للمنهج العلمي كمسألة “تخمين ودحض”، بإجراء تخمين معقول، واستنتاج عواقبه، ثم محاولة تخطئته، وتمييز إمري لاكاتوش شبه البوبري، وتفريق “ما بعد كون” بين برامج البحث الرجعية مقابل التقدمية)؛ ومؤخراً، مقاربة بايز، ونظرية القرار… إلخ.
وبحلول عام 1970، توصل بول فييرابند إلى استنتاج جوهري مفاده: أن المبدأ المنهجي الوحيد الذي لن يعيق تقدم العلم هو أن “كل شيء مباح”.50 واقترح فلاسفة علم آخرون – بطريقة أكثر عقلانية -أنه لا يوجد منهج علمي ثابت، إنما تتبدل الطريقة وتتغير مع تقدم العلم، فلا وجود لمنهج علمي واحد، بل طرق علمية مختلفة في مجالات علمية مختلفة. لكن عالِم فيزياء رصين وضع إصبعه على النقطة الأساسية منذ عام 1949 فقد كتب بيرسي بريدجمان: “هناك الكثير من الجلبة حول المنهج العلمي” ، كما لاحظ بذكاء”الأشخاص الذين يتحدثون كثيرًا عنه هم الأشخاص الذين لا يفعلون شيئا حياله.” وتابع أنه لا يوجد عالم عامل يسأل نفسه ما إذا كان “علميًا” أو أنه يستخدم “المنهج العلمي”، لا، “إنه منشغل تمامًا بالعكوف على النقاط الأساسية ليكون على استعداد لقضاء وقته في العموميات.”51 “نظرًا لأنه منهج،” يعلق بريدجمان: بأن المنهج العلمي هو مجرد ” أن يفعل المرء أعجب ما عنده بعقله، لا توجد قيود.”52
هذه الملاحظات المنطقية صحيحة تمامًا، أي باحث تجريبي جاد-بغض النظر عن موضوعه – سيقدم تخمينًا منطقيًا كتفسير محتمل للحدث أو الظاهرة التي تحيره، ويكتشف عواقب هذا التخمين، ويرى إلى أي مدى تصمد هذه النتائج مع الدليل الذي يملكه وأي دليل آخر يمكن أن يضع يديه عليه، ثم يستخدم حكمه فيما إذا كان يجب التمسك بالتخمين الأول، أو تعديله، أو إسقاطه والبدء من جديد، أو الانتظار حتى يتمكن من اكتشاف دليل إضافي قد يوضح الموقف، وكيفية الحصول عليه. على مدى قرون من العمل، طور العلماء تدريجياً مجموعة من الأدوات والتقنيات لتوسيع وصقل القدرات المعرفية البشرية والتغلب على قيود المعرفة البشرية: تقنيات الاستخراج والتنقية، إلخ، وأدوات المراقبة من المجهر والتلسكوب إلى الاستبيان؛ التقنيات الرياضية من حساب التفاضل والتكامل إلى الإحصاء على الحاسوب وحتى التنظيمات الاجتماعية الداخلية التي – إلى حد ما، وإن كانت إلى حد معين فقط- توفر حوافز للعمل الجيد والخيالي والصادق، ومثبطات للإهمال والغش.53
الإجراءات الأساسية لجميع البحوث التجريبية الجادة – تجربة إفتراض ما، ثم التحقق منها 54 – لا يستخدمها العلماء فقط، ولا يستخدم جميع العلماء، “المساعدات” العلمية في البحث -والتي يتم تكييفها وتحسينها باستمرار- غالبًا ما تكون محلية في مجال معين من العلوم. لذلك لا يوجد “منهج علمي” يستخدمه جميع العلماء وفقط العلماء. و بعيدًا عن الإيحاء بأن تمكن العلوم الطبيعية من “تحقيق العديد من الاكتشافات الحقيقية” مجرد لغز، فإن هذا المنهج يقترح تفسيرًا معقولًا لكيفية تمكنهم من صقل وتضخيم وتوسيع القدرات الإدراكية البشرية المجردة تدريجيًا، كما أنه يلقي بعض الضوء على ما إذا كانت العلوم الاجتماعية تستخدم نفس منهج العلوم الطبيعية بالفعل، أو تستخدم منهجًا مميًزا خاصًا بها، سيتبع البحث العلمي الاجتماعي النمط الأساسي لجميع الأبحاث التجريبية الجادة على( نمط البحث العلمي الطبيعي )، وسوف يستفيد – مثله – من التنظيمات الاجتماعية الداخلية بدلاً من تشجيع العمل الجيد والصادق والشامل، وتثبيط الغش، وسيحتاج إلى العديد من الأدوات والتقنيات الخاصة التي من المرجح أن تكون مختلفة جدًا عن الأدوات والتقنيات الخاصة الأكثر فائدة في العلوم الطبيعية.55
- التطلع إلى العلوم للحصول على إجابات لأسئلة خارج نطاقها
هناك العديد من الأسئلة التي تقع ضمن نطاق واحد أو أكثر من التخصصات المصنفة تقليديًا كعلوم والتي لا توجد إجابات لها حتى الآن. (هذا هو السبب في أن سرعة تصديق التكهنات العلمية الحالية، حتى التكهنات الواهية والتي لم يتم اختبارها بعد، هي في حد ذاتها علامة على العلموية.) هناك أيضًا العديد من الأسئلة داخل نطاق العلوم التي لا يمكن حتى طرحها -كما كان سابقًا – قبل التعرف على الحمض النووي والعمل بمفهوم الجزيء الضخم،56 فالأسئلة حول بنية ووظيفة الحمض النووي التي نعرف إجاباتها الآن لم تكن ممكنة جدًا. ومع ذلك، فإن كل هذه الأسئلة تدخل بوضوح في نطاق التخصصات المصنفة تقليديًا على أنها علوم؛ والتطلع إلى العلوم التي تجيب عليها أمر صائب تمامًا. ولكن هناك أيضًا العديد من الأسئلة المشروعة خارج نطاق العلوم تمامًا: الأسئلة القانونية، والأدبية، والمطبخية، والتاريخية، والسياسية، وغيرها والأسئلة الفلسفية التي سأركز عليها هنا.
فقد أثبتت بعض القضايا التي كانت تدخل في نطاق فلسفة العقل، أو نظرية المعرفة الإدراكية أنها قابلة للبحث من قبل علم النفس، والسؤال الميتافيزيقي المحير: “لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟” الذي تمت الإجابة عليه جزئيًا عندما عالج علماء الكونيات مشكلة (ما يسمونه) “تراكم المادة”. 57 مثل هذا التغير بالحدود ليس دائمًا أو بالضرورة علميًا، بل إنه غالبًا ما كان تقدمًا فكريًا حقيقيًا. ولكن عندما تُعتبر الإجابات العلمية التي تترك العناصر المركزية للأسئلة القديمة كما هي دون مساس على أنها كافية، فهذه هي العلموية.
غالبًا ما يكون لنتائج العلوم تأثير على أسئلة السياسة فقد يخبرنا علم البيئة عن عواقب إلحاق الضرر بهذا النهر، والعلوم الطبية عن أي مرحلة يصبح الجنين البشري قابلاً للحياة، والدراسات الاجتماعية العلمية عن عواقب تغيير الحوافز الضريبية بهذه الطريقة أو تلك، وإلغاء عقوبة الإعدام… إلخ. على الرغم من أن قدرًا كبيرًا من العمل العلمي وثيق الصلة بالسياسة، فإن البحث العلمي – إذا أريد له أن يكون بحثًا حقيقيًا، وليس ما يسمى بشكل متناقض “بحوث ترويجية” – محايد بالنسبة إلى السياسة.
لا يمكن لعلم البيئة – بمفرده – أن يخبرنا ما إذا كانت فوائد سدود الأنهار تفوق سلبياتها، وبالتأكيد لن يخبرنا ما إذا كان بناء السد فكرة جيدة، ولا تستطيع العلوم الطبية – بمفردها- أن تخبرنا ما إذا كان الإجهاض مقبولاً أخلاقياً (ولا بالطبع، ما إذا كان ينبغي السماح به قانونياً)، لا يمكن للاقتصاد، بمفرده، أن يخبرنا ما إذا كان ينبغي علينا تغيير النظام الضريبي بهذه الطريقة أو تلك. من المؤكد أنه سيكون لعلماء البيئة، وعلماء الاجتماع، وعلماء الاقتصاد…إلخ، على الأرجح آراء حول أسئلة السياسة التي تؤثر عليها أعمالهم العلمية؛ ومن المشروع تمامًا لهم التعبير عن هذه الآراء علنًا. لكن يحدث خطأ ما عندما يسمحون لقناعاتهم الأخلاقية أو السياسية بالتأثير على حكمهم على الأدلة، أو عندما يقدمون تلك المعتقدات الأخلاقية أو السياسية كما لو كانت نتائج علمية.
تطرح هذه الحجج البسيطة نسبيًا استنتاجًا بسيطًا: أن ثمرة العلوم يمكن أن تعطينا معلومات حول علاقة الوسائل بالغايات، لكن لا يمكنها أن تخبرنا ما هي الغايات المرغوبة. هذا صحيح، بقدر ما يكون ممكنًا، لكنه لا يكون ممكنًا بما فيه الكفاية. إنه يترك مسألة أعمق بكثير، فإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن أن يكون للنتائج العلمية أي تأثير على أسئلة الغايات المرغوبة ولا يتم التطرق لها. وفي هذا الصدد، أنا مع جون ديوي، الذي كتب إن :”استعادة التكامل بين معتقدات الإنسان التي تمس العالم الذي يعيش فيه ومعتقداته حول القيم والأغراض التي يجب أن توجه سلوكه هي المشكلة الأعمق في الحياة الحديثة” 58. إن فكرة أن العلم واقعي، و”خالٍ من القيمة” تمامًا، وغير وثيق الصلة تمامًا بالمسائل المعيارية= هي فكرة فجّة للغاية.
سأركز على الأخلاق ولنضع الأسئلة حول القيم المعرفية والجمالية وغيرها جانبًا، إن الأخلاق – كما أراها -ليست نظامًا مستقلاً وبدهيًا بالكامل، ولا مجرد فرع ثانوي من العلوم الإنسانية. (هذا نوع من الطبيعانية الأخلاقية المتواضعة، تغذيها فكرة أن ما هو جيد أو صحيح أن يقوم به البشر لا يمكن فصله تمامًا عما هو صالح لهم.) معرفة ما يتيح الازدهار البشري حقًا – المعرفة التي لا تقتصر المساهمة فيها على علم الأحياء ولكن تشمل علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد وغيره – على الرغم من أنه لا يكفي في حد ذاته لإخبارنا بما يجب علينا القيام به، إلا أنه يمكن أن يكون له صلة إسهامية بالمسائل الأخلاقية.
تقدم ورقة بحثية حديثة في ( مجلة لانسيت) مثالًا حيًا لمخاطر اللجوء إلى النتائج العلمية كما لو كانت كافية للإجابة على الأسئلة الأخلاقية. أطروحة مؤلفي البحث هي أن أفضل نظام من ناحية أخلاقية لتخصيص الموارد الطبية النادرة هو مبدأ “الحياة الكاملة”، الذي يعطي الأولوية لليافعين والشباب على حساب الرضع وكبار السن. ويستشهدون باستطلاعات استقرائية تُظهر أن “معظم الناس يعتقدون” أن وفاة يافع أسوأ من وفاة طفل رضيع.59 ضع جانبًا حقيقة أنهم يستشهدون بدراستين فقط، ولم تذكر أي منهما في الواقع ما يقترحه ملخصهما. 60 النقطة الأساسية هي أن “معظم الناس يعتقدون أن س هو الأفضل من الناحية الأخلاقية” في حين أن “س هو الأفضل من الناحية الأخلاقية” هي افتراضات مختلفة تمامًا. 61 يُعتبر الخلط بينهما علامة أكيدة على العلموية.
إن “الأخلاق التطورية” التي قدمها إي أو ويلسون تبدو كمثال أكثر تعقيدًا لنفس النوع من العلموية. يخبرنا ويلسون أن تعريف المشاعر الأخلاقية يقع في نطاق علم النفس التجريبي، ونطاق البحث في توريث هذه المشاعر في علم الوراثة، والبحث في تطور المشاعر الأخلاقية في الأنثروبولوجيا وعلم النفس،62 و “التاريخ العميق للمشاعر الأخلاقية” في علم الأحياء التطوري.63 إذا كان الإدعاء هو أن مثل هذه البحوث العلمية هي كل ما تتطلبه النظرية الأخلاقية، فمن المؤكد أنه خاطئ: فهو يستند إلى الفرضية غير المثبتة بأن الأخلاق يجب أن تُفهم من منظور المشاعر الأخلاقية؛ لا يخبرنا ما هي المشاعر التي تعتبر أخلاقية؛ وحقيقة بحد ذاتها (بافتراض أنها حقيقة) أن هذه المشاعر يمكن أن تُعطى تفسيرًا تطوريًا لا تُظهر في حد ذاتها أنها مرغوبة أخلاقياً أو أنها ليست كذلك، إنه نوع من العلموية.
لكن الأخلاق التطورية لويلسون هي أحد جوانب الصورة الأكبر لما يسميه “وحدة المعرفة”، وفهمه لهذه “الوحدة” غامض شائك. فهو – من جهة معينة – يبدو أنه يقدم أطروحة متواضعة مفادها أن كل المعارف يجب أن تنسجم مع بعضها البعض في كُلّ متماسك في النهاية (وهذا صحيح واضح)، في حين تبدو الأطروحة – من جهة أخرى – أن مفادها: أن كل المعرفة يجب أن تكون قابلة للإشتقاق من المعرفة العلمية في النهاية (وهي- في اعتقادي – غير واضحة وخاطئة). لذلك ليس مستغربّا – بعد أن اتضح أنه يشير إلى أن نتائج العلوم الأحيائية قد تكون كافية للإجابة على الأسئلة الأخلاقية – أن يستمر ويلسون في التساؤل عن كيفية تصنيف الغرائز الأخلاقية، وأيها يمكن إخضاعها بشكل أفضل؟ ما هي المبادئ الأخلاقية التي يتم دمجها بأفضل شكل في القانون والتي تقبل الإستثناءات؟، وما إلى ذلك .64 لنقر بأن علم الأحياء وثيق الصلة ولكنه ليس كافيًا في النهاية، والذي – أعتبرُه – مناسبًا، وليس علمويًّا، وقد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
- تحقير ما هو غير علمي
كتب ستيفن واينبرغ عن “نزع السحر” التدريجي عن العالم من خلال التقدم العلمي.65 وقد قدمت التطورات في علم الكونيات وعلم الأحياء التطوري تفسيرات طبيعية للظواهر التي كان يُعتقد في السابق أنها تتطلب تفسيرات خارقة للطبيعة، وأظهرت أن الأسئلة المتعلقة “بالتصميم”- سواء المتعلقة بالأعضاء مثل العين، أو بالكون عمومًا – تستند إلى افتراضات خاطئة. هذا الاعتراف ليس علمويًا من وجهة نظري[*]. ولكن من العلموية أن نتخيل أن التقدم فى العلوم سوف يحل فى النهاية محل الحاجة إلى أى نوع آخر من البحث.
غالبًا ما يكون الخط الفاصل بين الاحترام اللائق للعلم والانصياع الخاطئ خطًا رفيعًا.وليس من العلموية تثمين الدراسات التجريبية التي أحدثت تغييرات قانونية (على سبيل المثال، تأثير إلغاء عقوبة الإعدام على معدل القتل، أو آثار فرض حد أقصى على التعويضات التأديبية في دعاوى سوء الممارسة الطبية على عدد الأطباء الذين يجتمعون في ولاية ما). ومع ذلك، فمن المنطقي الافتراض أن الدراسات القانونية التجريبية الاجتماعية العلمية هي بطبيعتها أكبر قيمة من الدراسات القانونية التفسيرية التقليدية. وتعد خسارة حقيقة أن تعطي الجامعة أولوية للبحوث الطبية التي بإمكانها تحسين الصحة بشكل كبير على حساب الأبحاث الأخرى الأقل عملية، ليس لأنه لا يمكن التنبؤ بالعمل الذي سيكون له تطبيقات عملية مهمة فقط ولكن توقف الجامعات عن تقدير العمل الفكري الجاد بحد ذاته- بغض النظر عن الموضوع أو العائد المحتمل- خسارة.
على الرغم من أن قدرتنا على البحث هي موهبة بشرية رائعة -تتجلى بشكل لافت للنظر في العلوم، ولكنها غير مقتصرة عليها، فنحن البشر لدينا مواهب أخرى أيضًا: سرد القصص والغناء والرقص والرسم…وغيرها. (لقد قيل أن القدرة البشرية على الكلام – التي بدونها لن يكون العلم ولا رواية القصص ممكنًا – ربما نشأت في الواقع من قدرة موسيقية بدائية) 66 بالتركيز حاليًا على القصة، ألاحظ أنه على الرغم من الحديث الفضفاض عن “ثقافتين”، 67 هناك أوجه تشابه كبيرة بالإضافة إلى اختلافات كبيرة بين العلم والأدب -كما يلاحظ بيرس – ليس هناك ما هو ضروري للعمل العلمي أكثر من الخيال، فرجل العلم كما يقول “يحلم بالتفسيرات والقوانين” 68 بينما يحلم الروائي بأناس وأحداث وعوالم خيالية. من وجهة نظري، ليس فقط من العلموية أن تفترض أن البحث العلمي أفضل بطبيعته من الأنواع الأخرى من البحث؛ من العلموية أيضًا افتراض أن العلم بطبيعته أكثر قيمة من الأدب (أو الفن، أو الموسيقى، أو ، إلخ). وسؤال “أيهما أكثر أهمية، العلم أم الأدب؟” هو سؤال مضلل، وميؤوس منه مثل قولك “أيهما أكثر أهمية، روح الدعابة أم حس العدالة؟”
هذا يفضي إلى بعض الأفكار الختامية الموجزة حول الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر، “التقاليد والعالم المعاصر”.
ما نسميه اليوم “العلم الحديث” ازدهر في أوروبا، وكان من عمل الرجال البيض غالبًا. وهنا يشتكي – أنصار ما بعد الاستعمار، والنسويات، وغيرهم- من “نقاد العلم” من أن العلم عنصري ومتحيز جنسيًا، فهو ذكوري أبيض وهذه فكرة سخيفة. ينشأ العلم المعاصر نتيجة جهود بشرية منذ القدم لفهم العالم؛ كانت هناك العديد من التوقعات الهامة حول العلم المعاصر: في الصين والعالم العربي وأماكن أخرى، واليوم يوجد علماء أكفاء من كل عرق وجنس تقريبًا. العلم ليس شيئاً خاصًا بالذكور البيض. إنه شيء إنساني أتذكر أنه منذ وقت قريب، تحدثت باستفاضة مع اثنين من حاملي شهادة ما بعد الدكتوراه في معهد البحوث الطبية في سويسرا، 69 امرأة شابة من كندا، وشاب من أوزبكستان: عالمين متباينين ثقافيًا، تقاسموا تراثًا علميًا مشتركًا وتطلعات علمية مشتركة.
لكن بالطبع، العلم المعاصر حديث (نسبيًا). ويمكن أن تشكل التطورات العلمية تهديدًا حقيقيًا لأفكارنا المطمئنة حول أنفسنا ومكاننا في الكون، وحول الطرق التقليدية المألوفة للقيام بالأشياء. لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن مثل هذه التطورات تواجه أحيانًا مقاومة من أولئك الذين يثمنون الطرق القديمة. أحيانًا تكون المقاومة حمقاء، قرأت – على سبيل المثال – أن بعض علماء الاجتماع الهنود البارزين يفضلون العادة التقليدية للتجدير -التلقيح بمادة الجدري البشرية، مصحوبة بدعوات لآلهة الجدري- على الممارسة العلمية الحديثة للتطعيم باستخدام لقاح جدري البقر، الذي تقل احتمالية تسببه في الإصابة بالجدري لدى المريض. 70 في رأيي،هذا أسوأ من مجرد كونه سخافات.
ومع ذلك، يجب الاعتراف أنه عندما يتم استبدال التقاليد القديمة بممارسات وطرق علمية أحدث فهناك احتمال للخسارة إضافة إلى المنفعة. (أقول “ممارسات وأساليب علمية أحدث”،وأدرك أن التمييز بين آثار التقدم العلمي وبين آثار التحول الصناعي والتحضر والآن العولمة، أمر صعب للغاية، وربما يكون غير ممكن). ذات مرة، عمل هنود باناري في فنزويلا معًا على إزالة الأشجار بالفؤوس الحجرية، مع وجود فؤوس فولاذية جديدة موفرة للعمالة تمكّنهم من إزالة الأشجار بشكل أسرع وأكثر كفاءة و تلاشي طرق العمل التقليدية والتعاونية.71 يبحث المستهلكون الأمريكيون الأثرياء الذين يقدرون صلابة وحرفية تقنيات البناء القديمة ذات التقنية المنخفضة عن بناة الأميش للعمل لديهم.72 يلاحظ الأكاديميون بفزع أن نسيان الطلاب الذين لديهم موارد الإنترنت الهائلة – إذا عرفوا أصلا – كيف يقرؤون كتابًا حقيقيًا، من المحتمل أن نكون جميعًا هنا تقريبًا قد استفدنا بطريقة ما من التقدم في العلوم الطبية، أعتقد أن الكثير – مثلي- يشعر ببعض القلق بشأن الطابع غير الشخصي للطب المعاصر المعقد تقنيًا.
مثل هذه الأمثلة يمكن أن تتضاعف بلا حدود، لكنني سأتوقف عند فكرة بسيطة: أن ننسى أنه بقدر ما أدى التقدم التقني الذي جلبه العلم إلى تحسين حياتنا فقد كان له تكلفة حقيقية هي استبدال الممارسات والمهارات التقليدية القيمة= هو نفسه نوع من العلموية .73
[*] هذه وجهة نظر الكاتبة، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المنصة. الإشراف.
Notes
1 © 2009 Susan Haack.
2 Charles Sanders Peirce, Collected Papers, eds. Hartshorne, Charles, Paul Weiss, and (volumes 7 & 8) Arthur Burks (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-58), 5.172 (1903). References to the Collected Papers are by volume and paragraph number.
3 A. H. Hobbs, Social Problems and Scientism (Harrisburg, PA: Stackpole Press, 1953), p.17.
4 My source is Peirce, Collected Papers (note 2 above), 5.361 (1877). (Bacon was for a time Lord Chancellor – roughly, what in the U.S. would be called Attorney General – of England.)
5 Susan Haack, Defending Science – Within Reason: Between Scientism and Cynicism (Amherst, NY: Prometheus Books, 2003).
6 According to Friedrich von Hayek, although the earliest example given by Murray’s New English Dictionary was dated 1867, this narrower usage was already coming into play by 1831, with the formation of the British Association for the Advancement of Science. F. A. Von Hayek, “Scientism and the Study of Society,” Economica, August 1942: 267-91, p.267, n.2, citing John T. Merz, History of European Thought in the Nineteenth Century (Edinburgh: W. Blackwood and Sons, 1896), vol. I, p.89. See also the entry on “science” in the Oxford English Dictionary online (available at http://dictionary.oed.com)
7 See the Oxford English Dictionary online (note 6 above) entry on “scientism.”
8 Hayek, “Scientism and the Study of Society” (note 6 above), p.269 (describing scientism, the “slavish imitation of the method and language of science” as a “prejudice”).
9 E. H. Hutten, The Language of Modern Physics (London: Allen and Unwin, 1956), p.273 (describing scientism as “superstitious”).
10 Peter Medawar, “Science and Literature,” Encounter, XXXI.1, 1969: 15-23, p.23 (describing scientism as an “aberration of science”).
11 There are exceptions, such as Michael Shermer, who adopts the word “scientism” as a badge of honor, writing in “The Shamans of Scientism,” Scientific American, 287.3, September 2002, p.35 that “[s]cientism is a scientific worldview that encompasses natural explanations for all phenomena, eschews supernatural explanations, and embraces empiricism and reason as the twin pillars of a philosophy of life suitable for an Age of Science.” But this is an exception.
12 Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579 (1993). See also Susan Haack, Trial and Error: The Supreme Court’s Philosophy of Science,” American Journal of Public Health, American Journal of Public Health, 95, 2005: S66-73; reprinted in Haack, Putting Philosophy to Work (Amherst, NY: Prometheus Books, 2008), 161-82.
13 Mary Lefkowitz, Not Out of Africa (New York: Basic Books, 1996), p.157.
14 I am thinking, for example, of the conference at the New York Academy of Sciences in which I participated in 1996, and the corresponding volume. Paul R. Gross, Norman Levitt, and Martin Lewis, eds., The Flight from Science and Reason (1996: Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1997). I had suggested that the terms be reversed (“Reason and Science”) – but my suggestion wasn’t taken up.
15 “Do Charters ‘Cream’ the Best?”, Wall Street Journal, September 24th, 2009, A20.
16 Hobbs, Social Problems and Scientism (note 3 above), pp.42-3.
17 For a skeptical view of this supposed discipline, see Matthew Stewart, “The Management Myth,” Atlantic Monthly, 297.5, June 20th, 2007: 80-87.
18 In 1968 C. Trusedell gave a list based on a random search of graduate school catalogues: “‘Meat and Animal Science’ (Wisconsin), ‘Administrative Sciences’ (Yale), ‘Speech Science’ (Purdue), … ‘Forest Science’ (Harvard), ‘Dairy Science’ (Illinois), ‘Mortuary Science’ (Minnesota).” Trusedell, Essays in the History of Mechanics (New York: Springer, 1968), p.75. The list, and especially “Mortuary Science,” became famous among philosophers of science when Jerome Ravetz cited it in Scientific Knowledge and Its Social Problems (Oxford: Clarendon Press, 1971), p.387, n.25.
19 See Dagfinn Føllesdal, “Science, Pseudo-Science and Traditional Knowledge,” ALLEA (All European Academies) Biennial Handbook, 2002: 27-37; citing Fenstad, E.-J., et al., Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge, UNESCO World Conference on Science 2003, “Preamble,” p.4 (available athttp://www.unesco.org/science/wcs/eng/declaration_e.htm , last visited September 15, 2009).
20 As I was writing this paper, newly-discovered fossils obliged evolutionary biologists to re think the ancestry of homo sapiens – we are, it now seems, less directly related to chimpanzees than was formerly supposed. See Robert Lee Hotz, “Fossils Shed Light on Human Past,” Wall Street Journal, October 2, 2009, A3.
21 Friedrich von Hayek, The Counter-Revolution of Science (Glencoe, IL: Free Press, 1952), p.13.
22 Olli P. Heinonen, Denis Slone, and Samuel Shapiro, Birth Defects and Drugs in Pregnancy (Littleton, MA: Sciences Group, 1977); see in particular the description of the project design and data collection, pp.8-29. The record in Blum v. Merrell Dow Pharms, Inc, 33 Phila. Co. Rptr., 193 (Ct. Comm. Pleas Pa. 1996), 215-7, shows that Dr. Shapiro admitted under oath that the study had failed to distinguish these two sub-groups of the sample.
23 Christine Haller and Neal A. Benowitz, “Adverse Cardiovascular and Central Nervous System Events Associated with Dietary Supplements Containing Ephedra Alkaloids,” New England Journal of Medicine, 343, 2000: 1833-1838, p.1836. (The table is incompatible with the text on the same page.)
24 Robert Merton, Social Theory and Social Structure (1957; enlarged ed., Glencoe, IL: Free Press, 1968), p.47.
25 David Abrahamson, The Psychology of Crime (New York: Columbia University Press, 1960), p.37.
26 Of course, psychology also suffers from scientism; and also has a therapeuticallyoriented wing in which inquiry takes second place to practice.
27 See Robert L. Heilbroner, The Worldly Philosophers (1958: 7th ed., New York: Simon and Schuster, 1999), chapter xi. Susan Haack, “Science, Economics, ‘Vision,’” Social Research, 71.2, 2004: 167-83; reprinted in Haack, Putting Philosophy to Work (note 12 above), 95-102.
28 See Susan Haack, “Peer Review and Publication: Lessons for Lawyers,” Stetson Law Review, 36, 2007: 789-819.
29 Nowadays, thinking about the condition of the philosophical journals, I’m afraid I sometimes find this observation of Michael Polanyi’s coming unbidden to mind: “if each scientist set out each morning with the intention of doing the best bit of safe charlatanry which would just help him into a good post, there would soon exist no effective standards by which such deception could be detected.” Michael Polanyi, Science, Faith and Society (Oxford: Oxford University Press, 1946), p.40.
30 See Susan Haack, “The Meaning of Pragmatism: The Ethics of Terminology and theLanguage of Philosophy Today,” Teorema, forthcoming 2009.
31 It was; and historians now believe that Gutenberg printed all three. See Robert Buderi, “Science: Beaming in on the Past,” Time, Mar. 10, 1986, available at http://www.time.com/time/printout,0,8816,96050,00.html (last visited October 1, 2009).
32 See Jefferson-Hemings Scholars’ Commission, Report on the Jefferson-Hemings Matter (April 12, 2001); William G. Hyland, Jr., In Defense of Thomas Jefferson: The Sally Hemings Sex Scandal (New York: St. Martin’s Press, 2009). (The reasonable conclusion seems to be a very modest one: that one of Sally Hemings’ children was fathered by some male member of the Jefferson family.)
33 “Wish You Were Here,” Oxford Today, 10.3, 1998: 40.
34 Gregory L. White, “GM Takes Advice from Disease Sleuths to Debug Cars,” Wall Street Journal, 8 April 1999, pp. B1, B4.
35 The origins of this idea are described in Karl R. Popper, Unended Quest (La Salle, IL: Open Court, 1979), pp.31-38 (published as a book after first appearing in Paul A. Schilpp, ed., The Philosophy of Karl Popper (La Salle, IL: 1974), 3-181.
36 Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (1934; English ed., London: Routledge, 1959).
37 Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies (1945; revised ed., 1950), p.374.
38 Popper, Unended Quest (note 34 above), pp.167-180.
39 Karl R. Popper, “Natural Selection and Its Scientific Status,” a lecture of 1977. First published in Dialectica, 1978; reprinted in David Miller, ed., A Pocket Popper (London: Fontana, 1983), 239-246.
40 Popper, The Logic of Scientific Discovery (note 35 above), p.39.
41 Ibid., p.37.
42 Ibid, p.18.
43 Daubert (1993) (note 12 above). Of course, though the Supreme Court doesn’t realize this, it is hard to think of a philosophy of science less suitable than Popper’s – which expressly denies that any scientific theory is ever shown to be reliable – to serve as a criterion of reliability. See Susan Haack, “Federal Philosophy of Science: A Deconstruction – and a Reconstruction,” NYU Journal of Law and Liberty, forthcoming 2010.
44 McLean v. Arkansas Board of Education, 529 F.Supp.1255 (1982). Of course, though the court in McLean didn’t realize this, in view of Popper’s ambivalence about the status of the theory of evolution it is far from clear that his criterion would enable us to classify evolution as science, and creation “science” as non-science.
45 See Susan Haack, “Not Cynicism but Synechism: Lessons from Classical Pragmatism” (2005), in Haack, Putting Philosophy to Work: Inquiry and Its Place in Culture (note 12 above), 79-93.
46 For that matter, there are also some very significant differences among the various disciplines conventionally classified as sciences – between the natural and the social sciences, of course, but also between physics and biology, between sociology and economics, and so on.
47 I learned this from Føllesdal, “Science, Pseudoscience and Traditional Knowledge” (note 19) above; Føllesdal again cites the 2002 UNESCO report (note 19 above).
48 Jeremy N. Norman, “William Withering and the Purple Foxglove: A Bicentennial Tribute,” Journal of Clinical Pharmacology, 25, 1985: 479-83. Susan Wray, D. A. Eisner, and D. G. Allen, “Two Hundred Years of the Foxglove,” Medical History, Supplement 5, 1985: 132-
- Dale Groom, “Drugs for Cardiac Patients,” American Journal of Nursing, 56.9, September 1956: 1125-1127. James E. F. Reynolds, ed., Martindale: The Extra Pharmacopoeia (London: Pharmaceutical Press, 30th ed., 1993), pp.665-6. Another example would be quinine, derived from the bark of the cinchona tree, now standard in the treatment of malaria. See Tropical Plant Database file for quinine (available at http://www.rain-tree.com/quinine.htm , last visited October 6, 2009); Lexi Krock, “Accidental Discoveries” (available at http://www.pbs.org/wgbh/nova/cancer/discoveries.html , last visited October 6, 2009).
49 Friedrich von Hayek, The Counter-Revolution of Science (note 21 above), p.15.
50 Paul K. Feyerabend, Against Method (London: New Left Books, 1970).
51 Percy Bridgman, “On Scientific Method” (1949), in Bridgman, Reflections of a Physicist (New York: Philosophical Library, 1955), 81-2, p.81.
52 Percy Bridgman, “The Prospect for Intelligence (1945), in Bridgman, Reflections of a Physicist (note 50 above), 526-52, p.535.
53 These ideas are developed in detail in Haack, Defending Science – Within Reason (note 5 above), chapter4.
54 Calling this underlying pattern the “hypothetico-deductive method,” as if it were a special, technical procedure, and peculiar to science, is itself a kind of scientism.
55 These ideas are developed in detail in Haack, Defending Science – Within Reason (note 5 above), chapter6.
56 The stuff we now call “DNA” was discovered in 1859 by Friedrich Miescher (who called it “nuclein”). The concept of a macromolecule was introduced by Hermann Staudinger in 1922. See Franklin H. Portugal and Jack S. Cohen, A Century of DNA: A History of the Discovery of the Structure and Function of the Genetic Substance (Cambridge, MA: MIT Press, 1977); Robert Olby, The Path to the Double Helix (Seattle, WA: University of Washington Press, 1974).
57 See John Maddox, What Remains to be Discovered: Mapping the Secrets of the Universe, the Origins of Life, and the Future of the Human Race (New York: Simon and Schuster, 1998), pp.25 ff.
58 John Dewey, The Quest for Certainty (1929; reprinted, New York: Capricorn Books, 1960), p.255.
59 Govind Persad, Alan Wertheimer, and Ezekiel J. Emanuel, “Principles for Allocation of Scarce Medical Resources,” The Lancet, 373, Jan 31, 2009: 423-31. (Mr. Emanuel is health adviser to President Obama.)
60 Aki Tsuchiya, Paul Dolan, and Rebecca Shaw, “Measuring People’s Preferences Regarding Ageism in Health: Some Methodological Issues and Some Fresh Evidence,” Social Science and Medicine, 57, 2007:688-96 (finding that people are broadly in favor of giving priority to older over younger patients, but noting that how the questions are asked may affect the upshot); Jeff Richardson, “Age Weighting and Discounting: What Are the Ethical Issues?”, Working Paper 108, Health Economics Unit, Monash University (Australia) (using the term “empirical ethics” to refer to surveys of people’s beliefs about ethical questions).
61 The authors of the Lancet paper also fudge the relation of economic values to ethical ones. Perhaps there is a plausible economic argument that society has made a greater economic investment in adolescents or young adults than in infants, and can expect greater future return on the investment in adolescents or young adults than on older people; but Persad et al. simply
dismiss the economic fact that society has invested less in underprivileged adolescents or young persons – this irrelevant, they say, because it is itself the result of “social injustice.” “Measuring People’s Preferences” (note 58 above), p.428.
62 While I was writing this paper a new book suggested fascinating conjectures about the origins of empathy, in humans and other animals. Frans de Waal The Age of Empathy (New York: Harmony, 2009). See also Robert Lee Hotz, “Tracing the Origins of Human Empathy,” Wall Street Journal, September 26, 2009, A11.
63 Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge (1998; reprinted New York:Vantge, 1999), p.279.
64 Ibid., pp.279-80.
65 Steven Weinberg, Dreams of a Final Theory (1992; reprinted New York, Vintage, 1993), p.245.
66 Robert Lee Hotz, “Magic Flute: Primal Find Sings of Music’s Mystery,” Wall Street Journal, July3-5, 2009, A9.
67 C. P. Snow, “The Two Cultures” (1959), in The Two Cultures and a Second Look (Cambridge: Cambridge University Press, 1964).
68 Peirce, Collected Papers (note 2 above), 1.48 (c.1896).
69 The Friedrich Miescher Institute, Basel. (Recall from note 55 that it was Miescher, a native of Basel, who discovered DNA.)
70 See Meera Nanda, “The Epistemic Charity of Social Constructivist Critics of Science and Why the Third World Should Reject the Offer,” in Noretta Keortge, ed. A House Built on Sand: Exposing Post-Modern Myths about Science (New York: Oxford University Press, 1998) ( 286-311, p.291; Nanda cites Fredérique Apfel Marglin, “Smallpox in Two Systems of Knowledge,” in Fredérique Apfel Marlin and Stephen Marglin, eds., Dominating Knowledge: Development, Culture and Resistance (Oxford: Clarendon Press, 1990), 102-44.
71 Katherine Milton, “Civilization and Its Discontents: Amazonian Indians,” Natural History, 101.3, March 1992:36-42.
72 “Amish” refers to a religious sect that eschews modern technology, still using horses and buggies instead of motor vehicles, etc. Nancy Keates, “From Barn Raisings to Home Building: Consumers Hire Amish Builders, Citing Craftsmanship, Costs,” Wall Street Journal, August 15, 2008, W1.
73 My thanks to Mark Migotti for very helpful comments on a draft, and to Pamela Lucken for help in finding relevant material.