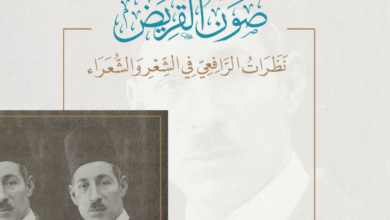- حسين نور عبد الله
- تحرير: عبير العتيبي
- مراجعة: أروى الشاهين
تتميز الطُّفولة بأنَّ كلَّ أحداثها على تماسٍّ مباشرٍ بالواقع، فعقل الطِّفل ما زال ينمو، ويخلق روابط عصبيَّة تكوِّن معلومةً ما، وعليه تُحدَّد طريقة الاستجابة. فمثلًا أوَّل ما يتعلَّمه الطِّفل كلمات التحفيز والتحذير، كنواة وبداية تصنيفٍ لكل حدث وفعل، فيتعلَّم بالثَّناء، والتحذير، وكلّما زادت مفردات أحدهما عن لآخر؛ انعكس ذلك على حياته بأكملها.
فستجده ميَّالًا إما للخوف والحذر دائمًا، فتكون نظرته للحياة متوجِّهةً نحو نصف الكوب وجانبه السَّلبي، ومن ثَّمَّ تكون قراراته سيئة. وعلى العكس فمع الكلمات المحفِّزة، أو التَّعليمية، وخاصّةً الثَّانية، حيث يميل الفرد إلى النَّظر للجانب الإيجابي، أو المكسب من وراء كلِّ خطوة، لا كمن كانت كلمات التحذير أعلى، فينعكس ذلك على مستوى حياته ونجاحاته.
فترة الطُّفولة فترةٌ جدُّ مهمِّة، وللأسف فإنَّ الإنسان لم يطوِّر موروثًا كاملًا صلبًا يُعين الآباء والأمهات على التَّعامل مع هذه الفترة، أو أنَّ الإنسانَ تجاهل التَّعاليم المهمَّة في هذا الجانب. ناهيك عن حداثة سنِّ بعض الآباء والأمهات، أو طرق الزِّيجات التي تُفضي إلى علاقةٍ هامشيِّةٍ وسطحيِّة بين زوجين، يبرهن لهم الوقتُ سوءَ قرارهم، لا أكثر.
ومن ثَمَّ يستمرُّ نموُّ العقل، فيتَّجه إلى محيطٍ أكبرَ من المنزل، إلى محيط الأصدقاء فيتعرَّف على ما يثير الاستحسان وما يثير القلق، وهكذا يدخل عقل الإنسان في هذه العملية المعقَّدة، والمستمرَّة طوال حياته.
وتزداد هذه العملية غموضًا حيث إنَّ الطَّفلَ يتعرَّف على بيئته، وما هو نافع، وما هو ضارٌّ كسائر الكائنات الحيَّة الاخرى، وأيضًا مثل إنسان الغاب الذي كان يقضي حياته كالطَّفل؛ حيث إنَّ عمليَّة التَّفكير هذه تظلُّ متطابقة مع واقعه، بل دفعته إلى بناء مكانه الآمن واختيار الغذاء المناسب؛ وبهذا تكون مستوياتُ هرمونات القلق والتوتر (الكورتيزول والأدرينالين) في أقلِّ مستوياتها.
في وقتنا يحدث العكس، عمليَّةُ التَّفكير تخرج من الواقع الملموس، وتدخل في حيَّز المسرح الإنساني وأدواره وطبقاته، فنبدأ بتحليل ما يجب علينا فعله لنيل استحسان باقي أفراد المجتمع، وما يتوجب علينا التوقُّف عن فعله. كيف نبهر الآخرين؟ كيف نظهر بمظهر لائق ونترك انطباعا حسنًا؟
كلُّ هذه الأفكار والتَّقسيمات لا علاقة لها بالواقع الملموس؛ بل هي عالمٌ داخل أدمغتنا، عالمٌ من الأفكار يفرض علينا الاختيار، إما الانصياع له، وإما الرفض واللعب بهذا النِّظام بأفضلِ طريقةٍ ممكنةٍ للفرد.
فالبوذيِّة تُسمِّي هذا العالم بـ “المايا” التي تعني الوهم، حيث إنَّ همومنا ومشاكلنا كلَّها مرتبطةٌ بعالمٍ خياليٍّ يتعلَّق بما فعلناه في السابق، وكيف نريد للمستقبل أن يكون، ناهيك عن ارتباطنا بواقع مشوهٍ حيث إنَّه لا يرتبط بالواقع على أنَّه واقع، بل بانطباع النَّاس عنَّا وعن أفعالنا، وتحقيق القصَّة التي يتشاركها المجتمع من تعليم وعمل وزواج…، وكلّها تحت ضغط الطَّبقة الاجتماعية؛ فنجد أنفسنا نعيش في أدمغتنا أكثر فأكثر، ويكاد الواقع لدينا لا يوقف الصَّوتَ المستمرَّ، والمحادثة الطويلة من نقدٍ أو تحفيزٍ في الدماغ!
فنحن بذلك نعيش محاكاةً لواقعنا، دائمًا نريد أكثرَ من الواقع، ونضع عليه أفكارنا وخيالاتنا ونطالب الواقع أن يتماشى مع ذلك، ونكون بذلك كمن يحتاج إلى سُلَّمٍ وينظر إلى الشَّجرة، ويتحسَّر على غياب الفأس بدلًا من أن يجد حلًّا ولو بيده!
انقطاعنا المستمر عن الواقع الذي ازداد مع تطبيقات التَّواصل الاجتماعي؛ يجعلنا لا نرى في الزَّهرة أو الطَّقس الجميل إلا استثمارًا لصورةٍ جميلةٍ تنال الإعجاب!
لم نعد في الواقع، فإمَّا أن نعيش بين أفكارنا والماضي والمستقبل، وإما بين تطبيقات التَّواصل الاجتماعي، والنَّتيجة: تزايدٌ في الاضطرابات النفسيَّة، وكلُّ ذلك يقودنا إلى منبع المشكلة الذي يكمن في الوعي.
فالانسان يحتاج لأنْ يُولد مرّةً أخرى، ولكي يولد عليه أن يهدأ ويكفَّ عن ركضه في الحياة لينظر إليها حقًّا.
ماذا يريد؟
ما هي شخصيّته؟
ما نوع الحياة التي يودُّ أن يعيشها؟
ما الصفات التي بنيتها لأجل استحسان والدتي ومن ثم المجتمع؟
ما التجارب التي شكَّلت شخصيته؟
ما أفضل حياة ممكنة وما هي الشخصية المطلوبة والمظهر المطلوب؟
ومن ثَمَّ ينتقل إلى الإحساس بالواقع بإعطاء جسده ورغباته حقّها في التَّساؤل، ما الرغبات التي أقمعها ولماذا؟
وكيف أحقِّق أفضل جسدٍ ممكن؟
وبمثل تلك الأسئلة ينقل جُلَّ عمليات تفكيره من الآخرين إلى ذاته، فيجد البساطة ملازمةً له، والهدوء وتحرِّي الراحة، ومن ثَمَّ التَّفكير الهادئ في حلِّ مشكلاته.
فمن غير المعقول الشُّروعُ في بناء خيمةٍ في جوٍّ عاصف! والإنسان دائمُ التَّفكير يعاني من العاصفة فكيف يضع قصَّته وسط كلِّ هذا؟
للصوفيَّة جملةٌ رائعة “غِب عن الطَّريق؛ تجده” وأيضًا: “وتحسبُ أنَّك جرمٌ صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر” ووصيَّة الفلسفة الاولى “اعرف نفسك “، واستنارة بوذا والتاو الهادئ عند لاوتزه؛ كلُّها تخبرنا بأهميَّة الهدوء أوّلًا.
فالهدوء لغة الطبيعة، وكلُّ شيءٍ يتحرَّك بتناغم وسكينة، ويكفي أن نعطي وقتًا ضئيلًا للتَّأمل، وهذا كان يحدث سابقًا ولكن لم تعد الطبيعة حولنا، وهذا للأسف سببه تناقص المناظر الطبيعية فبِتنا نعيش في مدن إسمنتيَّة تدفعنا إلى المكوث في خيالاتنا لا أكثر.
ومن الطَّريف أنَّ أثرياء العالم يعيشون وسط هذه المناظر الطبيعية، ويملكون إمكانيَّة الوصول إلى بقعةٍ ساحرة في أيِّ لحظة، ويتكوَّن يومهم من الهدوء، أكثر من أيِّ شيءٍ آخر، وتقِلُّ الحظوة ترتيبيًا لتنعدم عند الطَّبقة العاملة؛ فلا ترى أعينُهم سوى الأسمنت والحديد لتذكَّرهم بكلِّ مشاكلهم.
ومع ذلك على الإنسان أن يتحرَّى لحظات يقظته، حين يهدأ، أو يتعلَّم كيف يهدأ، عن طريق التَّأمُّل أو التَّجارب الروحيَّة، ويقرأ ويحاول أن يتعامل مع واقعه وقصَّته تعاملًا حقيقيًّا، لا أن يلعب دور الكومبارس في قصَّته، ويترك دور البطولة للأهل أو المجتمع أو الشركات أو الحكومات، أو أيِّ أمرٍ خارجٍ عن ذاته هو.
علينا تعلُّم الهدوء، فقد عُلِّمنا العكس منذ الصَّفِّ الأوَّل الابتدائيِّ؛ حيث المنافسة وعدم تقبُّل الأخطاء والشَّخصية المفضَّلة للنظام الدراسي، والتَّفكير في المستقبل، حيث اليوم مجرَّد حرثٍ للغد؛ لذلك نلاحظ هدوءًا أكبرَ عند من لم يدرس، وامتنانًا وطاقةً مفعمة سواء بالحزن أم الفرح، فكلاهما يظِهران مقدارَ انسجامه في حياته.
فالإنسان قصَّة وتلك الأفعال التي لا تبني قصَّته تعتبر هدَّامةً له، وهناك قصَّةٌ جاهزةٌ، يرويها الكلُّ، أو قصَّةٌ خاصَّةٌ باختباراتٍ خاصَّة. الأولى تنتِج إنسانًا عاديًّا، والثَّانية إنسانًا عظيمًا. فأنْ تعيشَ خارج عقلك أمرٌ صعب، ويزداد صعوبةً مع سنِّ الفرد؛ حيث يتعمَّق الفردُ في قصَّته المشوَّهة إن لم تأتيه لحظةُ استنارة، فيتوه في عقله، ويمرض أو يُجنَّ وهو يراقب حياته المثاليَّة تتلاشى.
يصفها نيتشه بـ “amorfati” بمعنى: حبُّ الواقع؛ حيث لا يرى الفرد شخصية أفضل من ذاته ويتقبل واقعه، ويبدأ في تحسينه وتطويره، ويعيش حياةً خاصَّة به تكون بسيطةً، وتتمحور اهتماماته حول راحته، والغريب أنَّ كلَّ ما يريحنا؛ متوفِّر دائمًا ومع ذلك نبحث عنه في الأشياء والأشخاص!
إنَّنا نفني ذواتنا في المسرح الإنسانيِّ؛ حيث نُجهّز للعب أدوار محدَّدة بسبب الوراثة، فيكون أحدهم في أعلى الهرم والآخر في أسفله، وبهذا تختلف شدِّةُ حياة كلِّ طرف، ومع كلِّ هذا يبقى هناك أمر إيجابيٌّ في كلِّ سلبيٍّ يؤهِّلنا لعيشِ أفضل نسخةٍ ممكنةٍ من ذواتنا.
وهناك أمرٌ سلبيٌّ في كلِّ إيجابي، فالرَّاحة تضعِف حواسَّنا وقدراتنا وكلَّما كان الفرد واعيًا بذلك؛ تفادى ما هو سلبيٌّ، وغنِم ما هو إيجابي.
كلُّ ذلك على مرمى حجرٍ منَّا ويكمن في داخلنا، يتوجب علينا أن نهدأ ونعيد النظر في ذواتنا بعيدًا عن المنافسة، وبعيدًا عن المسرح الإنساني؛ حيث إنَّ أغلب العظماء يمرُّون بمرحلةٍ مهمَّة تسبق عظمتهم، تكمن في الخروج من محيطهم؛ وبهذا يمتلكون الوقت والهدوء لإعادة النَّظَر في ذواتهم.
للأنبياء قصصٌ مع الجبال، وحتى بوذا خرج إلى النَّهَر ولاوتزه إلى الجبل، وشعر بها غاندي وهو في جنوب أفريقيا، وفي البقعة ذاتها حُبس مانديلا سبعًا وعشرين عامًا، وخرج وصحَّح الأوضاع في البلاد كلِّها، كما فعل غاندي في الهند، وخرج أرنستو بدرَّاجته وجاب قارَّته، وعاد باسم “تشي” -الذي يعني الرَّفيق- فأعاد رسم أمريكا الجنوبية.
لا وجودَ لعظيمٍ لم يمنح فرصةً لذاته ليسبر أغوارها، فأنْ تعيشَ خارج برمجة أفكار المسرح الإنساني صعب، ولكنَّه رسالةُ كلِّ فردٍ منا، ولا معنى للحياة إن لم نولد مرةً أخرى خارج أدمغتنا وخيالاتنا.
اقرأ ايضاً: معتقلات الانطباعات