- سلطان بن عواد البنوي
يحكي الفيلسوف الأندلسي أبو بكر محمد ابن طفيل في حكايته الفلسفية المعنونة بـ حي بن يقظان عن إنسان نشأ في جزيرة نائية من جزر الهند في عزلة تامة عن أي تجمعات بشرية أو آثار إنسانية وكيف تدرج في تلك الجزيرة النائية في تربية نفسه وتأمين الغذاء لها مهتديا في ذلك بسلوك الحيوانات من حوله، محاكيا غرائزها، متتبعا أفعالها حتى نمت في نفسه القدرات والإمكانات فدفعت به إلى تعلم أشكال أخرى من العناية بنفسه فهدته من ثَمّ إلى صنع أثوابه من جلود الحيوانات ومن ثم إلى تشريحها وتطبيبها حتى وصل بفضل قدراته وملكاته إلى فهم العلوم الطبيعية والفلسفية والدينية ..الخ.
تطرح هذه الحكاية الفلسفية المتخيلة عدة إشكالات وتساؤلات تستحق النظر والفحص، ومن أوائل هذه الإشكالات سؤال: ما معنى الدرس؟ يؤكد ابن طفيل إلى أن الإنسان يمكنه أن يُدرِّس ويُعلّم نفسه من غير كسب أو تعليم حتى يصل إلى فهم كافة العلوم بمختلف مجالاتها وفروعها مستقلا في ذلك بذاته، وحتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال فإنه ينبغي علينا التصريح بأصل معنى الدرس عند ابن طفيل بل عن أصله في التقليد الفلسفي منذ أفلاطون، يقول الفيلسوف الألماني إرنست كاسيرر:
“معرفة النفس- أو الذات- أسمى غاية في البحث الفلسفي، تلك حقيقة تلقى اعترافا عاما فيما يبدو، وقد ظلت ثابتة لا تتغير خلال كل المعارك التي نشبت بين مختلف المذاهب الفلسفية، وقد برهنت تلك الحقيقة على أنها النقطة الأرخميدية في الفكر كله، أعني النقطة الثابتة المستقرة”[1]، فكل بحث أو دراسة لا تبدأ من هذه النقطة الأرخميدية فإنه محكوم عليها بالعدم والأفول والنسيان.
ويقول ابن رشد في تلخصيه لكتاب النفس لأرسطو:
“المعرفة بأمر النفس نافعة في كل علم يقصد تعلمه، وذلك لأمور ثلاثة: إما من قبل أن معرفة مبادئ كل علم هي حاصلة في هذا العلم…”[2] أي: أن العلم بالنفس أساس ومبدأ كل المعارف؛ إذ عبرها تنمو أغصان شجرة العلم والفهم، ويقول أيضا في موضع آخر: “ومن المعلوم بنفسه أنه لا شيء أشرف من النفس وأحق بالرئاسة منها وبخاصة العقل، فإنه يظهر أنه ليس هاهنا شيء ينبغي أن يتقدم عليه”[3].
وينقل المتفلسف الشيعي حسن زاده آملي عن أبي الحسن الأبيوردي:
“نمهّد لك أولاً مقدّمة هي أنّا نعلّم أنفسنا من غير كسب بل تحضر ذاتنا عندنا دائماً ولا تغيب عنّا أصلاً. ولسنا نحتاج في العلم بأنفسنا إلى ملاحظة شيء من الأمور الخارجة ضرورة فإن العلم بالنفس هو الشعور بمعنى لفظ أنا لا غير، وهو ضروري”[4].
ويقول المفكر الألماني مارتن هايدغر مستنكراً:
“ما هو موضوع البحث الفلسفي؟ إنه بالنسبة لهوسرل كما بالنسبة لهيغل بحسب التراث نفسه الذاتية والوعي”[5].
إن أول خطوة إذن للإجابة عن سؤال: ما معنى الدرس؟ في أطروحتنا هذه هي محاولة فك الارتباط بينه وبين التقليد الفلسفي الذي رُسّخ في أذهان كثير من المعاصرين ممارسين على منوال العبارة الكانطية ذات الدلالة العلمانية[6] دون أدنى فحص أو نقد لها، فقبل محاولة طرح معنى الفهم ينبغي طرح معنى الدرس ومساءلته؛ لذا حتى يتبين لنا مدى نجاعة مفهوم الدرس في التقليد الفلسفي سنطرح خصائصه وسماته وهل تقودنا وتهدينا فعلا إلى الفهم أولا ثم إلى المراد منها ثانيا أم لا؟
من خصائص الدرس الفلسفي:
الخاصية الأولى (الذاتية):
إن أول خاصية لهذا التقليد الفلسفي كما ذكرنا أعلاه هو أن “الحكمة هي معرفة الذات”[7]، وطبيعة هذه المعرفة أنها ليست معرفة لموضوع ما بل هي الأصل والقاعدة لفهم كل الموضوعات؛ وهذا من لوازم ذاتيتها، أي أن يُفهم كل موضوع من خلالها ابتداءً؛ لذا من شرطها ألا تتغير ولا تتبدل؛ لأن تبدلها يجعلها موضوعا عرضيا، وإذا صار أصل المعارف وقاعدتها عرضا من الأعراض امتنع التفريق بين العلم واللا علم، واستحالت كل المعارف إلى أهواء وذوقيات وخيالات، لذلك يقول شمس الدين الشهرزوري “العلوم هي التي لا تتغير بتغيُّر الأزمنة والأعصار ولا تختلف باختلاف الأدوار والأكوار”[8]، وحتى يصح شرط عدم التغير وجب أن يتم فصل مفهوم العلم عن العالِم، ومفهوم الفهم عن الفاهم، إذ لو لم يُشترط ذلك لوقع في نفس الأعراض التي يقع فيها حامله (الإنسان) من الأوهام والشكوك والنسيان وغيرها من الآفات التي يتعرض لها بنو آدم، ومن هذه الجهة ندرك علة اختراع الفلسفة لعالَم المعقول أو العالم الداخلي (السيكولوجي) أو بحسب اتجاهات فلسفية أخرى عالَم المُثل أو بالمعنى المنطقي القواعد التي تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ أو سوء الفهم؛ فإن أهم وظيفة لهذه التشكلات من العوالم الفلسفية أن تكون ضامنة لفصل العلم عن العالِم، والفهم عن الفاهم لئلا يتغير بتغير حامله ومستعمله؛ فيكون الفهم بذلك فوق التاريخ بل حاكم عليه ومعيار على تغيراته؛ لذا فإن الفهم بحسب هذا الشرط هو حركة النفس في معانيها فقط، وهذه الحركة النفسانية نحو الفهم الذاتي تستلزم “أن تكون حركات السماء هي نفس حركة النفس … لأن التوازي بين العالَم والنفس هو شرط المعرفة”[9]، ومن هذه الجهة صار الفهم نوعا من انطباع الصورة ثم انتقل بعد ذلك إلى مفهومه المنطقي دون إشارة للعلة التي جعلت معنى الفهم تصورا محضا ابتداء، والذي هو مفهوم العالَم الذي يضمن ألا تتغير فيه الصور بمرور الأزمان وتغير الأحوال وتبدل التاريخ بغض النظر عن سمات هذا العالَم وخصائصه؛ إذ كل فيلسوف يغير شروط عالمه بحسب فهمه الذاتي فقط؛ إذ الحكمة هي المعرفة بالذات! ومن هذه الجهة نفهم أيضا كيف دخلت الثنائيات في صلب التقليد الفلسفي وترسخت فيه. إذن، من أوائل وأهم شروط الدرس في التقليد الفلسفي هو ثنائية العالَم النفسي والعالَم الخارجي؛ إذ بذلك نجعل الفهم محض صورة، ومن ثم نختزل الحقيقة في مفهوم المطابقة بين الشيء وصورته، بل إن الصورة تصبح هي سبب إنتاج الشيء الخارجي، إذ إن أرسطو “يدفع برد السبب إلى العلة إلى أبعد الحدود، فيذهب إلى حد القول: (إن مبدأ كل إنتاج، مثلما هو الحال في القياسات هو الجوهر الصوري: لأنه من الماهية إنما تنطلق القياسات، ومنها كذلك تنطلق الإنتاجات”[10]، إذن، نخلص إلى أن السمة الأولى في معنى الدرس في التقليد الفلسفي هو أن معيارية الفهم تنطلق من ثنائية بين عالمَين، أحدهم معياري، والآخر فرع وامتداد له ينبغي أن ينتظم وفق العالَم المعياري الذي يشيده الفيلسوف ويبنيه من منظوره الذاتي، وحتى ننقض هذه الخاصية لمفهوم الدرس الفلسفي ينبغي أن ننطلق من نقض معنى الأنا أو الذاتية؛ إذ هي علة اختراع هذه الثنائية بين عالَمين، فنقول: أن أصل البدء بتسويغ الإقرار بـ (الأنا) أن الفيلسوف يقف موقفا مضادا من اللغة اليومية داخل المجتمع كما يؤكد جوناثان إزرايل في تحليله لقصة ابن طفيل قائلاً “ومن الأمور المركزية في رؤية ابن طفيل، مثل رؤية ابن رشد، الصدام بين الفرد العقلاني والمجتمع”[11]، لذلك فإنه يحاول أن يبتعد بلغته عن لغة الجماعة البشرية، ومعنى ذلك أن دلالة لفظة (الأنا) التي تبدأ منها الحكمة بحسب الدرس الفلسفي ليست هي ذات الدلالة للفظة (أنا) المستعملة في الحياة اليومية للغة، مما يعني أن الفهم أيضا غير مشروط بها، وهنا يأتي الإشكال على معنى الدرس الفلسفي؛ إذ كل فهم للأنا سيكون فهما صائبا، وما تراه فهما خاطئا سيكون كذلك أيضا دون أي تعليم خارجي عنها، حينها سيتلاشى الفرق بين العلم واللا علم وبين الفهم والجهل؛ لأن شرط الحكيم ألا يطلب تعليما من غير ذاته؛ فإذا كان الأمر كذلك فكيف يميز الحكيم الفهم الصحيح من سوء الفهم؛ إذ رجوعه لأي شرط خارجي ينقض أصل مفهوم الحكمة بما أنها المعرفة بالذات، أي أنه يقع في لغة خاصة لا يفهمها أحد، ويلزم من ذلك أن الشعور الضروري للذاتية محتاج لإضفاء المعنى عليه من خارجه، أي أن درس الفهم مفتقر بالضرورة لتعليم مُعلّم من داخل الجماعة البشرية ولغتها المعيشة؛ لأن معنى الذاتية يتشكل من خلال التعليم الجماعي اللغوي لها، وليس بالضد منها كما في حكاية ابن طفيل.
وإننا حين نعود إلى الشروط الأنثروبولوجية التي هيأت لفصل مفهوم العلم عن العالِم، ومن ثم عزلت الفهم عن حامله فإننا سنلاحظ أن اختراع تقنية الكتابة في التاريخ البشري كان عاملا جذريا لتغير معنى الدرس وما يتعلق به من شروط علمية وسياقية، يقول الإنثربولوجي والترج أونج:
“تم الكشف في السنوات الأخيرة عن فروق أساسية في طرق تحصيل المعرفة والتعبير بالكلام بين الثقافات الشفاهية الأولية (ثقافات بلا معرفة بالكتابة على الإطلاق) والثقافات عميقة التأثر بالكتابة. ويُعد ما انطوت عليه هذه الكشوف من نتائج أمرا مذهلا. ذلك أن كثيرا من الملامح التي قبلناها بوصفها قضايا مفروغا منها في الفكر والأدب؛ في الفلسفة والعلم… ليست ملامح أصلية للوجود الإنساني في حد ذاته”[12]، أي أن اللازم من هذه الكشوف أن مفهوم الحكمة بوصفها المعرفة بالذات التي لا تتغير بتغير الأزمان والتاريخ- كما نقلنا أعلاه- هي منتج تاريخي في أصله، وليس أمرا أصليا في الوجود البشري؛ إذ أن اختراع الكتابة أعاد إنتاج عملية الكلام واستعمال اللغة؛ ومن هذه الجهة نفهم علة توهم انفصال (الأنا) عن تشكلها التاريخي والاجتماعي، يقول والترج أونج أيضا أثناء تحليله لأثر اختراع الكتابة في بناء الوعي وتغير معنى الفهم:
“أما الكلمات في النص فتقف بذاتها. أضف إلى أن من يؤلف النص أو (يكتبه) يكون أثناء إنتاجه منفردا كذلك. فالكتابة تتمتع بـ (مركزية الأنا) فأنا أكتب كتابا آمل أن يقرأه مئات الآلاف من الناس، لذا يجب أن أكون معزولا عن كل أحد… أما في الكلام الشفاهي فلا بد من أن تشمل الكلمة هذا التنغيم أو ذاك كأن تكون الكلمة حيوية، أو مثيرة، أو هادئة، أو ساخطة أو مذعنة”[13]، أي أن الكلمة المنطوقة لا تُفصَل عن طرق أداء حاملها؛ إذ الأداء شرط من جملة الشروط السياقية التي يكتمل بها الفهم بخلاف الكلمة المكتوبة فإنها تقع تحت سطوة كاتبها يضيف عليها من معانيه الذاتية دون رقيب غير نفسه عليها، ومن هذه المنظور تقع لفظة (الأنا) في لغة الفيلسوف في مفارقة غريبة، فهي من جهة أثر لإنتاج تاريخي واجتماعي، ومن جهة أخرى تدعي وتتوهم أنها متعالية على تشكلها التاريخي والاجتماعي داخل اللغة، ويتبعه في ذلك معنى الدرس لدى التقليد الفلسفي برمته! بل إن اختراع تقنية الكتابة تاريخيا شكّل عاملا جذريا لابتكار المفهوم اللا تاريخي للصورة المنطقية، يقول جاك دريدا:
“تعيد عملية الكتابة إنتاج عملية الكلام، وبذلك كان الشكل الخطي الأول يعكس الكلمة الأولى: الشكل والصورة، إنها كتابة تصويرية… كانت العلامة التصويرية الأولى مثلها مثل الكلمة الأولى عبارة عن صورة بمعنى أنها تمثيل مُحَاكٍ وانتقال استعاري في آن واحد، ولا يتم عبور الفاصل الذي يفصل الشيء نفسه وإعادة إنتاجه- أيا كانت أمانة إعادة الإنتاج هذه- إلا بواسطة تحويل ما”[14] أو تقنية ما، وقد كانت هذه التقنية هي اختراع الأبجدية والكتابة، والفارق الفاصل في دور التقنية بين المجتمعات القديمة والمجتمعات الراهنة أن “علاقة الإنسان بالصنع والتشكيل في الفترة التي سبقت العصر الحديث كانت تسترشد في المقام الأول بانفتاح معين، وبحميمية متبادلة واهتمام صادق (بين الصانع ومصنوعه). لم يكن تحدي العالم وتنظيمه يكتسب أهمية توازي أهمية (السماح بالوجود)، والسماح للعالَم بأن يعرض نفسه بأشكاله الخاصة. ومن ثم كانت المعايير الرئيسية التي تحدد مستوى منتجات الحرف والصناعات اليدوية تهتدي بحاجات المنتفع بها وخياراته. وكان ذلك المثل الأعلى للصنع (Poiesis). وأما التكنولوجيا الحديثة فإنها تصنع الأشياء أولا ثم تخلق الحاجة إليها بانية صناعة إيقاظ للمستهلك وتحفيزاً لاحتياجه. فالمعايير لا يحددها المنتفعون بل إنها تُفرض عليهم فرضاً”[15]، وتؤكد عالمة الآثار كلاريس هيرينشميت على أثر التشكل التاريخي لمفهوم الصورة المنطقية قائلة: “ومع دخول الكتابة، حرّك كتبة بلاد الرافدين عملية تقوم على إزاحة السياق وتباعد أشياء اللغة عن أشياء العالَم”[16]. ويؤكد أونج ذلك أيضا بقوله: “إن الكتابة تخلق ما سماه بعض الباحثين لغة طليقة من السياق… وهو خطاب لا يمكن مساءلته أو معارضته، على نحو ما يحدث في الخطاب الشفاهي؛ ذلك لأن الخطاب المكتوب منفصل عن مؤلفه”[17]، ويقول أونج أيضا في موضع آخر: “الكتابة تنمي التجريد الذي يبعد المعرفة من ساحة النزال، حيث لكافحت الكائنات البشرية بعضها بعضا، إنها تفصل العارف عن المعروف، في حين تضع الشفاهية المعرفة في سياق الصراع بإبقائها في عالم الحياة الإنسانية… يعني فعل التعلم أو التعرف في نظر الثقافة الشفاهية إنجاز انتماء حميم ومشاركة وجدانية وجماعية مع المعروف؛ أي احتواءه، أما الكتابة فتفصل بين العارف والمعروف، وتبني شروطا لـ(الموضوعية) بمعنى عدم الارتباط الشخصي، أو الابتعاد”[18] عن المعروف، بل إن مفهوم الموضوعية التي تولد من رحم تقنية الكتابة قد يؤدي إلى تدمير الفهم اليومي لعالم المعيش كما يرى ذلك بيير بورديو[19]، أي أنه يوهمنا بالفهم في حين أنه يعدمه، ولعل من أظهر الأمثلة لهذه العدمية التي ينتجها الدرس الفلسفي للفهم هو معنى الإله[20]، ويقول أيضا سيلفان أورو: “إن عملية ظهور الكتابة هي عملية وَضْعَنة اللغة، أي تمثيلها الميتا-لغوي”[21] أي: أن ابتكار المجتمعات البشرية لطرق الكتابة كان عاملا جذريا لنشأة القواعد المنطقية التي تفصل العلم عن العالِم[22]، والفهم عن سياقات حامله وممارساته، أضف إلى ذلك أن التقنية تغير العلاقات بين الحواس؛ فقبل اختراع تقنية الكتابة كانت المجتمعات تفكر وتفهم بطرق مختلفة عن الطرق التي رسخها الدرس الفلسفي في تعلم العلوم وإفهامها، يقول أونج: “لقد كان السمع وليس البصر هو الذي هيمن على العالم الفكري القديم بطرق لها دلالتها، واستمر ذلك طويلا حتى بعد أن تم استيعاب الكتابة استيعابا عميقا… وكانت المادة الكتابية تابعة للسمع بأشكال تدهشنا اليوم بغرابتها… لقد ظل التناول السمعي يهيمن حتى بعد تطوير الطباعة بوقت طويل، على النص المرئي رغم أن دور السمع تآكل مع مرور الزمن ومع ترسخ التقاليد الطباعية… فالطباعة تحل الكلمات في الفراغ بصورة أكثر صرامة مما فعلته الكتابة في تاريخها كله، فعلى حين تُحرك الكتابة الكلمات من عالم الصوت إلى عالم الفراغ المرئي، تحبس الطباعة الكلمات في موضعها داخل هذا الفراغ، والتحكم في الموضع هو كل شيء في الطباعة”[23]، بل إن “في الثقافة الشفاهية الأولية، حيث لا وجود للكلمة إلا في الصوت، دون إشارة من أي نوع إلى أي نص يُدرك إدراكا بصريا، بل دون وعي بإمكان وجود هذا النص، تدخل ظاهرية الصوت بعمق إلى شعور الكائنات البشرية بالوجود، كما تنتجه الكلمة المنطوقة.. ومن الواضح أن معظم خصائص الفكر والتعبير القائمين على أساس الشفاهية.. ترتبط ارتباطا حميما بالنظام الصوتي الذي يدركه البشر، وهو نظام يفضي إلى التوحيد وإلى الاتجاه نحو المركز، والنظام اللغوي الذي يسود فيه الصوت يتفق مع الميول الجماعية (والمساعدة على الائتلاف) أكثر من اتفاقه مع الميول التحليلية، التجزيئية (التي سوف تأتي مع الكلمة المكتوبة، المرئية، لأن البصر حاسة تجزيئية)”[24]، وكما تؤكد ذلك كلاريس هيرينشميت أن “الكتابة تجعل اللغة مرئية”[25]، لا سمعية، أي أن التقنية الكتابية تغير الفهم أيضا بتغيير العلاقات بين الحواس ومع كل اختراع تقني توجده المجتمعات الإنسانية، وقد يُعترض على ذلك بأن الحواس مجرد قنوات وأدوات للفهم، والحق أن هذا الاعتراض مبني على مفهوم الذات (أو النفس) كما يؤكد ذلك ابن رشد في تلخيصه لكتاب النفس لأرسطو[26]؛ فإذا تم نقض المفهوم الفلسفي للنفس تبعته لوازمه ولواحقه من المفاهيم المغلوطة، ومن الأصول التي بُني عليها الفصل بين الحواس والفهم أن الفيلسوف يفترض أن نفسه وذاته موجودة بلا أي تنظيم بما أنه هو الذي يصنع وينظم عالمه بنفسه، والحق أن هذا محض وهم لا يمت بالحياة اليومية بأي صلة، إذ “بحسب منظّري علوم الاتصال، باتيسون (Bateson) في الإنثربولوجيا، وغوفمان (Goffman) في علم الاجتماع، وفاتسلافيك (Watslawick) في علم النفس ..إلخ، فإن الإنسان لا يفعل وإنما يتفاعل، ولا يتفاعل مع عمل ما (أو موضوع ما) ولكن مع تفاعل آخر، وسلسلة هذه التفاعلات هي التي تشكل الرابط الاجتماعي”[27]، فأن توجد ابتداء كإنسان هو أن تكون داخل تنظيم وفهم معين، أو كما يصيغ الأمر القانوني الفرنسي آلان سوبيو “أن كل مولود جديد قد سمّي وأدرج في بنوّة: لقد أُسند له موضع في سلسلة الأجيال؛ ذلك لأنّه حتّى قبل أن نتمكّن من التلفظ بكلمة (أنا)، كان القانون قد جعل كل واحد منّا ذاتاً قانونية. فحتّى يكون الشخص حرّا، عليه أن يُقيَّد أولا بأقوال تربطه بالآخرين”[28].
إذن، من خلال ما سبق تبيينه ندرك أن الخاصية الأولى لمفهوم الدرس في التقليد الفلسفي يحمل في طياته إشكالات وأوهام تؤول به إلى ضد ما يدعيه ويصرح به، ولعل من أهمها أن درس الفهم يبدأ من وضعه داخل علاقات التفاهم مع الجماعة البشرية، وليس بالضد منها، وهنا يطرأ تساؤل عن أصل وطبيعة هذه العلاقات التفاهمية مع الآخرين التي نتشارك على أساسها معنى الفهم، كيف تتشكل تلك العلاقات؟ وعلى أي أرضية تنمو وتزدهر؟ إن الإجابة بعبارة مختصرة: التراث، فنحن نتفاهم ونمارس على ضوء ما تعلمناه من الجماعة البشرية التي ننمو ونتربى فيها، يقول هانز جورج غادامير عن أثر التراث في تشكل معنى الفهم:
“إن البحث في العلوم الإنسانية لا يمكن أن يعد نفسه في تناقض مع الطريقة التي نرتبط فيها نحن، بوصفنا كائنات تاريخية، بالماضي. بأي حال فإن علاقتنا العادية بالماضي لا تتميز بابتعادنا عن التراث، وتحررنا منه؛ بل إننا بالأحرى متموقعون ضمن التراث، وتموقعنا هذا ليس تموقعاً بإزاء موضوع، فنحن لا نتصور التراث شيئاً آخر، أو شيئا غريبا عنا. فالتراث دائما جزء منا، كنموذج أو كمثال أو كنوع من الإشارة المميزة التي تفيد أنه من الصعب لحكمنا التأريخي الأخير أن يُعتبر نوعاً من المعرفة، بل هو صلة روحية حميمة بالتراث.. إن الفهم الذي تتضمنه العلوم الإنسانية يشترك مع حياة التراث في شرط أساسي؛ وهو أن يدع نفسه لتوجيه التراث”[29]، أي أن يكون تلميذا له؛ فنحن لا نبدأ الفهم إلا عندما تخاطبنا لغة ما؛ لأن ذواتنا وأفهامنا تتشكل ابتداء داخل الروابط الاجتماعية بمختلف أنواعها من أبوة أو أمومة أو بنوة أو أخوة أو صداقة …إلخ؛ إذ نحن دائما في علاقة ما بخلاف ما يدعيه الدرس الفلسفي أن هناك ذاتا أولا تتكشف لنفسها وتسوغ وجودها عقلانيا وتفهم باستقلال أو بالضد من الآخرين؛ إذ هؤلاء الآخرون يحملون تراثا من حيث الممارسة تم تعليمهم إياه، لذلك يصر غادامير “أن أحد شروط الفهم في العلوم الإنسانية هو الانتماء إلى التراث”[30] لأنه هو الذي يجعل الفهم أمرا ممكنا، وكما يؤكد عالم الاجتماعي موريس هالبفاكس “إننا لا نتذكر إلاَّ بشرط أن نضع أنفسنا من جديد في تيار فكري أو في عدة تيارات فكرية بتعبير آخر، إننا لا نتذكر على الإطلاق لوحدنا”[31]، وفي الحقيقة أن هذا الشرط- أي أننا لا نتذكر لوحدنا وأن الذاكرة الشخصية مشروطة دائما بالجماعة- يجعل الدين بوصفه ممارسة- وليس مجرد تنظير- شرطا ضروريا لإمكان الفهم ذاته؛ إذ لا تخلو جماعة ما عبر التاريخ من الانتماء الديني وممارسته، بذلك يكون ادعاء الملحد لإلحاده مضاد تماما لإمكان الفهم أصلا، بل خالٍ تماما من المعنى؛ إذ ممارساته وسلوكياته اليومية تضاد تصريحاته؛ إذ كما يؤكد الانثربولوجي مرسيا إلياد أن “الإنسان العقلاني هو فقط تجريد، لا يوجد أبدا في الواقع.. إذ الانسان غير المتدين، شاء أم كره، ما زال يحتفظ بآثار سلوك الإنسان المتدين، ومهما فعل، فهو وريثها”[32].
وهنا نقطة ينبغي إيضاحها جيدا، وهي أن ربط الفهم بالتاريخ والتراث- كما فعلنا أعلاه مثلا في نقد مفهوم الصورة والقواعد المنطقية واختزال معنى الفهم فيها- لا يستلزم أن تكون علاقات السلطة بين الروابط الاجتماعية هي المعيار الذي يحكم عملية تشكل الفهم بل إن العلاقة في جذرها قائمة على الثقة المتبادلة بين تلك الروابط؛ إذ لو كانت مبنية على العلاقات السلطوية لامتنع تشكل التراث الذي ينمو فيه درس الفهم؛ لأن السلطة بطبيعتها لا ترى في ممارسات مَن سبقها حقيقة تحافظ عليها بل ستسعى لإقصاء التراث ونسيانه وتبديله؛ فالسلطوية تنطلق في جذرها من القطيعة مع المرجعية أو السعي إلى التحكم بها، لكن المفارقة أنها لا تستطيع ذلك إلا بالاقتباس من مرجعيات تراثية أخرى؛ لأن الإنسان العقلاني بشكل محض مجرد وهم، والسلطة كذلك، فهي في حقيقة الأمر لم تقطع مع التراث بل انتمت إلى تراث آخر فقط، وهذا تحقيق للشرط المذكور أعلاه، وهنا مسألة دقيقة نحتاج لإيضاح حتى نتبين أن العلاقات التي يهيئها التراث لتشكل الفهم ليست علاقات سلطوية بل علاقات تلمذة وتعليم وثقة، وهي أن السلطوية تفصل القواعد عن الممارسة، وتعزل المعيارية عن الفاعلية، وهذا امتداد في حقيقة الأمر لفصل الفهم عن الفاهم أو العارف عن المعروف، الذي ذكرناه أعلاه، وهذا الفهم الفوكوي للسلطة استمرار لكيفية فهمهم لمعنى الإله والدين، يقول الفيلسوف الألماني/الكوري بيونج تشول هان في كتابه: ما السلطة؟ “إن الإله من طبيعة سلطوية، وفهم هيجل للدين يأخذ تماما شكل السلطة الذي سيطر عليه كلية، وهذا غير القول بأن السلطة هي التي تحدد الدين في ذاته تحديدا أساسيا. لم يُعتبر للحظة واحدة احتمالية أن الدين بمقدوره أن يسمح بوجود أي مساحة لا تقع تحت سيطرة منطق سلطته، وذلك لأن خبرة الدين قد تكون تجربة في التواصل مختلفة جذريا، وعلى نحو أساسي عن استمرارية الذات وتواصلها الناتج عن السلطة، وذلك لأن الدين يعبر عن الحركة القوية أو النوعية الشديدة التي ليست أي شيء سوى ارتداد نحو الذات”[33]، وهذا الفهم للدين وعلاقة المجتمعات بالإله مغلوط تماما؛ لأنه عائد في أصله إلى خلط الممارسات الدينية بمباحث الفلسفة والميتافيزيقا، وكما يقول الانثربولوجي روبرتسون سميث أثناء شرحه لطبيعة التدين في المجتمعات السامية القديمة: “الدين بالمعنى الحقيقي للكلمة لا يبدأ بخوف غامض من قوى مجهولة، بل بتقديس ودي لآلهة معروفة ترتبط بأتباعها بأواصر قربى وثيقة… ويبدو في الدين القديم عند الساميين أن الثقة في العناية الإلهية لا تخص كل إنسان في اهتماماته الخاصة؛ بل تخص الجماعة في مهامها وأهدافها العامة”[34]، إذن، الفارق بين العلاقات التراثية التي ينمو فيها درس الفهم دون سلطوية أنها قائمة على ترسخ الثقة المتبادلة داخل الجماعات البشرية، وهذا يطرح علينا تساؤلا عن كيفية دخول مشكلة السلطة في دراسة الفهم، والإجابة عن ذلك تطرنا إلى بحث تشكل الدولة الحديثة وأثرها على المجتمعات عموما، وهذا ليس مجال أطروحتنا.
الخلاصة التي نريد أن نؤكدها في نقدنا لهذه الخاصية في الدرس الفلسفي أن التلمذة شرط ضروري لإمكان الفهم، وأن الثقة- وليس السلطة- شرط أيضا لإمكان التراث وتشكله على المدى الزمني الطويل، وحين نتتبع أصول استبعاد التلمذة من شروط الفهم سنرى أن ذلك عائد إلى فصل قواعد الفهم عن ممارسته، والحق أن كل تفسير لقواعد الفهم بالقواعد أيضا سيُرجعنا إلى تسلسل لا نهائي، لذلك تقول ماري ماجين في تحليلها لمعنى قولنا (فهمت الآن): “أنا أستخدم جملة (الآن فهمت) بخلفية تاريخية معيّنة؛ مثل: إنني تدربت على استخدام صيغ الجبر، أو لدي قدرة خاصة على رؤية الأنماط المتعددة، أو أنني تدربت على إدراك السلاسل العددية بما فيها هذه السلسلة. فاستخدامي للكلمات لا يتعلق بملاحظة عملية ما أو افتراضي لعملية ما لا أراها، إنما ببنية الحياة التي كوّنت ثقافتنا، والتي تُكشف بالنظر إلى شكل أو نمط أدائي الماضي، وهذه الخليفة التاريخية هي التي أعطت لكلماتي هذه الدلالة التي تمتلكها…إن نحو مفهوم الفهم لا يذهب بنا بعيداً إلى الداخل بالقرب من حالة آلية معينة، ولكن ينتشر على سطح ممارستنا ويرتبط بالأشكال المعقدة والمتضمنة داخل صورتنا الخاصة عن الحياة… إن تعليم طفل استخدام كلمة (الآن فهمت) لا يلفت انتباهه إلى شيء يحدث في عقله أو إلى ترابط تجريبي بين التفكير في صيغة واتباعها بشكل صحيح، بل يقوم المعلم بتشجيع النماذج المنبثقة في سلوك الطفل التي تدل على زيادة تمكنه من اللغة، فيستجيب الطفل بدوره بشعور بمزيد من الثقة والبراعة”[35]، وفي الحقيقة هذا أمر تؤكده البحوث الإنثربولوجية لأشكال الدين في المجتمعات البشرية القديمة أيضا، يقول روبرتسون سميث: “لم تكن الديانة في العصور البدائية نسقاً عقائديا ذا تطبيقات عملية، بل كان مجموعة من الممارسات الثابتة الموروثة يؤمن بها كل فرد من أفراد المجتمع باعتبارها مسلمات… إذ كان التطبيق العملي يسبق النظرية العقائدية”[36] ويقول أيضا باسكال فيرنوس أثناء شرحه لمعنى الدين في مصر قديما: “إن الديانة المصرية القديمة ليست نظرية ممنهجة تمثل نتاج فكر متأمل جالس وحيدا في غرفته. لقد تطورت بقوة الآلاف من الممارسات..”[37]، إذن، إن التلمذة على التراث شرط ضروري لإمكان الفهم واستمراره، وأي محاولة للقطيعة مع هذا الشرط يضاد إمكان الفهم من أصله[38]، والفهم بهذا المعنى ممارسة عابرة للزمن.
الخاصية الثانية (الشك النظري):
إن من أهم ما يبدأ به درس الفهم في التقليد الفلسفي استشكال كل مسلمة أو ممارسة حتى يبدأ الفهم خالصا صافيا من الأوهام والخرافات؛ لذا فإن “إثارة المشكلة هي أول خطوة في بنية ومسار الدرس الفلسفي، تتحدد انطلاقا من وضع المكتسبات موضع تساؤل ومراجعة وتشكيك. وأن اقتضاءها المنهجي محكوم بثنائية الطريقة والهدف: فهي كخطوة أولى؛ تؤسس لبعث الطريقة الحوارية في إثارة التفكير وتحريكه حيث إن تحويل المسلمات إلى مشكلات يحيل المتعلم إلى فاعل متفاعل مع العلم لا منفعل به”[39]، يقول الفيلسوف الأمريكي جوزيه رويس: “الروح التي لم تمارس الشك لا تعرف ما تؤمن به، وفي كل الأحوال، الشخص أو المفكر الذي لم يعش تجرية الشك لا يحق له الارتقاء لدرجة الفيلسوف”[40]، إذن، الخاصية الثانية لدرس الفهم في التقليد الفلسفي هو الشك والارتياب من كل ما يتم تعليمه من الجماعة البشرية عموما، ووضع كل الاعتقادات على طاولة النقاش والجدل؛ لذلك نرى تضخم مفهوم البرهنة المنطقية في كل جزئية في المعرفة النظرية؛ فمن البرهان على وجود الإله إلى البرهان على وجود العالم الخارجي مرورا بالبرهنة على وجود عقول أخرى إلى غير ذلك من محاولاتهم للتخلص مما زرعته أفهامهم وحصدته شكوكهم[41]، يقول ابن رشد في تفسيره لكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو: “الطريق إلى حصول العلم هو أن تقع أولا تلك الشكوك التي هي سبب غموضها ثم تنحل من قبل أن نسبة الشكوك من النفس نسبة الرباط من الأعضاء ونسبة العلم الحاصل بعد تلك الشكوك نسبة الحركة المطلوبة بعد حل الرباط”[42]، وقد نتوهم بأن معضلة الشك أمر فلسفي محض لا علاقة لتشكل المجتمعات المعاصرة به، لكنه منذ تشكل الدولة العلمانية الحديثة وهي تعامل المجتمعات من منطلق فرداني كما يؤكد ذلك ميشيل مافيزولي[43]؛ فالدولة العلمانية الحديثة ليست أداة قسر وإكراه فقط، وإنما أداة إنتاج وإعادة إنتاج للمخيال والمفاهيم الاجتماعية بل كما يؤكد بيير بورديو فـ”إن الدولة (العلمانية) تبني وتُنشئ مقولات الإدراك ثم تفرض ما تبنيه من هذه المقولات على الفاعلين”[44]، وخلاصة الأمر في علاقة الدولة العلمانية الحديثة بدراسة الفهم أنها كما يعبر بورديو في موضع آخر أيضا “أن الدولة مُوحِّد نظري، إنها منظِّر من أهل النظر، فهي تنفذ توحيد النظرية، أو توحيدا لنظرية؛ تأخذ زاوية نظر أو نقطة مركزية ومرتفعة”[45] ثم تفرضها على موضوعاتها من المواطنين؛ إذ المواطن في منظور الدولة العلمانية الحديثة ليس سوى موضوعٍ من موضوعاتها؛ لذا فإن إمكانات فهمه مشروطة بحدود النظرية التي تتيحها له، وهذه الفردية التي تنتجها الدول العلمانية تنزع نحو التخلص من عبء المجتمع الذي تترعرع وتنبت فيه بكل حمولاته التاريخية والتراثية؛ إذ طبيعة المسؤولية وعلاقتها بالفهم اختلف جذريا عن طرق تحمل المجتمعات القديمة لهما[46]، فكما أن المرء لا يتذكر بمفرده- كما قررنا ذلك أعلاه- بل من داخل جماعة لغوية ممتدة عبر الزمن فإنه أيضا يستمد معنى وحِمل مسؤوليته وفهمه من هذه الجماعة الممتدة، فمعالجة معضلة الشك إذن ليست معالجة لأمر نظري لا يمت بأي صلة بحياة الناس اليومية بل إن المجتمعات المعاصرة تُصاغ وتُهندس على ضوء هذه المعضلة الشكية التي بدأت بعيدا عنها، باختصار صار الشك تحت حماية الدولة العلمانية الحديثة شأنا عموميا مشاعا لا ينضبط بأي ضابط سوى الأهواء والرغبات، إنه شك مبتذل! والدخول معه في جدل معرفي أو محاورة نظرية يرسخه في سياقات المجتمعات المعلمنة؛ إذ من شروط علمنة المجتمعات أن يُطرح الشك بوصفه خيارا مع الخيارات الإيمانية، وحتى يصل لمبتغاه ينبغي أن يكون الشك الفلسفي ذا دلالة ومعنى في المدينة العلمانية، ومن أصول إساءة فهم المؤمنين لطبيعة الشك أن معنى الفهم في التقليد الفلسفي يبدأ بالضد من مكانيته؛ إذ من لوازم فصل الفهم عن حامله فصله أيضا عن معنى أن يكون الفهم في مكان ما- أي باختصار شك نظري- وإن هذا الفصل بين الفهم ومكانيته تُوهمه بإمكان الفهم دون الحاجة لسياق أو مجتمعات، وإن المدينة العلمانية بمبانيها وعمارتها وطرقها تؤطره وتوجهه بحسب أهدافها ورغبات مصمميها؛ إذ نحن دوما في تنظيم ما، وكما يؤكد أستاذ الحوسبة المعمارية ريتشارد كوين أن المهمة الرئيسية للعمارة: تفسير أسلوب الحياة الصالح… وأن العمارة الحديثة أتت إلى الوجود لمساعدة الإنسان على أن يشعر بالألفة في العالم[47] أو بالاغتراب عنه، ومن ثم فإن الفهم كما أنه داخل علاقات زمانية (تراثية) فإنه أيضا داخل علاقات مكانية تؤثر ضمن مؤثرات أخرى في فهمه وما يقبله أو يرفضه أو يشك ويرتاب فيه، ومن يصنع وينظم مكانية الفهم يؤثر في أفهامنا ومنظوراتنا، ومن ثم يجعل للشك معنى، وهو في هذه الحالة: الدولة الحديثة؛ لذلك استبعادها عن دراسة معنى الفهم في البحث الراهن يضللنا ويحرفنا عن تتبع تشكلات أفهامنا، بل إن علاقات الفهم قد تبدل بين وظيفتي المكان والزمان؛ إذ نجد ذلك في بعض المجتمعات، فمثلا “إن تسمية أغلب الأيّام في الجاهلية العربية بأسماء الأماكن التي حصلت فيها الوقائع يدل على الرغبة في تأسيس ذاكرة حية لجغرافيا الصراع … وبذلك يكتسب المكان لدى الجاهليين وظيفة زمنية”[48]، أي إن وعي المجتمع العربي ببيئته في تلك الفترة نقل المكان إلى مؤثر صريح في تفسيرهم لأنفسهم، ومن يتتبع التنظيم المكاني في الدول الحديثة يلاحظ أن اظهار أمكنة دون أخرى عائد لتعيين الزمان وتكثيفه فيها، وهذا من طرق اظهار قدسيتها وعظمتها، ومن ثم تأثيرها على الفهم اليومي، ومن منظور انثربولوجي فإنه “كان التنظيم الاجتماعي أنموذجاً لتنظيم المكان الذي هو أشبه بنسخة طبق الأصل عن التنظيم الاجتماعي. حتى بدء التمييز بين اليمين واليسار، كان كلّ تنظيم مكاني نتاجاً على الأرجح لتصوّرات دينية وبالتالي جمعية”[49]، لذلك كانت المجتمعات القديمة تمارس نوعا من العناية والرعاية له؛ إذ هو يعكس هويتها، ومن ثم فهمها.
حينما نحلل أسباب ظهور المعضلة الشكية في الدرس الفلسفي فإننا سنجد أن من الأسباب الرئيسية لظهورها أنه يُحوّل الممارسات الاعتقادية والعادات الاجتماعية إلى تصريحات نظرية ومعرفية؛ لأن الفلسفة تنطلق من دراسة الوعي ابتداءً، فالمشكلة الأساسية عند الفلاسفة هو سؤال: كيف صار الوعي ممكنا؟ وكيف نسوغه عقلانيا؟ لذا فإن “الفلسفة تحقق دورها عندما تُهيّئ منظومة من المعرفة، وتنجز بذلك التسمية التي وُجدت عليها، أي: محبة المعرفة”[50]، أي أن الفعل والممارسة أمر إلحاقي بالتنظير المعرفي، وفي سعيها إلى ذلك تقع في إساءة استعمال اللغة اليومية والممارسات المضمنة فيها ومن ثم تغيير معانيها ودلالاتها، أي أن الدرس الفلسفي بتغيير استعماله للغة يغير الممارسات القاعدية[51] التي يقوم عليها معنى التفاهم داخل مجتمع وتراث معين؛ لأنه كما ذكرنا سابقا أن لغة الفيلسوف تعمل بالضد من استعمالات المجتمع للغة، فهل تستعمل اللغة اليومية كلمة (أنا أعرف) كما يستعملها الفلاسفة أم لا؟ إن اللغة الفلسفية بانطلاقها من مشكلة الوعي كأساس تجعل المعضلة الشكية إحدى المضمرات المنهجية التي تستبطنها؛ إذ ما معنى أن يتساءل المرء أنه واعٍ دون افتراض أنه ربما يحلم أو يشك في كونه واعياً على الحقيقة مثلا؛ لذا فإن التصريحات النظرية لعبارات كـ (أنا أعرف) أو (أنا أفهم) تقع دائما في ظِلال من الشك والارتياب.
يحاجج لودفيج فيتجنشتاين أثناء اعتراضاته على جورج إدوار مور في كيفية استعماله لصيغ التعبير بالمعرفة قائلا “أن رؤية مور تنحدر بالفعل إلى الرؤية الخاطئة المنطوية على أن المعرفة هي حالة ذهنية استبطانية، تلك التي تضمن ما هو معروف، فالاستعمال الخاطئ لقضية (أنا أعرف) يكمن في اعتباره إياها مثل الكلام الذي نادراً ما يخضع للشك كقضية (أنا أتألم)”[52]، إذن، أصل المعضلة أن الدرس الفلسفي يحوّل كل ممارسة اعتقادية أو شعور أو انفعال إلى حالة معرفية استبطاينة، وبذلك يكون الفهم أيضا في الدرس الفلسفي حالة استبطانية أو فينومينولوجية.
تقول ماري ماجين في شرحها لمعنى الفهم عند فيتجنشتاين وسبب اعتراضاته على الدرس الفلسفي عموما:
“إن الصورة الزائفة للارتباط بين ما يحدث في عقل المتكلم عندما يسمع كلمة ويفهمها، واستخدامها الذي سيقوم به فيما بعد، تتصل بفكرة أن فهم المتكلم للغته هو نوع من الحالة النفسية التي هي مصدر قدرته على المضي قدماً في استخدام لغته بشكل صحيح”[53].
ما تشير إليه ماجين أن الفهم ليس فقط غير مرتبط بالحالة النفسية أو بالعالم الداخلي للفاهم بل إنه يرتبط بنموذج معين من النشاط الحياتي أو الممارسة أو العادة العملية، وليس بشيء يحدث في عقل وذهن الفاهم، فالفهم إذن مشروط بالعمل والممارسة، بل إنه ينمو وينبت من داخلهما، و إن العمل الذي يرتبط به الفهم متعلق بأعمال الآخرين أيضا؛ فهناك مضمرات سلوكية إذا صُرِّح بها وانتقلت من الاعتقاد المضمر في الممارسات والعادات الاجتماعية إلى التصريح النظري صارت خالية من المعنى وغير مفهومة في اللغة اليومية، مثلا؛ يصرح أحدهم في محفل عام (أنا إنساني) أو (أن وعيه في دماغه)، هل كان القائل قبل تصريحه حيوانا؟! أو كان عقله في موضع آخر؟![54] أو يقول أحدهم (أنا موجود)! لا معنى لهذه التصريحات سوى أنها تفترض ابتداء معضلة شكية لا أساس لها في لغة الناس وتفاهماتهم اليومية، هذا اللغو من التصريحات النظرية والفلسفية يمثل معضلة أساسية في الدرس الفلسفي وحالاته من الفهم عموما؛ لأنه ينقل الممارسات الاعتقادية المضمرة التي تظهر في سلوكيات الناس دون استدلال عليها إلى معرفة نظرية ثم تجعل النظر أصلا للعمل وتؤطره به، ومنشأ ذلك أنهم يفصلون فصلا حادا بين المعنى والمعرفة، وعلة هذا الفصل عندهم هو افتراضهم لعوالم فلسفية يسندون إليها معارفهم، وأيضا لأنهم ينطلقون في دراسة الفهم من منطلق ذاتي؛ إذ لو كانت منطلقاتهم من منظور اجتماعي تعليمي لدخلوا في اللغة اليومية للجماعة البشرية، ومن ثم امتنع فصل المعنى عن المعرفة؛ إذ الفصل بينهما يجعل التفاهم ضبابيا ومشتبها بما أنه ذاتي وشخصي[55]، وقد يعترض أحد الأذكياء بالتالي: إذا كان شخص ما يعرف (أ) ويعرف أن (أ) تضمر (ب) إذن هذا الشخص يعرف أيضا (ب)؛ إذن يمكنه التصريح به دائما، يمكن أن نصطلح على تسمية هذا الاعتراض بـ (اعتراض الإلزام النظري) الآن حتى نفهم؛ ما المعضلة؟ المعضلة هي أن دراسة الفهم في الدرس الفلسفي ينقل الاعتقادات المضمرة في الممارسات والعادات الاجتماعية التي يقر بها الجميع إلى معرفة نظرية؛ فما الإشكال؟ الإشكال بما أنها التزمت التنظير لما أصله اعتقاد ممارس وعادة مضمرة مجمع عليها في تراث ما؛ فينبغي على المعترض إذن التزامه النظري دوما به، وإلا ما فائدة التنظير؟! وأول الإشكالات هو: متى تتوقف سلسلة الإلزام النظري؟ وطبعا الإجابة التي يتم تجهيزها دوما إلى أن نصل إلى البدهيات العقلية التي في العالم النفسي للفاهم أو في عقل/دماغ الفيلسوف، فلو جاء فيلسوف مشككٌ وقال: أريد أن أطرد مع (اعتراض الإلزام النظري) وأشكك في البدهيات أيضا؛ لأن معيار الفهم شأن نفساني أو داخلي استبطاني؛ فإن الإجابة الجاهزة أيضا في الدرس الفلسفي والنظري أن ذلك يجعلنا ندخل في السفسطة وانعدام المعايير، فسيجيب المشكك: يحق لي في التنظير ما يحق لكم، بل أنا مطرد مع التنظير بخلافكم! وليس لدى مدرسي النظريات والفلسفات سوى إرجاعه إلى الممارسات الاعتقادية والعادات الاجتماعية التي يُضبط بها سلوك المشكك فيستدلون بها على امتناع التزام (اعتراض الإلزام النظري) الذي بدأوا به تصريحاتهم النظرية في دراسة معنى الفهم! وحينها سينقطع تشكيك المشكك دون انقطاع تنظيره للفهم؛ لأن الدرس الفلسفي يجعل كل اعتقاد ممارس مفهوما نظريا وليس عمليا من حيث البدء، هذا الشكل من تدريس الفهم يقع في كوارث؛ من أشنعها أنها لم تلتزم باعتراضها الأصلي، بل تجاهلته حينما واجهت التحدي الشكي، أي أنها تعارض وتضاد ما تدرسه نظريا؛ فبأي معنى يكون هناك فهم إذا عارضنا في آخر تنظيراتنا ما نقرره في أولها؟! ثانيا أنها تقع في ازدواجية المعايير والمصادرة، ففي حين تُجوّز لنفسها التنظير بعيدا عن الممارسات الاجتماعية فإنها تمنعه حينما لا يوافق نموذجها النظري، ثالثا أنها تفصل بين الفهم والممارسة؛ وبذلك تقرر تصريحات نظرية وأسماء وأخبارا ليس لها إحالة خارجية بل إحالتها مشروط بالنموذج النظري النفسي والاستبطاني، أليست هذه إحدى خصائص الميتافيزيقي؟! والأسوأ من ذلك كله أنها تُسكِّن وتبيئ الشك داخل اللغة وتجعل له معنى، وحتى في حال انقطاعه ما زال لتشكيكه معنى مفهوما حسب الدرس الفلسفي؛ إذ هو دائما حاضر بشكل مضمر في دراسة الفهم في التقليد الفلسفي، وهذا في حقيقته كارثة لأي دراسة في معنى الفهم؛ لأنها لا تفرق بين الشك في الحياة اليومية والشك الفلسفي، ومن الفروق المهمة بينهما أن الشك في الحياة اليومية لا يقع إلا في حالة من النسيان أو على جزئيات محدودة مضبوطة بسياقات الكلام والممارسة الاجتماعية، أي أنه يقع وهو مقر ابتداء بأنه منمذج ومؤطر وفق ممارسات تفاهمية وذاكرة تراثية بخلاف الشك الفلسفي فإنه يسعى للبدء من الدرجة الصفر للذاكرة، أي كمؤسس لأي ذكرى أخرى.
يقول آلان بادلي في كتابه الذاكرة الإنسانية: “يُفترض عموما أن الذاكرة تشبه مكتبة واسعة، وهي مماثلة لها حدودها، لكنها يمكن أن تكون مفيدة. وبصيغة ما تشبه الذاكرة المكتبة في أن أيا من هذين النظامين لن يشتغل بفعالية إلا إذا خزنت المعلومة بكيفية نسقية ومبنينة، ويرتبط استرجاع المعلومة آنئذ بهذه الفهرسة”[56] المنظمة، أي يلزم أن يكون هناك سياق حياتي لتعمل الذاكرة وتمارس وظائفها فيه، وما ليس قابلا للعيش ليس قابلا للفهم؛ والسعي لمحاولة تنظير فهمه يضاد المعنى من وجود المجتمعات البشرية؛ لذلك كان الشك الفلسفي لغوا وبلا معنى البتة.
نخلص مما سبق أن دراسة الفهم من منطلق شكي وارتيابي يسيء لمعناه أولا وكيفية تشكله وتعلمه وحاجته إلى زمان/مكان ممتد والحاوي الاجتماعي له، بل إن كل فهم يبدأ من اعتقاد ممارس في حقيقة الأمر، وليس من البرهنة، وهذا شرط ضروري لمعنى أن يتحدث الإنسان لغة ما، وامتناع وجوده خارج اللغة أصلا؛ لأن البرهنة تفترض شكا وارتيابا- ابتداءً- في حين أن الممارسة الاعتقادية تُبنى على الثقة.
الخاصية الثالثة (اللغة الخالصة):
من التأثيرات التي ظهرت بعد اختراع تقنية الأبجدية والكتابة على طرق الفهم ونقل العلوم أنها دفعت بمرور الزمن إلى الشروع في محاولات لابتكار لغة للعلم والفهم خالصة نقية من الاستعارات والأمثال والتخييل..إلخ- وذلك من آثار استبعاد اللغة عن سياقاتها كما نبهت لذلك عالمة الآثار كلاريس هيرينشميت والانثربولوجي والترج أونج وغيرهما- أي إلى لغة صناعية تبتذل اللغة الطبيعية واستعمالاتها التي لا يمكن ضبطها دون حاجة للعودة لسياقات التكلم المتخمة بدورها بالاستعارات والتمثيلات والكنايات، يقول ابن ملكا البغدادي: “وأما التمثيل فإنه تعريف الشيء بنظائره وأشباهه والكلي المعقول بجزئياته وأشخاصه ومحسوساته.. كتعريف العقل بالنور.. وهو كثير النفع في التعاليم لتقريبه على المتعلمين وتخفيفه عن المعلمين ومع ذلك فقلما تحتاج إليه الأذهان القوية وتلتفت عليه الغرائز الذكية خصوصا إذا ارتاضت في العلوم وتمرنت في الفهم والتفهيم والعلم والتعليم ويعدونه كلفة وهذرا في الأقاويل المعرفة”[57]، وفي حقيقة الأمر أن من أسباب ظهور هذا المشروع الأفلاطوني أن تقنية الكتابة تُوهم بأن لغة التفاهم ممكنة دون ضرورة العودة إلى سياقات الكلام اليومي؛ لأن هذه العودة تجعل الارتباط الشخصي والحميم من شروط الفهم، ومن ثم عدم الفصل بين العارف والمعروف، والفاهم ومفهوماته، وهذا يضاد ما يعتبره التقليد الفلسفي شرطا لإمكان الفهم أصلا، ويرجع أصل هذا الرفض إلى الفلسفة الأفلاطونية إذ “إن النسق الأفلاطوني يقوم على تصور وجود عالمين، عالم محسوس يتضمن أشياء هي في حقيقتها صورة لشيء آخر يحيل عليها، وعالم معقول يعد أصلاً في وجود عالم الحس المتغير، وبذلك ستكون المحاكاة، التي هي في الأساس نسخة من الدرجة الثانية لواقع هو نفسه نسخة للفكرة المطلقة، أساسا في رفض أفلاطون للأعمال الفنية بشكل عام وللشعر بشكل خاص”[58].
عندما نحلل الأساس المعرفي لاستبعاد وإفراغ لغة العلم والفهم من الاستعارات والتخيلات والتمثيلات سنلاحظ أن مفهوم التعريف (الحد) الذي قدمه المنطق الأرسطي هو الجذر لهذه المحاولات الوهمية لصنع لغة موضوعية خالصة، إذ به يعين مفردة لغوية في مقابل مرجع خارجي[59]، والحد مبدأ البرهنة[60]، وبه تحصل الصور الذهنية أو تتمايز به الأشياء، و”المواد الأولى لجميع المطالب هي التصورات”[61]، ومنها يبدأ مشروع لغة العلم الخالصة، وفي حقيقة الأمر إن “مشكل الماهية هو عين مشكل اللغة والتسمية”[62]، و”الفيلسوف لا ينظر إلى الحد على أنه مجرد آلة تسدد الذهن نحو تصور ماهيات الأشياء وتقيه من الوقوع في الغلط بشأنها، بل ينظر إليه أيضا على أنه يدل على طبيعة الأشياء وجوهرها”[63]، إذن، ما هو الاسم الذي يبدؤون به للفصل بين الاستعارات ولغة العلم؟ ابتداء ينبغي التأكيد على أن التعريف المنطقي للاسم عائد إلى المفهوم الفلسفي للنفس كما يؤكد ذلك الفارابي قائلا أن “ما يخرج بالصوت وهو الألفاظ دال أولا على المعقولات التي في النفس”[64]، وكما يسميه أيضا في موضع آخر: “المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهم، ويسمونها النطق الداخل”[65]، وكما يؤكد ذلك ابن رشد في شرح البرهان لأرسطو بقوله: “والبرهان هو بحسب النطق الداخل، لا بحسب النطق الخارج”[66]، إذن، فإن الأساس الأول الذي قام عليه مشروع اللغة الخالصة والمفرغة من الاستعارات والتمثيلات هو مفهوم النفس (أو الذاتية) الذي نقدناه في الخاصية الأولى، والأساس الثاني هو اختراع تقنية الكتابة؛ إذ التقنية الكتابية تحبس الصوت في صور كما بينا ذلك أعلاه، فمشروع استبعاد التخييل عن لغة العلم ليس أصيلا بل وليد ظروف تاريخية أدت به إلى هذه النزعة من إعادة إنتاج تقنية الكتابة للغة الفهم؛ إذ كما يؤكد الانثربولوجي روبرتسون سميث قائلا “ليس في الفكر القديم حد فاصل بين المجازي والحَرفي، أو بين أسلوب التعبير وأسلوب إدراكه”[67]، والأمر ليس شأنا حدث في الفكر القديم فقط ولا يحدث في طرق الإدراك والفكر في المجتمعات الحديثة؛ إذ يتتبع لايكوف وجونسون أثر الاستعارات في كل أشكال الفهم اليومي- بما في ذلك لغة العلم- قائلا: أن “الاستعارة حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية. إن النسق التصوري العادي الذي يسير تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس”[68]، إذن، فإن السعي نحو اصطناع لغة خالصة تقع في مفارقة غريبة فهي من جهة تزعم أنها لغة لا تخضع لصيرورة التاريخ، ومن جهة أخرى هي نتاج شروط تاريخية!
إذن لنقض الدعوى الوهمية لاستبعاد الاستعارات عن لغة الفهم ودراسته ينبغي أن ننطلق من نقد مفهوم الماهية؛ ومشكل الماهية هو عين مشكل اللغة والتسمية كما يؤكد بول ريكور وغيره، هناك عدة تعريفات للتقليد الفلسفي والنماذج العلمية المتأثرة به لمفهوم الاسم، منها مثلا:
التعريف الأول: “الاسم لفظة مفردة دالة على معنى يمكن أن يُفهم وحده وبنفسه من غير أن يدل بذاته وبنيته وشكله على زمان ذلك المعنى”[69].
التعريف الثاني: “يعرف الاسم بأنه الذي يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصَّل”[70].
ومن التعاريف ندرك أن من سمات مفهوم الاسم الذي يقوم عليه مشروع التأسيس الأرسطي للغة الخالصة غير ما ذكرنه أعلاه هي:
- أنه لفظة مفردة تدل بمفردها على معنى في نفسه.
- التجرد عن الزمان.
يتصارع على تفسير السمة الأولى كلا من الفلسفات التجريبية والفلسفات المثالية؛ فالأولى تزعم أنه معنى منتزع من المحسوسات، في حين أن الفلسفات المثالية تقر بوجود عالَم مفارق يضمن دلالة اللفظة لمعناها بمفردها، ورغم الصراعات الفلسفية حول معنى (دلالة اللفظة المفردة على معنى في نفسه) فإن كل الاتجاهات الفلسفية تتفق على افتراض التكافؤ بين اللفظة المفردة والمعنى- مع اتفاقات أخرى ذكرناها سابقا- أي أن الاسم يحيط ويعين الشيء الذي يسميه بغض النظر عن تعدد السياقات أو العوالم الفكرية أو الأزمنة[71]؛ إذ التعيين مبدأ أساسي لإرجاع الفهم إلى محض نظرية؛ لذلك يتفقون حول دعوى التكافؤ، وإن الفلسفة رسخت تقليدا نظريا يدور على أن عمل اللغة هو الإحالة سواء إلى النفس أو إلى الخارج أو للتطابق بينهما بلا أدنى تأثير لها على عمليات بناء الفهم ونقله، والاستعارات والتمثيلات والتخيلات تعارض- وفقا لهم- الروابط الصلبة والخالصة بين الاسم والمعنى- الخارجي أو النفسي- فتمتنع المطابقة النظرية بينهما كما يؤكد ذلك الشهرزوري قائلا: “ومن جملة التعريفات (المثال) كتعريف العقل بالنور.. وهذا وإن كان بعيداً عن معرفة الحقيقة بل مانعاً ومنافيا من وجه، فلا يخلو من فائدة للعوام والقاصرين عن تصوّر الكنه”[72]، فاستبعاد التمثيلات من لغة الفهم عائد في الأصل إلى فلسفات الماهية باختلاف اتجاهاتها.
إذن، لنقض هذه السمة الفلسفية حول معنى الاسم ينبغي أن ننقض اختزال دور اللغة في تعيين الإحالات، ومشكلة التعيين فرع عن الثنائية الفلسفية= داخل النفس وخارجها، ومن جهة أخرى فإنها نفس المشكلة الحديثة في فلسفة اللغة المعاصرة حول اسم العَلم؛ إذ كلا منهما يسعى لدراسة طبيعة انطباق التسمية على المعنى[73] أو المساواة بينهما، أي طبيعة المقابلة والمبادلة بين الاسم والمرجع الذي يسميه- سواء كان في النفس أو في الخارج- لذا حين درس ويلارد كواين طبيعة العلاقة بين الاسم ومرجعه اعتمادا على تعدد المتكلمين بالاسم عن الشيء لاحظ أن محاولات وصف الشيء بلغة ما أو وصفه ونقله من لغة إلى أخرى يكون افتراضيا وتقريبيا فقط مع امتناع تعيين المرجع، أي أن السياقات اللغوية تغير وتعدد الأوصاف والتأويلات للشيء[74]، ومن ثم طرق إدراكه، لأنها كلها تصفه بأعراضه، فلا وجود لماهية ثابتة مع تغير سياقات التسمية، بحيث يمتنع انطباق الاسم على الماهية، أو بالأصح، إن افتراض وجودها خطأ محض؛ لأنها تفرض فصلا بين العارف والمعروف، وبعبارة تقريبية أخرى يكون الاسم دائما ناقصا يُكمله تاريخ تشكله في اللغات الطبيعية التي يُستعمل فيها، أي أن الاسم بما أنه في سياق لغوي دائما فلن يكون اسما خالصا، ومن ثم يتغير معناه بتغير تلك السياقات، مما يعني أن مرجع الاسم يتغير أيضا؛ لأن الوظيفة التواصلية للغة تبني المرجع الذي تتحدث عنه باستمرار، ولنضرب لذلك مثالا توضيحيا “ينطلق هذا الفيلسوف الأمريكي من موقف الترجمة الجذرية: هناك عالِم لسانيات يجد نفسه أمام لغةٍ لا يعرفها ويجب عليه أن يتعلمها بواسطة الطريقة المباشرة، أي بمراقبة ما يقوله المتكلمون المحليّون في الظروف التي يصادفونها أو يتخيلونها. إنه لا يملك معجماً وُضع من قبل وليس أمامه شيءٌ آخر سوى السلوك. لنفرض أن عالم اللسانيات هذا لاحظ نوعاً من التلازم بين مرور عدد من الأرانب ونُطق المتكلمين المحليين بعبارة (غافاغي). من الممكن أن يفترض هذا اللساني أن (غافاغي) تدل على (أرنب) ولكي يختبر افتراضه هذا، يعرض على مُخبر العبارة (غافاغي) في شكل سؤال عندما يكونان سوية أمام أرنب ومع الإشارة إليه بإصبعه. فإذا أجاب المُخبر بالموافقة، هل يستطيع الاستنتاج بأنه حصل على الترجمة الصحيحة؟ يجيب كوابن: بلا، لأن المتكلم المحلي كان ليعطي بالضبط الجواب نفسه لو كانت (غافاغي) تدل على (جزء لا يتجزأ من الأرنب) أو على (مقطع زمني خاص بالأرنب). الترجمة غير معينة، هناك عدة افتراضات تتلاءم مع المعطيات السلوكية. فليس لدينا مقياس فعلي للترادف نساوي به بين (غافاغي) و(أرنب)”[75]، ولنطبق هذا المثال على أطروحتنا هذه حول معنى الفهم لنفترض أن أستاذ ما يدرس معنى كلمة (فهم) ولنضع في اعتبارنا أنه ينطلق من معيار نفساني، فإذا أراد أن يعين معنى كلمة (الفهم) بالإشارة إلى سلوكيات أو ممارسات ما أو عندما يشرح لفظة (فهم) لشخص ما، فهل يستطيع التلميذ الاستنتاج بأنه حينما تُعين الإشارة ممارسات ما أنه أدرك المعنى؟ الإجابة أيضا: بلا، لأن المعيار الذي ينطلق منه الأستاذ= نفساني، فما في نفس الأستاذ قد يعني أمرا آخر عما في نفس التلميذ، ما دام المعيار هو المفهوم الفلسفي للنفس، وهذا إحدى تمظهرات المشكلة المسماة في فلسفة العقل المعاصرة بمعضلة العقول الأخرى، أي أن المعاني تتعدد بتعدد مفسريها إذا اختزل معيار المعنى في المفهوم الفلسفي للنفس، أضف لذلك أن تعليم معنى الإشارة نفسه مفتقر لسياق اجتماعي وتاريخي، فهل نتعلم الإشارة بإشارة أخرى؟! فكيف ندرك معنى لفظة (فهم) إذن؟ احدى أهم الشروط هو العودة بمعناها إلى تاريخ تشكلاتها في اللغات الطبيعية، وكيفية ممارسته فيها، وهذا يُدخل الاستعارات في عمق عملية الفهم ودراسته؛ لأنه يمتنع الفصل بين اللغة الطبيعية وبين الاستعارات والتخيلات ..إلخ، ومن ثم يكون من شروط فهم شيء ما الارتباط الحميم به وممارسته على المدى الزمني الطويل؛ لأن استبعاد هذا الشرط يعيدنا إلى مشكلة الفصل بين الذات والموضوع، المتفرعة أصلا عن الفصل بين العارف والمعروف التي ظهرت للفكر البشري مع اختراع تقنية الكتابة، ومن وجهة أخرى، بما أن لفظة (الأنا أو الذاتية) التي يقولها الفيلسوف بالضد عن السياق الاجتماعي محض وهم فإن الأسماء المفردة الخالصة من سياقاتها هي أيضا محض وهم، إذ الضامن لإفراد الاسم عن السياق هو العالَم النفسي (الداخلي/السيكولوجي).
لنفترض مثالا آخر تطبيقيا على الدرس العقدي يشرح بعض ما مر بنا، وهو كالتالي: لنفترض أن (س) من الناس كل ما مر به إحساس (أ) عيّن أو أطلق عليه الاسم (ب) وهكذا باستمرار، مع تكرار ربطه وتعيينه بين احساسه (أ) والاسم (ب) سيتشكل مرجع أو ذكرى سيكولوجية خاصة به؛ إذ هو بنفسه الذي أنشئ هذا التعيين بينهما، الآن، لنفترض أيضا أن هناك شخصا آخر (ع) كل ما مر به احساس (أ) عيّن أو اطلق عليه الاسم (ج) وهكذا باستمرار، وأيضا مع تكرار ربطه وتعيينه بين احساسه (أ) والاسم (ج) سيتشكل معنى وذكرى نفسية خاصة به دون غيره، إذن، عندما يلتقي (س) بـ (ع) ويتحدثان عن (أ) فإن المفترض أنه سيكون لكل واحد منهما مرجع وذكرى خاصة به بل إنهما سيتكلمان عن شيئين مختلفين تماما، هذا المفترض؛ لأن التعيين الذي عيّنه (س) لـ (أ) مختلف تماما عن التعيين الذي عيّنه (ع) لـ (أ)، أي أن التفاهم بينهما سيكون ممتنعا- ومن ثم الإعذار والمسامحة؛ إذ هما فرع عن الفهم- ومع ذلك فلن يمتنع الفهم بينهما، فلماذا؟ لأنه تم تهميش المرجع الداخلي الذي نشـأ عن الربط النفسي بين (أ) و(ب) بالنسبة لـ(س)، وأيضا المرجع الداخلي الذي نشأ عن الربط النفسي بين (أ) و(ج) بالنسبة لـ (ع)، حين حديثهما مع بعضهما، المرجع النفسي لا قيمة له تماما حين حديثهما عن (أ) في لغتهما الطبيعية؛ إذ لو كان لربطهما النفسي أي معيارية- سواء كانت معيارية إثباتية أو تفاهمية[76] – لامتنع التخاطب بل التفاهم بينهما؛ إذ معيار المرجع سيكون الربط النفسي الذي ربطه كل واحد منهما بـ (أ)- وهما مختلفان عن بعضهما في ذلك- وليس المعنى الاستعمالي بينهما في اللغة الطبيعية، أي أن اللغة الصناعية التي حاولا أن يصطنعاها- والتي يحاولان بها حصر لغة الفهم والعلم أيضا- لا قيمة لها البتة؛ لاختلاف المعيارية النفسية بينهما، ومن ثم المراجع التي تحيل عليها.
هل حديثهما عن (أ) أحدث ربطا أو تعييناً جديدا لنقل مثلا أنه (ش)؟ هذا راجع إلى سؤال آخر، وهو: هل الحديث عن (أ) ليس له سوى شكلا واحدا فقط أم أن إيراده يختلف بحسب مكانه في السياقات اللغوية؟ إن كان الأول؛ فنعم، لكن سيلزم من ذلك أنه عندما يتحدثان (س) و(ع) مع جماعة لغوية أخرى سيتشكل تعيين جديد لـ (أ) أيضا، وهكذا بلا نهاية؛ وسينفرط المعنى دون أي معيارية تضبطه، وإن كان الثاني؛ فلا، لأن الغرض من اللغة ليس تعيين المرجع والإحالات خارجها أو داخل نفس متحدث بعينه بل التواصل بين الجماعة اللغوية ثم بناء ذلك المرجع؛ إذ اللغة تبني عالمها بممارسات مستعمليها.
هل يستلزم من حذف القدر المشترك الذهني/النفسي أو لنقل (الداخلي) كمعيار للفهم اعتماد المشترك اللفظي معيارا بديلا للتفاهم؟ طبعا لا؛ إذ حينها سيعني (أ) أي شيء، أي: سيكون قولا فارغا من المعنى؛ لأن الضابط اختفى هنا بين السياقات اللغوية والمراجع خارجها؛ إذ مشكلة المشترك اللفظي أنه يعتمد على نظرية الوضع وعلى مفهوم الصورة المنطقية التي نقدناها أعلاه، وهذان يعتمدان بالأصل على المفهوم الفلسفي للنفس.
عندما يقول تعالى: (.. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ..) السؤال الخاطئ الذي يُسأل هنا دائما هو: ما مرجع لفظة يد خارج اللغة؟ هذا السؤال يفترض عدة أمور غير مسلم بها ابتداءً وهي بإيجاز، أولاً: النفس بمفهومها الفلسفي، وثانياً: أن هناك إدراكاً خالصا بلا واسطة لغوية للخارج، مما يعني افتراض ثنائية داخل-خارج كمبدأ ومصحح لفهم النصوص أو إثبات مراجعها في الخارج، ومعنى لفظة (يد) من ثمَّ، ومن هنا يدخل التأويل بمفهومه عند المتكلمين والفلاسفة، والفيلسوف والمتكلم يبنيان داخل نفسهما رابطا أو تعيينا بين لفظة (يد) بعيدا تماما عن سياقات استعمالها وبين أي شيء آخر؛ إذ لا يفهم من الآية سوى السعي نحو تعيين المرجع خارج اللغة واستعمالاتها، سواءً كان المرجع قدراً مشتركاً ذهنياً كمصحح لفهم الآية أو مشتركاً لفظياً، فكلا الاتجاهين ينطلقان من مشكل تعيين المرجع خارج اللغة بناءً على افتراض فلسفي لم يُطرح على طاولة النقاش بشكل جيد حتى الآن في ظني، وهو: ثنائية الداخل-الخارج وأثرها على فهم نصوص الصفات في الدرس العقدي! ما الحل المقترح إذن؟ لا أزعم أبدا أني سأطرح حلاً في كلمات قليلة لمشكلة اختصم فيها علماء كبار من كافة الفرق الإسلامية رحمهم الله ورضي عنهم وجمعنا بهم في جنانه، ويكفيني فقط من هذا المثال أن أفتح به نقاشا بين المهتمين، ومن أهم الأمور التي ينبغي التنبه لها كما ذكرت سابقا، مشكلة السعي نحو تعيين المرجع خارج اللغة وكأن الذهن البشري يستطيع استبعاد اللغة من إدراكه، وهو سعي أدخلته الفلسفة في دراسة الفهم، عندما ترد علينا آية كما في قوله تعالى: (.. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ..) هل المراد من ايرادها في سياقها العمل بها أم تعيين مرجع لفظة ا(ليد) خارج اللغة؟ إذا فهمنا المثال الذي ضربتُه أعلاه فإن تعيين المرجع خارج اللغة أو داخل النفس نوع من العبث؛ إذ كل متكلم أو فيلسوف سيربط بين لفظة (يد) وأي شيء آخر في ذهنه (أو داخله) وسيكون حسب فهمه صوابا، وحينها سيختفي تماما معنى التصويب والتخطئة في فهم نصوص الصفات في الدرس العقدي؛ لأن كل ربط وتعيين للمرجع داخل نفسه سيكون صوابا؛ إذ المعيار ومصحح الفهم هو داخل نفس عالم الكلام فقط، وليس المعنى الاستعمالي في الجماعة اللغوية التي نزل عليها القرآن الكريم، وأيضا لأن من مشاكل السعي الفلسفي نحو تعيين المرجع خارج اللغة أو داخل النفس= أنه ينتزع المفردات اللغوية من سياقاتها سواء لإدخالها في قدر مشترك ذهني أو مشترك لفظي، في كلا الحالتين المفردة اللغوية انتزعت من سياقها الذي يشرح معناها، وتم فهمها وفق مشكلة فلسفية هي: ثنائية الداخل-الخارج، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه كما ذكرتُ أعلاه توضيح وظيفة اللغة، هل هي لتصوير المفردة اللغوية للشيء خارجها أو الصورة داخل النفس أما للتواصل بين الجماعة اللغوية؟ فإن كانت الإجابة الأولى فإننا سنعود لنفس المشكلة الفلسفية وثنائية داخل-خارج، وإن كانت الثانية، أي: التواصل؛ فإن اللغة هنا ستبني مرجعها بأفعال مستعمليها وممارساتهم، أي: أنه سيكون اللازم من فهم قوله تعالى: (.. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ..) هو العمل بموجبها، وهذا هو المراد من بناء المرجع أو أن مستعمل اللغة يبني عالمها.
السمة الثانية من تعريف الاسم في التقليد الفلسفي والعلوم المتأثرة به ذكرنا أنها: التجرد عن الزمان، وهذه السمة مبنية على السمة الأولى؛ إذ تمت إضافتها في التعريف من جهة البنية اللغوية فقط دون اعتبار للحيثيات الأخرى[77]، ولذلك يضيف البعض قيد (زمان محصل) على التعريف أعلاه؛ لئلا تختلط بالمصادر والمشتقات سوى أن زمانهما غير محدد، يقول ابن سينا: و”معنى التجريد من الزمان هو أن يبرأ المدلول عليه من زمان يلحقه، فإن التجريد هو تبرئة عن شيء لو لم يبرأ عنه لكان لاحقاً من خارج”[78]، أي يضاف إليه أمر من خارج ماهيته التي يعينها أو يشير إليها الاسم، فكما هو واضح فإن هذا القيد عائد إلى النظر في الاسم من جهة الماهية؛ إذ بها يُفهم الاسم بوصفه صورة؛ ومن ثم تُصنع لغة الفهم والعلم وفقا لذلك، فـ”المواد الأولى لجميع المطالب هي التصورات”[79]، فمشكل الاسم هو نفس مشكل الماهية[80]، والجزء المعقول الذي يُبحث عنه عبر الاسم هو الصورة[81]، وهذا يفصل اللغة عن طبيعتها الاجتماعية والتعليمية، فإذا كانت النفس (أو الذاتية) بمفهومها الفلسفي ممتنعة خارج سياقات الحياة اليومية فكل فهم للغة تبع لذلك أيضا.
عندما نتتبع معنى الاسم قبل نشوء الفلسفة- أي كيفية تعامل الناس معه في حياتهم اليومية- نلاحظ أنه كما يشير لذلك دوركهايم “أن الاسم، بالنسبة إلى البدائي، ليس مجرد كلمة أو اجتماع أصوات؛ إنه جزء من الكائن، بل شيء جوهري فيه”[82]، أي أن الإنسان قبل نشوء الفلسفة كان يتعامل مع اسمه كأنه سيرة ذاتية له[83]؛ لأنه لم يصطنع فارقا نظريا بين اسمه وفعله حين الممارسة، ولم يصنع فارقا فلسفيا أيضا بين معناه وزمن تشكله؛ إذ هذه الفروق تظهر حينما تتوقف الممارسة ويبدأ التنظير والتأمل الفلسفي اتجاه موضوع ما، وهذا أمر يشكل في حقيقته “قوام إحدى المشكلات التي تُطرح على كل باحث، وخصوصاً في العلوم الاجتماعية، هو أن تعرف، ثم أن تعرف كيف تتخلص من المعارف. وهذا أمر يسهل قوله ونحن نقرأ الخطابات المعرفية الإبيستمولوجية.. إلا أنه يظل عصيا عسيرا في الممارسة”[84]، أي أن الإنسان قبل نشوء الفلسفة بما أنه لا يطرح نفسه كموضوع نظري بإزاء ذات متأملة فإن فهمه يظهر عبر ممارسته لا عبر تنظيره؛ لذلك تكون التمثيلات والاستعارات جزءا من بناء عالمه؛ إذ مشروع استبعاد الاستعارات قائم على نظرية، فإذا امتنعت لزم أن تكون عاملا أصليا في بناء الفهم ودراسته، أضف لذلك أن الاسم غير المعين يستلزم أن معناه يظهر أيضا عبر مجموع الأوصاف التي تعلمها صاحبه من جماعته اللغوية، وبذلك يكون مسؤولا عن اسمه؛ إذ هو حامل سيرته وذكره بعد مماته، لذلك كان القدماء لا يخبرون به إلا الثقات، وهذا ليس كما فسره جيمس فرايزر في كتابه الغصن الذهبي؛ إذ يقول “غير قادر على التمييز بين الأشياء والكلمات يتصور البدائي أن العلاقة بين الاسم وصاحبه ليست مجرد علاقة عشوائية تصورية، بل ارتباط مادي وحقيقي يوحدهما بطريقة تمكنه من إجراء السحر على الشخص خلال اسمه تماما كإجرائه خلال شَعره” [85]، وتفسير فرايزر عن علاقة الاسم بحامله في المجتمعات القديمة تفسير بأثر رجعي، ومن جهة السببية بمفهومها الفلسفي، أي أنه تفسير طبيعاني لممارسة الإنسان وعلاقاته واعتقاداته، في حين “نحن لا نفكر في عرض الملاحظات السالفة بوصفها نظرية متكاملة لمفهوم السببية، لأن المسألة أعقد من أن تحل بهذه الطريقة. إذ اختلف فهم مبدأ السببية باختلاف الأزمنة والبلدان؛ كما أنه يتنوع في المجتمع الواحد بتنوع الأوساط الاجتماعية”[86]، لذلك يختلف نشوء الظواهر وفهمها من وسط اجتماعي لآخر؛ إذ السببية الفلسفية تنطلق من التعيين، والتعيين مبدأ التنظير كما ذكرنا ذلك أعلاه- لأن به تُبنى الحدود والتعريفات التي تنطلق منها النظريات واللغة الخالصة/البرهانية- بخلاف فهم السببية من منظور اجتماعي تاريخي؛ إذ السببية تتشكل من خلال فهم الجماعة البشرية وممارساتها، أي أنها تشارك في بناء معنى السببية داخلها[87]، وهذا من معاني مسؤوليتها وتحمل الأمانة بمعناها الديني، أي أن الذي يضمن دوام معنى الأسماء ودلالاتها وفهمنا لها هو ممارستها على ضوء ما تنقله وتسنده الجماعة البشرية عبر التاريخ، وأخيرا كما يبين بيار بورديو فإن أهمية البحث في معنى الاسم وتشكلاته وتأثيراته على دارسة الفهم أن “سلطان التسمية هو سلطان خلق اجتماعي، فهو يوجد الشخص المسمى، المُعَيَّن، وفقا لتسميته وتعيينه”[88]، ولأنه في الحقيقة “لا يمكن للإنسان أن يتعلم إلا عندما يستطيع أن يسمي بدقة”[89].
خاتمة:
هذه الخصائص والسمات ليست سوى فروق محدودة ضمن عدة اختلافات وتفاوتات يمكن تتبعها وفحصها في دراسات الفهم، وفي الحقيقة من ضمن ما يهمنا الإشارة إليه في ختام رسالتنا هذه أن دراسة الفهم التي ندعو لها نوع من إعادة توطين الإنسان في مسكنه في التاريخ واللغة والتراث بدلا من اصطناع اغتراب ووحشة بين نفسه ومصادر تشكلها عبر الزمن، وحتى نعود إلى ذاكرتنا ينبغي أن نعالج ما خالط إدراكاتنا من أشكال للفهم الزائف، أو أن نقع في تجزئة الفهم إلى أجزاء وشظايا تُفهم كل جزئية باستقلال عن الأخرى، إذ الفهم كما يقرر علم النفس الجشطالت ينمو داخل رعاية الكل، وكما يؤكد رودلف أرنهايم أن “المقولة الكل أعظم من مجموع أجزائه .. تعتبر مضللة، حيث توحي بأنه في سياق معين، تظل الأجزاء كما هي، إلا أنها ترتبط معاً من خلال خاصية إضافية غامضة، وهي التي تُحدث الفروق (في الفهم). وبدلاً من ذلك فإن مظهر أي جزء يعتمد على إنشاء الكل، وهذا الكل تقريبا بدوره، يتأثر بطبيعة أجزائه”[90]، أي أن الفهم يستيقظ دوما داخل علاقة مكانية/زمانية ما، وليس كما يرسخ التقليد الفلسفي أن الفهم يبدأ من تعريف ماهية شيء ما أو تعريفه المميِّز للشيء عن غيره.
ومن أهم التساؤلات التي تستحق الإشارة إليها في خاتمة أطروحتنا هذه، لماذا قارنا بين فهم المجتمعات القديمة وفهم المجتمعات الحديثة؟ الإجابة باختصار هي أنه ينبغي دراسة الفهم في ضوء الأصالة، وليس كما يصاغ الأمر في دراسات ما بعد الكولونيالية أن الهوية الإنسانية- وما يلازمها من فكر وفهم- دوما في هجانة ما أو تقع في بلبلة اللغة[91]، ورغم اتفاقنا معهم أن الانطلاق من التعيين النظري للفهم والهوية متعذر إلا أن الحفاظ على دوام الدلالات والهويات والأفهام مع مرور الزمن ليس مسألة نظرية بل إرادة ومسؤولية، والتلمذة ركن وأساس لإمكان الفهم نفسه؛ إذ رفضها بحجة أن التاريخ يُحكى في سردية القوي أو تحت سطوة الحاضر أو امتناع التعيين النظري للهوية .. إلخ يؤول لإمتناع الفهم نفسه، والحق أن هذا الخلط وقع بعد أن صار معنى الفهم في ضوء الإشكالات الفلسفية التي طرأت على معضلة الوعي والذاتية وانقطاع الصلة الفلسفية بين المتناهي واللامتناهي؛ لأن الأصالة تم اختزالها في مفهوم التأسيس النظري فقط؛ ولذلك التزموا نفس المبدأ الذي التزمه التقليد الفلسفي قبلهم وهو: رفض التلمذة والتعليم.
والصلاة والسلام على معلم البشرية وخير البرية.
[1] – إرنست كاسيرر، ترجمة د. إحسان عباس، مقال في الإنسان- مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية، لبنان، ابن النديم للنشر والتوزيع (2020) (ص 25)
[2] – أبو الوليد ابن رشد، تحقيق وتعليق: ألفرد .ل. عبري، مراجعة: د. محسن مهدي، تصدير: د. إبراهيم مدكور، تلخيص كتاب النفس، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة (ص 1).
[3] – المرجع السابق، (ص41).
[4] – حسن حسن زاده آملي، عيون مسائل النفس وسرح العيون في شرح العيون، طهران، مؤسسة امير كبير تهران، (1385) (ص112) ، ويقول آملي في موضع آخر (ص369) “المدرك لجميع المدركات بجميع أصناف الإدراكات هو النفس وحدها” بل إن حسن آملي يحيل حقيقة التوحيد إليها كما يقول في (ص335) من نفس كتابه المذكور “اعلم أن حقيقة التوحيد تعرف بعرفان النفس.. وهي مدخل الولوج إلى ديار المرسلات”!
[5] – مارتن هايدغر، ترجمة: وعد علي الرحية، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، (2016) (ص63). وهناك نصوص كثيرة متنوعة من كافة المذاهب الفلسفية تؤكد نفس المعنى أعلاه بغض النظر عن الاتجاه الذي يتبناه القائل، يقول مثلا ملا صدرا الشيرازي في شرحه لإلهيات الشفا لابن سينا (ص21): “وجه أن الحكمة النظرية هي الحكمة المطلقة، هذا العلم علم حر مطلق عن الافتقار إلى غيره والتعلق بما سواه؛ وسائر العلوم بمنزلة العبيد والخدام لهذا العلم”.
[6] – يقول إيمانويل كانط في رسالته جواب عن سؤال: ما الأنوار؟ “إن الأنوار هو خروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه، والذي يعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغير… تجرأ على أن تعرف! كن جريئاً في استعمال عقلك أنت! ذاك شعار الأنوار” ثلاثة نصوص، دار محمد علي للنشر (ص83).
[7] – مونيك ديسكو، ترجمة: حبيب الجربي، أفلاطون – الرغبة في الفهم، المركز الوطني للترجمة، تونس (2010م) (ص120).
[8] – شمس الدين محمد الشهرزوري، رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية، مؤسسة بزوهشى حكمت وفلسفة إيران، طهران، (1383) (ص38). وينبغي الإشارة هنا أن أصل معنى العلم في التقليد الفلسفي له بُعد نظري/طبيعاني، أي أنه علم غير محايث للممارسة الإنسانية، ولا أقول أنه مشتق منها؛ لأن القول بأن أصل معنى العلم مشتق من الفعل البشري يستلزم تاريخانية محضة يضيع فيها أصل المعنى برمته، لذا هذا الفرق دقيق ومهم في تبيين أن أصل العلوم ممارسة تتأثر بالتاريخ من جهة، ومن جهة أخرى أن معنى أن يكون هناك تاريخ بشري هو أن يكون أصل الممارسة شأنا أنثربولوجيا عابرا للمجتمعات، وليس شأنا خاصا بمجتمع دون آخر، ومن هنا يعارض البحث الأنثروبولوجي عن اصل معنى العلم الدراسة الفلسفية عنه، كما يؤكد ذلك بروس مازليش في كتابه الحضارة ومضامينها (ص 41) :”إن الأنثربولوجيا باعتبارها تخصصا ناشئا تحدت الجهود التجريدية والميتافيزيقية في تحديد ما كان يمكن وصفه إنسانيا بالمسلمات، متوسلة مقاربة ذات توجه تجريبي بخصوص الشامل والنسبي”. وليس معنى كلمة (تجريبي) في الاقتباس هو نفس المعنى في الفلسفة التجريبية بل إن معناه معيشي؛ إذ من هنا ينطلق الأنثربولوجي دراساته.
[9] – حسن زاده آملي، مرجع سابق، (ص 134) بتصرف يسير. ويقول أيضا في نفس الكتاب (ص 369) “المدرك لجميع المدركات بجميع أصناف الإدراكات هو النفس وحدها”.
[10] – بول ريكور، ترجمة: محمد محجوب، الوجود والماهية والجوهر لدى أفلاطون وأرسطو، المركز الوطني للترجمة، تونس، (2012) (ص 252).
[11] – جوناثان آي إزرايل، ترجمة: د. محمد المغيربي ود. نجيب الحصادي، التنوير متنازعاً فيه- الفلسفة والحداثة وانعتاق الإنسان 1670-1652م، هيئة البحرين للثقافة والآثار، (2020م) (ص697).
[12] – والترج أونج، ترجمة د. حسن البنا عز الدين، الشفاهية والكتابية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، (1994م) (ص 37).
[13] – والترج أونج، مرجع سابق، (ص 157).
[14] – جاك دريدا، ترجمة: أنور مغيث ومنى طلبة، المركز القومي للترجمة، القاهرة،( 2008) (ص 518-519)
[15] – موسوعة الهرمانيوطيقا، مجموعة كتاب، ترجمة محمد عناني، المركز القومي للترجمة، (2028م)، (ص89) بتصرف يسير.
[16] – كلاريس هيرينشميت، ترجمة: د. جمال شحيد، الأبجديات الثلاث- اللغة والعدد والرمز، هيئة البحرين للثقافة والآثار، (ص50).
[17] – والترج أونج، مرجع سابق، (ص 129).
[18] – والترج أونج، مرجع سابق، (ص88).
[19] – يقول حسن احجيج في كتابه نظرية العالَم الاجتماعي-قواعد الممارسة السوسيولوجية عند بيير بورديو (ص90) “يرى بورديو أن الطابع العملي للتجربة في العالم يتم تدميره على يد المذهب الذاتي والمذهب الموضوعي، اللذين يقومان على الموقف النظري نفسه، وهو موقف المتفرج غير المتحيز”.
[20] – راجع دراستنا المعنونة: مدخل إلى فهم الإله الفلسفي أو في شطب إله العدميين، منشورة في موقع أثارة من علم.
[21] – سيلفان أورو، ترجمة عبدالرزاق بنور، تاريخ التفكير اللساني- نشأة اللغات الواصفة في الشرق والغرب، المركز الوطني للترجمة، تونس، (2010م)، (ص33/1).
[22] كما يصرح سيلفان أورو في كتابه فلسفة اللغة، المنظمة العربية، (ص127) “لم يَبْن البشر قواعد اللغة ولا يستطيعون بناء قواعد للغة إلا في ما يختص باللغات المكتوبة. إن هذه الوضعية أثّرت على تاريخ تصوراتنا للغة”.
[23] – والترج أونج، مرجع سابق، (ص 177-179).
[24] – والترج أونج، مرجع سابق، (ص122).
[25] – كلاريس هيرينشميت، مرجع سابق، (ص36).
[26] – ابن رشد، مرجع سابق، (ص107).
[27] – آلان سوبيو، ترجمة: عادل بن نصر، الإنسان القانوني- بحث في وظيفة القانون الأنثربولوجية، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، (2012م)، (ص 224) بتصرف يسير.
[28] – المرجع السابق (ص 14)
[29] – هانز جورج غادامير، ترجمة: د. حسن ناظم، علي حاكم صالح، الحقيقة والمنهج، الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، (2007م) (ص 389-390).
[30] – المرجع السابق، (ص444).
[31] – بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان ترجمة: د.جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، (2009م) (ص191).
[32] – مرسيا إلياد، ترجمة: أحمد آيت إحسان، المقدس والدنيوي، دار الحوار، (2018م) (ص 188- 193).
[33] – بيونج تشول هان، ترجمة: بدر الدين مصطفى، مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر، القاهرة، (2021م) (ص111).
[34] – روبرتسون سميث، ترجمة: عبدالوهاب علوب، محاضرات في ديانة الساميين، دار رؤية، (2019م) (ص56- 258).
[35] – ماري ماجين، ترجمة: رضا زيدان، مركز براهين، القاهرة، (2016) (ص134)، وتقول أيضا (ص135): أن “جملة (الآن فهمت) لا تتعلق بالحالة النفسية المصاحبة للنطق بهذه الجملة بل بالظروف التي قيلت فيها”. بتصرف يسير.
[36] – روبرتسون سميث، مرجع سابق، (ص34).
[37] – باسكال فيرنوس، ترجمة: منى زهير الشايب، المعبودات المصرية، المركز القومي للترجمة، القاهرة (2018م) (ص26)
[38] – يقول جون غرايش في كتابه العيش بالتفلسف، مؤمنون بلا حدود، (ص73): “كانت العلاقة شيخ-مريد تؤدي دوراً أساسياً في التراث القديم، مثلها مثل الحياة في المجتمع في المجتمع الفلسفي بالنسبة للبعض، غير أن الفلسفة حوَّلت العلاقة شيخ-مريد، تحويل كان سقراط شاهداً عليه بالدرجة الأولى”.
[39] – د. عبدالقادر بالعالم، الوظيفة التربوية للسؤال الفلسفي من خلال النموذج السقراطي: الأصول السقراطية لبنية الدرس الفلسفي وفعاليته في البناء الفكري والنفسي للإنسان (ص37) مجلة أفكار وآفاق، المجلد 8، العدد 1، (2020م).
[40]– جوزيه رويس، ترجمة: أحمد الأنصاري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، (2009م) (ص151).
[41] – وهذا الأمر ظاهر في الدرس العقدي ايضا، يقول الإمام أبو المعين النسفي الماتريدي- رحمه الله- في كتابه تبصرة الأدلة في أصول الدين، المكتبة الأزهرية للتراث (ص162) “التصديق العاري عن الدليل ليس بإيمان.. يقول أبو الحسن الأشعري والمعتزلة: إن الدليل لا بدل أن يكون عقليا، إذ لا وجه إلى جعل قول الرسول، دليل حدوث العالم وثبوت الصانع لأن قول الرسول لا يكون حجة ما لم يثبت رسالته، ولا وجه إلى القول برسالته إلا بعد معرفة مرسله، ولن يتهيأ معرفة مرسله إلا بعد ثبوت المعرفة بحدوث العالم”.
[42] – ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، مؤسسة انتشارات حكمت، طهران (1377) (ص 170/1).
[43] – يقول مافيزولي في كتابه نظام الأشياء – التفكير في ما بعد الحداثة ، المركز العربي، (ص 186) : “الأساس الأولي للأزمنة الحديثة هو ابتداع الفرد”.
[44] – بيار بورديو، ترجمة: نصير مروة، عند الدولة- دروس في الكوليج دو فرانس، المركز العربي، بيروت، (2016م) (ص 292) بتصرف. ويقول في موضع آخر (ص 372) “إن الدولة تركّز الثقافة؛ وينبغي أن نسترجع هنا موضوعة توحيد البنى العقلية، وواقعة استملاك الدولة للبنى العقلية وأنها تنتج ملكًة/تعوُّدًا ثقافيا موحدا، تتحكم في نشوئه وبنيته في آن”.
[45] – المرجع السابق، (ص368).
[46] – يقول روبرتسون سميث في كتابه ديانة الساميين (ص 251) : “الديانات القديمة والقبَلية تسير كالآلة. فالبشر راضون عن آلهتهم، ويشعرون أن آلهتهم راضون عنهم. وإذا حلت في أي وقت مجاعة أو وباء أو كارثة تنم عن غضب الآلهة، فإن هذا لا يلقي بظلال من الشك على كفاية النظام الديني القائم، بل لا يزيد عن كونه دليلاً على ارتكاب أحد الناس خطأ فادحاً. ما يجعل الجماعة كلها مسؤولة عنه”
[47]– موسوعة الهرمانيوطيقا، مرجع سابق، (ص155).
[48] – د. عبدالستار جبر، الهوية والذاكرة الجمعية، إعادة إنتاج الأدب العربي قبل الإسلام (أيام العرب نموذجا)، دار المدار الإسلامي، (2019م) (ص300) بتصرف يسير.
[49] – إميل دوركهايم، ترجمة: رندة بعث، الأشكال الأولية للحياة الدينية- المنظومة الطوطمية في أستراليا، بيروت، (2019م) (ص32).
[50] – جون غرايش، ترجمة: محمد شوقي الزين، العيش بالتفلسف-التجربة الفلسفية، الرياضات الروحية، وعلاجيات النفس، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط (2019م) (ص80)
[51] – نعني بـ (الممارسات القاعدية) الممارسات التي تجمع عليها كافة الجماعات البشرية باختلاف أماكنها وتواريخها، كالحاجة لعبادة إله أو رفع اليد للسماء حين الدعاء بل إنها في حقيقتها أرضية لإمكان أي ممارسة أخرى دون الحاجة للاستدلال على وجوده؛ إذ إدخالها في مساحة ما يُستدل أو يُنظّر له يضاد طبيعتها المُمارَسة.
[52] – أندي هاملتون، ترجمة: د. مصطفى سمير عبدالرحيم، فيتجنشتاين وفي اليقين، مدخل موسع لأهم وآخر ما كتب فيتجنشتاين، دار ابن النديم، بيروت، (2019م) (ص 258).
[53] – ماري ماجين، ترجمة رضا زيدان، فيتجنشتاين والبحوث الفلسفية، مركز براهين، القاهرة (2018م) (ص 125)
[54] – فكرة موضعة العقل في حقيقتها فرع عن إساءة فهم استعمالات اللغة اليومية ومجراها.
[55] – يقول إدموند هوسرل في كتابه تأملات ديكارتية : “إن الفلسفة- الحكمة- هي على نحو ما عمل شخصي بالنسبة للفيلسوف، فالفلسفة ينبغي أن تنشأ بوصفها فلسفته، وأن تكون حكمته هو، ومعرفته الخاصة، التي على الرغم من أنها تنزع نحو ما هو كوني، فإنها يجب أن تظل نتيجة لتحصيله الشخصي” نقلا عن كتاب في دلالة الفلسفة للدكتور الطيب بو عزة، مركز نماء (ص 73).
[56] – آلان بادلي، ترجمة: محمد المير، الذاكرة الإنسانية- نظرياتها وتطبيقاتها، دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، (2020م) (ص 299).
[57] -أبو البركات ابن ملكا البغدادي، المعتبر في الحكمة الإلهية، دار ومكتبة بيبليون، لبنان، (ص96).
[58] – كرد محمد، أفلاطون والشعر، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، ج وهران 02، المجلد 9 (2020م).
[59] – يقول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات، دار المعارف (ص1/138) “وأول ما يفتتح به منه فإنما يفتتح بالأشياء المفردة التي منها يتألف الحد والقياس وما يجري مجراهما”.
[60] – محمد المصباحي، من الوجود إلى الذات- بحث في فلسفة ابن رشد، دار الأمان، (2006م) (ص36). ويقول ابن رشد في شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان- دار آفاق (ص115)”مبادئ البراهين قد تبين من قِبَل الحد وليست تبين من قبل البرهان”، ويؤكد أيضا في موضع آخر على أن مبادئ البرهان تحصل دون تعليم كما يقول في موضع آخر من كتابه هذا (ص147): “إن هذه المبادئ إنما تحصل لنا عن قوة واستعداد موجود فينا، شأن تلك القوة وذلك الاستعداد أن تحصل عنه تلك المبادئ”.
[61] – نصير الدين الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، (ص1/126).
[62] – بول ريكور، الوجود والماهية والجوهر لدى أفلاطون وأرسطو، مرجع سابق (ص21).
[63] – محمد المصباحي، من الوجود إلى الذات- بحث في فلسفة ابن رشد (ص56).
[64] – الفارابي، المنطقيات- الشروح على النصوص المنطقية، منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، (2012م) (ص2/9).
[65] – المرجع السابق، (1/13).
[66] – ابن رشد، شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان، دار آفاق، (2020م) (ص59غ)
[67] – روبرتسون سميث، مرجع سابق، (ص267)
[68] – جورج لايكوف ومارك جونسون، ترجمة: عبدالمجيد جحفة، الاستعارات التي نحيا بها، دار توبقال للنشر، (2009م) (ص21)
[69] – الفارابي، الشروح على النصوص المنطقية، مرجع سابق (ص22).
[70] -شمس الدين الشهرزوري، مرجع سابق، (ص62).
[71] – سواء كان الشيء في النفس أو الشيء في الخارج؛ فإنهما تعيين نظري، يُستعمل كمحدد نظري للفهم.
[72] – الشهرزوري، مرجع سابق، (ص97).
[73] – انظر : سيلفان أورو، ترجمة: بسام بركة، فلسفة اللغة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، (2012) (ص250- 257).
[74] – د. يوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم-قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة، ابن النديم للنشر والتوزيع، (2014) (ص284).
[75] – سيلفان أورو، مرجع سابق، (ص290).
[76] – أي سواء كان العقل معيارا لإثبات صفة أو اسم لله عز وجل أو مجرد مصحح لفهم الصفات دون إثباتها.
[77] – يقول ابن سينا في كتابه الشفاء، المطبعة الأميرية، القاهرة (25/1) “ولا يُلتفت في هذه الصناعة (أي صناعة المنطق) إلى التركيب الذي يكون بحسب المسموع”. وإن كنا نعترض على لفظة (تركيب) لأن اللغة لم يُبدأ فهمها من جهة وضعية تحليلية إلا بعد اختراع الكتابة كما أشرنا لذلك سابقا.
[78] – نقلا عن الحسن الهلالي، المكون المنطقي في الدلالة عند العرب، دار الكتاب الجديد، بيروت، (2012) (ص83).
[79] – نصير الدين الطوسي، مرجع سابق، (ص1/126).
[80] – يقول بول ريكور، مرجع سابق، (ص19): “إن مشكل التعريف هو منذ البداية معلّق إلى مشكل اللغة، من خلال الاسم. من صاحب الكلمة؟ إن وظيفة وحدة الماهية وهويتها وظيفة مرسومة في الإسم، ومشكل الماهية هو مشكل تبرير اللغة”.
[81] يقول بول ريكور شارحا فلسفة أرسطو، مرجع سابق، (ص209) “إن السبب الصوري هو المطلوب في نهاية الطريق” ويقول في موضع آخر (ص248) “تتماهى الصورة، من الزاوية المنطقية، أي من جهة ما هي إمكانية للحد وللبرهنة، مع المائية… إن مثال اسم العلَم من جهة لصوقه بالإنسان الفرد يوضح ذلك أيما توضيح”.
[82] – إميل دوركهايم، مرجع سابق، (ص 185). ويقول في موضع آخر من زاوية انثربولوجية (ص252): “لا يعد الاسم الذي يحمله فرد ما مجرد كلمة أو علامة اصطلاحية، إنما هو جزء أساس من الفرد نفسه”.
[83] – أو كما يُعبر عنه في فلسفة اللغة المعاصرة= مجموع أوصافه غير المتعينة خلافا لـنظرية الأوصاف برتراند راسل، أي المبثوثة في حياته من الميلاد إلى الممات.
[84] – بيار بروديو، مرجع سابق، (ص188).
[85] – جيمس فرايزر، ترجمة: نايف الخوص، الغصن الذهبي- دراسة في السحر والدين، دار الفرقد، دمشق، (2014م) (ص 323).
[86] – دوركهايم، مرجع سابق، (ص475).
[87] – لاحظ قلنا (تشارك) ولم نقل (تسبب) إذ لو قلنا ذلك لوقعنا فيما نحذر منه، أي في لغة خاصة لا معنى لها.
[88] – بيار بورديو، مرجع سابق، (ص465).
[89] – محمد الهادي عياد، الكلمة- دراسة في اللسانيات المقارنة، مركز النشر الجامعي، تونس، (2010م) (ص371).
[90] – ردولف أرنهايم، ترجمة: حسام الدين زكريا، الفن والإدراك البصري- سيكولوجية العين المبدعة، المركز القومي للترجمة، القاهرة (ص 164) بتصرف يسير
[91] – يقول هومي .ك. بابا في كتابه موقع الثقافة ( ص 44) “والتقدير والاحترام الذي يمنحه التراث إنما هو شكل جزئي من أشكال تعيين الهوية. فهو إذ يعيد إخراج الماضي على مسرح الحاضر إنما يدخل إلى ابتداع التراث زمنيات ثقافية أخرى مباينة ومغايرة. وهذه سيرورة تحول دون أي نفاذ مباشر إلى هوية أصلية أو تراث قار”



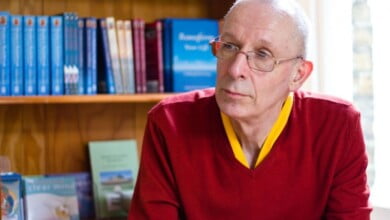

هذا الرجل بحر!
أحاول ان افهم مقابلتك قدر الإمكان.. بالنسبة لي أصعب من المسائل الرياضية المعقدة.. لكن اشيق منها
اذا كان هناك من يترجم لي اكون له من الشاكرين
وان لم يكن فأنا ساقرأها إلى أن ارضى على اي حال
جميل ، اللهم بارك.
الموضوع عميق ، وفي كل فقرة أرجع وأحاول ألا أغرق وأتوه :)
وهي المرة الأولى التي أقرأ فيها مقالات من هذا النوع في قسم الفلسفة -الذي لا أدخله أبداً- لكن العنوان صادف شغفاً وحباً للاكتشاف هذه المرة.
• ملخص:
الدِّين، والانتماء للتراث، والتلمذة -وعليه خاصة-، والارتباط الحميم بالشيء وممارسته على المدى الزمني الطويل: شروط أساسية لإمكان الفهم واستمراره.
• اقتباسات:
“العلاقات التي يهيئها التراث لتشكل الفهم ليست علاقات سلطوية بل علاقات تلمذة وتعليم وثقة”.
“الحفاظ على دوام الدلالات والهويات والأفهام مع مرور الزمن ليس مسألة نظرية، بل إرادة ومسؤولية، والتلمذة ركن وأساس لإمكان الفهم نفسه”.
“الذي يضمن دوام معنى الأسماء ودلالاتها وفهمنا لها هو ممارستها على ضوء ما تنقله وتسنده الجماعة البشرية عبر التاريخ”.
“أصل العلوم ممارسة تتأثر بالتاريخ”.
“الفهم يستيقظ دوما داخل علاقة مكانية/زمانية ما”.
“إن كل فهم يبدأ من اعتقاد ممارس في حقيقة الأمر، وليس من البرهنة”.
“لا يمكن للإنسان أن يتعلم إلا عندما يستطيع أن يسمي بدقة”.
“هذه الفردية التي تنتجها الدول العلمانية تنزع نحو التخلص من عبء المجتمع الذي تترعرع وتنبت فيه بكل حمولاته التاريخية والتراثية؛ إذ طبيعة المسؤولية وعلاقتها بالفهم اختلف جذريا عن طرق تحمل المجتمعات القديمة لهما”.
“إن الدولة تركّز الثقافة؛ وينبغي أن نسترجع هنا موضوعة توحيد البنى العقلية، وواقعة استملاك الدولة للبنى العقلية وأنها تنتج ملكًة/تعوُّدًا ثقافيا موحدا، تتحكم في نشوئه وبنيته في آن”.
” فمعالجة معضلة الشك إذن ليست معالجة لأمر نظري لا يمت بأي صلة بحياة الناس اليومية، بل إن المجتمعات المعاصرة تُصاغ وتُهندس على ضوء هذه المعضلة الشكية التي بدأت بعيدا عنها، باختصار صار الشك تحت حماية الدولة العلمانية الحديثة شأنا عموميا مشاعا لا ينضبط بأي ضابط سوى الأهواء والرغبات، إنه شك مبتذل! والدخول معه في جدل معرفي أو محاورة نظرية يرسخه في سياقات المجتمعات المعلمنة؛ إذ من شروط علمنة المجتمعات أن يُطرح الشك بوصفه خيارا مع الخيارات الإيمانية، وحتى يصل لمبتغاه ينبغي أن يكون الشك الفلسفي ذا دلالة ومعنى في المدينة العلمانية”.
“المهمة الرئيسية للعمارة: تفسير أسلوب الحياة الصالح… وأن العمارة الحديثة أتت إلى الوجود لمساعدة الإنسان على أن يشعر بالألفة في العالم أو بالاغتراب عنه…”.
“ومن أهم التساؤلات التي تستحق الإشارة إليها في خاتمة أطروحتنا هذه، لماذا قارنا بين فهم المجتمعات القديمة وفهم المجتمعات الحديثة؟ الإجابة باختصار هي أنه ينبغي دراسة الفهم في ضوء الأصالة”.