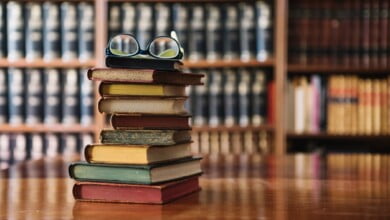- د.حامد بن أحمد الإقبالي*
آلت العلوم الاجتماعية والإنسانية في البلاد العربية والإسلامية إلى استقاء الكثير من معارفها ومناهجها من الفكر الغربي، مع تقعيد هذه العلوم وصياغة أسسها العلمية وأساليبها المنهجية، ولم تكن التربية بكافة فروعها ومجالاتها بدعاً من هذه العلوم، فقد تأثرت هي الأخرى كغيرها من العلوم النظرية بهذه المعارف والآليات والصيغ التي لا تمت إلى جذوره الإسلامية بصلة، فاختلط الحابل الأوربي بالنابل الإسلامي، فتضعضعت المفاهيم واختلطت المصطلحات، وأصبح المتخصص الكاتب في التربية فضلاً عن الباحث المبتدئ كحاطب ليل يجمع في بحثه وكتابه العديد من المفاهيم التربوية والاجتماعية الصالح منها والطالح. وقد استغل أصحاب الاتجاهات الإلحادية المادية ضعف الأمة فعملوا على تشويه الكثير من مفاهيمها” (العساسي، 1432،22) مما دعا إلى الحاجة الى بناء مفاهيم خاصة بالتربية الإسلامية ليس دعوى عبثية مجردة، وإنما يدفعها في ذلك الحاجات النفسية والاجتماعية.
ويعاني اليوم المتخصصون في التربية الإسلامية من استخدام مفاهيم الآخر دون فحصها على مشرح المعرفة الإسلامية، فمن دون أن ينجح المهتمون في هذه التربية الأصيلة في إيجاد ونحت مفاهيم إسلامية تنحاز للحقيقة في حقل التربية الإسلامية فإن إحدى الركائز التي تقوم عليها هذه التربية تكون قد غابت، وإذا غابت فإنها – أي التربية- ستكمل طريقها كما هي عليه الآن أسيرة لثقافة المركزية الغربية، مكبلة بجمود علمائها في ترديد ما تقوله الثقافة الغالبة، حرفاً بحرف، وصفة بصفة، وعيناً بعين، حذو القذّة بالقذة (النقيب، 1418،ص107).
ولأن المصطلح يعتبر من أهم ساحات الصراع الحضاري بين الفكر الغربي والحضارات الأخرى، ليس في الجانب اللفظي أو الصناعة اللغوية فقط، بل إن المصطلح في طياته يحمل أبعاداً حضارية تحاول إيصال مفهوم معين بصيغة محددة، وهنا يكمن خطورته في تداول هذه المصطلحات في ميدان التربية، فيتلقفها الصغار دون وعي، فينشؤون عليها، وينمون عليها ثرواتهم اللغوية، وتؤثر في النهاية في طريقة تفكيرهم وسلوكهم تجاه الحياة (عبيكشي، 1428،ص6) وقد عدّ بعض الفقهاء أن الاصطلاح مقابل للشرع، فإذا كان الشارع هو وحده الذي يقر الأمور الشرعية، فإن أهل علم من العلوم لهم حق التصالح والتشارك في وضع المصطلحات، وذلك في حدود اللغة التي اعتبرها كثير من الفقهاء وأهل التفسير أنها توقيفية (الكفوي، 1435،109).
ولا نعني بهذا البحث الانغلاق على النفس، والانعزال بالذات عن الآخرين في العوامل البشرية المشتركة، لأن مناط المعرفة الحقيقية هي الحكمة، وإن هذه العزلة لو حدثت، فإنها منافية لحقائق الفكر والتاريخ، لكن لكي يتم التلاقح الحضاري – وليس الاستلاب كما يحدث الآن – فيجب أن نتوصل الى طرائق التفكير ضمن ظروفها الاجتماعية والثقافية والتربوية، وكل هذا لا يحدث ولا يتم الا بالوعي، الوعي بالاختلاف، والشعور بالمشكلة، لتحقيق أقصى خطوات النهضة المنشودة، لأن انعدام الإحساس بهذه المعضلة التاريخية – لاسيما بين متخصصي التربية الإسلامية – يجعل الجهود المبذولة في التأصيل والإبداع والتجديد تضيع سراباً ووبالاً، وعندما يشعر الجميع بحجم مهمة (البناء التربوي الحضاري) فإنهم سيتنادون بالجهاد النفسي، والاجتهاد العلمي المفضي إلى إعداد الإنسان المسلم، وفق التصور الإسلامي الخالد .
فالتربية الإسلامية لم تنتج حتى الآن مصطلحاتها الخاصة على الظواهر المستجدة والنوازل التربوية التي تصبغها بروحها ومرجعيتها ولغتها، ولكنها تستعير هذه المصطلحات جاهزة على ما فيها من رؤية مغايرة، ورسالة مخالفة للدين الإسلامي، ومعنى غير وافٍ أو ناقص، ويجب عند اضطرارنا لاستعارة مصطلح ما من خارج منظومتنا التربوية؛ أن نصيغ عملية التصور والمفاهيم كاملة، فتغيير المصطلح تستتبعه جهود أخرى للتخلص من أي أفكار مضمرة تتسلل إلى الفكر التربوي، وهذا التصوّر هو المعيار الذي يُرى به الأشياء ويحكم عليها بالصواب أو الخطأ؛ ولا يأتي التصور إلى بعد أن تنعكس القيم والمفاهيم في الواقع المعاش لحياة المسلم، من خلال مظاهر السلوك والعادات الاجتماعية وتفاعله مع المواقف اليومية، فيتوقف عند المواقف التي تتباين مع قيمه العليا وعقيدته الإسلامية، ويقبل ما تبيحه هذه المثل العليا المتجذرة في نفسه وسلوكه، لأنّ القيم الأخلاقية إذا ضعفت في شخصية الإنسان، انعكست على تصوّره للمواقف والأحداث ما تجعله يتخبط مع أهوائه ورغباته.
ويمكن القول إن التحيز هو أداة معرفية غربية للسيطرة على الآخرين، كما هو الاستشراق أداة ثقافية لتحقير الشعوب، وكما هو الحال في الاستعمار الذي يعتبر أداة حربية لاستحلابهم، وذلك كأدوات حديثة ظاهرها الرحمة ومساعدة الشعوب، وباطنها الحقد والعذاب الأليم، والمصطلحات هي أداة نقل هذه الحضارة بكل علاتها، حتى تتشكل لدى الآخرين دون أن يلتفتوا الى هذه الحمولات المخالفة , وعلى الرغم من أن المصطلحات لا تتجاوز مفرداتها كلمة أو كلمتين في الغالب، إلا أنها تعد من أشد العناصر الفكرية أثراً وتأثيراً في ثقافة الشعوب، فبسببها يتم تثبيت المفاهيم والأفكار، وقد تؤدي الى تحويل الفكرة الى النقيض تماماً، وقد تم تشويه التفكير الإسلامي من باب المفاهيم والمصطلحات، من خلال الغزو الثقافي الذي كاد أن يتسبب في اندثار كثير من المفاهيم الإسلامية (أمحزون، 1432، ص111-112).
وتكمن مشكلة التربية في أن النظريات المعرفية الغربية تحوي تحيزاً سواء في رؤيتها، أو مصادرها، أو فلسفاتها، ومفاهيمها، ومن ثَمّ مصطلحاتها التي تعبر عن اللبنة الأخيرة في التعبير عن النموذج الغربي، مما أدى إلى تأثر المصطلح التربوي بهذا التحيز المعرفي، وظهور هذه المصطلحات عبر التربية العربية والإسلامية، لاسيما المصطلح المعبّر عن الذات الغربية والمصوّرة لفكرهم الحضاري الخاص بهم وبسياقهم التاريخي.
وحين نقل المسلمون العلوم التربوية وبالتحديد هذا النموذج، اكتشفوا أنه يحوي داخله كموناً للفلسفة الغربية ومصطلحاتها التربوية بما تحويه من إلحاد، ومعاداة للإنسان، وحرب على الطبيعة، ومحاولة للسيطرة على الكون، وربما أسهم في إخفاق التربية عند المسلمين الى تبنيها هذا النموذج المادي الذي لا يجيب على الأسئلة النهائية الكبرى، كما أنّ هذه المصلحات الغربية لا تتواءم مع الدراسات التربوية ذات الأصل الإلهي، حيث تقوم بإحداث قطيعة مع التراث أياً كان هذا التراث من منتجات وآثار المدونة التربوية لعلماء المسلمين، أو ما تمثّل بالنصوص الشرعية والأدلة الدينية القطعية.
إن المنظومة المعرفية الغربية تسعى بما تحتويه من مناهج وعلوم إلى إقرار حقيقة أن مركز الكون كامن فيه وليس متجاوزاً له، وهذا يعني أنه لا يخضع لإله موجود، كما أنه لا يعترف بالمنظومة الأخلاقية والمعرفية المتعالية، فالكون يفسر نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى قوى خارجية ومرجعيات غيبية، لذلك هو يصنع أخلاقه وتربيته وفلسفته بالعودة إلى تاريخه وعلمائه .ولم تكن هذه الرؤية إلا عبر مراحل تاريخية طويلة، فأول ما ظهر الرؤية الإنسانية الهيومانية التي جعلت من الإنسان مركزاً للكون، بل وآلهته حتى أن الأدب كان معبراً عن مركزية الإنسان في الكون، ثم تطور الأمر مع فلاسفة عصر الاستنارة الذين رأوا أن الإنسان ما هو إلا آلة، حتى بزغ عصر داروين ونيتشة وأنجلز فقاموا بتفكيك الإنسان وإعادة صياغته حتى يتسق مع منطق المادة والأشياء الطبيعية، فالعالم في نظرهم نسق كلي طبيعي مادي متماسك وفي حركة دائمة مستمرة، كما أنه يخضع لمنطق تطوري، وتقدم مستمر لا تراجع فيه، وهذه الفلسفة تهدف في النهاية إلى تشكيل نظرة كلية أن الإنسان جزء مادي وليس ظاهرة فريدة مما يعني تفسير سلوكه وغاياته وفقاً لتفسير القوانين المادية الطبيعية (المسيري، 1996 ).
وحين ظهر أوغست كونت(1798-1857) وضع كما تشير الوثائق التاريخية أسس المدرسة الوضعية في الفكر الغربي ليكون مؤسساً لعلم لاجتماع الحديث، الذي يُعنى بدراسة الظواهر القابلة للملاحظة وإقامة علاقات بينها تشبه القوانين، وذلك عن طريق كسب معرفة دقيقة وواقعية، والمعرفة الإنسانية لا تصبح معرفة مالم تستند إلى الملاحظة والتجربة والمقارنة، ولا شك أن كونت قد تأثر بعلماء الطبيعة ومنهجيتهم في العلوم البيولوجية والطبيعية في دراستها للظواهر الجامدة والحية (الذوادي، 1997، ص27-28).
وقد طوّرت أوربا في الزمن المعاصر، منظومة من الأفكار والممارسات التي تفاعلت معاً لتكوّن نسقاً موحداً، يتجاوز إشكاليات وخلافات العصور الوسطى، حينما كانت أوربا منقسمة على نفسها بسبب الحروب، فبدأ الكيان الأوروبي مؤثراً في العالم، ويمكن اعتبار عدد من العوامل هي التي ساهمت في هذا المكون المتجانس لعل أبرزها: اللغة اللاتينية، الأدب القديم، الانتلجنسيا التي بدأت منذ القرن الثالث عشر تدرس في جامعات متماثلة، تطابق الأذواق والميول عند الطبقات الحاكمة، البعثات العلمية إلى الشرق الأقصى في القرن الثالث عشر (إبراهيم، 1997) ويعني هذا التوقف أمام تاريخ التربية والفلسفات التي قامت عليها، إذ نحن أمام تحريف وتحيز يجعل من الصعوبة نقل هذه الفلسفات وما أفرزته من تجارب ومفاهيم تربوية، وذلك لأنها تستبعد الأصول الدينية (الكتاب والسنة) من مصادرها المعرفية وتعتمد على ما أنتجه فلاسفتها وعلماء تربيتها بناء على استقرائهم التاريخي وحدسهم الفكري.
ويعاني المجتمع المسلم اليوم في مناهج العلوم وفلسفتها لاسيما في العلوم الاجتماعية والإنسانية من النظرة التحيزية الضيقة التي صبغت النظريات والأفكار العلمية عند الغرب، فأصبحت نظرته للعالم هي النظرة الأوحد التي يلزم بها كافة مدارس العالم ومذاهبه، فالتحيّز في أصل فلسفته؛ ما هو إلا تمحور وتمركز حول الذات ورؤية الآخرين من خلالها، مما يعني ” نفي الآخر نفياً كاملاً خارج إطار التاريخ أو العلم، والسعي نحو استبدال ماهيته أو هويته وإحلالها بمحتوى يتفق ومعطيات الذات وأهدافها، وذلك بالقضاء على تفرّده وخصوصيته وإعادة إدماجه في النسق الذي ترى الذات المتحيزة أنه الأمثل، طبقاً لمنظورها للإنسان والكون والحياة” (عارف، 1997، 2-172).
إن فلسفة أي نموذج معرفي تقوم على عدد من المعايير والمحكات الداخلية، التي تتكون من عقائد ومسلمات وأسئلة كلية ونهائية تشكل أصوله وأسسه المعرفية، وتعتبر هي” النموذج والقيمة الحاكمة التي تحدد النموذج وضوابط السلوك، وحلال النموذج وحرامه، وما هو مطلق ونسبي من منظوره، فهي باختصار مسلمات النموذج الكلية أو مرجعيته التي تجيب عن الأسئلة الكلية والنهائية ” (المسيري، 1997، 9) وهذه الاسئلة تختلف في النموذج الغربي عنها في العقيدة الإسلامية، فسؤال مثل : ما الهدف من الوجود في الكون ؟ لا تتطابق إجابته عند علماء التربية في الغرب مع علماء الإسلام، وهذا سؤال واحد فضلاً عن بقية الأسئلة الغائية التي تتباين إجاباتها تماماً عن النموذجين، مثل الطبيعة الإنسانية، ومركزية الكون، والعلاقة مع الطبيعة، مما يضحي التسليم بهذه المعرفة ونقلها دون تمحيص ذوباناً للعقيدة الإسلامية وانصهاراً في ثقافة تتعارض بالضرورة مع مرجعيته الفكرية.
لقد سنحت فرصة ذهبية لمفكري الغرب في الاستفادة من مؤسس علم الاجتماع العالم الإسلامي عبدالرحمن بن خلدون، وذلك في دراسة علم العمران، والتنظير حول تطور المجتمعات واندثارها، لكن لأن الملة الباطلة لا ترى إلا ما يوافق هواها، فقد رأت أن مقدمة ابن خلدون ما هي إلا ترهات وتناقضات لا تستقيم مع أسس المنطق الوضعي الذي بنوه، وإنه لا يعدو أن يكون سوى فكر لاهوتي خرافي، وهذا يعود إلى اختلاف الرؤية الاجتماعية والتاريخية لابن خلدون عن ظروف المجتمع الغربي، لأن الصراع بين الكنيسة والعلم لم يحدث في أي تاريخ بشري سوى عند الشعوب الأوروبية، كما أن دراسات ابن خلدون عن الغيب والنبوة والخوارق اعتبرها الغربيون أنها في عالم غير حسي، فهي في تصوّرهم تكهنات خاطئة على الرغم من أنها من صميم المعرفة الإسلامية الراسخة عند المسلمين.
إن العقل الغربي المعاصر المعتمد على المادة والتجريب والمتحيز ضد ما هو غيبي، لا ينظر إلا للمعرفة عن طريق الحس والتجربة الماديين، مما جعله يتبنى مفهوم الحتمية المتشددة بخصوص القوانين التي تحكم السلوك البشري والظواهر الاجتماعية، وما لم تتخلص المعرفة الغربية من هذه الرؤية الحتمية و الأحادية للعلم، وتستبدله منظار متعدد الرؤى لفهم الظواهر الاجتماعية، فإنها ستظل تدور في حلقة مفرغة لا مخرج منها (الذوادي، 1997، 36-41) ويجب علينا لتجاوز هذا الخلل في نظرية المعرفة الغربية أن نصنع دورنا الحضاري بأنفسنا، وذلك من خلال نقل الوظيفة التقدمية للعلم وفقاً لإمكانات وظروف المجتمع المسلم، ولا يأتي ذلك إلا بالتنبه للمفاهيم والمصطلحات السارية عند الدول المتقدمة، كما يجب التوقف عن استيراد المناهج والممارسات التي استخدموها في حضارتهم لأنها لا تفسر السلوك البشري القويم في صورته التي أظهره الله عليها.
أولاً: المعالم الرئيسة للتحيز في فلسفة التربية الغربية
تأثر النظام التربوي في العصر الحاصر في المجتمعات المسلمة بما أفرزه النظام التربوي في المجتمع الغربي، لاسيما فيما يخص المناهج البحثية التي تقوم على نظام وضعي وتحكيم العقلانية والموضوعية وإمكانية تكرار الملاحظة في السلوك البشري ” وتمتد أمثلة السعي المستمر لمفكري المناهج للتشبه بالعلم الطبيعي وإجراءاته، وتمتد أمثلة السعي المستمر لمفكري المناهج للتشبه بالعلم الطبيعي كما أشار(اسماعيل، 1997) من الطموح المبكر لشارترتس (sharturts ) وبوبت ( Boobitt) واشتقاق سنيون المكثف من مناهج البحث في علم الاجتماع إلى المساعي الأخيرة الحديثة لاستخدام منهج تحليل المنظم لتقويم الناتج التربوي والعمليات التعليمية، حتى أن الطبيعة الإنسانية التي تعتمد عليها التربية في كشف خصائص النفس البشرية ودوافعها من أجل اختيار السلوك الذي يوائمه لا يزال عند الغرب لم تستقر دعائمه، ولا يزال إنسان التربية في المختبر وداخل المعمل تُجرى عليه التجارب والافتراضات، فكان من نتائج هذا الفكر الوضعي سكوته عن دراسة السمات التي يتميز بها الإنسان عن سواه من الكائنات الحية، فأصبح ما يسميه الفلاسفة بحرية وإرادة وروحانية وأخلاق الإنسان لا تلقى إلا التجاهل في موسوعة معارف العلوم الاجتماعية والتربوية الحديثة .
ويحدد( الذوادي،1997، ص34) السبب في ذلك إلى عدة عوامل، منها : أنها لا تعترف بوجود هذه المسائل أساساً، لأنها تعتبر عند المنطق الوضعي الإمبريقي من قبيل الميتافيزيقا، أو لكونها لا تقدر على دراستها بمناهجها الوضعية الكمية التجريبية، أو ايضاً لكون الاعتراف بعوامل الحرية والإرادة والروحانيات، كمؤثرات في سلوك الإنسان، يصطدم مع قانون الحتمية الاجتماعية المتصلبة عن كل من دوركايم وعلماء النفس السلوكيين.
ولو استعرض الناقد التجارب العلمية التي أقامتها المدارس التربوية على الحيوانات والحشرات لرصد التناقض البيّن فيها، على ما فيها من تعارض مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ذلك تجربة (سكنر) العالم السلوكي الشهير الذي اخترع صندوقاً مزوداً بقضيب كلما ضغط عليه الفأر سقطت له قطعة طعام، واتضح أن الفأر ظل يردد ضغطه على القضيب ويتناول ما يسقط من الطعام، حتى إذا شبع كفّ عن الضغط، وتخلص هذه التجربة إلى أمر مفاده أنه لا داعي لافتراض مؤثرات غير مادية كالإرادة والقدرة على اتخاذ القرار، فإذا ما فُحص هذا الموقف تجد أن ما اكتشفوه ليس هو كل ما تدلّ عليه المشاهدة، وأن هناك تجارب أخرى تدحض هذه التجربة؛ حيث إن دوافع الأفعال ليست محصورة في توقع هذه الجزاءات المادية وإنما هناك أبعاد غيبية ونفسية متعددة وأن هذه التجربة لا تصلح لتفسير السلوك الحقيقي علاوة على ما فيها من تعريف انتقائي للسلوك(إسماعيل، 1997، ص444-445).
لقد هيمنت مظاهر التحيز حتى وصلت إلى أقسام الأصول التربوية، دون أن يتمكنوا من فرز هذه الأفكار التربوية المتحيزة من كشفها وتحييدها، وأردف (إسماعيل، 1997، 444) ويتصل بهذا ما يتم في المقرر الذي يحمل اسم أصول التربية حيث تتم فيه دراسة مفاهيم معظمها تمثل طرحاً أمريكياً براجماتياً واضحاً مثل : الخبرة والديموقراطية، دون أي جهد يذكر لدراسة الأصول الإسلامية للتربية العربية والمتمثلة في القرآن والسنة واجتهادات المفكرين والمدارس التربوية الإسلامية فينشأ معلمونا وقد ارتبطت عقولهم بالنهج الغربي في التربية.
بل أصبحت التربية الإسلامية في بعض مقررات أقسام التربية الإسلامية مجرد مرحلة تاريخية ولّى عصرها، وذلك حين تجد في بعض مقررات التربية الإسلامية في الدراسات العليا أنها تبدأ في المقررات التي تتعلق بالتطور التاريخي للتربية بتقديم نماذج منها عند اليونان والرومان والمصريين والصينين، ثم تقدم في العصور الوسطى التربيتين الإسلامية والمسيحية معاً فتأتي التربية الإسلامية بشكل عرضي في سياق تاريخي غير مؤثر ومستمر، ويختتم المقرر بالتربية الحديثة التي تمثلها التربية الغربية الحديثة، ويُكتب على التربية المستوحاة من الكتاب والسنة وتتميز بالشمول والثبات أن تظل أسيرة في كتب التراث ومدوناتها، وفي ذلك إشارة مضمرة أن التربية الحديثة المتحيزة لمرجعيتها، أنها التربية العالمية التي يجب أن تكون النموذج المحتذى لأمم الأرض، الأمر الذي يدعو مؤسسات التربية النظر إلى هذه المقررات بعين العدل، ووضعها في سياقها الحقيقي، فالتربية الإسلامية بدأت من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في أوج ازدهارها واستمرت على عهد الخلفاء الراشدين وإن كانت ضمرت في عصر من العصور، فإنها لا تزال تمتح من الوحي الرباني ولم تنقطع بعد والذي توقف هو فكر علماء التربية، وكانت هزيمتهم النفسية قد ساهمت في هذا الإحجام .
ولعل من المهارات التربوية التي تأثرت التربية الإسلامية من خلالها بالبيئة الثقافية التقدمية مهارة الحفظ، فقد روجت حيناً من الدهر أن هذه المهارة قد تسببت في تردي مستوى التعليم، مما يجب معه إغفال هذه المهارة واستبدالها تماماً، وهي ربما كانت إشارة غير مباشرة إلى تهميش مركزية القرآن الكريم الذي يعتمد نقله بشكل كبير على الحفظ من أجل فك علاقة المحبة والتأثر بين القرآن والمتلقي، وقد أشار (المسيري، 1997) إلى ذلك بأنه كان يؤمن بهذه المقولة حتى وصل إلى جامعة كولومبيا عام 1963 في دراسته للماجستير ففوجئ بطلب الكلية منه حفظ الشعر الرومنتيكي عن ظهر قلب، وحين سأل عن السبب قيل له إن الحفظ من أحسن آليات إنشاء المودة والحميمية بين الطالب والنص .. ثم تعلمنا أنه في كثير من العلوم الإنسانية لابد وأن يقوم الطالب بحفظ بعض قواعد والعناصر الأساسية عن ظهر قلب، فتسلّل الشك إلى قلبي من يقيني التقدمي.
ثانياً: مظاهر التحيّز العربي في المصطلحات التربوية
قال ابن حزم في كتابه النبذ “والأصل في كل بلاء، وعماء، وتخليط، وفساد واختلاف الأسماء، ووقوع اسم واحد على معانٍ كثيرة. فيخبر المخبر بذلك الاسم وهو يريد أحد المعاني التي تحت ذلك الاسم فيحمله السامع على غير ذلك المعنى…فيقع البلاء والإشكال” (ابن حزم، 2010، ص22) وأضاف (الغزالي، 1424،ص22) على ذلك “بأن كثيراَ من الخلافات منشؤها عدم الوضوح في المصطلح بين المشتغلين بها.
فالمصطلح إذن في العلوم لاسيما العلوم التربوية لابدّ أن يجلّي حقيقة معرفية لا نزاع فيها، كما يعبّر عن هوية الأمة ومقوماتها ولغتها، فإذا كان هذا كذلك، فإن استيراد مصطلحات الآخرين بحمولاتها الفكرية ودلالاتها المنحرفة سيكون معبراً لتخلف الأمة وتراجعها، على ما فيه من توقف الإبداع الفكري المعبر عن حاجات الأمة وتطلعاتها، وستكون مؤسسات التربية نسخة من نظيراتها عند الآخرين مصدراً ومظهراً، فالتحيز ليس مسألة حتمية يضطر الناس الى الوقوع فيها، فالتجرد والحياة هو سمة الحقيقة، وحيما ندعو الى الحقيقة، ونرى أننا متحيزون لها فقد ضاعت، ولكن ندعو ونحن نقرأ هذه المعرفة الغربية أن نؤصل فكراَ جديداَ وذلك لتعتنقه البشرية جمعاء، ولا يقتصر على المسلمين، وهذه دعوة ربانية قال تعالى فيها ( وكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ )(البقرة :143) وهذا يتناقض مع تصور لزوم التحيز.
وبدون محاكمة المصطلحات التربوية الغربية وما تنطوي عليه من بذور مادية وإلحادية سيظل المشهد التربوي تابعاً لا مبدعاً، مما يعني وجوب الإحاطة بهذه المصطلحات واستيعابها وفهمها ومن ثم توليدها، فهو الخطوة الأولى ” لأن يساير إبداع المصطلح عملية النمو والازدهار لكل الأمة، خروجاً من استدعاء المصطلحات المتحيزة التي تغيب فيها الخصوصية التربوية والثقافية، لأن أخطر ما يصيب الأمة أن تصاب في عقلها ولغتها وثقافتها، لأن ذلك يؤثر على المدى البعيد على عقيدة الأمة وحضارتها وإنسانها(شيار، 1421، ص29).
ومن مظاهر هذا التحيز أن مفهوم الأسرة الذي تعني في المجتمع الإسلامي الوحدة الأولى للمجتمع، وأولى المؤسسات التربوية التي تنشّئ الفرد اجتماعياً، ويكتسب منها المعارف والمهارات والميول والعواطف حتى سن متقدمة، يتوقف مفهومه في الغرب عند سنٍّ مبكرة، حيث ينتهي علاقته بوالديه وتصبح العلاقة فيه تعاقدية بحتة، فالدال (الأسرة) واحد لكن يحمل دلالتين متباينتين (الرويلي والبازعي، 2002، ص106) ويرجع هذا التباين إلى أن كل مجتمع ينظر إلى الأسرة وفقاً لرؤيته الدينية والفلسفية، فالعلاقة عند المسلمين هي علاقة تراحمية يصل فيها الأخُ أخاه ويصل فيها الابن والديه وهكذا، خلافاً لما عند الغرب الذي ينظر إلى الأسرة وفق رؤية كامنة تفرضها عليه فلسفيته الحضارية، مما يجب معه فك الاشتباك عند التربويين عند الحديث عن الأسرة كمصطلح تربوي بحيث يحدد الأسرة ومكوناتها عند أي حضارة وفي أي مجتمع.
فمن اتبع هذا النموذج في مصطلحاته ومنطلقاته دون إدراك كامل للبعد المعرفي، فإنه سيتبنى مسلمات النموذج ومناهجه دون شعور منه، لاسيما أن هذا النموذج قد تمكن بسطوته وقوته من فرض نفسه سواء كان بالإغراء أو بالقوة، بل وصل الحال بمفهوم الأسرة إلى ما هو أسوأ من ذلك، إذ صار محور الأسرة وبانيها وهو : المرأة، في مهب ريح الحداثة وفقاً ل(المسيري، 1997) فالحداثة الغربية ترى أن العمل الذي تمارسه الزوجة أو الأم في المنزل ليس عملاً حقيقياً، وأن عمل المرأة داخل المنزل لا يمكن قياسه كما لا تتقاضى عليه أجراً، إذن فهو عمل فارغ من القيمة التربوية ينتمي للحياة الخاصة، والعمل الحقيقي هو في الحياة العامة باعتبار أن حلبة السوق هي المضمار الذي يمكن أن تقدم فيه المرأة العمل الحقيقي.
ففلسفة كهذه يمكن أن تخرج عاملة متميزة في الميدان العملي، لكن المهمة التي انتدبها الله لها من إنجاب الأولاد، وتربيتهم على العقيدة الإسلامية، ورعاية الزوج، هي شيء هامشي ثانوي لا قيمة لها في عالم الإنتاج، مما يجعل المربي على حذر عند تعرضه لهذه المفاهيم المراوغة التي تتعارض مع تربيتنا الإسلامية، فالمرأة هي الأس التي تبنى عليها الحضارات حين تكون مدرسة ولادة لأبنائها، تنشئهم النشأة الصالحة، وتغذوهم القيم الأخلاقية كما تغذوهم الحليب والطعام، لأنها لو لم تعمل ذلك لفشلت الأسر في تربية الابناء، في الوقت الذي من الممكن أن يقوم الرجل بما تقوم به المرأة في ميدان الإنتاج والعمل.
لقد أفرزت فلسفة التربية الغربية مصطلحات مادية عديدة، وهي في خضم عملية التقدم، كالديموقراطية، والحرية، والعدالة، لكنها أهملت مصطلحات أخرى ولم تلتفت إليها تشمل البعدين المادي والروحي، وتتضمن العالمين : عالم الغيب وعالم الشهادة، ومفاهيم التقشف والزهد والإيثار التي تحث عليها التربية الإسلامية بل ” أين مفاهيم مثل التكافل الاجتماعي، كذلك أين موضع المجتمع العقدي الأخلاقي الذي يرى غايته في تحقيق مُثل مِثل الطهارة والعدل والالتزام ..الخ؟ … وهل تم استقراء غايات جميع المجتمعات البشرية ثم صيغت غايات مشتركة تعبر عنها جميعاً؟ هل قرئت الأديان والفلسفات البشرية جميعاً لاستخلاص أهم غايات الإنسان في هذا الكون؟ أليس الأكثر صدقاً أن يكون لكل مجتمع غاياته؟”(عارف، 1997، 184) مما يعني أننا بحاجة مع هذا الواقع المعرفي المتحيز إلى الاختلاف التربوي، لكن يجب أن نعي أن الاختلاف هو نتيجة عملية فكرية شاقة، لكنها تعبر عن إرادة علماء التربية وعقيدتهم، ولا يعني ذلك إلغاء أفكار ومشاريع الآخرين بقدر ما يعني الاعتزاز بالهوية التربوية الإسلامية التي تراعي احتياجات المجتمع.
ومن المصطلحات التربوية التي يكثر استخدامها في الجامعات ومراكز البحث العلمي : مصطلح العلوم الإنسانية، ترجمة لكلمة (humanities) المستخدمة في الغرب، والتي لا تعني أنها العلوم المتعلقة بدراسة الإنسان كما يعتقد الكثير من الباحثين، لأن علماء الغرب يستخدمونه كما يشير (الفاروقي، 1995) “ويقصدون به منذ عصر النهضة عندهم : العلوم التي تؤخذ المعرفة بها من الإنسان لا من الوحي الرباني، أي أنها تعني عندهم اتخاذ الإنسان مصدراً للمعرفة بدلاً من الله”.
لقد شاعت مصطلحات عديدة في الوسط التربوي لا تمثل الفكر التربوي الإسلامي الذي يحدد معالم الحكم على الأشخاص والأشياء بدقة وعدل “وكذلك فإن الحكم على الأعمال والمنجزات التاريخية والحضارية ينبغي أن تستخدم فيه المصطلحات الشرعية وهي: الخير، والشر، والحق، والباطل، والعدل، والظلم، كما جاءت محددة في القرآن والسنة، ولا تستخدم معايير الفكر الغربي كالتقدمية والرجعية” (أمحزون، 1432،ص111-116).
ومن المصطلحات الإشكالية التي صبغها العرب بفكره المتحيّز: مصطلح الثقافة، هذا المصطلح الوارد من أوروبا، وهو يعني عند العرب التقويم والتهذيب، لكنه في عصر النهضة الأوروبية أصبح يُطلق على الآداب والفنون (مرسي، 1417)ويعنون به قبل غرس هذه القيم : اقتلاع القيم السائدة القديمة في أي مجتمع سوى أوربا، باعتبار أن عملية التنمية لا يمكن أن تتم في ظل وجود ثقافة معوقة وغير تنموية، وهذا يستدعي إزاله هذه الثقافة التقليدية، ونشر قيم الحداثة بدلاً منها.
فالثقافة التقليدية هي الجمود الفكري والتأخر العلمي والطابع الأبوي، أما خصائص الثقافة الحديثة التي تمثل أوربا فهي تتصف بالعلمانية والمساواة والإنجاز، والتطور التقني، وهذا يعني ضرورة التخلي عن الأفكار القديمة والتخلص من رواسب التفكير في حال الرغبة في الدخول إلى بوابة الثقافة العالمية
أما مفهوم الموضوعية فهو من أخطر الإشكاليات التي يتعرض لها الدارسون للمفاهيم التربوية وذلك لما ينطوي عليه هذا المفهوم من مراوغة وضبابية، فالحقيقة أن النظريات العلمية والتطبيقات التي تحتويها تحمل بذورها الأخلاقية داخلها، فعندما تنقل إلى المجتمع التربوي فإنها بالضرورة تكون مشبعة بأخلاق المجتمع الذي صدرت منه سواء كان بوعي منهم أو بغير وعي، فالموضوعية تتمحور حول تحييد الإنسان عواطفه، ومشاعره المجردة تجاه القضايا والمعالجات التي يَحتاج فيها إلى اتخاذ قرار فهي على هذا “معيار أساسي من معايير البحث، يقوم على الصِّدق والعلم والأمانة، والبُعد عن الأهواء الشخصية (عبدالله، 1407، ص6) يقول رفيق حبيب “وتتزايد درامية الصورة عندما يحاول الآخر المتقدم إقناعنا بموضوعية العلم، وحتمية استيعاب العلم الحديث حتى نواكب التقدم المعاصر، وعندما نقتنع بالموضوعية المطلقة، وننقل العلم ننقل معه قيم الآخر المتقدم، فلا نتبع الآخر في المنهج والمحتوى العلمي فقط، بل نتبعه في القيم والأخلاق والعادات أيضاً، وهنا تكمن خطورة العلم الاجتماعي، فقد يكون وسيلة ناجحة لتحقيق التبعية الثقافية والسلوكية والقيمية الأخلاقية”(حبيب، 1997، 307-308).
فالموضوعية على ما فيها من نقل قيم الآخر على علّاتها، هي وهم علمي لا يمكن تصديقه، فكل علم أنتجه عالم بشري فإنه يحتوي بالضرورة على تفضيلات شخصية، أو أنماط فكرية معينة، لا يمكن فصلها عن السياق العلمي، فالذات تتدخل في محتوى الموضوعية، وأن كل الظواهر هي نتيجة اختيار، وليس هناك موضوعية حقيقية ومن ينادي بها يضع لها معانٍ محددة لا يؤمن بها إلا هو، وأقرب المصطلحات إلى الموضوعية مطابقة ومعنىً في التربية الإسلامية مصطلح (القِسط) الذي يعني تقديم مبدأ العدل وعدم التجاوز في الخلاف أو الحكم سورة الحق، قال تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )(النساء: 135) فالقرآن الكريم يدعو إلى التجرد عن حظوظ النفس عند الشهادة، ولو كان الحق على النفس وهو أشدها وقعاً وصعوبة، وهذا تجسيد لمفهوم العدل الحقيقي في التربية الإسلامية ويغني عن مصطلح الموضوعية وحمولاته التربوية.
ومن المصطلحات المتحيزة التي يطللقها علماء التربية في سبيل التهيئة على استيعاب الآخرين، وتقبل أطروحاتهم المخالفة، مصطلح : التعددية الفكرية، والذي يعني في أبسط صوره : تعدّد الأديان والنحل والأفكار، وهي دعوة لتقبّل آراء الآخرين واستيعابها أياً كانت إساءتها للدين ومخالفتها له، بل نحتوا مصطلح (الأحادية) لمن يضيق فكره عن استيعاب آراء الآخرين، وإن كان كفراً بواحاً، وهذا مدخل مفاهيمي يستطيعون من خلاله النفاذ إلى الدين والإساءة إليه، والقدح في الأنبياء، والدعوة إلى الانحراف أياً كانت اتجاهاته، وذلك تحت ذريعة قبول الآخر، ولا يختلف عن ذلك مفهوم كالتجديد مثلاً، فهو يشير عند المجتمع الأوربي إلى الثورة المستمرة على القديم والانقلاب على كل فكرة تجاوزها الزمن، فالتحول هو الثابت الوحيد، لكن التجديد عند المسلمين له شروط وضوابط باختلاف الزمان والمكان، وليس نتيجة ضغوط الآخرين وتمريراً لقناعاتهم الفكرية وضغوطهم العسكرية. ويمكن في هذا الإطار استبدال مصطلح التعددية الفكرية بمصطلح : الاختلاف الشرعي، أو الحوار البناء، ليكون مقبولاً ويمكن استيعابه داخل المنظومة التربوية ” فالتعدد والاختلاف بينهما تقارب من جهة اللغة والاستعمال، لذلك فلا ضير أن تأخذ التعددية تقسيمات الاختلاف وأحكامه” (الأهدل، 1435، ص57).
لذلك فإن من الإشكالات العلمية أن الحضارة الغربية تقيس كل المصطلحات المنبثقة من قيم خلقية على مفهوم التقدم المادي المضطرد فهو المحك والمعيار الحقيقي بالنسبة لهم، فترى هذه الحضارة أن مصطلحات مثل الحق، والعدل، والظلم، والضلال، مصطلحات متحولة المحتوى والمدلول بتغيّر الفضاء والزمان، فيصبح ما هو تقدّم حقاً وعدلاً من وجهة نظرهم، وما هو تخلّف هو بالضرورة ضلالٌ وظلمٌ، لذلك لم يكن غريباً أن تنهب الشعوب، وتسرق ثرواتها، وتستعمر شعوبها بحجة دمغ هذه المجتمعات بقيم التقدم والعدل والمساواة، وما مواعيد هذه الحضارة إلا الأباطيل، ويدخل في هذا الإطار مصطلحات (الإنسان الاقتصادي) و(القيمة) و(العمل) فأضحت مدلولاتها لا تتجاوز الحياة الدنيا ولا شغل لها بإخراج الإنسان الذي يبتغي الآخرة، فالإنسان في هذا المصطلح ؛ هو المحور الكامن وراء الفكر الاقتصادي الغربي، الذي يتحكم في السوق والعرض والطلب، دون أي اعتبار لفطرة الإنسان وجبلّته البشرية وإن كان في ذلك تحفيزاً لشهواته وتسهيلاً لنزغاته، وأما القيمة فتتحدد بساعات العمل الاجتماعي دون أدنى اعتبار للطبيعة والأرض التي تعتبر من ركائز القيمة الأولية التي هيأها الله للإنسان ليستفيد منها في نفعه ونفع جميع البشرية.
إن التربية الإسلامية اليوم في حاجة إلى بعث مصطلحاتها ومفاهيمها من القرآن الكريم وإشاعتها في الميدان التربوي، ولا يعني ذلك سدّ منافذ الاستفادة من مصطلحات الآخرين، فإن اقترضت التربية مصطلحاً من لغة أخرى وجب عليها أن تستوعبه في نظام اللغة العربية وتنقيته من الحمولات الفكرية العالقة به، لأنها لو أبقته على وضعه السابق صياغة ومعنى فقد تحول إلى مصطلح دخيل لا يسهم في تطوير عملية التربية، وهذا يستدعي أن يهب علماء التربية الإسلامية لصياغة مصطلحاتهم بأنفسهم والعناية بها، وتأهيل متخصصين في كافة مجالات التربية مثل : الأصول التربوية، وتاريخ التربية، والمناهج الدراسية، والإدارة التربوية، وعلم النفس، ونظريات التعلم يدرسون المعاجم اللغوية، ويقارنون المفاهيم مع بعضها ويحددون هذه المفاهيم ويحررون معانيها ومضامينها، ومن ثم اشتقاق المصطلحات التربوية الملائمة لمدلولاتها.
فمن أعظم الإشكالات وضع تلك المصطلحات الوافدة من بيئتها الأصلية معيارًا ثابتاً تُفسر به الظواهر الاجتماعية في البيئة الجديدة؛ ويُحكَم به على كل شيء، الأمر الذي يساهم في ضمور المصطلحات التربوية الأصيلة للبيئة الثانية، فبقدر ما تحدث عملية الإحلال والتحويل يتم تجاهل المصطلحات الثانية الجديدة وتجاوزها، ومن ثم يجب في نهاية الأمر أن يتم سكّ المصطلحات التربوية المناسبة، وقد وضع بعض علماء اللغة ضوابط معينة تعين على سلامة المصطلح، ومنها : دلالة المصطلح المستعمل على مدلول واحد، وأن تكون وفقاً للحقيقة العرفية وليس المجاز، كما يتوجب على هذه الدلالة أن تكون جامعة مانعة لا تحتمل التوسع أو الحصر، واقتصادها في عدد الحروف تسهيلاً للاستعمال (قروي، 2008، ص286).
كما يمكن تدعيم المصطلحات والمفاهيم بالأبعاد الغيبية المتجاوزة لعالم الشهادة، واستلهام مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في تذكيره للصحابة بعاقبة أعمالهم في الآخرة مما يعني اتصال المصطلح بالمصائر والمآلات البعيدة، ومن ذلك حين سألهم عن المفلس، فكانت إجاباتهم لا تتجاوز ما يعتقدونه من انعدام المتاع في الدنيا، فلفت انتباههم بقوله ” أنّ المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ” (صحيح مسلم،1427 ،رقم الحديث 2581).
ولعل من ضمن الآليات التي اقترحها بعض الدارسين المشتغلين بقضية التحيز المصطلحي “محاولة الوصول إلى مصطلح أكثر عمومية من المصطلح الغربي، بحيث يصبح المصطلح الغربي هو عبارة عن مثال نسبي خاص، أو مجرد حالة لظاهرة إنسانية عامة” (هاشمي، 2014، ص304-305) وهو حل منطقي وعملي معاً، فقد كان لعلماء الأمة الإسلامية القدرة في (امتياز) كهذا، بل كانت تجربة المصطلح الأصولي ناجحة ومثمرة في دلالتها وإحكامها، لاسيما في مجال علوم القرآن، وأصول الفقه وعلم اللغة ومصطلح الحديث الشريف، وكان من تطبيقات ذلك كتاب : الرسالة للشافعي، وكتاب : علوم الحديث لابن الصلاح، وغيرها من الكتب التي امتازت بها الأمة في تاريخها الحضاري، ولديها القدرة في إعادة صياغتها من جديد وفقاً لمتغيرات العصر وظروف المجتمعات.
كما أن من الحلول لمواجهة هذا التحيز التربوي، عملية الاشتقاق التربوي من المفاهيم، وذلك بالحصول على لفظ من آخر أصل منه يشترك معه في الجذور، فيكون اشتراكاً لفظياَ ومعنوياً، كما يمكن توليد بعض الألفاظ من خلال عملية النحت اللغوي، ومن الوسائل المعينة على تفريد المصطلح التربوي الإسلامي كما اقترح (شيار، 1421 )عملية التعريب بحيث تنقل المصطلحات من الآخرين وإعادة صياغتها وفقاً للهوية الإسلامية، كما يمكن أن نقوم بعملية النقل والاستعارة إذا تحقق شرطان وهما : الفصل والوصل، بحيث نقوم بعملية فصل النموذج التنظيمي المطلوب استدعاؤه وبين الأصل العقائدي والإيدلوجي الذي نشأ عنه في بيئته الأولى، ثم وصل هذا النموذج التنظيمي بالسياق الديني الحضاري السائد في البيئة الجديدة.
فعلى الباحث في التربية الإسلامية أن يبرز من خلال منطلقاته؛ الفكرة الإسلامية الرشيدة من خلال الدراسة العلمية، كما يتوجب عليه أن يضع نصب عينيه وهو يراجع المفاهيم التربوية الوافدة أن تكون: غير متعارضة مع مفاهيم العقيدة الإسلامية بكافة مجالاتها وتصنيفاتها، والتفتيش عنها في التراث التربوي عبر تاريخه المتفوق الطويل.
- دكتوراه في الأصول الإسلامية في التربية