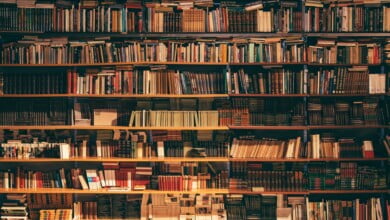- تأليف : إليزابيت دون – Elizabeth Dunn
- ترجمة : محمد بن خليفة الغافري
- تحرير : ياسر الرميح
مخيّم “سكرا” في جمهوريّة جورجيا، يُعتبَر واحد من أفضل المخيّمات في العالم، لكن على الرغم من أنّ المنازل المصنوعة من الطوب مُجهّزة بالكهرباء؛ إلّا أنّها غير مزوّدة بمصدر مستمرٍّ للمياه. ولأنّ المصدر الوحيد للتّدفئةِ هو مواقد الخشب الصّغيرة في البيوت؛ قامَ اللاجئونَ بقطع معظم أشجار المُخيّم في أوّلِ شتاءٍ قَضَوْهُ في المُخيّم.
تُواجه القارّة الأوروبيّة في الوقتِ الحَاضِر توافُد عشرات الآلافِ من اللاجئينَ من دول عدّة كسوريا وأفغانستان وشَمالِ أفريقِيَا، الذّينَ يجوبونَ عباب البِحارِ بقوارِبَ مُتهالِكَةٍ، وتراهم يتدفّقونَ من الحواجِز، ويمَلؤونَ محطّات القطارات، ساعينَ إلى إعادَةِ توطينِ أنفسهم في أرضٍ أخرى غير موطنهم الأصليّ. يُطلقُ على هذه الظّاهرة لفظ “أزمَة”؛ وهو مصطَلحٌ يُشير إلى مُشكلةٍ مؤقّتةٍ فقط ثمّ ستنتهي، و الفَضلُ في هذه الظاهرة يعودُ إلى الحروب الأهليّة المتكرّرة والوحشيّة في مختَلف أنحاء العالم التّي تسبّبت بمضاعفة عدد النّازحين ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال عشر سنوات، حيث ارتفع من 20 مليونًا إلى أكثر من 60 مليون لاجئ، وهو عددٌ يُقاربُ عدد سكّان المملكة المتحدّة. إنّ السّاسة الأوروبيين يتكبّدونَ نتائج المشكلة المركزية للسياسَة العالميّة في القرن الحادي والعشرين، حتّى إن لم يرغبوا بالإعترافِ بذلك. التغيّر المناخي، والاضطرابات السّياسيّة، ومشاكل أخرى، تضمَنُ أنّ هذا القرن سيشهدُ المزيد من الأفراد اللاجئينَ أو المهاجرين لأسبابٍ اقتصاديّة. ويُضاف إلى هذه المشكلة؛ الفشَل الذّريع لمشاريع مخيّمات اللاجئين كحلٍّ إنسانيٍّ وسياسي، فمنذُ خمسينيات القرن المنصرم؛ حاولت أوروبا جاهدةً لمنع النازحينَ من دخول أراضيها، وذلك من خلال تمويل مخيّمات اللاجئين المنتشرة على نطاقٍ واسع في دول العالم الثالث.
وعلى الرّغم من نداءات المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لإيجاد حلول مُستديمة؛ فإنّ الخطّة التي يعملون عليها هي أي ينتظر اللاجئون في المخيمات حتى تلك اللحظة التي يستطيعون فيها العودة إلى مواطنهم، حتّى لو لم تكن هناك نهاية متوقّعة للحروب، أو للإحتلال الذي تسبّب في نزوحهم. تعدُّ المخيّمات طريقةً مريحةً وفي المتناول بالنّسبة للسياسيين لكي يُجنّبوا أنفسهم عناء إصدار قراراتٍ جريئة عن الحروب الخارجيّة وقضايا الهجرة المحليّة وبالتّالي تحمُّلِ نتائجها، لكن المشكلة هي أنّ المخيّمات ليست إلّا ملاذًا وقتيًّا فقط؛ وبشكلٍ دائم [أي أنّ صفة الوقتيّة هي صفة ملازمة للمخيّمات إلى الأبد]. ولعدم وجود احتماليّة لإعادة التوطين الدائم للنّازحين، أو حتى توفير الضروريات الأساسية لهم لاستمرار الحياة، فليس من المستغرب أن يلجؤوا إلى الرحلات البريّة الخطيرة إلى أوروبا من أجل العيش.
“إن هذا ليس عيشًا، إنّه وجودٌ فقط” كما قالت لي مازيا خيزانشفيلي في صيف ٢٠١٤، عندما كنّا جالسين خارج كوخها الصغير في مخيّم لاجئين بجمهورية جورجيا. خلال الحرب بين روسيا وجورجيا، كانت خيزانشيفيلي مديرة مدرسة في منتصف العمر، وضحيّة للتطهير العرقي الذي طال ٢٨ ألف شخص آخرين في إقليم مقاطعة أوستيا الجنوبية الاتفصالية.
بعد أكثر من ٦ سنوات من الحرب، لا يزال أغلبهم موجودين في المخيّمات، التي أسمتها الحكومة “مستوطنات جديدة” تلطيفًا. وعلى الرّغم من وصول معدّلات البطالة في المخيّم إلى أكثر من ٨٠ بالمائة، ومع وجود قليل من الأراضي الزراعية المتاحة لسكّان المخيّم، قد فعل النّازحون الداخليون في أوروبا ما يفعلُهُ النازحون حول العالم في مخيّمات اللاجئين: لقد مكثوا وانتظروا فيها آملينَ ببدء حياةٍ جديدة.
عندما دخلتُ المُخيّمَ للمرة الأولى أُصبت بصدمة شديدة. كانت الشوارع المبنيّة بالحصى الأبيض المغبّر جرداء وتبعث على الكآبة، وكانت صفوف الأكواخ الصغيرة عبارة عن مكعّب أبيض متماثل يتبع بعضه بعضًا. لا توجد متاجر ولا كنائس ولا مدارس. لا توجد أشجار ولا شُجيْرات لتعطي منظرًا طبيعيًّا دالًّا على وجود حياة. لا يوجد حتى منعطف طريق يكسر صفوف الأكواخ المتتابعة في خطوط مستقيمة. كانت المستوطنة رتيبة للغاية، لدرجة أنّك تَتُوهُ بداخلها. في اليوم الذي انتقل فيه رجلٌ إلى المخيّم بادر بالسؤال ” عندما أكونُ في حالة سكر، كيف يمكنني معرفة المكان الذي أسكُن فيه؟”، حتّى عندما لا أكون ثملاً، تكون لديّ مشكلة كهذه، فكُنت كلّما قابلتُ أحدًا من سكان المخيم طيلة الستة عشر شهرًا التي قَضيتُها فيه بين عاميّ ٢٠٠٩ و ٢٠١١؛ كنتُ أضع له علامةً على الخريطة للعثور عليه لاحقًا.
مخيّمات اللاجئين صُمّمت خصّيصًا لفترة مؤقتة: لتلبية أمرٍ طارئ، ثم تختفي كأن لم تكن. هذه الطبيعة المؤقّتة للمخيمات تتجلّى في هندستها المعمارية، مثلا مخيّم الزعتري في الأردن يقطنُ فيه أكثر من ٨٣ ألف شخص في خِيَمٍ صغيرة، صفًّا تلو صفٍّ من الخيام، تكون غير ملائمة للسُّكنى في ظروف مناخيّة كتساقط الثلوج ودرجات الحرارة تحت الصّفر والفيضانات، وفوق كل هذا؛ لا توجد خطط لعودة اللاجئين منه إلى سوريا أو إعادة توطينهم في أيّ مكانٍ آخر. اللاجئون الكونغلويون في مخيّم نياراجاسو في تنزانيا أُجبروا على بناء منازلهم الخاصّة مستخدمينَ فقط قشًّا وطوبًا غير محروق، كل هذا لتتمكّن المفوضيّة السامية للأمم المتحدة – المسؤولة عن المخيم- من هدمها متى شاؤوا. “جُبلت أكثر الأماكن حميميًّة لللاجئين-يعني المخيّمات- على الزّوال المفاجئ، إنّ منازلهم بُنيت بنيّةِ تدميرها في أيّ وقت”، كما تقول عالمة الأنثروبولوجيا مارني طومسون.
لا أحد يريد أن تكون مخيّمات اللاجئين دائمة، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدُّول المُضيفة ولا وكالات الإغاثة الدّولية، لكن حياة العذاب داخل المّخيّمات تدوم لعقود وربّما حتّى لأجيال، هذا لأنّ الأوضاع السياسيّة في أوطان النّازحين تظلّ مضطربة. إنّ متوسّط مدّة الإقامة في مخيّمات اللاجئين لا يتعدّى ١٢ سنة، لكن الفلسطينيون يدخلون في سنتهم السابعة والستّين منذ نزوحهم. التقيتُ في جورجيا بأشخاصٍ نزحوا منها بسبب الحرب التي كانت في مقاطعة أبخازيا منذ ٣٢ عامًا، أناسٌ لا يزالون مزدحمين داخل أنقاض لفنادق سوفييتية قديمة منهارة، والتي اعتُبرت رسميًّا ملاجئًا للنازحين، أنقاض تحتوي جدرانها المتفتتة وأرضيّاتها الخشبية المتعفّنة على مياهٍ للصّرف الصحّي وتماثيل لستالين. أيضًا في السودان يعيش أكثر من ٢٠ ألف نازح من إقليم دارفور في مخيّم زمزم لأكثر من ١٢ سنة، وهو ملجئٌ مصنوعٌ من عصيّ وأقمشة بلاستيكيّة. لا يبدو بأنّ هناك احتماليّة لعودة النّازحين إلى مساكنِهم، ولا أيضًا لاندماجهم في المجتمع الذي يُقيمون فيه حاليًّا، بعبارةٍ أخرى؛ إنّهم مُحاصرون في ما تُسمّيه مفوضيّة الأمم المتحدة “حالة نزوح ممتدّة”. عندما يمكثُ الناس لفترة طويلة في المخيمات، يُصبح خلوّها من الأغراض وعوز خدماتها وعزلتها عن المجتمعات المُجاورة مشاكِلَ مزمنة، فالمُخيّمات تُبقي الناس أحياءً، لكنّها تمنعهم من العيْش. كثيرٌ من المخيّمات تفتقر إلى المدارس، ودُوَر العبادة، والمتاجر، حتّى عندما يقومُ مانحون كالأمم المتحدة أو الحكومة التركية ببناء مخيّمات ببنية تحتيّة مُستدامة؛ فإنّ معظم تلك المخيّمات تفتقرُ إلى تلك المرافق التي تحتويها أي مدينة أخرى بنفس الحجم.
البَطالة مُتفشيّة في مخيمات اللاجئين، ذلك لأنّ العديد من المُخيّمات تُبنى، عن قصدٍ، بعيدًا عن المناطق المدنيّة المُتحضّرة؛ لكي لا تؤثّر على القوى العاملة المحليّة. من ثَمَّ يكونُ صعبًا على اللاجئين، أو حتّى المستحيل، أن يجدوا عملًا مدفوعَ الأجر، حتّى عندما تُزوّدهم وكالات الإغاثة قُروضًا صغيرة أو تدريبًا مهنيًّا. إنّ بعض المخيمات في جورجيا بعيدةٌ للغاية، لدرجة أنّ سُكانها يُفضّلون تركها والإنتقال إلى العاصمة في محاولةٍ منهم لكسب قوتِ يومهم عبر بيع أقلام الرّصاص والسّجائر على أرصفة الشّوارع، أو حتّى العودة إلى قراهم الأصليّة المتهدّمة والقابعة تحتَ الإحتلال العسكريّ. حتّى أنّ الحياة مع الجيش الروسي الثامن والخمسين أفضلُ لدى بعضهم من الحياةِ في مخيّمٍ قصيٍّ على سفح تلٍّ تعصِفُ عليه ريحٌ متجمدة لدرجة أنه يجب عليك أن تُكافح للحصول على الغذاء. في مُخيّمات كتلك الموجودة في تنزانيا وتايلند، حيث يُمنع اللاجئين من أيّ شكل من أشكال العمل القانونيّ، يلجؤُ النازحون إلى العمل سرًّا، مما يجعلهم مُعرّضينَ لسرقة الأجور، والإعتقال، والحبس.
الأنكى من ذلك، تلك المخيّمات التي يُطلق عليها “المُخيّمات المُغلقة”، حيث تحظُر الحكومة المُضيفة اللاجئين من مغادرتها. في مخيّم نياراجوسو في تنزانيا؛ يُمنع على اللاجئين عن الابتعاد عن المخيّم أكثر من ٤ كليو مترات. بالطّبع إنّهم يفعلون ذلك، يتوجّب عليهم فعلُ ذلك أصلًا، سواءً أكان لشراءِ ما يحتاجونه، أو للعمل، أو حتّى لرؤيةِ أفراد عائلاتهم الذين لا تنطبق عليهم حالة اللّجوء ممن يقطنون في مدنٍ مجاورة بشكلٍ غير قانونيّ. وعندما يتم إيقافهم من قبل الشّرطة؛ إمّا إنهم يدفعون رشاويَ ضخمة، أو يتمّ اعتقالهم. ” حتّى لو كنّا أفضل حالًا، لا زلنا في سجن” كما يقول لاجئ كونغوليّ لطومسون.
على الرّغم من أنهم ليسوا بمجرمين؛ إلا أنّ اللاجئين فعليًّا يعيشونَ كالمساجين، ولفترة غير محدّدة. مُجبرينَ على العيش بحلولٍ مؤقتّة، وإلى الأبد، في مخيّمات بحجم مدينة، توفّر أملًا ضئيلًا للقاطنين فيها بتحقيق اكتفاء ذاتيّ من الناحية الاقتصادية. إنّ الأفراد النازحين يعيشون في أوضاع بائسة مفروضة ومُكرّسة عليهم. لذلك لا غرابة في أن يقوم السوريون أو الإفريقيّون، ممن يملكونَ مواردًا ومهارات، بمحاولة الوصول إلى أوروبا. إنّها أفضل فرصة يمتلكونها ليُعاودوا الإندماج في المُجتمعات المُتقدّمة، وإعادة بناء حياتهم الطبيعيّة.
بريزيتي، مخيّم للنازحين في جمهورية جورجيا، بعيدٌ جدًّا عن المناطق المأهولة لدرجة أنّ قاطنيه يشتكون من أنّ قطعانًا من الذئاب تلاحق أطفالهم في طريقهم إلى المدرسة. وذلك لأنّ المخيّم بعيدٌ جدًّا من أماكن العمل والخدمات المدنيّة. الكثير من سكّان المخيم قد عادوا إلى بلدانهم في جنوب أوسيتيا، حيث يعيشون تحت احتلالٍ عسكريٍّ روسيّ.
لو قلنا بأنّ من غير المرجّح أن تكون المخيّمات مؤقّتة فعلًا، فلماذا إذن تستمرّ الدول المتقدّمة-كالولايات المتحدّة ودول أوروبا الغربيّة- بتمويلها عوضًا من أن تبتكر حلًّا دائمًا؟ نظريًّا، تجعل المخيّمات المساعدات الإنسانيّة أكثر كفاءة. فمن خلال جمع النّازخين في مكان معيّن، تُقلل وكالات الإغاثة تكاليف تقييمات أوضاع واحتياجات النّازحين، وشحن امدادات الإغاثة وتوزيعها. لكنه في الواقع، يُوضع النازحون في مخيّمات لأسبابٍ أقرب لأن تكون سياسيّة أكثر من كونها أسبابًا إنسانيّة. فعندما تكون المخيمات في دول العالم الثالث؛ فإنّها تعمل على إبقاء النازحين بعيدًا عن أوروبا، وأيضا بعيدين عن الأنظار.
كانت أوّل مخيمات حديثة للنازحين داخل أوروبا، فما بين عاميْ ١٩٤٥ و ١٩٥١؛ قامت قوات التحالف وإدارة الأمم المتحدّة للتأهيل والإغاثة بإدارة مخيّمات فرنسيّة وألمانيّة وبريطانيّة، آوَت أكثر من ٨٥٠ ألف نازح أغلبهم من أوروبا الشرقيّة. لكن هذه المُخيّمات تمّ إخلاؤها، وقد تمّ ذلك إلى حدّ كبير بواسطة إعادة توطين النّازحين في الولايات المتحدة وكندا. لكن الدول الأوروبية توصّلت إلى خطّة بديلة لإدارة أولئك النازحين، خطّة من شأنها أن تُبعد النازحين الذين كانوا يمثّلون تهديدًا سياسيًّا وأولئك غير المرغوب فيهم اجتماعيّا، خارج أوروبا: أن تقوم بدعم المُخيّمات. حاليًّا، توجد أكثر من ٨٠ بالمائة من مخيّمات اللاجئين في الدول النامية، ومن خلال تمويل المفوضيّة الأممية للاجئين ووكالات الإغاثة الأخرى؛ قد استمرت الدّول الغنيّة بالدّفع مقابل إبقاء اللاجئين في أماكنهم.
خلال حروب يوغوسلافيا في تسعينيّات القرن الماضي، ظهرت استراتيجيّة أخرى لإبقاء اللاجئين بعيدًا. فظهر ما يُسمّى بـ “المناطق الآمنة” داخل الدّول التي مزّقتها الحروب، والتي تمنعُ النازحين من عبور الحدود الدوليّة، مما يجعلهم لاجئينَ بموجب القانون الدّوليّ، من ثمّ يُتاح لهم طلب اللجوء للدول المُجاورة. يضمنُ إبقاء النازحين في “أماكن شبيهة بالمخيّمات” انسيابيّة حركيّتهم، لذلك في حال استُعيدت أراضيَ أوطانهم؛ سيسهل إعادتهم إليها ليسكنوها. هذه الإستراتجيّة قامت برفع عدد “النازحين داخليًّا” إلى أرقامٍ فلكيّة. في عام ١٩٨٩، كان عدد اللاجئين ١٧ مليون، وعدد النازحين داخليًّا ١٦.٥ مليونًا. في عام 2009، قبل اندلاع الحرب الأهليّة السوريّة، كان عدد اللاجئينَ تقريبًا مستقرٌّ عند ١٥.٧ مليون، لكن عدد النازحين داخليًّا قد تضخّم إلى ٢٧ مليونًا.
إنّ الارتفاع الهائل في أعداد الأفراد النازحين داخليًّا يعني أن هناك خياراتٌ أقلّ وأقل للإحتواء. اليوم، يوجد تقريبًا ٢٠ مليون لاجئ وأكثر من ٣٨.٥ مليون نازح داخليّ، والذين بإمكانهم أن يعبروا الحدود الدولية من ثمّ يبدؤون بالتحرك نحو الدول المتقدمة. وفي نفس الوقت، أصبحت الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوربي أكثر ترددا من ذي قبل في تمويل أرخبيل المخيمات الذي يتزايد على نحو متسارع. في نهاية عام ٢٠٠٤، تمّ تمويل ٢٥ بالمائة فقط من المساعدات التي نادت بها المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين، وكانت مؤونة الغذاء والأدوية والطاقة قد بدأت بالنفاد. أضف إلى ذلك، أنّ برنامج الغذاء العالميّ، والذي يتم تمويله من قِبَل عملية نداء مشتركة من الأمم المتحدة، قد خفّضَ ميزانية اطعام اللاجئين السوريين إلى مجرّد ١٣.٥٠ دولارًا في الشهر. كلّ هذا يُخبرنا بأنّ محاولات العديد من اللاجئين لدخول أوروبا لا تتعلّق فقط بحياةٍ أفضل، بل بالبقاء على قيد الحياة.
الأمر جليّ، أزمة اللاجئين وُجدت لتبقى. على الرّغم من تعهّد الولايات المتحدة بإيواء مئة الف لاجئ بحلول نهاية ٢٠١٦، وتعهّد ألمانيا بإيواء ما يقارب من ٨٠٠ ألف لاجئ وتعهّد الإتحاد الأوربي بإيواء ١٦٠ ألف آخرين، يوجد ٥٨ مليون فرد نازح يتطلعون إلى مأوًى دائم. تستمر هذه الأرقام بالإزدياد، وكل رجل أو امرأة تعرّضوا للضّرب من قِبَل شرطة الحدود اليونانيّة على شواطئ ليسبوس، أو الذين يزحفون عبر السّياج الشائك الفاصل بين المجر وصربيا؛ سوف يتحدّون الأفكار الغربيّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، وسيُظهرون هشاشة مؤسسات الإتحاد الأوروبيّ التي أدارت العمل الجماعي لدول الإتحاد البالغ عددها ٢٨ دولة.
إنْ كان حجز اللاجئين في أماكن مؤقتة بشكلٍ دائم (أي: مخيمات) وعزلهم عن المجتمعات المحيطة يفشلُ في إبقاء المهاجرين خارج حدود الدول المتقدّمة؛ فكيف ستكون ردّة فعل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدّة لموجات المهاجرين القادمة؟ الحل الوحيد يكمُنُ في جَعْل الإستقرار حقّ من حقوق الإنسان، وأيضا بمساعدة اللاجئين لإيجاد حلول بأنفسهم تساعدهم على الإندماج في المجتمعات الجديدة، في وقتٍ مبكّر من نزوحهم. وبهذا سنتوقّف عن اعتبار اللاجئين أزمة ناتجة عن فقدان السيطرة على الحدود. إنّ سياج المجر يدلّ على هذه النظرة التي عفا عليها الزّمن: فهي ترتكز على فكرة أنّه إذا كان من الممكن منع اللاجئين من الدخول جسديًّا، فإنّ مشكلة اللاجئين ستظلّ خارج حدود أوروبا. لكن محاولة الولايات المتحدة للسيطرة على الحدود المكسيكيّة تُظهر بأنّ المهاجرين سيدخلون لا محالة، قانونيّا إن استطاعوا، وبشكل غير قانونيّ إن لم يقدروا.
الحلّ ليس في اقصائهم أو احتجازهم في بلدانهم الأصليّة، لكن بمساعدتهم لإعادة توطين أنفسهم بطرق تنفع الاقتصادات المحليّة والبيئات المدنيّة. أوروبا لديها عدد سكان كبيرٌ في السن، والذي يتسبّب بإبطاء النمو الاقتصادي ووضع عبئ ثقيل على شبكات التأمين الإجتماعيّ. قد يكون تدفّق شباب عاملين- مصلحو حواسيب، سبّاكون، مهندسون معماريون، مساعدو الرعاية الصحيّة المنزلية- حافزًا اقتصاديا للنمسا وألمانيا. فتقديمُ أشكالٍ متنوعة من المساعدات كالمنح النّقدية وقسائم الاسكان؛ عوضًا عن عزلهم في أماكن احتجاز أو البدائل الأخرى للمخيّمات، سيسمح لهذه الدول من الإستفادة من مهاراة اللاجئين اللغويّة وتدريبهم المهنيّ وروابطهم العائلية والموارد الماليّة التي يجلبونها معهم.
أمّا أولئك الذين يختارون البقاء في المخيّمات- سواءً أكان بسبب أملهم في العودة إلى الوطن في نهاية المطاف، أو للبقاء بالقرب من أقربائهم، أو لأنّهم يفضّلون البقاء بين أفراد يتشابهون معهم في اللغة والدين والثقافة- سيحتاجون إلى دعم مستمر من الغرب حتى يتمكنّوا من الاندماج في المحيط الذي هم فيه عوضًا عن إجبارهم على الهجرة. فبدلا من استمرار وجود مخيّمات تعاني من نقصٍ في التمويل بشكل مستمر؛ يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ الالتزام بتمويل مسكن دائم ومُجتمعات نشطة في الدّول التي يلتمس اللاجئون اللجوءَ إليها. في دول كتركيا وباكستان ولبنان، التي تؤوي ٣٠ بالمائة من اللاجئين حول العالم، فإنّ تدفّق المساعدات لبناء مدن حقيقيّة- مدينة مزوّدة بصرف صحيّ وشبكة كهرباء، ومدارس ومكتبات وأماكن عامّة ومؤسسات مدنيّة- من شأنه أن يحفّز الاقتصاد المحلّي، ويخلق وظائف جديدة، ويُسهّل على الدولة المُضيفة اعتبار اللاجئين كنعمة وليست نِقمة.
الأمر الوحيد الذي لا يسع الولايات المتحدة والدول الأوروبية القيام به هو انتظار اللحظة التي تنتهي في الحرب مِن ثمَّ عودة اللاجئين إلى مواطنهم. السّواد الأعظم من الصراعات القائمة التي تفرز لاجئين ليست قابلة إلى حلٍّ سياسيّ سريع. والدّمار الهائل التي تُخلّفه الحرب يعني أنّه لا توجد مساكن للعودة إليها. كما أخبرتني ماموكا خادوري، طبيبة بيطرية قاطنة في مخيّم لأفراد نازحين داخليّا في جورجيا بأنّه ليس هناك فائدة في انتظار الوقت الذي سيعود فيه اللاجئون من حيث أتوْا، “يجب علينا أن نعيش كما لو كنّا سنعيش هنا إلى الأبد”.
المصدر : The Failure of Refugee Camps