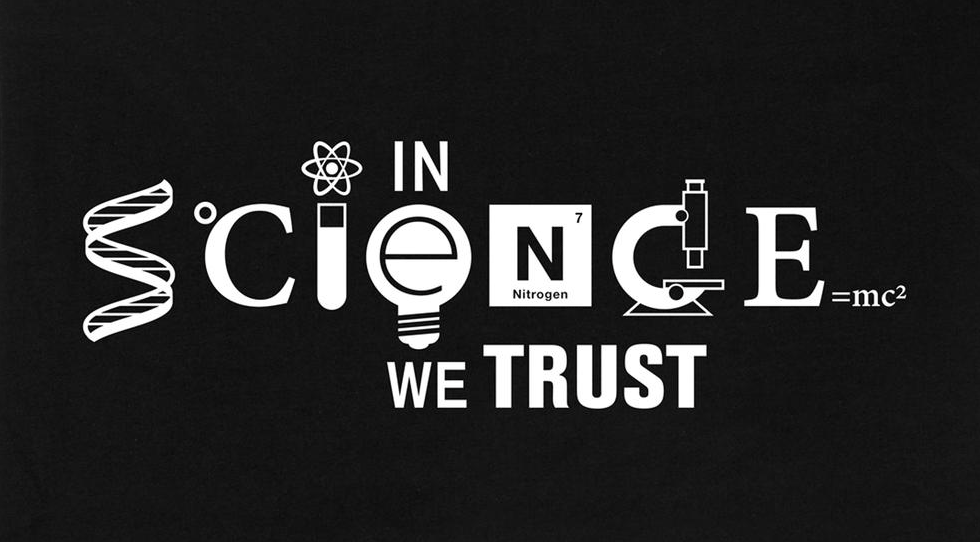- بندر الأسمري
- تحرير: عبد الرحمن الميمان
“ولكنه مُثبَت علميًّا!” إحدى العبارات التي تنهال على مسامعنا متكررةً تَكرارًا تسمج منه الآذان.
ما العلم؟ ما طرائقه؟ ما مدى صدقه؟ كيف وصل إلى ما وصل إليه؟ أسئلة كثيرة تُراوِد يقظتنا وأحلامنا تنتقل مع بعضنا إلى حُجَج واستدلالات من دون أن نفهم ما كُنْهُها وما جوهرها.
هل العلم قطعي؟ هل العلمُ علومٌ متعددة؟ هل هو جُزُر متناثرة ضمَّها حدٌّ واحد؟ أهو قطع مكرونة يجمعها جامعٌ شامل، أم كعكةٌ تفرَّق شَمْلُها بمُدْية التخصص؟ أسئلة مُلِحة راوَدَني حلمُ تبسيطها ومحاولة الاقتراب منها مع وُعُورة مسالكها، داعيًا مَن عَزَّ شأنُه أن يهديني طريق الصواب.
اختلف المؤرخون في اختيار نقطةِ بدايةٍ معتبَرة لِمَا بات يُعرَف بالعلم، وسلكوا في ذلك مسالك شتى. منهم ج.ج. كراوثر الذاهِب إلى أنَّ العلم أقدم عهدًا في الوجود مِن الإنسان؛ لأنَّه يَعتبِر الإنسانَ كائنًا لاحقًا عن كائنٍ بشريٍّ سابقٍ عنه، ظهر هذا الإنسان مع ظهور إنسان نياندرتال. “هذه الكائنات دون البشرية اتخذت من الحجارة مادةً تصنع منها أدواتها…فاستخدموا حجر الصوان لقدح الشرر وتوليد النار…فاكتسب بذلك المبادئ الأولى لعلم التعدين “[1]. أما مع المدرسة البنائية الوظيفية في علم الإنثروبولوجيا ورائدها مالينوفسكي فلهم نظرةٌ مختلفة تتَّسم بنوع ٍمن الاعتدال نحو بدايات تاريخ العلم. فأيُّ ظاهرة اجتماعية –ومثالها هنا ظاهرة العلم– لا نستطيع فَهْمها تمامَ الفهم إلا بالتركيز والكشف عن العلاقات القائمة بينها وبين بقية الظواهر الاجتماعية الأخرى، “مالينوفسكي قدم مفهوم الوظيفة كأداة منهجية ليتمكن الباحث من وصف الثقافة البدائية، فمفهوم الوظيفة يعني الدور أو الإسهام الذي يقوم به كل نظام اجتماعي في حياة المجتمع ككل”[2]. فالعلم لا يُتعامَل معه على أنه ظاهرة منعزلة، بل له مسالك مرتبطة بالسِّحْر والدِّين، “ويُسهِب مالينوفسكي في إيضاح كيف أن هذه الدوائر الثلاث، السحر والعلم والدين، متمايزة تمامًا في العقلية البدائية، وغير صحيح أن دائرة السحر تبتلع دائرة العلم، أو أن دائرة الدِّين تنفيها، فلولا المساحة التي تنفرد بها أصول التفكير العلمي من ملاحظة للطبيعة واعتقاد راسخ بوجود النظام فيها لَمَا سارت عمليات الصيد والزرع وسائر الفنون والحرف والصنائع التي تقيم الحياة البدائية”[3]. فحسب الأصول الإنثروبولوجية للعلم وأصوله فإنَّ وجود العلم يتوافق مع وجود الإنسان وتاريخه. فالتاريخ من أقدم ما انشغل به العقل البشري في محاولاته الجادة للوعي بحاضره ومعرفة تنبؤاته المستقبلية في مجال محدد يبتغي من خلاله سَبْر أغوار قديمة ومجهولة له. لا رفاهيةً ولا استزادة معرفيةً وحسب، بل رغبةً في إرواءِ عطش الفطرة الإنسانية في معرفة كل مجهول ومخبوء. في ثقافتنا الإسلامية غنًى عن ورود موارد الاختلاف بين المدارس التاريخية وعلوم الآثار والحضارات القديمة في إجاباتها عن بدء العلم؛ فالعلم كما بيَّنه القرآن الكريم مِنَّة من الله على خلقه منذ مبدئهم مع خلق آدم عليه السلام، ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[4] ، فلا يُتصور كائن بشري غير مقترن بعلم.
ولكن السؤال هنا هو: ما مفهوم العلم؟ الاختلاف حول ما يُفهم من (مصطلح العلم) دخل من مدخل طبيعة تصوُّرنا للعلم، فمَن جعله ضيِّقًا حَرَجًا مقتصرًا على العلم التجريبي الحديث في مختبراته ومعامله قال إنَّ العلم لم يعرفه الإنسانُ إلا حديثًا، وأخلَّ بذلك بالمعنى الشامل الواسع للعلم عِوَض أنه أسقط الجهل على كل الحضارات السابقة لنا، كما أن فيه ادعاءً بأن كل معرفة خارج العلم الطبيعي التجريبي لا تُعتبر علمًا.
يبدو العلمُ في الحضارة الإسلامية مختلفًا عن مفهومه عند غيرنا من الأمم، أو على الأقل عن مفهومه الحديث في الحضارة الغربية؛ لأنَّ الحضارة الغربية أبدَتْ –وعن جدارة– تقدُّمًا هائلًا في مجال العلوم البحتة التطبيقية، مما جعل لها الريادة في إطلاق معنى ما تريد على ما تريد، وباقي البشر تبعٌ لها. ولكن ليس الأمر بهذه البساطة؛ فلفظة العلم مثلُها مثل غيرها من الألفاظ التي يطرأ عليها وعلى معانيها التغيير والتطوير والتبديل، “كلمة العلم التي كانت تعني في تراثنا الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل والذي شاع استعماله الآن في مقابلة ترجمة اللفظة الإنجليزية Science ومعناها العلم الْمُدرَك بالحس فقط دون غيره من وسائل الإدراك العقلية أو السمعية أو العرفانية”[5] ومنها أضحى مصطلح علمي (scientifique) “هو المنسوب إلى العلم، تقول المعرفة العلمية، والروح العلمية… ويطلق هذا الاصطلاح الأخير على العقل المنظم الواضح الذي لا يُسلِّم بصِدْق حُكْم إلا بعد تحقيقه والتدقيق فيه وإقامة البرهان عليه”[6]. ولك أن تقارن هذا التضييق الشديد في التعامل مع مفهوم العلم في الحضارة الغربية مع المنهج الشمولي الواسع عند تعامل الحضارة الإسلامية مع مصطلح العلم. فلو ذهبنا إلى تقسيم الإمام أبي حامد الغزالي للعلوم في كتابه (إحياء علوم الدين) نجد أن العلوم عنده تنقسم إلى قسمين كبيرين هما: العلوم الشرعية والعلوم غير الشرعية، ويعني رحمه الله بالعلوم الشرعية ما يُستفاد من الأنبياء ولا يُرشِدُ العقل إليه ولا التجرِبة ولا السماع، أما العلوم غير الشرعية فعلى ثلاثة أصناف، علمٍ محمود وثانٍ مذموم وآخر مباح، فما من العلوم ترتبط به مصالح الدنيا كالطب والحساب فهو محمود، وهو بدَورِه على صنفين أيضًا، فمنه ما هو فرض كفاية وما هو أقل مِن أن يصل على مرتبة الفرض ولكنه فضيلة. ففرض الكفاية هو كل علم لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب والحجامة والفلاحة والسياسة والحياكة وغيرها من العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها اختلَّ هذا البلد، وإذا قام بها واحدٌ كفى -ولا يمنع هذا أن يكون هذا الواحد فردًا واحدًا أو مؤسسة واحدة- وأما ما يُعد فضيلة؛ فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب أو ما يُسمى الآن بالتخصص الدقيق في علم واحد. وأما المذمومة فهي علوم السحر والطِّلِّسْمَات، وأما المباح فعلوم الأدب والأشعار والتاريخ وما يجري مجراه[7].
وكذلك ابن سينا له قِسمةٌ للعلوم قريبة من هذه، فهي عنده إما نظرية أو عملية وكل منهما على ثلاثة أقسام؛ فالعلوم النظرية هي العلم الرياضي والعلم الطبيعي والعلم الإلهي، أما العلوم العملية فهي علم الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم تدبير المدينة (السياسة)[8]. أُشير هنا إلى لفتة جميلة أشار إليها الدكتور محمد السيد الجَلَيَنْد في كتابه (تأملات حول منهج القرآن)، هي أنَّ لفظ العلم بمعناه المطلق تختصُّ به الذات الإلهية، فقد جاء مضافًا إلى الله تعالى في جميع موارده في القران الكريم، ولم يأتِ مضافًا إلى الإنسان إلا مقيَّدًا بأنه قليل ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾[9]وأحيانًا مضافًا إلى الإنسان ومقيدًا من الله ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾[10] وأحيانًا جاء مقيَّدًا بأنه يتعلق بظواهر الأشياء ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾[11]، أما لفظ المعرفة فقد ورد ذكره في القرآن مضافًا إلى الإنسان من جميع الوجوه، وفي إضافته إلى الإنسان جاء في جميع الآيات مقرونًا بعلاقته وموضوعه الحسي. يسند هذا قول الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[12] “وعدل عن أن يقال (يعلمونه) إلى (يعرفونه)؛ لأنَّ المعرفة تتعلق غالبًا بالذوات والأمور المحسوسة”[13] وعلى هذا، فلفظ (المعرفة) يتعلق بالأمور المحسوسة، أما لفظ (العلم) فيتجاوز هذه الظواهر إلى بواطن الأشياء.
أما في هذه المقالة الوجيزة فمرادي من كلمة العلم: المعرفةُ الطبيعية التطبيقية البحتة، أي العلوم التي اهتمت بدراسة ظواهر الكون الطبيعة المادية غير البشرية. وبما أنه شاع وانتشر معرفتها بالعلم، فسأسير على ما شاع مع استبطان الفرق. وللدكتور عبد الله بن سعيد الشهري تعريفٌ شامل للعلم الطبيعي أوَرَدَه في (محاضراته عن فلسفة العلوم) يقول فيه: إن العلم –أي العلم الطبيعي– نشاطٌ نظري عملي منهجي للكشف عن خواص وعلاقات العالم المادي القريب واستغلالها عند القدرة. بمعنى أن هناك مفاهيم وتطبيقات تسير وفق منهج واضح محدد ليكشف لا عن الخواص الأشياء وحسب، بل وعن العلاقات الرابطة بينها في الكون المشهود الملاحظ مع استغلال تلك العلاقات والخواص وتوظيفها في خدمة الإنسان عبر المنتجات التقنية والصناعية والمعلوماتية والعسكرية والحياتية وغيرها.
هذا العلم بدأ منذ خُلق أبونا آدم عليه السلام ثم نما وترعرع وتطوَّر كلما وقفت مشكلات الطبيعة حاجزًا بين الإنسان وطريقة عَيشه. فالعلم منذ أول خطواته لم ينفكَّ متفاعِلًا مع تحديات وجود الإنسان، تحدٍّ يُولِّد حاجة إنسانية في التغلب عليه، يتولد منها كشفٌ لظاهرة يعقُبُها استغلالٌ لها في الواقع العملي تُسهِّل ذلك التحدي، وهذا الاستغلال يولِّد بدوره تحدِّيًا آخر يرغب الإنسان في التغلب عليه وهكذا يستمر العلم متفاعلًا من الواقع، فجهود العلماء تتركز على حل المشاكل والعكوف على تحسين هذه الحلول، وهذا قانون طبيعي تجده واضحًا بيِّنًا في العصور السحيقة من تاريخ البشرية كما تراه في أيامنا هذه. الإنسان ما يزال مريدًا للعيش مع تخفيف العبء، لك أن تتخيل حياة الإنسان الأول، حياة أولئك البشر في أول سُلَّم الخليقة[14]، لا أعلم كيف اكتشفوا أن الدفء يُستمَدُّ من النار مع أنها تثير الرعب والفزع عند أول تعامل معها، ولا كيف اكتشفوا العلاقة بين النار وعملية الطهي وهل هي أسبق أم صناعة الأواني الفخارية بواسطة النار -ربما لأننا البشر نمتلك جهاز كشف الفاعلية فائق الحساسية المزروع في طبيعتنا الفطرية[15]– ولكنهم حتمًا احتاجوا إلى الحطب، هذه معضلة. المهم أنهم بطريقة علمية ما ابتكروا أداة قطع الخشب سَهُلت معها حياتهم ولكنها وقفت عاجزة أمام تقطيع الصخور، ابتكروا أداة أخرى، في البدء ربما كان أداة فاشلة عن القطع، مع التجرِبة علموا أنه كلما كانت الأداة حادةً قطعتْ بشكل أفضل، وهكذا في علاقة تفاعلية بين وجود الظاهرة والعلم بها وفهمها ثم حلِّها واستغلال الحل استغلالًا عمليًّا تسير عجلة العلم اقترانًا مع عجلة الحياة. “لقد ظهرت التكنولوجيا وظهر العلم أول ما ظَهَرَا متمثِّلين في الأسلوب الذي كان الإنسان يستخلص به المواد ويشكِّلها لكي يستخدمها كأدوات تخدم مطالِبَه الأولية. فالتقنية أو الإنجاز الفني هو أسلوب يكتسبه الفرد ويتبناه المجتمع لإنجاز شيء ما، والعلم هو أسلوب لفهم كيف ينجز شيء ما بهدف تحسين هذا الإنجاز”[16] القصة نفسها تتكرر في العصر الحديث، اكتُشفت أشعة ألفا الموجبة وفسرت ظاهرة ما، ثم استُغلت هي في كشف معضلة بنية الذرة ليظهر لنا الإلكترون والنيترون، هذا النيترون الذي من دونه لَمَا أمكننا توليد الطاقة النووية. لن أتجاوز الحقيقة إن قلت إنك تستطيع إيجاد خطٍّ تاريخي متصل يصل آخر ابتكار بشري بأول ابتكار وجدناه، “إن سمة العلم هي طبيعته التراكمية”[17] من دون أن نغفل أنَّ كثيرًا من الأشياء التي أرشدنا إليها أجدادنا الأوائل لم تتبدل حتى الآن، منها شكل الإناء الحافظ للسوائل، والأطباق المستخدمة عند الأكل، وأقمشة الملابس، الكرسي والمنضدة، حتى على المستوى الاجتماعي، فالقضاء والملوك والجنود والخدم والتجار هم عندنا كما كانوا عندهم، كل هذا يجعلنا نؤمن أن الحضارات القديمة قد نجحت في ابتكار وإنجاز التقدم في التقنيات والأفكار إلى حد لم نستطع نحن المتأخرين أن نتجاوزها إلا شكليًّا وحسب، فكما كان الإناء من جلد وهو ربما أفضل، أصبح الآن من زجاج، أما الإناء فهو نفسه. “نحن نعرف تمام المعرفة أن كل ما نتمتع به الآن من معرفة إنما جاءت هدية من شعوب كثيرة”[18]، وهنا قد يثور سؤال: لماذا لا نعرف علمًا أو فكرًا أقدم من علماء ومفكري اليونان؟ هل هذا يعني أن اليونان وحتى 700 ق.م هم أصحاب الفضل في الاكتشاف والابتكار؟ أُنكر تمامًا ما أطلق عليه بعض العلماء بالمعجزة اليونانية، ويعنون بها أن اليونانيَّ –وبمعجزةٍ ما– استطاع التفكير والاختراع والاكتشاف والتنظيم والتنظير وسلك طُرق العلم بما يملكه من قدرات ذهنية لم توجد عند غيره، هذه فكرة ساذجة لا تتفق والتاريخ، فكلُّ ما يقال إن كثيرًا من الأفكار قد نُسبت إلى فلاسفة اليونان لأنهم كانوا أول مَن نعرفهم ووصلت إلينا مؤلفاتهم وكتبهم، فلو أنَّ الحملة الفرنسية ضد مصر سنة 1798 لم تكن فرنسية وكانت هندية مثلًا، لرأيتنا الآن نتغنى ونشيد ونقدس من دور الفلسفة الهندية وعلمائها ومؤلفاتها.
العلم التجريبي في الحضارة الغربية المعاصرة قُسِّم عند جون ديزموند برنال إلى أربع مراحل أساسية:
المرحلة الأولى: ومركزها روما حيث تحددت الميكانيكا وعلم التشريح والفلك بفضل ليوناردو وفاسالياس وكوبرنيكوس.
المرحلة الثانية: ومركزها فرنسا وبريطانيا بدءًا بفرانسيس بيكون وغاليلليو وديكارت وحتى وفاة إسحاق نيوتن، وهي المرحلة التي فجرت نموذج ميكانيكا العالم.
المرحلة الثالثة: المرحلة الصناعية التي فتحت للعالم آفاقًا للخبرة، وعندها أصبح العالَم قادرًا أن يطوِّر الإنتاج والمواصلات باستخدام الطاقة.
المرحلة الرابعة: هي مرحلة الثورة العلمية التي نعيشها الآن[19].
لا أُخالِف أنَّ العلم الحديث قدَّم خدمات جليلة للبشرية سهَّل لهم حياتهم وأمور عيشهم ومكَّنهم من إرواء غليلهم في اكتشاف الكون والطبيعة واستخراج مكنوناتها المودَعَة فيها واستغلالها لِمَا فيه الارتقاء الحياتي والمعيشي، ولكنني أجادل في نقطتين في صورة مختصرة فما هنا إلا مقالة:
الأولى: ادعاء الحيادية والموضوعية في مناهج العلم.
الثانية: التطرف والغلو في تقدير قدرة العلم.
النقطة الأولى تبرُز عن توهُّم أن العلم الطبيعي له مجاله الخاص المنفصل عن باقي مجالات الحياة، ولكن في الواقع أن العلم يلتقي لقاءات حميمية مع السياسة والاقتصاد والدين والفكر، ومن هذه النقطة سأُفرع فرعين: الفرع الأول له ارتباط بالعلاقة اللاشعورية بين ما يؤمن به العقل وما ينتج عنه، فالعلم ما هو إلا نتاج من إنتاجات العقل البشري الذي ما ينفك مرتبطًا بالذات الإنسانية بما تحمله من معتقدات وآراء وتفسيرات ونظرات خاصة في رؤيتها للكون والطبيعة، فنحن لا نتعامل مع علم مجرد كاشفٍ لمظاهر الطبيعة بل نتعامل مع تفسيرات العالِم لذلك العلم الكاشف لمظاهر الطبيعة، بمعنى أن مشكلتنا ليست مع القانون العلمي بل مع تفسيرات ذلك القانون العلمي. تجربة واحدة لها قانونها ونتائجها المتكررة ولكن تفسيرها مختلف، مثال واحد رغبة في الاختصار: طبقات الأرض متحركة في المكان خلال أزمنة سحيقة متطاولة، ثبتت هذه الحركة ودُرست ووضعت لها القوانين الرياضية الحسابية، ولكن ما التفسير لظاهرةِ حركة الأرض أو هذه الزحزحة القارية؟ أو ما الإجابة عن سؤال: لماذا تتحرك طبقات الأرض؟ مدارس شتى ذهبت شرقًا وغربًا في محاولاتها التفسيرية، فمثلًا هناك مَن قال إن اليابسة تعوم فوق مادة سائلة كثافتها عالية وبيَّن أن تفاعلات الانحلال الإشعاعي صعِدت من شدة قوة تيارات الحمل نتيجة الحرارة المتولدة في باطن الأرض والتي كانت سببًا في تكسُّر القارة الأم وانفصالها إلى قارات تتباعد. فكلا التفسيرين نابعٌ –ولو من دون قصد– من مفاهيم مسبقة في العقل لا علاقة لها بالتجربة، تعلم هذا إن علمت أن صاحب تفسير الانحلال الإشعاعي السابق هو آرثر هولمز المهتم بدراسة الانحلال الإشعاعي قبل أن يهتم بدارسة جيولوجيا الأرض، لا أعني أن نتيجته خاطئة، بل كانت صحيحة، أقصد أن المعرفة الموجودة في العقل والسابقة عن التجربة لها تأثيرٌ فعَّال في تفسير تلك التجربة. قِسْ على هذا أغلب الاكتشافات العلمية، ولا أظنُّ مهتمًّا بالعلم يجهل أنَّ الجاذبية أمرٌ ملاحظ وملموس ومشاهد، ورغم هذا فهناك تفسير أرسطو وتفسير إسحاق نيوتن وتفسير ألبرت آينشتاين المفترقة تمامًا عن الظاهرة نفسها، “الصعوبة الكبرى في الاكتشافات لا تتمثل في إجراء ما يلزم من ملاحظات، ولكنها تتمثل في التحرر من الأفكار التقليدية عند تفسير هذه الملاحظات، فمنذ زمن كوبر نيكوس عندما أرسى حقيقة تحرك الأرض، وهارفي عن دورة الدم، إلى زمن آينشتاين عندما ألغى فكرة الأثير وبلانك عندما ساق نظرة الكم، كان الصراع للتغلغل في أسرار الطبيعة أخفَّ من الصراع للتحرر من الأفكار الراسخة”[20]
الفرع الثاني: ما له ارتباط بالعلاقة الشعورية بين الذات والعقل، أعني تلك التدخلات المتعمدة من علماء ادَّعوا الحياد العلمي مع نتائج تجاربهم ورفضهم القيام بتحويرها بما يتفق مع رغباتهم الذاتية. منها تلك التجرِبة التي قام بها وليم سمرلين في سبعينات القرن العشرين حول تجارِب زرع الجلد في الفئران من خلال طريقة نستطيع بها تجاوز معارضة جهاز المناعة عن تقبُّل الجلد المزروع بين الفئران غير المتقاربة وراثيًّا. ادَّعى سمرلين أنه استخدم طريقة ناجحة في تطعيم جلدٍ مأخوذ من فئران ذات شعر أسود في فئران ذات شعر أبيض. فذاعت النتائج وانتشر الخبر، حتى اكتُشف بعد ذلك أن سمرلين استخدم قلمًا حادًّا لصبغ شعر الفئران البيضاء باللون الأسود حتى تظهر الفئران وكأنها متباعدة وراثيًّا واختلق نتائج ناجحة[21].
النقطة الثانية التي أُحاجِج فيها هي التطرف والغلو في تقدير قدرة العلم، والادعاء بأنه قادر على تفسير كل شيء داخل الكون وأنه هو المصدر الوحيد للوصول إلى المعرفة. بدأ هذا في العقل الغربي بصورة واضحة بعد أن وضع إسحاق نيوتن معادلاته الميكانيكية في تفسير حركة الكواكب والتنبؤ بها، وهي صحيحة في بنائها الرياضي؛ إذ أثمرت نتائج متطابقة بين الواقع والقانون الرياضي، وعلى إثر هذا اعتقد الإنسان اعتقادًا جازمًا أنه استطاع فكَّ لُغزِ الكون وفَهْمَ كل ما فيه، ولم يدرك المسكين أنه بالكاد خطا أول خطواته في طريق العلم الطويل، “وقد نجم انتشار الثقة بالعلم عن اعتقاد الناس بأن العلم هو الذي يكشف الغطاء عن الصورة الصحيحة للحقيقة، إذ إنه يرتكز إلى قواعد ثابتة تجعله بمنأى عن الخطأ”[22] ولكن العلم في تقدُّمه أبى إلا أن يُلبِس نفسه شيئًا من التواضع حين وقف على أمور عجز عنها وعن تفسيرها حتى ضمن حدوده التي احتدَّها لنفسه، “ولم يعد العلم بسيطًا، ولربما لم يَعُد يستند على المادة الميكانيكية، وقد كُشف النقاب عن كونٍ غامض، مقدَّرٍ لجزءٍ منه أن يبقى غامضًا، كما وقُذفنا بأُحجِيات لا يستطيع العلمُ حلَّ ألغازها داخل أعماق الحقيقة، وهكذا أصبح العلماء أكثر تواضعًا وأخذوا يتحدثون عن الكون الغامض”[23]. فمع أوائل القرن العشرين وولادة ميكانيكا الكم مع نيلز بور وهايزنبرغ وشرودنجر تعرضت يقينيات العلم الكلاسيكي الراسخة للتقويض الجذري ولم نصل إلى نهاية العقد الثالث من القرن العشرين إلا وسائر الفرضيات الرئيسة للتصور العلمي السابقة قد دُحضت، الذرات وحدات بنائية صلبة، المكان والزمان مُطلَقان مستقِلَّان عن بعضهما، وجود سببية ميكانيكية حتمية خلف الظواهر، المادة والطاقة شيئان مختلفان ومنفصلان، المكان ثلاثي الأبعاد، الزمان مفهوم ثابت يتدفق بثبات في كل أرجاء الكون، الكواكب تنجذب إلى بعضها بفعلِ قوى الجذب فيما بينها، كل هذا وغيره قُوِّض من أساسه مع تقدُّم العلم وأبان للإنسان أنه مجرد كائن مغرور مشاغب لم يرتشف من العلم إلا بمقدار قطرة ارتُشفت من بحر عظيم. “تمت إضافة عدم قابلية الفهم إلى عدم التجانس؛ لأنَّ التصورات المستمدة من الفيزياء الجديدة لم تكن صعبة الفهم بالنسبة إلى الشخص العادي وحده، بل وشكَّلت عقبات يتعذَّر تجاوُزُها ظاهريًّا بالنسبة إلى بداهة الإنسان عمومًا”[24]. يبدو أن العلماء أعرضوا عن نزعتهم العلموية وبات فقط صغار المتطفلين متعلقين بتلابيبها. فهل آن لنا أن نضع العلم التجريبي الطبيعي في مكانته التي هو يسعى لها، ونعلم أنه لم ولن يصل إلى حَدِّ الجزم القطعي وإنما هو ظنٌّ في أفضل حالاته، وهذا ليس عيبًا بل ميزة، فلو كان قطعيًّا لوقف عند أول عتبة تخطاها في مسيرته التاريخية ولَمَا سعى العلماء إلى مزيد من الكشف والبحث.
اقرأ ايضاً: العلموية ونُقّادها
[1] ج.ج. كراوثر، قصة العلم، ترجمة: يمنى طريق الخولي، المجلس الأعلى للثقافة، 1998، صفحة 17
[2] حسين فهيم، قصة الإنثروبولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، 1986، صفحة 167
[3] يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة، 2000، صفحة 32
[4] البقرة، 31
[5] علي جمعة محمد، المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة 1، صفحة 7
[6] جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، الجزء الثاني، 1982، صفحة 102
[7] راجع، أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المنهاج، 2011، الطبعة الأولى، صفحة 62
[8] جميل صليبا، المعجم الفلسفي، صفحة 100
[9] الإسراء، 85
[10] النساء، 113
[11] الروم، 7
[12] البقرة، 146
[13] الطاهر ابن عاشور، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، الجزء الثاني، الكتاب الأول، 1984، صفحة 40
[14] سيبقى خيالك قاصرًا عن إدراك الحقيقة؛ لأنك لن تستطيع الانفكاك عن مقارنة ما تتخيله بما تعيشه واقعًا الآن.
[15] يُعبر به لوصف القدرة البشرية الفطرية لتحسس المخاطر، فلو أنك في غابة موحشة وسمعت خشخشة بين الأشجار فستتوقع خطرًا سيهجم عليك ولو لم تره أو تدرك حقيقته. للاستزادة: جستون باريت، فطرية الإيمان، مركز دلائل، الطبعة الأولى، 1438، صفحة 254
[16] ج. د. برنال، العلم في التاريخ، ترجمة علي علي ناصف، الجزء الأول المؤسسة العربية للدراسات والنشر، صفحة 53
[17] ج. د. برنال، العلم في التاريخ، الجزء الأول، صفحة 48
[18] جورج سارتون، تاريخ العلم، الجزء الأول، دار المعارف، صفحة 45
[19] العلم في التاريخ، ج. د. برنال، الجزء الأول، صفحة 8
[20] ج. د. برنال، العلم في التاريخ، الجزء الأول، صفحة 58
[21] للاستزادة حول تفاصيل هذه القصة وغيرها مما يدور في فلكها، راجع: ديفيد ب. رزنيك، أخلاقيات العلم، سلسلة عالم المعرفة، 2005، صفحة 114
[22] رونالد سترومبرج، تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، ترجمة أحمد الشيباني، دار القارئ العرب، الطبعة الثالثة، 1994، صفحة 509
[23] السابق، صفحة 514
[24] ريتشارد تارناس، آلام العقل الغربي، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 2010، صفحة 426