- بهيجة الماضي
تعود جذور كلمة هيرمنيوطيقا (herméneutique) إلى الكلمة اليونانية “هرمس” التي تعني المفسر أو الشارح، وفي الأسطورة اليونانية كان هرمس رسول الآلهة قادرا بنعله ذي الأجنحة، على تجسير الفجوة بين الإلهي والعالم البشري ويصوغ بكلمات مفهومة ذلك الغموض القابع وراء القدرة البشرية على التعبير.[1] ومن ثم يمكن القول إن الهيرمينوطيقا هي محاولة فهم ماهو غير قابل للإدراك. ومصطلح الهيرمينوطيقا مشتق من (hermé) وتعني القول والتعبير والتأويل والتفسير، وكلها اتجاهات متقاربة من حيث الاتجاه نحو الإيضاح والكشف والبيان.[2] وبهذا تعني الكلمة في الأصل فن أو علم التأويل. وإذا كانت الهيرمينوطيقا قد انبثقت من التفكير في فن تأويل النصوص، فإنها قد تحولت بفضل دلتاي ونيتشه وهيدجر إلى فلسفة تأويل كونية. وقد عرف تطورها امتدادا واسعا ظهرت أهم نتائجه ومعالم تأثيره في فكر جورج غادامير، وبلغ ذروته مع بول ريكور. فما الجديد الذي أضافه بول ريكور إلى نظرية التأويل؟
1-إضاءة تاريخية:
يعتبر بول ريكور من أهم وأعمق فلاسفة الـتأويل في القرن العشرين، حتى لقب بفيلسوف التخوم
(un philosophie des frontières)، لكون نظريته التأويلية تنهل من مختلف الاختصاصات: فلسفة الوجود التي كان قريبا منها بحكم معاصرته لأصحابها، ونظرية المعرفة التاريخية، وتأويل التوراة بحكم نشأته في بيئة متدينة، و نظرية التحليل النفسي، والنظرية اللسانية، ونظرية الفعل، والظاهراتية، ونظرية السرد ونظرية الأخلاق. فهو في كل كتاب من كتبه يحاول المصالحة بين مقاربات مختلفة، ويعتبر كتابه ” الزمن والسرد”، الوارد في ثلاثة أجزاء أخطر كتاب في القرن العشرين حسب وصف مترجمه. فقد جاء مشروع بول ريكور التأويلي في زمن تعددت فيه المدارس التأويلية، وكثر الحديث عنها بشكل غير مسبوق في تاريخ الغرب، حتى صار البعض يتحدث عن فوضى التأويل نظرا لتحول التأويل إلى عملية ذاتية لا تخضع لأية معايير موضوعية، خصوصا بعد الانحراف الذي أصاب الهيرمينوطيقا على يد كل من هيدجر وغادمير، حيث نقلاها من مقاصدها الأساسية وهي تفسير النصوص إلى أسئلة الفلسفة والوجود واللغة. لهذا لا يمكن الحديث عن تأويلية بول ريكور دون التوقف عند هيدجر، نظرا لارتباط المشروعين بعلاقة نقدية لاتخول فهم الأول إلا من خلال الثاني؛ إذ يعتبر هيدجر أول من نقل الهيرمينوطيقا من مجال اللاهوت إلى مجال الأدب والفلسفة. فلم يعد السؤال مع هيدجر كيف نفهم النصوص؟ وإنما تحول إلى سؤال الكينونة في حد ذاته، وهو مايعبر عنه بمفهوم “الدازاين” (Dasein)، أي البحث في الأساس الأنطولوجي للهيرمينوطيقا وجذورها العميقة. فتحولت معه الهيرمينوطيقا إلى عملية تأملية بدل أن تكون تفسيرية، فاحتلت اللغة مع هيدجر مكانة جوهرية أكثر من النص نفسه. وهو الذي سيعتبره بول ريكور بمثابة التحريف الذي أصاب الهيرمينوطيقا، ويجب تصويبه. حيث سيعيدها إلى التقليد السابق، وينقلها من الوجود واللغة إلى النص والتفسير” مرة أخرى. رغم أن بول ريكور لم يكن يجهل أن هيدجر قد أراد ان يتجاوز ديلتاي إلا أنه أراد ان يقاوم دفعه التأويلية باتجاه الأنطولوجيا.”[3] فقد حاول بول ريكور تطوير الفينومينولوجيا والتأويلية في حقل العلوم الاجتماعية بصفة عامة، والعلوم الانسانية بصفة خاصة. مما جعل منهجه متميزا يجمع المنهجين معا الفينومينولوجي والتأويلي. منخرطا ضمن فلسفة التنوير ومابعد التنوير، دون أن يفشل في تحقيق التوازن بين كل هذه الانتماءات. وهو مايعبر عنه كتابه” الأنا كآخر”. كما يعتبر ريكور أول من ربط بين التأويلية ونقد الأيديولوجيات بالتمييز بين نمطين من التأويلية: تأويلية الشك، وتأويلية الثقة، ساعيا إلى تأسيس هيرمينوطيقا الإيمان رغم كونه يرفض السماح للمعتقد الديني بتحريف مسار النص أثناء القراءة. معيدا الاعتبار للرموز الكبرى المنسية عبر التاريخ، إذ يسلم برمزية الشر؛ نظرا لعدم القدرة على إدراكه إلا من خلال التفسير والتأويل. فلأنا لا يعرف في نظره بالاستبطان، وإنما يفهم بتأويل الرموز الكبرى: كآدم وحواء…فهي النماذج التي تعطي مشكلة الشر معنى معينا. فما هي خصائص نظرية التأويل عند بول ريكور؟
2- نظرية التلقي والتأويل عند بول ريكور:
لقد حاول بول ريكور إيجاد نظرية أخرى في قراءة النص، نابعة من الجمالية لا من البلاغة. حيث يؤكد على أهمية استجابة القارئ في عملية القراءة، ليصبح فعل القراءة حلقة رابطة في سلسلة تاريخ جمالية التلقي. وهو التلقي الذي يؤسس في نظره لما يسمى بقصدية التاريخ؛ لأنه يضع في الحسبان أن معنى الوعي ومعنى تأويل التاريخ ممكن دائما. ونظرا لعمق وغنى فكر بول ريكور، يصعب تمثل نواة تصوره التأويلي بأكمله، لهذا سنكتفي بالاشتغال على نموذج من كتبه وهو:”نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى” حيث شكل هذا الكتاب مساهمة نوعية في مجال التأويلية، إذ يعيد الاعتبار للغة بوصفها خطابا وليس مجرد لسان كما ادعى دي سوسير. فماهي أسس نظريته التأويلية؟
1-1مشكلة الخطاب:
يرى بول ريكور أن مشكلة اللغة تمثلت عبر التاريخ من خلال النظر إليها كبنية ونسق، ولم يتم النظر إليها من جهة الاستعمال، لهذا لم يتم الانتباه للغة بوصفها خطابا. فكيف ينظر بول ريكور إلى اللغة بوصفها خطابا؟ وإلى أي حد يقبل الخطاب الفهم والتفسير؟
يدعو بول ريكور إلى التمييز بين علمي الدلالة والسيمياء، فالأول معني بمفهوم المعنى، في حين أن الثاني مجرد دراة صورية للعلامات. وهذا التمييز يشكل في نظره مفتاح مشكلة اللغة بأكملها. فكل خطاب يحضر فيه جدل الواقعة والمعنى، فتحقق الخطاب بوصفه واقعة يؤدي إلى فهم الخطاب بوصفه معنى، فالخطاب ليس مجرد واقعة كما يوحي التضاد بين اللغة والكلام، فالخطاب له بنية خاصة هي بنية التحليل التأليفي أي التفاعل بين وظيفتي التحديد والإسناد في الجملة الواحدة، وليس الخطاب بنية وحدات منفصلة ومعزولة عن بعضها. مما يفرض الجمع بين الحدث والبنية “فالكتابة هي التجلي الكامل للخطاب”.[4]
- جدل التفسير والفهم:
التفسير هو منهج يسمح باستخلاص العلاقات الثابتة بين الظواهر المدروسة مع إمكانية التنبؤ، وهو منهج العلوم الحقة. لكن بعد النجاح الباهر الذي حققه هذا المنهج في العلوم الحقة تساءل علماء الإنسان: لم لا يتم تبني هذا المنهج لمعالجة الظواهر الإنسانية، مادام قادرا على قيادة العقل إلى نتائج موضوعية؟ فكان الاتجاه الوضعي بريادة أوجست كونت وإميل دوركايم، من أشد المتحمسين لهذا المنهج. ولعل مفهوم الفيزياء الاجتماعية الذي نحته أوجست كونت أبلغ دليل على هذا الحماس. بيد أن حماسهم لم يدم طويلا بسبب الصعوبات التي بدأ يواجهها هذا المنهج في ميدان العلوم الإنسانية؛ نظرا لتفرد الظاهرة الإنسانية، وما تتميز به من تعقد يعود أساسا إلى حضور الوعي الذي وصفه كلود ليفي ستراوس بالعدو السري للعلوم الإنسانية “يبدو الوعي بمثابة عدو سري لعلوم الإنسان، سواء تعلق الأمر بالوعي التلقائي المحايث لموضوع الملاحظة، أو بالوعي التأملي- وعي الوعي- عند العالم”،[5] مما جعل دلتاي يطلق عليها اسم علوم الروح كدلالة لعدم قابليتها للتفسير بقدر ما تحتاج إلى الفهم ” نفسر الطبيعة ونفهم الحياة النفسية”.[6] ولم تكن تأويلية بول ريكور بمنأى عن هذا النقاش، حيث أقام علاقة جدلية بين المقاربتين التفهمية والتفسيرية، محاولا من خلال ذلك التأسيس النظري لعلاقة الفلسفة باللاهوت والعلم، دون تجاوز الحدود الفاصلة بينهما، فكيف ذلك؟
ينطلق بول ريكور من الإقرار بأن الطبيعة هي المجال المناسب لتطبيق منهج التفسير، في حين أن منهج الفهم يجد مجاله الأصيل في علوم الإنسان. لكنه يقر رغم ذلك بالتداخل الحاصل بينهما، لكون الطبيعة هي الأفق المشترك للوقائع “المعادل المناسب للتفسير هو الطبيعة مفهومة على أنها الأفق المشترك للوقائع والقوانين والنظريات والفرضيات وعمليات التحقق والاستنتاجات”.[7] ويتخذ هذا التداخل صورة جدلية تعود أساسا إلى مشكلة التأويل كعملية معقدة تفترض الإثراء بكل المناهج المتاحة. فالفهم يتجه نحو الوحدة القصدية للخطاب، في حين يتجه التفسير نحو البنية التحليلية للنص، بحيث يصبحا قطبين متميزين في ثنائية متطورة. وهكذا يصبح التأويل هو جدل التفسير والفهم، وسيرورة معقدة تنطلق تدريجيا من الفهم إلى التفسير ومن التفسير إلى الاستيعاب، حيث يتم الانتقال تدريجيا من الفهم البسيط إلى الفهم المعقد، كمرحلة نهائية في عملية التأويل، يتم فيها امتلاك النص والكشف عن معنى المعنى. في هذه السيروة يحتل التفسير مكانة توسطية بين “الفهم والاستيعاب” من أجل تقديم عرض علمي لجدل التفسير والفهم، كمرحلتين من عملية فريدة، أقترح وصف الجدل أولا كنقلة من التفسير إلى الاستيعاب، في المرة الأولى، سيكون الفهم إمساكا ساذجا بمعنى النص ككل، وفي المرة الثانية سيكون الاستيعاب نمطا معقدا من الفهم تدعمه إجراءات تفسيرية يعدو معها الفهم في البداية كمجرد تخمين، وفي النهاية يرضي الفهم مفهوم التملك. ويغدو التفسير بوصفه وساطة بين مرحلتين من الفهم، فإذا عزل عن هذه العملية العينية فسيكون مجرد صنيع للمنهجية”.[8] فلماذا يتخذ التأويل في نظره هذه السيرورة المعقدة؟
- مشكلة المعنى:
إن أزمة التأويل في نظر بول ريكور تعود أساسا إلى مشكلة المعنى، وترتد هذه المشكلة الى الفرق بين الكلام والكتابة، بين الواقعة والمعنى. فكل خطاب ينتج بوصفه واقعة لكنه يفهم بوصفه معنى. وتزداد المشكلة تعقيدا في الأعمال الأدبية التي تتميز بفائض المعنى، وهنا يبدأ جدل التفسير والفهم، حيث يتحول التفسير إلى عملية مستقلة من خلال تخارج الواقعة والمعنى. وهو جدل تفرضه طبيعة النص ذاته، فالنص أخرس لا صوت له، لكون صاحبه لم يعد حاضرا، ومن هنا تنشأ العلاقة غير المتكافئة بين القارئ والنص. فكل منهما يتحدث على لسانه، وقد لا يتوافق المعنى اللفظي للنص، مع المعنى العقلي أو قصد النص نفسه. وهنا يشبه بول ريكور النص بالقطعة الموسيقية، فالقارئ أشبه بعازف الأوركسترا الذي يطلع تعليمات التنغيم. وبهذا لا يعود الفهم مجرد تكرار لواقعة كلامية في واقعة شبيهة، بل توليد واقعة جديدة تبدأ من النص[9]. هذا الصمت الذي يتميز به النص يفرض على القارئ ثلاث عمليات أساسية كنقطة انطلاق لا مفر منها في عملية التأويل وهي:
- التخمين:
يعتبر التخمين في نظر بول ريكور الفعل الأول من أفعال الفهم، مادام النص صامتا وقصد المؤلف بعيدا عن متناولنا، بخلاف الأمر في الخطاب الشفوي الذي يتيح لك إمكانية استنطاق صاحبه. لهذا فإن الامكان الوحيد الذي يتيحه لنا النص هو التخمين. لكن ألا يقود التخمين إلى الفهم الخاطئ للنص؟ لايرى بول ريكور في الأمر حرجا، فسوء الفهم ممكن بل لا يمكن تحاشيه ولو بالعودة إلى موقف المؤلف، أو حياته الشخصية، أو تجربته النفسية كما يدعي أصحاب التأويلية الرومانسية. فلا يجب ان نتحرج من التخمين مادام أن ترجمة المعنى إلى معنى لفظي للنص ليس سوى التخمين بعينه. فالسؤال الذي ينبغي التوجه إليه هو ما الذي يجب تخمينه وليس لماذا التخمين؟ يجب أن يتجه التخمين في نظر بول ريكور إلى العناصر التالية:
- تخمين النص في بعده الواحدي أي بصفته كلا منفردا.
- تخمين المعاني الاستعارية والرمزية.
- تخمين علاقة الكل بالأجزاء في إطار التعدد النصي الذي يسم الخطاب.
ويؤكد بول ريكور أن نجاح القارئ في هذه التخمينات الثلاثة يقودنا في النهاية إلى التصديق.
ب- التصديق:
هو المرحلة التي نصل إليها بعد التخمين، وهي لا تعني الدوغمائية المطلقة، بقدر ما هي حركة بين حدي الدوغمائية والشكية، بحيث يمكن الوقوف مع أوضد تأويل معين، ويرى ريكور أن التخمين إن كان يفتقد للقواعد، فالتصديق ليس كذلك ” إذا كنا نفتقر إلى وجود قواعد للقيام بتخمينات صحيحة فان هناك مناهج للتصديق على تلك التخمينات التي نقوم بها وكلا الطرفين مطلوب في هذا الجدل”.[10]
ج- الاستيعاب:
هو المرحلة المتأخرة والنهائية في عملية التأويل، وهو فعل يتعالى على وظيفة الإحالة الظاهرية المرتبطة باللغة المنطوقة، إلى كونه كشفا وخلقا لنمط جديد من الوجود، وهكذا يصل فعل القراءة إلى الأعماق من خلال تملك معنى النص في سيولته المتحركة. وهذا التملك هو غاية التأويل عند بول ريكور حتى أنه يرد التأويل في النهاية إلى مجرد عنصر من عناصر الفهم والاستيعاب ” يمكن توقع أن يظهر التأويل بوصفه مجرد مقاطعة ملحقة بامبراطورية الاستيعاب والفهم”.[11]
وهكذا يظل الجدل بين الواقعة والمعنى، جوهر بنية الخطاب، والجدل بين الفهم والاستيعاب متلازما في فعل القراءة، لأن فعل القراءة ما هو إلا نظير لفعل الكتابة نفسه، والتفسير هو الفعل الذي يتوسط مرحلتين من الفهم تكون فيهما الثانية أكثر تعقيدا من الأولى. ولا يمكن للفهم أن يتم إلا بالإشتراك في عالم المعنى نفسه وصولا إلى معنى المعنى.
وختاما يمكن القول أن التأويل عند بول ريكور سيرورة معقدة تنطلق من الفهم إلى الاستيعاب توسطا بالتفسير، وصولا إلى التملك، تملك معنى النص في سيولته المتحركة بوصفه اتجاه الفكر الذي يفتتحه النص.
إن ما يميز تأويلية بول ريكور هي توسيعه لمفهوم النص، بحيث لم يعد يشمل النص المكتوب فقط، بل امتد ليشمل كل الفعل الانساني والتاريخ الفردي والجماعي. لقد حول الرموز من حقائق زائفة مع ماركس ونيتشه إلى نافذة نطل منها على عالم المعنى. كما يؤكد ريكور على التداخل بين الأخلاق والتأويل، فالتأويلية دون أخلاق تبقى فارغة، لكن الأخلاق بدون تأويلية تظل أخلاقا عمياء أيضا. ويمكن تلخيص مشروعه التأويلي في مفهومي المعنى والوجود؛ فإذا كان هيدجر قد جعل الوجود نقطة انطلاق، فإن بول ريكور جعله نقطة وصول. والسر هو اقتناع ريكور بأن الوجود الانساني له معنى، فما له معنى يفوق ما ليس له معنى رغم وجود الشر والألم. لكن رغم ذلك فقد وجهت لنظريته العديد من الانتقادات خاصة من طرف مدرسة التحليل النفسي والمدرسة الوضعية المعاصرة، يمكن إجمالها في ما يلي:
- إهمال المؤلف على حساب القارئ فهو لايهتم بتجربة المؤلف.
- إلغاء الجانب النفسي والتاريخي في فهم النصوص فهو يقصي مايقصده المؤلف ويهتم بالخطاب في صيغته الدلالية فقط باعتماد الرمز والاستعارة.
ورغم أن بول ريكور حاول إقامة نظرية موضوعية في التفسير والفهم، لتحويل التأويلية من فن إلى علم لإنقاذها من الفوضى، فإنه لم يفلح في ذلك؛ فرفضه الانغلاق على البنية، ودفاعه عن الانفتاح التأويلي وحرية التخمين، سيؤدي إلى عدد لا حصر له من الفهومات والتفسيرات للنصوص، وقد يكون هذا إيجابيا في مجال الإبداعات الأدبية، لكنه يصبح خطيرا في مجال النصوص الدينية. إذ لابد من التوافق على قواعد مشتركة حتى لا تضيع الحقيقة الدينية أمام الذاتية.
ويعتبر هذا الإشكال جوهر مشكلة الهيرمونيطيقا الغربية عموما، إذ إن غياب معايير موحدة لقراءة النص الديني، حول فعل القراءة إلى ميول ذاتية أكثر من اهتمامه بتحصيل حقيقة النص الديني. الهرمنيوطيقا المعاصرة تقوم على الجدل أكثر من قيامها على الاتفاق على الجواب الصحيح، حتى صارت على حد تعبير دايفيد جاسبر” تجعل الأشياء أكثر تعقيدا في حين يفترض بها ان تكون بسيطة ومباشرة.”[12] كما أن الهيرمونيطيقا المعاصرة صارت ترفض في كثير من الأحيان المعنى البسيط، رغم أنه يمثل الفهم المناسب وتسعى وراء معنى المعنى حتى وإن كان يغرق بها في متاهات الشك والحيرة. وربما يعود سبب هذه الحيرة والفوضى التأويلية إلى أمرين: طبيعة النص الديني المسيحي، حيث إن فعل كتابة النصوص الدينية، سواء المسيحية أو اليهودية تزامن مع فعل التفسير ذاته. فكان الكتاب من آباء الكنيسة يقحمون تأويالتهم مع الكتاب المقدس نفسه. ثم طبيعة النص نفسه الغير القابلة للاستجواب، بخلاف الخطاب الشفوي الذي يتيح إمكانية الطلب من المتحدث أن يعيد ما قاله بطريقة مختلفة، مما يجعل النص مفتوحا على إمكانات لا حدود لها من التأويلات. لكن هذا لا يعني أن النص الديني مستغن عن التأويل، فحاجة العقل المسلم اليوم إلى صياغة نظرية جديدة للتأويل يعادل حاجته إلى الحياة نفسها.
[1] – مقدمة في الهرمنيوطيقا , دايفيد جاسبر، ترجمة: وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم، بيروت – لبنان، ط1، 2007 ص 21.
[2] – Kelkel, (Arion Lothar), La légende de l’Être, langage et poésie chez Martin Heidegger (Libraries philosophique, Jean Vrin, Paris, 1980), p 186
[3] – جان غراندا، التأويلية، ترجمة جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى 2017 ص 85.
[4] – بول ريكور، نظرية التاويل: الخطاب وفائض المعنى، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي الطبعة الثانية 2006 ص 56.
[5] -Claude Lévi-strauss, Anthropologie structurale, plon , Paris. 1974 , pp:345.
[6] – فلهلم دلتاي، عالم الروح: ترجمة م.ريمي. أوبي. الجزء الأول، ص 149-150
[7]– نظرية التأويل مرجع سابق ص 119.
[8]– نفسه ص 122- 121.
[9]– المرجع نفسه ص 122.
[10]– المرجع نفسه ص 124.
[11] – نفسه ص.120
[12]– دايفيد جاسبر مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمة وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم ناشرون: الطبعة الاولى 2007 ص 40.


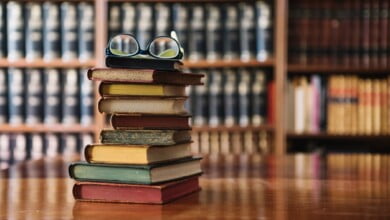


موضوع جد مهم يتميز بالراهنية والعمق، أتمنى للأستاذة بهيجة المزيد من التألق والتوفيق