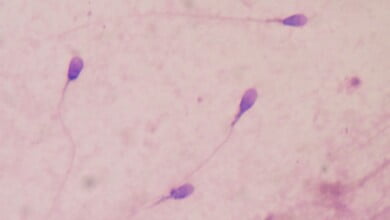- ويسي دو تويت
- ترجمة: رغد سالم
- تحرير: عبد الرحمن روح الأمين
يطمح العلم على نحوٍ تقليدي إلى أن يكون شاملًا وعالميًا من ناحيتين. الأولى: يسعى إلى تراكم المعرفة الأساسية، أي الحقائق الصحيحة عالميًا. ومن الناحية الأخرى: فهو يهدف إلى أن يكون مجردًا في الممارسة؛ أي يجب أن تكون الهوية غير مرتبطةٍ بالعملية التي يتمّ من خلالها الحكم على الادعاء العملي.
لكن منذ الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية، توقّف العديد عن الأخذ بهذه التطلّعات؛ ولكون الشمولية لا تجعل من العلم وسيلةً موثوقةً لفهم العالم فحسب؛ بل إنها تجعل المؤسّسات العلمية هي الملجأ الأول في الاستجابة لمختلف التحديات المروّعة والمعقّدة التي تواجه البشرية، وتشمل هذه التحديات اليوم الأضرار البيئيّة والأمراض المُعدية والتكنولوجيا الحيوية وانعدام الأمن الغذائي والطاقة. ومن المؤكّد أنه إذا تمكّن أي شخص من تجاوز تضارب الثقافة والمصالح – ربما أيضًا مساعدة الحكومات للقيام بالشيء ذاته- فسرعان ما سيُلحق بالأشخاص ذوي المعاطف البيضاء الذين يُضرب بهم المثل في إنقاذ البشرية.
ومع ذلك وجدنا مؤخّرًا أن مبدأ الشمولية والعالمية ذاته أصبح موضع شكٍّ. مسلّحين بأدوات النظرية النقدية؛ يُؤكّد علماء العلوم الاجتماعية والإنسانية أن العلم ليس سوى نظام معرفيّ من بين العديد من الأنظمة التي خرجت من السياق الغربي وتطوّرت فيه. ومن وجهة النظر هذه فإن العالمية التي تمكّن العلم من فرض كلمته على الشعوب والثقافات الأخرى هي في الحقيقة شكلٌ من أشكال الهيمنة الظالمة.
حتى الآن؛ وخاصة ما تمّت مناقشته في البيئة التعليميّة، كانت هناك دعوات لإنهاء استبداد المناهج العلمية ومعالجة الاختلافات السيموغرافية بين الطلاب على أسسٍ اجتماعيةٍ مغايرة؛ ولكن كيف سيُؤثّر ذلك على تلك المؤسّسات التي تسعى إلى تعزيز التعاون العلمي في قضايا السياسة الحرجة؟
اندلع جدال هذا العام في مجال علم البيئة تمحوَر حول هيئة تسمى IPBES (الفريق الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية). اعتقد أن بعض القرّاء سبق وسمعوا بهذه المنظمة، غير أن هذه المنظمة بحد ذاتها تعكس نموذجًا سيئًا في سبيل إنقاذ العالم؛ حيث يُعد المنبر الحكومي الدولي أقلّ الوسائل التي تجذب انتباه الحكومات إلى التدهور العالمي السريع للتنوّع البيولوجي ومجموعات الحيوانات والنباتات بشكل عام.
نشَر أعضاء بارزون في اللجنة مقالًا في مجلة Science في كانون الثاني معلنين عن “نقلة نوعية” من شأنها الإسهام في إتمام المهمة، مدّعين أن النموذج العلمي -أو العلمويّ– والذي تأسّس عليه المنبر الإعلامي- ينص على “ضرورة هيمنة المعرفة العلمية على العلوم الطبيعية والاقتصاد”، كما يميل إلى تبني “منظور التعميم والشمولية لـنموذج العلم الغربي”. وبناء على ذلك فهم يتجادلون عن عدم توفّر مساحة للعلوم الإنسانية والاجتماعية إضافةً إلى أنه لا يَعترف بمعرفةِ وقيمِ الشعوب المحلية والسكّان الأصليين.
جاء في المقالة التي أثارت جدلًا حادًّا داخل مجتمع البحث بعد عدة سنوات طوّرت فيها الأوراق والتقارير التي أصدرتها الهيئة “نهجا تعدّديا للاعتراف بتنوّع القيم”. وقد اعتمدت اللجنة الآن وبشكل رسمي نموذجًا جديدًا “يُقاوم الهدف العلمي المتمثّل في تحقيق مخطّط قابل للتطبيق عالميًّا” بينما يسعى لـ” التغلّب على عدم تناسق القوة الحالي بين العلوم الغربية والمعرفة المحلّية والمتعلّقة بالشعوب الأصلية وبين التخصّصات المختلفة في العلوم الغربية”.
العلم ومبدأ السياسة والسياسات
من السهل استبعاد مثل هذه المصطلحات باعتبارها “مجرّد حبر على ورق”، وهو ماقام به بعض النقّاد، فهم يزعمون أن “النقلة النوعية” تتطلب “تسوية سياسية، وليس تقديم مفهوم علمي جديد”.
بعبارةٍ أخرى، يُعتبر تصنيف النظرة الشمولية للعلم الغربي بادرةً دبلوماسية لتهدئة المشكّكين، فالانفتاح على “مجموعةٍ متنوعةٍ من القيم” لايُغيّر البيانات ذات الصلة؛ لأنه بغضّ النظر عن طريقة تشكيلها وصياغتها فالبيانات تظل بيانات في نهاية الأمر.
لكن هنا تكمن المشكلة، فعندما يتعلق الأمر بالمنظّمات التي يتمثّل دورها في إعلام السياسة؛ فإن هذه الفجوة الدقيقة بين العلم والسياسة تظلّ مضلّلة. وعادةً مايكون لدى العلماء أهدافهم السياسية الخاصة التي توُجّه نشاطَهم العلمي. وأما بالنسبة لمنابر النشر، فإن هذا الهدف ماهو إلا إقناع صنّاع السياسة بالحفاظ على العالم الطبيعي، ومن ثم فإن اللجنة لا تقوم فقط بجمع البيانات حول صحة النظم البيئيّة في حين أنها تجمع البيانات التي توضّح كيف يستفيد البشر من النظم البيئية الصحّية وذلك للتّأكيد على تكاليف إهمالها.
ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية تُجبر المنصّات على إصدار أحكام قيميّة لا تخضع مباشرة للأساليب العلمية. لتقييم فوائد الطبيعة؛ يجب على المرء ألّا يأخذ بعين الاعتبار الهواء النقي ومغذّيات التربة فقط، بل وأيضاً العوامل غير المادية كالإلهام الديني والهوية الثقافية التي تختلف النطاق الواسع في جميع انحاء العالم. هل يمكن حقًّا دمج كل هذه الأمور في نظامٍ شاملٍ وموضوعي وقياسها بمقاييسِ العلم؟
حاولت منصة IPBES القيامَ بذلك ولكن حتمًا كانت النتيجة إطارًا من المقاييس النفعية البحتة، فقد سعى إلى تصنيف وتقدير جميع مزايا الطبيعة (بما في ذلك الدينية والثقافية) وتحويلها الى قيمٍ نقديّة. وهذا في نهاية المطاف هو اللغة التي يفهمها صنّاع السياسة بشكلٍ أفضل. بناءً على ما أوضحته المقالة المنشورة في مجلة Science في أطروحتها الأساسية؛ فإن هذا النهج الاختزالي أدّى إلى نفور عددٍ كبيرٍ من العلماء بالإضافة إلى السكان المحليّين الذين تُعد مشاركتهم أمرًا ضروريًا لحماية البيئة.
كل هذا يُوضّح بعض المشكلات العامة المتعلقة بالشمولية كأساس للتعاون. فأولًا: عندما توجه مؤسسة معينة عملَها نحو تحقيق نتائجَ سياسيةٍ معيّنة، فإن ادعاءها الموضوعية يُصبح أكثرَ إثارةً للشك؛ ورغم أنها قد تستمر مع ذلك في إنتاج معرفة صحيحة عالميًا، لكن الأسئلة الأكثرَ إثارةً للجدل: ما هي المعرفة التي تسعى إليها المؤسسة بالفعل؟ وكيف تُترجم تلك المعرفة إلى أدواتٍ سياسية؟
تظهر هذه المشكلة حتى في الحالات التي يجب أن يكون هناك إجماعٌ علميٌ راسخ على ضروريتها وأهميتها، كتغيّر المناخ مثلًا، وارتفاع درجات الحرارة، ولكن ماهي العواقب التي يجب على العلماء التحقيقِ فيها لجذب انتباه صنّاع السياسة والناخبين؟ وماهي السياسيات الاقتصادية التي ينبغي عليهم الإقرار بها؟ والتي حتمًا ستكون هذه الأحكام تَتبع نظام سياسي وأيديولوجي.
علاوةً على ذلك، فإن بعض الموضوعات هي ببساطة مثيرةٌ للجدل الثقافي أكثر من غيرها من الموضوعات. هناك العديد من المجالات التي حتى وإن كان من الممكن تعميمُها؛ فسيُعتبر مع ذلك طريقةَ تفكيرٍ غريبة وغير مرحبٍ بها. وكما رأينا تُعدّ الطبيعة أحدُ هذه المجالات. كما يُعتبر تعديل الجينات مثالٌ آخرَ واضحٌ والذي قد سمحت به اليابان مؤخراً في الأجنّة البشرية. من المحتمل أن تتطلّب أيَّ محاولاتِ لتنظيم هذه التكنولوجيا نقاشاً حول الأعراف الدينية والثقافية بقدر ما تتطلّبه العلوم الصعبة.
حدود التعدّدية
ولكن السؤال هو: هل التعدّد الذي يُنادي به المنبر الحكومي يقدم حلولًا في إمكانها حلّ هذه المشكلات؟ أشك في ذلك. إن تأثير النظرية النقدية -تثبيت المعرفة كبديل للسلطة- هو في حد ذاته نقيضٌ للتعاون الذي من شأنه أن يَسفر عن الحلول؛ فبدلًا من مجرّد تحديد القيود العملية للنظرة العلمية للعالم؛ فإنه يضع العلم في منافسةٍ مَحصلتُها صفر مع وجهات نظرٍ أخرى.
تبدأ المشكلة بالانحدار من التعدّدية الثقافية إلى النسبية المعرفية. حيث تُعامَل أنظمة المعرفة في أدبيّات “التحوّل النموذجي” على أنها ذات “سياقٍ محدّد”، كل منها يحتوي على “معايير الصلاحية الخاصّة به”. وكنتيجةٍ لذلك، يتراجع احتمال الوصول إلى حلّ؛ لأن الأمر يخرج عن السيطرة، وتصبح الأولوية هي: “ربط نظم القيم المختلفة بشكل منصف والسماح في النهاية بعمليات التعلّم الجماعي”.
فكما حذّر النقّاد، هناك خطر من فقدان الوضوح والتركيز مما يُؤدّي ذلك إلى تأييد أقلَّ فاعلية. تَبرز في الوقت الحالي أوراقَ وتقاريرَ المنبر مع مناقشاتٍ واسعةِ النّطاق حول الخصوصية الثقافية، مما يُهدّد في بعض الأحيان بأن يُصبح ذلك مهمةً موازيةً تماماً. ومع ذلك عندما قدّمت اللجنة في عام ٢٠١٦ التقييم الأكثر شمولاً حتى الآن، بالكاد تضمَن ملخّصَ صنّاع السياسة أي معلوماتٍ حول التكاليف الاقتصادية للضرر البيئي.
بالرغم من الشكوك في الواقع المزعوم بأن هناك جو من الخيال يحيط بهذا الخطاب. حتى ولو كان هناك مجالاتٌ يكون فيها من غير اللائق فرض وجهة نظر علمية بحتة، فإنه من الخداع التظاهر بالرغم من وجود هدف معين في عين الاعتبار في حين أن جميع وجهات النظر مفيدة بالقدر ذاته. وبالمثل، لا يمكن لأي قدر من التشاور والنقاش أن ينفي حقيقة أنه مع محدودية الموارد فإنه يجب مقايضة القيم والمصالح المختلفة ضدّ بعضها البعض. عندئذٍ إذا تبرّأ العلماء من هذه المسؤولية فإنهم ببساطةٍ ينقلونها إلى صنّاع السياسة.
للشمولية حدود عملية خاصة بها: فهي لاتستطيع حل الاختلافات الثقافية أو إزالة الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية. ولكن بشرط فهم هذه القيود فإنها بالتأكيد تظلّ المبدأ الافتراضي الأكثر فائدةً للعمل التعاوني. ولأنه حتى المؤسسات المتنوعة تحتاج إلى أهداف مشتركة، فالتعامل مع القيم على أنها غير قابلة للقياس تماما هو دعوة للعجز وتسييس المعرفة ذاتها هو المخاطرة بتفكيك المشروع العلمي بالكامل.