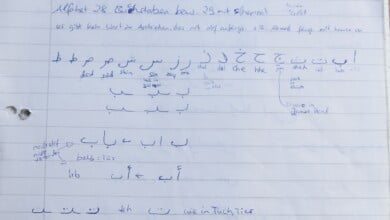- عبدالرحمن بن أحمد الخطيب*
- تحرير: عبد الله الفهد
في البداية كنت سأسمّي عنوان هذه المقالة بنظامي التفكير الروحي والعلمي، ثم ارتأيتُ أن أستقرّ على الديني والعلماني، مع اقتناعي بالتشابه المحدود بين المسمَّيين؛ حيث إنّ التفسير الروحي يتبنّى جزئيًا الجانب الديني، ولكنه قد يهمل العلمي، بعكس الديني حسب تصوري له الذي يضيف الجانب الروحي إلى العلمي ليكون متّسقًا مع كليّة الإنسان. وأيضًا لأنّه عندما نذكر الروحي يذهب المتأثرون بالفكر الغربي أو بعض الفلسفات الشرقية إلى أن الروحي هو ما يُهمِل الجوانب الجسدية، بعكس الديني في التصور الإسلامي الذي يتبنى الروحي والجسدي معًا. أما بالنسبة للجانب العلمي فهو حسب التصور الحديث مثل العلماني؛ فهو يُهمِل التفسير الديني واندماجه، ولكن هذا لا يعني أن كل علمي هو بالضرورة علماني، فإذا فسّر الدين شيئاً في الوجود وأثبتته الشواهد فهو يُعتبر نظرية علمية مثبتة حتى يثبت بطلانها، بعكس العلماني الذي يرى الوجود والعلم خارج التصورات الدينية. وأنا عندما أقول: ديني أو علماني، فإنّي لا أنفي العلمية عن أيٍ منهما، ولكن أفرق بينهما من ناحية تصورهم للحياة وللإنسان، واستخدامهم وتطويرهم للعلم بناءً على هذا التصور؛ ولهذا استقرّيتُ على العنوان: “نظامي التفكير الديني والعلماني في الاضطراب النفسي: ثنائي القطب نموذجًا” غير أني أتمنى ألا يكون مدعاةً لأن تحمل شحنة أيديولوجية، أو تسبّب اصطفافاتٍ متضادة، فغرضي هو التحليل. وأيضاً، وهو الأهم، ولكوني اخترتُ اضطرابًا نفسيًا ليكون محل المقارنة. بحيث يبرز فيه التفسيران الديني والعلماني، تحديداً كجانبين شبه متقابلين، كما مررتُ بهما في تجربتي مع الاضطراب النفسي “ثنائي القطب”، ولاعتقادي بالإجمال: أن علوم النفس الحديثة يبرز فيها الاختلاف بين التفسيرين: الديني والعلماني في أكثر تطبيقاتها، وهذه العلوم ما زالت غامضةً، وهي في طور المزيد من الاكتشافات لعوالم النفس الإنسانية المعقدة والخفية.
***
ثنائي القطب بحسب الطب النفسي الحديث -كما تم تشخيصه لأول مرة قبل حوالي مائة وخمسين عامًا- هو باختصار: حالة ينتقل فيها الإنسان بين قطبين متقابلين في المزاج والشعور. كأن يكون -مثلًا- في القطب المُسمى بالهوس في قمة السعادة والنشوة والطاقة، وفي المقابل يكون في القطب الآخر المُسمى بالاكتئاب، فيكون في حالةٍ من انخفاض المزاج والضيق، وكلا الحالين يُرجعان بحسب الطب النفسي الحديث إلى اعتلال بيولوجي في كيمياء الدماغ واضطراب التوازن فيه. وهذه النظرة لثنائي القطب سأقوم بتحدِّيها في مقالتي هذه ومحاولة التجديد فيها.
في هذه المقالة، وهذه نقطة مهمة، تجربتي في الهوس هي ناتجة عن تجربة دينية عميقة فهي قد لا تمثل كل تجارب الهوس، ولكن المصابين بشكل عام يشترك معظمهم في ارتفاع نسبة الروحانية وسمو الشعور ورهافة الإحساس والقدرة الإبداعية والتذوق الفني، وهذا هو جوهر التجربة، ولا يلزم أن يكون ذلك ناتجًا عن تديّن، فقد تتسم التجربة بسمو الروح مع ما قد يصاحبها من ضلالات في التفكير بسبب ما سنتطرق له لاحقًا. ولهذا فهذه المقالة تحكي تجربةً شخصيةً من طبيب امتياز، ومن نقاشات مع عدد من الأصدقاء المصابين بنفس الاضطراب، وهذه التجربة الدينية تمر بها مجموعة كبيرة من المصابين بهذا الاضطراب ممن مرّوا بحالة ما يُسمى بالهوس، حيث تُشير الدراسات إلى أن نسبةً عاليةً ممن يمرون بحالة الهوس يمرّون بتجربةٍ دينيةٍ وروحيةٍ عالية، يحسّون فيها بالقرب من الإله، ويحسّون بنوعٍ من التجاوز الميتافيزيقي، وبالاتصال بما يمكن اصطلاحًا تسميته: بالمقدس والمطلق واللانهائي، الذي عندما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه.
ولا أنوي -من هذه المقالة- إثبات التصوّر الشعبي عن الاضطرابات النفسية وإرجاعها إلى تلبّس الجن أو السحر أو غيره، ولكن المقالة هي لإعطاء تصورٍ علميٍّ مستفاد من تراكمات المعرفة الطبية النفسية الحديثة. وهي عبارة عن محاولة مني لوضع نظريةٍ تفسّر الاضطراب بطريقة أشمل من النموذج التفسيري الحالي، والغرض منها: طرحُ الفكرة العامة للنظرية وسماع وجهات النظر المختلفة والمخالفة؛ حتى يتسنّى لي تطويرُ النظرية، ونمذجتها بصورة أوضح وأقوى؛ لتعطي أكبر قدرة تفسيرية. وهذا النموذج التفسيري يُثبت نفسه ويضعها على المحك من خلال قدرته التفسيرية وشموليته، خلافًا للنموذج التفسيري السابق.
القصة باختصار:
نشأتُ نشأةً دينية وحفظت القرآن الكريم وكنت من المتميزين في دراستي ودخلت كلية الطب. وفي حياتي الجامعية بدأ يحصل لي تغيرٌ في طريقة التفكير؛ لأن التعليم الجامعي في كلية الطب يُركّز على التفسيرات المادية البحتة -بحسب النموذج الثقافي الغربي- ويعتمد في التدريس فيما يخص جسم الإنسان على نظرية التطور.
تطوّر هذا التجاذب بين نظامي التفكير أكثر عندما ابتُعِثتُ في فترة الصيف لعمل أبحاث في أمريكا في مستشفى مايو كلينيك، حيث تعرضتُ أكثر للنظريات والفلسفات الغربية من علماء ومفكرين كبار في حقولهم. تعرضتُ بعد عودتي لأزمة فكرية ونفسية وروحية عميقة، وما يمكن تسميته “بدوار ميتافيزيقي” فكنتُ أحاول أن أجد تفسيرًا وأن أبني تصورًا فكريًا فلسفيًا لفهم الحياة والتعايش معها بالمنطق السليم؛ مما سيوفر التوازن لي كإنسان. قرأتُ لكثيرٍ من الفلاسفة والعلماء والكتَّاب التراثيين والمعاصرين في الفكر الإسلامي والغربي، محاولًا إيجاد الحل بين هذين التصورين وبين نظامي التفكير في رؤيتهم للحياة. فتارةً كان يخف جانب التديّن عندي، وذلك عندما أقرأ لفلاسفة الغرب، مثل: نيتشه وراسل وفوكو من ذوي النظرة الأكثر مادية للحياة، وتارةً يقوى الجانب الديني، وذلك عندما أقرأُ لفلاسفة وعلماء الإسلام، مثل: الغزالي وابن تيمية وابن القيم وعلي بيغوفيتش من ذوي النظرة الدينية للحياة. فكنتُ -حرفيًا- أتنقل بين قطبين من التفكير والرؤية الوجودية. ولستُ أزعم بذلك أن هذا هو سبب ثنائي القطب عند كل المصابين، بل هي تجربة شخصية فقط. ولكني أرى فيها تجسيدًا لرؤيتي لهذا الاضطراب الذي هو في جوهره تنازعٌ بين قطبين متمايزين ومتراكبين معًا، وأرى أن تجلّي هذين القطبين يختلف من إنسان لآخر، فالإنسان كائنٌ مركبٌ من قطبي روح ومادة، مهما كان دينه أو كانت خلفيّته الثقافية، ويتنازعه هذان القطبان وتختلف شدتهما بحسب وعيه وتجربته.
وبعد عدّة سنوات من القراءة المكثفة، وفي يومٍ من الأيام، ومع هذه التنقّلات والبحث عن الحقيقة، وبينما كنتُ أقرأ أحد كتب الفلسفة، إذ بدأتُ أتنفّس بعمقٍ وأقول: “إنني وجدت الحقيقة” و” وإنني أقوم بولادة الروح” وكأنّ روحي عادت إليّ من جديد بعد تيهٍ وتعب، وكأن شيئًا قُذف في قلبي من يقينٍ بالله، وكنتُ أحسُّ بمعيّة الله وبقربه منّي وأحسُّ بنور الله وبالحق يشعُّ في مخيلتي وصدري وقلبي. وكنت وقتها أنظر إلى السماء بيقينٍ وروحانيةٍ عالية، وبهدوءٍ وسكينة، وأحسست بانجذابٍ روحانيٍّ عميق، وبتعلّق وقرب من الله سبحانه وتعالى، وبطاقة هائلة، وبرهافة في الحس. ثم خرجتُ أمشي كثيرًا في إحدى الحدائق، ثم ركبتُ الطائرة وسافرت إلى المدينة المنورة، حيث أحسستُ بالأمان والاطمئنان، وجلست فيها عشرة أيام حتى هدأت نفسي.
في وصف الحالة:
عندما كنتُ في هذه الحالة، كان هناك جانبٌ من التفكير غير المنطقي، وجانبٌ من التخيلات غير الواقعية، وأحسستُ بتضخّم الذات، وتطاير الأفكار. ولكن إلى جانب ذلك كان هناك نوعٌ من الفهم السريع، ومن القدرات العالية على التحليل وطرح الأسئلة والاستنتاج والتذوق العالي لمعاني كلمات القرآن والشعر وألحان الموسيقى. وكان لدي وقتها طاقةٌ إيجابيةٌ عالية، تجذب من هُم حولي من الناس، وتجعلهم ينجذبون لي ويستمتعون بالحديث معي.
وهذه الحالة الشعورية العميقة التي مررتُ بها، والتي لا تكفي العبارات لوصفها، ولا تبلغ المجازات التعبير عنها، ولا عن مدى إشراقها ووهجها وبروز الجوهر الإنساني بكثافة تجلياته الوجودية فيها، والتي يفسرها الأطباء بأنها مجرد اعتلالٍ في كيمياء الدماغ، ولستُ أعتقدُ ذلك إطلاقًا، بل هي شيءٌ أعقد من هذا. وأعتقدُ أن الكيمياء هي منتوجٌ ثانويٌ وليست أوّلي. فهناك شيءٌ ما أوليٌّ خارجيٌّ مجاوزٌ للإنسان يؤثّر في هذه الإفرازات الدماغية، التي تجعل الكيمياء تزداد وتنقص. ولذا أعتقدُ أنّه من الممكن التحكم بالعامل الثانوي بطريقة صناعية، وذلك عن طريق الأدوية والعقاقير التي تُعدِّل أو تُثبِّت المزاج([1]) أو المنتجات الطبيعية التي ترفع الطاقة الروحانية عند الاكتئاب مثل بعض أنواع الفطريات.
ولكنها كلها تعمل في الجانب الثانوي صناعيًا، وليست في العامل الأوّلي، ومفعولها مؤقتٌ لا يخلو من ضرر. وإذا كان الجانب الثانوي عاملًا لحدوث انتكاسة هوسٍ -كما يحصل عند متناولي حبوب المخدرات- فلا يصح أن نُرجع هذه التجربة إلى مجرّد هرمونات دماغية؛ لأنّه كما أشرنا سابقًا إلى أن إمكانية التلاعب والتحكم بالعامل الثانوي، لا يُلغي العامل الأساسي والأولي، وهو الجانب الروحي والمتجاوز. وهذا مبحث جميل وهام ويستحق التوسع فيه.
والانتشار الهائل لمضادات الاكتئاب في هذا العصر، سببها: انخفاض العوامل المسبّبة الأولية للسعادة والارتياح، مثل: الاهتمام بالروح وتنميتها التي تخفّف عوامل الاكتئاب، واللجوء إلى العوامل الثانوية كدواء “البروزاك” والمشروبات الكحولية والحبوب المخدرة.
وهنا أضرب مثالًا: فالأمر كمن يحافظ على صحته بطريقة طبيعية بالرياضة والأكل الصحي حتى يُحسّن من إفرازات “الإنسولين” ويحسّن استجابة الخلايا له؛ ليتحكم بمرض السكري، وكمن يقوم بمقاومته بالأدوية الكيميائية الصناعية التي لا تخلو من أعراضٍ جانبية.
فالصلاة والعبادة والتأمل هي العامل الطبيعي لتجاوز حدود الإنسان الطبيعية وإفرازاته الدماغية.
وهنا أشير إلى أنني زرتُ عددًا من الاستشاريين في الطب النفسي، فوجدتُ فيهم الجفاء وعدم الاهتمام بالتجربة الروحية العميقة التي مررتُ بها، ولاحظتُ تفسيرهم الدائم بأنها مجرد اختلالٍ في كيمياء الدماغ، إذ إن الطب النفسي الحديث يتعامل مع الجسد بما هو جسد في الطبيعة، لا بما هو في قدرته على تجاوز حدوده الطبيعية إلى شيءٍ أسمى وأعمق، أي لا بما هو مركبٌ من جوهر الروح والجسد.
حتى أن إطلاق مسمّى “الهوس” على هذه لحالة التي يكون فيها سعادةٌ غامرة، وفي بعض الأحيان قربٌ من المعبود أو رهافةٌ في الحس والمشاعر، هو في الواقع اختزالٌ لهذه التجربة الإنسانية العميقة والثرية في نوعٍ من الهوس وفقدان السيطرة، وهي في الواقع أعمقُ وأكثرُ امتلاءً وشعورًا، رغم اعترافنا بما قد يُصاحبها من ضلالاتٍ وأوهامٍ ينبغي الحذر منها.
ومع الامتلاء الروحاني يكون هناك هدوءٌ وصفاء وامتلاءٌ باليقين واستشعارٌ بمعية الله الدائمة مع الإنسان، وبأنه أقرب إليه من حبل الوريد عند من مروا بتجربة دينية، حتى أني وقتها صرفتُ كل ما كان في جيبي من مالٍ؛ لتسليمي المطلق بما عند الله من الخير والنعيم الدائم والعوض القادم. ولم أكن أشعرُ بأيّ اهتياجٍ أو بأيّ تصرفاتٍ عدوانية مما قد يتعرّضُ له بعضُ المصابين، غير أنه كان هناك بعض الأفكار الغريبة كفكرة قرب حدوث بعض الكوارث.
تحليل واستنتاجات:
باعتقادي، وحسب نظريتي التي أودُّ أن أطرحها، أرى أنّ اضطراب “ثنائي القطب” ينشأ نتيجةً لحدوث عدم توازن بين المركبين الجوهريين للإنسان، وهما: الروح والجسد. لا نعرفُ بالتفصيل ماهية هذا المركب، وكيف يترابط، ولكن بحسب تصورنا الإسلامي فالإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم هو عبارة عن امتزاج بين هذين المركبين. وبناءً على أسباب معينة لا أستطيع التفصيل فيها الآن منها الاستعداد الفطري والتاريخ الشخصي للمصاب، فقد يحدث عدم تواؤم في هذا المركب الروحي الجسدي في الإنسان فينشأ من هذا التنازع خللٌ في شخصية المريض، وتضخم الروح -في حالة الهوس- فتقلُّ السيطرة على العقل والجسم المادي؛ فتنتج بعض الضلالات والأفكار المُتوهَّمة مع سموٍ في الروح تنتج عنه طاقةٌ عالية ورهافةٌ في المشاعر والأحاسيس، وفي بعض الناس ينتج إحساسُ الاتّصالِ بالمقدس والمطلق. ولهذا فأنا في مقالتي هذه تحاشيتُ أن أًصفهُ بالمرض، واقتصرتُ على وصفه بالاضطراب؛ لكونه في أساسه اضطرابٌ في هذه العلاقة التكاملية بين الروح والجسد.
فاضطرابُ “ثنائي القطب” هو تأرجح الإنسان بين المادة والروح تأرجحًا شديدًا وربما يكون طاغيًا. ففي حال الطغيان المادي تبرز العدمية والعبثية، ويحدث ما يُسمّى بالاكتئاب، وفي حال الطغيان الروحي يحدثُ ما يُسمّى بالهوس. فالاكتئاب ينشأ نتيجة التشبّث بالحياة المادية وقوانينها العقلية البحتة وضيقها الدنيوي، بالتزامن مع فقدان المقدَّرات الروحية الدينية التي تسمو بالإنسان وتعطيه الأمان. وينشأ نتيجة الهوس الذي هو تجاوزٌ ميتافيزيقي ينشأ نتيجة التخلي عن القوانين العقلية المادية المباشرة بالدخول إلى عالم التصوّف والروحانيات. ولهذا فإن الحل يكمن في التوفيق المعرفي بين المادية وبين الروحانية أو الدينية، فالإنسان كائنٌ ثنائيُ القطبِ بطبعه وجوهره وهذه الثنائية متكاملةٌ وليست منفصلة.
هذه النظرة لثنائي القطب وعلاقته بالإنسان من الممكن على الأقل أن تفسّر كيفية نشوء الاضطراب وعلى أكبر تقدير يمكن أن تساهم في علاجه ودراسته بشكل ملائم. وأعتقدُ أنه إذا ما أُدمج الجانب الروحاني والتجربة الدينية في علاج ثنائي القطب فإنّ ذلك سيكون مساعدًا لقدرة المريض على التكيّف وسيكون ذلك أقدر له على التأقلم وعلى وضع آليات لمواجهة الاضطراب يدمج فيها نشاطه الروحي ويعزّزه لا أن يُقلَّل من شأنه فيعود عليه بالسلب. وباعتقادي، فإنّ لعلوم السلوك قدراتٌ هائلة في تفسير كثير من هذه التجارب النفسية خصوصاً إذا ما تكاملت مع منجزات علوم النفس الحديثة.
ولهذا فإن المريض عندما يكون في قطب الاكتئاب نحتاج أن نعزز الجوانب الروحية والعاطفية فيه أكثر بكثير من الجوانب المادية؛ كي تنتشله من بؤسه وشقائه كما نحتاج أن نخفف من تذكيره بما يجب عليه من الأمور المادية في حياته. وعندما يكون في قطب الهوس نحتاج أن نكثف الجانب العقلاني والمحسوس، وأن نحاول السيطرة عليه حتى يعود إلى وعيه، مع مراعاة الفروق الشخصية في كل فرد.
وأختم بأن أبيّن نقطةً في غاية الأهميّة، وهي أنّ هناك تصوّرًا مختلفًا في طريقة النظر ورؤية اضطراب ثنائي القطب، أي عندما ننظر له من منظور ديني من جهة ومن منظور علماني من جهة أخرى، فهما منظاران مختلفان، ويختلف تأثير اضطراب المريض وعلاجه بناءً على الإيمان بأي هذين المنظورين، حيث إن الأول -وهي الديني- يعطي نظرة مغايرة حتى في طريقة التعايش مع الاضطراب وتكون أكثر سلوانًا للمريض وتقبلاً لحاله، وباعثًا على منعه من الإقدام على أي عمل قد يسبب له الإيذاء، لأن هذا المنظور أقرب للمشاعر ولحقيقة الإنسان، وأكثر تثمينًا للتجربة الروحية التي مر بها. أما المنظور الثاني -وهو العلمانية- فهي تتسم بالجفاء، وتجعل الإنسان يتصور نفسه بأنه مجرد آلة، وأنّ التي تتحكم به ما هي إلّا مجرّد مركبات كيميائية.
فطريقتا التفكير تنعكس على تصور المصاب للاضطراب، وعلى رؤيته للعالم من حوله وعلى كيفية تعايشه مع الاضطراب. وأنا من خلال تجربتي عندما أمارس التأمل في الكون والوجود وقراءة القران بتدبر والصلاة والقرب من الله وعندما أمارس ما ينمّي الجانب الروحي عندي، فإنّي أجدُ نوعًا من الاطمئنان والتخفيف والإحساس بالأمان وبتخفيف حدة الاكتئاب المادية المغلقة والمصمتة للوجود، فالتفسير الديني هو الأقرب إلى القلب والأقرب إلى هدوء النفس وسكينتها وطمأنينتها.
وأخيرًا فإنّ الاضطرابات النفسية مثل “ثنائي القطب” هي من أكبر الدلائل الممكن استخدامها فلسفيًا -إذا ما وُظفت بشكل صحيح- في إثبات أن الإنسان كائنٌ متجاوزٌ لحدوده المادية والطبيعية المقيِّدة له، وأيضّا إن الأمراض النفسية هي تعبير على هذا التجاوز بنوعٍ من التمرّد والخروج والانتقال فلربما استطعنا تسميتها بـ “تمرد الروح”. وليس المقصود هنا أن أفسّر التجارب التي يمر فيها المصاب على أنها نوعٌ من الولاية أو الكرامة، ولكنّها من التجلّي لحقيقةٍ جوهرية في الإنسان، وهي كونه مكونًا في الأساس من قطبين متمايزين ولكنهما متكاملان.
- عبدالرحمن احمد الخطيب: طبيب امتياز.
[1]– وهنا أؤكد على أهمية الأدوية التي ثبتت فائدتها