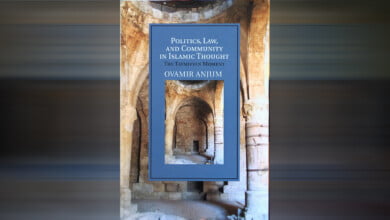- محمد بن بلال عبد المجيد
- تحرير: عبد الرحمن روح الأمين
ليست النفوس سواءً في تقبّلها للحقائق؛ بعض النفوس تسعى للحقيقة في صدق وإخلاص وحرص، فإذا ما وافتها الحقيقة اهتزّت وربت وأينعت فيها ثمار الحقيقة، وبعض النفوس كالقيعان -كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم – لا تُمسك ماءً ولا تنبت كلأً، إذا صادفتها الحقيقة لفظتها ولم تقبلها، ولم تكتفِ بالصدود والإعراض، بل تبدأ في تعكير صفو الحق، ونكت السواد في بياضه الأغرّ. وقد تقبل هذه النفوس بعض الحقّ وتعرض عن بعض، وقد تقبل الحقّ بعد أن تخلطه ببعض أهوائها، فتخرج منه نسخة ترتضيها وتستسيغها أمزجتها المريضة.
ومحمد أسد – الرحالة والمفكر النمساوي، الذي اعتنق الإسلام بعد رحلة طويلة للبحث عن الحق- نحسبه من النفوس التي قبلت الحق ورفعت به رأسًا، وقد رأينا على سحنات فكره وألفينا من نتاج قلمه ما يُنبئ عن ذلك من عزة بالإسلام واستعلاء بالإيمان وتقبّل لدين الله بكلّيته دون تجزئة ودفاعٍ قوي ثابت عن القرآن والسنة ودعوة إلى إحيائهما والاستدواء بهما، وهذه كلّها من ثمار الحقّ وأمارات قبول النفس له.
وفي هذه المقالة، نقصر اهتمامنا على إحدى ثمار الحقّ في نفس محمد أسد، وهو دفاعه عن السنّة حجّيتها وموثوقيتّها، واعتباره إيّاها حصن الإسلام ومفتاح فهمه وتقدمه، وسبيل إصلاح أحوال المسلمين. ومصدرنا في ذلك كتابه الأهم “الإسلام على مفترق الطرق”، ولا يزال هذا الكتاب – رغم مرور ما يقارب القرن على تأليفه – محتفظًا بنفاسته، وقادرًا على وصف مشكلات واقعنا وحلولها بدقة شديدة.
حجية السنة
القرآن والسنة معًا هما الأصلان الأوّليّان الأوثقان في الإسلام، وهما المصدران الرئيسيان للتشريع الإسلامي، لا يُنكر هذه الحقيقة إلا جاهل لحقيقة الإسلام أو معاند. والعلاقة بين القرآن والسنة علاقة تلازم وثيقة تأبى على الحل والفصل، إلا إذا أردنا أن نحل عُرى الإسلام ونقوّض بناءه. يقول أسد: “إن العمل بسنة رسول الله هو عمل على حفظ كيان الإسلام وعلى تقدمه، وإن ترك السنة هو انحلال الإسلام .. لقد كانت السنة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما، أفيدهشك أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق؟“
السنة النبوية إذن تُبين القرآن وتفصّل مجمله وتوضّح تشريعاته وأحكامه، ليس هذا فحسب، بل تحوي السنة على تشريعات لم ترد في القرآن مجملة ولا مفصّلة، وليس هذا نقصًا في القرآن، إنما هو تكامل مصادر التشريع وتناغم أجزاء الإسلام وتناسق أبعاضه، وهو دليل على المصدر الإلهي لهذا الدين، وكثيرًا ما يكون هذا التكامل والتناسق في بناء الإسلام سببًا في هداية الناس إليه، وها هو محمد أسد يجيب عن سؤال تردّد عليه كثيرًا: ما الذي جذبك إلى الإسلام خاصةً؟ فيقول: “وهنا يجب أن أعترف أني لا أعرف جوابًا شافيًا! لم يكن الذي جذبني تعليمًا خاصًا من التعاليم، بل ذلك البناء المجموع العجيب والمتراصّ بما لا نستطيع له تفسيرًا.”
ويقول أيضًا: “لا أستطيع أن أقول أيّ النواحي قد استهوتني أكثرَ من غيرها، فإن الإسلام على ما يبدو لي بناء تام الصنعة، وكل أجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضًا، ويشد بعضها بعضًا، فليس هناك شيء لا حاجة إليه، وليس هناك نقص في شيء، فنتج عن ذلك كله ائتلاف متّزن مرصوص، ولعل هذا الشعور بأن ما في الإسلام من تعاليم وفرائض قد وضعت موضعها هو الذي كان له أقوى الأثر في نفسي.“
وبذلك نتيقّن أن محاولات إقصاء السنّة والاكتفاء بالقرآن هي إيمان ببعض الإسلام وكفر ببعض، بل هي إيمان ببعض القرآن وكفر ببعض، لأن القرآن يفيض بالآيات الدالة على حجّية السنة، وهو يحثّ دائمًا على طاعة الرسول ويُقرنها بطاعة الله وحبّه، وليت شعري كيف لرجل يؤمن بالقرآن أو يدّعي الإيمان به، ثم يقع على سمعه قسم الله تعالى في القرآن: ” فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا” ثم تبقى في نفسه ذرّة من شكٍّ في اتّباع السنة وطاعة الرسول.
وكما أن الفصل بين القرآن والسنة مخالف لروح الإسلام ومفتت لوحدته، فكذلك الانتقاء من السنة حسب الأهواء، واتباع بعضها وتعطيل بعض بناءً على تنظيراتٍ وتصنيفاتٍ متهافتةٍ هو أيضا مخالف لتكامليةِ هذا الدين العظيم، وقد عانت السنة من تصرّف بعض المُتَمَحدِثِين فيها حسب أهوائهم دون اتباع دليل معتبر، ودون التزامٍ حتى بمنهجٍ نقديٍّ مطرد، والبعض الآخر منهم يصنف السنة إلى سنة ملزمة وسنة غير ملزمة عفا عليها الزمن وانتهت صلاحيتها. يقول محمد أسد :”إن القول بأننا مجبرون على اتباع بعض أوامر الرسول، ولسنا مجبرين على اتباع البعض الآخر، إنما هو نظر سطحي، وهو فوق كل ذلك مناهض في روحه للإسلام، مثل الفكرة القائلة بأن بعض أوامر القرآن قد قصد بها العرب الذين عاصروا نزول الوحي، لا النخبة من الجِنْتِلْمِين (gentle men) الذين يعيشون في القرن العشرين. إن هذا بخس شديد لقدر النور النبوي الذي قام به المصطفى.“
موثوقية السنة وعدالة الصحابة
قرّ الآن في يقيننا أن السنة حصن للقرآن ومفتاحٌ لفهمه، وبدونها يصبح القرآن عرضة لتصرّف الأهواء فيه، وعرضة لسيل من التأويلات والتفسيرات المتلاطمة، وعرضة لأن يتم تسْييله وتفريغه من دلالاته الحقيقية. لذلك كان حفظ السنة من حفظ القرآن الذي تعهد الله به: “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”.
ومن حفظ الله لسنة نبيه أن قيّضَ لها من يوثّقها توثيقًا هو المنتهى في الدقة والغاية في الصرامة النقدية، هؤلاء الذين قال عنهم محمد أسد:”قد قاموا بكل ما في طاقة البشر عند عرض صحّة كل حديث على قواعد التحديث عرضًا أشدّ كثيرًا من ذلك الذي يلجأ إليه المؤرخون الأوروبيون عادة عند النظر في مصادر التاريخ القديم.“
بذَل علماء الحديث المسلمون جهودًا جبارةً في توثيق السنة، والتحقّق من صحة الأخبار المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسّسُوا في سبيل ذلك لعلم الحديث بمباحثه الكثيرة المتشعبة، ليكون مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية، وعلامة على عناية الله وحفظه لسنة نبيه. والمقام هنا لا يسمح حتى بالإطلالة الخاطفة على شيء من هذا العلم المترامية أطرافه.
والناظر في خطاب منكري السنة أو القرآنيين -وليتهم قرآنيون حقًّا- يجد أن طعنهم في موثوقيّة السنة أكثر من طعنهم في حجيتها، يقول محمد أسد: “هنالك كثير من المسلمين العصرِيّين الذين يعلنون بأنهم على استعداد للعمل بالسنة، ولكنهم يظنون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على مجموع الأحاديث التي تقوم عليها السنة. ولقد أصبح من قبيل الزي في أيامنا هذه أن ينكر المرء مبدأيًا صحة الحديث، ثم هو من أجل ذلك ينكر نظام السنة كله.“
ولكن الشيء الذي يشترك فيه جل -إلم يكن كل- منكري السنة هو جهلهم الشديد أو معرفتهم السطحيّة بجهود علماء الحديث في نقد الأخبار والمرويّات التاريخيّة، وكان هذا الجهل هو السبب في تشكيكِهم في السنة ونقدِهم المتهافت لهذه الجهود، وأنه “على الرغم من جميع الجهود التي بُذلت في سبيل تحدي الحديث على أنه نظام ما، فإن أولئك النقاد العصريّين من الشرقيّين والغربيّين لم يستطيعوا أن يدعموا انتقادهم العاطفي الخالص بنتائج من البحث العلمي.” كما يقول أسد.
كما كانت قلة اطلاع القرآنيين على جهود علماء الحديث سببًا في استنكارهم للمكانة التي احتلها الأئمة المُحدِّثون -أمثال البخاري ومسلم- في نفوس المسلمين، حتى ظنّوا أن المسلمين يقدِّسون البخاري ومسلم أو ينسبون إليهم العصمة، والحقيقة أن مكانة هؤلاء الأئمة في نفوسنا عظيمة، ولكننا نُجلّهم ولا نقدّسهم، ونحبّهم لأنهم أفنَوا أعمارهم في حماية السنة والذبّ عن حِياضِها، ونقلوها إلينا صافيةً من أكدار الدسائس والموضوعات. وحبّنا لهم هو فرعٌ عن حبنا لرسول الله وحرصِنا على سنته وهديِه، لأنهم هم من نقلُوا إلينا هذه السنة، وحفظها الله -تبارك وتعالى- على أيديهم، وليس هذا بالشيء الهيّن لو يعلم السادة القرآنِيّون الأفاضل.
أما عن عدالة الصحابة -والمقصود بها سلامة الصحابة من اتّهامات الكذب على رسول الله أو وضع الأحاديث عمدًا، وهي قاعدة متّفقٌ عليها عند علماء الحديث- فقد حاول أن يثبتها محمد أسد من الناحية النفسانِيّة المحضة، فقال: “إن الأثر العظيم الذي تركته شخصية الرسول في أولئك الرجال إنما هي حقيقةٌ من أبرز حقائق التاريخ الإنساني، فهل يمر في خيالنا أن أولئك الرجال الذين كانوا على استعداد لأن يضحّوا بأنفسهم وما يملكون في سبيل رسول الله كانوا يتلاعبون بكلماته؟ لقد قال الرسول: “من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار” أفَمِن المحتمل، من وجهة النظر النفسانيّة إذن أن يغفَلُوا هذا النهي الصريح نفسَه؟“
والعجيب أن هذه السَّطوةَ السيْكُولُوجِيّة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مقصورة على الصحابة وحدهم، بل طالَت كل من عاصر النبي أو التقى به، فلم نسمع مثلًا عن واحدٍ من المشركين المُعادين لرسول الله يختلق أحاديثًا ويدسّها على لسانه، وها هو أبو سفيان يمتنع عن الكذب على الرسول في لقائِه المشهور مع هِرقل، ولم يكن قد أسلم بعد. نعم كان امتناع أبي سفيان عن الكذب في أحد جوانبه تعفّف العربي ومروءته وخوفه أن يُعرف عنه كذب، ولكنه كان من جانب آخر إذعانًا للسَطوة المحمديّة على نفسيّته.
أسباب إنكار السنة
طالما ثبت أن محاولات إنكار السنة والطعن في حجّيتها وموثوقيّتها ليست إلا هذرٌ وعبثٌ، وليست إلا “قضية ذوق، قصّرت عن أن تجعل من نفسها بحثًا علميًا خالصًا من الأهواء” كما يقول أسد، إذن وجب علينا أن نبحث عن الدوافع والأسباب بين السطور وتحت الغطاء المبَهرجِ الخادع، سواءً كان المنكرون على وعيٍ بهذه الدوافع أو كانت خفيةً عنهم تُحرّكهم دون وعي منهم.
من هذه الأسباب -كما يراها محمد أسد-: “استحالة الجمع بين طريقة حياتِنا وتفكيرِنا الحاضرة المُتقهقِرة وبين روح الإسلام الصحيح -كما يظهر في سنة النبي- في نظام واحد.“
إن منكري السنة يُكابِدون آلام انشِطار أرواحهم بين الواقع المرير الذي تمرّ به الأمة وبين نظام السنة الذي يرونه لا يتماشى مع هذا الواقع ولا يستوعبه، ولن يستطيعوا أن يضمدوا جراحات أرواحهم إلا بالتخفّف من أثقال نظام يرسم للإسلام معالم واضحة محدّدة ويمنع العقول من التخبّط في تفسير تعاليمه حسب الأهواء، وهذا يكون بلفظ السنة والانعتاق منها. يقول أسد:” ولكي يستطيع نَقَدَة الحديث المزيّفون أن يبرّروا قُصورهم وقصور بيئتِهم فإنهم يحاولون أن يزِيلوا ضرورة اتباع السنة، لكي يكون بإمكانهم حينئذٍ أن يتأوّلوا تعاليم القرآن كما يشاؤون على أوجه من التفكير السطحي.”
ومن أسباب إنكار السنة أيضًا، أن “المغلوب مولَع بتقليد الغالب” كما يقول ابن خلدون، ولما كان الغرب -في عصرنا هذا- غالبًا على الدنيا، صارت لثقافته سطوة على الثقافات، وصارت الشعوب والأمم المهزومة مولَعةً بتقليده، وخصوصًا تلك الشعوب التي غرقت في نقدها لذاتها حتى كرِهت نفسَها وانسلخت من ثقافتها وانْبَتّت عن جذورها الحضارية والتاريخية، فأضحت فريسةً سهلةً للاستعباد الثقافي من قبل الشعوب الغالبة. يقول أسد:”إن السنة تعارض الآراء الأساسية التي تقوم عليها المدنية الغربية معارضةً صريحة، حتى أن أولئك الذين خلبتهم الثانية لا يجدون مخرجا من مأزِقهم هذا إلا برفض السنة على أنها غير واجبة الاتباع على المسلمين.“
كما يرى أسد أن من أسباب إنكار السنة هو ادّعاء معارضتها للعقل، وهو يرى أن هذا ادّعاء خاطئٌ ناشئٌ عن خلطٍ بين العقل وبين الفلسفات والمذاهب العقلية، يقول: “إن العقل يعرف حدوده الخاصة به، ولكن الفلسفة العقلية تتخطّى المعقول في ادّعائها حصر العالم بجميع خفاياه في نطاقها الفردي الضيّق… إن قدر تلك الفلسفة العقلية فوق قدرها هو أحد الأسباب التي تحمل المسلمين على أن يأبوا إسلام أنفسهم إلى هداية الرسول.”
وحتى العقل البشري في أكثر صوره تجردًا وموضوعيةً وبساطة، هو قاصر عن الاستقلال بذاته، والاستئثار بمصدريّة المعرفة وحده، لأننا -كما يقول أسد-: “لا ندري ما اللانهاية ولا ما الأزل، وإننا -في قضايا الدين المبنية على أسس مطلقة- نحتاج ضرورة إلى هادٍ يتّصف عقله بشيء فوق ما يتصف به التفكير المادّي وفوق ما تتّصف به الفلسفة العقلية الذاتية العامة فينا.”
الدور الإصلاحي للسنة
يرى محمد أسد أن السبيل الوحيد للإصلاح وتغيير أحوال المسلمين يَكمن في خطوتين لا ثالث لهما، وهما “أن ننفُض عن أنفسنا روح الاعتذار، الذي هو اسم آخر للانهزام العقلي فينا، أو هو إقناع لتشاؤُمنا. أما الخطوة الثانية فهي أن نعمل بسنة نبينا على وعيٍ منّا وعزيمة.“
ويقول أيضًا: “لقد كانت السنة مفتاحًا لفهم النهضة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، فلماذا لا تكون مفتاحًا لفهم انحلالنا الحاضر.”
يطرح أسد سؤالًا مهما على نفسه، وهو: ما الجدوى من إقامة السنة؟ “وما المعنى الروحي لذلك النظام المفصل من القوانين والآداب والسلوك التي يجب أن تعين للمسلم سلوكه في أهم نواحي وجوده وفي أقلها أهمية على حدٍ سواء؟”
ويجيب بأن الدور الحضاري والإصلاحي للسنة -كما يراه- يتمثل في ثلاثة تجلياتٍ رئيسية؛ إثنين منها يتعلّقان بالفرد، وواحدة تعمّ المجتمعَ المسلم بأسره.
التجلّي الفردي الأول هو المراقبة الذاتية الصارمة التي يمارسها الإنسان الذي يتّبع السنة إزاء أخلاقه وسلوكيّاته، فهو في حالة رياضةٍ نفسيةٍ أخلاقية دائمة، يحاول دائمًا أن يتخلّص من سلوكيّاته المخالفة للسنة، وأن يتمثّل السلوكيات التي تُوافقها. في حالة كهذه يكون الإنسان ضابطًا لنفسه شديدَ اليقظة عميقَ الوعي بذاته وما فيها من دوافع وانفعالات وتوجهات، وهو بذلك قادر على تضييق نطاقِ الأعمال والعادات التي تقع عفو الساعة، وهذه العفويّات -في نظر أسد- “عثرات في طريق التقدّم الروحي للإنسان، وهي تُتلف التوجيه الروحي للفكر.”
والتجلّي الفردي الثاني هو ما يمكن أن نلخّصه في قولنا: استنساخ شخصية الرسول في حياة كل واحد منا، لا أن يكون مجرّد مثالٍ كاملٍ بعيدٍ عن واقعنا وحياتنا اليومية. وفي أثر هذا الأمر يقول محمد أسد:”وهكذا نكون دائمًا، إذا فعلنا أو تركنا، مجبرين على التفكير في أعمال الرسول وأقواله المماثلة لأفعالنا هذه. وعلى هذا تصبح شخصية أعظم رجل متغلغلة إلى حد كبير في منهاج حياتنا اليومية نفسه، ويكون نفوذه الروحي قد أصبح العامل الحقيقي الذي يعتادنا طوال الحياة.”
أما التجلّي الثالث فهو اجتماعي، فالسنة لها قيمة اجتماعية كبيرة، لأنها “تجعل المجتمع متماسكًا مستقرًّا في شكله“، وتجعل أفراد المجتمع كالبنيان المرصوص.
السنة تصبغ المجتمع بصبغة مخصوصة، وتهب للمجتمع الإسلامي أصالته وتميّزه، كل ذلك دون أن تطمس فرديّة الأفراد أو أن تقمع تميّزهم، ولكنها مع ذلك تُذيب الحواجز بينهم، تلك الحواجز التي تنشأ عن تنافُر الأمزِجة والطباع وتعدّد العادات واختلاف الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
رحم الله الرجل الباحث عن الحق محمد أسد، فقد انعطفت جنباتُ نفسه على الحق اعتناقًا ويقينًا، فكان رجلًا مؤمنًا مستعليًا بإيمانه، حريصًا على إعادة الثقة للمسلمين في أنفسهم وفي دينهم وفي سنة نبيهم، وما أجمل قوله: “إن الإسلام ليس سبيلًا من السبُل، ولكنه السبيل! إن الرجل الذي جاء بهذه التعاليم ليس هاديًا من الهداة، ولكنه الهادي! فاتباعه في كل ما فعل وأمر هو اتباع للإسلام عينه، وأما اطراح سنته فهو اطراح لحقيقة الإسلام.”
*المصادر:
1-كتاب الإسلام على مفترق الطرق – محمد أسد – ترجمة د. عمر فروخ.
2- الكتاب والسنة – مقال للمسلم النمساوي الأستاذ محمد أسد (ليوبلد فايس) – ترجمة الدكتور صالح الحصين – تعليق الدكتور محمد إبراهيم السعيدي.