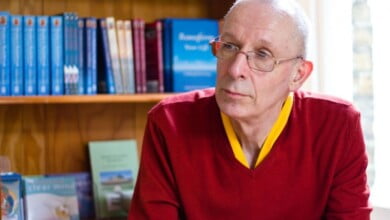- كورينا ستان
- ترجمة: أحمد علي حسن
- تحرير: سهام سايح
- مراجعة: أميرة القحطاني
“في غرفةٍ غريبة، يجب أن تُفرغ نفسك من كلِّ شيء للنوم. وقبل أن تُصفِّي ذهنك للنوم، من أنت؟ وعندما تصفِّي ذهنك للنوم… لم تكن أبدًا كذلك؛ وعندما تغطُّ في النوم… فأنت لم تفعل أبدًا”.[1]
أنا لستُ في غرفة غريبة، لكن غرفتي المألوفة في عالمٍ غريب، وهذا المقطع من رواية ويليام فوكنر يلاحقني دومًا.
عشتُ في الخارج طوال حياتي، وكنت أفكر في آثار البُعد لسنوات، أنا وعائلتي والعديد من أصدقائي نعيش في قارات مختلفة، وفي معظم الأوقات نلتقي عبر الإنترنت، ونلتقي بشكل شخصي في الصيف فقط، لذلك كلما رأينا بعضنا البعض، نأخذ بهدوء الاختلافات الدقيقة التي حدثت طوال فترة غيابنا عن بعضنا البعض، وهي عبارة عن مُلخصٍ بسيط لعدم الاتصال ويتبعُ تلك الاختلافات ابتسامة أكثر إحكامًا أو استرخاءً ، عدد قليل من الشَعر الأبيض بات موجودًا ، الأطفال الذين يبدون أكبر قليلاً، بشرة شاحبة قد توحي بالمرض، صمتٌ أعمق لشخص ما، ونتجنب الحديث في بعض الموضوعات من خلال نظرة بسيطة توحي بأنّنا لا نريد أن نتكلم في تلك النقطة، كل ذلك يشير إلى التراكم الكثيف للأيام التي لم نكن فيها معًا.
يجب أن أتظاهر بأنّ أصدقائي هنا وزملائي يعيشون أيضًا في الخارج، وأنه يفصلني عن جيراني زجاج منزلهم الذي لا يُفتح، من الغريب أن نعيش في منفى بعيدًا عن كل شخص تقريبًا، كما لو كان كل منا قد ذهب عبر بوابة إلى جزيرة بعيدة للغاية بل قل إلى كوكب بعيد.
عندما تستعدُ للنوم في نهاية اليوم، تبدأ في تلك اللحظة العديد من الأفكار، الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو الذين لم يتمكنوا من تقديم وداع أخير لأحبائهم، أو الحديث من خلال الشاشات لكي تعرف الأخبار ولكن تبقى مكتوف اليدين فلا يمكنك فعل شيء، أو العائلة التي ستظل بعيدة على الأقل إن استمر الوضع هكذا؛ إنّ لحظة الاستعداد للنوم لحظة تكتشف فيها الكثير والكثير… “من أنت؟”.
لا يوجد سبب -وغالبًا لا يوجد وقت- للتفكير في حياتنا اليومية عندما نكون فيها، الطقوس التي ننخرط فيها دون تفكير، وعادات التفكير المُشتتة، ألِفنا كل ذلك حتى أضحى غير مألوف، مثل شكل أحذيتنا على أقدامنا ، أو المساحة الحميمة للطاولة الليلية التي نجلس إليها دون النظر في طريقنا إليها، أشياء بسيطة لكنها طقوس أصبحت يومية.
هناك شيء من هذا الانخراط المسلّم به للعالم في مجال العلاقات الاجتماعية، ليس فقط العائلة والأصدقاء الذين نختار أن نقضي الوقت معهم أو الزملاء الذين نعمل معهم، ولكن كل هؤلاء الأشخاص العاديين الذين نحتكُّ بهم بشكل يومي وعارض في الحياة الاجتماعية ،الأشخاص الذين نراهم عرضًا للحظات معدودة، أو حتى لا نراهم على الإطلاق، لكن وجودهم يمنحنا إحساسًا بالحياة.
إنّك تشعر بهذا الوجود في الطاقة التي يشعلها في داخلك زحام فِئات من الناس، كأن تكون في ملعب كرة سلة حيث مئات أو آلاف النظرات المتوجهة إلى الكرة، أو في قاعة حفلات موسيقية، التي ينضبط إيقاعها ليطرب مئات الأشخاص. أعلمُ وأتجاهَل ما أفتقده هذه الأيام، أظن أن قلقي ليس له علاقة بعدم القدرة على التفاعل مع طلابي شخصيًا، من الصعب استرداد الطاقة التي يمنحونها لي في الفصل الدراسي من الابتسامات المنقطعة، حيث تكون نهاية كل جلسة مقلقة قليلاً؛ نظرًا للاختفاء المفاجئ للجميع كأنهم يرحلون بضغطة زر.
أفتقد زحام الملاعب حيث اصطحب ابنتي للعب إلى جانب أطفالٍ آخرين، ودور السينما في الحي التي كنت أذهب إليها بين الحين والآخر لمجرد مشاهدة فيلم في مكان هادئ من أشخاص آخرين، يبدو الأمر كما لو أنّ كل هذه الأماكن كانت تستضيف نسخة من فلم ‹‹John Cage’s 4’33 ››، ذلك الفلم الذي أضحى بلا معنى بسبب ما وصلنا إليه.
قبل بضع سنوات انتهيتُ من العمل على كتاب بعنوان ‹‹فن التباعد››، والذي أصبح خط الأساس لمحاولة فهم معنى هذه الحقبة التي نعيشها جميعًا، من خلال تجربتنا الجماعية في التباعد الاجتماعي، ما القيمة التي يمكن للمرء أن ينسبها إلى الابتعاد؟ وما الأفكار التي نكتسبها من الابتعاد عن الآخرين؟ وفي مثل هذه الأماكن القريبة مع أنفسنا.
****
لقد شغلت مسألة المسافة الصحيحة بين الذات والآخرين الفلاسفة والكتاب بشكل خاص خلال وبعد لحظات من الاضطراب الاجتماعي، عندما بدت الحياة كما عرفوها تتحول أمام أعينهم. قبل أقل من قرن، كان إريك بلير عائداً إلى إنجلترا مستاءً من العمل غير الآدمي للإمبراطورية الذي قام به كمدير استعماري في بورما، عازمًا على النزول بين المظلومين، أدار ظهره لعائلته من الطبقة المتوسطة، وارتدى لباس متشرد وعاش لبضعة أشهر مع المشردين، ثم عبر القناة وعمل في غسل الصحون في الفنادق الباريسية.
جُمعت هذه التجارب في كتاب ‹‹Down and Out in Paris and London (1933)›› وكان أولُ كتاب لبلير، نُشر باسم المؤلف الذي نعرفه الآن بـ (جورج أورويل). افتتح الكتاب مسيرةَ أورويل الأدبية، وبإخلاص لا هوادة فيه أصبح سمته -في عمله الصحفي التالي- هو شجب تجربته الخاصة ووصفها بأنّها (حفلة تنكرية)، بعد أن تعلم أنّ الفروق الاجتماعية ليست مسألة تافهة، وأنّ إلغاء الفروق الطبقية يتطلب ما لا يقل عن تحولٍ كاملٍ لموقف الفرد من الحياة.
صاغ العديد من المفكرين في القرن الماضي تشخيصاتهم للعالم المعاصر في مفردات البُعد والقُرب، في نفس الوقت تقريبًا، بدأ إلياس كانيتي المعاصر تشريح الأنماط البشرية للانفصال والتباعد التي أصبحت عمل حياته. إنه كاتب باللغة الألمانية ولد في بلغاريا في عائلة من اليهود، أمضى كانيتي العقود الأخيرة من حياته في إنجلترا، حيث تتكون الحياة الاجتماعية من جهود عبثية غير مُجدية، كان مهووسًا بالحشود، مقتنعًا بأن الأيديولوجيات التي شكلت القرن العشرين – الشيوعية والفاشية – والكوارث البشرية التي تلت ذلك يمكن تفسيرها برغبة الناس الساحقة في أن يكونوا جزءًا من الحشد وبالتالي تُلغى التباعدات والفروق في الحياة اليومية.
عندما أنهى كتابه الطموح ‹‹الحشود والسلطة›› (1960) الذي استغرق 30 عامًا لإكماله، تنهد بارتياح؛ لأنّه “نجح في الإمساك بهذا القرن من حلقه”، بعد أن فهمه بشكل أفضل من أي شخصٍ آخر. الفيلسوفة والروائية إيريس مردوك التي كان لكانيتي معها علاقة قصيرة، كانت أيضًا منشغلة بكيفية عيش الناس معًا، ويمكن قراءة الكثير من رواياتها كتأمل مُمتد على تحديد المسافة المثالية للبُعد عن الآخرين.
في رأيها، كان من أعظم تحدِّيات الحياة الأخلاقية أخذ الحقيقة الكاملة للآخرين على محمل الجد، وهذا يعني فهم الآخر على أنّه ليس مجرد امتداد للنفس، فواحد من أكثر الأجزاء الرائعة في روايتها ‹‹ 1958 The Bell›› تصور شابة تزور المعرض الوطني في لندن وتكتشف بعد التفكر في اللوحات مثالًا على هذا التباعد المثالي:
“كان هناك شيء لا يمكن لوعيها استيعابه، وجعلُه جزءًا من خيالها يجعَله لا قيمة له… نظرت إلى القماش اللامع الداكن في لوحة غينزبرة، وشعرت برغبة مفاجئة في النزول على ركبتيها والبكاء أمامها واحتضانها”.
تستند هذه الرموز الثلاثة – أورويل وكانيتي ومردوك – إلى لحظاتهم التاريخية: الاستعمار والكسادُ العظيم، إنّه “عالم المنفيين” الذين عانوا في أعقاب النازية من الفظائع وتدمير الحرب العالمية الثانية، ولكن حتى في الأوقات الأكثر هدوءًا، هناك أولئك الذين فكروا كثيرًا في مسألة التباعد بين الأشخاص. في مَثلٍ يُحبه آرثر شوبنهاور وسيجموند فرويد، تتجمع بعض النَّيص معًا في الطقس المتجمد، محاولين البقاء قريبين بما يكفي للتدفئة، ولكن أيضًا بعيدًا بما يكفي حتى يتجنبوا وخز بعضهم البعض، نقلاً عن هذا المثل صاغ عالم السيميولوجيا الفرنسي رولاند بارت مسار محاضراته “كيف نعيش معًا” حول سؤال: “على أيّ مسافة يجب أن أحمي نفسي من الآخرين لأبني معهم مجتمعًا بدون عزلة وعزلة بدون منفى؟”.
في الواقع، صاغ العديد من المفكرين في القرن الماضي تشخيصاتهم للعالم المعاصر في مفردات البُعد والقرب، تحت رعاية إعلان بارت “نحتاج إلى علم، أو ربما إلى فن التباعد”، تنفتح منطقة فكرية حيث قد نجد بعض الاتجاهات المفيدة الآن بعد أن تعطل ما نعتبره عادةً أمرًا مفروغًا منه على أنه حياتنا اليومية.
****
اعترف بارت في محاضرته الافتتاحية أن مقرره الدراسي مستمد من خيال شخصي: يعيش من ثمانية إلى عشرة أفراد معًا في مجتمع صغير بما يكفي للسماح بالاتصالات الشخصية واحترام خصوصية كل فرد، ولكنه أيضًا كبير بما يكفي ليكون متنوعًا وممتعًا. يتجنب بارت مصطلح “المجتمع”، ويفضل التحدث عن “العيش معًا في جماعة” (أي vivre-group)، والتي غالبًا ما تكون مكتوبة بحروف كبيرة، ما يهمه:
“ليس من هو الداخل ومن هو الخارج، ولكن كيف يقوم الأفراد المعنيون بمعايرة المسافة التي تفصلهم عن بعضهم البعض؛ ليس مرة واحدة وإلى الأبد، بل من لحظة إلى لحظة”.
تمتد هذه المدينة الفاضلة إلى عالمين متقاطعين من التجربة الإنسانية: الصداقة والمجتمع، حيث تؤثر مشكلة التباعد على مسائل الاجتماع والقيم والأساطير التأسيسية ومفاهيم الهوية والاختلاف. بالنسبة للجزء الأكبر، وضعَ التقليد الفلسفي الغربي الصداقة في قلب الحياة السعيدة، حيث يُعتبر تشابه الاهتمامات والعادات والقيم مهمًا لأفراد أي جماعة.
ومع ذلك، فإنّ المقولة المتناقضة لأرسطو -يا أصدقائي، لا يوجد أصدقاء!- تسلِّط الضوء على المطالب المستحيلة للصداقة الأصيلة، وحقيقة أنّها ربما لا يمكن أن توجد إلا كمثالية في أفق تفاعلاتنا الاجتماعية. بالنسبة إلى رالف والدو إيمرسون، يجب أن يظل الصديق روحًا محصورة على مسافة ما، و”إلى الأبد يظل نوعًا من العدو الحميم، لا يمكن ترويضه، وهو موقر بإخلاص، وفي نفس الوقت ليس وسيلة ترفيه تافهة يتمُّ تجاوزها قريبًا والتخلص منها”.
بمعنى آخر، لا توجد صداقة حقيقية دون أن تكون هناك مسافة وانفصال. يجب ألا تكون صديقتي قريبة مني لدرجة أنها لا تستطيع الإشارة إلى إخفاقاتي؛ ولا يمكنني أن أكون مرتبطًا جدًا بما لدينا من قواسم مشتركة (وصورتي المنعكسة في تلك السّمات المشتركة) لدرجة أنني لا أستطيع تغيير طرقي وأصبح نسخة أفضل من نفسي.
دفع نيتشه -وهو قارئ لإيمرسون- هذا المنطق إلى أبعد من ذلك. في المقاطع التي تردد صدى تصوير الفيلسوف الأمريكي للصديق المثالي على أنّه “عدوٌ جميل”، يذهب نيتشه على لسان “زرادشت” إلى حد إدانة حب الجار الذي أشادت به الأخلاق المسيحية باعتباره “حبًا ضارًا” على النفس. بل ينصحُ بدلاً من ذلك بـ “حب الأبعد”، فبدلاً من تنمية الروابط مع أولئك الأقرب إلينا، يجب أن نبحث عن روابط مع أولئك المختلفين عنا، أولئك الذين يمكنهم مساعدتنا في توسيع آفاقنا.
وهكذا يدير نيتشه ظهره لتقليد كامل من التفكير في المجتمع الذي يقدِّر التاريخ المشترك، وأساطير الأصل والطقوس المشتركة، ويلقي باللّوم على الأخلاق اليهودية المسيحية لتشجيعها على تنمية “عقلية القطيع” التي أنكرت تنوع أشكال الحياة. فبدلاً من الالتزام المطلق بالقواعد والتوقعات التي تحاصرنا في مجتمع من الأفراد المتشابهين في التفكير، يجب على المرء أن يبحث عن تلك المنطقة التي يمكن أن تكون فيها المواجهات الصعبة والمفاجئة ممكنة. يُذكِّر نيتشه القراء بأنّ كل العصور القوية كانت تزرع “حب التَباعد”.
قد يبدو هذا وكأنه وصفة للفردانية والفوضى. من المؤكد أن هناك أشكالًا للحياة أكثر قيمة أو أهمية من غيرها، ولا يحتاج البعض منا إلى ركيزة النظم الأخلاقية لمساعدتنا في مقاومة أسوء دوافعنا؟ أليس من صميم بشريتنا أن تربطنا عاطفة قوية بالمقربين إلينا؟ ومع ذلك، فقد اتبعت الكثير من فلسفة القرن الماضي مسار نيتشه، مما أدى إلى نقد لا هوادة فيه لـ “مجتمع التقارب”، الذي يُفهم تاريخيًا على أنّه مجموعة من الأشخاص يعيشون معًا في مساحة محدودة، حيث يشغلون مكانًا ودورًا في التسلسل الهرمي الاجتماعي.
المفارقة هي أنّ ‹‹مجتمعات التقارب›› تتأثر بنوع مقلق من التباعد، على وجه التحديد؛ لأنّها تستند إلى حوادث الحياة التي تجبر أعضاءها على تقييم أنفسهم من خلال المقارنة مع الآخرين. في كتابه “الكينونة والزمان”، يشير مارتن هايدجر إلى هذا الجانب بمصطلح “البُعد” (Abständigkeit): الاهتمام المزعج بكيفية اختلاف المرء عن الآخرين، والذي يتجلّى في “المراقبة الغامضة لبعضنا البعض، والاستماع السِّري والمتبادل”، والعداء بدلاً من حب الخير للآخر.
ردّد كانيتي هذا الفكر في بداية ‹‹الحشود والسلطة›› ببديهية: “كل الحياة… مبنية على التباعد، المنزل الذي يغلق فيه [الرجل] بابه على نَفسِه ومُمتلكاته، والمناصب التي يشغلها، والمرتبة التي يرغب فيها، كل هذه تعمل على إنشاء مسافات وتأكيدها وتمديدها”.
نظرًا لأنّ هذه العادات عالقة وسط أشغال الحياة، فقد تظل غير مفحوصة. ولكن ماذا عن موقف مثل وضعنا؟ عندما نكون في حالة ابتعاد عن التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، والمواجهات المخطط لها وغير الملزمة، هل نحن أقرب إلى حياة الأصالة؟ أو إذا وضعنا جانبًا -كتدريب فكري- مجتمعًا كالذي نعرفه، فكيف سيبدو البديل؟
في صحبة بارت وغيره من المفكرين الذين استثمروا في هذه المشكلة، يصبح سؤال المجتمع: ما الطريقة الأخلاقية للتواصُل مع الآخرين؟ وماذا يحدث عندما نجد أنفسنا في عزلة؟ نحن لا نفكر فقط في بعدنا عن الآخرين، ولكن أيضًا بالمسافات داخل أنفسنا.
[1] – المقطع من رواية (بينما أرقد محتضرة). -الإشراف.