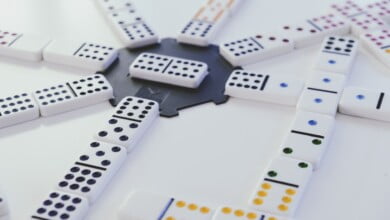- دانييل لوبيز
- ترجمة: هديل أسامة
- تحرير: ريم الطيار
وُلد جورج زيمل عام 1858م في قلب العاصمة برلين، حيث لخّصت تلك المدينة مخاض ألمانيا في طريقها الفريد نحو الحداثة، دفع كل من التحضر المتسارع والمضاربة المالية ببرلين إلى أن تتبوأ منصبها على خشبة المسرح العالميّ، كما ازدهرت نخبة ثقافية طليعيّة بشيءٍ من القلق بجانب الطبقة الأرستقراطية في أوروبا الوسطى، في حينما كانت الطبقة البروليتارية الشابة تحارب كل من الولاية والطبقة البرجوازية لنيل حقوقها السياسيّة والاقتصاديّة.
إن انتشار التقنيات الحديثة أدّى إلى إنتاج السلطة والثروة في حين أدّى إلى تقهقر سلالة يونكرز مُلّاك الأراضي النبلاء في بروسيا، التي ينحدر منها الأمير بيزمارك أمير الإمبراطورية الألمانية الموحّدة، تولّت سلالة هوهنتسولرن الملكيّة – التي تُعد من أقدم السلالات في أوروبا – الحكم على إمبراطورية متقلّبة ومخمورة بأحدث الأفكار.
تلقى زيمل تعليمه في جامعة برلين التي كانت مُشبعةً بالروح النقدية التأريخية للكانطية الجديدة، ولكنّه وجد صعوبةً في الانسجام مع ثقافة ألمانيا الأكاديمية؛ إذ فشلت أطروحته الأولى حول علم الموسيقى العرقي بوصفها غاية في ” التخمينية، الحِكمية والإهمال الأسلوبي”. على الرغم من أنه نال درجة الدكتوراه عام 1881م ودرجة التأهل للأستاذية عام 1885م، ربما كان مُمتَحِنوه على حق؛ إذ إنّ مقالاته المنشورة كثيراً ما تجاهلت المصادر واستنكرت ضيق الأفق الأكاديمي، كما كتب غوستاف فون شمولر أحد معاصري زيمل واصفاً أسلوبه: إنه يُؤْثِر أن يُقدِّم مزيداً من الكافيار على أن يقدّم خبزاً أسود، وأن يستضيء بالألعاب النارية على أن يستعين بمصباح قراءةٍ.
بفقدانه حسّ الانتماء إلى الأطروحات العلميّة، التصنيف والدراسات أحاديّة الموضوع، كان زيمل كاتب مقالاتٍ في المقام الأول، كتب ندّه العالم الألماني تيودور أدورنو متحدثاً عن بنية المقال، مستحضراً زيمل: إنّه لا يدع مجاله يُحدد نيابةً عنه.
إنّ المقال لا يلعب بالقواعد المنّظمة للعلم والنظرية… عوضاً عن صياغة نسقٍ شاملٍ، فإن المقالات غالباً ما تشير برفقٍ إلى المعاني المُضمَرة وإلى الترابط الفينومينولوجي، يشبه انطباع ذلك إنارة كليّة مؤقتة سرعان ما تتلاشى، مما يجعل المرء يشعر بأنه ما زالت هناك مساحةً للمزيد من الاكتشاف، شريطة أن يكون هناك وميض آخر من الإشراقٍ. تستهلّ مقالة زيمل “المتروبوليس والحياة العقليّة” (1903م) بـ:
أعمق مشاكل الحياة الحديثة تنشأ من مطالبة الفرد بالحفاظ على استقلاليته وفرديّة وجوده في مواجهة كلٍ من ضغوطات الحياة الساحقة، الموروث التاريخيّ، الثقافة الخارجية وتقنية الحياة.
يُؤسس زيمل بنية تحقيقاتٍ ثريّة دون أيّ عناءٍ. علاوةً على ذلك، نحن لا نسمع ببساطة عن الفرد بصفةٍ عامةٍ، ولكن عن ذلك الفرد الذي عانى ليجد مكاناً في عالمٍ يتسم بالعدوانية. أحبّ زيمل عالمه رغماً عن ذلك. يقول: “ربما كان بإمكاني أيضاً تحقيق شيءٍ ذي قيمة في مدينة أخرى”، وأشار لاحقاً، “لكنّ هذا الإنجاز بالتحديد، والذي في واقع الأمر أجني ثماره في هذه العقود، دون شكٍ مرتبط مع بيئة وسياق برلين”، لهذا السبب وجدت برلين وعيها الذاتيّ في مقالاته.
يركز تحليل (المتروبوليس والحياة العقلية) على شكلين اجتماعيين متداخلين: المال والمدينة، كلما يزدادان هيمنةً فإنهما يقومان بتقويض التناغم الطبيعي للإنتاج والعلاقات الاجتماعيّة التقليديّة.
إنّ هذا مُحرّر؛ فالمال لا يهتم بالحقِّ الطّبيعيّ، إنه يهتم فقط بما هو معلوم لدى الجميع مطالبتِه بالقيمةٍ التبادليّةٍ، مع ذلك توجد قيمة خفية؛ أنّ المال يختزل ما هو ذو قيمة فريدة إلى رقم، سعر.
وبالنسبة الصحيحة فإنّ السلع الجيّدة المصنوعة يدوياً تساوي الخردة ذات الإنتاج الضخم. هذا يقلل من قيمة السلع – إذ أنّ لا شيء يمكن شراؤه فريدٌ من نوعه – علاوةً على تسريع البحث عن كل ما هو فريد بحقٍ وذو قيمة لا تُضاهى.
تسرّع المدينة منطق المال المحسوب، متعديةً حتّى على تجربتنا مع الزمن، كما كتب زيمل:
إذا حدث خطأ مفاجئ في توقيت جميع ساعات برلين بمختلف الطرق، حتى ولو بساعةٍ واحدةٍ فقط، ستتعطّل الحياة الاقتصادية، والاتصالات في المدينة لوقتٍ طويلٍ.
لم يعد الوقت محكوماً بالمواسم أو الأجرام السماوية، بل أصبح مُجرداً وموزوناً، كما أنّ المدينة تُضيِّق مفهوم المكان اجتماعياً وجغرافياً.
وأصبحت شتّى الطبقات؛ الشرائح، الثقافات، المجموعات اللغوية، والمهن على أبعادٍ متقاربة، لهذا السبب كما لاحظ زيمل، وقَف الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه ضد المدينة بشدّة؛ إذ إن المدينة هددت بتحويل فردانيّته النبيلة إلى “مجرد كتلة من الذرات”، ومع أنّ زيمل كان قارئاً عميقاً لنتيشه وشاركهُ انجذابه الرومانسي نحو (التتابع اللانهائي للتناقضات)، فقد ابتعد عن الراديكاليّة الأرستقراطيّة للأخير بدلاّ من البحث عن التطرف في جبال سيلس ماريا، وجده زيمل في حشد المدينة، حيث يمكن للمرء أن يشعر بالوحدة الاستثنائية للعصر الحديث عبر المرور بآلاف الوجوه دون تمييز صديقٍ واحد.
أبرزت قمم ووديان نيتشه أعالي نبيلة وأعماق دنيئة، لكن بدلاً عن ذلك قامت مدينة زيمل بصقل مواطنين[1] لا مباليين blasé، يخافون من أن يتّم تصنيفهم، ويميّزون أنفسهم بالتجاهل البارد الخارجي.
كان الصالون الأدبي الذي يرعاه حول منزله لا يقل أهمية لعمله عن المكتبة:
بخيبة الأمل الناتجة عن عدم تحقيق شهرة وإثارة في حياته، اقترح زيمل أن يبحث الأفراد اللامباليين عن الفضيلة في آخر ملاذٍ لهم (الشخصيّة).
يميل الإنسان إلى تبنّي الخصائص الأكثر تحيّزاً، وذلك على وجه التحديد هو الإسراف الحضريّ في التصنّع، النزوة، النَفاسَة… معنى هذا الإسراف [يكمن] في تصوره عن فكرة “أن تكون مختلفا ً”، في البروز بطريقةٍ لافتةٍ للنظر وبالتالي جذْب الانتباه.
يعرف زيمل أمثال هذه الشخصيّات جيّداً نظراً لترددهم المنتظم لتناول العشاء، وكان الصالون الأدبيّ الذي يرعاه حول منزله مع زوجته، غيرترود، لا يقل أهمية لعمله عن المكتبة. كتبت مارغريت سوسمان، ضيفةٌ منتظمةُ لدى أسرة زيمل:
كانت الأيام الأسبوعيّة… عالَماً اجتماعياً مُصغّراً: إذ كانت تتّسم بالمؤانسةِ التي تكمن أهميتها في التثقّف من الأشخاص ذوي المراتب العليا، هنا تحلّق المحادثة في جو من الّتعقل، الود واللباقة، مستقلة عن العبء الأبديّ للعنصر الشخصي.
ولم يشارك في هذه المناسبات الاجتماعية سوى أشخاصٍ استثنائيين تميّزوا بالذكاء أو بالجمال حتى.
كان من بين ضيوف زيمل ستيفان جورج، شاعر الحركة الرمزيّة، ولو أندرياس سالومي، محللة نّفسية، كاتبة، وفي ذات يومٍ قرّة عين نيتشه. في مقابل رعايتهم، وجّه زيمل المرآة نحو هذه النخبة الثقافيّة. حظيت محاضراته العامة بالإشادة، وجذبت الأفضل من النخبة الفكرية في أوروبا الوسطى. ولفترة وجيزة قبل الحرب العالمية الأولى، أشخاص متنوعون مثل ليون تروتسكي، سيغفريد كراكاور، كارل مانهايم، جورج لوكاش، كارل ياسبرز وإميل لاسك أثنوا ركبهم عند محاضرات زيمل.
كان تأثيره الدوليّ يعادل بلا ريب تأثير معاصريْه، إميل دوركهايم وماكس فيبر، إذ وجد جمهوراً في شيكاغو في وقتٍ مبكرٍ من عام 1890م، ومع ذلك فقد حُرم على الدوام من الترقية الأكاديميّة، بما أنّ والده توفي عندما كان صغيراً، عُيّن له وصيّ امتلك دار نشر موسيقية وترك لزيمل ميراثاً كبيراً الذي أدّى إلى تأمين سعيه الفكريّ ماليّاً، ظلّ من عام 1885م إلى عام 1900م محاضراً خاصاً، وهو المحاضر الذي تعتمد أجرته على مقدرته على جذب الطلاب، بما أنّ المال لا يُميّز، فكذلك زيمل – إذ رحّب بالنساء كضيوفٍ في محاضراته، وفي هذا انتهاك للاتفاقيات المتزامنة، خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، وعلى الرغم من قوانين عهد بيزمارك المعادية للاشتراكيّة، انضم زيمل إلى الأوساط الاشتراكيّة، بل وحتّى نشر في الصحيفة التابعة بهم، صحيفة فورفرتس، وحقيقة أنّه تحرّك في الدوائر الخاطئة وجذب الطلاب الخاطئين أضافت عوائقاً أمام تقدّمه الأكاديمي.
في نهاية المطاف تمّت ترقيته عام 1898م إلى رتبة أستاذ مساعد، وهي درجة غير شائعة لـ “بروفيسور من غير كرسيّ”، إذ أنّه يؤجر بنصف المعدل.
كما حرم هذا زيمل حقّ الإشراف على طلبة الدكتوراه، ربما كان يتصور أنّ كتاب فلسفة المال (1900م) أعظم إبداعاته، من شأنها أن تُبرهن بشكلٍ نهائيّ على أهلّيته لنيل رتبة الأستاذية الكاملة.
إذا أمعنتَ النظر في ورقة 100 مارك – العملة الألمانية عام 1908م -والتي صدرت بعد عامٍ واحدٍ من نشر الطبعة المنقّحة لكتاب فلسفة المال – فستجدها مُسْفرةً عن الكثير من الزلل، تنجذب العين أولاً إلى الـ‘100‘، ثم إلى الأرقام التسلسليّة الحمراء وإلى ختم مديريّة البنك. وبينها توجد تواقيع، يُتأرجح أعلاها تاريخ الإصدار، وضمانات الموثوقيّة – وبطبيعة الحال – أحرف سوداء بخطٍ قوطيٍّ دقيقٍ، مشيرةً مرةً أخرى إلى قيمة الورقة النقديّة، والتماثيل التي تختلف تماماً عن الزخارف التّنويرية الموجودة على الأوراق النقديّة الفرنسية أو الأمريكية، ملمّحةً إلى النزعة الرومانسية القوميّة في ألمانيا.
على ظهر الورقة يتبدّى تجسيدٌ أنثويٌّ للإمبراطورية الألمانية، مدججةً بالسلاح لكنها في حالةٍ من السلام، تجلسُ متوسطةً رموزاً من الثقافة، العلوم والصناعة، تنتصب خلفها أشجار بلوط عتيقة ورمز يُمثل[2] دونار (المقابل الألماني[3] لثور)، ويمر في الأفق موكب من السفن الحربية التي تعمل بالفحم.
تمزج هذه الجماليات بين المجرّد والماديّ؛ فعلى جانب واحد توجد قيمة عدديّة، وعلى الجانب الآخر توجد رسومات إيضاحيّة لثروةِ الأمة وفضائلها، وفيما بينهما ضمانات قانونيّة عديمة الجدوى وشبه سحريّة، كل هذا كما ينبغي أن يكون عليه.
إنّ المال كائن اجتماعي فريدٌ من نوعه، عديم الجدوى في حد ذاته لكنه مُنِحَ القوة بوساطة البنك الدولي ودُعِّمَ (في أيامنا هذه) بالذهب.
يستطيع المال معادلة مختلف البضائع المادية كالأدوية، والسلع الصناعية، أو حتى الملذات الثقافية (أو الاحتفالات المشابهة لطقوس الإله ديونيسوس[4])، ويمكن للمرء توقُع قيمة سعره هذه السلع بما يعادل قيمة تذكرة حضور أوبرا خاتم فاغنر بمدينة بايرويت.
إنّ المال لا شيء ومع ذلك فإنه يسيل في كلّ مكان ويتوسط بين كل شيء؛ تماشياً مع هذا الوضع الغامض المتجاوز إلى حدٍ ما، مزج زيمل في أسلوبه بين الجماليّات والفلسفة، وأوضح أنّ “الميزة الكبرى للفن على الفلسفة” هي أنّه:
يعيّن لنفسه في كل مرة قضيةً واحدةً محددةً بدقةٍ: شخصاً، منظراً طبيعيأً، مزاجاً.
كل امتداد لأحد هؤلاء إلى العامة، كل إضافة للمسات جريئة من العاطفة إلى العالم، قد تمّ صُنعها لتبدو كإثراءً، كهديّةً، كمنفعةً غير مستحقة.
أما من جانب الفلسفة فإنها تتطلّب أن يخضع هذا الاستدلال الجمالي إلى “التبادليّة اللانهائية” للعقل، والنتيجة هي فلسفة مال تتسم بالانتقاديّة على وجه التحديد لكونها صادقة ًحول بنيتها الجمالية والذاتية، وعدم اكتمالها الحتمي.
“بالنسبة للإنسان الذي يسعى دائماً، ولا يرضى أبداً، وفي تحول مستمر، الحب هو الحالة الإنسانية الحقيقية“.
يتمحور عمل زيمل حول تصور مفهوم التبادل، وهو فعل بين طرفين يُنتج قيمةً، ‘مصطلح ثالث، مفهوم مثاليّ يدخل في الثنائية ولا يُختزل فيها‘. وعدم الاختزال هذا هو السبب في أن القيمة -متمثلةً في المال بإمكانها أن تأخذ حياة خاصة بها، والتي يصفها زيمل بأنّها ‘تجسيد للتبادل بين الناس، وتجسيم للوظيفة المجردة‘، بالطبع لم يقل أحد أن التبادل سيكون عادلاً على الدوام: فكما يعلم قطّاع الطرق وشركات التأمين الصحي، سيدفع المرء أيّ ثمن مقابل أن يعيش. لكن مع انتشار عمليات التبادل، تُمنطق العملات والأسعار القيمة وتعايرها.
إن المال كنهر هيرقليطس يجري باستمرار بينما يبقى على حاله، ولأنه لا يطمح إلى تحقيق هدفٍ يتجاوز تداوله، فإنه يُدلل على قيم غير اقتصادية، لكن مع نمو السوق، تطول “سلسلة المعاملات الغائية”، مما يجعل الأهداف غير المالية أكثر بعداً وأثمن قيمةً، خذ الحب على سبيل المثال عندما نصبح أكثر جهلاً وتباعداً عن بعضنا بعضا، فإن الحب – الذي يتوق للتغلب على المسافة بين الذات والمحبوب – يزدهر كما قال زيمل: “بالنسبة للإنسان الذي يسعى دائماً، ولا يرضى أبداً، وفي تحول مستمر، الحب هو الحالة الإنسانية الحقيقية”. وهذا أيضاً كما أشار في مقالته عن البغاء، هو السبب في أن المال يستطيع شراء الجنس – ولكنه لا يستطيع شراء الحب.
من خلال اختزال الوقت إلى قيمةٍ قابلةٍ للقياس – على سبيل المثال، الأجر بالساعة – يخلق المال شعور التوق إلى قضاء وقتٍ ذي جودة.
يمكن أن يكون هذا الوقت ليلة في الخارج، أو عطلة، أو مدةً تشعر فيها بالساعات وكأنها ثواني، والتي يمضي الوقت فيها سريعاً أو التي ينسى المرء فيها الوقت ببساطة، كما يقول زيمل في مقالته بعنوان “المغامرة”، المغامِر هو الشخص الذي يُصمم حياته حول قضاء وقتٍ ذي جودة.
قد يبدو أن المغامِر قد وُهب مهارةً – ولكنه ببساطة يُجمِّل الحظ الأعمى اللامبالي، مانحاً لحياة كهذه مساحةً للإمكانيّة.
لذا دائماً ما تنتهي المغامرة بالفشل أو التقاعد (وهما وجهان لنفس العملة)، والرومانسية -التي تعهد بجعل الوقت اليوميّ المعتاد جميلاً، هي وسيلة فرار المغامر الحقيقيّة.
لم يمجّد زيمل الاقتصاد النقديّ، ولم يقتصر على ربطه بالتحرر من السحر فقط، بل كان على وعيٍ بضحاياه مع نمو الاقتصاد، “يظلّ المعدل الأكبر من إنسان التحضّر مُستعبداً للأبد، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في الاهتمام بالتكنلوجيا”.
في هذه الفقرات يمكننا رؤية تأثير كارل ماركس على زيمل، وتأثير زيمل على لوكاش ومارتن هايدغر، بينما تفادى زيمل السياسة الراديكاليّة المرتبطة بهذين الاثنين، تزداد أنماط شخصيته راديكالية على سبيل المثال، يتحدث زيمل عن[5] الكلبيّ المعاصر، المسحور بمعرفة أنّ المال بإمكانه خفض أعلى المستويات وأدناها إلى الشكل الأساسي نفسه:
بناءً على ذلك فإن حاضنات التشاؤميّة هي تلك الأماكن التي تشهد دوراناً ضخماً لرأس المال، متمثلةً في صفقات أسواق الأسهم، حيث يتوفر المال بكمياتٍ مهولة ويتبدل مالكوه بكل يسر.
وبروحٍ خائرة القوى، أقنع المتشائمون أنفسهم بأنّ استهلاك المواد الخام وتبادلها هي الحقيقة الوحيدة.
كلّ متشائم هو عاشقٌ مرفوض، في المقابل الشخص الذي ينظر بمنظار اللامبالاة يعلم أنه من الأفضل أن يكون قد أحب وفقد الحب، وفي اللحظة التي يبدو فيها الحب ممكناً مرةً أخرى، يكون blasé على بعد خطوة واحدة من التخلي عن فتوره والتحول لنقيض المتشائم: المتحمس المتفائل.
يدافع زيمل في كتاب فلسفة المال عن النسبيّة المطلقة، وهذا يطابق المنطق العام لمذهب الكانطية الجديدة، التي بعد أن تم إحراقها بانهيار المثاليّة الهيجليّة المطلقة في منتصف القرن التاسع عشر، ركّزت على صلاحيّة الحقائق المعيّنة المحدودة على كل حالٍ، في حين أن طائرَ سنونو واحد لا يدل على دخول فصل الربيع، إلا أنّ عبارةً حقيقيّةً واحدةً تستلزم سلسلةً من المعاني والافتراضات، والاقتراحات التابعة لها.
ولكشف هذه السلسة اللانهائية من الحقائق بشكلٍ نهائيّ، سيكون من الضروريّ الإلمام بالكُلّيّ – وهو موضوع واسع جداً – أو الغوص إلى الجذور، أيْ إلى الحقائق الجوهريّة التي تتفرع منها جميع الحقائق، على الرغم من أنّ هذا ينطوي على مخاطر الاختزاليّة، رفض زيمل كلا الاستراتيجيتين.
بدلاً عن ذلك، خلص إلى أنّ “الحقيقة صالحة منطقيّاً، ليس على الرغم من أنّها نسبيّة ولكن بسبب ذلك على وجه التحديد”.
رأى زيمل أن بحث الفرد عن الحقيقة سيبوء بالفشل حتمياً، كاشفاً عن كون هذا الطريق دائريّ بشكلٍ مهلِك، ليشبه بذلك حركة المال، لذا تعيّن على النسبيّة – مذهب التقلب المستمر – أن تكون المطلق الوحيد القابل للتطبيق.
يطرح زيمل هذا على أنه مُحرِّر: “سيتم الآن مصادرة المصادرين، كما قال ماركس عن عملية مماثلة في الشكل -ولن يبقى شيءٌ سوى التفكك النسبيّ للأشياء إلى علاقات وعمليات”، لكن ثمة أيضاً عنصر تراجيدي هنا؛ أن نحبَّ الحقيقة يعني أن نحبَّ شيئاً نشعر أنّه من واجبنا البحث عنه، بالرغم من أنّه يظلّ دائماً بعيد المنال، مثل بطل هيرمان هسه في روايته ذئب البراري (1927)، طارد زيمل مطلقاً مراوغاً.
كما استمر في التقدّم بطلب الحصول على درجة الأستاذيّة، وتمَّ الإثناء على طلبه بالحصول على منصب الكرسي الثاني للفلسفة بجامعة هايدلبرغ على نطاقٍ واسعٍ من قِبل قسم كلية الفلسفة، ولكن في نهاية المطاف رُفض بحجة أنّ خبرة زيمل اقتصرت على علم الاجتماع، وبالتالي كان اختصاصه الفلسفي هامشياً وغير موثوق به.
لم تكن هذه سوى نصف القصة: إذ لمّح تقرير أُعّد لوزير التعليم بولاية بادن لأسبابٍ أعمق. وصف مُعده أنّ زيمل “إسرائيليّ عن ظهر قلب”.
كانت عائلة زيمل قد تحولت من اليهودية إلى المسيحية، واتّبع زيمل عقيدة أمه اللوثرية، غير أنّ هذا لم يكن حول الدين: فمنذ أواخر القرن التاسع عشر حوّل حكام فترة *فيلهلم الأول والثاني المعادين للساميّة اليهودية إلى تصنيفٍ عرقيّ في مفارقة قاسية، فهِمَ زيمل معاداة السامية أفضل من العديد من المعاصرين؛ إذ إنّ مقالته “الغريب” ما زالت نموذجاً متبعاً. وفي مفارقةٍ أقسى، سلّحت العبارات المجازيّة المعادية للساميّة الأشكال الاجتماعية والثقافية التي دعمتها: الاقتصاد النقدي، المدينة العالميّة، الطليعة الثائرة، ومزيج القرب والبعد عن الثقافة الألمانية المميّز للمجتمع اليهودي. والأقسى من كلّ هذا، كانت المعاداة للساميّة أحد أعراض مرضٍ كامنٍ هو: الأزمة الحضاريّة.
تخيلّ شجرةً زُرعت من مخزونٍ بريٍّ على مر السنين لتُنتج بوفرةٍ ثماراً جيّدةً، والآن قارنها مع صارية سفينة مصنوعة من نفس الشجرة، تم تحويل هذه الأخيرة كلياً، وهي منتوج عقلٍ أداتيّ في المقابل، في حين أنّ ثمار الشجرة لم يكن باستطاعتها أن تُنتج دون تقنيّة الإنسان، فإن منتجها “ينبثق في نهاية المطاف من القوى الدافعة الخاصة بالشجرة، ولا يُحقق سوى الاحتمالات التي حُددت في توجهاتها”، تم صنع الصارية عن طريق تدمير شجرةٍ لغرض ٍخارجيٍ، بينما زُرعت الشجرة المثمرة وفقاً لنوعٍ من الأسباب القادرة على إدراك الطبيعة كقيمةٍ في حد ذاتها.
القديس الزاهد هو ثائرٌ يرى العالم يحترق من أجل وعد الوحدة المستقبليّة
هذه هي الاستعارة المحورية في مقالة زيمل “مفهوم الثقافة ومأساتها”، حيث ينظر إلى الثقافة نظرةً أرسطيّة: نحن نشبه الأشجار في أنّ الحياة الإنسانيّة تحتاج إلى الرعاية والتثقيف لكي تزدهر، ومع ذلك كما لاحظ زيمل، كلّما نمت الثقافة كلّما تبلورت وأصبحت متشظّية ومتخصصة وغير صالحة للتنمية؛ وكلّما تنمو شجرتنا تُصبح ثمارنا أصغر حجماً، وأقل وفرةً، وأصعب في الحصول عليها، وأقل تغذيةً لنا؛ إذا كانت الثقافة لا تستطيع تغذيتنا روحياّ فإنها تخاطر بذبولها، فالثقافة لا تحيا سوى لأننا نرعاها وترعانا هي.
يحدّد زيمل نوعين آخرين من الشخصيات البديلة التي تبرز استجابةً لهذه المسألة. الأولى هي شخصية “القديس الزاهد” الذي يرفض التخصصيّة، ويحاول بدلاً عن ذلك الحفاظ على الوحدة الروحية عبر رفض الثقافة[6] كلياً، وإلى الحد الأقصى، فالقديس الزاهد هو ثائرٌ يرى العالم يحترق من أجل وعد الوحدة المستقبليّة؛ لأن أمثال هذه الشخصيات ترفض الثقافة ككل، وجب أن يكون عدوها شاملاً – مثل طبقةٍ اجتماعيةٍ أو نظام.
يستحضر المرء شخصيةً في رواية الجبل السحري لتوماس مان: هي شخصية ليو نافته، العدميّ الغريب الهجين بين التقليد اليهوديّ، اليسوعيّة والماركسيّة. يُصّرح مشمئزاً من الليبرالية التنويرية بأنّ “الحرية، وإنماء الفرد ليسا مفتاح عصرنا، هما ليس ما يحتاجه عصرنا، إنّ ما يحتاجه، ما يكافح من أجله، ما سوف ينتجه هو – الإرهاب”.
الشخصيّة المقابلة هي “المتعصب المتخصص” الذي تم تشويهه وتجريده من إنسانيته بسبب الجزء المحدود من الثقافة الذي تخصص فيه، ولكي يجد مكاناً في كلٍ متجزئٍ، فهو يُجزأ نفسه، ويقود هذا النهج أيضاً إلى رغبة لاعقلانية في إنقاذ الحياة من الثقافة فقط؛ لأن المتخصصين هم من لديهم مكان، فإنّ نهجهم لا يُفضي إلى الرضوخ إلى كلٍ أخرويٍّ روحانيّ، ولكن إلى شغفٍ بالنضال القوي الذي ربما يُنعش ثقافتهم، ولذلك لا يجب تحويل المجتمع بأسْره إلى عدو ما يلزم بدلاً عن ذلك، هو كبش فداءٍ معين للمرض الثقافي الذي يضمره المتعصب المتخصص.
وقد قاد هذا الاتجاه إلى اليمين السياسي، الذي صنّف الأجانب ولا سيما اليهود على أنّهم أعداء.
بالرغم من أنّ زيمل لم يؤيّد معاداة السامية إطلاقاً، فقد كان مفتوناً بمعتقد التجديد الوطنيّ المرتبط بهذه الحركة، اختتم قائلاً:
لكن هذا هو المصير الحقيقيّ للحياة، لكون الحياة كفاحاً بالمعنى المطلق الذي يتجاوز التمييز النسبي بين الكفاح والسلام، في حين أنّ السلام المطلق والذي يتجاوز هذا التمييز أيضاّ يظل لغزاً إلهياً.
يشير ذِكر السلام المطلق – إضافةً إلى تركِ طريق الهروب في اللحظة الأخيرة – إلى أنّ زيمل أصبح منهكاً، تزامن ذلك مع أتعس وآخر فترة من حياته في عام 1914م، تم تعيينه أخيراً كرئيسٍ لقسم الفلسفة في جامعة لويس باستور في فرنسا، وغادر زيمل برلين على مضضٍ، وبعد فصلٍ واحدٍ فقط من التدريس اندلعت الحرب.
اُقتيد زيمل وراء النزعة العسكريّة الوطنيّة بشكلٍ من الانزعاج، كتب في لحظةٍ غاية في الرقة:
أنا أحب ألمانيا، ولهذا أريدها أن تعيش – فلتذهب إلى الجحيم جميع التبريرات “الموضوعيّة” لهذه الإرادة فيما يخص الثقافة، الأخلاق، التاريخ وأي شيء آخر.
ويخمّن معظم المعلّقين أنّ زيمل كان مدفوعاً برغبةٍ لحظيةٍ يائسةٍ لنيل الاعتراف والاستقرار، فبدلاً من اللحن الحزين لأعماله المبكّرة، ربما وجد عظمةً عابرةً في اللحن المبهج لنشيد الإمبراطوريّة الوطنيّ، أيّاً كانت الحالة، شعرَ تلميذه سابقاً إرنست بلوخ بعد حضوره محاضرةً مؤيدة للحرب ألقاها زيمل بالاضطرار لكتابة رسالةٍ لم تُرسل قط، كتب: “لقد تفاديتَ الحقيقة طوال حياتك … والآن تعثر على المطلق في الخنادق”.
في السابع من نوفمبر عام 1917م، ألقى عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر محاضرةً بعنوان (عملُ العالِم) (عادةً ما تُترجم إلى “العلم كمهنة”) في جامعة ميونخ، تحدّث في قاعة محاضراتٍ صغيرةٍ لجمهور تم حشده بواسطة جمعيّة الطلّاب اليساريين الأحرار، ومع تبقي سنةٍ ويومين على اندلاع ثورة نوفمبر التي أوقفت الحرب وأنهت حكم سلالة هوهنتسولرن، كان جمهور فيبر مدركاً تماماً للوضع المتردّي والأخطار المحدقة بأحلامهم في امتهان مهنةٍ أكاديميّة، يقول فيبر مبيّناً:
بل يجب على المرء أن يسأل كلّ امرئ آخر: هل تعتقد بكامل الوعيّ أنّه يمكنك تحمّل رؤية الرداءة تتبعها الرداءة، سنةً بعد سنةٍ، دون أن تشعر بالمرارة ودون أن تصيبك الحسرة؟ بطبيعة الحال، يتلقّى المرء هذا الجواب: بالتأكيد أستطيع، فأنا أعيش فقط من أجل “شغفي”. ومع ذلك، فقد اكتشفتُ أنّه لا يمكن سوى لعددٍ قليلٍ من الأشخاص تحمّل هذا الوضع دون أن تصيبه الحسرة.
وبلا شك كان فيبر يستحضر صديقه زيمل كأحد هؤلاء القلة.
مع مرور الوقت، تراجع تأييد زيمل للحرب، وأثار موت صديقيه الفيلسوفين لاسك وفيلهلم ويندلباند أزمةً إيمانيّةً عنده، تخلى زيمل عن اتباعه لكنيسة أمه، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستقلال الديني، وبنهاية الحرب كان قد انطوى على نفسه في منزلٍ يقع في الغابة السوداء، قبل وقت قصير من إصابته بسرطان الكبد الذي أودى بحياته، أثمرت شجرة زيمل ثمرتها الأخيرة والأكثر فلسفيّة.
في كتابه الأخير “نظرةُ الحياةِ”، تخلى زيمل عن نسبيّته السابقة لصالح فلسفةِ الحياة. إذ قدّمت الحياة إرشاداً أحدث وأثرى لاح كلٌ من المال والثقافة في التعارض الميتافيزيقي بين الذات والموضوع، وبين الماضي والحاضر.
لكن بما أنّ الأزمة الماليّة دفعت بأوروبا إلى حربٍ بين الثقافات المتضادة، أصبح من الواضح أن نسبيّة المال والثقافة أخفت وراءها العدميّة بدلاً عن ذلك، يشير زيمل إلى أن الحياة في حد ذاتها هي المصدر الحقيقيّ لجميع القيم المتجاوزة.
تخلق الحياة – الإنسانيّة والحيوانيّة وحتى النباتيّة – حدوداً (بين الذات والآخر، بين هنا وهناك وبين هذا وذاك)، ودائماً ما تتجاوز تلك الحدود بالنمو، والاستهلاك، والتكاثر، والموت.
ويُضفي البشر بُعداً إضافياً، فعند تأملنا لهذه الحدود: ننكر الحدّ لحظةَ معرفتنا بانحيازه، وبذا دون أن نتوقف عن أن نكون بداخله، على حد تعبير زيمل، خذْ الانقسام بين الماضي والمستقبل على سبيل المثال، يجادل زيمل بأنّ:
ما دام أنّ الماضي والحاضر والمستقبل منفصلين عن بعضهم بضبطٍ نظريّ، فالوقت غير حقيقيّ، لأن اللحظة غير الممتدة زمنياً (أي الحاضر اللاوقتيّ) فقط هي اللحظة الحقيقيّة.
إنّه لصحيح أنّ المال والثقافة يُجسّران بطرقهما الخاصة الهوّة بين الماضي والمستقبل -لكنهما لا يستطيعان بمفردهما ضمان وجودٍ ثريٍّ. يقول زيمل:
الحياة هي نسق الوجود الفريد الذي لا تنطبق عليه حقيقة هذا الفصل [بين الماضي والمستقبل] والوقت حقيقيٌّ بالنسبة للحياة وحدها فقط.
بدلاً من التشاؤميّ مُتّبع النسبيّة المطلقة، العالقِ في دائرةٍ مفرغةٍ من الرفض، والمتحمس المتفائل للدوغمائية، الذي يُخفي المحدوديّة وراء المطلق الهش، توصّل زيمل إلى فهم أنّ الحقيقة ينبغي عليها أن تكون محدودة لتكون حقيقةً – وأنه في إدراكنا لهذا، نُدرك اللامحدوديّة على أنّها ملكٌ لنا، وهذا إنجاز عظيم؛ إذ يعثر كلٌّ من التشاؤميّ والمتحمس المتفائل على غايتهما خارج نطاق حياتهما، في المقابل تقترح فلسفة الحياة الخاصة بزيمل أنّ الحقيقة ملكٌ لنا، ليس على الرغم من حدودنا ولكن بسببها، وبمجرد أن نتعرف على هذه الحدود نتجاوزها: “بفضل وعْينا الأعلى والمتجاوز للذات في أيّ لحظة معيّنة، نحن المطلق فوق نسبيّتنا”.
أقامت حياة زيمل في المساحة الحديّة بين الاعتراف والاغتراب”
يقوم زيمل[7] بهدم تسامي المعتقدات الدينيّة التي تضع معنىً أسمى يتجاوز هذا العالم، وذلك من خلال اكتشاف مبدأها الأساسيّ في الحياة.
على سبيل المثال، فإنّ معتقد تناسخ الأرواح، وهو جزء من علم الكونيّات البوذيّة، هو شيء نختبره باستمرار: ففي أيّ لحظةٍ حيّة، تُمازج الروح الفرديّة بين التحوّل والثبات. وعلى نحوٍ مماثل، فإنّ الشغف المسيحيّ بالكمال الأخلاقي هو تعبير متغرّب عن الحزن في عالمٍ منهارٍ وإقرار بأنّ الخير موجود بالفعل -في هذا العالم بهذه الطريقة يمكن لأنظمة التقييم الدوغمائيّة العثور على محتواها الحقيقي في عالمنا المحدود، بينما تُترك نموذجها المُستبعد، وهذا يفتح طريقاً إلى الحريّةٍ الروحانيّةٍ الواقعيّة، سواء كانت الحياة معزوفة[8] إيتود، أو مقطوعة حالمة أو مازوركا، فإنها تخضع لتأثيرنا بينما نحن نشارك في التناغم harmony متعدد الإيقاع للحياة الاجتماعيّة.
أقامت حياة زيمل في المساحة الحديّة بين الاعتراف والاغتراب، ولأنه واجه ذلك بنزاهةٍ فكريّة ثابتة، فقد ركزّ ذلك تفكيره وعمله، وهذا هو السبب في أنّ فكره يغمر كأس علم الاجتماع، والذي على الرغم من نطاقه الواسع، فهو من الناحية التاريخيّة محدّد بالزمان والمكان، وصف في مفكرة الأقوال المأثورة الخاصة به إرثه بتواضعٍ مميزٍ:
أعلم أنني سوف أموت دون أن يكون لي وُرثاء روحيين (وهذا هو ما ينبغي أن يكون.) فآثاري تشبه إرثاً نقديّاً موّزعاً بين العديد من الورثة.
لكنّ زيمل هنا قلّل من قيمة نفسه على أقلّ تقديرٍ، فقد جمع إرثه الاهتمام، لقد جعل عصرنا المُتسم بالتمويل الجامح والقوميّة المتجددة علم الاجتماع الفلسفي لزيمل أكثر تبصراً من أي وقت مضى.
إنّ الأخطار المتّصلة بالتغيّر المناخيّ الكارثيّ والجائحة قد جعلت فلسفته للحياة ضروريّة.
في كتاب شوبنهاور ونيتشه (1907م)، كتب زيمل:
الكينونة والصيرورة هما أكثر الصيغ الثنائيّة الأساسيّة عموماً ورسميّةً وشمولاً، والتي تُنمط جميع المخلوقات البشريّة: إذ إنّ جميع الفلسفات الكبرى تشترك في إنشاء مُلاءمةٍ جديدةٍ بينهما، أو نهجٍ جديدٍ لمنح أحدهما أولويةً قاطعةً على الآخر.
ويصحُّ هذا أيضاً لزيمل نفسه، فبفتح روحه لهذين النقيضين، اكتشف أخيراً أسلوب حياة الفيلسوف الذي بإمكانه توفيق فردانيّته مع عالمه، وبذلك ساهم بإضافة فلسفةٍ إلى حضارتنا، والتي أدّت إلى توسيع مداركنا وتعميق أرواحنا – ومساعدتنا على العيش.
اقرأ ايضًا: الحياة العصرية سبب الصراع السياسي
[1] – blasé في مفهوم زيمل تعني الفرد الذي يشعر بالملل المطلق، أو فقدان الاهتمام بسبب التعرض المتكرر أو الانغماس. يمارس الأفراد هذا السلوك كطريقة للتكيّف مع محيطهم دائم التغيّر، حتى يتمكنوا من حماية فردانيتهم.
[2] – دونار هو اسم إله الرعد في الأساطير الألمانية.
[3] – ثور هو أحد شخصيات الأساطير الإسكندنافية، يحمل مطرقة ويرتبط بالرعد والبرق والعواصف.
[4] – إله الخمر عند الإغريق القدماء ومُلهم طقوس الابتهاج والنشوة.
[5] – الكلبيّة أو الفلسفة التشاؤميّة هي مذهب فلسفي ينادي بعدم الثقة في وجود الخير في الطبيعة البشرية، والكلبيّ يرفض كافة التقاليد، سواء كانت باسم الدين أو الأخلاق أو كانت تتعلق باللباس أو اللباقة أو غيرها من القيود الاجتماعية.
en tito – [6]
[7] – de-sublimate
[8] – etude، nocturne، mazurka: هي أسماء مقطوعات بيانو شهيرة ألّفها فريدريك شوبان.