- رياض بن صالح الشمراني
في كتابه الحياة السائلة يصف باومان حياتنا المعاصرة بأنها حياة استهلاكية وأن المجتمعات الحديثة -غالباً- هي مجتمعات استهلاكية ويُدخل في وصف الاستهلاكي كثيراً من الأشياء من حولنا كالطفولة والجسد والثقافة والفنون والاعلام والحب والأحلام والرغبات.. وغيرها، فماذا يعني هذا الوصف “استهلاكي”؟ وكيف يمكن أن نصف كل هذه الأمور بأنها استهلاكية؟ وما هي آثار تلك الرؤية الاستهلاكية على حياتنا وعلاقاتنا وأنفسنا؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه من خلال الاقتباسات من سلسلة كتب باومان عن السيولة وعلى وجه الخصوص كتب الحداثة السائلة والحب السائل والحياة السائلة.
يلفت باومان نظرنا إلى تحول مجمل عناصر حياتنا إلى أشياء استهلاكية، يقول: ” تتوسط السوق الآن في الأفعال التي ترسخ العلاقات بين الناس وتمزقها، الأفعال التي تجمع بين الناس وتفرقهم، الأفعال التي تصل بين الناس و تفصلهم، الأفعال التي تدونهم في سجل الاتصال و تحذفهم منه، إنها تتوسط في العلاقات الإنسانية في العمل والمنزل و في الاماكن العامة وفي أكثر الأماكن خصوصية وحميمية، إنها تعيد تشكيل اتجاهات الحياه وصياغتها ومساراتها بحيث لا يمكن أن يغفل أي منها عن المحال التجارية، إنها تسرد سيرورة الحياه باعتبارها سلسلة متتابعة من المشكلات المستعصية التي لا يمكن أن تجد لها حلاً إلا في أرفف المحال التجارية، إنها -أي السوق- توفر طرقاً تكنولوجية مختصرة في المحال التجارية إلى الأهداف التي لم يكن من الممكن تحقيقها في الماضي إلا عبر المهارات الخاصة والسمات الشخصية والتعاون الحميم والتفاوض الوردي”.
يواصل باومان القول “إن هذه النزعة الاستهلاكية ألقت بظلها الكبير على عالم الحياة بأسره وهي تجزم أن كل شيء إنما هو سلعة أو يمكن أن يكون سلعة وإن لم يكن كذلك فينبغي التعامل معه كالسلعة، وذلك يعني ضمنا أنه من الافضل للأشياء أن تكون مثل السلع وينبغي التشكك فيها، بل ورفضها واجتنابها إن لم تتبع نموذج السلع الاستهلاكية”.
المجتمع والمتلازمة الاستهلاكية
يصف باومان مجتمع المستهلكين بأنه ذاك المجتمع الذي استبطن الرؤية الاستهلاكية وأصبحت نموذجه المعرفي الذي ينظر ويقيم به الأشياء والعلاقات و كل ما حوله. يقول: “في ذلك المجتمع تتعدد الطرق وتتفرق، لكنها تؤدي جميعها إلى المحال التجارية. فكل هدف من أهداف الحياه لا سيما الكرامة و تقدير الذات والسعادة يتطلب توسط السوق، والعالم الذي يحوي هذه الأهداف يتألف من السلع وهي موضوعات يخضع الحكم عليها أو تقديرها أو رفضها للإشباع الذي تحققه لزبائن العالم، ونتوقع من هذه السلع أن تكون سهلة الاستخدام سريعة الاشباع وسهلة الاستهلاك،فلا تستدعي سوى جهد قليل أو لا تستدعي جهداً على الإطلاق، ولا تستلزم تضحية من جانب المستهلك، فإذا عجزت هذه السلع عن الوفاء بوعودها وإذا لم يكن الاشباع كاملاً ولا عظيماً كما ينبغي فإن الزبائن سيرجعون إلى المحال التجارية ويتوقعون استرجاع أموالهم وإن لم يكن ذلك ممكناً فسيتفحصون الأرفف المكتظة بالسلع و يستبدلون أغراض أخرى بأغراضهم”.
والملفت في حديث باومان عن المشكلة الاستهلاكية أنه يجعلها مشكلة اجتماعية في المقام الاول ونفسية أو سلوكية في المقام الثاني كما يصفها بأنها متلازمة. يقول: “يتجاوز مجتمع المستهلكين التعبير المحدود عن اللذة التي يجدها المستهلكون في التسوق، ومن ثم بذل وقت وجهد كبيرين في تعظيم ملذات التسوق، إنه يعني أيضاً أن النظر إلى أركان الظرف الاجتماعي والأفعال كافة التي تستدعيها وتؤطرها تحكمه متلازمة استهلاكية للميول الإدراكية والتقويمية. فمكونات الحياة بما فيها العلاقات بين الأفراد عادة ما يُعاد تشكيلها على غرار وسائل الاستهلاك وموضوعاته ووفق الخطوط التي ترسمها المتلازمة الاستهلاكية”.
ويضيف ” إن تلك المتلازمة تتجاوز مجرد الانبهار بملذات الطعام والشراب والملذات الحسية والوقت الممتع، بل إنها متلازمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهي جملة من الاختلاف والارتباط بين عدد من المواقف والاستراتيجيات، والميول الإدراكية والأحكام القيمية والتحيزات والافتراضات الصريحة والمضمرة عن العالم…”
يكمل باومان وصفه للمتلازمة الاستهلاكية ويقول: ” فالمتلازمة الاستهلاكية تقوم في المقام الاول على نفي شديد لفضيلة الإرجاء ووجاهة إرجاء الاشباع واستحسانه، وهما الركيزتين القيمتان لمجتمع المنتجين -الذي سبق ظهور مجتمع المستهلكين- الذي تحكمه المتلازمة المتمركزة حول الإنتاج”
ويقول: “إن مجتمع المستهلكين يستجوب أعضائه باعتبارهم مستهلكين في المقام الأول والأخير، إنه مجتمع يحكم على أعضائه ويقيَمهم بما لديهم من قدرة استهلاكية وما يتبعونه من سلوك استهلاكي“.
هذا الاستجواب بطبيعته يستلزم أناس ينجحون في هذا السباق الاستهلاكي وآخرون يفشلون، فما هو مصير الفاشلين وكيف ينظر إليهم مجتمع المستهلكين؟
يقول باومان: “هؤلاء المستهلكين “العاجزين”.. مخلوقات عديمة القيمة تماماً وبكل تأكيد إنهم مخلوقات فائضة، وفضلات زائدة لمجتمع يعيد تكوين نفسه باعتباره مجتمع المستهلكين، إنهم لا يملكون شيئا يقدمونه للاقتصاد المتمركز حول المستهلك لا الآن ولا مستقبلاً، إنهم لم يضيفوا الى قائمة العجائب الاستهلاكية، ولن ينقذوا البلاد من الكساد فهم يتداولون بطاقات ائتمان لا يملكونها ويفرغون حسابات ادخار لا يملكونها، ومن ثم فان مجتمع المستهلكين سيكون أحسن حالاً اذا ما اختفوا منه”
الطفولة والمتلازمة الاستهلاكية
يتطرق باومان إلى أن مجتمع المستهلكين يدرب أطفاله منذ الصغر ويعيد تهيئتهم ليكونوا أعضاء مناسبين في هذا المجتمع.
يقول: “يركز مجتمع المستهلكين في إعادة معالجته للطفولة على إدارة الأرواح حتى يجعل أعضائه قادرين على العيش في موطنهم الطبيعي المحال التجارية والأماكن التي تعرض فيها السلع التجارية”.
ويواصل القول: “إن المعارك التي تُشن حول الثقافة الاستهلاكية للأطفال ليست أقل أهمية من المعارك التي تُشن حول طبيعة الأشخاص ونطاق الشخصية في ظل التوسع الهائل للتجارة، فتفاعل الأطفال مع المواد ووسائل الاعلام والصور والمعاني التي تفرزها وتتشابك بها مع عالم التجارة يؤدي دوراً مركزياً في تكوين الأشخاص والمواقف الأخلاقية في الحياه المعاصرة، لا شك أن عالم التجارة يؤدي دوراً مركزياً ومن سن صغيره جداً، فبمجرد تعلم الأطفال القراءة أو ربما قبل ذلك يبدأ اعتمادهم على المحال التجارية، وهم يُقذفون من كل جانب بعروض تقول لهم إنهم يحتاجون إلى هذا المنتج أو ذاك حتى يصيروا شخصيات مناسبة تستطيع أن تؤدي واجبها الاجتماعي ويراهم الناس وهم يفعلونه، ومن ثم يشعرون بعجزهم وقصورهم إذا لم يلبوا النداء على الفور”
ويشير إلى حالة السخط وعدم الرضا التي تثيرها وسائل التسويق في نفوس الأطفال، يقول: “أما خبراء التسويق فيحاولون أن يولدوا في نفوس الأطفال حالة من السخط الدائم من خلال إثارة رغبتهم في الأشياء الجديدة والنظر لما سبقها باعتبارها أشياء قديمة وفضلات عديمة القيمة، فهدفهم النهائي هو إعادة إنتاج دورة الرغبة الدائمة التي تندم فيها الطفولة الرأسمالية الاستهلاكية”.
ويختتم حديثه عن ظاهرة الطفولة الاستهلاكية بمرارة وحسرة، فيقول: ” ربما تكون الروحانية هدية ميلاد طفل لكنها صودرت من قبل الأسواق الاستهلاكية وأُعيد توظيفها في دفع عجلة الاقتصاد الاستهلاكي، فالأطفال يتدربون على رؤية العلاقات كافة بلغة السوق وعلى رؤية البشر الآخرين بما فيهم الأصدقاء وأعضاء الأسرة بمنظار السوق وعمليات الإدراك والتقويم الصادرة عنها”.
الموضة والمتلازمة الاستهلاكية
وإذا انتقلنا إلى مجال آخر وهو مجال الموضة، يرى باومان أن مفهوم الموضة أصلاً مفهوم استهلاكي قائم على سرعة الاتلاف وإحلال الجديد مكان القديم. يقول: “وفي عالم الموضة، نجد أن ما يجب على الناس أن يرتدوه أو ما يجب أن نراهم وهم يرتدونه يتحول إلى ما لا يجب عليهم أن يرتدوه بسرعة تفوق الزمن الذي يستغرقه المرء في فحص محتويات دولاب الملابس،وأسرع من استبدال أرضيه خشبية مزخرفة بسجادة، ففي المجلات (واليوم عالم الإنترنت) التي تحدد أنماط الحياة تظهر المقالات المخصصة لما هو جديد أو الموضة – ما لابد للمرء من أن يمتلك، ويفعل، ونراه وهو يمتلك أو يفعل- إلى جوار المقالات المخصصة لما هو خارج الموضة (ما لا يجب على المرء أن يمتلك، ويفعل، ولا يُرى وهو يمتلك أو يفعل) وتأتي أخبار أحدث الإضافات بجوار ما يجب أن يلقى في سلة المهملات”.
ويقول: ” إن ما يزين به المرء جسده هو وسيلة تتناسب مع عصر السرعة…. فالأشياء التي يتزين بها المرء ويخلعها ويتخلص منها بسرعة فيما تُلحق/ تُستبدل وتحل محل بعضها البعض بوتيرة مذهلة”.
المعرفة والمتلازمة الاستهلاكية
ويربط باومان بين البقاء في ماراثون المستهلكين وبين الحاجة لمعرفة استهلاكية أيضاً، سرعان ما تُكتسب وسرعان ما يُحذف بها في غياهب النسيان بعد مرور الزمن عليها. يقول: “وحتى يحقق المرء الاستفادة التامة من الأشياء على أكمل وجه فإنه يحتاج بكل وضوح إلى كثير من المعلومات المحدثة على الدوام وأسلاك التقاء البث الاذاعي والتلفزيوني والشبكي على رأس الحساب المصرفي وبطاقات الائتمان. إن مقدار المعرفة التي يحتاج إليها المرء حتى يثبت في موضعه يُذهل العقل، أعداد مهولة تُصيب الرأس بالدوار من الأسماء والعلامات المسجلة والشعارات التي يحتاج المرء إلى حفظها والاستعداد لنسيانها حيث تظهر فجأة أسماء جديدة مشاهير تعبدها الجماهير والشركات الرائدة في التصميم، وأسواق الموضة تنفخ الأبواق وتدق الطبول ثم تختفي”.
“ومصير المعرفة مثل كل الأشياء الأخرى في العالم،التقادم المتسارع لا محالة، ومن ثم فإن رفض القبول بالمعرفة القائمة أي رفض اتباع الأولين وإدراك الحكمة التي تحويها دروس التجربة المتراكمة صارت قاعدة الفاعلية والإنتاجية”
العلاقات الإنسانية والمتلازمة الاستهلاكية
ماذا عن العلاقات الإنسانية، ذاك المجال الذي كان ملاذ الفرد الأخير وآخر قلاعه المحصنة بعد تهاوي بقية القلاع وتداعي دفاعاته ومناطقه الآمنة؟
يجيب باومان ويقول:” فالمستهلكون الذين اعتادوا السلع الاستهلاكية التي تنتهي صلاحيتها بسرعة حتى يستبدلوا غيرها على الفور، سيجدون في يقظتهم وعنايتهم – وهي مهام تحتاجها أي علاقة صادقة- مهمة ثقيلة على النفس ومضيعة للوقت،وإذا قرروا الاستمرار في تلك العلاقات الإنسانية فسيعوزهم العادات والمهارات المطلوبة… فالملل من الحياه الزوجية على سبيل المثال كان سابقاً يأتي بعد سبع سنوات من بدايتها أما الآن فإن الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن هذا الملل يبدأ بعد ثمانية عشر شهراً أو سنتين على أكثر تقدير ينتهي عندها الشوق بين الأزواج هذه الإحصاءات ليست مفاجئة فهي تبدو متوافقة مع المفهوم الحديث للإخلاص والصبر، هذا التدهور الجذري الذي أصاب فضيلة الصبر يُرغب في الإنهاء السريع (للعلاقات الضارة)”.
وينقل عن إريك فروم قوله “لا يمكن تحقيق الاشباع في الحب من دون تواضع حقيقي وشجاعة حقيقيه وإيمان حقيقي وانضباط حقيقي” ولكن فروم ما يلبث أن يقول في حزن وأسى “إنه في ثقافة تندر فيها تلك الخصال، لابد أن تندر القدرة على الحب”. ويؤيد باومان فروم ويقول: “وهذا الكلام صحيح تماماً في ثقافة استهلاكية مثل ثقافتنا، فهي ثقافة تفضل المنتجات الجاهزة للاستخدام الفوري والاستعمال السريع والاشباع اللحظي، والنتائج التي لا تحتاج إلى جهد طويل، والوصفات السهلة المضمونة والتأمين ضد المخاطر كافة، وضمانات استرداد النقود المدفوعة فالوعد بتعلم فن الحب إنما هو وعد بتحويل تجربة الحب إلى ما يشبه السلع الأخرى التي لها مفعول السحر والإغواء بالتلويح بكل المميزات والوعد بالإشباع الفوري من دون انتظار ولا جهد ولا تعب، فالوعد بتعلم فن الحب وعد زائف يتمنى الناس كل المُنى أن يكون وعداً حقيقياً “.
تحول “الحب” تلك الحاجة الدفينة لكل فرد إلى سلعة تعطي وعوداً جميلة ولكنها لا تفي بها أبداً، وتجعل من يعيش تجربة الحب يعود منها محبطاً حاملاً آماله وأحلامه على كتفه ومعها الخيبة والمرارة.
يقول باومان:” فأنت في نظر شريكك الأسهم التي لا بد من أن يبيعها أو الصفقة الخاسرة التي لابد من الانسحاب منها، ولا أحد يستشير الأسهم قبل طرحها مرة أخرى في الأسواق، ولا الصفقات الخاسرة قبل الانسحاب منها”.
وينقل في سخرية لاذعة نصيحة أحد المستشارين الأسريين للحفاظ على الطبيعة العابرة للعلاقات “فلا تدع العلاقة تفلت من مراقبة عقلك الثاقب، ولا تدعها تطور منطقها الخاص بوجه عام، ولا تدعها تكتسب حقوقاً دائمة بوجه خاص، ولا تدعها تسقط من جيبك العلوي فهذا مكانها الطبيعي… فإذا لاحظت شيئاً لم تتفاوض عليه ولم تكترث به، فاعلم أنه حان الوقت للانتقال إلى غيره”.
وينقل نصيحة أخرى عن أحدهم “لا تقع في المصيدة! واجتنب الارتباطات المحكمة، وتذكر أنه كلما زادت ارتباطاتك والتزاماتك وتعهداتك عمقاً وقوة زادت المخاطر التي تواجهها… وبالطبع تذكر أن وضع البيض كله في سلة واحدة هو الغباء الذي ليس بعده غباء”.
ويضيف في موضع آخر “وهكذا صارت الروابط والعلاقات أشياء نستهلكها لا ننتجها، إنها تخضع لمعيار التقييم نفسه الذي تخضع إليه موضوعات الاستهلاك الأخرى كافة، ففي السوق الاستهلاكية عادة ما تُعرض السلع المعمرة في ظاهرها على سبيل التجربة استعاده الثمن مكفولة إن لم يرضى المشتري عن المنتج تمام الرضا، فإذا كان الشريك في العلاقة الإنسانية ينطبق عليه هذا التصور بهذه اللغة، فلم تعد إذاً مهمة الشريكين كليهما العمل على استمرار العلاقة ونجاحها،العمل على نجاحها في العسر واليسر،في السراء والضراء،وقت الشده والرخاء بحيث يكون كل شريك في عون شريكه في أفراحه وأتراحه،وأن يعدَل رغباته المفضلة إذا اقتضى الأمر، وأن يتنازل ويصل إلى حلول مرضية للطرفين، وأن يضحي في سبيل رباط دائم،بل صار الأمر مسألة تتعلق بإشباع الرغبة من منتج جاهز للاستهلاك، وإذا كانت اللذة الحاصلة لا تصل إلى المستوى الموعود ولا المتوقع يمكن للمرء أن يقيم دعوى طلاق،ويستشهد بحقوق المستهلك وقانون المواصفات التجارية، فما من سبب يجعل المرء يتمسك بمنتج قديم أو رديء بدلاً من أن يبحث عن منتج جديد ومعدل في المحلات”.
الجنس والمتلازمة الاستهلاكية
ويرى باومان أن المتلازمة الاستهلاكية غزت مجالاً آخر من أكثر المجالات حميمية وخصوصية في حياة الانسان ألا وهو الجنس، فأصبح محرراً من الارتباط ويُنظر إليه بحسب لذته الخالصة. يقول:” إن تصفية الجنس من الالتزام والارتباط تُمكن الممارسة الجنسية من التكيف مع النماذج المتقدمة للتسوق / الاستئجار. وهكذا يمكن فهم (الجنس الصافي) باعتباره سلعة لها ضمان معتمد باسترداد النقود المدفوعة، وهكذا يمكن لشركاء اللقاء الجنسي الصافي الشعور بالأمان، فالوعي بعدم وجود روابط يعوَض الهشاشة المزعجة للعلاقة”.
ويتحدث في نص مهم وعميق كيف تحول الجنس من وسيلة مساعدة ومتطلب مهم لعلاقه دائمة والتزام طويل إلى غاية في حد ذاته ويستمد معاييره من داخله. يقول: “ويذهب انتوني غيدنز -عالم اجتماع بريطاني شهير- إلى أن العلاقات الصافية صارت النموذج المثالي المهيمن للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهكذا يُتوقع من الجنس أن يستمد مرجعيته وبقاءه من داخله وأن يقف على قدميه، وأن لا يُحكم عليه إلا بمقدار الاشباع الذي يحققه بنفسه، فلا عجب أن مقدرة الجنس على إحداث الإحباط وتفاقم الاحساس بالانفصال الذي كان يُرجى أن يداويه قد زادت زيادة كبيرة”.
ثم ينقل عن فولكمار زيجوش وهو متخصص بارز في الدراسات الجنسية خلاصة توصل إليها بعد لقائه أصحاب العلاقات العابرة والجنس العرضي.يقول: “ترتدي أشكال العلاقات الحميمة السائدة كافة هذه الايام قناع السعادة الزائفة الذي كان الحب بين الأزواج والحب الحر فيما بعد يرتديانه، فعندما أمعنا النظر، ونزعنا القناع،ظهرت لنا رغبات مُحبطة وأعصاب محطمة، وحب خائب، وجراح،ومخاوف، ووحدة، ونفاق،وقهر،وأنانية…كما حلَ الأداء الجيد في الفراش محل الاحساس بالنشوة، و الفيزيقا محل الميتافيزيقا،وأما العفة، والزواج الأحادي، والاختلاط المستهجن فقد أُزيلت جميعها تماماً من الحياة الحرة للتجربة الحسية “.
ويستكمل باومان القول “فعندما يتحول الجنس إلى حدث فسيولوجي في الجسد، ولا تثير “التجربة الحسية” سوى لذة جسدية ممتعة فإن ذلك لا يعني أن الجنس قد تحرر من الأعباء الثقيلة الزائدة المقيدة غير الضرورية، بل يعني على العكس تماماً، بل يعني أن الأعباء التي يحملها زادت عن حدها المعقول فصار يفيض بآمال ليس بوسعه تحقيقها”.
ثم يقول: “إن الكرب الذي يعانيه الإنسان الجنسي في أيامنا هذه هو كرب الإنسان المستهلك، لقد ولدا معاً وإذا رحلا فسيرحلان معاً الكتف بالكتف والقدم بالقدم”.
البحث عن الهوية والمتلازمة الاستهلاكية
ويرى باومان أن البحث عن الهوية تأثر هو الآخر بالمتلازمة الاستهلاكية، وأصبح التجريب المستمر بدون الركون إلى رؤى وأفكار وأنماط سلوك محددة سائداً.
يقول:” تنجرف الهوية مع تيار الأحداث واحداً تلو الآخر، من دون وعي بمآلاته ولا مقاصده، إنها تنساق وراء الرغبة في اجتناب الماضي لا رسم خريطة للمستقبل، ولذا فهي تظل حبيسة حاضرها إلى الأبد بعد تحريرها من دلالتها الدائمة بوصفها أساس المستقبل. إنها تصارع من أجل أشياء لا يمكن للمرء أن يكون أو يُرى من دونها اليوم، وإن كان يدرك تماماً أنها ستغدو أشياء لا يمكن أن يكون أو يُرى بها في الغد. فماضي كل هوية ممهد بمقالب النفايات التي تُلقى فيها تلك الهويات كل يوم، واحدة تلو الأخرى، تلك الأشياء التي ما كان من الممكن الاستغناء عنها قبل أول أمس، تحولت إلى أعباء ثقيلة أمس…إن الهويات القادرة على البقاء بشكل مثالي يجري تخريبها والتخلي عنها، والممتلكات والشركاء يُشردون بدلاً من الحفاظ عليهم ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الذات لابد أن تبرهن للسوق على قدرتها على التغيير”.
ويضيف “هؤلاء المستهلكون يتجولون في الممرات المتعرجة داخل مراكز التسوق وأماكن اللذة، يراودهم الأمل بأن يعثروا على علامة هوية أو علامة تجارية من شأنها أن تُحدث ذواتهم وفق أحدث الصيحات، كما يستحوذ عليهم توجس مخيف من إغفال اللحظة التي تتحول فيها علامة تجارية يتفاخرون بها إلى علامة يخجلون منها”.
ويعزو سبب ذلك إلى أن مجتمع المستهلكين لا يهتم بالأفكار الكلية والمُثل الثابتة فعقيدته هي التغيير والاستمرار في التغيير.
يقول: “فالمجتمع الاستهلاكي يحط من قدر المُثل التي تحتفي بالكلية والمدى البعيد فلا تحظى تلك المُثل بجاذبيتها المعهودة في ذلك المجتمع الذي يُرَوج الاهتمامات الاستهلاكية ويعيش عليها، ولا تجد تلك المُثل تأييداً لها في التجربة اليومية ولا تتناغم والاستجابات المعهودة، ولا تتوافق والبديهيات المكتسبة، فعادة ما تختفي تلك المُثل وتحل محلها قيم الاشباع الفوري والسعادة الفورية”.
الثقافة والمتلازمة الاستهلاكية
ويستمر باومان في الربط بين كثير من الأشياء من حولنا والنظر إليها بحسب نموذجه التفسيري وهو المتلازمة الاستهلاكية،ويحاول هذه المرة تقييم الثقافة والفنون من زاويتها.
يقول:” وفي أيامنا هذه نجد أن الزبائن المحتملين وأعدادهم والأموال النقدية بحوزتهم هي التي تحدد بطبيعتها ومن دون قصد قَدر الإبداعات الثقافية. فالخط الفاصل بين المنتجات الثقافية الناجحة والمنتجات الثقافية المخفقة ترسمه المبيعات وتقديرات الزبائن والعوائد”.
ويضيف ” فالسوق الاستهلاكية تروج أفكار التداول السريع واختزال المسافة بين استخدام الأشياء وتحويلها إلى نفايات والتخلص منها، والاستبدال الفوري للبضائع التي لم تعد تدر أرباحاً، كل ذلك يتعارض تعارض صارخاً مع طبيعة الإبداع الثقافي”.
ويصف بعض الأعمال الفنية الرائجة في المجتمع الاستهلاكي والتي فقدت أي معنى أو ثبات، يقول:” فتلك اللوحات والجدران التي تكتظ بطبقات متراكبة من المعاني التي كانت موجودة من قبل أو ستكون موجودة، أو ربما مازالت موجودة إنما هي لقطات تاريخ قيد الإعداد، تاريخ يتقدم إلى الأمام بتمزيق آثاره، التاريخ بوصفه مصنع الفضلات والنفايات،فما من خلق ولا تدمير، وما من تعلم ولا نسيان حقيقي، بل دليل شاحب على تفاهة تلك التفرقات، بل وسخافتها التامة،فما من شيء يولد هنا ليعيش طويلاً وما من شيء يموت موتاً مؤكداً”.
الجسد والمتلازمة الاستهلاكية
وينتقل باومان إلى مجال آخر لكنه ما زال قريب جداً من الفرد وهو جسده،ويُفسَر لنا كيف ينظر أفراد مجتمع المستهلكين إلى أجسادهم، ففي فصل من كتابه “الحداثة السائلة” عنونه بجسد المستهلك يُفرق بين الصحة واللياقة،ويرى أن الصحة لها معايير واضحة يمكن وصفها وقياسها من الخارج، وأنها كانت مطلوبة لمجتمع المنتجين،أما في مجتمع المستهلكين فأصبحت اللياقة هي المطلوبة وهي بطبيعتها لا تخضع للقياس الدقيق، فهي تعني أنه يمتلك جسداً يتسم بالمرونة والقدرة على الاستيعاب وقابلية التعديل،جسد على استعداد بأن يحيا عبر ملذات حسية لم يجربها من قبل، ويستحيل تحديدها مسبقاً إلا بتجربتها، فإذا كانت الصحة لا تزيد ولا تقل عن كونها تعبيراً عن حالة، فإن اللياقة تضل منفتحة دوماً على الزيادة…ومن ثم فإن طلب اللياقة على العكس من العناية بالصحة، لا نهاية طبيعية لها. فالأهداف لا يمكن أن تُوضع إلا للمرحلة الحالية الآنية من الجهد الذي لا ينتهي أبداً، والاشباع الناتج من إصابة هدف محدد إنما هو اشباع لحظي. ففي طلب اللياقة مدى الحياة لا يوجد وقت للراحة وكل احتفال بالنجاح الذي تحقق إلى الآن إنما هو استراحة قصيره قبل بداية شوط جديد من العمل الشاق. الشيء الوحيد الذي يعلمه طلاب اللياقة هو أنهم لا يملكون لياقة كافية، لكن لا بد من أن يستمروا في طلبها”.
ويقول:” ما دام الوضع المثالي للياقة لا يُقدم سوى إرشادات عامة غامضة غير محددة فيما يتعلق بما يجب اتباعه وما يجب اجتنابه، وما دام المرء لا يمكنه أبداً أن يكون على يقين بأن الارشادات لن تتغير أو تلغى قبل أن يتمكن من تنفيذيها على أكمل وجه، فإن الصراع من أجل اللياقة يعني استحالة الراحة، بل واستحالة الشعور بإمكانية الراحة بضمير مرتاح بلا هواجس، فالشخص الذي يجاهد في سبيل اللياقة البدنية في حركة دائمة على الدوام، وعليه أن يتغير دوماً وأن يكون مستعداً لمزيد من التغيير، فشعار الزمان الذي نعيشه هو المرونة، والتكوينات كافة ينبغي أن تكون قابلة لإعادة التكوين من جديد،والأحوال كافة مؤقتة والأشكال كافة قابلة لإعادة التشكيل مجدداً، ذلك لأن إعادة التشكيل الوسواسي الإدماني واجب وضرورة على حد سواء”.
ولو انتقلنا إلى جانب آخر أخذ حيز كبير من أوقاتنا ومتابعتنا وهو “الحياة الخاصة” للمشاهير ومن يطمحون إلى الشهرة سنجد أن باومان يربطها أيضاً بالمتلازمة الاستهلاكية، ومحاولة الخلاص من خلال الدروس المستفادة من سردهم لقصصهم وأسلوبهم في التعامل مع المواقف المختلفة!
يقول:” تدفع ظروف الحياة التي نحن بصددها الرجال والنساء إلى البحث عن نماذج لا عن قادة، إنها تجعلهم ينتظرون من المشاهير جميعهم وأي واحد فيهم أن يدلوهم على طريق إنجاز الأمور المهمة… فالوجود في محط الأنظار أسلوب وجود في حد ذاته، يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما وكرة القدم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم على حد سواء.وأحد الشروط التي تنطبق عليهم جميعاً أنه يُتوقع منهم وعليهم واجب عام بأن يعترفوا بأسرارهم في سبيل الاستهلاك العام وأن يضعوا حيواتهم الخاصة للعرض العام”.
عالم الحياة والمتلازمة الاستهلاكية
واخترت نصاً من كتاب باومان (الحداثة السائلة) فيه إيجاز مكثف للجوانب التي غزتها المتلازمة الاستهلاكية. يقول:” إننا نتسوق المهارات المطلوبة لكسب قوتنا،ونتسوق الوسائل اللازمة لإقناع أصحاب العمل بأننا نمتلك هذه المهارات، ونتسوق الصورة التي تبدو جميلة إذا ما ارتديناها، أو الطرق التي تقنع الاخرين أننا ما نرتدي، إننا نتسوق طرقاً نصنع بها صداقات مع أشخاص جدد نريدهم، وطرقاً للتخلص من أصدقاء قدامى لم نعد نريدهم،إننا نتسوق طرقاً لجذب الانتباه، وطرقاً للتواري عن الأنظار، إننا نتسوق طرقاً لاعتصار ما يمكن اعتصاره من لذة الحب،وطرقاً تجنبنا الاتكال على المحب أو المحبوب في الحصول على هذه اللذة ! إننا نتسوق طرقاً لكسب حب المحبوب، ونتسوق طرقاً أقل كلفة لفك الارتباط ما إن انطفأت حرارة الحب ولم تعد تجلب لنا مزيداً من اللذة، إننا نتسوق أفضل الوسائل المسعفة لادخار القرش الأبيض حتى ينفع في اليوم الأسود، وأفضل الوسائل الملائمة لانفاق المال قبل أن نكسبه، إننا نتسوق الموارد التي تعيننا على أن ننجز بسرعة أكبر الأشياء التي لابد من فعلها، وأشياء نفعلها حتى نملأ الوقت الذي صار فراغاً، إننا نتسوق أشهى الأطعمة التي تسيل اللعاب، وأفضل نظام غذائي للتخلص من عواقب أكلها، إننا نتسوق أقوى مكبرات الصوت وأكثر حبوب الصداع فاعلية،وهذا غيض من فيض،فمهما طالت قائمة التسوق فإنها لا تتضمن طريقة تدل على انعزال السوق والانفكاك عنه”.
وكل هذه الجوانب من حياتنا التي خضعت للمتلازمة الاستهلاكية يقابلها جانب جواني بداخل كل فرد يتم تطويعه وإغواءه وإغراءه حتى ينظر إلى الاستهلاك على أن فيه خلاصه وسعادته. يقول:” يقوم المجتمع الاستهلاكي على وعد بإشباع الرغبات البشرية بما يفوق ما كان بإمكان المجتمعات الماضية كافة أن تشبعه أو تحلم بإشباعه، ولكن وعد الإشباع لا يحتفظ بسحره إلا بعدم الإشباع، والتشكيك في الإشباع الحقيقي والكامل للرغبة، فتحديد أهداف متواضعة وضمان الوصول إلى الأشياء التي تحقق الأهداف، والاعتقاد بوجود حدود موضوعية للرغبات، كل ذلك يمثل نذيراً بنهاية المجتمع الاستهلاكي… وبوسع المجتمع الاستهلاكي استدامة عدم الإشباع من خلال الحطَ من قيمة السلع الاستهلاكية بعد فترة وجيزة من ترويجها في عالم رغبات المستهلك…فالمستهلك المثالي الذي تسعى وراءه السوق الاستهلاكية يمكن وصفه على أفضل حال بأنه مصنع يعمل بكامل طاقته 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع ضماناً للرغبات العابرة الزائلة القابلة للارتواء مرة واحدة والتخلص منها على الفور”.
بعض نتائج العيش في مجتمع المستهلكين
وأخيراً يحاول باومان تذكيرنا بالنتائج المترتبة على العيش ضمن مجتمع المستهلكين ورؤية الحياة والنفس والآخر من منظور المتلازمة الاستهلاكية،أحدها هو استحالة تعميم الحياة الاستهلاكية على كافة سكان الكوكب وبالتالي حتمية الاستقطاب بين أناس لديهم الموارد الكافية لدخول سباق الاستهلاك وأغلبية ساحقة تجد نفسها خارج السباق الاستهلاكي. يقول:” لا عجب في أن سيرورة النزعة الفردية تبعث على سخط الساخطين، فإذا كانت هذه السيرورة تنتج مستهلكين سعداء فإنها تنتج أيضاً وبالكفاءة نفسها ولكن برغبة أقل في الدعاية والإعلان أناساً غير مؤهلين لحضور الحفل الاستهلاكي و دخول سباق الفردية… لقد وصل الاستقطاب إلى درجة كبيرة وينقل عن جون ريدر قوله إذا عاش كل واحد على كوكب الأرض في رغد وراحة مثل ما يعيش المواطن العادي في أمريكا الشمالية فلن نكون بحاجة إلى كوكب واحد بل إلى ثلاثة حتى نتمكن من توفير سبل العيش لأهل الأرض”.
ويستكمل القول في موضع آخر:”الفقراء لا يسكنون ثقافة مختلفة عن الأغنياء فلا بد لهم من أن يعيشوا في العالم نفسه الذي وُضع لمصلحة أصحاب المال، كما أن فقرهم يتفاقم من جراء النمو الاقتصادي تماماً مثلما يزداد من جراء الركود وعدم النمو، في مجتمع الإغواء والإغراء الذي يسكنه مدمنو التسوق والفُرجة، لا يستطيع الفقراء أن يغضوا الطرف عما حولهم، فلا يوجد مكان يمكنهم فيه أن يغضوا الطرف، فكلما زادت الحرية على الشاشة،وجاذبية المغريات التي تغري الناس بعروض محال التسوق، زاد الاحساس بالواقع البائس الفقير، وزادت الرغبة العارمة في تذوق ولو للحظة خاطفة عابرة نعمة القدرة على الاختيار، فكلما كثرت اختيارات الأغنياء نقصت قدرة الجميع على احتمال حياة بلا قدرة على الاختيار”.
وأيضاً من نتائج العيش في مجتمع المستهلكين،تشجيع سيرورة النزعة الفردية، ويصبح هم كل فرد في هذا المجتمع هو كيف يحقق أكبر قدر ممكن من اللذة والمنفعة لنفسه، ويصبح غير مكترث بمشاكل مجتمعه وهمومه. يقول باومان:” يُعد الاستهلاك نشاطاً متفردا بطبيعته حتى إن كان يُمارس برفقة آخرين، أما جهود الإنتاج فعلى العكس من ذلك تتطلب التعاون حتى وإن لم يتجاوز ذلك تجميع القوى العضلية، أما في حالة الاستهلاك فليس التعاون ضرورياً بل لا داعي له على الإطلاق ومهما كانت المادة المستهلكة فإنها تُستهلك على نحو فردي”.
مصير الآمال في مجتمع المستهلكين
وأخيراً هل حقق ذلك المجتمع الاستهلاكي وعده بتحقيق الحياة الطيبة لأفراده؟
يجيب باومان:” فكل وعد من الوعود في المجتمع الاستهلاكي لابد من أن يتسم بالخداع أو المبالغة على أقل تقدير إذا كان لطلب الأشياء أن يدوم.
فمن دون الإحباط المتكرر للرغبات ربما يتوقف الطلب الاستهلاكي بسرعة وربما يفقد الاقتصاد المتمركز حول المستهلك قوته الدافعة… إن النزعة الاستهلاكية تعني اقتصاديات الخداع والاسراف والنفايات،وهذي الاقتصاديات لا تشير إلى خلل أو عطل بل إنها ضمان السلامة الذي يكفل البقاء لمجتمع المستهلكين…فحتى تبقى الآمال على قيد الحياة وحتى تسرع الآمال الجديدة في ملء الفراغ الذي تركته الآمال المهملة، فإن الطريق من المحال التجارية إلى سلة المهملات لابد من أن يكون قصيراً ولا بد للمرور من أن يكون سريعاً”.



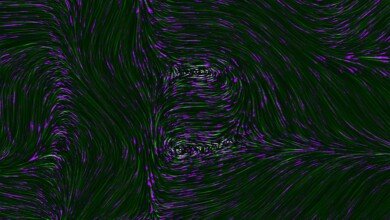

كان الوليد بن المغيرة يتزين ببنيه في مجالس قريش؛ يروى أنه كان يُلبسهم الحرير الأحمر ويصفّهم خمسة عن يمينه وخمسة عن يساره.
أقول أن في ذلك تزيُّناً ومباهاة بصرية، كذلك. غير أن محل التزيّن وموضوعه منصرف إلى معنى إنساني خالص (فهو يتباهى برابط أسري، وبمعنى حضور الأبناء ومشاركتهم*).
ثم جاء السوق ليلتهم كل شيء، يلتهم العلاقة الإنسانية في مظهرها وجوهرها، حتى صارت العلاقات الإنسانية تبدأ من السوق وتنتهي إليه.
—————
** وقد امتن الله على الوليد بحضور أبنائه: “وبنين شهودا” وفي تأويل ذلك: أنهم حاضرين معه.