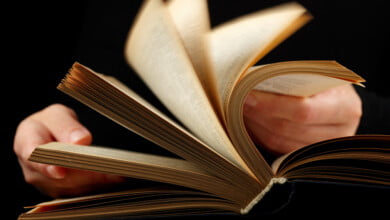- عبد الله الفهد
“ثُمَّ جَاءَ المُتَنَبِّي فَمَلَأ الدُّنْيَا وَشَغَلَ النَّاسَ..”
(ابن رشيق القيرواني، العمدة)
أكتبُ هذه السطور لأكونَ مشغولًا بالمتنبي، لكنّه ليس شغلًا على النحو الذي شَغَلَ به المتنبي الكُتّابَ فيمن شغل، فالشغلُ بالمتنبي قد امتدّ وتشعّب وصار القولُ فيه يسلك طرائق قددا ومذاهب عددا، ولستُ معنيًا في هذه السطور بتحقيق القول في شيٍ من سيرة المتنبي أو شخصيته ولستُ معنيًا كذلك بنقد طرفٍ من شعره والكلام فيه. ولكنّي أريدُ أن أعرض لبعض من كتب في الشاعر، فإذن هذا شغلٌ متقدّم، هو بالمشغولين بالمتنبي أقرب منه إلى أن يكون بالمتنبي نفسه.. ولو أردتُ تتبّع كل من شُغل بالمتنبي لطال بي الاستقصاء وصرفني عن كل شغل، لكنّي أعرض لشيء من ذلك على سبيل الإلمام..
***
أمّا أول المشغولين ممن أعني في هذا الإلمام، فهو الشيخ الأستاذ محمود شاكر، وأمّا ثانيهما حسب تاريخ الاشتغال فهو أستاذه الدكتور طه حسين..
فقد كتب محمود شاكر مقالاتٍ في مطلع يناير لعام 1936م أُفردت لها صفحاتُ المقتطف احتفالًا بذكرى المتنبي بعد ألف عامٍ انقضت على وفاته، ثم كتب طه حسين كتابًا أسماه “مع المتنبي” بعد كتاب محمود شاكر بعامٍ على التمام. ثم دارت معارك في التحقيق والمنهج ليست هي إلينا الآن، والذي إلينا هو أن نقول قولتنا عن صورة المتنبي في هذين الكتابين..
وبادئ الأمر إذا ما أردنا قبل كل قول أن نصف كتاب محمود شاكر في الظاهر والجملة، فإننا نقول: هو كتابٌ في التحقيق دخل فيه الأدب من جهة التذوق والأسلوب، وقد التزم شاكرٌ الجدَّ في كتابه ثمّ قدّم له فيما بعد بفصولٍ طويلةٍ في المنهج وما إليه، كلها جدُّ من الجد. أما إذا أردنا أن نصف كتاب طه، على ما التزما فإنّا نقول: هو كتابٌ في الأدب دخل عليه التحقيق دخولًا ما.. وأخرج طه كتابه مخرج التبسّط وقدّمه بمقدمةٍ في العبث تقي مقاتل ما أراده من البحث والتقرير.
هذا فيما يختلف فيه الكتابان، أمّا الذي يتفقان فيه فهو: أنّ كل كتابٍ منهما وإن كان قد عمِد إلى تصوير المتنبي، إلّا أنّه يصوّر لنا كاتبه تصويرًا يطغى في بعض التفاصيل فترى صورة الكاتب أوضح فيها من صورة المتنبي، ولست أعني أنّه يصوّر ما أخذ كل كاتبٍ به نفسه من المنهج والإخراج والسبيل، إذ لن نزيد في هذا على أن نقول ما هو واضحٌ للقارئ من الاختلاف بين الرجلين في الالتزام والتنظيم وما هو جليٌ من مصادر كلٍ منهما واتجاهه.. وإنما أعني أنّ الكتاب يصوّر نفس الكاتب وحركتها وهمومها ومزاجها وخواطرها التي رسم بها صورة المتنبي أو أراد من طرف خفيّ أن يكون المتنبي على ما يحبُّ أن يراه عليه..
فإذا ما طلبنا صورة المتنبي في كتاب محمود شاكر، وجدناه رجلًا أنفد عمره في جدٍ لا لهو فيه إلا فيما قد اضطُرّ إليه اضطرارًا، وقد كان المتنبي رجلًا فيه من العزم والحزم ما اتفق عليه الرواة، لكننا نجد انّ شاكرًا يحتفل بهذا احتفالًا عظيمًا حتى ليكاد يخيّل للقارئ أنّ المتنبي كان صاحب دعوةٍ لا شاعرًا يجري عليه ما يجري على غيره من الشعراء.. وهذا الاحتفال إنما هو صادرٌ عن طبيعة جادّة يشحذها ما يراه شاكرٌ في نفسه من الانضباط..
وإذا أخذ القارئ في كتاب شاكر، وجد المتنبي على ما هو مقرر في التاريخ_ عربيًا من أرومة عربيّة، وعروبيًا يتعصّبُ للعرب.. لكنّه لا يرى غير ذلك من شأن المتنبي فيما يتصل بالعرب والعروبيّة، فتجد أنّ شاكرًا ينساق لتأوّل كل مدائح المتنبي في غير العرب من أمراء الأعاجم، فيجعلها مطويةً على مدح العرب أو هي في سبيلٍ من إعلاء المشروع العربي كما يقال، ونحن وإن كنّا نوافقُه ونوافق الرواة من قبله على ما ذهب إليه في أمر كافور، إلّا أنّ غير هذا من أمور المدح الذي خصّ به الأعاجم يستعصي على التأويل، ومن المعلوم أن شاكرًا عربيٌ شديد الاعتزاز بالعرب والعربيّة، شديد التعصّب على مناهج المستشرقين الأعاجم، ومؤلفاته طافحةُ بنقدهم ونقد أساليبهم.. وقد رأى شاكرٌ نفسَه في المتنبي، ورأى أنّ نفس المتنبي تنطوي على ما تنطوي عليه نفسه من بغض الأعاجم مع اختلاف الأغراض، فاسترسل في تصوير المتنبي على هذه السجيّة حتى لتشعر أنّك لا تكاد تجزم بأنه يتحرّج مما يسوقه على لسان المتنبي من السباب الذي كان يكيله لكافور فيما يتصل بزنجيته وخصائه، وحتّى تجده قد أعرض أو كاد عن تناول مدائحه في الأعاجم، وأشاح بقلمه عن تناول ما ظهر من المتنبي من شعوبيّة وازدراء للعرب في سياق مدحه لبعض الأعاجم..
ويتلمّس القارئ قبل ذلك ملامح المتنبي في الكتاب، فيجده غلامًا في المكتب تضطرب نفسه وتثور أو تحدّث صاحبها بالثورة على هذا الداء العضال الذي استشرى أمره في جسد الأمّة العربيّة، ويراه حاد المزاج متبرمًا من مجتمعه الصغير تبرّمه من المجتمع الكبير، ويراه وكأنّه لا يهدأ له بال ولا يغمض له جفن، وهو يأخذ نفسه بالجهد والإعداد لمحاربة هذا الفساد المستطير الذي لا سبيل لإرجاع أمجاد العرب إلّا باستئصال شأفته، وقد ترى شاكرًا يسترسلُ في ذلك استرسالًا منسجمًا ممتدًا على طول الكتاب، وتراه ينبسط لهذا ويمدّ الصورة بمزيجٍ من الألوان التي كان يبصرها في نفسه، فإذا رأى القارئ المتنبي على هذه الصورة لا تفتأ أن تنقدح له صورة شاكرٍ في صباه المضطرب، وهو يثور على روحه وعلى الجامعة و “الأساتذة الكبار” وعلى المجتمع بما فيه من “فساد حياتنا الأدبيّة” وعلى المناهج وما فيها من “تفريغٍ ثقافي” والحديث عن هذا المزاج الثائر الحاد قد كفانا شاكرٌ بعينه الحديث عنه في أكثر ما نشر..
وأنت إذا رأيت هذا الاسترسال تجد أنّ حافزه ومُمدّه هو الحسُّ الذوقي الأدبي في الكتاب وهو الجانب الذي ينفث فيه الكاتب من نفسه، لكنّك تجد أنّ خطام هذا الحس قد كان مركوزًا في أرض التحقيق، إلّا في مواضع قليلةٍ تسامى فيها الذوق وجمح واستعصى على الالتزام، منها البحث الذي عقده الأستاذ في تقرير حبّ المتنبي خولةَ أخت سيف الدولة؟ وهذا ما لم يصرّح به الشاعر وما لم تأتِ به الروايات، فهل أسبغ الكاتب الشاب عواطفه على الشاعر الكهل؟ هذا ما لا نقطع به الآن! رغم أننا نجد من تأريخ ديوانه المطبوع ومما يحكيه عنه تلامذتُه ومريدوه من أمر هذه الفترة ما يرجّح أنّ الكاتب الشاب كان يعيش في ميعة من ميعات الهوى ربما كان لها أثرٌ في تقرير حبٍ لا يسنده إلّا التذوّق اللغوي، “فليس أحدٌ في الدنيا المكتوبة (أي التاريخ) يعلم هذا السرّ أو يظنّه.”[1]
***
أما حين نتحدّث عن طه، فإنّا وإن لم نجده يسترسل فيما يُسقط على المتنبي من ذات نفسه لبعد ما بينه وبين المتنبي في الخليقة والطبع، إلا أننا نجده أوضح الكاتبينِ تحكيمًا للمزاج في رسم صورة المتنبي، وهي صورةٌ لا تقتصر على الملامح الشخصيّة، بل تتعداها في استيثاقٍ وثيق إلى ترجمة المتنبي وتاريخه..
فنحن نرى منه أول ما نرى كيف أنكر على المتنبي نَسَبَهُ وأنكر على الرواة نِسْبَتَهُم إياه، بل أنكر على المتنبي كل نسبٍ يُعرف في الأنساب، فجعل الشاعر مجهول النسب، لا يعرف أباه ولا أمّه! وقد كان يشكُّ من قبل في أن المتنبي “لقيط لغية” وهذا أمرٌ ليس بغريب على العميد! فالقارئ في كتابات الدكتور يجده يغرى شديدًا بأحاديث الشذوذ والفساد، بل يجده يُشغف في تفسيق أحوال الذين يُترجم لهم، ولو أمسك القارئ كتابه “حديث الأربعاء” لوجده ينبسط في الترجمة لشعراء الغزل، ويتوسّع في إحالتهم إلى المجون والخلاعة، بل يحب أن يتوسّع في إحالة العصور الإسلاميّة إليهما.. وقد تنبّه لهذا الأستاذ المازني في كتابه “قبض الريح” فقال: “لقد لفتني من الدكتور طه في كتابه “حديث الأربعاء” وهو مما وضع، وفي “قصص تمثيلية” وهي ملخصة، أنّ له ولعًا بتعقُّب الزناة والفسّاق والفجرة والزنادقة”[2] فلا عجب إذن إذا وجدناه يجعل المتنبي وليد خطيئةٍ، ويظنّ أكبر الظنّ “أنّ مولده كان أثرًا من آثار هذا الفساد العظيم”[3] الذي عمّ البيئة التي عاش فيها المتنبي.
ثم هو عند الدكتور قرمطيٌ كان قد ارتحل إلى البادية ليتعلم أصول القرامطة، ولم يكد يبلغ آخر صباه حتّى “تمّ له حظّه من القرمطة” فلمّا عاد، عاد “وهو قرمطيُّ الرأي، متحفزٌ أن يكون قرمطيَّ السيرة أيضًا”.. وهذه أحكام عريضةٌ كما ترى، تتجاوز الرواية والبيئة والتاريخ! أفضى إليها طه -فيما نرى ويرى الشيخ محمود شاكر– اعتمادًا على أمورٍ كان للمزاج في صياغتها وحبكها وتقريبها وردم فجوتها دورٌ كبير..
وأمرٌ آخر من ملامح تقريب المزاج، نلحظه حين نستحضر نزعة الدكتور نحو الثقافة اليونانية والغربية، ولسنا نطيل في تبيان هذا النزعة فأمرها مشتهرٌ مبثوث في سيرته وكتاباته، وقد يكفي القارئ أن يعرّج على كتابه “مستقبل الثقافة في مصر” حتّى يقرر هذا النزوع.. ومن آثار هذه النزعة: احتفال الدكتور بكل خبرٍ عارض أو خاطرٍ سريع يُتيح له ربط كل عبقريّة عربية بثقافة يونان التي تُمثّلها دولة الرومان في ذلك الزمان.. ففي كتابه “مع المتنبي” يومض الدكتور في صفحاتٍ متناثرة إلى هذا المعنى، ونجده يقرر نبوغ المتنبي في طور اتصاله بسيف الدولة، ثم يقرر تطور الحياة العلمية في البيئة الحلبيّة، فيقول في وصفها: “ولم يكن اتصال هذه الدولة الناشئة بالروم في غير انقطاع ليضعف من هذه النهضة أو ليحد آفاقها، وإنما كان خليقًا أن يزيدها قوّةً، بما يثير من نشاطٍ في النفوس، وبما يُحدث من اختلاطٍ مستمر بين العرب والروم أثناء الحرب والسلم، لكثرة من كان يقع في إسار المسلمين من الروم، ومن كان يقع في إسار الروم من المسلمين.”[4] ثم يمضي طه ممهدًا لقارئه هذا التأثير، ومعرّضًا بتأثّر المتنبي بهذه البيئة حتى ينتهي الفصل. ثمّ يستأنفُ فصلًا مفردًا في التقرير، يبدأهُ باصطناع الظن وشيءٍ من إيهام التحرّز، فيقول: “وما أستبعدُ أن يكون سيف الدولة قد ألمّ شيئًا باليونانية وثقافة اليونانيين، لاتصاله اليومي أثناء حياته كلها باليونان وشئون اليونان. فمن الحق على الشاعر الذي يريد أن ينقطع لأمير كهذا الأمير، ويشارك في مجلسٍ كمجلس سيف الدولة، أن يهيئ نفسه لذلك أحسن تهيئة، ويعدها له أقوى إعداد.”[5] ثم يحاول الدكتور أن يتدرّج بالقارئ من الظن إلى شيءٍ من الوثوق، فيقول: “والرواة يحدثوننا، والديوان يحدثنا، بأن المتنبي قد جد في ذلك فأحسن الجد، وأتيح له في ذلك أحسن توفيق”[6]
ثمّ بعد أن جهّز قارئهُ أتمّ تجهيز، أراد الدكتور أن يطّرح هذا الاصطناع وهذه المداورة على المعنى ليباشره فيقول: “وإذن فلم يكن رقي شعر المتنبي في هذا الطور شيئًا مفاجئًا ولا أثرًا من آثار المصادفة، وإنما كان شيئًا طبيعيًا، ونتيجةً لازمة لهذه الحياة الجديدة التي انغمس فيها” [7]
وبهذا يرسم الدكتور صورة المتنبي في هذا الطور على شيءٍ من المزاج كما قد فعل مع المعرّي حين أراد أن يُثبت له قصّة اجتيازه صغيرًا باللاذقيّة واجتماعه إلى راهبٍ من رهبانها ليلةً بدير الفاروس فسمع منه شيئًا من الفلسفة وعلوم الأوائل (أي اليونانيين)، فكان من شأن هذه الليلة أن أفسدت عليه دينه وكان لها التأثير بالتلازم في حياته وشعره ونبوغه!..
ولا نريد أن نطيل في الحديث عن أثر المزاج عند طه على رسم صورة المتنبي فقد كفانا هذا العناء حين أقرّ ذلك في نهاية الكتاب إذ قال عن كتابه: “فهو خليقٌ أن يصورني أنا في بعض لحظات الحياة، أثناء الصيف الماضي، أكثر مما يصوّر المتنبي”[8]
ولا إخالني أغربُ حين أقول إنّه كان يرمي إلى تلميذه محمود شاكر عندما قال بعد ذلك: “وإنّه لمن الغرور أن يقرأ أحدنا شعر الشاعر أو نثر الناثر، حتّى إذا امتلأت نفسه بما قرأ أو بالعواطف والخواطر التي يثيرها فيها ما قرأ، فأملى هذا أو سجّله في كتاب، ظنّ أنّه صوّر الشاعر كما كان، أو درسه كما ينبغي أن يُدرس، على حين أنّه لم يصوّر إلا نفسه، ولم يعرض على الناس إلا ما اضطرب فيها من الخواطر والآراء”[9] انتهى.
***
وإلى هنا أستروح عن الانشغال بالمتنبي، ولكنّه حتمًا استرواحٌ إلى حين.. ولا يجمل بي إذا انشغلت بالمتنبي أن أدع الانشغال به دون أن أُنشد له شيئًا من الشعر! ولستُ أظنّ أنّ في ديوانه ما هو أقمن بهذا المقال من هذا البيت -ونحن نوجهه إليه-:
فلَقَدْ عُرِفْتَ وما عُرِفتَ حَقيقَةً
ولقد جُهِلْتَ وما جُهِلْتَ خُمُولا
[1] هذه كلمة الرافعي عما نحن فيه، أتى بها عن قضية حب المتنبي عند الأستاذ محمود شاكر كانت في سياق التقريظ. انظر: وحي القلم 3/357
[2] قيض الريح 83
[3] مع المتنبي، 32
[4] مع المتنبي 182
[5] مع المتنبي 184
[6] المرجع السابق
[7] المرجع السابق
[8] مع المتنبي،378
[9] المرجع السابق