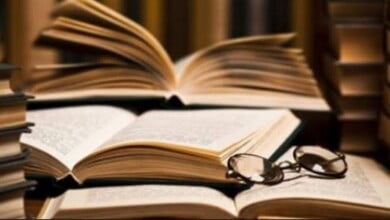- بيتر آدمسون – جامعة نوتردام.
- ترجمة: الجراح القويز
- تحرير: عبد الرحمن روح الأمين
الملخّص
لقد اجتذبت بعض مساحات النّقاش في الفلسفة العربية اهتمامًا كبيرًا، مثل مُباحثة الغزالي لمبدأ “السببيّة “causality في المسألة السابعة عشر في كتابه “تهافت الفلاسفة”، في مقابل ردّ ابن رشد عليه ومناقشته في كتاب “تهافت التّهافت”. والسؤال الذي يطرحُ كثيرًا: إلى أيّ مدًى يمكن أن ينسب الغزالي إلى مذهب الاقتران (occasionalism)؟[1] وبشكل أدقّ، هل ينتظم الغزالي في سلك المتكلّمين الذين يحصرون السببيّة في الله وحده؟ والشّيء الذي لم يتناول بشكل دقيق في الدراسات السابقة، هو السؤال الحاسم لدى كلٍ من الغزالي وابن رشد في المسألة السابعة عشر: ماهي النظرية السببية الكافية لتفسير المعرفة الإنسانية؟ في هذا الورقة سأبين أن نظريات الغزالي وابن رشد في السببية مرتبطة بشدة بنظرياتهم المعرفية. يمكن تلخيص الفرق بين هذين المفكرين على النحو التالي: النموذج الفكري في المعرفة الإنسانية عند ابن رشد هو: العلم البرهاني. وفي المقابل، فإن نموذج الغزالي الفكري للمعرفة الإنسانية هو (أو على الأقلّ يتضمّن): الوحي. حتى الآن التزم كلٌ منهما بنموذج العلم الأرسطي والمبادئ التابعة له. وهكذا، فإن موقف الغزالي في المسألة السابعة عشر يُسلّط الضوء على نقده للفلسفة في التهافت، وتحديدًا اعتباره أن الفلسفة لا تقف على أرض صلبة (متهافتة)[2]، وسأُقارن بإيجاز هذا الموقف مع موقف توما الإكويني، في سبيل وضعها في سياقات أكثر وضوحًا.
لفتت عدةُ مواطن من الفلسفة العربية الأنظار، كمُباحثة الغزالي للسببية في المسألة السابعة عشر من كتابه “تهافت الفلاسفة”، في مقابل رد ابن رشد عليه في كتابه “تهافت التهافت”. والسؤال الذي تم مناقشته عدة مرّات هو إلى أي مدى يعتبر الغزالي متّبعًا لمذهب الاقتران الكوني، وهل يتّبع المتكلمين في قَصْرِهم الفاعلية السببية على الله وحده[3]. والشيء الذي لم يتطرّق إليه في دراسة هذا النص هو السؤال الحاسم لدى كلٍ من الغزالي وابن رشد في المسألة السابعة عشر وهي: ما هي النظرية السببية الكافيه لتفسير المعرفة الإنسانية؟[4] وفي هذه الورقة سأوضح بأن نظريات الغزالي وابن رشد عن السببية لها ارتباط وثيق بنظرياتهم المعرفية. والفرق بين هذين المفكرين يمكن تلخيصه بالقول بأن النموذج الفكري للمعرفة الإنسانية عند ابن رشد هو العلم البرهاني، بينما عند الغزالي هو الوحي (أو على الأقل يتضمّنه). وختامًا سأبين أن التزام الغزالي بنموذجه الفكري يُسلط الضوء على القصدية الإرشادية في نقده للفلسفة في التهافت.
لكن قبل أن ننتقل إلى المحور المعرفي في المسألة السابعة عشر، دعوني أُعبّر عمّا فهمته من موقف الغزالي من السببية. كما ذكر البعض، فإنه قد واجه الفلاسفة بمفهوم صارم للسببية: وهو أن وجود السبب يستلزم/يستوجب وجود المسبَّب[5]. ويرى الغزالي أنه وفقا لهذا المفهوم: فإن الله وحده هو السبب الحقيقي. ونظرا لوقوع المعجزات، وقبول الافتراض القائل بأن الله على كل شيء قدير= فإنه لايوجد سبب حقيقي غير الله يمكنه أن يوجِب وقوع مسبَّبٍ ما، لأن من الممكن دائمًا ألا يريد الله استمرار هذا المسبَّب بعينه، أو أنه يريد نتيجةً مختلفةً تمامًا لهذا السبب. والغزالي يواجه بهذا الرأي الكثير من الفلاسفة الذين يعزون الحوادث إلى العِلل الطبيعيّة، مثل كون النار سببًا لاحتراق القطن، فهم يرون أنها السبب الوحيد والكافي لهذا التأثير. وأيضًا ضدّ أولئك من أمثال ابن سينا، الذين يقولون بأن هناك واهبًا للصور من العالم السماوي، حيث يَهب الصورة إذا توفّرت أسبابها في فلك ما تحت القمر. ويَطرح الغزالي حجّته المشهورة ضدّ هذا الرأي التي تمّت مقارنتها بحجة هيوم: وهي أن ملاحظة التتابع الزمني بين السبب والمسبَّب لا تعني وجود علاقة سببية بينهما. وضدّ هذه الرؤية الأخيرة، يقول الغزالي: إذا كانت الآثار ناتجةً عن مبادئَ عليا، فهي تعتمد في النهاية على مشيئة الله، وأن الله يمكنه فعل كل شيء إلا الممتنع لذاته. وعلاوة على ذلك، فليس من الضروري أن نفس السبب يولد نفس المسبَّب، مالم يكن السبب ذا صلة بالله نفسه.
لكن الغزالي يكمل بقوله: من حيث الجوهر، يمكننا اعتبار العلل الطبيعية “أسبابًا” إذا استندنا إلى مفهومٍ أضعف للسببية. فهو يُقرّ بأن السبب الطبيعي له طبيعة تؤدي إلى تأثيرات معيّنة ويُمثّل بأن: النار لها طبيعة تجعلها تحرق كل ما تتصل به، لكن هذا لا يعني أن الاحتراق يلزم ضرورة عن النار؛ بمعنى أن وجود القطن (عند) النار يعني منطقيًا احتراقه. ويقول: أن النار تستمدّ طبيعتها المُحرِقة من الله، وهو الذي يختار ما إذا كانت هذه الطبيعة ستؤدي إلى تأثيرها الطبيعيّ أم لا. ويرى بأن الأسباب الطبيعية ماهي إلا أسباب عَرضِية؛ وآثارها تستمرّ فقط إذا أراد “الفاعل الحق” الذي منحها طبيعتها[6]. إن ابن رشد هو أول من رأى في التسليم بهذا الموقف تنازلًا من الفلاسفة للغزالي، لأنه يبدو من الوهلة الأولى أن الغزالي قال بأن الله هو السبب الحقيقي الوحيد، ثم زعم بأنه خلق أشياء لها طبيعة تجعلها تُسبّب آثارًا معيّنة. لكن رؤية الغزالي ليست متضاربة فهو يرى: أن الأشياء مخلوقة بطبيعة معينة، وتأثيرها مشروط، لأنه يعتمد على إرادة الله، تمامًا مثلما أن وجودها معتمد على إرادة الله.
يعتمد رد ابن رشد على الغزالي على الاعتراض القائل بأنه إذا تم قبول أي شكل من أشكال مذهب الاقتران، فإن المعرفة البشرية غير ممكنة. ويُشير إلى أن قبول رأي الغزالي -الذي اعتبره إنكارًا للسببية- يعني أنه لا توجد معرفة ثابته بأيّ شيء؛ لأن العلم اليقيني هو إدراك الشيء على ما هو عليه[7]. وهنا يعتمد ابن رشد بشكل ضمني على مبدأين من المدرسة الأرسطية : الأول – هو ما يمكن تسميته بالتفاؤل المعرفي (epistemic optimism)[8]: فابن رشد باعتباره أرسطياً فهو يُسلّم بأن الإنسان يمتلك إدراكًا، وإذا كانت النظرية السببية ليست متطابقة مع إدراكنا للأشياء كما هي، فهذا بحدّ ذاته يعتبر كافٍ لهدم أي نظرية عن العلم. الثاني – هو مبدأ أن الأشياء لا يمكن معرفتها بوضوح إلا من خلال أسبابها. وهذا بالطبع هو أحد المبادئ الأساسية لنظرية المعرفة في العصر الوسيط. وفي مواطنَ أخرى من الفلسفة العربية، يستخدم للدفاع عن استحالة وجود لاهوت إيجابي[9] في كتاب الأيضاح في النور المحض (Liber de Causis) ، وهو الأساس لمفهوم القديس توما الأكويني حول (a propter quid demonstration)[10]. بالنسبة لابن رشد، فإن هذين المبدأين يُوجّهان ما يجب الاتفاق عليه لتأسيس النظرية السببية. فهو يقول على سبيل المثال : “فإن كانت الأشياء التي لا تحس لها أسباب مجهولة بالطبع، ومطلوبة، فما ليس بمجهول فأسبابه محسوسة ضرورةً”[11]. وبناءً على قوة المبدأين، فهو واثق من أن يمكنه استبعاد أي شكل من أشكال مذهب الاقتران.
في البداية، مايجب الإشارة إليه في اعتراض ابن رشد على الغزالي، أنه يبدو خارج محل الخلاف. فهو يفترض بأن الغزالي يرفض فكرة أن الأشياء لها طبيعة، وهذا هو مبدأ العلم البرهاني والسببية. ويحتجّ ابن رشد بأن الغزالي بإنكاره للسببية، فهو يرفض إمكانية المعرفة. لكن كما رأينا فإن الغزالي في الحقيقة لا يرفض وجود طبيعة معيّنة للأشياء في ذاتها؛ فهو يعتقد أن المخلوقات لها طبيعة مخلوقة تُسبّب تأثيراً محدّدًا، لكن الطبيعة والعلاقة السببية خاضعتان دائما لمشيئة الله. ومع ذلك، فالمرء يستطيع بسهولة أن يرى كيف يمكن تكييف اعتراض ابن رشد ليتناسب مع بناء وجهة نظر أقلّ ارتباطًا بمذهب الاقتران. فإذا كانت طبائع الأشياء هي فقط التي يمكن أن تُّب في آثارِها، فإن معرفتنا بها ليست حتمية، إنما محتملة فقط؛ فيجب أن تظلّ الطبيعة دائمًا كما هي لكي تكون هدفاً للمعرفة العلمية البرهانية[12]. وقد لمح ابن رشد إلى هذا المطلب عندما أشار إلى أن المعرفة القائمة على الطبيعة يجب أن تكون “ثابتة”. وبعبارة أخرى، يجب دائمًا أن تكون الطبيعة هي السبب في التأثير المناسِب، وهذا هو الذي يستتبعه تعريفه “الطبيعة”[13]. وهذا أحد الأسباب التي جعلت ابن رشد يُصرّ على أن المعجزات -أي : تلك الحالات التي يتدخل فيها الله ويخل بالمسار الطبيعي للسببية- ليست حتى شيئًا يمكننا مناقشته بعقلانية. فخوارق الطبيعة -كما يوحي الاسم- تتخطى إي معرفة لدينا عن الطبيعة، بل لا ينبغي أن تكون ضمن أي نقاش عن السببية أو الفلسفة بشكل عام.
وهناك مقياس لعدم ملائمة المقارنة التي تجرى أحيانًا بين الغزالي وهيوم، وهو أن الغزالي توقّع هذا الاعتراض وأخذه على مَحمل الجد. ومن المؤكّد أن هدفه لم يكن نوعًا من الشك الذي كان يستهدفه هيوم، بل على العكس من ذلك، فهو ملتزم تمامًا مثل ابن رشد بالتفاؤلية المعرفية الأرسطية، وهو بشكل ما ملتزم بمبدأ أن المعرفة لا تتم إلا من خلال الوقوف على الأسباب. لذلك طرح الغزالي على نفسه سؤالاً عن كيف أن المعجزات لاتمنعنا من إدراك طبيعة العالم؟ وقد أقر أنه إذا حدث ذلك، فإن الرجل إذا ترك كتابًا في منزله سيقول: “لا أدري ما في البيت الآن، وإنما القدر الذي أعلمه أني تركت في البيت كتاباً، ولعلّه الآن فرس”[14]. كان ردّ الغزالي هذا على الاعتراض أكثر إثارة للإهتمام؛ فهو يقترح أن الله يخلق فينا باستمرار معرفةً بعد معرفة بأنه لن يحدث هذه المعجزات. ولهذا فإن مصدر معرفة الإنسان (إذا قلنا إن كتابه مازال في المنزل) هو الله نفسه. في الواقع، يبدو أن الغزالي جعل مايسمى “المعرفة بالتجربة” التي تؤدي فيها عادةُ توقع سلوك معين إلى معرفة بأسباب لها تأثير محدد= معرفةً يقينية أنشأها الله فينا. وجديرٌ بالذكر ذلك التساؤل الذي يستفسر عن هذه الفقرة وتمثيلها لوجهة نظر الغزالي، وهذا يحول الخلاف إلى موضوع الترجمة[15] ومع ذلك، فإننا لانحتاج أن نحسم السؤال هنا، لأن الغزالي حتى خارج هذه الفقرة ، يطرح باستمرار إمكانية خلق الله المعرفة فينا، سواء في هذه المسألة أو غيرها[16].
كما أظن فإن القارئ الحديث يميل إلى رفض حل الغزالي باعتباره غير كاف: فالمعرفة التي خلقها الله في الإنسان لا تكاد تبدو مؤهلة كالمعرفة بالمعنى الدقيق بتاتًا. هذا بالضبط هو الاعتراض الذي طرحه ابن رشد، وجادل بأن المرء يمتلك معرفة لها علاقة بالأسباب الطبيعية المعروفة. حتى بافتراض أن الله خلق المعرفة في شخص ما، فهو لايقول أنه يعرف الا إذا كانت المعرفة “شيء تابع لطبيعة الموجود، فإن الصادق هو أن يعتقد في الشيء أنه على الحال التي هو عليها في الوجود”[17]. ولهذا، فإنهما مختلفان جذريًا بشأن السؤال التفاؤلي: ماهي شروط المعرفة اليقينية؟ فعند الغزالي، المعرفة الناجمة عن الخبرة ليست معرفة ضرورية؛ إنما المعرفة تكون يقينية إذا استندت إلى الله. أما عند ابن رشد، فالموقف معكوس تماما، فهو يرى: إذا كان الله خلق المعرفة فينا، فإنها لن تكون معرفة إلا إذا كانت مطابقة للطبيعة الحقيقية.
بغض النظر عن الأفكار الحديثة حول هذا السؤال، فإن علينا أن نُقرّ بأن تبرير الغزالي يتماشى بشكل مثالي مع رؤيته حول السببية. فالغزالي مقرّ بمعرفتنا أن هناك أشياء معينة ستحدث وأخرى لن تحدث. ولكن إذا كانت الأسباب وإنتاجها لمسبَّباتها مرتبطة دائما بإرادة الله، فإن المعرفة اليقينية يمكن أن تنشأ فقط من المصدر الحقيقي الضروري لهذه العلاقة السببية، أي الله. وهكذا، كما ذكرنا سابقًا، الغزالي متّسق مع نفسه بقبوله للمبدأ الأرسطي الثاني القائل بأن المعرفة تتم دائما من خلال الأسباب. لكن هذا عنده يعني أن المعرفة اليقينية دائما تستند إلى الله، لأن السببية تستمد وجودها فقط من الله. ويمكن التأكيد على أن اتجاه الغزالي نابع من حقيقة أنه يضع الاحداث العادية في نفس المستوى مع المعرفة الخاصة التي يتمتع بها الأنبياء. فالمعرفة التي تتأتى من المسار المعتاد للطبيعة، هي يقينية كمعرفة الأنبياء بأنه سيكون هناك استثناء (معجزة) في مسار الطبيعة، لأن كلا المعرفتين من الله[18] ولهذا من المقبول أن يقال أن الغزالي يرى أن: النبوة والوحي ما هي إلا شكل نموذجي من المعرفة لدى البشر.
في ظل هذه الرؤية، فإن إصرار ابن رشد على التعريف الأرسطي للمعرفة بصفتها تصور ماهية طبيعة الشيء يتجاوز حتى المصادرة على المطلوب. وهذا لأن ابن رشد يفترض -كما ذكرنا سابقا- بأن خوارق الطبيعة (وهو موضوع جوهري عند الغزالي)، لايمكن فهمها ولا حتى مناقشتها بعقلانية. بل إنه في الواقع، انتقد الغزالي مرارًا لتضمين كتابه جدالات لاينبغي أن تكون محل نزاع؛ خشية أن تضر بوظيفة الدين السياسية. في المسألة السابعة عشر، تعد حجّة ابن رشد السياسية ضد الغزالي مدعمة بحجة معرفية: فالمعرفة على هذا النحو شيء له علاقة بالطبيعة؛ ولهذا يجب أن تُستبعد الاسباب والأحداث الخارقة للطبيعة. وسواء كان ابن رشد يؤمن بحدوث المعجزات فعلًا، أو يقول أنها تحدث فقط لأجل مصلحة عامة المؤمنين، إلا أنها بحكم تعريفها لا تقع في نطاق الخطاب الأرسطي العلمي ” ولذلك يجب أن يُقال في أن مبادئها [أي الشريعة] هي أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية فلا بد أن يعترف بها مع جهل أسبابها “[19]. وهذا التأكيد في حد ذاته هو مصادرة على المطلوب لأنه لا يُعالج الأمثلة المضادّة المحتمَلة للنموذج “الفلسفي” للمعرفة – كالمعجزات مثلًا- بافتراضه عمليًا أن “السبب” و “المعرفة” هي مصطلحات بسيطة لاتنطبق على خوارق الطبيعة.
ومع ذلك، لدى ابن رشد ردّ أكثر وضوحًا حول اتهامه بالمصادرة على المطلوب، بسبب تفسيره لأهمية الله بالنسبة للأسباب الطبيعية. وبحسب رؤية ابن رشد، فإن انتظام الأسباب الطبيعية وقابليتها للتنبؤ هو دليل على حكمة الله. ويمكن لابن رشد أن يأتي بدليل على هذه الرؤية من القرآن، وقد استدلّ بـ: {فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًاْ}[20].فإن المعرفة العلمية إذن لا تعني تجاوزًا أو طعنًا في قدرة الله، بل إنها ممكنة فقط بحكمة الله، التي لا تسمح لطبائع الأشياء وعلاقاتها السببية بالتغيّر. وقد تعمّق ابن رشد في الدفاع عند إشارته لمذهب آخر هو يعتقده في التهافت، وتحديدًا قوله بأن علم الله بالأشياء هو سبب وجودها. وقد ذهب ابن رشد إلى حدّ معين بقوله أن علم الله بطبيعة الاشياء يجب أن يكون له نفس الموضوعية مثل معرفتنا، مع أن الحال مع علم الله هي العلاقة السببية، وكما أنها تفائلية: “فإن كان لنا في هذه الممكنات علم، ففي الموجودات الممكنة حال هي التي يتعلق بها علمنا.. وهذه هي التي يُعبّر عنها الفلاسفة بالطبيعة.. وكذلك علم الله بالموجودات، وإن كان علّة لها فهي أيضًا لازمة لعلمه، ولذلك لزم أن يقع الموجود على وفق علمه”[21]. ولكن الرد مفتوح أمام الغزالي بوضوح، فقد رفع ابن رشد المعرفة العلمية هنا بشكل فعلي إلى مستوى العلم الإلهي، بل في الحقيقة أنه أثبت الاثنين. لكن في مواجهة الغزالي، فإن هذا الرأي لا يزال يصادر على المطلوب. لأن ابن رشد يفترض -دون أن يبرهن- أن الحكمة والعلم الإلهي لا يتماشيان مع تغيير مسار الطبيعة، بينما يُصر الغزالي بشدة أن مثل هذه التغييرات ممكنة.
لكن ألا يملك ابن رشد مسوغًا لنقد الغزالي باعتبار أن موقف الأخير لا يجيز العلم الطبيعي مطلقاً؟ إذا كان الغزالي متمسّكًا بنوع من التفاؤلية المعرفية تجاه العلوم الطبيعية، فإن هذا يجب أن يعتبر مشكلة بالنسبة له. وإجابة هذا السؤال تسلط الضوء على موقفه العام من الفلسفة في التهافت. لنتذكّر أن الغزالي في الحقيقة سلّم للفلاسفة بأن هناك طبائع تنجم عنها تأثيرات. فهو بذلك يُتيح مجالًا للمعرفة العلمية عن تلك الطبيعة (مثل معرفة أن النار تحرق). وما ينفيه الغزالي هو أن هذه المعرفة تشكّل معرفة ضرورية، فالخطاب العلمي محدود وقاصر، لأنه لا يمكنه إثبات ما إذا كان السبب الطبيعي ستُبطله خوارق الطبيعة أم لا. لذلك الغزالي لايرفض المعرفة العلمية والفلسفية تمامًا. إنما يُثبت أنها لا تَرقى إلى ذلك المستوى المرتفع الذي وضعه الفلاسفة لأنفسهم، أي أن المعرفة بوصفها علاقات منطقيّة ضرورية.
وسأقدّم تمثيلًا لاستراتيجية الغزالي في التهافت. فهدفه ليس إظهار “تهافت” مذاهب الفلاسفة، بمعنى أن الفلسفة كلها متهافته. إنما هدفه بالأحرى هو إظهار أن الفلسفة يجب أن تندرج في مشروع فكري يكون الوحي فيه حاضرًا في معادلة المعرفة، بل إن الوحي يجب أن يُعتَبر أعلى نوع من المعرفة. تتمثّل استراتيجية التهافت في إظهار أن الفلسفة -المتمثلة في ابن سينا غالبا- قد تجاوزت نفسها في عدد من الحالات، لتصل إلى استنتاجات خاطئة، بينما الصواب هو الاعتراف ببساطة أنها عاجزة وقاصرة. وهكذا، في المسألة السابعة عشر، أشار الغزالي أنه فيما يتعلق بالمعجزات النبوية ” فإن مقادير ذلك الاختصاص [أي النبوة] لا ينضبط في العقل إمكانه، فلم يجب معه التكذيب لما تواتر نقله وورد الشرع بتصديقه.”[22] وبالمثل، في المسألة الثانية -باتباع منهج يقارب منهج موسى بن ميمون- يحتج الغزالي بقوله : “وإذا تبين أنا لا نُبعد بقاء العالم أبدًا من حيث العقل بل نُجوّز إبقاءَه وإفناءَه[أي العالم] فإنما يُعرف الواقع من قِسمي الممكن بالشرع ، فلا يتعلّق فيه النظر بالمعقول”[23]
على الرغم من النظرة التقليدية للغزالي بأنه مناهض للعقلانية، ومجرد معارِض ناقمٍ على الفلسفة، إلا أن تحليلنا للمسألة السابعة عشر يُشير إلى أن موقفه من الفلسفة دقيق وأقلّ راديكالية من المشهور عنه. لا ينبغي تصنيف الغزالي في كتابه التهافت كمناهض للعقلانية، بل تصنيفه ممن اهتمّوا بوضع الفلسفة في موضعها الصحيح. ولرؤية موقف مشابه له في أوروبا إبان العصور الوسطى، فإننا لا نتجاوز القديس توما الاكويني. على الرغم من اعتبار الأكويني عقلانيًا أكثرَ بكثيرٍ من الغزالي،[24] إلا أننا نجد عنده استراتيجية غزالية للحد من ادعاءات الفلسفة، مثلا : السؤال 12 من بريما بارس، حيث يجادل الأكويني بأن العقل البشري في حد ذاته غير قادر على معرفة الله، لذلك يحتاج البشر إلى مساعدة غيبّية لتحقيق كمالهم. وهذا لايعني بأن رأي الأكويني حول قضية السببية خصوصًا يمكن مقارنته مع رأي الغزالي. ولكن بدلًا من ذلك، فإن الغزالي مثل توما، ويمكن اعتباره متعاطفًا مع الفلسفة في حدودها المناسبة، حتى مع اعتقاده بأن الفلسفة ليست أعلى نموذج في المعرفة الإنسانية.
[1] تُرجم هذا المصطلح في موسوعة لالاند الفلسفية إلى (الظرفية)، وفي المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى (مذهب المناسبة)، وجاء في شرحه: “المناسبة ظرف يهيئ لحدوث نتائج معينة. ومذهب المناسبة قال به مالبرانش (۱۷۱۰م)، ويتلخص في أن المخلوقات وأفعالها مجرد مناسبات لوجود موجودات وأفعال أخرى يفعلها الله، وقد سبق إليه أبو الحسن الأشعري. والكلمة المقابلة في الاستعمال الإسلامي هي الاقتران، أو جريان العادة”، وهي تحمل معنى المقولة المشهورة في علاقة الأسباب بمسبباتها: “عندها، لا بها”. وقد آثرنا مصطلح (الاقتران) عند الحديث عن الغزالي خاصة؛ مراعاة لمصطلحه الذي بدأ به المسألة السابعة عشرة من كتابه «تهافت الفلاسفة». (الإشراف).
[2] في الترجمات اللاتينية والأوروبية لكتاب الغزالي ظهرت كلمة “التهافت” بمعانٍ مختلفة، فمنها Ruina (الهدم باللاتينية)، و destruction (الهدم بالإنجليزية)، و collapse (انهيار)، chute و effondrement (تساقط بالفرنسية)، و incoherence (تناقض). ومن العسير أن نحدد المعنى الذي كان يقصده الغزالى من عبارة “تهافت الفلاسفة”، لاحتمالها معانی عديدة، وقد يكون المقصود حماقات الفلاسفة؛ أو تساقط مذاهب الفلاسفة، مع حذف كلمة مذاهب لدلالة الكلام عليها؛ أو ضعف وفساد مذاهب الفلاسفة، على طريقة الحذف أيضا، أو مسارعة الفلاسفة بلاروية ولا إعمال فكر إلى تقليد مذاهب باطلة اعتقدوها فتساقطوا بسببها في الهلاك الأبدي، وتهافتوا في النار؛ أو مضاحك الفلاسفة ومهازلهم. انظر: ( مقدمة التهانت ص 6). (الإشراف)
[3] An argument against the occasionalist reading of al-Ghazālī is mounted in L.E. Goodman, “Did al-Ghazālī Deny Causality?,” Studia Islamica 47 (1978), pp. 83-120. A more occasionalist reading is given in Binyamin Abrahamov, “Al-Ghazālī’s Theory of Causality,” Studia Islamica 67 (1988), pp. 75-98, which also takes account of al-Ghazālī’s writings outside the Tahāfut. Ilai Alon, “Al-Ghazālī on Causality,” American Oriental Society Journal 100 (1980), pp. 397-405, argues that al-Ghazālī is trying to compromise between the theological and philosophical views. Another discussion can be found in Stephen Riker, “Al-Ghazālī on Necessary Causality,” The Monist 79 (1996), pp. 315-324
[4] The only treatment of this issue I have found is Michael Marmura, “Ghazali and Demonstrative Science,” Journal of the History of Philosophy 3 (1965), pp. 183-204. Marmura raises some of the same topics I treat here, notably the tension between knowledge and occasionalism and the importance of the creation of knowledge by God. Marmura’s reading of al-Ghazālī is, however, more occasionalist than my own, so that we reach different conclusions about al-Ghazālī’s epistemology.
[5] See Goodman, pp. 84-5.
[6] تذكرنا وجهة نظر الغزالي بالرأي الذي حدده الكندي في أطروحته القصيرة عن الفاعل الحق في كتاب الفلسفة الأولى من رسائل الكندي الفلسفية – ت: محمد عبدالهادي ابو ريدة – م: 1 – ص: 182-184 (القاهرة 1950)، يجادل الكندي في هذه الرسالة بأنه على الرغم من أن الله هو الفاعل الحق، فإن تأثيراته هي الفاعل الحقّي الثاني -مجازا-، من خلال اعتمادها عليه.
[7] تهافت التهافت لابن رشد، تحقيق: محمد العريبي، دار الفكر اللبناني – بيروت 1993، ص: 296
[8] – في نظرية المعرفة يمكن التمييز بين رؤيتين أو إجابتين على سؤال إمكان المعرفة، وهما غير متعارضين، ولكنهما تبرزان جوانب مختلفة من حالتنا المعرفية؛ يرى بعض الواقعيين والمتفائلين المعرفيين epistemological optimists أننا قادرون في الغالب على اكتساب المعرفة حول العالم الموضوعي؛ ومقتنعون بأنه على الرغم من صعوبة الأمر، فإننا يمكننا الوصول إلى معرفة موضوعية بالعالم على ما هو عليه/ العالم في ذاته. وضد هذا التيار هناك التشاؤم المعرفي epistemological pessimism. (الإشراف)
[9] – اللاهوت الإيجابي فيما يتعلق بصفات الله يعني إمكانية إسناد صفات محددة للذات الإلهية، كالسمع والبصر والقدرة والعلم…إلخ، وهذا في مقابل اللاهوت السلبي الذي يعني وصف الإله بالسلوب فقط، وعدم إسناد صفات إيجابية له. (الإشراف)
[10] النور المحض، الباب الخامس “وكل شيء إنما يعرف ويوصف من تلقاء علته، فإذا كان الشيء علة فقط وليس بمعلول، لم يعلم بعلة أولى ولا يوصف لأنه أعلى من الصفات، وذلك أن الصفة إنما تكون بالمنطق” المصدر: https://www.graeco-arabic-studies.org/single-text/text/badawi-94/page/9.html
[11] تهافت التهافت – ص:290-291
[12] A similar point is made by Marmura, p. 200
[13] وبالطبع هذا لا يستبعد أن يكون هناك شيء آخر قد يعيق سببًا من إحداث تأثيره، كما في حالة وجود شيء ما على اتصال بالنار لكنه لا يحترق لأنه مغطى بالطلق. وتناول ابن رشد هذه النقطة، معبرا بأن السببية قد تتعطل (وهي بهذا المعنى ليست ضرورية)، لكن هذا لا يعني أن النار فقدت اسمها أو حدها، أي الطبيعة التي تجعلها تسبب الاحراق. تهافت التهافت – ص: 291
[14] تهافت التهافت – ص:295. نقلا عن الغزالي.
[15] يشير Goodman (ص 105) إلى أن ترجمة Van Den Burgh تحذف جملة “فليس هذا الكلام إلا تشنيع محض”، وقد ترجمها: “…محض سخافة” بمعنى أن الغزالي يصف موقف علماء الدين بأنه سخيف. أما Marmura الذي يدافع عن قراءة تميل أكثر لاقترانية الغزالي، يترجم نفس الجملة، على أنها إشارة إلى الفلاسفة. من الواضح أن الأخيرة هي الأفضل، مما يشير إلى أن الغزالي يشير في الواقع إلى النقد الذي وجهه إليه الفلاسفة. Riker, p. 319.
[16] تهافت التهافت – ص:300، 258. نقلا عن الغزالي.
[17] تهافت التهافت – ص:296.
[18] تهافت التهافت – ص:295-296.
[19] تهافت التهافت – ص:294
[20] سورة فاطر الاية 43.
[21] تهافت التهافت – ص:296
[22] تهافت التهافت – ص:298. نقلا عن الغزالي.
[23] تهافت التهافت – ص:84. نقلا عن الغزالي.
[24] -هذه وجهة نظر المؤلف، لكن تتابعت الأبحاث العلمية على الإشارة إلى أن الغزالي كان أداة رئيسية في البناءات الفلسفية التي شيدها الإكويني. انظر: لويس صليبا، موسوعة القديس توما الأكويني (1225 – 1276)، الجزء الخامس منها بعنوان «توما الأكويني والإسلام»(لبنان، 2011). الإشراف.