“ذهبتُ في بدايةِ الكتابة إلى بعضِ الأدباء وزرتُ مجلاتٍ وصحفًا؛ لأعرضَ عليهم شيئًا ممَّا كتبت، فلا أذكر أنَّ أحدًا منهم شجعني وأخذَ بيدي، شاعرٌ كبير قرأتُ له مقالة فقال لي: لا تسرق! وأستاذ له قدره أبى أن يستمعَ إليَّ بحجة أنه ما عاد يحفل بمثلِ هذا.. ورئيس تحرير مجلة نهرني في الهاتف، ورئيس تحرير مجلة أخرى خرجتُ من مكتبه شبه مطرود، ومسؤول في مجلة طيَّب خاطري بكلمة سريعة وهو يمشي لاستقبال ضيوفٍ عنده في المكتب … وهكذا طويلًا من الإهانةِ أو شبهها، حقيقة لا أدري لم كان هذا لكنه ما كان، فكرهتُ أوهام النُّخبة وبصقتُ المداد عليها، وعدتُ أدراجي-منكسرًا-إلى عزلتي ومكتبتي لسنواتٍ لا أكاد أعرفُ أحدًا”. مما قاله الأستاذ الهدلق في الحديثِ عن شيءٍ من تجربته.
ما كتبه الهدلق أعاد إلى ذهني كثيرًا من الأمورِ التي كنتُ قد نسيتها أو تناسيتها، ففي كتابي “اغتيال الربيع”، ألمحتُ إلى فكرةٍ كهذه، عن أديبٍ شابٍّ، يُعرِضُ عنه الكبار، تُغلَقُ في وجهه الأبواب، وعندما يموتُ في حادثِ سيرٍ مفاجئ، يُدركُ من حوله قيمته، ومكانته كأديبٍ بارع، فيسارعونَ في تكريمه وقد وُسِّدَ الوجه الحالمُ تحتَ الثَّرى!. “فعندما ترتفعُ الرُّوح، ينتشرُ شداها بينَ الخلق، فتُرىٰ كما لم تُرَ من قبل.. ويعيشُ صاحبها حيًّا بينَ الأمواتِ الأحياء، بعد أنَ كانَ ميتًا بينهم في لحظةٍ ما..”.
أخذتني تجربة “الهدلق” إلى تذكُّرِ بعضِ الأدباء الذينَ اكتشفهم أدباء آخرون، وكانوا سببًا في إبرازهم، والأخذ بأيديهم إلى السَّاحة الأدبية، والتبشيرِ بهم، ولا يفعلُ هذا إلا كبير النَّفس، وبعيد النَّظر.. كما فعل “سيِّد” عندما اكتشفَ موهبة “محفوظ” الفذَّة في السَّردِ والقص، وأظهرها، وتنبَّأَ به ليكونَ أفضل قاصٍّ مصري، وقد كان. فبعد أن قدَّمَ “سيِّد” قراءة نقدية فنيَّة لـ “خان الخليلي” للأديب الرَّاحل نجيب محفوظ، ختمَ حديثه قائلًا: “وكل رجائي ألا تكون هذه الكلمات مثيرة لغرور المؤلفِ الشَّاب المرجو-في اعتقادي- لأن يكون قصاص مصر في القصَّة الطويلة. فما يزال أمامه الكثير لتركيز شخصيته والاهتداء إلى خصائصه، واتخاذ أسلوب فني معين توسم به أعماله وطابع ذاتي خاص تعرف به طريقته”[1]. وفي رأيي ما زال “محفوظ” يتربَّع عرش القصة والرواية العربية، كأعظم ساردٍ وقاص بزغَ نجمه من أزقة “حي الجمالية” إلى فضاءِ العالمية!
ومن الأدباءِ الذين يملكونَ ظلًا خفيفًا، وقلمًا رشيقًا، واستحضارًا جيدًا للأدبِ الرُّوسي الموغلِ في أغوارِ النَّفسِ ومتاهاتها؛ الأستاذ الرَّاحل “رجاء النَّقاش” ومما يخفى عن النَّقاش، أنه صاحبُ الفضلِ في إظهارِ العديدِ من الأعمالِ الأدبية الرَّائدة المعاصرة، فهو الذي أظهرَ أديبَ السُّودان، “الطيَّب صالح”، وأسهمَ في إشهار وتقديم روايته الذَّائعة: “موسمُ الهجرة إلى الشمال” لدى الجمهورِ العربي، وكذا فعل مع درويش القصيدةِ محمود، إذ كتبَ عنه كتابًا بعنوان: “محمود درويش شاعر الأرض المحتلة” فبعثَ له الأخير رسالة ود وعرفان، عبَّر فيها عن حبِّه وامتنانه، قال فيها[2]:
“عزيزي رجاء النَّقاش.. كنتَ وما زلتَ أخي الذي لم تلده أمي، منذ جئتُ إلى مصر، أخذتَ بيدي وأدخلتني إلى قلبِ القاهرة الإنساني والثقافي، وكنتَ من قبل قد ساعدت جناحي على الطيران التدريجي، فعرفتَ قراءكَ علي وعلى زملائي القابعينَ خلف الأسوار.. عمقتَ إحساسنا بأننا لم نعد معزولينَ عن محيطنا العربي”.
عرفتُ النَّقَّاش عن قرب، والتقيته مرارًا عبر صفحات كتابه النَّابض بالإنسانية والأدب والجمال، “تأملاتٌ في الإنسان” أو “التَّماثيل المكسورة” في تسميته الأولى، قرأته كثيرًا، وما زلتُ أعودُ إليه بينَ الفينةِ والأخرى.
في فترةٍ سابقة كنتُ أقرأ في كتاب: “جنون آخر” لممدوح عدوان، ذكرَ بشكلٍ عابر شيئًا عن الصِّدام الذي دار بين “النَّقاش وأدونيس”، بسبب مواقفِ الأخير السياسية المتقلبة، فـكتبَ-النقاش-مقالًا بعنوان: “أيها الشَّاعر الكبير إني أرفضك”[3]، يعني أدونيس؛ ولهذا الذكر العابر الذي أورده “عدوان” في كتابه، تذكرتُ النَّقاش، وذكرياتي معه في كتبه، وإسهامه في اكتشافِ المواهب الأدبية. وقد رحلَ “رجاء” تاركًا وراءه العديد من الأعمالِ الأدبية والنَّقدية، وعند رحيله وَصَفَه بعضُ النُّقاد: “بأنه من الكُتَّاب الذين يتقونَ الله فيما يكتبون”، وهو معنى صحيح تمامًا في وصفِ هذا الأديب، فهو لا يستهينُ بقارئه أبدًا، ولا يجعل ميزانه يميلُ عن الحقِّ والإتقانِ والجمال”.
وعلى ذكر ما وقعَ بين النَّقاش وأدونيس، أتذكرُ أني كنتُ في فترةٍ من فتراتِ العمر المبكرة، مولعًا بقراءةِ المجلات الثقافيةِ المختلفة.. تأتي على رأسها مجلة “دبي الثَّقافية”، تنفتحُ شهيتي لها بسببِ الكتابَيْنِ الذَيْنِ أحصلُ عليهما هديةً في كلِّ عدد! في تلك الفترة كنتُ أوهمُ نفسي أني أمتلكُ حدًّا أدنى من الثَّقافة، باعتبار معرفتي وقراءاتي لكبارِ الكتَّاب، واهتمامي بالشَّأنِ الثقافي.. في صوره المتعددة!
لكنَّ الشيء الذي كان يصيبني بإحباطٍ شديد، ويفتني كالوهنِ في رغبتي بالاستمرار.. قراءتي للعمود الذي يكتبُ فيه “أدونيس”، كنتُ أنتهي منه بصعوبةٍ بالغة، وعندما أصلُ إلى دكَّةِ الختام لا أذكر أني فهمتُ شيئًا، وهنا أتوجه باللومِ إلى نفسي العاجزة، المفتقِرة إلى أدواتِ الفهم، ومجاراةِ الإبداع.. فنحنُ مذنبون؛ لأننا نعجز عن فكِّ الإلغاز في لغةِ أدونيس.. هكذا كنتُ أحدِّثُ نفسي!
الذي كان يخففُ عني شيئًا من هذا الإحباط، أني أقرأ الأعمدة الأخرى، والتي كان يكتبُ فيها أديب اليمن وشاعرها “المقالح”، والأديب اللساني “عبد السَّلام المسدي” و”تاج السِّر” و”واسيني الأعرج”، فأشعر بأنَّ الفهمَ عاد إليَّ بعد أن غادرني مذ بدأتُ القراءةَ لأدونيس!
في فترةٍ خلت، قرأتُ مقالًا طويلًا للكاتبِ المعروف “سليم بركات” عن ذكرياته مع “محمود درويش”، وقد أثار المقال ضجَّة كبيرة بسببِ إفشاء “سليم” سرَّ درويش الذي كان بينهما[4].. لكنَّ هذا الأمر لا يهمني هنا.. ما يهمني، اللغة التي كُتبَ بها المقال، فقد كانت مبهمة، معقَّدة، لا تصلُ إلى منتهاه إلا وأنتَ تشعرُ بإرهاقٍ شديد، هذا إذا تمكنتَ من الوصولِ إلى آخره! وهذا ما دعاني إلى استحضاره كنموذجٍ مشابهٍ لأدونيس.
وما زال السُّؤال قائمًا؛ هل نحنُ أغبياء لا نفهمُ المكتوب.. أم أنهم تعودوا الإلغاز والرمزية المفرطة في اللغةِ التي يكتبونَ بها، لنتوهم بأننا أغبياء؟! أجدني أردِّد ما صَرخَ به النَّقاش: “أيها الشَّاعر الكبير إني أرفضك”.
على النَّقيض من نمطِ الشَّاعر “أدونيس” و “بركات”، عشتُ فترةً أقرأُ لأديبٍ من أعظمِ أدباءِ العربية، لا يتكرَّر إلا مرة كل عشرات السِّنين.. لغته عالية، رفيعة، تشعرُ وكأنَّكَ تحلِّقُ في مرتفعاتٍ بعيدة لا يصلها إلا القليل والقليل جدًّا.. وما إن انتهيتُ من قراءةِ كتابه، شرعتُ في قراءةِ كتابٍ آخر لأديبٍ آخر.. أحسستُ أني هبطتُ من مكانٍ عال، بدا لي أني أسيرُ في طرقاتٍ مزدحمة متعثرة، تتسمُ بأجواءٍ خانقة لا صفاءَ فيها.. لم أعد أجدُ لذَّةَ العلو الأدبي الخالد الذي لامسني فترة قراءتي لذلكَ الأديب.. غابَ السحر الذي تلبَّسني.. فيممتُ مسرعًا أبحثُ له عن كتابٍ آخر؛ لتعود حالتي الأولى التي أنِسْتُ بها.. فلذتُ بأحدها؛ لأجد للحرفِ لذَّة، وللكلمةِ قوة.. وللعربيةِ مهابة و قارًا، وهناك فقط عرفتُ ما معنى الأدب.
والأديب الذي أقصده بحديثي، شيخُ العربية وأديبها الفذ العلامة محمود شاكر، صاحب المتنبي، فمن الأمور التي أقفُ حيالها متعجِّبًا، وأحيانًا أشعرُ بشيءٍ من الإحباط كلما مرت بخاطري؛ صناعته لكتابه ذائع الصيت “المتنبي” وهو في السَّادسة والعشرين من العمر! هذا الأمر قد لا يعني الكثير لبعضهم؛ لكنه يعني لي الكثير، وكل من مرَّ على الكتابِ ولو مرورًا عابرًا؛ يدركُ حجم الدهشة التي تتملكُ القارئ عند السَّير في قراءةِ الإبداع الشَّاكري الفاخر!
في إحدى اللقاءات التي نُشِرَت مؤخرًا يذكرُ “شاكر” شيئًا عن كتابه المتنبي، ومدى فخره واعتزازه به، وبالمنهج العلمي الذي سار عليه، فقد كتبَ كتابه: “المتنبي على منهجٍ فريد، مباين كل المباينة لكل ما كان معروفًا من مناهج البحثِ حتى عام 1935” بل، ويذهب معتقدًا أنَّ التكريم الذي حظيَ به كان بسبب كتابه “المتنبي”، ففي حواره المشار إليه مع الدكتور محمود الشرقاوي، يقول رحمه الله: “إنَّ الكتاب الذي رشحني لنيل هذه الجائزة-يقصد جائزة الملك فيصل-كان كتاب “المتنبي” الذي كتبته وأنا في السادسة والعشرين من عمري عام 1935، إلا أنَّ التقدير الأولى لي هو أن الله هداني مبكرًا لأدرك دوري، ووضعني على الطريق الصحيح الذي أخدم به ديني ولغتي وأمتي، ولذلك فأنا أعتبر أن كل يوم مرّ من عمري هو تقدير متجدد لي، يهتف بي دائمًا “سر إلى الأمام.. فأنتَ على حق”[5].
استوقفني قوله: أنَّ الله هداه مبكرًا ليدركَ دوره جيدًا، ووضَعَه على الطَّريق الصحيح” فلا تعجب إذا رأيتَ النتاج الأدبي الرَّصين الذي تركه شاكر، وتحقيقاته العظيمة، وكتاباته المتناثرة في شتى فنون العربية والتراث؛ لأنها ثمرة الإدراك المبكر للطَّريق، الأمر الذي يسهمُ في اختصار الزَّمن، وقلة الالتفات، والمضي صوبًا للدورِ الذي ارتضاه لنفسه!
إعجابي بـ”شاكر” نابعٌ من الرُّوح الثَّورية التي تُقذَفُ في روعكَ وأنتَ تقرأ له، والعزَّة التي تكتسبها من سياقِ حديثه، وفخامة العربية وعلوها، التي تشعر بهيبتها في نفسك، وقلمك.. والشيء بالشيء يُذكر، فلا بدَّ من استحضار العميد طه حسين في مقامٍ عابرٍ كهذا، لما كان بينه وبين شاكر من خبرٍ معلومٍ عند أصحابِ الأدب، ومع أني قرأتُ لـ”طه”، وطربتُ لأسلوبه العذب، وطريقته السَّلسة في الكتابة، إلا أنه لم يأخذ بتلابيبي كما صنعَ شاكر، ربما يعودُ ذلكَ لاستعداد النَّفس لاستقبالِ الأسلوب، باعتباره الوجه الآخر للإنسان، وهنا يكمنُ التَّمايز بينَ القبول والرَّفض..!
وعلى ذكر طه حسين، يحضرني إعجاب أديب المغرب الأكاديمي “عبد الفتاح كيليطو” بشخصيةِ طه، ففي الحوارِ الذي أجراه معه الباحث والمترجم الأمريكي “روبن كريسويل”[6] للاقترابِ من بعضِ الأسئلة، والإشكاليات التي تهمُّ الثقافة العربية من جهة، وأنماط اتصالها بالآخرِ من خلالِ التَّرجمة من جهةٍ أخرى، لفتَ نظري تأثره وإعجابه الكبير بالرَّاحل “طه حسين”، ومما وردَ في سياقِ الحوار: “كان لديَّ انجذابٌ شديد لـ”طه حسين”. وأنا مدينٌ لهذا الرجل في الإحاطةِ، علمًا بأنَّ أي شيء وكل موضوع قابل للمطارحة. لم يكن طه حسين يُهادنُ أحدًا”. وقال أيضًا: “لم يبقَ ثمة بعد طه حسين أي شيء قابل للإعجاب، ولَم يعد ثمة وجود لأبطال”. وختمَ بقوله: “كان يساورني انطباعٌ وأنا أقرأ طه حسين بأنني أكتسبُ ذكاءً وألمعية”. وأنتَ مدركٌ حجمَ الإعجاب الذي تركه صاحبُ “الأيام” المشرقي، على الأديبِ النَّاظرِ “من شرفةِ ابن رشد” في المغربِ العربي .
وبالعودة إلى التجربة الملهمة التي ذكرها الأديب المثقف عبد الله الهدلق، عند قوله: “وعدتُ أدراجي-منكسرًا- إلى عزلتي ومكتبتي لسنواتٍ لا أكاد أعرف أحدًا”. في ظني أنه ما فعل ذلكَ إلا لأنَّ الله هداه مبكرًا لإدراك دوره، ووضعه في الطَّريق الصَّحيح، كما قال شاكر؛ ولهذا نجده يذكر ثمرة الطَّريق الذي سار فيه وارتضاه لنفسه، في قوله: “ثم خرجتُ أقوى مما كنتُ عليه، وكتبتُ وواصلتُ إلى أن رحَّبَ بي الأدباء، وعُرضت عليَّ الكتابة-بإلحاح من بعضها وإغراء وبما أريد من مساحة ويوم- في أكثر من عشرٍ من الصحف والمجلات، بعضها مما خرجتُ منه شبه مطرود!” و الهدلق أديبٌ ومثقفٌ كبير، وقارئٌ موهوب، مثار الإعجاب لكثيرٍ من روَّاد الأدبِ والفكر إلى اللحظة. آثرَ العزلة على صخبِ الحياة الثقافية؛ لأنه لم يكن قد درسَ على طرائقِ طلبةِ العلم التقليدية، ولم يكن على علاقةٍ بنوادي المثقفين؛ لهذا السبب ختم تجربته قائلًا: “فقد كنتُ غريبًا على هؤلاءِ وهؤلاء، فاستوحشَ كثيرٌ منهم من هذا الذي هبطَ عليهم لا يدرون من أينَ جاء! فكان استيحاشهم مني باعثًا لأُنسي بنفسي”.
لقد تركتُ العنان للقلم أن يثرثرَ كثيرًا، آمل أن يُستلطفَ هذا التَّطواف عن الأدباء، وشيء مما يتعلقُ بهم، وإن أحسستَ أني استطردتُ كثيرًا، فلستُ ببدعٍ من الكتَّاب الذين شكَّل أسلوب الاستطراد نمطًا من أنماطِ الكتابة لديهم، كشيخِ العربية والبيان أبي عمرو الجاحظ في القديم، وأديب الفقهاء علي الطَّنطاوي في العصرِ الحديث، فكلاهما كان من أكثرِ الأدباء استطرادًا. وأين استطرادهم من استطرادي، لكنه عذرُ التشبه بالكبار؟!
أجدني أشعر برغبةٍ ملحة أن أختمَ هذا الحديث الطويل، بكلمةٍ لطيفةٍ أوردَها الطَّنطاوي في “ذكرياته” عن أسلوبِ الاستطراد الذي ابتُلي به، وبات عادةً له في كل كتاباته، إذ يقول رحمه الله: “قد صار الاستطراد عادةَ لي، أعترف أنها عادة سيئة، ولكن ما أثر العادات السيئة التي لزمتنا فلم نستطع الانفكاك عنها، ولو كانت من المحرَّمات لأكرهتُ نفسي على تركها، فليس لمسلم يأتي المحرَّمات أن يحتجّ بتعُّوده عليها، ولكنها لسوء حظي ليست من المحرّمات.
ولطالما كنتُ أخطبُ في الحشدِ الكبير، أو أتكلم في الإذاعة أو الرائي (التلفزيون)، وأحاديثي فيهما كلها ارتجال، ليس أمامي ورقة مكتوبة أقرأ فيها، فأستطرد وأخرج عن الخط، فإذا انتهى الاستطراد وقفتُ كما وقف حمار الشيخ في العقبة، فلا أذكر من أين خرجت، ولا إلى أين أعود!
ولا تسألوني من هو هذا الشيخ، فإن المثل خلّد ذكر الحمار، ونسي اسم الشيخ، ليعلمنا أن خلود الأسماء ليس الدليل على عظمة أصحابه”[7].
[1] كتب وشخصيات، سيد قطب, ط3, دار الشروق, 1983, ص165.
[2] بمناسبة حفل تكريم أقيم لرجاء النقاش بمناسبة بلوغه الثالثة والسبعين, في نقابة الصحفيين المصريين في العام 2008م.
[3] جنون آخر, ممدوح عدوان, ط4, دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع, ص50.
[4] مقال الشَّاعر سليم بركات في “القدس العربي” المنشور في 6/6/2020 تحت عنوان: “محمود درويش وأنا”.
[5] مقابلة خاصة لم تنشر من قبل, مع العلامة أبو فهر
[6] انظر إلى الحوار بتمامه
[7] ذكريات علي الطنطاوي, ط3, دار المنارة للنشر والتوزيع, ص11 .

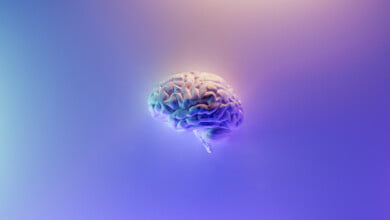



ما كل هذا الجمال.. ابداع منقطع النظير