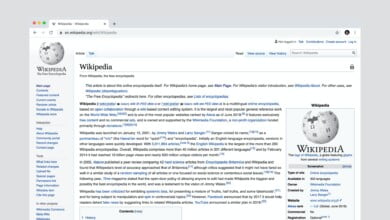- توماس ويتكوفسكي
- ترجمة: مصطفى هندي
عندما هبط الجنود البيض على جزر المحيط الهادئ، كان السكان الأصليون مفتونين بوفرة السلع والمؤن التي جلبوها معهم، وراقبوا بجدية سلوك الزوار. وخلصوا إلى أن الطيور العظيمة في السماء (الطائرات الحربية) -المحملة بصناديق الإمدادات التي تحمل نقش “بضائع”- كانت هدايا من الآلهة. لذلك، بدؤوا في تقليد الوافدين الجدد، وبناء مدارج في وسط الغابة، وإشعال الحرائق على غرار نمط أضواء مهبط الطائرات، وبناء أبراج تحكم صغيرة من الخشب والخيزران. ثم انتظروا إحسان الآلهة، لكن آلهتهم لم تعرهم انتباهًا. فلم تهبط الطائرات على مدارجهم، على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلوها في بنائها والدقة في نسخ مباني ومعدات الجنود البيض. حتى اليوم، تستمر ديانات المؤن cargo cults الحربية هذه في بعض أنحاء أوقيانوسيا.
في خطاب ألقاه في حفل الحصول على درجة علمية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، قارن ريتشارد فاينمان -الفيزيائي الشهير والحائز على جائزة نوبل في عام 1974- العلوم الاجتماعية وشعائرها البحثية بطقوس ديانات المؤن الحربية؛ وجادل بأن ممثلي العلوم الاجتماعية لا يحسنون سوى تقليد سلوك ومناهج العلوم الأخرى، ولكن دون جدوى؛ تمامًا كما يبنى أتباع ديانات المؤن مدارج للطائرات المتوهمة. لم يقف فاينمان عند هذه المقارنة، بل سرد أمثلة من مجالات إعادة التأهيل والعلاج النفسي وعلم التخاطر. وذكر أنه على الرغم من الجهود الهائلة المبذولة في البحث وإتقان طرق التدريس، فإن نتائج الطلاب كل عام من سيء إلى أسوأ. وينطبق الشيء نفسه على علم الإجرام والمشكلات الأخرى التي تحاول العلوم الاجتماعية حلها؛ هل كان فاينمان على حق؟
ضجيج أتباع “الشعائر البحثية”
ينطبق المثل القائل “تمخض الجمل فولد فأرًا” على العديد من المجالات، حيث تسفر الجهود الكبيرة عن نتائج تافهة؛ بل في بعض الأحيان لا تزيد الجهود المبذولة الوضع إلا سوءًا. في ديسمبر 2020، نُشر تحليل تلوي/ ما بعد إحصائي meta-analysis[1] شامل يغطي 50 عامًا من البحث في فعالية التدخلات المختلفة التي تهدف إلى منع الانتحار وإيذاء النفس. قام فريق بحثي بقيادة كاثرين فوكس من جامعة دنفر و زينينج هانج من جامعة ولاية فلوريدا بتحليل 1125 بحثًا من أكثر الأبحاث المعترف بدقة منهجيتها، والتي أجريت في نصف القرن الماضي. من بين أمور أخرى، تناول البحث التدخل في حالات الطوارئ، والعلاج النفسي الديناميكي، ودعم الأقران، والرعاية الاجتماعية، والعلاج بالعقاقير، والاستشفاء، وطرق التحكم الخارجية، والمناهج المعرفية والسلوكية، والعلاج النفسي الجدلي والسلوكي، بالإضافة إلى طرق العلاج النفسي الأخرى. كانت النتائج محبطة؛ فقد تبين أن فعالية جميع الطرق التي تم فحصها منخفضة للغاية، وأن التأثيرات لا تدوم طويلاً بعد التدخل، ولا يوجد فرق جوهري بين الطرق المختلفة. لكن الأكثر إثارة للدهشة هو اكتشاف أنه على الرغم من النمو الهائل تقريبًا في كمية البحث في هذه الأساليب، فإن فعاليتها اليوم منخفضة كما كانت قبل 50 عامًا! وعلى تنوع المناهج، لم تُكتشف أي مؤشرات من شأنها أن يكون لها تأثير حاسم على فعالية التدخلات المعترف بها لمنع الانتحار.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ففي الفترة من الستينيات إلى عام 2012 -وهي الفترة التي لم تتحسن فيها أساليب مساعدة أولئك الذين يرغبون في قتل أنفسهم- ارتفع عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف من السكان بنسبة 60 بالمائة. اليوم، يقتل حوالي 1.5 في المائة من السكان أنفسهم. وصار الانتحار هو أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين الشباب، والمسؤول عن حوالي 20 في المائة من جميع الوفيات بين المراهقين. مقابل كل عملية انتحار تامة هناك ما بين 10 و 40 محاولة فاشلة. في الولايات المتحدة وحدها، تقدر تكاليف الانتحار بنحو 94 مليار دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، يمارس حوالي 5.5 في المائة من جميع البالغين إيذاء الذات بشكل مستمر، ويصل هذا الرقم بين المراهقين إلى 17.2 في المائة. والسؤال هو: هل الجهد المبذول في نصف قرن من البحث وتحسين الأساليب في مساعدة المقدمين على الانتحار يختلف حقًا عن الضجة والصخب التي يثيرها أتباع ديانات المؤن الذين لم يتمكنوا من استقدام الطائرات المتوهمة إلى مدارجهم؟
هذا التحليل التلوي ليس الدراسة الوحيدة من نوعها التي تُظهر عجز العلوم الاجتماعية فيما يتعلق بمشكلة الانتحار. في عام 2017، نشر فريق بحثي بقيادة جوزيف فرانكلين من جامعة هارفارد نتائج تحليل تلوي آخر، والذي أظهر أن 50 عامًا من البحث في تنبؤات الانتحار لم توفر لنا تنبؤات أكثر موثوقية من رمي العملة!
في ضوء ما سبق: يقول كل من الباحثين والممارسين الذين يستخدمون هذه الأساليب عند العمل مع المرضى في كثير من الأحيان أنه بدون جهودهم قد تكون مؤشرات الانتحار أعلى، وأن مستوى فعاليتهم المنخفض أفضل من لا شيء. ومع ذلك، إذا كانت طرق التدخل البسيطة قصيرة الأجل فعالة مثل البدائل طويلة الأجل والمعقدة والمكلفة (على سبيل المثال: العلاج النفسي الديناميكي)، فليس هناك ما يبرر استخدام هذا الأخير، إلا المصلحة الاقتصادية لمقدمي المساعدات.
التدخل الفعال
بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات أخرى إلى أنه يمكن تغيير عدد حالات الانتحار بطرق خارج نطاق العلوم الاجتماعية والنفسية. حتى الآن، كانت أنجح طريقة لمنع الانتحار هي أنواع مختلفة من القيود على الوسائل والفرص التي تؤدي إليه. حوالي ثلث حالات الانتحار في جميع أنحاء العالم تتم باستخدام مبيدات الآفات السامة؛ خلال الثمانينيات والتسعينيات، كان لسريلانكا أعلى معدل انتحار في العالم، وعندما بدأت الأمم المتحدة في الحد من سهولة الوصول إلى المبيدات الحشرية، كان هناك انخفاض بنسبة 70 في المائة في العدد الإجمالي لحالات الانتحار. حدث انخفاض مماثل في بنغلاديش بعد إدخال اللوائح للحد من الوصول إلى مبيدات الآفات السامة، وأدى حظر بيع مبيدات الحشائش التي تستخدم بشكل متكرر في كوريا الجنوبية كسم إلى تقليل فوري لهذا النوع من الانتحار وحالات الانتحار بشكل عام. وقد تم تطبيق إجراءات مماثلة بنجاح في الصين ونيبال. بالطبع، من المستحيل استبعاد العوامل الأخرى التي تؤثر على انخفاض معدلات الانتحار تمامًا، ولكن يبدو أنه ثبتت نجاعة القيود الموضوعة على الوسائل.
كما أدى تقييد الوصول إلى الأسلحة النارية والأدوية السامة والمواد المسكرة -مثل الكحول والوسائل الأخرى- إلى تقليل العدد الإجمالي لحالات الانتحار. في شرق آسيا خلال التسعينيات، كانت إحدى الطرق الشائعة للانتحار هي حرق الفحم في مكان مغلق لتوليد تركيز قاتل من أول أكسيد الكربون. لذلك أزالت محلات البقالة الفحم من أرفف الوصول المفتوح، وكان على العملاء أن يسألوا مندوب المبيعات إذا كانوا يريدون شراءه. تبع ذلك انخفاض فوري في عدد حالات الانتحار، على الأقل بين أولئك الذين يستخدمون تلك الطريقة.
حتى وسائل الردع البسيطة مثل الحواجز على الجسور وأرصفة المترو والسكك الحديدية لها تأثير على معدل الانتحار. أظهر تحليل حالات الانتحار المحتملة في المستشفيات أنه يمكن تقييد عدد المحاولات الناجحة بسهولة عن طريق تقييد الوصول إلى الأماكن التي يؤدي القفز منها إلى الموت أو التي يمكن أن يشنقوا فيها أنفسهم. وعلى الرغم من أن المنتحر الحازم والمصمم سيجد دائمًا بديلاً، إلا أن تقييد الخيارات ربما لا يزال على الأرجح الطريقة الأكثر فاعلية للسيطرة على أعداد المنتحرين في النهاية.
بين فارتر و باباجينو
كما توفر التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار بعض المؤشرات الصادمة. غالبًا ما يتبع انتحارَ شخص مشهور موجةٌ من المقلدين الذين ينتحرون بنفس الطريقة. تُعرف هذه الظاهرة بـ”تأثير فارتر”، أو “الانتحار بالتقليد”. أدى اكتشاف هذا التأثير إلى اتفاقية دولية تقيد الإبلاغ العلني عن حالات الانتحار، صاغتها المنظمات الدولية المسؤولة عن الصحة والإعلام. تحترم المؤسسات الرائدة في مجال الصحافة توصيات Reportingonsuicide.org، والتي تتسم بالبساطة بحيث يمكن اختصارها إلى جملة واحدة فقط : “كلما قل الحديث عن الانتحار كان ذلك أفضل”.
ومع ذلك، فإن دخول الانتحار إلى لائحة المسكوت عنه إعلاميًا هو إجراء شبه سطحي، لأسباب منها أن تأثير فارتر لم يتم إثباته بشكل حاسم. شكك بعض الباحثين -مثل جيمس هيتنر- في هذه النظرية، مشيرًا إلى أنه يجب تحليل الزيادة في الانتحار باستعمال ما يسمى “القيمة المتوقعة”، والتي تعتمد على العديد من العوامل المختلفة، مثل الظروف الاقتصادية السائدة، وحتى موسم العام أو درجة الحرارة أو مستوى تلوث الهواء. لذلك إذا انتحر أحد المشاهير في بداية أزمة اقتصادية أو في فترة محددة من العام يهيمن عليها الضنك والكرب، فإن الزيادة في عدد حالات الانتحار بعد وفاته يمكن أن تُعزى جزئيًا إلى التغطية الإعلامية. تظهر التحليلات المتكررة لحالات تأثير فارتر المحددة في الأدبيات العلمية أن حالات الانتحار لا تعتمد بدرجة تُذكر على الدعاية الإعلامية. علاوة على ذلك، يشير الباحثون إلى حقيقة واضحة إلى حد ما وهي أن المشكلات العقلية هي السبب الرئيسي لمحاولة الانتحار؛ فحقيقة وفاة شخص مشهور بهذه الطريقة قد تسرّع من اتخاذ القرار فقط، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هي السبب الرئيسي وراءه، لذلك قد يكون تأثير فارتر مجرد اضطراب في تكرار حالات الانتحار المرتكبة. على مدى فترة زمنية أطول -سنة على سبيل المثال- سيكون عدد المنتحرين ثابتًا نسبيًا ويتناسب مع عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عقلية تؤدي إلى قتل النفس.
في بعض الأحيان يحدث تأثير معاكس، ويقل عدد حالات الانتحار نتيجة للتقارير الإعلامية. كان هذا هو الحال مع انتحار كورت كوبين، والذي وجدت التحليلات أنه لم يتبع انتحاره تأثيرُ فارتر، والذي بدا أنه ردع الكثيرين عن اتباع خطى كوبين. تم تأكيد هذه النتيجة من خلال تحليل أجراه ستيفن ستاك من مركز أبحاث الانتحار في جامعة واين ستيت. كانت القصص التي تحتوي على أوصاف سلبية لحالات الانتحار أقل فعالية بنسبة 99٪ في نشر العدوى الانتحارية مقارنة بتقارير وسائل الإعلام الأخرى. تمت تسمية هذا التأثير العكسي غير المعروف على اسم أحد الشخصيات الرئيسية في سمفونية The Magic Flute لموتسارت؛ حيث يريد باباجينو Papageno الانتحار بعد أن فقد حبه الحقيقي، لكنه يتراجع عن قراره بمحادثة مع ثلاثة شبان أظهروا له طريقة بديلة لحل الموقف. ومن ثم، فإن إظهار فعل الانتحار من منظور مناسب قد يساعد في منعه.
أجرى فريق من علماء النفس والأطباء النفسيين النمساويين والألمان المتخصصين في مهارات التواصل تحليلاً شاملاً لما يقرب من 500 تقرير صحفي حول حالات الانتحار. قاموا بفحص حالات الانتحار التي تبعها تأثير فارتر، الحالات التي تبعها تأثير باباجينو، ونشروا النتائج التي توصلوا إليها في المجلة البريطانية للطب النفسي في عام 2018. توصلوا إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في معدلات الانتحار من خلال النشر المتكرر للتقارير حول الانتحار نفسه، وتكرار الأساطير المتعلقة به، ولا سيما إضفاء الطابع المثالي على أعمال قتل النفس [اليابان أنموذجًا]. أما المنشورات التي تحلل الأفكار الانتحارية الفردية غير المصحوبة بالسلوكيات الانتحارية كانت مرتبطة سلبًا بزيادة في المؤشرات. كان لتقارير وسائل الإعلام التي تظهر الأشخاص في مواقف الأزمات الذين تبنوا استراتيجيات أخرى غير الانتحار للتعامل مع الظروف المعاكسة تأثير مماثل. ومن المثير للاهتمام أن المقالات التي تحتوي على آراء موضوعية للخبراء وحقائق وبائية تتعلق بهذه الظاهرة زادت من احتمالية الانتحار. لذلك، يمكن للتغطية الإعلامية للانتحار أن تساعد في تقليل فرص التقليد، ولكن هناك ندرة في المعلومات الواردة في البحث حول كيفية تحقيق ذلك؛ وليس هناك ذكرٌ لتأثير باباجينو حتى في صفحات الويب الخاصة بـ reportonsuicide.org.
الخلاصة
يمكن أن تكون العلوم الاجتماعية وسيلة قيمة لفهم العالم وتحسين رفاهية الإنسان عندما يتم تطبيقها بشكل صارم وعملي. يتطلب هذا النهج دحض الفرضيات التي تبين خطؤها، والتحسين المستمر للطرق المستخدمة، والتخلي عن تلك التي ثبت عدم فاعليتها بعد البحث. من ناحية أخرى، فإن النهج الشعائري المتبع في الأبحاث مضللٌ، لأنه يقوم على افتراضات غير مؤكدة تجريبيًا، والتي تم تبنيها غالبًا منذ فترة طويلة، كما يجب التوقف عن تطوير الأساليب المتقدمة دون النظر إلى النتائج التي تحققها.
لماذا إذن عند البحث عن طرق لمنع الانتحار نعتمد على مناهج العلوم الاجتماعية التي تتبع أساليب شعائرية بدلاً من الأساليب العملية؟ حتى يومنا هذا، تتكرر هذه الطقوس بعناد، على الرغم من أنها لم تقنع أي “طائرات” بعدُ بالهبوط بحمولتها التي طال انتظارها! بل لم يفعلوا شيئًا سوى حصد الاحترام والتقدير وتعزيز المكانة الاجتماعية لكهنتهم. ألا يحصل كهنة العلوم الاجتماعية على مزايا مماثلة؟ ألم تثمر الأبحاث الغزيرة التي تُظهر ضعفنا سيلًا من المنشورات والألقاب الأكاديمية والمنح والمكانة الاجتماعية؟
خلال الحرب العالمية الثانية، في هذه الأوقات التي انعدمت فيها البصيرة، أخطأ الطيارون أحيانًا في التعرف على المدرجات المشتعلة التي شيدها سكان الجزر، وظنوا أنها مدارج خاصة بهم وحاولوا الهبوط هناك. غالبًا ما انتهت هذه المحاولات بشكل مأساوي، لكن بالنسبة لسكان الجزر كانت علامة من الآلهة على أن جهودهم قد آتت ثمارها. وبغض النظر عن أنها جلبت إليهم كومة من الخردة بدلاً من الثروات المتوقعة، فقد عززت لديهم الاقتناع بأن جهودهم تستحق العناء، وهكذا استمروا، تمامًا كما نستمر نحن في العديد من الممارسات غير الفعالة التي نشأت في مجال العلوم الاجتماعية. كثيرًا ما اعتقدنا أن الصدفة والعشوائية هي الحقيقة.
اقرأ ايضًا: الانتهار لمن عزم على الانتحار
[1] – التحليل التلوي هو تحليل في عِلم الإِحصاء يتَضَمَّن تطبيق الّطُرُق الإحصائيّة على نَتائِج عِدّة دِراسات قد تكون مُتوافِقة أو مُتضادّة، وذلك من أجِل تَعيين تَوجُّه أو مَيل لِتلك الّنتائِج أو لإيجاد عِلاقة مُشتَركة مُمكِنة فيما بَينها. يُمكن أن يُفهَم الّتحليل الّتلوي على أنَّه إجراء خُطوَة تحليل تالية ضِمنَ أسلوب بحث عِلمي على بيانات ناتِجة عن عَمليَّات تحليل سابقة، أيّ أنّه بِبَساطة إجراء عمليّة تحليل للتحاليل. يُمكِن للتحليل الّتلوي أن يتَضمّن استِخدام وسائِل إحصائيّة تَدرُس حجم الأثَر أو القيمة الاحتماليّة وحِساب مُتَوسِط مِن المُريح اتِّباع المُصطَلحات المُستَخدَمة في مُؤسَّسة كوكرين، و استِخدام “الّتحليل الّتلوي” للإِشارة إلى الّطرق الإحصائيّة لِجمع الأدلَّة، و تَرك الجوانِب الأخرى مِن “تجميع الأبحاث” أو “تجميع الأدلّة” ، مِثِل جَمع المعلومات المُستَمدّة مِن الّدراسات الّنوعيّة، كَجُزء مِن الّسياق الأَعَم لِمُصطلح “المُراجَعات المنهجيّة”. -المترجم.