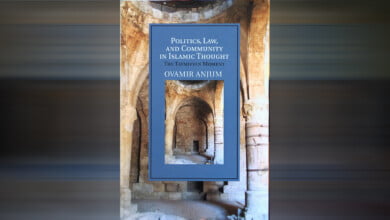د. عائض بن سعد الدوسري
قصة الغلام اليونان وحقيبة الذهب!
هناك قصة تُروى عن غلامٍ يوناني، كان يحمل حقيبة ثقيلة مليئة بالذهب، لكن دفعه ثقلها وشعوره بالتعب والممل وهو يسير بها إلى إلقائها في اليم. لقد ارتاح في تلك اللحظات من العبء الثقيل، وأصبح حُرًا لا يثقله حِمْلٌ، لكنَّه لم يدرك أنَّ راحته الآنيَّة هل سيترتب عليها لاحقًا شقاء حياته الباقية أم سعادتها!
ماذا لو كانت تلك الحقيبة المُثْقَلَة والمليئة بالذهب هي مجموعة من الأفكار والقيم والنُظُم الأخلاقيَّة التي يحملها عقله؟ وكانت قَيِّمَة عنده كقيمة الذهب أو أكثر، لكنَّها أصبحت ثقيلة ليس فقط على عقله، بل على قلبه وجسده أيضًا، فهل –والحالة تلك- يستطيع بسهولة أن يتخلص منها كما تخلص الغلام اليوناني من حقيبة الذهب؟
ولادة أفكارٍ جديدةٍ في العقل أو التخلص من أفكارٍ قديمة ليست عمليَّة سهلة على كل حال، فليست الأفكار مجرد أشياءٍ عينيَّةٍ داخل حقيبةٍ أو كيسٍ يُمكن رميها والتخلص منها بكل يسرٍ وسهلةٍ، فالأفكارُ التي تأسَّسَت لدى الإنسان عبر الزمن والمكان، هي مجموعةٌ معقدةٌ من المشاعرِ والعقائدِ والذكرياتِ والصورِ التي خالطت جزئيات عقلة وقلبه ونفسه وارتبطت بها، وليست مجرد فكرة عابرة يمكن التخلص منها، بنسيانها المتعمد أو تجاهلها أو الهروب منها.
ولادة الأفكار الجديدة أو التخلص من القديم، هي في الحقيقة عمليَّة مخاض مؤلمة وعسيرة عند كثيرٍ من النَّاس، ولا يُمكن التبني للجديد ولا التخلص من القديم هكذا في لمحة بصرٍ خاطفة، بل في العادة تمر تلك العمليَّة بمنعرجاتٍ ومنحنياتٍ، تضيق في لحظاتٍ كثيرةٍ وتتسعُ في لحظاتٍ أخرى، وقد لا يظهر للنَّاس أي شيءٍ عن تلك العمليات والتفاعلات وسلسلة الانفجارات الانشطاريَّة داخل عقل أو قلب ذلك الإنسان، لكنَّها في مرحلة مُعّيَّنة تظهر على لسانِهِ وملامحِ وجههِ على شكلِ وهيئةِ أسئلةٍ قلقةٍ تبدو أنَّها عابرة أو هكذا يريدها أن تظهر صاحبها، أو على شكلٍ كلماتٍ ذاتِ دلالة ينفلت بها لسانه في مناسباتٍ مخصوصةٍ، يُدركها العارف المتبصر بمثل تلك الحالات. واللحظة التي ينقلب فيها الإنسان فكريًّا على أفكاره السابقة، إنَّما تمثل ظهور رأس الجبل في نفسه ليس إلا، فتسعة أعشار تلك الأفكار قد استوت في داخله من قبل.
إنها عمليَّة مخاضٍ طويلةٍ وعسيرةٍ ومؤلمةٍ، يتفاوت النَّاس فيها كثيرًا، بحسب علمهم وتجاربهم ومتانة عقولهم وإيمانهم، ورقة قلوبهم وأحاسيسهم، ومدى تنازلهم وتخليهم عن مصالحهم الدنيويَّة، وبقدر ما يوطنون أنفسهم على تحمل المخالفة وتبعاتها من الأذى، والهجوم الشخصي، والاتهام، والانفصال الروحي والاعتباري عن الوسط السابق المألوف والحاني والدافئ. والنَّاس أيضًا تختلف في اتجاهاتها التي تسلكها، وتتحمل كل ما يُصيبها لأجل ذلك، فبعضهم يتحمل ذلك مُنحازًا إلى الحق والصواب، وبعضهم لأجل الباطل، وبعضهم لأجل الانتقام، أو التحدي أو مجرد المخالفة والظهور وإثبات الذات، كثيرٌ ما يحصل ذلك للأذكياء والنابهين. وعلى أي حالٍ، فالتحول والتغير من فكرة إلى فكرة أخرى جديدة وجذريَّة مضادة، يجعل الإنسان يمر بتجربة مؤلمة وربما عنيفة. يقول وولتر باغهوت Walter Bagehot، الكاتب والاقتصادي والسياسي البريطاني: “أحد الآلام الكبيرة التي تعاني منها الطبيعة الإنسانية هو ألم فكرةٍ جديدةٍ”.
ما العوامل الثلاثة المؤثرة في تَغَيُّر الأفكار؟
النَّاس في تلقيها للأفكار الجديدة وقبولها أو رفضها لها، ثباتها أو ترددها أو سرعة تحولها، تختلف جذريًّا عن بعضها، تبعًا لمجموع أمورٍ ثلاثةأمرين، وهي:
(1) الشخص نفسه، وذلك من خلال: قوة علمه أو ضعفه، قوة عقله أو ضعفه، صلاح سلوكه أو فساده، إيثاره للخير والصواب أو إيثاره لمصلحته الشخصيَّة القريـبة، قوة قلبه أو جبنه، شخصيته ومدى تماهي قناعاته مع أفعاله، ومحل هواه من نفسه، وعاطفته من عقله. وقد نَبَّه نُقَّادُ الأفكار -أمثال ابن تيميَّة– إلى أهميَّة الطابع الشخصي العاطفي وعلاقته بالأفكار، تركًا وأخذًا قبولاً ورفضًا، فالقلب يتغير بتغيير تصورات العقل أو أوهامه، فينقلب المكروه محبوبًا، والمحبوب مكروهًا، فالقلب إنَّما يحب ويكره بما يزوده العقل من صور وخيالات، فهو تابعٌ يتبع ما يصوره العقل ويخلقه من خيال، وكم كره الإنسان واقعه الذي يعيشه بسبب تصوير الوهم له صورًا خيالية يعيشها الآخرون ولا يعيشها هو! يقول ابن تيميَّة: “الإنسانُ قد يبغض شيئًا فيبغض لأجله أمورًا كثيرة بمجرد الوهم والخيال، وكذلك يحبُ شيئًا فيحب لأجله أمورًا كثيرة؛ لأجل الوهم والخيال”. وكما أنَّ العقل إذا مرض يُمْرِض القلب، فإنَّ القلب المريض يمرض العقل واختياراته، يقول ابن تيميَّة: “من كان في قلبه مرض يأخذ من كل كلام ما يناسب مرضه”. كذلك من علل النفوس وأمراضها الضخصيَّة، الكبر والغرور، الذي يحجب الحقيقة ويمنع الهداية حتى عن بعض الأذكياء، فالذكاء وحده دون سلامة القلب واستقرار النفس وخلوها من الأمراض الأخلاقيَّة؛ لا ينفعها ولا يفيدها بل قد يضرها، وربما وَهَبَ صاحبه العناد والمكابرة، بل وحب الانتقام فيما يُعلنه من أفكارٍ مخالفةٍ لوسطه، لأنَّه يشعر بالاضطهاد وهضم حقه، وعدم تقدير وسطه لذكائه ونباهته. يقول ابن تيميَّة: “وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظرًا، ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرًا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فمن اتكل على نظره واستدلاله، أو عقله ومعرفته خُذِل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كثيرًا ما يقول: (يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك)”. أما الشخصيَّة المتزنة والمعتدلة فهي كما يقال ابن تيميَّة: “ومن سلك طريق الاعتدال عظَّم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فيعظِّم الحق ويرحم الخلق”. أما علاقة علم الشخص وإيمانه بالأفكار، فيقول ابن تيميَّة: “أكثر ما نجد الردة فيمن عنده قرآنٌ بلا علمٍ وإيمانٍ، أو من عنده إيمانٌ بلا علمٍ وقرآنٍ”. وكذلك مدى تعرض الإنسان للأفكار المخالفة والمشوِّشَة والمشَكِّكَة، مع ضعف الإيمان وقلة البضاعة في الفكرة الرئيسة التي يؤمن بها، يقول ابن تيميَّة: “فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف، أضعاف، أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة”.
(2) الفكرة نفسها، وذلك من خلال: قوتها أو ضعفها، صوابها أو حقها، تماسكها واطرادها أو تناقضها وتفككها، بساطتها أو تعقيدها، قربها من الفطرة والعقل أو بعدها، وكون الإنسان إنما يقلد غيره في قبول تلك الفكرة أو يرفضها، لا لقيمةٍ أو معنىً بالضرورة ترجع إليها بذاتها. يقول ابن تيميَّة: “أكثرُ دياناتِ الخلقِ إنَّما هي عاداتٌ أخذوها عن آبائهم وأسلافهم، وتقليدهم في التصديق والتكذيب، والحب والبغض، والموالاة والمعاداة”.
(3) السياق الزمني والمكاني، وذلك من خلال: كونه بلاء وفتنة أو سلامة وأمنًا، شدة أو سهولة ورخاء، ظهور وقوة أهل الفكرة التي ينتمي إليها أو ضمورهم وضعفهم، ظهور أعداء فكرته وقوتهم أو هزيمتهم وتقهقرهم. ولهذا، يظل إيمان معظم النَّاس ثابتًا حتى تحركه الفتن، ولو سلموا منها لسلم لهم إيمانهم، وإنَّما تأتي الفتن ابتلاءً للتمايز بين القلوب، قلوب الذين يقنون، وقلوب الذين شربوا من نهر الحياة الدنيا، فتعلقوا بها لم يقدروا بعدها على الفِطَام منها، ومثل تلك القلوب تنكشف سريعًا عند الهزَّات الأولى. يقول ابن تيميَّة: “كَمَائِنُ القُلُوبِ تَظهَرُ عند المِحَنِ”. ولهذا يُبَيِّن ابن تيميَّة أنَّ “عامة الناس… إذا ولدوا على الإسلام … فهم مسلمون، وعندهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان في قلوبهم إنما يحصل لهم شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك”، وأنَّه “لو شُكِّكُوا لشكُّوا”، وأنَّه “ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب”، وأنَّ “هؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتُلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريـبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين”، ثم يتحدث ابن تيميَّة عن واقع عامة النَّاس في زمانه في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجريين، فيقول: “وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً… وهم مؤمنون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، باطنًا وظاهرًا، لكن إيماناً لا يثبت على المحنة”. وبعض هؤلاء الذين يصفهم ابن تيميَّة لديهم تجاه فكرتهم التي يؤمنون بها فرط حساسيَّة ومشاعر مرهفة، أصلها طيب وخَيِّر، لكنَّ إفراطهم في تلك المشاعر وشدة هشاشتهم، يعود عليهم بالشر والتضعضع، يقول ابن تيميَّة: “وكثيرٌ من النَّاس إذا رأى المنكر أو تَغَيُّر كثيرٍ من أحوالِ الإسلامِ جَزِع وكَلَّ وناحَ كما ينوح أهلُ المَصائب، وهو منهيٌّ عن هذا. بل هو مأمورٌ بالصبرِ والتوكُّل والثَّبات على دين الإسلام”. وعلى أيِّ حالٍ وبشكلٍ عام، فإنَّ العوام أكثر النَّاس ثباتًا على أفكارهم، وسبب ذلك يعود إلى بعدهم –بطبيعة حالهم- عن معارك الأفكار ومخاضات التفكير، وهم في الوقت نفسه أكثر النَّاس الذين يتغيرون بسرعة وسهولة، إلى الحق أو إلى الباطل، عند وجود المؤثر الموجب لتغيرهم، وذلك مرجعه عادةً إلى مقدار العلم، ولصفات شخصيَّة، عقليَّة وقلبيَّة، تُهيئ النفوس لمثل ذلك.
صراع الأفكار بين (مارد التفكير) و(شرطة الأفكار)!
في مسيرة تاريخ الفكر الإنساني، يظَلَّ (الفكر) متذبذبًا، يتمدد تارة ويتقلص أخرى، يتأخر ويتقدم، يشتط أو يتهذب، مترددًا ما بين (سلطان الفكر) و(مارد التفكير)، الذي يدفعه دومًا ويؤزه إلى الأمام، وبين مراقبة (شرطة الأفكار)، التي كانت بواسطة المنع تحد من تطوره وتقدمه، وتضع العراقيل الوقتية في طريقه، فيتأخر أحيانًا كثيرة، لكنَّ الفكر في صيرورته يستمر في التقدم والتطور. والفكر بطبيعته له سلطان وتأثير، فإذا ما اقترن به مارده الخارج عن عقاله؛ طبعه بالفوضويَّة، وهنا تدخل شرطة الأفكار، تلك العقول التي تراقب -بطبيعتها- بتوجسٍ وحذرٍ وتحفظٍ تلك الأفكار الجديدة، فينتج الصراع بينهما، والفكر إنما يتطور في محصلته النهائيَّة من خلال الصراع بين جديدٍ متحفزٍ وقديمٍ متحفظٍ. فسُلطان الفكر، قوةٌ تعيش في ازدهارٍ ونموٍ بين ثنائيَّة متناقضة: حريَّة التفكير وشرطة الأفكار، وتظل في حالة تذبذب، بين إقبال وإحجام، ومد وجزر. ورب أفكارٍ كانت ستموت وتضمحل لولا وجود التحدي الذي لم يقتلها ولكنَّها حَفَّزَها على البقاء والمقاومة، وربما أفكارٍ حَفَّزَها غياب التحدي على التراخي والاضمحلال ثم الموت!
ومع أنَّ الحريَّة –كما يعتقد كثيرٌ من النَّاس- هي الشرط الأساس لنمو الأفكار بشكلٍ طبيعيٍ، إلا أن الحريَّة هذه كثيرًا ما قادت التفكير إلى الفوضى، وأطلقت مارده من عقاله وأخرجته من مصباحه، فلم يهتد إلى شاطئ يرسو فيه. كذلك إذا نشأت هذه الحريَّة في وسطٍ فوضوي لا أسس له، لم تُنتج ما يُطمح إليه من فكرٍ، بل صيرت الإنسان تائهًا مُشتَّتًا قد يترك –تحت وطأة تلك الحالة- ما لديه من أفكارٍ جيدة؛ ليختار أفكارًا أخرى تكون في غير الضعف والركاكة، ثم يصعب عليه بعد ذلك العودة إلى أفكاره السابقة الجيدة، لأنَّ عقله وقلبه قد تسمم بالفوضويَّة، فهو ربما يعلم أنَّ تلك الأفكار القديمة جيدة ومثاليَّة بالمقارنة إلى ما هو عليه الآن، ويجد إحساسًا ضروريًا بذلك كأنَّها فطرة فيه، لكنَّه لا يقدر أن يمتلك منهجًا يقوده بالقناعة إليها، فكل ما في ذهنه مشوش ومرتبك ويصعب تنظيمه!
يقول أستاذ الفلسفة بيرتون بورتر Burton F. Porter: “يتمتع الناس حاليًا بقدرٍ لم يسبق له مثيل من حريَّة اختيار ما يروقهم من طريق للحياة، غير أنَّ هذه الحريَّة في الاختيار قد ظهرت في عهد يسوده اللايقين والارتياب في تحديد أفضل الطرق المختلفة للحياة، والظاهرتان متلازمتان، لأن الحريَّة تولد الارتياب. ففي النصف الأخير من القرن العشرين، فَقَدت الأصول التقليدية للمعرفة سلطانها، تاركة النَّاس في حالة من التشوش والقلق، بلا ركيزة يعتمدون عليها، أو اتجاه محدد يتبعونه. أجل! إنَّ لدينا مجالات متعددة لاختيار نوع الحياة التي نرغبها، غير أنَّنا على غير يقينٍ من ماهيَّة الحياة التي نود اختيارها، فلم يعد بمقدورنا العودة إلى اليقينيات العريقة”.
والإنسان العاقل بطبيعته لا يقتنع بالحياة أي حياة كما اتفق، حتى ولو كانت تلك الحياة لا حدود لها من حيث مساحات الحريَّة الممنوحة، فالعاقل، خصوصًا إذا حُرِسَ قلبه بالإيمان، يحرص كل الحرص على فهم مغزى حياته، ويفحصها جيدًا للبحث عن الصواب والحق والهدى، فكون الأفعال حرة لا يمنح ذلك الأفعال الفوضويَّة احترامًا، بل يمنحها المسؤوليَّة التي تستشعر ثقل التكليف، وتبحث عن أفضل الخيارات المتاحة لتصب فيها ممارساتها الفعليَّة، فالحياة بلا فحص ليست حياة حقيقيَّة، أو كما يقول سُقْرَاط Socrates: “إنَّ الحياة التي لم تُفْحَص؛ لا تَسْتَحِقُ أن تُعَاش”. والإنسان العاقل، الذي لا ينساق لأهوائهم وشهواته، هو في كل المجتمعات أكثر النَّاس قدرة، ليس فقط على فحص معاني حياته، بل على فحص الأفكار عامة، وما يترتب عليها من أهميَّةٍ أو أخطارٍ، ومآلاتٍ يُمكن أن تنفع المجتمع كله أو تضره، وهو أيضًا الأجدر على التنبؤ بالأفكار في مهدها وأطوارها البدائية، وما يُكمن أن تُحدثه من أثار عميقةٍ وحتميَّةٍ في المستقبل، ولذلك هو الشخص الذي يُمكنه، لأنَّ يعرف الأضداد، أن يكشف الأفكار التي لم يأت أوانها ووقتها بعد!
يقول فكتور هوغو Victor Marie Hugo: “لا يوجد جيشٌ يستطيع أن يصمد أمام قوةِ فكرةٍ حان وقتها”. والسبب في ذلك بسيطٌ جدًا، فإنَّما يحرك النَّاس الأفكار، الخَيِّرة أو الشريرة، فدوافع النَّاس وحركاتهم تابعة في الغالبِ لأفكارهم التي تقطنُ في عقولهم منذ زمنٍ، وتصنع مشاعرهم في قلوبهم، والجيوش والأسلحة لا تقتل الأفكار، بل الأفكار هي التي تقدر أن تقتل الجيوش وتستخدم أسلحتها ضدها، والمعارك في حقيقتها، كما يقول روبرت رايلي Robert Riley مدير إذاعة صوت أمريكا: “الطبيعة الحقيقية للصراع، صراع المشروعية الفكريَّة في قلوب وعقول الناس، وليس القوة العسكرية. إنَّ الحروب تخاض ويتم فيها تحقيق النصر أو الهزيمة في عقول النَّاس، قبل وقتٍ طويلٍ من بلوغها نهايتها في ميدانِ قتالٍ بعيدٍ”.
وفي تلك المعارك الفكريَّة بطبيعتها، هناك قانونٌ ثابتٌ وحتميٌ، وهو: إذا تَقَلَّصَتْ فكرة ما وانسحبت من ساحاتٍ معينةٍ؛ فلن تظل تلك الساحات فارغة، بل ستسارع أفكارٌ أخرى، أقوى منها أو أضعف، إلى احتلال مكانها بأسرع مما يتم تصوره عادة وإزاحتها نهائيًا عما تبقى لها في تلك المساحة، وفي أمكان لا يتصور أبدًا أن تحتل فيها تلك الفكرة البديلة مكان الفكرة السابقة، لترسخ أقدامها فيها بقوة. وهذا يرجع في الحقيقة إلى أنَّ المجتمعات الإنسانيَّة لا تبقى بدون فكرة إيمانيَّة تعتنقها وتهديها، ولا يُمكن ذلك، فإما أن تكون الفكرة الهادية للنَّاس هي الحق أو الباطل، الخير أو الشر، الصواب أو الوهم، وكل ساحة تنسحب منها فكرةٌ من الأفكار، ويضعف ناصرها وداعمها، تحتل مكانها فكرةٌ أخرى، إذا توفر لها داعمٌ وناصرٌ جديد، وهنا يلتف النَّاس حولها. ومبدأ صراع الأفكار حقيقة وجوديَّة لا يمكن الهرب منها، وبقدر ما تنجح فكرة ما باحتلال مكان ما؛ بقدر ما تزيح غيرها من الأفكار عن ذلك المكان نفسه، وكلما تمددت الفكرة تقلصت بقية الأفكار، وكلما تقلصت فكرة ما وانزاحت -بسبب ضعفها الذاتي أو ضعف مناصرة أتباعها- من مكانها الذي كانت مهيمنة عليه، حَفَّزَت وشَجَّعَت بقيَّة الأفكار الأخرى وأغرتها بأخذ مكانها، فـ”الضعف يحرض عليك الآخرين“، كما يقول وزير الدفاع الأمريكي السابق رامسفيلد، ومهما كانت الأفكار الجديدة ضعيفة ومشوشة ومشوّهة ومرتبكة، فإنَّها تجد لها مكانًا في الفراغ، فالفراغ الفكري هو الأرض الخصبة لسائر الأفكار. وهناك ظاهرة تاريخيَّة واجتماعيَّة وفكريَّة يَحْسُنُ تأملها مليًا، تؤكد قاعدة تتعلق بأي مذهب أو دين أو فكرة جامعة يتجمع حولها النَّاس، وهي: إذا ضعف الوسط الداعم لها، والذي كان يحتضنها؛ تفككت بقية الأطراف وتفرقت في اتجاهات مختلفة، وقد يعود بعضها عدوًا للفكرة الأولى التي كان يعتنقها قبل ضعف وضمور ذلك الوسط.
إنَّ الأفكار الضعيفة بذاتها قد لا تكون مؤثرة ولا فاعلة، ولا تعمل إلا حينما تكون بمواجهة فراغٍ معرفيٍ، حينها تقوم تلقائيًا بالتسلل إلى ذلك الفراغ، لتقوم بسده والاستحواذ عليه. وهذا بخلاف الأفكار القويَّة، فهي قادرة على مواجهة الأفكار التي قبلها أو بعدها والصراع معها، ثم النجاح في إزاحتها والحلول محلها أو تثبت نفسها. وأحيانًا الخصم الذي يمتلك فكرة ضعيفة ويريد إحلالها محل الفكرة القويَّة وهو لا يقدر على ذلك ذاتيًّا، فإنَّه يقوم بخلق حالة من الوهم عند أصحاب الفكرة القويَّة، بأنَّ فكرتهم هزيلة وضعيفة ومحل سخرية، وغير صالحة ولا بد من استبدالها، والعقل الجاهل كالكأس الفراغ، ليس فقط لا يعرف قيمة أفكاره، بل يسمح لمن يرغب في صب ما يريد فيه أو إفراغه مما صُب فيه من قبل، بكل يسرٍ وسهولةٍ، ولذلك تراه كثير التغير والتحول والانتقال، ولا يدري أحيانًا لِمَ، وهو لذلك مع كل جديد مثير متبع، وبكل فكرة مهما كلمت تافهة معجب، يتخبط في سيره، ولا يخجل من تناقضاته، ويظن أنَّه على شيء!
ومن هنا وجب على الإنسان أن يُراقب أفكاره الذاتيَّة، ويقوم بفحصها بكل جديَّة ودقة، فالذي يعرف الحق فقط ليس مثل الذي يعرف الحق ويعرف الباطل معًا، لا يستويان في العلم ولا في الإيمان، ولهذا قال ابن تيميَّة: “[من لم يعرف] ما يعارض [الحق] ليتبين له فساده، [فإنَّه] لا يكون في قلبه من تعظيمِ الإسلامِ مثل ما في قلب من عرف الضدين”. ومعرفة الضدين –في صراع الأفكار- تتمثل في إتقان أربعة مستويات من التفكير، وهي كما يقول ابن تيميَّة: “وليس كلّ من وَجَدَ العلم قَدرَ على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلمُ شيءٌ، وبيانُهُ شيءٌ آخر، والمناظرَةُ عنه وإقامة دليله شيءٌ ثالث، والجوابُ عن حجة مخالفهِ شيءٌ رابعٌ”.
وإذا فحصت حال أغلب النَّاس تجدهم يمارسون رقابة صارمة على ما يأكلون وما يشربون، أي يمارسون رقابة على ما يدخل إلى بطونهم، لكنَّ عدد الذين يمارسون الرقابة على ما يدخل إلى عقولهم من أفكار سلبية وآراء مغلوطة قليلٌ جدًا بالمقارنة إلى ذلك، وكأنَّ بعض هذه العقول رضيت أن تتحول إلى سلةِ مهملاتٍ، كل فكرةٍ تافهةٍ أو مزيفةٍ تجد لها مكانًا مستقرًا في عقولهم!
ولهذا، إذا عجز عامة النَّاس عن فحص الأفكار التي تصلهم عبر هذا الفضاء المفتوح بلا حدود، فهناك عقول واعية وناضجة ومثقفة، تعرف الضدين، وترى أنَّ مهمتها الثقافيَّة المركزيَّة تتمثل في فحص الأفكار ومراقبتها ونقدها، لإيمانهم الواعي والعميق بخطورة ترك الأفكار بلا مراقبة أو دراسة نقديَّة، وكما يقول الناقد الألماني هاينرش هاينه Heinrich Heine: “إنَّ الأفكار الفلسفيَّة التي يطرحها أستاذ من مكتبه الهادئ قادرة على إبادة حضارة بكاملها”. ويعقب عليه السير إيزايا برلين Isaiah Berlin، الفيلسوف ومؤرخ الأفكار والمنظر الاجتماعي والسياسي، محذرًا من مغبة ترك الأفكار دون تصدٍّ لها، بقوله: “إن إهمال الأفكار من قِبَل الذين ينبغي أن يعتنوا بها، أي من قِبَل مَن تدربوا على تبني نظرة ناقدة للأفكار عمومًا، قد يؤدي أحيانًا إلى اكتسابها قوة كاسحة، لا يمكن مقاومتها أو كبحها، تفرض على أعداد هائلة من البشر”.
هل يكون الكتاب حصان طروادة الأفكار المخالفة؟
من أسهل وسائل تدفق الأفكار الجديدة، الموافقة أو المخالفة، (الكتاب)، لسهولة انتقاله بصيغ متعددة، ومحبة معظم النَّاس له، ثم تتفاوت الكتب في سهولتها وخطورتها وتأثيرها بحسب أساليب مؤلفيها وقوة محتواها. لكنَّ الأمر المهم الذي يَحْسُنُ إدراكه هو: أنتَ بعد قراءة كتابٍ يحمل بالنسبة إليك فكرة عميقة ومتماسكة وملحة، وقد لا تكون كذلك في نفس الأمر، لستَ ذلك الشخص نفسه الذي كان من قبل. فالرحلة مع مثل هذا النوع من الكتب المركزيَّة، على الأقل بالنسبة إليك، ليست مجرد رحلة استجمام واسترخاء ثم عودةٍ إلى ما كنتَ عليه، بل قد تكون رحلة ذات اتجاهٍ واحدٍ لا عودةَ فيها لما كنتَ عليه سابقًا. وربما تستطيع أن تتوقف عن القراءة، وأن تضع الكتاب جانبًا عنك في أي لحظة تريد ذلك، لكنَّك في كثيرٍ من الأحيان لن تستطيع أن تتوقف عن التفكير فيما قرأتَهُ لو أردتَ ذلك، خصوصًا إذا صادفتَ فكرةً لا تزال تُلِحُّ عليك، لأنَّها هَزَّت عقلك أو استحوذت على وجدانك ومشاعرك، أو بنت في أعماقك أفكارًا صغيرة لم تنتبه لها، كالبذور التي طُرِحَت في داخلت، لتُنبِتَ شجرة جديدة تحمل أثمارًا من الأفكار الجديدة.
كيف يُمكن لكتابٍ يحمل فكرةٍ ما أن يُحدِثَ أثرًا بالغًا وربما فادحًا بفكرةٍ أخرى مخالفة؟
هل يُمكن لدراسةٍ رصينةٍ ما أو لكتابٍ ما أن يُحدث هزةً عنيفةً في دين ما أو مذهب ما بحيث يُهدد كيانه ووجوده ويُزعزع قناعات أتباعه ويُفقدهم الإيمان؟ الجواب عن ذلك يعود إلى مجموع الأمور الثلاثة، وهي: الشخص نفسه، الفكرة نفسها، السياق الزمني والمكاني. فإذا كان الشخص نفسه ضعيفًا في علمه وعقله، وكانت الفكرة التي يؤمن بها هزيلة ومفككة ويعوزها الدليل والبرهان، وكان السياق الزمني والمكاني معاديًا له ولها أو غير وديٍ وصديقٍ، كانت كل عوامل انهيار وفشل تلك الفكرة متوافرة جميعًا، ولهذا كان فشلها واضمحلالها أمرٌ حتميٌ، أما إذا اختل واحدٌ من تلك العوامل أو اثنان، فإنَّ فشلها أو اضمحلالها يكون محتملاً، وستظل تتردد ويحدث لها تباطؤ في سيرها، حتى تصادف ما يُقويها؛ فتنمو وتزدهر ثم تنتشر، أو تصادف ما يمرضها ويضعفها؛ فتضمحل وتموت، وربما يكون ذلك العامل فكرة واحدة، أو مجرد كتاب وحيد يهز أركانها ويبعثر قواها! مع أنَّه يَحْسًنُ التنبه إلى أنَّ العامل الأول المتعلق بالشخص نفسه إذا كان ضعيف العلم أو العقل، قد يُفسد أثر العامل الثاني، وهو كون الفكرة ضعيفة وهزيلة ومخالفة للعقل، فضعف علمه وعقله قد يحجب عنه معرفة ما في فكرته من ضعفٍ وهُزالٍ.
مثال تطبيقي… الكتاب “الشيطاني” الذي “هَزَّ المسيحيَّة”!
مع أنَّه ربما يكون من المبالغة نسبة انقلابٍ تامٍ في دينٍ أو مذهبٍ أو كيانٍ ما إلى كتابٍ ما أو شخصٍ ما، لكن في الوقت نفسه من الخطأ أن يتم التقليل من شأن بعض الكلمات فضلاً عن دراسةٍ رصينةٍ أو روايةٍ مُتْقَنَةٍ، وما يُمكن أن تُحدثه من أثرٍ لا يُستهان به على مستوى العقائد والديانات والأخلاق. وتاريخ مقارنة الأديان والأفكار لا يبخل بتقديم النماذج والأمثلة العديدة لما يُمكن أن يُحدثه شخصٌ أو كتابٌ في مذهبٍ ما أو ديانةٍ ما. ولذا، لا يستبعد المراقب المتخصص أن يحصل من التأثير العميق بسبب كتبٍ يحمل فكرة قد آن وقتها وتكون محل اعتبار كثيرين، أما مُنتهى هذا التأثير فالمستقبل وحده يتكفل بكشفه.
ويُمكن افتراض ذلك بقوةٍ، إذا أخذنا في الحسبان التآكل الداخلي الرهيب الذي تُعاني منه الفكرة نفسها، وهي هنا الإيمان المسيحي، وفي الغرب خصوصًا. فالمختصون بمراقبة الحالة الدينيَّة والإيمانيَّة في الغرب، من أمثال غيرد غيركن Gerd Gerken وميشائيل كونيستر Michael Konitzer، يؤكدون أنَّ هناك انسحابات رهيبة في الغرب من الكنيسة ومن الإيمان المسيحي، وأنَّها تزداد يومًا بعد يوم بشكل غير عادي. وأنَّ الشباب بشكلٍ خاصٍ، وهم أهم طبقة في المجتمع، يودعون الإيمان المسيحي. يقول غيركن وكونيستر: “على المرء كإنسانٍ شابٍ أن يبرر لنفسه الانتساب إلى الكنيسة أكثر من أن يبرر الانسحاب منها”. أما عالم الاجتماع هاينر بارتس، والذي كُلِّفَ من قِبَلِ (رابطة الشبيبة الإنجيلية) بدراسةٍ حول الشبيبة والدين في ألمانيا، فقد أكد عمق الغربة التي يعيشها الشبان الألمان عن الدين والكنيسة، وأنَّ تعاليم الإيمان المسيحي تنحط في أعينهم.
في ظل هذا السياق الزمني، وطبيعة الفكرة نفسها، يُمكن فهم مدى تأثيرِ كتابٍ صدر في الغرب، وكان له أعظم التأثير في إيمان كثيرٍ من الغربيين. هذا الكتاب، وهو عبارة عن رواية قصصيَّة، استوحت بعض معلوماتها من دراسات أكاديميَّة، هو رواية (شيفرة دافنشي) أو (The Da Vinci Code)، للروائي المشهور: دان بروان Dan Brown. تتمحور قصتها حول شخصيَّة خياليَّة متمثلة في أستاذٍ جامعيٍ اسمه روبرت لانغدون Robert Langdon، تخصصه في تاريخ الأديان وفك الرموز من جامعة هارفارد، يقوم برحلة طويلة للبحث عن الأسرار المدفونة منذ قرونٍ طويلة في صدور جماعة دينيَّة باطنيَّة، تسمى (جمعية صهيون) وهي جمعية سريَّة تتشكك في كل أحد ولا يمكنها الوثوق في أحد، واحتمالية الوصول لهذا السر من خلالها يعد أمرًا بالغ التعقيد والصعوبة! وتبدأ رحلة الأستاذ الجامعي الشاقة والطويلة، بحادثة قتل مدير متحف اللوفر، مرورًا بمعرفته بصوفي نوفو خبيرة الشيفرة في الشرطة الفرنسية… إلى آخر تلك الرواية المثيرة، التي تتعرض بالتشكيك لأهم معتقدات الديانة المسيحيَّة!
ومنذ أن ظهرت رواية (شيفرة دافينشي) على هيئة كتابٍ، وهي تثير الكثير من الجدل ليس بين عامة الناس فحسب، بل بين الأكاديميين والمتخصصين في فن الرواية وتاريخ الأديان، وقد بلغت شهرتها حداً كبيراً، حيث طُبِعَ منها عشرات الملايين من النسخ، وبأكثر من 50 لغة مختلفة، ثم أنتج بوحيها الفيلم السينمائي الشهير الذي يحمل الاسم نفسه. وطبقاً لما ذكرته The Telegraph Daily بتاريخ 3/10/ 2004م، فإنَّ رواية (شيفرة دافينشي) هي أكثر الروايات الخياليَّة مبيعاً على الإطلاق. ولشهرة هذه الرواية تحولت قصتها –كما ذُكر- إلى فيلم سينمائي بلغت تكاليفه حوالي (100) مليون دولار أمريكي، وقام بتمثيله: توم هانكس Thomas Jeffrey Hanks، وعرض عام 2006م، وحصل مؤلف الرواية من وراء روايته على عشرات الملايين!
والعجيب في هذه الرواية مدى تأثيرها القوي في النَّاس، وكيف استطاعت أن تغير بل تقلب قناعات كثيرٍ من المؤمنين المسيحيين وطريقة تفكيرهم، وهي ليست إلا رواية فحسب! فهذه الرواية كانت سبباً أساساً في تدفق الزوار -وهم يمسكون بنسخة من الرواية- إلى متحف (اللوفر) وكنيسة (سان سولبايس)، وكأنَّ هذه الرواية تحولت إلى كتابٍ مقدسٍ للسياحة، يسير وفق هديه ومعطياته هؤلاء السياح!
تقول إيلين مكبرين، المؤرخة الفنيَّة في جامعة هارفارد ومؤسسة شركة باريس ميوز للسياحة: “عندما وصل العدد إلى 30 ممن سألوني: هل هذا هو المكان الذي قُتل فيه أمين المتحف؟ أو هل صحيح ما قيل عن لوحة دافنشي (عذراء الصخور)؟ وتصورتُ كيف بدأ النَّاس يقتربون من اللوفر، وتساءلتُ لماذا لا نستفيد من ذلك؟”. وعندها بدأت إيلين مكبرين بتنظيم رحلات مكثفة تحت عنوان (حل شيفرة دافنشي في اللوفر)، ووصلت هذا الرحلات إلى (100) جولة في الشهر لسياحٍ قادمين من أمريكا الشمالية فقط!
وتقول ليديا سانفيتو المرشدة السياحية بروما: “لم أسمع حديثاً إلا عن رواية شيفرة دافينشي بعد أن نشرها المؤلف الأميركي دون بروان في مارس آذار 2003م، وكان الاهتمام أولاً من قارئين أمريكيين، ثم من إيطاليين، وجنسيات أخرى، ابتداءً من أواخر العام الماضي، بعد نشر ترجمات بلغات أخرى في جميع أنحاء العالم”.
وقد أشار القسيس بول روماني من كنسية سان سولبايس إلى أنَّ رواية (شيفرة دافينشي) دفعت عشرات الآلاف من المعجبين بالرواية لزيارة الكنيسة للبحث عن مفاتيح الشفرة!
وتقول السائحة فيكتوريا سينـتون من جوهانسبرج: “اعتقد أنَّ الكتاب يمكن تصديقه بصورة كبيرة”. ويقول جوسيبي نبوليون المدير المسؤول عن لوحة دافنشي: “شهد المتحف اهتماماً متجدداً من النَّاس جاءوا لرؤية هذه التحفة الفنية بعد أن حقق الكتاب شهرة واسعة”. ثم يقول نبوليون: “للعمل عند لوحة (العشاء الأخير) وشرحها للزائرين؛ أصبحت قراءة الكتاب مطلوبة من جانب كل العاملين تقريباً، أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يسألون أي الشخصيات تمثل يوحنا، ويسألون عن شكل الحرف “V” الذي تشكل بين جسمه وجسم المسيح“.
وأما الرواية في جانبها الديني والتاريخي –وهو ما يهم هنا- فقد مثلت صدمة للاعتقاد السائد في المسيحيَّة، فقد كان لها تأثيرها العميق الذي لا يمكن أن يُوصف، وقد يصعب فهم: كيف لرواية خياليَّة أن تزعزع عقائد النَّاس؟! يقول القسيس بول روماني: “أدركُ أنَّ كثيراً من النَّاس يتعاملون في الواقع مع الرواية على أنَّها حقيقة راسخة”. ويقول الكاردينال جورج رئيس أساقفة شيكاغو: “إنَّه كتابٌ مقنعٌ بالنسبة لكثيرين”. ويهم هنا كثيرًا ما قامت به إحدى عضوات كنيسة الثالوث المقدس بلندن (Holy Trinity)، حيث تابعت مواقف النَّاس تجاه المسيحية بعد رواية (شيفرة دافينشي)، فوجدت تأثيراً قويًّا أحدثتُه تلك الرواية في قناعات الناس. ومن تلك الشهادات، شهادة رجل قال لها: “إنَّ الرواية تبين أنَّ الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون صحيحاً، وأنَّه حدث تغيير في النص”. وتقول فتاة مؤمنة مسيحيَّة: “هذا الكتاب كاد يفقدني إيماني”. وتقول فتاة أخرى مسيحية متدينة: “هذا الكتاب جعلني أعتقد أنَّه ليس لديَّ حقائق واقعية تدعم إيماني”. وتقول ليديا سانفيتو المرشدة السياحية بروما: “إنَّهم يعذبونني، لم أفاجأ من الأمريكيين، ولكن أذهلني بالفعل أنَّ الايطاليين يطرحون أيضاً مثل هذه الأسئلة بالرغم من تقاليدهم الكاثوليكيَّة الراسخة”.
وبسبب ما أحدثته تلك الرواية من زعزعة وبلبلة في عقائد وفي عقول المسيحيين، وكأنَّ الرواية تحولت إلى صندوق باندورا، فإنَّ الكنيسة لم تقف مكتوفة اليد، بل حاولت إغلاق هذا الصندوق، فحرمت قراءة تلك الرواية وحرمت رؤية الفيلم، وأصدرت عشرات البيانات الاستنكارية، وأصدرت الكتب والمقالات الكثيرة للرد على رواية (شيفرة دافينشي). ويقول المفكر الفرنسي موريس ماشينو Maurice Maschion إنَّ الكنيسة الكاثوليكيَّة قامت بوضع رواية (شيفرة دافينشي) في فهرس المحرمات المكتوبة في عام 2005م، وبذلك ينضم الكتاب إلى قائمة الكتب المحرمة التي عملت عليها محاكم التفتيش منذ نشأتها في الأندلس عام 1557م حتى إلغائها سنة 1966م وتغيير مسماها، حيث بلغت الكتب المحرمة أكثر من خمسة آلاف كتاب!
ويقول الكاردينال تارسيزيو بيرتوني Tarcisio Bertone الرجل الثاني في الفاتيكان وسكرتير الدولة: “لا تقرأوا ولا تشتروا شيفرة دافنشي”! ويقول الأنبا يوحنا باسم كمال قلته، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك: “شاهدتُ الفيلم مع مجموعة من أهل العلم والنقد لفنون السينما، وأعلن بصراحة وأمانة أنَّه فيلمٌ شيطانيٌ ملعونٌ بكل المقاييس، الفيلم يحاول هدم العقيدة المسيحيَّة من أساسها، أيُّ شيطانٍ وراء هذا العمل؟ وأيُّ فكرةٍ جهنميةٍ تريد أن تغزو العقول البريئة والبسيطة؟”. وقد أُلفت كتبٌ مسيحيَّةٌ كثيرةٌ للرد والتصدي لرواية دون بروان، منها ما ألفه القس الشهير نكي جمبل Nicky Gumbe، بعنوان: (The “Da Vinci Code”: A Response)، وقَدَّم لهذا الكتاب وقرَّظَهُ كل من: الدكتور منير حنا أنيس، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس، مطران الأقباط الأرثوذكس. وغيره من الردود الكثيرة والعنيفة للكنسية ورجال الدين المسيحيين.
والسؤال المهم هنا: كيف حَدَثَ هذا الأثر العقائدي المدمر بين المسيحيين هؤلاء بسبب رواية خيالية؟
يُمكن معرفة الجواب بشكلٍ عميقٍ من خلال معرفة العوامل الثلاثة بشكلٍ عميقٍ المرتبطة بالمسيحيين وبالديانة المسيحيَّة في هذا العصر، والله أعلم.