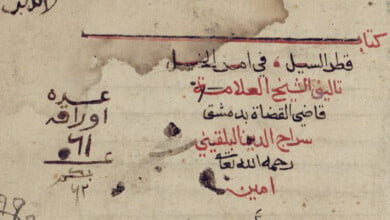- د. رامون هارفي
- ترجمة: زياد الحازمي
- تحرير: نايفة العسيري
تنبيه من المؤلف:
تم اختصار هذه المقالة من الفصل الأول من كتاب: “القرآن والمجتمع العادل” (من مطبوعات جامعة إدنبرة ، 2018) من تأليف رامون هارفي، والكتاب يقدم السرد التاريخي الذي يرويه القرآن لرحلة الروح من الحياة الدنيا إلى الآخرة. مع محاولة لاستكشاف المفاهيم الرئيسية لتوفير دليل لمفردات القرآن الأخلاقية.
مقدمة
كل شيءٍ يبدأ وينتهي بحكمة الله عز وجلّ، هذه هي الفكرة الأساسية التي تغذّي الحكاية التي يرويها القرآن منذ بداية الوجود البشري إلى مستقبله النهائي، وبخلافِ الكتاب المقدس (الإنجيل) حيث الكشفية التاريخية لعهد الله مع البشرية تُقتفى من خلال الترتيب المتتابع للنص، فإنّ السردية الأخلاقية في القرآن يجب أن يعاد بناؤها من مقاطع متفرّقةٍ عبر صفحاته، من ناحيةٍ معينة فإنّ هذا يعكس مبادئَ أكثرَ عموميةً للبنية القرآنية، ومن ناحية أخرى فهي متناسقة تمامًا مع العناية التي توليها للأنماط الميتافيزيقية للحالة الإنسانية الأعمّ بدلًا من تاريخ شعوب معينة بذاتها، فالحكمة الإلهية هي الثابت الذي ينبئ بخلقه لهذا العالم كما ينبئ بكمال عدله ورحمته سبحانه في الحياة الآخرة.
ومن خلال تسليط الضوء على هذا المنظور وعرض القصة القرآنية الروحية للأفراد والمجتمعات، فمن الممكن أن نبيّن العلاقة بين المفاهيم الجوهرية للنظرة القرآنية للكون والعالم، السردية المتّبعة ترتكز على أربعة مراحلَ مختلفة مقسّمةٍ كالآتي: الميثاق، الفطرة، النبوة والآخرة.
الميثاق
إن التاريخ الإنساني وفقًا للقرآن الكريم يتملّك المعنى الأخلاقي فقط لوجود مكوّن المسؤولية الأخلاقية لدى الإنسان، وهذا المعنى قد صوّره القرآن في الآية 72 من سورة الأحزاب بعبارةٍ قويةٍ وجيزة ترتعد فيها أعظم مخلوقات الطبيعة لعرض الأمانة: “إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا”.
ويعظُم تأثير الآية من خلال تجسيد السموات والأرض والجبال بأفعال صيغ الجمع “فَأَبَيْنَ” و “وَأَشْفَقْنَ” المخصصة للكائنات العاقلة، ويمكن أن تفسّر الأمانة هنا كرمز للمسؤولية الأخلاقية المقبولة إنسانيًا مما يمكنها أن تكوّن شكلًا من أشكال الميثاق مع الله عز وجل، ثم عاهد البشر ربّهم أنهم سيوحدونه ويكرّسون حياتهم لعبادته وهذه هي الغاية الكبرى من الوجود الإنساني، وقد ذكر القرآن هذه الفكرة في سورة (الذاريات:56) : “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ”.
الميثاق القرآني يتميز بتركيبة تبادلية، فالبشر ملزومون بالوفاء بعهدهم، وبالمقابل فلا يُتصور أن الله عز وجل “الحكيم” سيخلف وعده لهم (الرعد:31)، وخُلِقت هذه الحياة الدنيا كساحة اختبار لهم كما ذُكِر في القرآن في سورة الملك الآية 2: ” ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا”، وعندما يعودون لربهم فهم موعودون بالجزاء على ما فعلوه في الحياة الدنيا بناءً على الحالة الداخلية لقلوبهم (الشعراء:89) وأفعال جوارحهم (النور:24).
ومع ذلك فقد ذكر في سورة الأنعام 54: “كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ”، وهكذا يتوازن عدل الله مع رحمته كسمةٍ ظاهرة لله، ويمكننا أن نلحظ نفس الشيء على المستوى الإنساني حيث إن طبيعة العدل مسبوقة بالإحسان.
في الإنجيل المسيحي، تمت تسمية العهدين القديم والجديد بذلك وفقاً لمسمىً إنجليزي عتيق لـ”الميثاق”، والفكرة أن ميثاقاً قديماً مع ولي من الأولياء كإبراهيم في سفر التكوين 17، والذي جُدّد مع الإسرائيليين من بعده، قد حلّ محله أو كمّله ميثاقٌ جديدٌ آخر لأتباع المسيح، القرآن من جهةٍ أخرى يقدّم ميثاقاً دائماً مع كل البشرية كما بيّن ذلك في سورة الأعراف 172-173: “وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173)”
الآيتان تستحضران لحظةً زمنيةً قديمة ارتبطت فيها البشرية جمعاء بميثاقٍ مع الله مؤكدين طاعتهم له، الآية الأولى تقرّب القارئ مباشرةً من المشهد حيث حصل الميثاق جاعلة القرّاء على مقربة من الحدث، أما النداء الإلهي في الآية والاستجابة له يمكن أن يعطي مؤشرًا حول النزعة الطبيعية عند البشر نحو الميل للإيمان بالله وطاعته، والمعطى المنطقي لهذه الشهادة هو إقامة حجّة عليهم يوم القيامة في حال إنكارهم لمسؤوليتهم كعبيدٍ لله أو لوم أسلافهم على عدم إيمانهم، إذن فالميثاق هو توكيد تمّ لعلاقةٍ سابقة موجودةٍ بين الرب والعباد يكون فيها العباد ليس فقط مدركين للآثار الأخلاقية الأوّلية المترتبة عليها فحسب، بل ومؤكدين للمُساءلة أمام الخالق، هنا يتّضح المفهوم المركزي للدين في أن يعيش المرء حياته بصفتها صفقةً لدَينٍ سيحاسبه الله عليه يوم الدين.
في المرحلة الأولية للتاريخ تم توثيق خلقِ كل مخلوقٍ على أنه دَينٌ تجاه الله، ثم تلت تلك المرحلة هذه المرحلة الدنيوية حيث يصرف البشر حياتهم في عبادة خالقهم موفين بالعديد من “الالتزامات” والتي وُضعت لهم بأمر إلهي، وفي اليوم الآخر المحتوم سيكون إمّا صفقةً رابحة أو خاسرة مستمرة إلى الأبد.
قصة آدم في القرآن تحاكي حياة أحفاده وسلالته، راسمةً لهم المجال الأخلاقي لحياتهم عبر تقديم مفاهيم كالاستخلاف والطاعة والإثم والتوبة، سجلت لنا الآية 30 من سورة البقرة حواراً بين الله وملائكته حيث يقول لهم:” إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً” وتقول الملائكة في نفس الآية: “أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ” فيقول الله عز وجل:” إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ”.
هناك نقاشٌ عريض في كل من الأدبيات التفسيرية المبكرة والدراسات الأكاديمية الحديثة حول معنى الخليفة في هذا السياق، مقترحةً بعض الاحتمالات الممكن كـ: الوريث، والنائب، والبديل، والعامل، والحاكم، يقدم الراغب الأصفهاني (ت 422 هـ/1031م) تحليلاً ثاقباً لمصطلح الخلافة باعتباره تمثيلًا لشخصٍ آخر إما لغائبٍ أو متوفىً أو عاجزٍ أو تكريماً للممثل نفسه، بما أن المعاني الثلاثة الأولى لا يمكن نسبتها لله، فإن المعنى النهائي لممثل أو نائب مكرّمٍ يناسب سياق فعل الخلق في الآية السابقة.
يكشف هذا المعنى عن سؤالين مهمين: ما هو معنى نائب أو ممثل الله؟ ولماذا قد تنسب الملائكة الفساد وسفك الدماء لمثل هذه الشخصية المكرمة؟ يتّضح من البيان الأولي ومن الرد الملائكي أن كلمة “خليفة” ليست محصورةً في آدم وحده، ولكنها شاملة لكل سلالته من الخلق الآدمي، هذا الأسلوب متوافق مع الاستخدام العربي حيث يستخدم اسم شيخ القبيلة أوالعشيرة للإشارة إلى أفراد ذات القبيلة، وكما تبيّن الآيات 31-33 من سورة البقرة، فإن البشر يتميزون بمكانة خاصةٍ بسبب قدرتهم على تعلم الأشياء في نطاق المخلوقات: “وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (33)”
تعليم آدم الأسماء قد يرمز لقدرة البشر على تكوين نوع من التقييمات الأخلاقية، كما يرمز لسلطةٍ على باقي المخلوقات وقوةٍ قادرةٍ على استزراع الأرض لأجل البشرية، وعلى النقيض فإن الإشارة إلى الإفساد في الأرض وإراقة الدماء فيه إلماحةٌ لما يملكه البشر من إرادةٍ حرة وإمكانيةٍ لرفض دورهم المناط بهم، والملائكة متفاجئون أن الله سيودع مسؤوليةً كهذه لمخلوقٍ غير قادرٍعلى ممارسة السلطة بعدالة كاملة، في صورةٍ مغايرةٍ تماماً لما هم عليه من الطاعة المطلقة لله عز وجل، والجواب “إنّي أعلمُ ما لا تعلمونَ” قد يشيرُ لتفوق الإنسانية المُعيبة ولكن ذات الإرادة الحرة، على نظيرتها الملائكية الكاملة الطاعة والتي لا إرادة لها، ومن المحتمل أيضاً أنها إشارةٌ هنا للهدى الذي سيرسله الله على يد رسله وأتباعهم لجلب الهداية وإقامة العدل.
ويكمل السياق القرآني أصداء هذين الجانبين السلبي والإيجابي للكائن البشري، فأشارت الآية 34 إلى الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم تكريماً له ورفض إبليس للسجود وقد شمله الأمر، وقدّمت لنا الآية 35 أول التزامٍ وطاعةٍ لأول كائنين بشريين: ” وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ”، وكان عصيانهما للطاعة سبباً أدّى لنزولهما لهذا العالم كما في الآية 36.
يهمس الشيطان لآدم: “قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ” (طه:120)، وفي هذا دليل على أنه وبرغم طبيعة الجنة الساحرة فإن آدم علم أنه حتماً سيموت ويُواجه حسابه، ويبدو أن جاذبية الشجرة كانت أنها ستعطيه طريقاً مختصراً للفردوس دون المرور بحالة الموت، كما قال الشيطان: “وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ” الأعراف 20، بالإضافة إلى أن حقيقة أن الله أخبر الملائكة قُبيل ذلك أنه سيستخلف في الأرض خليفةً فيه إشارة لعلم الله المسبق بمحصلة هذا الاختبار، كما يوضح للبشر النماذج الأساسية للطاعة والإثم والتوبة، ثم بعد ذلك: “فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ” والتي غالباً ما تُفسر أنها دعاء الاستغفار في ” قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ” (الأعراف:23)، وتُكمل الآية: ” فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ”، وأخيراً عندما أمر الله آدم وزوجه أن يهبطا لعالم الدنيا أعطاهم وعده الإلهي بالهداية والإرشاد في إشارة للتدبير المستقبلي للوحي، كما أخبرهم أين ستنتهي قصة البشر فإما في عودةٍ دائمةٍ للجنة وإما عذابَ الجحيم (البقرة 38-39).
الفطرة
قادت قصة آدم إلى النزول البشري لهذه الحياة الدنيا، لكن ما هي الحالة الأخلاقية لهذا المنزل الجديد وللمولودين فيه؟ إن الحالة التي يرسمها القرآن تُظهِر أن لعالمنا فضائل أساسية يُتوقع من البشر أن يتفاعلوا معها، وبما أن الميدان صمّم للمسؤوليات الامتحانية للدين والاستخلاف فمن المناسب لذلك أن يكون الخلق ذاته أتى مع ضبط أخلاقي مدمج، وهي فكرةٌ ذكرها القرآن توريةً تحت مسمى الميزان (الرحمن 7-12): “وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12)”
إن وضع الله عز وجل للميزان يوحي إلى اختبار قدرة البشر (والجن) على العيش وفقًا له، فوضع الميزان بين وصف السماء ووصف الأرض بنباتاتها وحيواناتها يعني أنه أمر طبيعي وقابل للتطبيق كونياً في أنحاء النظام المخلوق، والأمر الإلهي: “وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ” يستثمر استعارةً مجازية للمجتمع العادل، ويقاس مستوى الفعل الإنساني بشكل يعكس الصورة الدينية لدى الإنسان لقياس العدالة الأرضية وفقاً للمعيار الموضوع من الله، ويشير هذا التوصيف إلى موضوع الحرية الأخلاقية حيث إن الأمر بإقامة العدل يفترض احتمالية أن المخاطب قد لا يلتزم بذلك، وهذا يؤكد اختلافنا عن الحيوانات والتي تصنف بجانب النباتات كمجرد مُتلقٍ وليس ممثل للخيارات الأخلاقية.
ونظرًا لكون البشر جزءًا من هذا النظام المخلوق فمن المنطقي أنهم سيعكسون تركيبات مقياسه، وهذا الأمر طُرح في القرآن تحت مفهوم “الفطرة”: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” (الروم:30). هذه الآية قد تقرأ كتأييد قرآني لفكرة أن البشر بطبيعتهم يتجهون لتحصيل الإيمان والأخلاق، وهذا قد يكون ناتجًا عن ميثاق الأمانة (الأحزاب:72) وقد يكون السبب أنه لم يُعرف من خالف من الأرواح البشرية في الإشهاد (الأعراف:172) وكما هي متربطة في أدبيات علم التفسير.
هذه القراءة للفطرة على أنها ميلٌ قائمٌ للنفس البشرية نحو معرفة الله وعبادته يتواجه مع نزعتها نحو الإغراء الشيطاني وخداعها من قبل متع الحياة الدنيا، وبرغم أن هذا قد يقود لانهيار هذه الحالة البريئة الابتدائية فإنه لا وجود لمفهوم الخطيئة الأصلية في الرؤية الكونية القرآنية، ومثلما تحوي قصة سقوط آدم قي ثناياها الغفران والعفو: تبدأ حياة كل إنسان من نفس النقطة كآدم بالعودة إلى حالة الفطرة واختباره مجدداً كما سبق، وإذا تم التسليم بوجود إطار أخلاقي موضوعي للعالم فإن السؤال المعرفي حول ما إذا كان ذلك معروفاً قبل وصول الوحي أم لا يظل باقيًا، يجب التمييز أولًا بين ما يمكن معرفته وماهو معروف عادةً في أي مجتمع، ينتقد القرآن جزءًا كبيرًا من البشرية باعتبارهم ضالين عن الحق: “وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ” (الأنعام:116).
انطلاقًا من التفسير السابق للميثاق والمعيار فإنه من المنطقي فهم أن القرآن يؤكد أن القواعد الأخلاقية الأساسية معروفةٌ بشكل عقلاني للإنسان في حالة الفطرة، وبالرغم من ذلك فإن السؤال متوازن بدقة مع التفسيرات التي تتحدى هذا الافتراض، ومن الآيات التوضيحية المتنازع عليها: ” وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا” (الإسراء:15)، والتي يمكن أن تُفهم كموقف متطرف أن الالتزام الأخلاقي للإنسان مبني على ما أُنزِلت به الرسل، أو أن تُفهم كبيان لسنة الله عز وجل في إرسال النُذُر قبل تدمير قومٍ ما كما هو مذكور عادةً في القرآن.
تكمن الصعوبة في استخدام آياتٍ كهذه الآية الماضية لتأييد الفكرة السابقة أن الآية يجب أن تنفصل عن سياقها النصي لتخدم حجّة تنبع من التساؤلات اللاهوتية، لا القرآنية، تشير الآيات 4-7 في سورة الإسراء إلى نبذةٍ تاريخية من التحذيرات والعقوبات التي وقعت على بني إسرائيل، بينما تبدأ الآية التي تلي الآية 15 من نفس السورة ب:” وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً” مما يشير إلى أن معنى الآية توصيفي وليس إلزامي: أي أن من السنة الإلهية في التعامل مع الأقوام السابقة أن يرسل الله لهم المنذرين لهم قبل أن يأخذهم كم توضح الآية التي تليها: “وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا” (الإسراء:17).
النبوة
يخبر القرآن أن الله يعرف مواطن ضعف الإنسان بدقة: القلب والتهديد المستمر عليه من وساوس الشيطان، وإغراءات الحياة الدنيوية ودوافعها الأنانية، هو لا يترك البشرية وحدها منغمسةً في الفساد بل يرسل لهم الرسل بالهدى والهداية، وهذا ينسجم مع الفطرة التي تقابلها ويكمّلها لمساعدة البشرية في التغلب على ضعفها لتأكيد عهدها وميثاقها للإيمان بالله وعبادته.
يذكر القرآن في مواضع عديدة أن البشرية بشكل عام كانت أمةً واحدة، مثل قوله: ” وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا” (يونس:19)، وفي “كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ” (البقرة:213)، وفي سياق آخر في آياتٍ كـ (النمل:93) و(السجدة:8) و(المائدة:48)، والتي تشير على أغلب الظن إلى مرحلةٍ متقدمة من التاريخ يقول فيها الله أنه كان بالإمكان أن يجعل الناس أمة واحدة لكن الحكمة الإلهية اقتضت الاختلاف بينهم.
جانبٌ من هذه الحكمة قد وُضّح في قوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتقاكم” )الحجرات:13(، هذه الآية يتجلى فيها الرفض الحاسم لأي نوعٍ من أنواع التمييز العرقي، وخلقُ أممٍ متنوعة يزيد من فرصة حدوث التجربة الكونية في لقاء الآخرين الذين يختلفون عنا في الثقافة ومع ذلك نتشارك معهم هذه الذات الإنسانية، وجعل التقوى هي المعيار القياسي يضمن ألا تلعب الظروف المادية أي دور في النجاح الأخروي فيما يتعلق بالأخلاق.
وكما أنه يستخدم كوصفٍ عام للإنسانية جمعاء، فإن مصطلح أمة يستخدم أيضًا لوصف أمةٍ نبوية محددة بعينها كما في قوله:” وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ” (الأعراف:159)، كلمة ملّة تبدو كمصطلح لنفس الفكرة الأممية وهي مرتبطة تحديدًا بإرث نبي الله إبراهيم كما في قوله:” ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ” (النحل:123)، ويحوي القرآن أيضًا مفهوم الأخوة فعلى مستوى البشر كلهم يذكر القرآن:” يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً” (النساء:1)، وأما بالنسبة للأمة المؤمنة تحديداً ففي قوله:” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ” (الحجرات:10).
وبما أن الملة تكون مرتبطةً بنبي معين فهي تتلقى وحيًا خاصًا من شريعة الله، هذا المفهوم للقانون الإلهي والأخلاقي للإنسانية له أساسٌ ضمني في النص الشرعي وله أيضًا أساسٌ صريح مباشر في قوله:” ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا” )الجاثية:18(، وكلمة شريعة في اللغة العربية مشتقة من الطريق المؤدي لمورد الماء، مما يشير بشكلٍ رمزي للطريق المؤدي للشيء الأكثر أهمية في حياة الإنسان، يجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد في المعجم العربي القرآني فرقٌ جليّ بين مصطلحي القانون والأخلاق حيث ينسجم الاثنان مع بعضهما تحت مظلة الشريعة.
تبرز العديد من النصوص القرآنية دور الأنبياء والرسل كمبشرين ومنذرين في إشارة ضمنية للوعد بالجنة أو التخويف بالنار، ويأتي النمط القرآني في سياق وصف كل رسول من الرسل بمناداته لقومه بالنداء المتكرر: “يا قومِ”، بينما أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام للناس والجن أجمعين كما ذُكر في (الأنبياء:107) و(الأحقاف: 29-31) و(البقرة:151)، وأخبر الله بتفصيل السبب في إرسال النبي محمد لسكان الجزيرة العربية في قوله: ” كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ”
كلمة “آياتنا” يمكن تفسيرها بالعلامات أو الوحي والبراهين أو الآيات القرآنية، في هذا السياق في الحديث عن النبي تتوافق كل هذه التفسيرات بقدرٍ ما عند استصحاب بلاغة الآيات القرآنية بما يثبت مصدرها المقدس، فالمصطلح يشير إذن إلى الوسائل التي أنتجت موثوقية النبي كمتحدثٍ عن الله وكباعثٍ للإيمان في أمته والتي وبدونها لا يستطيع الاستمرار في مهمته، ثم تأتي “التزكية” والتي هي مبنيةٌ على أساس التغيير الداخلي خيرًا كان أو شرًا، فهي ما يكفل النجاح أو الخسران في الدنيا والآخرة، ويمكن ربط هذا المقام بمقام روحي أسمى وهو مقام الإحسان: وهو السمو فوق المتطلبات الأساسية للطاعات المفروضة لتحصيل المناقب العليا.
بالعودة للفظتي الكتاب والحكمة، فإنّي أرى أنه يمكن تطوير قراءةٍ متسقة من خلال فهم المصطلحين المقترنين بشكل عام على أنهما يشيران للواجبات المأمور بها والمبلغة من قبل الرسل ومقاصدهم الحكيمة، هذا التفسير يتحاشى التهمة التي يمكن توجيهها عند تفسير المصطلح بالكتاب والسنة للشافعي (ت 204 هـ) بأنها لا تأخذ بالحسبان المدى الواسع الممكن للاستخدام النصي للمصطلح.
وبالطبع فكما أن احتمالية فهم كلمة “كتاب” على أنها تشير إلى القانون لا يمنع بالضرورة أنها تشير أيضًا إلى المعنى الكلي للوحي، فقراءة “الحكمة” على أنها ترمز لمنطق القوانين الإلهية لا ينفي من القرآن الحكمة غير المرتبطة باتباع الأوامر، ومثل ذلك بارز في العديد من القصص والأمثال القرآنية كما في قوله تعالى: “وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ” (القمر: 4-5).
إذا تم فهم الكتاب والحكمة اللذان جاء بهما الرسل ضمن النظرة الكونية القرآنية على أنهما الأوامر الإلهية وحكمته في خلقه، فيصبح من المهم حينها أن نربط هذا بالإطار الأوسع لحياة الناس، والآية الرئيسية التالية تمرر هذا المفهوم الأوسع: “لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ” (الحديد:25).
هذه الآية تحملُ أهميةً خاصة لأنها تجمع بين الخيوط المختلفة التي تمت مناقشتها حتى الآن، وتعمل كنقطة انطلاق لبيان موضوع العدالة المجتمعية، في سياق الآية تم إعطاء الرسل ثلاثة أمورٍ: البراهين لإثبات صدقهم، على غرار مصطلح “الآيات” المذكور آنفًا، والأوامر والالتزامات من قبس الوحي والميزان في إشارةٍ لمقياس الأخلاق أو القانون الطبيعي المحدد داخل الخليقة، وهذه الآية مرادفة لقوله تعالى: “اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ” (الشورى:17)، جُعلت هذه الأمور الثلاثة لسبب معين وهو تمكين البشرية من إقامة القسط، وكلمة “قسط” هي إحدى كلمتين عربيتين في المفردات القرآنية تطابق معنى كلمة “Justice” في اللغة الإنجليزية، الكلمة الأخرى هي “عدل”، يمكننا أن نستنتج بالاعتماد على دراسة معانيهما اللغوية والكتابية أن هذين المصطلحين لهما دلالات مختلفة تتعدى المعنى العام للعدالة: العدل هو الخاصية الذاتية للمساواة، والقسط هو عدلٌ نشأ بشكل أساسي في المجال المجتمعي.
هذا الفهم للقسط بالإضافة للمبحثين السابقين للميزان والحكمة يمكّننا من وضع التعريف التالي: العدالة المجتمعية هي حالة المجتمع التي تتحقق بحكمة أوامر الله والتي تتناسب مع ميزان القيمة الأخلاقية، مثل هذا المجتمع العادل هو أسمى طموح أخلاقي للحضارة الإنسانية كنشاط منظم، يتجلى فيه كل القيم الأخرى الجديرة بالثناء مثل الرحمة والخير والتقوى، وبالنسبة لكل إنسان فإن دينه يتوقف على محاولته لتحقيق خلافة الإنسان في الأرض والمصير الرابح في الآخرة، وكما يشير (العطاس) فإن مفهوم الدّين يستلزم إنشاء حضارةٍ على الأرض بسمات عامة معينة تشمل: “الميل الطبيعي للإنسان لتشكيل المجتمعات اتباع القوانين والسعي إلى حكومة عادلة”.
فالخطاب القرآني يفترض ضمنيًا أن المجتمع العادل مبني على أسس القانون الطبيعي، يتجسد هذا النمط في القرآن في شخص النبي محمد ﷺ الذي عاش في ذروة التاريخ المقدس وتلقى الوحي الأخير المُنزل في دورة الإصلاح والإفساد، لذلك وُصِف بخاتم النبيين في سورة (الأحزاب:40)، وهو ما يتطابق مع ما ورد في (آل عمران:81) من أن الله أخذ عهدًا من الأنبياء يؤكد سلطانه عليهم، وينعكس هذا في عدة آيات تنص على أنّ على أمة المؤمنين أن يكونوا شهداء على سائر الأمم في الدنيا والآخرة والرسول هو كذلك شهيد عليهم، وهكذا يتصور القرآن أن النبي محمد ﷺ هو مبعوث السلطة الإلهية والخليفة الأخير لجميع الأنبياء، خليفة الله بامتياز، ومع ذلك فحقيقة أن القرآن موجَّه للنبي وليس عنه تعني أن المفسرين كثيرًا ما وجدوا دليلًا على ما سبق في خفايا العبارات بدلًا من العبارات الصريحة، يفسر الألوسي (ت 1270) قوله تعالى: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً” (البقرة:30)، حيث يقول إن توجيه الخطاب مباشرة إلى النبي هنا يلقي الضوء على أن عليه الجزء الأكبر من الخلافة المذكورة، و يصور القرآن النبي محمد ﷺ كالنبي إبراهيم من قبله، مَثلًا في السلوك الواجب اتباعه: ” لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا” (الأحزاب:21)، هذا الامتياز هو في المقاصد الكبرى التي من أجلها خُلق البشر ليقوموا بإرساء العدالة المجتمعية كخلفاء لله، وأخيرًا ليتمكنوا من العود إليه فرحين في الآخرة.
الحياة الشخصية للنبي ﷺ مرتبطة أيضًا بهذا السياق، الآية التالية تكررت مرتين في القرآن الكريم: “هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ” (الصف:9) و(التوبة:33).
وهناك آية مشابهة في سورة الفتح 28 لكنها استبدلت “ولو كره المشركون” بقوله -سبحانه- “وكفى بالله شهيداً”، يمكن قراءة هذه الآية على أنها تدل على اكتمال الوحي الإلهي رغمًا عن عداوة المعارضين للنبي وهو تفسير منسوب إلى الصحابي ابن عباس.
ونقيضًا لذلك فإن إحدى اتجاهات التفسيرات القرآنية المنتشرة في الترجمات الحديثة للقرآن يفسر “ليُظهره على الدين كله” بقوله “جعله مهيمنًا على جميع الأديان الأخرى”، ومع ذلك فإن هذا الرأي لا يتناسب مع البناء اللغوي للآية من ناحيتين: أولًا كلمة دين هنا جاءت بصيغة المفرد وليس الجمع، ثانيًا عندما يستخدم القرآن التعبير “أظهر/يُظهر على” فإنه لا يشير للهيمنة بل لجعل الشيء معروفًا، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الآية الثالثة من سورة التحريم والتي تشير إلى أن الله كشف للنبي سرًا متعلقًا بزوجاته، وما جاء في سورة الجن في الآية 26 والتي تنص على أن الله لا يكشف الغيب لأحد إلا من ارتضاه من رسول كما وضحت الآية التي تليها.
نقطةٌ أخرى هي أن كلا الآيتين، (الصف:9) و(التوبة:33) يتبعان آياتٍ يُذكر فيها أن الله عز وجل “يتّم نوره”، ويمكن فهم هذا بمعنى الوحي المتتالي للنبي محمد الذي ينير معرفته بشرع الله، وقد أُعلِن عن اكتمال مرحلة التنزيل أثناء الحجة الوحيدة للنبي في السنة العاشرة للهجرة، عندما تلا تلك الآيات الخالدة: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا” (المائدة:3).
الآخرة
المرحلة الأخيرة من الرحلة الروحية وفقًا للقرآن هي مثل المرحلة الأولى في أنها تحدث في عالم يتجاوز المعرفة البشرية الطبيعية ويتعلق بكل ما يأتي بعد الموت بما في ذلك القبر نفسه والقيامة الكبرى، ويوم الحساب والمقام الأخير في الجنة أو النار.
يواجه الإنسان عند الموت حقيقةٌ كانت حتى ذلك الحين غائبةً عن الأنظار، ويدرك الإنسان حينها المسؤولية الأخلاقية على الفرد ويعي حقيقة العودة لله للحساب، كما في قوله: ” وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ” (ق:19).
يقول الغزالي: “عند الموت تُكشف أمامه أشياء لم تتكشف له من قبل في حياته، كما تنكشف أمورٌ للرجل المستيقظ كانت قد أخفيت عنه في سباته، فكذلك الناس في سباتٍ وعند الموت يستيقظون”
إن النتيجة المنطقية للالتزام الأخلاقي هي وجود جزاءٍ بالمقابل، إما مكافأة أو عقوبة، وهذا ما توفره الساحة الأخروية، إن صدق الشخص مع الميثاق والإقرار بربوبية الله هي الواجب الأساسي ويبرزها الله إلى جانب اتباع رسله، والسلوك الظاهري، وعباداته، ونقاء القلب الداخلي، وبناء على ذلك يُرسَل الإنسان إلى مصير الجنة أو النار، ومن البديهي في القرآن أن الله عادل تمامًا في تنفيذ حكمه كما يقول: “وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون” (يونس:54).
هذا المفهوم عن العدل الإلهي الكامل مبني على فكرة أن الله وضع الحساب الذي يأخذ بالحسبان كل صغيرة وكبيرة ولا تظلم فيه روح واحدة: ” وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ” (الأنبياء:47).
في هذه الآية موازين العدل في الآخرة موازية للميزان المعدّ لقياس القيمة الأخلاقية في الحياة الدنيوية، ووصْفُ اللهِ عز وجل نفسهُ بأنه لا يظلم عباده هو أيضًا طبعٌ لغويٌ مهم في القرآن عند الحديث عن عدله سبحانه، المعنى المستخلص أن هناك معايير كحد أدنى وأعلى لشريعة إقامة العدل في الآخرة: لا تقليل من الحسنات ولا زيادة على السيئات كجزاء.
وأيضًا بعد ترسيخ هذه الفكرة بناءً على حكمة الله، فإن لله الحق في مضاعفة أجر الأعمال الصالحة، وهذا مصرّحٌ به في آيات مثل: ” وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ” (البقرة:261)، ومثل ذلك في مغفرة الذنوب، أما فيما يخص الذنوب العظيمة فقد ذكرت في قوله تعالى:” إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا” (النساء: 48)، ومع ذلك فحتى الشرك يمكن أن يُغفر بالتوبة الصادقة قبل الموت كما ذكر في سورة (النساء: 110)، بينما الذنوب والمعاصي التي تحدث في حالة انعدام الإيمان يمكن أن تُغفر أو تبدّل لحسنات من الله عز وجل عند حضور الإيمان كما في الآية 70 من سورة الفرقان.
إذن هناك فكرة توحيدية مضمنة يمكن استبانتها في الوعد الثنائي في القرآن بعدم ظلم الله للعباد وبحضور رحمته سبحانه، وبدلًا من أن يكون هذان العنصران مجرد تعبيرين كيفيين لإرادته بحيث تكون كل عقوبةٍ عادلة وكل أجر رحمة، فإنهما يعكسان السر العميق لحكمته، فرحمة الله واسعة ولكنها تصل للبشر وفقًا لشروطه.
أظهر هذا المبحث أن قراءة قصة القرآن لحالة الإنسان بشكل كلي يمكن أن تزودنا بجوانب أساسية لعلم اللاهوت الأخلاقي الخاص بها والذي يُفقد عند النظر في الآيات متفرقةً، الفكرة المهيمنة في هذه السردية هي حكمة الله في خلق الحياة كدَين مستحق والنجاح في اختبار الأخلاق هي طريقة سداده، وعلى الرغم من أن موضوع الحكمة هذا يجعل الحياة البشرية حياةً ذكيةً ذات هدفٍ إلا أنه لا يزال هناك عنصر عدم القدرة على الوصف في استعمالها كخاصية لوصف العلم الإلهي، في العالم المخلوق يتم تمثيلها بالميزان والذي يٌقرأ كمرادف قرآني للقانون الطبيعي، وهذا التفسير السياق القرآني العام بالإضافة لفكرة الفطرة تحديدًا يقود لمعرفة العادات الأخلاقية الأساسية على الأقل قبل الإقبال على الوحي، إذن فالعدالة التي يأمر القرآن أتباعهُ بإقامتها تقوم على إدراك حكمة التشريعات الإلهية بحيث تُبنى على القانون الطبيعي.
اقرأ ايضاً: انقيادٌ لا يلوي على حكمة