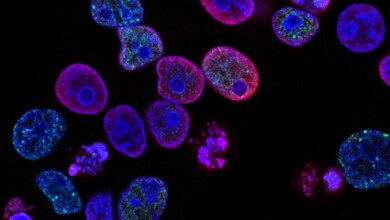- بيتر هاريسون
- ترجمة: وائل وسام
- تحرير: غادة الزويد
في عام 1966، قبل ما يزيد قليلاً عن 50 عامًا، تنبأ عالم الأنثروبولوجيا المميز الكندي المولد أنطوني والاس بثقة بزوال الدين العالمي نتيجة لتقدم العلم، فقال: ”إن الإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة محكوم عليه بالزوال في جميع أنحاء العالم نتيجة لزيادة كفاية وانتشار المعرفة العلمية“. لم تكن رؤية والاس هي الوحيدة؛ بل على العكس من ذلك، فإن العلوم الاجتماعية الحديثة -التي تشكلت في أوروبا الغربية في القرن التاسع عشر- اتخذت تجربتها التاريخية الحديثة الخاصة بالعلمنة كنموذج عالمي.
إن الافتراض في جوهر العلوم الاجتماعية ينص على أن جميع الثقافات ستلتقي في النهاية على شيء شبيه جداً بالديمقراطية العلمانية الغربية الليبرالية؛ إلا أن ما حدث تقريبا هو العكس.
لم تفشل العلمانية في مواصلة مسيرتها العالمية الثابتة فحسب، بل إن دولًا متنوعة مثل إيران والهند وإسرائيل والجزائر وتركيا إما استبدلت حكوماتها العلمانية بحكومات دينية، أو شهدت صعود حركات قومية دينية مؤثرة. فالعلمنة التي تم التنبؤ بها من خلال العلوم الاجتماعية أصبحت فاشلة.
من المؤكد أن هذا الفشل ليس بلا استثناءات. فلا تزال العديد من الدول الغربية تشهد انخفاضًا في المعتقدات والممارسات الدينية. تظهر أحدث بيانات التعداد السكاني الصادرة في أستراليا، على سبيل المثال، أن 30% من السكان يعتبرون أنفسهم “بلا دين”، وأن هذه النسبة في تزايد. كما تؤكد الاستطلاعات الدولية مستويات منخفضة نسبيًا من الالتزام الديني في أوروبا الغربية وأستراليا، حتى الولايات المتحدة، التي كانت مصدرًا قديمًا للإحراج لأطروحة العلمنة، شهدت ارتفاعًا في نسبة الانسلاخ من الإيمان.
تبلغ نسبة الملحدين في الولايات المتحدة الآن أعلى مستوياتها على الإطلاق -إذا كانت كلمة أعلى صحيحة- حوالي 3%. إلا أنه على الصعيد العالمي، لا يزال العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متدينين مرتفعًا، وتشير الاتجاهات الديموغرافية إلى أن النمط العام للمستقبل القريب سيشهد نموا دينيا، لكن هذا ليس الفشل الوحيد لأطروحة العلمنة.
توقع العلماء والمفكرون وعلماء الاجتماع أن يؤدي انتشار العلم الحديث إلى زيادة العلمنة -وأن العلم سيكون قوة لعلمنة المجتمعات- لكن الأمر لم يكن كذلك. إذا نظرنا إلى تلك المجتمعات التي يظل الدين فيها نابضًا بالحياة، فإن سماتها المشتركة الرئيسية لا تتعلق بالعلم، بل تتعلق أكثر بمشاعر الأمان الوجودي والحماية من بعض أوجه عدم اليقين الأساسية في الحياة. قد تكون شبكة الأمان الاجتماعي مرتبطة بالتقدم العلمي ولكن بشكل فضفاض فقط، ومرة أخرى فإن حالة الولايات المتحدة مفيدة هنا.
يمكن القول إن الولايات المتحدة هي المجتمع الأكثر تقدمًا علميًا وتكنولوجيًا في العالم، ولكنها في نفس الوقت أكثر المجتمعات الغربية تدينًا. كما لخص عالم الاجتماع البريطاني ديفيد مارتن في كتابه مستقبل المسيحية (2011): “لا توجد علاقة ثابتة بين درجة التقدم العلمي والمظهر المنخفض للتأثير، والمعتقد، والممارسة الدينية”.
تصبح قصة العلم والعلمنة أكثر إثارة للاهتمام عندما ننظر إلى تلك المجتمعات التي شهدت ردود فعل كبيرة ضد الأجندات العلمانية.
دافع أول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو عن المُثُل العلمانية والعلمية، وقام بإدراج التعليم العلمي في مشروع التحديث. كان نهرو واثقًا من أن الرؤى الهندوسية لماضي الفيدية والأحلام الإسلامية للثيوقراطية الإسلامية (الحكم الإسلامي) ستخضع للمسيرة التاريخية التي لا هوادة فيها للعلمنة، وأعلن قائلاً “ليس هناك سوى تيار ذو اتجاه واحد يسير نحو العلمنة”. ولكن بالنظر إلى الارتفاع اللاحق للصراع بين الأصولية الهندوسية والمسلمين، فقد كان نهرو مخطئًا. علاوة على ذلك، فإن ارتباط العلم بأجندة العلمنة، أدى إلى نتائج عكسية، حيث أصبح العلم ضحية جانبية لمقاومة العلمانية.
يعد تقدم تركيا حالة أكثر دلالة. مثل معظم القوميين الرواد، كان مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، علمانيًا ملتزمًا. اعتقد أتاتورك أن العلم مقدّر له أن يزيح الدين، ومن أجل التأكد من أن تركيا كانت على الجانب الصحيح من التاريخ، أعطى أتاتورك العلم -ولا سيما علم الأحياء التطوري- مكانًا مركزيًا في نظام التعليم الحكومي للجمهورية التركية الوليدة. نتيجة لذلك، أصبح التطور مرتبطًا ببرنامج أتاتورك السياسي بأكمله، بما في ذلك العلمانية. هاجمت الأحزاب الإسلامية في تركيا -في سعيها لمواجهة المثل العلمانية لمؤسسي الدولة- تعاليم التطور. بالنسبة لهم، يرتبط التطور بالمادية العلمانية. بلغ هذا الشعور ذروته حيث تم اتخاذ قرار في شهر يونيو الحالي، بحذف تدريس التطور من المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية. وهنا مرة أخرى أصبح العلم ضحية بالتبعية.
تمثل الولايات المتحدة سياقًا ثقافيًا مختلفًا، حيث أن القضية الرئيسية هي الصراع بين القراءات الحرفية لسفر التكوين والسمات الرئيسية للتاريخ التطوري. لكن في الواقع، فإن الكثير من خطابات داعمي نظرية الخلق تركز على القيم الأخلاقية. في حالة الولايات المتحدة أيضًا، نرى أن مناهضة التطور مدفوعة على الأقل جزئيًا بافتراض أن النظرية التطورية تخفي في طياتها المادية العلمانية والالتزامات الأخلاقية المصاحبة لها كما هو الحال في الهند وتركيا، العلمانية في الواقع تضر بالعلم.
باختصار: العلمنة العالمية ليست حتمية؛ وعندما تحدث، فهذا ليس بسبب العلم. علاوة على ذلك، عند محاولة استخدام العلم لتعزيز العلمانية، يمكن أن لذلك نتائج ضارة بالعلم. كما أن الأطروحة القائلة بأن “العلم يعزز العلمنة” فشلت ببساطة في الاختبار التجريبي، فقد تبين أن توظيف العلم كأداة للعلمنة استراتيجيةٌ سيئة. إن التزاوج بين العلم والعلمانية محرج للغاية لدرجة أنه يثير السؤال: لماذا يرى الآخرون العكس؟
تاريخيًا قدم مصدران مرتبطان فكرة أن العلم سيحل محل الدين، الأول: تمسكت النظرة التقدمية للتاريخ في القرن التاسع عشر -ولا سيما تلك المرتبطة بالفيلسوف الفرنسي أوغست كونت- بنظرية التاريخ التي تمر فيها المجتمعات بثلاث مراحل -دينية، ميتافيزيقية، ثم علمية (أو وضعية). ومن ثم صاغ كونت مصطلح “علم الاجتماع” وأراد تقليل التأثير الاجتماعي للدين واستبداله بعلم جديد للمجتمع، وامتد تأثير كونت إلى حركة “الشباب الأتراك” وأتاتورك.
والثاني: شهد القرن التاسع عشر أيضًا بداية “نموذج الصراع” بين العلم والدين. كان هذا هو الرأي القائل بأن التاريخ يمكن فهمه من منظور “الصراع بين حقبتين في تطور الفكر البشري: اللاهوتي والعلمي”. يأتي هذا الوصف من كتاب أندرو ديكسون وايت المؤثر “تاريخ حرب العلوم مع اللاهوت في العالم المسيحي” (1896)، والذي يلخص عنوانه بشكل جيد النظرية العامة لمؤلفه. أسس عمل وايت، بالإضافة إلى كتاب جون ويليام درابر “تاريخ الصراع بين الدين والعلم” (1874)، نظرية الصراع كنموذج للتفكير في العلاقات التاريخية بين العلم والدين، وقد تُرجم كلا العملين إلى لغات متعددة. طبع كتاب درابر أكثر من 50 طبعة في الولايات المتحدة وحدها، وتُرجم إلى 20 لغة، وأصبح على وجه الخصوص، من أكثر الكتب مبيعًا في أواخر الإمبراطورية العثمانية، حيث فهم أتاتورك أن التقدم يعني أن العلم يحل محل الدين.
اليوم، أصبح الناس أقل ثقة في أن التاريخ يسير عبر سلسلة من المراحل نحو وجهة واحدة، ولا يؤيد معظم مؤرخي العلوم -على الرغم من شعبية هذه الفكرة- فكرة الصراع الدائم بين العلم والدين. انقلبت الاصطدامات الشهيرة -مثل قضية جاليليو- إلى صراع على السياسة والهيمنة، وليس فقط بين العلم والدين.
كما كان لداروين أنصار داخل المؤسسة الدينية مهمون ومنتقدون علميون. والآن اكتُشف أن العديد من الحالات المزعومة الأخرى للصراع بين العلم والدين كانت محض تلفيق.
في الواقع -على عكس الصراع- كانت القاعدة التاريخية في كثير من الأحيان واحدة ألا وهي: الدعم المتبادل بين العلم والدين. اعتمد العلم الحديث في سنواته التكوينية في القرن السابع عشر على الشرعية الدينية، وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ساعد اللاهوت الطبيعي في نشر العلم.
يقدم نموذج الصراع بين العلم والدين رؤية خاطئة للماضي، وعندما يقترن بتوقعات العلمنة، فإنه يؤدي إلى رؤية خاطئة للمستقبل.
فشلت نظرية العلمنة في الوصف والتنبؤ، والسؤال الحقيقي هو لماذا نستمر في رؤية أنصار لفكرة الصراع بين العلم والدين بين كثير من العلماء البارزين؟ من غير المجدي في هذا الصدد أن تتلمس الإجابة في تأملات ريتشارد دوكينز حول هذا الموضوع، لكنه ليس الوحيد على أية حال؛ حيث يعتقد ستيفن هوكينج أن “العلم سيفوز لأنه يعمل”، وأعلن سام هاريس أن “العلم يجب أن يدمر الدين”، ويعتقد ستيفن واينبرغ أن العلم أضعف اليقين الديني، وتوقع كولين بلاكمور أن العلم سيجعل الدين في النهاية غير ضروري؛ إلا أن الدليل التاريخي ببساطة لا يدعم مثل هذه الادعاءات. بل في الواقع، يشير إلى أنهم مضلِّلون.
إذن فلماذا يصرون على رؤيتهم؟
الإجابة هي: السياسة. بغض النظر عن أي ولع طويل الأمد بأفكار غريبة عن التاريخ تعود للقرن التاسع عشر، يجب أن ننظر إلى الخوف من الأصولية الإسلامية، والغضب من نظرية الخلق، والنفور من التحالفات بين اليمين الديني وإنكار تغير المناخ، والمخاوف بشأن تآكل السلطة العلمية. وعلى الرغم من أننا قد نتعاطف مع هذه المخاوف، إلا أنه لا غبار على حقيقة أنها تنشأ من تدخل غير مفيد للالتزامات المعيارية في المناقشة.
التفكير القائم على التمني -وعلى أمل أن ينتصر العلم على الدين- ليس بديلاً عن تقييم موضوعي للواقع الحالي. بل من المرجح أن يكون لاستمرار هذه الدعوة تأثيرٌ معاكس لما هو مقصود.
لن يزول الدين في أي وقت قريب، ولن يدمره العلم. وإذا كان هناك من شيء يحدث في اللحظة الراهنة: فهو أن العلم يخضع لتهديدات متزايدة لسلطته وشرعيته الاجتماعية. وبالنظر إلى هذا، يحتاج العلم إلى جميع الأصدقاء الذين يمكن الحصول عليهم، ويُنصح أنصار هذه الدعوة بالتوقف عن اختلاق العدو (الدين)، أو الإصرار على أن الطريق الوحيد إلى مستقبل آمن يكمن في التزاوج بين العلم والعلمانية.